تاريخ التسجيل: Jul 2016
رقم العضوية : 2
المشاركات: 801
:
:
تاريخ الجزائر الثقافي.Word الجــــزء الثاني
الموضوع:
تاريخ الجزائر الثقافي.doc الجــــزء الثاني بقسم
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الدكتور أبو القاسم سعد الله
تاريخ الجزائر الثقافي
الجزء الثاني
(1500 - 1830)
دار الغرب الاسلامي
تاريخ الجزائر الثقافي
الجزء الثاني
(1500 - 1830)
دار الغرب الاسلامي
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
1998 دار الغرب الإسلامي
الطبعة الأولى
دار الغرب الإسلامى
ص. ب. 5787 - 131 بيروت
جميع الحقوق محفرظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونة أو كهروستاتية، أو أشرطة ممغنطة، أو وسائل ميكانيكية، أو الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.
الطبعة الأولى
دار الغرب الإسلامى
ص. ب. 5787 - 131 بيروت
جميع الحقوق محفرظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونة أو كهروستاتية، أو أشرطة ممغنطة، أو وسائل ميكانيكية، أو الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
تاريخ الجزائر الثقافي
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
فراغ فى الأصل
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
بسم الله الرحمن الرحيم
تنبيهات
- للإحالة على الدوريات ذكرنا اسم الدورية بين قوسين فتاريخها فالصفحة فإذا ذكرنا رقما قبل التاريخ فهو عدد الدورية.
- للإحالة على الكتب المطبوعة ذكرنا أول مرة ما يتعلق بتعريف الكتاب فإذا أشير إليه بعد ذلك نذكر عنوانه بين قوسين فالصفحة منه وإذا كان له أجزاء ذكرنا رقم الجزء تليه الصفحة ويفصل بينهما خط مائل.
- للإحالة على مصدر مخطوط ذكرنا مكانه ورقمه وبعض أوصافه ومكملاته ما أمكن مثل حالته وصفحه أو ورقة الخ.
- وهناك بعض المصادر كنا اطلعنا عليها مخطوطة ثم نشرت، مثل (الثغر الجمالي) و (التحفة المرضية)، فإذا كانت الإحالة مطلقة فتعني المطبوع، وإلا فإن عبارة "مخطوط " تذكر إزاءها.
- لم نختصر عناوين المكتبات مثل: المكتبة الوطنية - تونس، المكتبة الوطنية - الجزائر، الخزانة العامة - الرباط، الخ. تفاديا للالتباس وتسهيلا، للبحث.
- لم تكتب أسماء المؤلفين الأجانب باللاتينية إلا نادرا. وقد حاولنا في نطقها الرجوع إلى أصل لغة المؤلف مثلا شيلر وليس شالير كما هو في الفرنسية، الخ.
- في فهرسة الأعلام اتبعنا التنظيم الأبجدي العالمي، مع الاستغناء عن "ابن" و "أبو".
- زيادة في التوضيح نذكر أسماء المجلات الآتية مع أصلها باللاتينية
- (أنال) annales
تنبيهات
- للإحالة على الدوريات ذكرنا اسم الدورية بين قوسين فتاريخها فالصفحة فإذا ذكرنا رقما قبل التاريخ فهو عدد الدورية.
- للإحالة على الكتب المطبوعة ذكرنا أول مرة ما يتعلق بتعريف الكتاب فإذا أشير إليه بعد ذلك نذكر عنوانه بين قوسين فالصفحة منه وإذا كان له أجزاء ذكرنا رقم الجزء تليه الصفحة ويفصل بينهما خط مائل.
- للإحالة على مصدر مخطوط ذكرنا مكانه ورقمه وبعض أوصافه ومكملاته ما أمكن مثل حالته وصفحه أو ورقة الخ.
- وهناك بعض المصادر كنا اطلعنا عليها مخطوطة ثم نشرت، مثل (الثغر الجمالي) و (التحفة المرضية)، فإذا كانت الإحالة مطلقة فتعني المطبوع، وإلا فإن عبارة "مخطوط " تذكر إزاءها.
- لم نختصر عناوين المكتبات مثل: المكتبة الوطنية - تونس، المكتبة الوطنية - الجزائر، الخزانة العامة - الرباط، الخ. تفاديا للالتباس وتسهيلا، للبحث.
- لم تكتب أسماء المؤلفين الأجانب باللاتينية إلا نادرا. وقد حاولنا في نطقها الرجوع إلى أصل لغة المؤلف مثلا شيلر وليس شالير كما هو في الفرنسية، الخ.
- في فهرسة الأعلام اتبعنا التنظيم الأبجدي العالمي، مع الاستغناء عن "ابن" و "أبو".
- زيادة في التوضيح نذكر أسماء المجلات الآتية مع أصلها باللاتينية
- (أنال) annales
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
- (روكاي) Recueil des notes et mémoires de Constantine
- (نشرة جغرافية وهران) Bulletin de la Société de géographie d'Oran
- (المجلة الإفريقية) Revue Africaine
- (المجلة الآسيوية) Journal Asiatique
- (مجلة العالم الإسلامي) تعني - المجلة التي تحمل هذا الاسم بالإنكليزية والفرنسية، ولكننا فرقنا بينهما بذكر عبارة "بالإنكليزية"، أو "بالفرنسية".
Revue du Monde Musulman
Moslen world review
Société de Géographie D'alger et de L'afrique du nord = Sgaan
- مجلة الجمعية الجغرافية لمدينة الجزائر وشمال إفريقية.
- (نشرة جغرافية وهران) Bulletin de la Société de géographie d'Oran
- (المجلة الإفريقية) Revue Africaine
- (المجلة الآسيوية) Journal Asiatique
- (مجلة العالم الإسلامي) تعني - المجلة التي تحمل هذا الاسم بالإنكليزية والفرنسية، ولكننا فرقنا بينهما بذكر عبارة "بالإنكليزية"، أو "بالفرنسية".
Revue du Monde Musulman
Moslen world review
Société de Géographie D'alger et de L'afrique du nord = Sgaan
- مجلة الجمعية الجغرافية لمدينة الجزائر وشمال إفريقية.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الفصل الأول
العلوم الشرعية
العلوم الشرعية
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
فراغ فى الأصل
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
حول التقليد والتجديد
نقصد هنا بالعلوم الشرعية الدراسات القرآنية كالتفسير والقراءات، والحديثية كرواية الحديث ودرايته، بما في ذلك الأثبات والإجازات، والفقهية من العبادات والمعاملات كالنوازل. وقد كثرت هذه الدراسات بين الجزائريين خلال العهد العثماني حتى أنه يمكن القول بأن أغلب إنتاج الجزائر خلال هذا العهد يكاد ينحصر في العلوم الشرعية والصوفية والمجالات الأدبية. ورغم أن معظم الإنتاج في العلوم الشرعية كان يفتقر إلى الأصالة والجدة، فإن كثرة التأليف فيه يبرهن على سيطرة العلوم المذكورة على الحياة الفكرية عندئذ. ولا شك أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى كون القرآن والحديث كانا المنبع الذي يستمد منه الجزائريون كل ألوان تفكيرهم وأنماط حياتهم.
وأهم ما تميزت به العلوم الشرعية في هذا العهد التقليد والتكرار والحفظ. فالفقهاء قلما اجتهدوا أو استقلوا بآرائهم، بل كانوا يقلدون سابقيهم تقليدا يكاد يكون أعمى. فإذا ما حاول أحدهم أن يشذ عن هذا التيار أقاموا عليه الدنيا وأقعدوها، واجتمع عليه المجلس الشرعي الذي كانت تتدخل فيه الدولة. وفي أحسن الأحوال كان يحكم على المستقل برأيه بعزله من وظيفته. أما في أسوأ الأحوال فالحكم عليه بالتكفير والزندقة. ومع ذلك حاول بعض الفقهاء تحطيم هذا الجدار. ومنهم عبد الكريم الفكون في القرن الحادي عشر (17 م)، وأحمد بن عمار في القرن الثاني عشر، ومحمد بن العنابي في أوائل القرن الثالث عشر. وقد سقنا في الجزء الأول عدة نماذج من ثورة الفكون على الجمود العقلي لدى فقهاء عصره. ونود أن نضيف هنا
نقصد هنا بالعلوم الشرعية الدراسات القرآنية كالتفسير والقراءات، والحديثية كرواية الحديث ودرايته، بما في ذلك الأثبات والإجازات، والفقهية من العبادات والمعاملات كالنوازل. وقد كثرت هذه الدراسات بين الجزائريين خلال العهد العثماني حتى أنه يمكن القول بأن أغلب إنتاج الجزائر خلال هذا العهد يكاد ينحصر في العلوم الشرعية والصوفية والمجالات الأدبية. ورغم أن معظم الإنتاج في العلوم الشرعية كان يفتقر إلى الأصالة والجدة، فإن كثرة التأليف فيه يبرهن على سيطرة العلوم المذكورة على الحياة الفكرية عندئذ. ولا شك أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى كون القرآن والحديث كانا المنبع الذي يستمد منه الجزائريون كل ألوان تفكيرهم وأنماط حياتهم.
وأهم ما تميزت به العلوم الشرعية في هذا العهد التقليد والتكرار والحفظ. فالفقهاء قلما اجتهدوا أو استقلوا بآرائهم، بل كانوا يقلدون سابقيهم تقليدا يكاد يكون أعمى. فإذا ما حاول أحدهم أن يشذ عن هذا التيار أقاموا عليه الدنيا وأقعدوها، واجتمع عليه المجلس الشرعي الذي كانت تتدخل فيه الدولة. وفي أحسن الأحوال كان يحكم على المستقل برأيه بعزله من وظيفته. أما في أسوأ الأحوال فالحكم عليه بالتكفير والزندقة. ومع ذلك حاول بعض الفقهاء تحطيم هذا الجدار. ومنهم عبد الكريم الفكون في القرن الحادي عشر (17 م)، وأحمد بن عمار في القرن الثاني عشر، ومحمد بن العنابي في أوائل القرن الثالث عشر. وقد سقنا في الجزء الأول عدة نماذج من ثورة الفكون على الجمود العقلي لدى فقهاء عصره. ونود أن نضيف هنا
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
قوله عن ظاهرة الحفظ لدى هؤلاء الفقهاء. فقد استشهد ذات مرة، وهو ينعي على صديقه أحمد المقري عدم دقته العلمية واعتماده على الحفظ، بكلام أبي بكر ابن العربي من أن "العلم ليس بكثرة الرواية وإنما هو ما يظهر عند الحاجة إليه في الفتوى من الدراية، وأن السرد للمعلومات إنما حدث عند فساد القلوب بطلب الظهور والتعالي عن الأقران وكثرة الرياء في الأعمال". وقد علق الفكون على هذا من أن ما قاله ابن العربي يعبر عن الواقع في الجزائر وغيرها، فلا ترى إلا من يقول قال فلان قال فلان أو يذكر نص التأليف بدون تغيير. فإن صادف الحكم الحكم نجا وإلا أصبح كالصيد في الشبكة. وهم يفعلون ذلك حبا للمدح وصرفا لقلوب الخاصة والعامة إليه. ولو (سئل عن وجه الجمع بين المتشابهين أو الفرق بين المسألتين يقول النص هاكذا (كذا)، ويستظهر بحفظ النصوص، وهل هذا إلا جمود في غاية الجمود) (1).
ويعتبر نقد الفكون في غاية الصراحة والدقة. ذلك أننا لا نعرف أن فقهاء الجزائر الذين عاشوا في القرن الأول من العهد العثماني قد نادوا بتقديم الاجتهاد العقلي (الدراية) على التقليد (الرواية). فهم كانوا يرددون أقوال المتقدمين ويحفظونها حفظا سطحيا لا عقل فيه ولا تفكير، ويسردون المسائل كما هي في الكتب لا كما تقبلها أو ترفضها عقولهم. ويتظاهرون بالحفظ وقوة الحافظة، وكل العلم عندهم ما حواه القمطر. فإذا عدت إلى كتاب كـ (البستان) لابن مريم تجده لا يترجم لأحد الفقهاء إلا قال عنه إنه كان يحفظ كذا وكذا من الكتب. وقد وصف أحمد المقري معاصروه بأنه كان أحفظ أهل زمانه حتى قال فيه أحدهم بأنه لا يعرف في وقته أحفظ منه، وعندما خرج المقري من المغرب إلى المشرق قيل عنه "خلت البلاد من مثله ومضاهيه " (2). وكثيرا ما وصف المقري بأنه (حافظ المغرب الأوسط)، وهو نفس الوصف الذي أطلق على غيره أيضا، ولا سيما أبو راس الناصر.
وظاهرة الحفظ والتقليد قد جمدت الإنتاج في العلوم كلها، وخصوصا العلوم
__________
(1) عبد الكريم الفكون (منشور الهداية) من تحقيقنا، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1987
(2) عبد الحي الكتاني (فهرس الفهارس) 2/ 14.
ويعتبر نقد الفكون في غاية الصراحة والدقة. ذلك أننا لا نعرف أن فقهاء الجزائر الذين عاشوا في القرن الأول من العهد العثماني قد نادوا بتقديم الاجتهاد العقلي (الدراية) على التقليد (الرواية). فهم كانوا يرددون أقوال المتقدمين ويحفظونها حفظا سطحيا لا عقل فيه ولا تفكير، ويسردون المسائل كما هي في الكتب لا كما تقبلها أو ترفضها عقولهم. ويتظاهرون بالحفظ وقوة الحافظة، وكل العلم عندهم ما حواه القمطر. فإذا عدت إلى كتاب كـ (البستان) لابن مريم تجده لا يترجم لأحد الفقهاء إلا قال عنه إنه كان يحفظ كذا وكذا من الكتب. وقد وصف أحمد المقري معاصروه بأنه كان أحفظ أهل زمانه حتى قال فيه أحدهم بأنه لا يعرف في وقته أحفظ منه، وعندما خرج المقري من المغرب إلى المشرق قيل عنه "خلت البلاد من مثله ومضاهيه " (2). وكثيرا ما وصف المقري بأنه (حافظ المغرب الأوسط)، وهو نفس الوصف الذي أطلق على غيره أيضا، ولا سيما أبو راس الناصر.
وظاهرة الحفظ والتقليد قد جمدت الإنتاج في العلوم كلها، وخصوصا العلوم
__________
(1) عبد الكريم الفكون (منشور الهداية) من تحقيقنا، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1987
(2) عبد الحي الكتاني (فهرس الفهارس) 2/ 14.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الشرعية، وجعلته عبارة عن تكرار ونقل رتيب لأعمال الآخرين.
وإذا كان ابن عمار قد عاب على فقهاء عصره جمودهم العقلي وترهل الفكر عندهم فإن ثورته لم تصل إلى حدة ثورة الفكون ولا ثورة محمد بن العنابي، والواقع أن ابن العنابي كان من أوائل الفقهاء الذين لم يكتفوا بنقد الجمود العقلي بل أضاف إلى نقده اللاذع الدعوة إلى استعمال الاجتهاد والأخذ بأسباب الحضارة الغربية، والحد من نشاط الدراويش الذين أضروا في نظره بالمجتمع الإسلامي. وكأن ابن العنابي قد جاء ليوضح ما دعا إليه الفكون. ففي كتابه (السعي المحمود في نظام الجنود) نقد ابن العنابي معاصريه من الفقهاء بشدة وسخر من أفكارهم ومظهرهم، كما نادى بضرورة النهضة الإسلامية على أساس المنافسة بين العالم الإسلامي والعالم الأوروبي والسباق مع الحضارة الأوروبية والفوز عليها فيما تفننت فيه من أنواع الاختراعات والمبتكرات الصناعية والتقنية والحربية. وكان له رأي أيضا في الديمقراطية السياسية وتوزيع الثروة واختيار الأكفاء في الإدارة ونحو ذلك مما كان شبه محرم طرقه على الفقهاء قبله (1).
وظاهرة التقليد، بالإضافة إلى تخلف الثقافة عموما، كانت مسؤولة على ندرة الإنتاج في العلوم الشرعية التي تحتاج إلى ثقافة واسعة وعميقة كالتفسير. ذلك أن مفسر القرآن الكريم يحتاج إلى ثقافة دينية وتاريخية ولغوية قوية لكي يقدم على عمله، بالإضافة إلى استقلال عقلي كبير، وهذا ما لم يتوفر للجزائريين خلال العهد العثماني. فمجال الثقافة، كما عرفنا، كان محدودا، وميدان استثمارها كان أيضا محدودا. وإذا توفر جانب من جوانبها المذكورة (الدينية، التاريخية، اللغوية والاستقلال العقلي) فإن بقية الجوانب لا تتوفر. لذلك قل مفسرو القرآن من الجزائريين، وضحلت دراسات الحديث باستثناء بعض الفروع كرواية الأسانيد والأثبات ومنح الإجازات فيها. أما الدراسات الفقهية فقد كانت تقليدية أيضا. ولم يستطع أحد من
__________
(1) أبو القاسم سعد الله (رائد التجديد الإسلامي: ابن العنابي) ط 2، الإسلامي، بيروت 1990.
وإذا كان ابن عمار قد عاب على فقهاء عصره جمودهم العقلي وترهل الفكر عندهم فإن ثورته لم تصل إلى حدة ثورة الفكون ولا ثورة محمد بن العنابي، والواقع أن ابن العنابي كان من أوائل الفقهاء الذين لم يكتفوا بنقد الجمود العقلي بل أضاف إلى نقده اللاذع الدعوة إلى استعمال الاجتهاد والأخذ بأسباب الحضارة الغربية، والحد من نشاط الدراويش الذين أضروا في نظره بالمجتمع الإسلامي. وكأن ابن العنابي قد جاء ليوضح ما دعا إليه الفكون. ففي كتابه (السعي المحمود في نظام الجنود) نقد ابن العنابي معاصريه من الفقهاء بشدة وسخر من أفكارهم ومظهرهم، كما نادى بضرورة النهضة الإسلامية على أساس المنافسة بين العالم الإسلامي والعالم الأوروبي والسباق مع الحضارة الأوروبية والفوز عليها فيما تفننت فيه من أنواع الاختراعات والمبتكرات الصناعية والتقنية والحربية. وكان له رأي أيضا في الديمقراطية السياسية وتوزيع الثروة واختيار الأكفاء في الإدارة ونحو ذلك مما كان شبه محرم طرقه على الفقهاء قبله (1).
وظاهرة التقليد، بالإضافة إلى تخلف الثقافة عموما، كانت مسؤولة على ندرة الإنتاج في العلوم الشرعية التي تحتاج إلى ثقافة واسعة وعميقة كالتفسير. ذلك أن مفسر القرآن الكريم يحتاج إلى ثقافة دينية وتاريخية ولغوية قوية لكي يقدم على عمله، بالإضافة إلى استقلال عقلي كبير، وهذا ما لم يتوفر للجزائريين خلال العهد العثماني. فمجال الثقافة، كما عرفنا، كان محدودا، وميدان استثمارها كان أيضا محدودا. وإذا توفر جانب من جوانبها المذكورة (الدينية، التاريخية، اللغوية والاستقلال العقلي) فإن بقية الجوانب لا تتوفر. لذلك قل مفسرو القرآن من الجزائريين، وضحلت دراسات الحديث باستثناء بعض الفروع كرواية الأسانيد والأثبات ومنح الإجازات فيها. أما الدراسات الفقهية فقد كانت تقليدية أيضا. ولم يستطع أحد من
__________
(1) أبو القاسم سعد الله (رائد التجديد الإسلامي: ابن العنابي) ط 2، الإسلامي، بيروت 1990.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
العلماء في العهد العثماني أن يكتب عملا في الفقه شبيها بـ (معيار) أحمد الونشريسي. كما لم يكتب أحد منهم (فيما وصل إلينا) عملا في التفسير يشبه (الجواهر الحسان) للثعالبي. فإنتاج الجزائر إذن من العلوم الشرعية كاد ينحصر في مجالات واهية لتفسير القرآن الكريم، وبعض العناية بالقراءات، وفي مجموعة من الأثبات والإجازات، بالإضافة إلى أعمال فقهية تتناول فروعا من العبادات والمعاملات، وسنحاول الآن أن ندرس كل علم من هذه العلوم على حدة.
التفسير
يمكن أن نتناول التفسير من ناحيتين. ناحية التدريس وناحية التأليف.
أما تدريس التفسير فقد كان شائعا بين العلماء البارزين. ومن الذين اشتهروا بذلك محمد بن علي أبهلول، وابن للو التلمساني، وعبد القادر الراشدي القسنطيني، وأبو راس الناصر. ورغم أننا لا نملك الوثائق الآن فإن أمثال سعيد قدورة، وأحمد بن عمار، وسعيد المقري ربما تناولوا أيضا التفسير في مجالس دروسهم التي اشتهروا بها. ومن الطبيعي أن نقول إنه ليس كل من تناول التفسير أجاد أو جدد فيه. ذلك أن ظاهرة التقليد والحفظ كانت مسيطرة على العلماء في جميع الميادين، ومن بينها ميدان التفسير. فنحن نتصور أن
معظم المفسرين للقرآن الكريم في مجالس الدروس، كانوا يكررون في الغالب أقوال المفسرين المتقدمين، وقلما يخرجون عليها برأي جديد يتلاءم مع العصر.
ومن جهة أخرى فإن الوثائق تعوزنا في الوقت الراهن، فليس هناك ما يدل على نوع الطريقة (1) التي كان يستعملها أمثال أبهلول وابن لَلُّو والراشدي
__________
(1) ذكر ابن حمادوش في رحلته أنه حين زار الشيخ أحمد الورززي المغربي مدينة الجزائر سنة 1159 اجتمع إليه الطلبة (العلماء) وطلبوا منه أن يريهم كيف يبتدئ المدرس درس التفسير ففعل، وكان ذلك في الجامع الكبير. انظر التفاصيل والدرس الذي ألقاه، في رحلة ابن حمادوش، من تحقيقنا. نشر المكتبة الوطنية - الجزائر، 1983
التفسير
يمكن أن نتناول التفسير من ناحيتين. ناحية التدريس وناحية التأليف.
أما تدريس التفسير فقد كان شائعا بين العلماء البارزين. ومن الذين اشتهروا بذلك محمد بن علي أبهلول، وابن للو التلمساني، وعبد القادر الراشدي القسنطيني، وأبو راس الناصر. ورغم أننا لا نملك الوثائق الآن فإن أمثال سعيد قدورة، وأحمد بن عمار، وسعيد المقري ربما تناولوا أيضا التفسير في مجالس دروسهم التي اشتهروا بها. ومن الطبيعي أن نقول إنه ليس كل من تناول التفسير أجاد أو جدد فيه. ذلك أن ظاهرة التقليد والحفظ كانت مسيطرة على العلماء في جميع الميادين، ومن بينها ميدان التفسير. فنحن نتصور أن
معظم المفسرين للقرآن الكريم في مجالس الدروس، كانوا يكررون في الغالب أقوال المفسرين المتقدمين، وقلما يخرجون عليها برأي جديد يتلاءم مع العصر.
ومن جهة أخرى فإن الوثائق تعوزنا في الوقت الراهن، فليس هناك ما يدل على نوع الطريقة (1) التي كان يستعملها أمثال أبهلول وابن لَلُّو والراشدي
__________
(1) ذكر ابن حمادوش في رحلته أنه حين زار الشيخ أحمد الورززي المغربي مدينة الجزائر سنة 1159 اجتمع إليه الطلبة (العلماء) وطلبوا منه أن يريهم كيف يبتدئ المدرس درس التفسير ففعل، وكان ذلك في الجامع الكبير. انظر التفاصيل والدرس الذي ألقاه، في رحلة ابن حمادوش، من تحقيقنا. نشر المكتبة الوطنية - الجزائر، 1983
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
أثناء درس التفسير. فقد روى سعيد قدورة أن الرحال كانت تشد إلى شيخه محمد بن علي أبهلول لشهرته في علوم التفسير والحديث وما شابهها. وروى قدورة أيضا أن شيخه قد وصل في تفسيره إلى سورة الإسراء قبل أن يقتل سنة 1008 (1). فهل كان الشيخ أبهلول يملي تفسيره إملاء أو كان يلقيه إلقاء على طلابه؟ هذا ما لا تفصح عنه الوثائق. والظاهر أن الشيخ كان يفسر باللسان ولا يسجل بالقلم. ذلك أن الذين ترجموا له تحدثوا عن براعته في عدة علوم أخرى ولكنهم لم يتحدثوا عن كتب أو تقاييد له. فهو إذن من المدرسين في التفسير وليس من المؤلفين فيه. ولا نتوقع أن يكون تفسير أبهلول تفسيرا حيا أو مبتكرا، وإنما نتوقعه تفسيرا تقليديا منقولا عن السابقين، مع قليل من ذلاقة اللسان وبيان العبارة، لأن الشيخ كان مشهورا أيضا بحذق العروض والمنطق والنحو، وهي علوم تساعد على فهم القرآن وجودة تفسيره.
وعندما ترجم أبو حامد المشرفي لابن للو التلمساني قال عنه إنه قد ختم تفسير القرآن الكريم في الجامع الأعظم بتلمسان. وكان والد المشرفي معاصرا أو قريبا من زمن ابن للو، فهو الذي حدث ابنه، أبا حامد، بأن ابن للو قد فسر القرآن حتى ختمه. وقد عرفنا في الجزء الأول أن ابن للو كان غير راض على الأوضاع السياسية بتلمسان وأنه كان ساخطا على العثمانيين حتى أنه أمسك بلحية القائد حفيظ التركي ورد عليه هديته من السمن والدقيق. ويكفي ابن للو أنه كان أستاذا لعدد من الطلاب الناجحين، وعلى رأسهم الشيخ محمد الزجاي (2)، الذي اشتهر أمره أيضا أوائل القرن الثالث عشر. ونحن لا نستغرب أن يعمد ابن للو إلى تفسير القرآن الكريم ويتصدى لذلك حتى يختمه بالجامع الأعظم، فقد عرف عنه أيضا أنه كان من الأدباء الحاذقين حتى أن أبا حامد المشرفي جعله "خاتمة أدباء تلمسان
__________
(1) سعيد قدورة، مخطوطة رقم 422، مجموع المكتبة الوطنية، تونس. انظر أيضا أبو حامد المشرفي (ياقوتة النسب الوهاجة). انظر ترجمة قدورة في فصل التعليم من الجزء الأول.
(2) عن محمد الزجاي انظر فصل السلك الديني والقضائي في جزء لاحق
وعندما ترجم أبو حامد المشرفي لابن للو التلمساني قال عنه إنه قد ختم تفسير القرآن الكريم في الجامع الأعظم بتلمسان. وكان والد المشرفي معاصرا أو قريبا من زمن ابن للو، فهو الذي حدث ابنه، أبا حامد، بأن ابن للو قد فسر القرآن حتى ختمه. وقد عرفنا في الجزء الأول أن ابن للو كان غير راض على الأوضاع السياسية بتلمسان وأنه كان ساخطا على العثمانيين حتى أنه أمسك بلحية القائد حفيظ التركي ورد عليه هديته من السمن والدقيق. ويكفي ابن للو أنه كان أستاذا لعدد من الطلاب الناجحين، وعلى رأسهم الشيخ محمد الزجاي (2)، الذي اشتهر أمره أيضا أوائل القرن الثالث عشر. ونحن لا نستغرب أن يعمد ابن للو إلى تفسير القرآن الكريم ويتصدى لذلك حتى يختمه بالجامع الأعظم، فقد عرف عنه أيضا أنه كان من الأدباء الحاذقين حتى أن أبا حامد المشرفي جعله "خاتمة أدباء تلمسان
__________
(1) سعيد قدورة، مخطوطة رقم 422، مجموع المكتبة الوطنية، تونس. انظر أيضا أبو حامد المشرفي (ياقوتة النسب الوهاجة). انظر ترجمة قدورة في فصل التعليم من الجزء الأول.
(2) عن محمد الزجاي انظر فصل السلك الديني والقضائي في جزء لاحق
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
المتأخرين " (1). وهذا يؤكد ما قلناه من أن الذين تناولوا التفسير كانوا من أبرز العلماء ومن أكثرهم إلماما بمختلف العلوم الشرعية والعقلية. والظاهر أن ابن للو لم يكن يحتفظ بتقييد لما كان يفسره، ولم يهتم أحد من تلاميذه بجمع ما ألقاه. ولو فعلوا ذلك لوصل إلينا نموذج من تفاسير القرن الثاني عشر نستدل به على ثقافة العلماء عندئذ ومنهجهم في التفسير. ولعل منهج ابن للو في تفسير القرآن كان يعتمد على المعاني الظاهرية، كما كان يعتمد طريقة القدماء في الاستدلال والاستنتاج.
ومن الذين تناولوا التفسير تدريسا أيضا عبد القادر الراشدي القسنطيني.
ورغم شهرة الراشدي في وقته فإن حياته ما تزال غامضة وليس لدينا منها سوى نبذ متفرقة هنا وهناك. والذي يهمنا هنا ليس حياته وإنما مساهمته في تفسير القرآن الكريم، ذلك أن مترجميه قد تحدثوا عن أنه كان يعقد مجالس للفتوى والتفسير، غير أننا لا نعرف ما إذا كانت هذه المجالس للتدريس أو مجالس اجتماعية يحضرها الوالي والعلماء. والمعروف أن الراشدي كان قد تولى الإفتاء والتدريس بجامع سيدي الكتاني ومدرسته، وكلاهما من آثار صالح باي. كما أن للراشدي بعض التآليف، ولكننا لا نعرف ما إذا كان تفسيره قد جمع في كتاب، فلعله لم يكن يتناول التفسير بصورة منتظمة، وإنما كان يتناول بعض الآيات في المناسبات المعينة ويعرضها ويحللها، ونحن نتصور أنه كان إلى حد ما متحررا في فتاويه وآرائه. ذلك أن سيرته تشير إلى أنه قد واجه بعض التحدي نتيجة آرائه. فقد قيل عنه إنه كان يقول بالتجسيم وأن بعض علماء وقته قد حكموا عليه بالزندقة والكفر وكادوا ينجحون في الفتك به لولا تعاطف صالح باي معه. كما أنه قد ألف رسالة في تحريم شرب الدخان (2). وكل هذه المواقف والآراء تجعلنا نتصور أنه كان في تفسيره شيء
__________
(1) أبو حامد المشرفي (ذخيرة الأواخر والأول)، مخطوط، ص 12.
(2) أبو القاسم الحفناوي (تعريف الخلف برجال السلف) 2/ 219. وقد أخبر الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 172 أن ترجمة الراشدي توجد في معجم مرتضى الزبيدي. والمعروف أن الراشدي كان قد أجاز الزبيدي بالمراسلة. انظر قسم الإجازات من هذا الفصل=
ومن الذين تناولوا التفسير تدريسا أيضا عبد القادر الراشدي القسنطيني.
ورغم شهرة الراشدي في وقته فإن حياته ما تزال غامضة وليس لدينا منها سوى نبذ متفرقة هنا وهناك. والذي يهمنا هنا ليس حياته وإنما مساهمته في تفسير القرآن الكريم، ذلك أن مترجميه قد تحدثوا عن أنه كان يعقد مجالس للفتوى والتفسير، غير أننا لا نعرف ما إذا كانت هذه المجالس للتدريس أو مجالس اجتماعية يحضرها الوالي والعلماء. والمعروف أن الراشدي كان قد تولى الإفتاء والتدريس بجامع سيدي الكتاني ومدرسته، وكلاهما من آثار صالح باي. كما أن للراشدي بعض التآليف، ولكننا لا نعرف ما إذا كان تفسيره قد جمع في كتاب، فلعله لم يكن يتناول التفسير بصورة منتظمة، وإنما كان يتناول بعض الآيات في المناسبات المعينة ويعرضها ويحللها، ونحن نتصور أنه كان إلى حد ما متحررا في فتاويه وآرائه. ذلك أن سيرته تشير إلى أنه قد واجه بعض التحدي نتيجة آرائه. فقد قيل عنه إنه كان يقول بالتجسيم وأن بعض علماء وقته قد حكموا عليه بالزندقة والكفر وكادوا ينجحون في الفتك به لولا تعاطف صالح باي معه. كما أنه قد ألف رسالة في تحريم شرب الدخان (2). وكل هذه المواقف والآراء تجعلنا نتصور أنه كان في تفسيره شيء
__________
(1) أبو حامد المشرفي (ذخيرة الأواخر والأول)، مخطوط، ص 12.
(2) أبو القاسم الحفناوي (تعريف الخلف برجال السلف) 2/ 219. وقد أخبر الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 172 أن ترجمة الراشدي توجد في معجم مرتضى الزبيدي. والمعروف أن الراشدي كان قد أجاز الزبيدي بالمراسلة. انظر قسم الإجازات من هذا الفصل=
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
03:21 PM
08-24-2016
من الخروج عن المألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص وآراء الأقدمين.
أما أحمد المقري فقد عرف عنه كثرة المحفوظ في مختلف العلوم والفنون وكثرة التأليف في الأدب والتاريخ والحديث، ولكن لم يعرف عنه أنه كان من مدرسي القرآن الكريم. وقد أخبر عبد الكريم الفكون أن المقري قد انتصب للتدريس في الجامع الأعظم بمدينة الجزائر عندما أخرجته الظروف السياسية من المغرب، وأن من جملة ما درس هناك التفسير. ولكن إقامة المقري لم تطل بالجزائر، فقد توجه إلى المشرق حيث درس الحديث والأدب وتاريخ الأندلس والعقائد. ولكن مترجميه لم يذكروا أنه درس هناك التفسير أيضا. ويبدو أن ما قيل من أن العقائد كانت مهنة أهل المغرب وأن التفسير فن أهل المشرق قول فيه كثير من الصحة، والدليل على ذلك قلة التفاسير عند المغاربة مع كثرتها في المشرق، بينما الأمر بعكس ذلك بالنسبة للعقائد ونحوها. ومهما كان الأمر فإن أحمد المقري كان غزير المعرفة، يتمتع بحافظة قوية، ولم يكن يعوزه التأليف في التفسير فما بالك التدريس فيه. ونحن نعتقد أنه لو ألف فيه لأجاد كما أجاد فيما ألف في العلوم الأخرى. كما نفهم من نقد الفكون له أن طريقة المقري في التفسير، كما هي في علومه الأخرى، طريقة كلية لا جزئية تعتمد على التعميم وتبتعد عن الدقة. وهو، لكونه أديبا، كان يزوق الألفاظ ويستعمل العبارات المبهمة.
وقد أخذ عليه الفكون حين سأله عن إعراب ابن عطية للآية (ولأتم نعمتي عليكم)، تهربه من الإجابة العلمية (1).
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن هناك غير هؤلاء. فالوزان والأنصاري وعيسى الثعالبي كانوا أيضا من مفسري القرآن الكريم في دروسهم. وقد روى محمد بن ميمون أن القاضي أبا الحسن علي كان بارعا في تفسير القرآن حتى
__________
= أما رسالته عن الدخان فقد حققها عبدالله حمادي تحت عنوان (تحفة الإخوان في تحريم الدخان)، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1997.
(1) عبد الكريم الفكون (منشور الهداية) الخاتمة. انظر ترجمة أحمد المقري في فصل الأدب من هذا الجزء.
من الخروج عن المألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص وآراء الأقدمين.
أما أحمد المقري فقد عرف عنه كثرة المحفوظ في مختلف العلوم والفنون وكثرة التأليف في الأدب والتاريخ والحديث، ولكن لم يعرف عنه أنه كان من مدرسي القرآن الكريم. وقد أخبر عبد الكريم الفكون أن المقري قد انتصب للتدريس في الجامع الأعظم بمدينة الجزائر عندما أخرجته الظروف السياسية من المغرب، وأن من جملة ما درس هناك التفسير. ولكن إقامة المقري لم تطل بالجزائر، فقد توجه إلى المشرق حيث درس الحديث والأدب وتاريخ الأندلس والعقائد. ولكن مترجميه لم يذكروا أنه درس هناك التفسير أيضا. ويبدو أن ما قيل من أن العقائد كانت مهنة أهل المغرب وأن التفسير فن أهل المشرق قول فيه كثير من الصحة، والدليل على ذلك قلة التفاسير عند المغاربة مع كثرتها في المشرق، بينما الأمر بعكس ذلك بالنسبة للعقائد ونحوها. ومهما كان الأمر فإن أحمد المقري كان غزير المعرفة، يتمتع بحافظة قوية، ولم يكن يعوزه التأليف في التفسير فما بالك التدريس فيه. ونحن نعتقد أنه لو ألف فيه لأجاد كما أجاد فيما ألف في العلوم الأخرى. كما نفهم من نقد الفكون له أن طريقة المقري في التفسير، كما هي في علومه الأخرى، طريقة كلية لا جزئية تعتمد على التعميم وتبتعد عن الدقة. وهو، لكونه أديبا، كان يزوق الألفاظ ويستعمل العبارات المبهمة.
وقد أخذ عليه الفكون حين سأله عن إعراب ابن عطية للآية (ولأتم نعمتي عليكم)، تهربه من الإجابة العلمية (1).
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن هناك غير هؤلاء. فالوزان والأنصاري وعيسى الثعالبي كانوا أيضا من مفسري القرآن الكريم في دروسهم. وقد روى محمد بن ميمون أن القاضي أبا الحسن علي كان بارعا في تفسير القرآن حتى
__________
= أما رسالته عن الدخان فقد حققها عبدالله حمادي تحت عنوان (تحفة الإخوان في تحريم الدخان)، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1997.
(1) عبد الكريم الفكون (منشور الهداية) الخاتمة. انظر ترجمة أحمد المقري في فصل الأدب من هذا الجزء.
الموضوع:
تاريخ الجزائر الثقافي.doc الجــــزء الثاني بقسم
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
اشتهر به وتسابق الناس إلى درسه في الجامع الكبير، كما اشتهر بعلوم اللسان. وكذلك قال ابن ميمون عن المفتي مصطفى بن عبد الله البوني بأنه تناول تدريس الثعالبي "على سبيل التفقه " وأنه أجاد فيه (1)، ومن جهة أخرى ذكر ابن زاكور في رحلته أن شيخه أبا عبد الله بن خليفة الجزائري قد ختم القرآن الكريم تدريسا (2).
أما التفسير تأليفا فالخوض فيه قليل. ورغم شهرة مدرسة تلمسان العلمية فإنها لم تنتج مفسرين للقرآن الكريم جديرين بالإشارة. حتى العالم المعروف، أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد لم يعرف عنهما التأليف في التفسير. ونفس الشيء يقال عن مدرسة بجاية وقسنطينة. فرغم شهرة عمر الوزان وعبد الكريم الفكون (الجد) خلال القرن العاشر، فإننا لم نعثر لهما على تأليف في التفسير. وقد اعتنى عبد الرحمن الأخضري بمختلف العلوم، شرعية وعقلية، ولكننا لم نعرف عنه أنه حاول التفسير.
وهكذا ينتهي القرن العاشر (16 م) دون أن نسجل تأليفا واحدا في تفسير القرآن الكريم. غير أنه يقال إن محمد بن علي الخروبي قد وضع تفسيرا أثناء إقامته بالجزائر. فإذا صح هذا فإنه يكون أمرا غريبا من شيخ لا هم له عندئذ سوى نشر الطريقة الشاذلية وخدمة الدعاية العثمانية والتأليف في التصوف. ومهما يكن من أمر فنحن لم نطلع على هذا التفسير ولا تؤكد مصادر الخروبي وجوده (3)، وقد روى عبد الكريم الفكون (الحفيد) أن جده قد وضع "تقييدا" جمع فيه الآيات التي استشهد بها سعد الدين التفتزاني في كتابه المطول، ولكن العناية ببعض الآيات من القرآن الكريم لا تعني العناية بالتفسير كعلم قائم بذاته. ثم إن الرواية تشير إلى أن الشيخ الفكون قد جمع الآيات ولم تقل إنه فسرها أو علق عليها. ومن ثمة يظل هذا التقييد خارج
__________
(1) ابن ميمون (التحفة المرضية) مخطوط، 48، و 235 من المطبوع.
(2) ابن زاكور (الرحلة) 31، وكان ابن خليفة من الذين أجازوا ابن زاكور أثناء زيارة هذا للجزائر، وقد توفي ابن خليفة سنة 1094.
(3) أشار إليه صاحب (الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الإعلام) 4/ 150.
أما التفسير تأليفا فالخوض فيه قليل. ورغم شهرة مدرسة تلمسان العلمية فإنها لم تنتج مفسرين للقرآن الكريم جديرين بالإشارة. حتى العالم المعروف، أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد لم يعرف عنهما التأليف في التفسير. ونفس الشيء يقال عن مدرسة بجاية وقسنطينة. فرغم شهرة عمر الوزان وعبد الكريم الفكون (الجد) خلال القرن العاشر، فإننا لم نعثر لهما على تأليف في التفسير. وقد اعتنى عبد الرحمن الأخضري بمختلف العلوم، شرعية وعقلية، ولكننا لم نعرف عنه أنه حاول التفسير.
وهكذا ينتهي القرن العاشر (16 م) دون أن نسجل تأليفا واحدا في تفسير القرآن الكريم. غير أنه يقال إن محمد بن علي الخروبي قد وضع تفسيرا أثناء إقامته بالجزائر. فإذا صح هذا فإنه يكون أمرا غريبا من شيخ لا هم له عندئذ سوى نشر الطريقة الشاذلية وخدمة الدعاية العثمانية والتأليف في التصوف. ومهما يكن من أمر فنحن لم نطلع على هذا التفسير ولا تؤكد مصادر الخروبي وجوده (3)، وقد روى عبد الكريم الفكون (الحفيد) أن جده قد وضع "تقييدا" جمع فيه الآيات التي استشهد بها سعد الدين التفتزاني في كتابه المطول، ولكن العناية ببعض الآيات من القرآن الكريم لا تعني العناية بالتفسير كعلم قائم بذاته. ثم إن الرواية تشير إلى أن الشيخ الفكون قد جمع الآيات ولم تقل إنه فسرها أو علق عليها. ومن ثمة يظل هذا التقييد خارج
__________
(1) ابن ميمون (التحفة المرضية) مخطوط، 48، و 235 من المطبوع.
(2) ابن زاكور (الرحلة) 31، وكان ابن خليفة من الذين أجازوا ابن زاكور أثناء زيارة هذا للجزائر، وقد توفي ابن خليفة سنة 1094.
(3) أشار إليه صاحب (الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الإعلام) 4/ 150.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
النطاق الذي نتناوله. ذلك أن الفكون (الجد) كان مهتما اهتماما خاصا بعلم البيان وكان جمعه للآيات من مطول التفتزاني لا يخرج عن حبه للبيان (1).
وقد أنجب القرن الحادي عشر مجموعة من العلماء المشار إليهم من أمثال سعيد المقري، وابن أخيه أحمد المقري، وسعيد قدورة، وابنه محمد، وعيسى الثعالبي، ومع ذلك لا نجد أحدهم قد ترك تأليفا في علم التفسير (2)، وفي ترجمة علي بن عبد الواحد الأنصاري ذكر المحبي أن للأنصاري عملا في التفسير بلغ فيه إلى قوله تعالى: (ولكن البر من اتقى) (3)، وقد قام يحى الشاوي بوضع أجوبة على اعتراضات أبي حيان على ابن عطية والزمخشري.
ويبدو أن أجوبة الشاوي كانت ضخمة إذا حكمنا من حجم عمله (4)، ولم نطلع نحن على هذا العمل حتى نحكم على منهج صاحبه، ولكننا نعرف أن يحى الشاوي كان من أبرز علماء عصره تجربة وثقافة ونقدا. وقد ألف في علوم أخرى كالتوحيد والفقه سنعرض إليها. ونود هنا أن نذكر بما قلناه عنه من أنه كثير النقد لعلماء عصره وغيرهم، وإنه كان يعتبر هذا النقد، رغم ما فيه من تعرض للأخطار، مصدر ثواب. لذلك فنحن نتصور أن أجوبته على تفاسير غيره ستكون مشبعة بالآراء المستقلة التي كانت تهدف إلى فهم القرآن في ضوء مصالح المسلمين في وقته.
ومن العلماء الذين ألفوا في التفسير خلال القرن الثاني عشر أحمد البوني وحسين العنابي. وعنوان تأليف البوني هو (الدر النظيم في فضل آيات
__________
(1) عبد الكريم الفكون (منشور الهداية)، 18 - 23 في ترجمة جده المتوفي سنة 988.
(2) ذكر محمد بن عبد الكريم (المقري وكتابه نفح الطيب) 280، إن للمقري تأليفا عنوانه (إعراب القرآن) وأنه في المكتبة الوطنية بباريس.
(3) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 173.
(4) محمد بن عبد الكريم (مخطوطات جزائرية في مكتبات إسطانبول) ص 11 - 12. فقد ذكر أن نسخة من هذه الأجوبة (الحاشية) تبلغ 718 ص وأن نسخة أخرى منها تبلغ 810 ص. انظر أيضا مجلة (المورد) العراقية 7 (1978) 313. فقد ذكر هنا أن عدد الأوراق 259 ورقة. انظر أيضا ترجمة يحيى الشاوي في الفصل التالي.
وقد أنجب القرن الحادي عشر مجموعة من العلماء المشار إليهم من أمثال سعيد المقري، وابن أخيه أحمد المقري، وسعيد قدورة، وابنه محمد، وعيسى الثعالبي، ومع ذلك لا نجد أحدهم قد ترك تأليفا في علم التفسير (2)، وفي ترجمة علي بن عبد الواحد الأنصاري ذكر المحبي أن للأنصاري عملا في التفسير بلغ فيه إلى قوله تعالى: (ولكن البر من اتقى) (3)، وقد قام يحى الشاوي بوضع أجوبة على اعتراضات أبي حيان على ابن عطية والزمخشري.
ويبدو أن أجوبة الشاوي كانت ضخمة إذا حكمنا من حجم عمله (4)، ولم نطلع نحن على هذا العمل حتى نحكم على منهج صاحبه، ولكننا نعرف أن يحى الشاوي كان من أبرز علماء عصره تجربة وثقافة ونقدا. وقد ألف في علوم أخرى كالتوحيد والفقه سنعرض إليها. ونود هنا أن نذكر بما قلناه عنه من أنه كثير النقد لعلماء عصره وغيرهم، وإنه كان يعتبر هذا النقد، رغم ما فيه من تعرض للأخطار، مصدر ثواب. لذلك فنحن نتصور أن أجوبته على تفاسير غيره ستكون مشبعة بالآراء المستقلة التي كانت تهدف إلى فهم القرآن في ضوء مصالح المسلمين في وقته.
ومن العلماء الذين ألفوا في التفسير خلال القرن الثاني عشر أحمد البوني وحسين العنابي. وعنوان تأليف البوني هو (الدر النظيم في فضل آيات
__________
(1) عبد الكريم الفكون (منشور الهداية)، 18 - 23 في ترجمة جده المتوفي سنة 988.
(2) ذكر محمد بن عبد الكريم (المقري وكتابه نفح الطيب) 280، إن للمقري تأليفا عنوانه (إعراب القرآن) وأنه في المكتبة الوطنية بباريس.
(3) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 173.
(4) محمد بن عبد الكريم (مخطوطات جزائرية في مكتبات إسطانبول) ص 11 - 12. فقد ذكر أن نسخة من هذه الأجوبة (الحاشية) تبلغ 718 ص وأن نسخة أخرى منها تبلغ 810 ص. انظر أيضا مجلة (المورد) العراقية 7 (1978) 313. فقد ذكر هنا أن عدد الأوراق 259 ورقة. انظر أيضا ترجمة يحيى الشاوي في الفصل التالي.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
من القرآن العظيم) (1)، ويبدو من هذا العنوان أن البوني لم يتناول التفسير بالمعنى المتعارف عليه وإنما خص بعض الآيات من القرآن مستخرجا منها المعاني التي تناسب التصوف والآداب العامة.
أما العنابي فقد تولى الإفتاء عدة مرات في الجزائر، وكان من أبرز علماء الحنفية. وإذا كانت حياته في الوظيفة معروفة من سجلات الإدارة العثمانية فإن حياته العلمية ما تزال غير معروفة. ولا نكاد نعرف عنها أكثر مما ذكره حفيده محمد بن محمود بن العنابي الذي ذكر في تأليفه أن لجده تفسيرا للقرآن الكريم، وقد نقل منه عدة مرات مستشهدا بكلامه. ولم يصل تفسير حسين العنابي إلينا ولكن عبارة حفيده تدل على أن العمل كامل، فهو يقول:
"قال مولانا الجد الأكبر حسين بن محمد رحمه الله في تفسيره". ومما نقل عنه تفسيره لقوله تعالى: (نحن أولياؤكم! حيث قال حسين العنابي: "أي تقول لهم الملائكة عند نزولهم للبشرى، نحن أولياؤكم أي أنصاركم وأحباؤكم في الحياة الدنيا فنلهمكم الحق ونحملكم على الخير، وفي الآخرة بالشفاعة والكرامة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة" (2). ولم يذكر ابن العنابي عنوانا لتفسير جده ولا حجما. ولكن عبارته تدل على أنه كان يملك نسخة منه يستعملها عند الاستشهاد. ولم نطلع نحن على عمل آخر لحسين العنابي حتى يساعدنا في الحكم على تفسيره، والظاهر أنه تفسير ديني بالدرجة الأولى.
وهناك عالمان متعاصران ألف كلاهما في التفسير، وهما أبو راس الناصر ومحمد الزجاي. وكلاهما أيضا جمع إلى الثقافة الدنيوية ثقافة صوفية ودينية قوية. فأما أبو راس فقد ذكر أنه قد وضع تفسيرا للقرآن الكريم في ثلاثة أسفار وأنه جعل كل سفر يحتوي على عشرين حزبا، وسماه (التيسير
__________
(1) المعرض الخامس لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات 1973، ضمن مجموع رقم 406 ر. انظر أيضا (غريب القرآن) لمحمد بن عبد الله المجاسي (المجاجي؟)، الجزائر 413، بروكلمان 2/ 987.
(2) انظر كتابي (المفتي الجزائر ابن العنابي)، 100 انظر أيضا ط 2 منه.
أما العنابي فقد تولى الإفتاء عدة مرات في الجزائر، وكان من أبرز علماء الحنفية. وإذا كانت حياته في الوظيفة معروفة من سجلات الإدارة العثمانية فإن حياته العلمية ما تزال غير معروفة. ولا نكاد نعرف عنها أكثر مما ذكره حفيده محمد بن محمود بن العنابي الذي ذكر في تأليفه أن لجده تفسيرا للقرآن الكريم، وقد نقل منه عدة مرات مستشهدا بكلامه. ولم يصل تفسير حسين العنابي إلينا ولكن عبارة حفيده تدل على أن العمل كامل، فهو يقول:
"قال مولانا الجد الأكبر حسين بن محمد رحمه الله في تفسيره". ومما نقل عنه تفسيره لقوله تعالى: (نحن أولياؤكم! حيث قال حسين العنابي: "أي تقول لهم الملائكة عند نزولهم للبشرى، نحن أولياؤكم أي أنصاركم وأحباؤكم في الحياة الدنيا فنلهمكم الحق ونحملكم على الخير، وفي الآخرة بالشفاعة والكرامة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة" (2). ولم يذكر ابن العنابي عنوانا لتفسير جده ولا حجما. ولكن عبارته تدل على أنه كان يملك نسخة منه يستعملها عند الاستشهاد. ولم نطلع نحن على عمل آخر لحسين العنابي حتى يساعدنا في الحكم على تفسيره، والظاهر أنه تفسير ديني بالدرجة الأولى.
وهناك عالمان متعاصران ألف كلاهما في التفسير، وهما أبو راس الناصر ومحمد الزجاي. وكلاهما أيضا جمع إلى الثقافة الدنيوية ثقافة صوفية ودينية قوية. فأما أبو راس فقد ذكر أنه قد وضع تفسيرا للقرآن الكريم في ثلاثة أسفار وأنه جعل كل سفر يحتوي على عشرين حزبا، وسماه (التيسير
__________
(1) المعرض الخامس لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات 1973، ضمن مجموع رقم 406 ر. انظر أيضا (غريب القرآن) لمحمد بن عبد الله المجاسي (المجاجي؟)، الجزائر 413، بروكلمان 2/ 987.
(2) انظر كتابي (المفتي الجزائر ابن العنابي)، 100 انظر أيضا ط 2 منه.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
إلى علم التفسير). ومما عرفناه عن أبي راس نستطيع أن نحكم بأن تفسيره سيكون محشوا بالاستطراد كالأخبار والإعراب والحكايات ونحوها. ونحكم أيضا بأن عبارته ستكون سهلة وألفاظه قريبة من العامية. أما التفسير في حد ذاته فقد يكون مقتصرا فيه على المعاني الظاهرة التي لا تحتاج إلى كثرة الاستدلال والاستنباط والتفرع. ومهما كان الأمر فإن تفسير أبي راس. يذكر المرء بتفسير الثعالبي لأن كليهما كان يجمع الزهد إلى العلم، وكليهما جاء في وقت اضطربت فيه الأحوال السياسية في البلاد، كما أن حجم التفسيرين متقارب (1).
ويبدو أن محمد الزجاي قد غلب عليه التصوف أكثر من أبي راس.
فالذين ترجموا له عدوا له مجموعة من الكرامات، واعتبروه من زهاد العصر ومن علمائه أيضا. وللزجاي مجموعة من التآليف في التفسير والنحو والتصوف. ويهمنا من أعماله ما فسره من القرآن. فقد عد له أحد مترجميه "تفسير الخمسة الأولى"، وهو تعبير غير واضح، فهل هو تفسير السور الخمس الأولى أو تفسير الأجزاء الخمسة الأول؟. وعلى كل حال فإن التعبير يدل على أن هذا التفسير غير كامل وأنه تناول فيه جزءا فقط من القرآن الكريم. كما ذكر له مترجمه "حواش كثيرة في التفسير وغيره (2)، ولعل هذه الحواشي تشبه ما قام به يحيى الشاوي في تعاليقه على التفاسير المتقدمة.
والظاهر أن الزجاي الذي اشتهر بمهنة التدريس، كان يتبع في تفسيره طريقة الشروح المتداولة، حيث كانوا يعمدون إلى عبارة الأصل فيعربونها ويذكرون معناه أو معانيها ويستشهدون لذلك بما يعزز رأيهم، وقد يستطردون بعض
__________
(1) عدد أبر راس كتبه في رحلته المسماة (فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته) التي اطلعنا منها على نسختين، وقد خصص القسم الخاص منها لتعداد تآليفه وسمى هذا القسم "العسجد والإبريز في عدة ما ألفت بين بسيط ووجيز". وجعل التفسير هو الباب الأول من هذا القسم، ومنه الحديث، والتوحيد، والتصوف، والفقه، والنحو، والأدب، والتاريخ. وقد نشر محمد بن عبد الكريم هذه الرحلة.
(2) إتمام الوطر في التعريف بمن اشتهر) مخطوط باريس. عن الزجاي انظر فصل السلك الديني في جزء آخر.
ويبدو أن محمد الزجاي قد غلب عليه التصوف أكثر من أبي راس.
فالذين ترجموا له عدوا له مجموعة من الكرامات، واعتبروه من زهاد العصر ومن علمائه أيضا. وللزجاي مجموعة من التآليف في التفسير والنحو والتصوف. ويهمنا من أعماله ما فسره من القرآن. فقد عد له أحد مترجميه "تفسير الخمسة الأولى"، وهو تعبير غير واضح، فهل هو تفسير السور الخمس الأولى أو تفسير الأجزاء الخمسة الأول؟. وعلى كل حال فإن التعبير يدل على أن هذا التفسير غير كامل وأنه تناول فيه جزءا فقط من القرآن الكريم. كما ذكر له مترجمه "حواش كثيرة في التفسير وغيره (2)، ولعل هذه الحواشي تشبه ما قام به يحيى الشاوي في تعاليقه على التفاسير المتقدمة.
والظاهر أن الزجاي الذي اشتهر بمهنة التدريس، كان يتبع في تفسيره طريقة الشروح المتداولة، حيث كانوا يعمدون إلى عبارة الأصل فيعربونها ويذكرون معناه أو معانيها ويستشهدون لذلك بما يعزز رأيهم، وقد يستطردون بعض
__________
(1) عدد أبر راس كتبه في رحلته المسماة (فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته) التي اطلعنا منها على نسختين، وقد خصص القسم الخاص منها لتعداد تآليفه وسمى هذا القسم "العسجد والإبريز في عدة ما ألفت بين بسيط ووجيز". وجعل التفسير هو الباب الأول من هذا القسم، ومنه الحديث، والتوحيد، والتصوف، والفقه، والنحو، والأدب، والتاريخ. وقد نشر محمد بن عبد الكريم هذه الرحلة.
(2) إتمام الوطر في التعريف بمن اشتهر) مخطوط باريس. عن الزجاي انظر فصل السلك الديني في جزء آخر.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الشيء لإثراء الفكرة التي يسوقونها أو للتباهي بالحفظ والاطلاع.
ومما لا شك فيه أن هنالى أعمالا أخرى في التفسير لم نهتد إليها. وفي هذا الصدد نذكر أن ابن علي الشريف الشلاطي (محمد بن علي) قد ذكر أن من بين تآليفه عملا بعنوان (تفسير الغريب للمبتدئ القريب) وهو عنوان غامض لا نفهم منه بالضرورة أنه في تفسير القرآن الكريم، كما لا نفهم منه أنه موجه إلى الطلاب المبتدئين في هذا الميدان. فإذا صح أن هذا العمل هو تفسير للقرآن بطريقة بسيطة فإن مؤلفه قد يكون لجأ فيه إلى المعلومات التاريخية والفلكية، لأنه قد ألف أيضا في التاريخ الإسلامي والفلك (1)، كما أن الشيخ عمر بن محمد المحجوب المعروف بالبهلول الزواوي قد كتب تفسيرا للقرآن يبدو أنه انتهى منه حتى أصبح يعرف بـ (تفسير البهلول). وقد قيل عن البهلول وتفسيره هذه العبارة "وكان رجلا عاميا كتب في التفسير بما عنّ له " (2) والظاهر أن كلمة "عاميا" إنما تعني أنه قد أملى تفسيره على تلاميذه بشيء من البساطة في العبارة، أو أنه كان غير عميق في معانيه فظهر لمن اطلع عليه أن صاحبه عامي الثقافة.
القراءات
ويكاد ينسحب على القراءات ما قلناه عن التفسير. فقد اشتهر الجزائريون بتدريس القراءات أكثر مما اشتهروا بالتأليف فيها. وكانت بعض المراكز في أنحاء الجزائر قد عرفت بالحذق في هذه المادة، مثل زواوة حتى أنها كانت مقصودة للعلماء للاتقان والبراعة. فهذا الشيخ محمد بن مزيان
__________
(1) ذكر ذلك في كتابه الذي سنتناوله في فصل العلوم من هذا الجزء، وهو (معالم الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار) الذي ألفه سنة 1192. اطلعنا على نسخة منه في مكتبة الكونغرس الأمريكي، كما اطلعنا على صور أخرى منه في الجزائر.
(2) الخزانة التيمورية، ص 40، ولم نعرف إلى الآن عصر البهلول فلعله من أهل القرن الثاني عشر أيضا.
ومما لا شك فيه أن هنالى أعمالا أخرى في التفسير لم نهتد إليها. وفي هذا الصدد نذكر أن ابن علي الشريف الشلاطي (محمد بن علي) قد ذكر أن من بين تآليفه عملا بعنوان (تفسير الغريب للمبتدئ القريب) وهو عنوان غامض لا نفهم منه بالضرورة أنه في تفسير القرآن الكريم، كما لا نفهم منه أنه موجه إلى الطلاب المبتدئين في هذا الميدان. فإذا صح أن هذا العمل هو تفسير للقرآن بطريقة بسيطة فإن مؤلفه قد يكون لجأ فيه إلى المعلومات التاريخية والفلكية، لأنه قد ألف أيضا في التاريخ الإسلامي والفلك (1)، كما أن الشيخ عمر بن محمد المحجوب المعروف بالبهلول الزواوي قد كتب تفسيرا للقرآن يبدو أنه انتهى منه حتى أصبح يعرف بـ (تفسير البهلول). وقد قيل عن البهلول وتفسيره هذه العبارة "وكان رجلا عاميا كتب في التفسير بما عنّ له " (2) والظاهر أن كلمة "عاميا" إنما تعني أنه قد أملى تفسيره على تلاميذه بشيء من البساطة في العبارة، أو أنه كان غير عميق في معانيه فظهر لمن اطلع عليه أن صاحبه عامي الثقافة.
القراءات
ويكاد ينسحب على القراءات ما قلناه عن التفسير. فقد اشتهر الجزائريون بتدريس القراءات أكثر مما اشتهروا بالتأليف فيها. وكانت بعض المراكز في أنحاء الجزائر قد عرفت بالحذق في هذه المادة، مثل زواوة حتى أنها كانت مقصودة للعلماء للاتقان والبراعة. فهذا الشيخ محمد بن مزيان
__________
(1) ذكر ذلك في كتابه الذي سنتناوله في فصل العلوم من هذا الجزء، وهو (معالم الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار) الذي ألفه سنة 1192. اطلعنا على نسخة منه في مكتبة الكونغرس الأمريكي، كما اطلعنا على صور أخرى منه في الجزائر.
(2) الخزانة التيمورية، ص 40، ولم نعرف إلى الآن عصر البهلول فلعله من أهل القرن الثاني عشر أيضا.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
التواتي المغربي، الذي ورد على قسنطينة من المغرب، قد تثقف في المغرب في الفقه والنحو على الخصوص حتى أصبح يلقب بسيبويه زمانه. ومع ذلك فإنه حين جاء إلى قسنطينة وجلس للتدريس بها لم يستغن عن الذهاب إلى زواوة لتعلم القراءات السبع بها، وكان من شيوخه فيها عبد الله أبو القاسم، وقد أخبر عنه تلميذه الفكون أنه بقي في زواوة لذلك الغرض حوالي عام ثم عاد (ومتمكنا من علم القراءات) (1). ومن أشهر أساتذة القراءات بزواوة أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر الشيخ محمد بن صولة الذي قرأ عليه العالم التونسي أحمد بن مصطفى برناز القراءات السبع أيضا (2).
وفي تراجم الفكون وابن مريم إشارات إلى بعض العلماء الذين اشتهروا بتدريس القراءات وحذقها في عهدهما. ومن ذلك ما رواه ابن مريم في (البستان) من أن محمد الحاج المناوي قد تصدر للتدريس في عدة علوم ولكنه مهر خصوصا في القراءات (3). أما الفكون فقد ذكر، أثناء نقده لعلماء عصره، إن محمد بن ناجي كان له درس عظيم ومشاركة في علم القراءات. وقال عن أحمد الجزيري إنه كان مدرسا من أهل الفتوى والشورى، وإنه كان يتعاطى التفسير والفقه ويدعى الأستاذية في القراءات السبع ومعرفة أحكام القرآن. وكلمة (يدعى) هنا لا تهمنا كثيرا لأن الفكون كان شديد النقد للعلماء الذين ضلوا، في نظره، سواء السبيل، لدخولهم في خدمة الولاة وأصحاب السلطة، والذي يهمنا هنا هو أن الجزيري كان يشتغل بالقراءات السبع (4).
أما التأليف في القراءات خلال هذا العهد فقد كان أقل من التفسير. ويبدو أن جل اعتماد علماء الجزائر حينئذ كان على (مورد الظمآن) للشريشي
__________
(1) ترجم له تلميذه عبد الكريم الفكون في (منشور الهداية). وقد توفي التواتي بالطاعون في باجة بتونس سنة 1031، انظر عنه سابقا.
(2) حسين خوجة (بشائر أهل الإيمان). وقد توفي برناز سنة 1138. وزار برناز الجزائر سنة 1107.
(3) ابن مريم (البستان). 266.
(4) الفكون (منشور الهداية) مخطوط. وقد حققناه، انظر سابقا.
وفي تراجم الفكون وابن مريم إشارات إلى بعض العلماء الذين اشتهروا بتدريس القراءات وحذقها في عهدهما. ومن ذلك ما رواه ابن مريم في (البستان) من أن محمد الحاج المناوي قد تصدر للتدريس في عدة علوم ولكنه مهر خصوصا في القراءات (3). أما الفكون فقد ذكر، أثناء نقده لعلماء عصره، إن محمد بن ناجي كان له درس عظيم ومشاركة في علم القراءات. وقال عن أحمد الجزيري إنه كان مدرسا من أهل الفتوى والشورى، وإنه كان يتعاطى التفسير والفقه ويدعى الأستاذية في القراءات السبع ومعرفة أحكام القرآن. وكلمة (يدعى) هنا لا تهمنا كثيرا لأن الفكون كان شديد النقد للعلماء الذين ضلوا، في نظره، سواء السبيل، لدخولهم في خدمة الولاة وأصحاب السلطة، والذي يهمنا هنا هو أن الجزيري كان يشتغل بالقراءات السبع (4).
أما التأليف في القراءات خلال هذا العهد فقد كان أقل من التفسير. ويبدو أن جل اعتماد علماء الجزائر حينئذ كان على (مورد الظمآن) للشريشي
__________
(1) ترجم له تلميذه عبد الكريم الفكون في (منشور الهداية). وقد توفي التواتي بالطاعون في باجة بتونس سنة 1031، انظر عنه سابقا.
(2) حسين خوجة (بشائر أهل الإيمان). وقد توفي برناز سنة 1138. وزار برناز الجزائر سنة 1107.
(3) ابن مريم (البستان). 266.
(4) الفكون (منشور الهداية) مخطوط. وقد حققناه، انظر سابقا.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
المعروف بالخراز المغربي، وعلى شرح محمد التنسي، الذي أشرنا إليه، والمسمى (الطراز في شرح ضبط الخراز) (1). وفي نهاية القرن التاسع ألف محمد شقرون بن أحمد المغراوي المعروف بالوهراني عملا في القراءات أيضا سماه (تقريب النافع في الطرق العشر لنافع) (2). والنسخة التي اطلعنا عليها من هذا العمل عبارة عن قصيدة لامية تبدأ هكذا:
بدأت بحمد الله معتصما به ... نظاما بديعا مكملا ومسهلا وقد قسمها الى أبواب مثل باب الاستعاذة، باب البسملة، وباب ميم الجمع، باب المد والقصر، الخ. ويبدو أن محمد الوهراني قد شرح هذه القصيدة أو شرح (مورد الظمآن) للخراز، لأننا وجدنا له ما يدل على ذلك (3).
وكان محمد بن توزينت العبادي التلمساني من القراء المشاهير أيضا. وقد عرف عنه العلم والجهاد معا. ذلك أنه توفي مجاهدا ضد الإسبان سنة 1118، أي أثناء الفتح الأول لوهران. أما علمه، وخصوصا في القراءات، فيكفي أنه أخرج فيه تلميذه أحمد بن ثابت الذي لعله فاق أستاذه شهرة فيه. وكما أخرج ابن توزينت التلاميذ، ألف تقييدا في القراءات أيضا لعله كان الحافز الرئيسي لتلاميذه لكي يحتذوا حذوه، غير أننا لم نستطع أن نطلع على هذا التقييد لأن النسخة التي حاولنا الرجوع إليها منه مفقودة الآن (4). وقد
__________
(1) انظر الفصل الأول من الجزء الأول.
(2) مخطوطات باريس، رقم 4532 مجموع. انتهى منه الوهراني سنة 899. والنسخة التي اطلعنا عليها تعود إلى سنة 1149 وهي بخط محمد أبو ناب الغريسي. وفيها أخطاء كثيرة. انظر أيضا المكتبة الملكية بالرباط، رقم 4497 مجموع. وتوجد ترجمة الوهراني في (دوحة الناشر) وغيره.
(3) وجدنا في المكتبة الملكية بالرباط رقم 4497 مجموع ما يدل على ذلك حيث العنوان (تعليق على مورد الظمآن للخراز) وإن كنا لم نطلع على هذا العمل.
(4) المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2243. وقد ذكره تلميذه أحمد بن ثابت في (الرسالة الغراء) ونوه به، كما ذكره أبو راس الناصر في (عجائب الأسفار).
بدأت بحمد الله معتصما به ... نظاما بديعا مكملا ومسهلا وقد قسمها الى أبواب مثل باب الاستعاذة، باب البسملة، وباب ميم الجمع، باب المد والقصر، الخ. ويبدو أن محمد الوهراني قد شرح هذه القصيدة أو شرح (مورد الظمآن) للخراز، لأننا وجدنا له ما يدل على ذلك (3).
وكان محمد بن توزينت العبادي التلمساني من القراء المشاهير أيضا. وقد عرف عنه العلم والجهاد معا. ذلك أنه توفي مجاهدا ضد الإسبان سنة 1118، أي أثناء الفتح الأول لوهران. أما علمه، وخصوصا في القراءات، فيكفي أنه أخرج فيه تلميذه أحمد بن ثابت الذي لعله فاق أستاذه شهرة فيه. وكما أخرج ابن توزينت التلاميذ، ألف تقييدا في القراءات أيضا لعله كان الحافز الرئيسي لتلاميذه لكي يحتذوا حذوه، غير أننا لم نستطع أن نطلع على هذا التقييد لأن النسخة التي حاولنا الرجوع إليها منه مفقودة الآن (4). وقد
__________
(1) انظر الفصل الأول من الجزء الأول.
(2) مخطوطات باريس، رقم 4532 مجموع. انتهى منه الوهراني سنة 899. والنسخة التي اطلعنا عليها تعود إلى سنة 1149 وهي بخط محمد أبو ناب الغريسي. وفيها أخطاء كثيرة. انظر أيضا المكتبة الملكية بالرباط، رقم 4497 مجموع. وتوجد ترجمة الوهراني في (دوحة الناشر) وغيره.
(3) وجدنا في المكتبة الملكية بالرباط رقم 4497 مجموع ما يدل على ذلك حيث العنوان (تعليق على مورد الظمآن للخراز) وإن كنا لم نطلع على هذا العمل.
(4) المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم 2243. وقد ذكره تلميذه أحمد بن ثابت في (الرسالة الغراء) ونوه به، كما ذكره أبو راس الناصر في (عجائب الأسفار).
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وجدنا في التعريف بهذه النسخة أن صاحبها هو محمد بن علي بن توزينت وأنه من تلاميذ الشيخ محمد السنوسي. ولكننا نستبعد أن يكون ابن توزينت قد تتلمذ على السنوسى وذلك للمسافة الزمنية الطويلة التى تفصل بينهما والصحيح أن يقال إنه تلميذ لتلاميذ السنوسي.
أما تلميذه أحمد بن ثابت صاحب (الرسالة الغراء في ترتيب أوجه القراء) فلا نعرف عن حياته إلا القليل أيضا. فقد ذكر بعض المعلومات عن نفسه في رسالته المذكورة، مثل قراءته على شيخه ابن توزينت. وممن نوهوا به أبو راس الناصر الذي وصفه بالعلم الغزير والجهاد أيضا. فقد أخبر عنه أنه من أهل تلمسان وأنه، قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد حارب أهل تلمسان (حتى دوخهم) (1). وقد مات من أجل ذلك عدد كثير من الطلبة (وهم العلماء وتلاميذهم) وأنه قاد الطلبة في الحرب ضد الإسبان في وهران مثل شيخه ابن توزينت. كما اعتبره أبو راس شيخ مشائخه وقال عنه إنه ترك تلاميذ في القراءات وإنه كان من سلالة سلاطين تلمسان، وقد توفي ابن ثابت في منتصف القرن الثاني عشر. غير أن عبد الرحمن الجبرتي قد حدد تاربخ وفاته بسنة 1151 (2). وقد أورد الجبرتي بعض المعلومات التي تكمل معلوماتنا عن ابن ثابت. فهو عنده (الأستاذ العارف أحمد بن عثمان بن علي بن محمد بن علي بن أحمد العربي الأندلسي التلمساني الأزهري المالكي). ونلاحظ أن الجبرتي لم يذكر كلمة (ثابت) في هذه السلسلة. كما نلاحظ أنه قال عنه إنه أخد الحديث عن علماء المغرب العربي ومصر والحرمين وتصدر للتدريس في هذه الأماكن. بقي علينا أن نتساءل: هل أن أحمد بن ثابت عند أبي راس هو نفسه أحمد بن عثمان عند الجبرتي؟ إن تطابق العصر وتاريخ الوفاة والنسبة إلى تلمسان تجعلنا نرجح أن الاسمين لشخص واحد.
__________
(1) ذكر لي المهدي البوعبدلي في رسالة خاصة أن أحمد بن ثابت قد ثار على الأتراك سنة 1150 وأنه اضطر إلى الهجرة والوفاة في المهجر.
(2) الجبرتي (عجاب الآثار) 1/ 166.
أما تلميذه أحمد بن ثابت صاحب (الرسالة الغراء في ترتيب أوجه القراء) فلا نعرف عن حياته إلا القليل أيضا. فقد ذكر بعض المعلومات عن نفسه في رسالته المذكورة، مثل قراءته على شيخه ابن توزينت. وممن نوهوا به أبو راس الناصر الذي وصفه بالعلم الغزير والجهاد أيضا. فقد أخبر عنه أنه من أهل تلمسان وأنه، قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد حارب أهل تلمسان (حتى دوخهم) (1). وقد مات من أجل ذلك عدد كثير من الطلبة (وهم العلماء وتلاميذهم) وأنه قاد الطلبة في الحرب ضد الإسبان في وهران مثل شيخه ابن توزينت. كما اعتبره أبو راس شيخ مشائخه وقال عنه إنه ترك تلاميذ في القراءات وإنه كان من سلالة سلاطين تلمسان، وقد توفي ابن ثابت في منتصف القرن الثاني عشر. غير أن عبد الرحمن الجبرتي قد حدد تاربخ وفاته بسنة 1151 (2). وقد أورد الجبرتي بعض المعلومات التي تكمل معلوماتنا عن ابن ثابت. فهو عنده (الأستاذ العارف أحمد بن عثمان بن علي بن محمد بن علي بن أحمد العربي الأندلسي التلمساني الأزهري المالكي). ونلاحظ أن الجبرتي لم يذكر كلمة (ثابت) في هذه السلسلة. كما نلاحظ أنه قال عنه إنه أخد الحديث عن علماء المغرب العربي ومصر والحرمين وتصدر للتدريس في هذه الأماكن. بقي علينا أن نتساءل: هل أن أحمد بن ثابت عند أبي راس هو نفسه أحمد بن عثمان عند الجبرتي؟ إن تطابق العصر وتاريخ الوفاة والنسبة إلى تلمسان تجعلنا نرجح أن الاسمين لشخص واحد.
__________
(1) ذكر لي المهدي البوعبدلي في رسالة خاصة أن أحمد بن ثابت قد ثار على الأتراك سنة 1150 وأنه اضطر إلى الهجرة والوفاة في المهجر.
(2) الجبرتي (عجاب الآثار) 1/ 166.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ومهما كان الأمر فإن الذي يهمنا الآن هو رسالة أحمد بن ثابت المذكورة في القراءات (1) فقد اعتمد فيها على المؤلفين السابقين في هذا العلم أمثال الشاطبي صاحب منظومة (حرز الإماني ووجه التهاني) والجعبري وابن الجزري. وكثيرا ما يقول ابن ثابت إنه قرأ هو بقراءة كذا. وبعد أن بين الدوافع التي جعلته يؤلف رسالته أوضح طريقته فيها بقوله: (وبعد، فهذه الرسالة الغراء .. سألنيها بعض الثقات، ليعرف المقدم في وجوه الروات (كذا)، فاستبنت القوي من الضعيف، وباينت المشروف من الشريف ..) ومن عناوينه فيها ذكر اختلافهم - أي القراء - في التعوذ والبسملة وبيان الراجح من ذلك، اختلاف سورة آل عمران، ثم سورة النساء، الخ.
وقد أسهم عبد الكريم الفكون أيضا بالتأليف في القراءات. فقد ذكر أنه ألف عملا سماه (سربال الردة في من جعل السبعين لرواة الاقرا (كذا) عدة). وقد نص على أن هذا التأليف لا يتجاوز كراسة وأنه قد وضعه بعد واقعة وقعت له مع أحد علماء قسنطينة عندئذ، وهو أحمد بن حسن الغربي (2). ويبدو من العنوان ومن ظروف التأليف أن هذه الكراسة عبارة عن مناقشة لما ادعاه الغربي. ولكن معرفتنا لبعض آثار الفكون الأخرى تجعلنا نعتقد أن هذا العمل غني بالآراء والنقول، وأن صاحبه قد عالج فيه أنواع القراءات ورواتها وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع. ومما يتصل بأوجه القراءات طريقة النطق بالتكبير والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عند الختم. وقد ألف في ذلك أيضا أحمد بن ثابت التلمساني، الذي تقدم ذكره، رسالة لا نعرف الآن بالضبط اسمها لأنها مبتورة، والذي نعرفه عنها أن صاحبها قد نظم أبياتا في التكبير عند الختم بطلب من بعض إخوانه ثم شرح الأبيات. وجاء في طالعها:
__________
(1) المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2245 مجموع، وهي فيه من ورقة 171 إلى 182.
(2) الفكون (منشور الهداية)، مخطوط. وهو محقق ومطبوع.
وقد أسهم عبد الكريم الفكون أيضا بالتأليف في القراءات. فقد ذكر أنه ألف عملا سماه (سربال الردة في من جعل السبعين لرواة الاقرا (كذا) عدة). وقد نص على أن هذا التأليف لا يتجاوز كراسة وأنه قد وضعه بعد واقعة وقعت له مع أحد علماء قسنطينة عندئذ، وهو أحمد بن حسن الغربي (2). ويبدو من العنوان ومن ظروف التأليف أن هذه الكراسة عبارة عن مناقشة لما ادعاه الغربي. ولكن معرفتنا لبعض آثار الفكون الأخرى تجعلنا نعتقد أن هذا العمل غني بالآراء والنقول، وأن صاحبه قد عالج فيه أنواع القراءات ورواتها وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع. ومما يتصل بأوجه القراءات طريقة النطق بالتكبير والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عند الختم. وقد ألف في ذلك أيضا أحمد بن ثابت التلمساني، الذي تقدم ذكره، رسالة لا نعرف الآن بالضبط اسمها لأنها مبتورة، والذي نعرفه عنها أن صاحبها قد نظم أبياتا في التكبير عند الختم بطلب من بعض إخوانه ثم شرح الأبيات. وجاء في طالعها:
__________
(1) المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2245 مجموع، وهي فيه من ورقة 171 إلى 182.
(2) الفكون (منشور الهداية)، مخطوط. وهو محقق ومطبوع.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
إذا أدرت الختم للمكي ... من الضحى يروى عن النبي
أما الشرح فقد بدأه بهذه العبارات (وبعد، فلما كان التكبير سنة مأثورة على أهل مكة، وكان نظر شيخنا سيدي محمد بن توزينت كافيا في معرفة وجهه وكيفية تلاوته حالة الختم، واستكثره بعض الأخوان، وليس بكثير) (1)، أنشأ الأبيات المذكورة همع شرحها تلبية لمن طلبه ذلك.
الحديث
من العلوم التي أنتج فيها الجزائريون علم الحديث ومصطلحه. فقد اعتنوا به تدريسا وتأليفا ورواية وإجازة. ولا شك أن ذلك يعود إلى صلة علم الحديث بالدين وبالتصوف معا. كما يعود إلى كون علم الحديث يعتمد إلى حد كبير على الحفظ، وهم حفاظ مهرة حتى اشتهروا بذلك منذ القديم. وكان العمل عندهم بالكتب الستة، يدرسونها ويسندونها ويحفظونها أحيانا، ولكن عنايتهم بصحيح البخاري قد فاقت كل عناية. فهو الكتاب الذي كان متداولا لديهم أكثر من غيره، ولعله قد بلغ عند بعضهم مبلغ القداسة، فكتبوا عليه الشروح والحواشي، وتدارسوه للبركة والحفظ، واستعملوه في المناسبات الدينية والحربية، واهتموا به عند القراءة حتى لا تقع أخطاء في معانيه.
ولا نكاد نجد مدرسا من المدرسين البارزين الذين ذكرناهم إلا وقد برع في تدريس الحديث أيضا. وأهم الأماكن التي كان يدرس بها الحديث هي الجوامع الكبيرة احتراما له. وكان بعضهم يبالغ فيضيف إلى جو الدرس جوا آخر من البهجة والسرور برش ماء الورد في نهاية ختم البخاري، وإلقاء جملة من الأدعية المناسبة، وترنيم الأحاديث بصوت رخيم. وكان لا يتولى إملاء الحديث إلا كبار العلماء وذوو الأصوات الحسنة والجهورية. فهذا
__________
(1) المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2254 مجموع. لا يوجد منها سوى ورقتين مع (الرسالة الغراء) لنفس المؤلف. ولا نعرف مصدرا آخر لباقيها.
أما الشرح فقد بدأه بهذه العبارات (وبعد، فلما كان التكبير سنة مأثورة على أهل مكة، وكان نظر شيخنا سيدي محمد بن توزينت كافيا في معرفة وجهه وكيفية تلاوته حالة الختم، واستكثره بعض الأخوان، وليس بكثير) (1)، أنشأ الأبيات المذكورة همع شرحها تلبية لمن طلبه ذلك.
الحديث
من العلوم التي أنتج فيها الجزائريون علم الحديث ومصطلحه. فقد اعتنوا به تدريسا وتأليفا ورواية وإجازة. ولا شك أن ذلك يعود إلى صلة علم الحديث بالدين وبالتصوف معا. كما يعود إلى كون علم الحديث يعتمد إلى حد كبير على الحفظ، وهم حفاظ مهرة حتى اشتهروا بذلك منذ القديم. وكان العمل عندهم بالكتب الستة، يدرسونها ويسندونها ويحفظونها أحيانا، ولكن عنايتهم بصحيح البخاري قد فاقت كل عناية. فهو الكتاب الذي كان متداولا لديهم أكثر من غيره، ولعله قد بلغ عند بعضهم مبلغ القداسة، فكتبوا عليه الشروح والحواشي، وتدارسوه للبركة والحفظ، واستعملوه في المناسبات الدينية والحربية، واهتموا به عند القراءة حتى لا تقع أخطاء في معانيه.
ولا نكاد نجد مدرسا من المدرسين البارزين الذين ذكرناهم إلا وقد برع في تدريس الحديث أيضا. وأهم الأماكن التي كان يدرس بها الحديث هي الجوامع الكبيرة احتراما له. وكان بعضهم يبالغ فيضيف إلى جو الدرس جوا آخر من البهجة والسرور برش ماء الورد في نهاية ختم البخاري، وإلقاء جملة من الأدعية المناسبة، وترنيم الأحاديث بصوت رخيم. وكان لا يتولى إملاء الحديث إلا كبار العلماء وذوو الأصوات الحسنة والجهورية. فهذا
__________
(1) المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2254 مجموع. لا يوجد منها سوى ورقتين مع (الرسالة الغراء) لنفس المؤلف. ولا نعرف مصدرا آخر لباقيها.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
عبد الرزاق بن حمادوش، الذي تولى سرد صحيح البخاري في الجامع الكبير بالعاصمة، يروي أن ممليه كان محمد بن سيدي الهادي وأحمد العمالي والمفتي الحاج الزروق وعبد الرحمن الزروق، وغيرهم. وكان يميز من كان له صوت جهوري سليم ومن كان صوته ضعيفا وغير فصيح (1). كما تضمنت رحلة ابن عمار (2) ومذكرات الزهار وغيرهما المناسبات الدينية والاجتماعية التي يتلى فيها البخاري وطريقة التلاوة وزمنها ونحو ذلك. كما أن مصادر الحملات العسكرية ضد الأجانب تضمنت وصفا للجوء العلماء الجزائريين، أحيانا بأمر السلطات السياسية، لقراءة صحيح البخاري في المساجد أو بين أيدي المقاتلين. ومن ذلك ما رواه ابن زرفة في (الرحلة القمرية) (3) وابن سحنون في (الثغر الجماني) من أن الباي محمد الكبير قد أمر العلماء والطلبة بقراءة صحيح البخاري عند الحملة ضد الإسبان بوهران. وبالجملة فإن مكانة صحيح البخاري في الحياة الدينية والاجتماعية في الجزائر خلال العهد العثماني مكانة عظيمة حتى أن صحيح البخاري كاد ينافس المصحف في كثرة الاستعمال (4).
فإذا عدنا إلى الأثبات والفهارس وجدنا ثروة كبيرة تركها الجزائريون بهذا الصدد. كما أن إجازتهم لغيرهم قد تضمنت روايتهم للحديث وشيوخهم ونحو ذلك مما يتصل بالسند. وكان الجزائريون حريصين في أسفارهم وحجهم على الدراسة وطلب العلم، ولا سيما علم الحديث، للأسبالب التي ذكرناها في الجزء الأول، وعلى رأسها عدم وجود معاهد عليا للتعليم في
__________
(1) ابن حمادوش (الرحلة) مخطوط. انظر أيضا دراستي عنه في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر)، ج 1، ط 3، 1990.
(2) الحاج صادق، المولد عند ابن عمار (بالفرنسية)، دمشق، 1957.
(3) هوداس (مخطوط عربي عن خروج الإسبان من وهران) في وقائع مؤتمر المستشرقين الرابع عشر، الجزائر 1905.
(4) عالج ذلك محمد بن أبي شنب (وصول صحيح البخاري إلى سكان مدينة الجزاثر) في بحث قدمه إلى مؤتمر المستشرقين الرابع عشر، الجزائر 1905.
فإذا عدنا إلى الأثبات والفهارس وجدنا ثروة كبيرة تركها الجزائريون بهذا الصدد. كما أن إجازتهم لغيرهم قد تضمنت روايتهم للحديث وشيوخهم ونحو ذلك مما يتصل بالسند. وكان الجزائريون حريصين في أسفارهم وحجهم على الدراسة وطلب العلم، ولا سيما علم الحديث، للأسبالب التي ذكرناها في الجزء الأول، وعلى رأسها عدم وجود معاهد عليا للتعليم في
__________
(1) ابن حمادوش (الرحلة) مخطوط. انظر أيضا دراستي عنه في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر)، ج 1، ط 3، 1990.
(2) الحاج صادق، المولد عند ابن عمار (بالفرنسية)، دمشق، 1957.
(3) هوداس (مخطوط عربي عن خروج الإسبان من وهران) في وقائع مؤتمر المستشرقين الرابع عشر، الجزائر 1905.
(4) عالج ذلك محمد بن أبي شنب (وصول صحيح البخاري إلى سكان مدينة الجزاثر) في بحث قدمه إلى مؤتمر المستشرقين الرابع عشر، الجزائر 1905.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
بلادهم. فكانوا إذا حلوا بالمغرب أو بتونس، بمصر أو بالحرمين، بالشام أو العراق 0 يتتلمذون على أكابر العلماء إلى أن ينالوا منهم سعة الاطلاع والتعمق في المعارف ويحصلون منهم على الإجازات في مختلف العلوم، وخصوصا علم الحديث وكان علماء الجرائر بدورهم ينشرون هذا العلم عن طريق الإجازة ونحوها بالشروط المعروفه لديهم عندئذ. وبذلك ساعدوا من جهتهم على نشر علم الحديث وأظهروا العناية به. وقد ساعدتهم في ذلك قوة الحافظة التي أشرنا إليها. وهكذا فعل كبار علماء الجزائر أمثال عبد الكريم الفكون وابن العنابي وعلي بن الأمين وعيسى الثعالبي، وأحمد البوني، وأحمد بن عمار وأبو راس الناصر ويحيى الشاوي.
ولم يكن الحديث يدرس لذاته فقط بل كان يدرس أيضا للعمل به في مجالات المعرفة المختلفة. فالحديث قبل كل شئ مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وفي ضوء ذلك عمد الجزائريون إلى دراسة الطب النبوي وسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة، وما إلى ذلك من القضايا التي تضمنها الحديث. فقد ألف محمد بن علي بن أبي الشرف التلمساني كتابا كبيرا في أجزاء جرده من كتاب الشفا للقاضي عياض سماه (المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا) كما قام بشرح ما أخذه من الشفا. وكان المؤلف قد أخذ الشفا إجازة عن ابن غازي بفاس سنة 913. وبعد أن تشبع بالثقافة الجزائرية والمغربية توجه ابن أبي الشرف إلى المشرق حيث كان موجودا بمكة المكرمة سنة 930، ومن هناك انقطعت عنا أخباره فلعله ظل مجاورا بالحرمين إلى أن أدركته الوفاة في تاريخ ما زلنا نجهله. وطريقة الشرح التي اتبعها ابن أبي الشرف ليست جديدة، فهو يعمد إلى شرح الألفاظ التي انتقاها من الشفا شرحا لغويا ثم دينيا، ولكن بأسلوب سهل واضح (1).
__________
(1) اطلعنا على نسخة الخزانة العامة بالرباط، ك 340. وتوجد منه نسخة أخرى في المكتبة الوطنية بالجزائر، رقم 2113 وهناك نسخة أخرى منه مأخودة عن خط مؤلفه بالزاوية الحمزية بالمغرب رقم 468. وتاريخ النسخة 971. انظر (مجلة تطوان)، 8.
ولم يكن الحديث يدرس لذاته فقط بل كان يدرس أيضا للعمل به في مجالات المعرفة المختلفة. فالحديث قبل كل شئ مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وفي ضوء ذلك عمد الجزائريون إلى دراسة الطب النبوي وسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة، وما إلى ذلك من القضايا التي تضمنها الحديث. فقد ألف محمد بن علي بن أبي الشرف التلمساني كتابا كبيرا في أجزاء جرده من كتاب الشفا للقاضي عياض سماه (المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا) كما قام بشرح ما أخذه من الشفا. وكان المؤلف قد أخذ الشفا إجازة عن ابن غازي بفاس سنة 913. وبعد أن تشبع بالثقافة الجزائرية والمغربية توجه ابن أبي الشرف إلى المشرق حيث كان موجودا بمكة المكرمة سنة 930، ومن هناك انقطعت عنا أخباره فلعله ظل مجاورا بالحرمين إلى أن أدركته الوفاة في تاريخ ما زلنا نجهله. وطريقة الشرح التي اتبعها ابن أبي الشرف ليست جديدة، فهو يعمد إلى شرح الألفاظ التي انتقاها من الشفا شرحا لغويا ثم دينيا، ولكن بأسلوب سهل واضح (1).
__________
(1) اطلعنا على نسخة الخزانة العامة بالرباط، ك 340. وتوجد منه نسخة أخرى في المكتبة الوطنية بالجزائر، رقم 2113 وهناك نسخة أخرى منه مأخودة عن خط مؤلفه بالزاوية الحمزية بالمغرب رقم 468. وتاريخ النسخة 971. انظر (مجلة تطوان)، 8.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وقد ترك أحمد المقري عدة تآليف في علم الحديث والسنة النبوية.
وكان مشهورا برواية الحديث الذي أخذه عن علماء المغرب والمشرق. ومما أخذه عن عمه سعيد المقري بتلمسان سنده في الكتب الستة إلى القاضي عياض. وكان المقري قد تصدر لتدريس صحيح البخاري في الجامع الأزهر حتى بهر الحاضرين، كما وفد على المدينة المنورة سبع مرات وأملى الحديث النبوي عند قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم). وقد أملى صحيح البخاري بالجامع الأموي بدمشق أثناء درس كان يلقيه بعد صلاة الصبح. ولما كثر الناس حوله خرج إلى صحن الجامع. وحضر درسه غالب أعيان دمشق وجميع الطلبة، كما يقول المحبي. وكان يوم ختم البخاري (حافلا جدا اجتمع فيه الألوف من الناس وعلت الأصوات بالبكاء فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى الباب الذي يوضع فيه العلم النبوي في الجمعات من رجب وشعبان ورمضان. وأتي إليه بكرسي الوعظ فصعد عليه وتكلم بكلام في العقائد والحديث لم يسمع نظيره أبدا، وتكلم على ترجمة البخاري. وكانت الجلسة من طلوع الشمس إلى قرب الظهر، ثم ختم الدرس بآيات قالها حين ودع المصطفى (صلى الله عليه وسلم). ونزل عن الكرسي فازدحم الناس على تقبيل يده. ولم يتفق لغيره من العلماء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من الحظوة وإقبال الناس) (1) وكان ذلك قبل وفاة المقري بأربع سنوات. ومن تآليف المقري في السنة النبوية (فتح المتعال في مدح النعال) (2) وهو بحث في النعال النبوية ألفه في المدينة المنورة، و (أزهار الكمامة في أخبار العمامة ونبذة من ملابس المخصوص بالإسراء والإمامة)، وهو بحث في عمامة وملابس النبي (صلى الله عليه وسلم). كما ألف كتابا في الأسماء النبوية سماه (الدر الثمين في أسماء الهادي الأمين) (3)، وسنذكر ما للمقري من أثبات بعد قليل.
__________
(1) خلاصة الأثر، 1/ 305.
(2) طبع قي حيدر أباد سنة 1334.
(3) الكتاني فهرس الفهارس 2/ 14، وخلاصة الأثر 1/ 303، وفهرس دار الكتب المصرية رقم 24260 ب.
وكان مشهورا برواية الحديث الذي أخذه عن علماء المغرب والمشرق. ومما أخذه عن عمه سعيد المقري بتلمسان سنده في الكتب الستة إلى القاضي عياض. وكان المقري قد تصدر لتدريس صحيح البخاري في الجامع الأزهر حتى بهر الحاضرين، كما وفد على المدينة المنورة سبع مرات وأملى الحديث النبوي عند قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم). وقد أملى صحيح البخاري بالجامع الأموي بدمشق أثناء درس كان يلقيه بعد صلاة الصبح. ولما كثر الناس حوله خرج إلى صحن الجامع. وحضر درسه غالب أعيان دمشق وجميع الطلبة، كما يقول المحبي. وكان يوم ختم البخاري (حافلا جدا اجتمع فيه الألوف من الناس وعلت الأصوات بالبكاء فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى الباب الذي يوضع فيه العلم النبوي في الجمعات من رجب وشعبان ورمضان. وأتي إليه بكرسي الوعظ فصعد عليه وتكلم بكلام في العقائد والحديث لم يسمع نظيره أبدا، وتكلم على ترجمة البخاري. وكانت الجلسة من طلوع الشمس إلى قرب الظهر، ثم ختم الدرس بآيات قالها حين ودع المصطفى (صلى الله عليه وسلم). ونزل عن الكرسي فازدحم الناس على تقبيل يده. ولم يتفق لغيره من العلماء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من الحظوة وإقبال الناس) (1) وكان ذلك قبل وفاة المقري بأربع سنوات. ومن تآليف المقري في السنة النبوية (فتح المتعال في مدح النعال) (2) وهو بحث في النعال النبوية ألفه في المدينة المنورة، و (أزهار الكمامة في أخبار العمامة ونبذة من ملابس المخصوص بالإسراء والإمامة)، وهو بحث في عمامة وملابس النبي (صلى الله عليه وسلم). كما ألف كتابا في الأسماء النبوية سماه (الدر الثمين في أسماء الهادي الأمين) (3)، وسنذكر ما للمقري من أثبات بعد قليل.
__________
(1) خلاصة الأثر، 1/ 305.
(2) طبع قي حيدر أباد سنة 1334.
(3) الكتاني فهرس الفهارس 2/ 14، وخلاصة الأثر 1/ 303، وفهرس دار الكتب المصرية رقم 24260 ب.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وكان مختصر ابن أبي جمرة لصحيح البخاري متداولا أيضا بين الجزائريين. وقد شعر عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي أن هذا المختصر في حاجة إلى شرح يضبط ألفاظه ويقرب معانيه فقام بعمل ضخم بهذا الصدد، وسمى شرحه (فتح الباري في ضبط ألفاظ الأحاديث التي اختصرها العارف بالله (ابن أبي جمرة) من صحيح البخاري). وكان المجاجي قد درس أولا في موطنه مجاجة وفي تلمسان ثم في فاس على عدة شيوخ. وكان دافعه إلى القيام بهذا العمل الغيرة على قراءة الحديث حتى لا تقع فيه الأخطاء أثناء القراءة، وكون شيخه، محمد بن علي أبهلول، كثيرا ما فكر في كتابة عمل من هذا النوع، ولكن الأقدار لم تسعفه. لذلك قام هو بالمهمة. وقد بدأ المجاجي بتعريف علم الحديث، فقال: (علم الحديث من أجل العلوم قدرا، وأعلاها منزلة وخطرا، وكان الناس مقبلين على قراءة جامع البخاري عموما وعلى ما اختصر منه الشيخ العارف بالله ابن أبي جمرة .. خصوصا .. وكانت قراءة الحديث تحتاج إلى شروط جمة، وتلزمها آداب مهمة، أعظمها الاحتراز من الخطأ في إعرابه، ومن اللحن في مضبوط ألفاظه، فتحرك مني الغرام الساكن لضبط تلك الأماكن ..) وفي المقدمة التي وضعها المجاجي لشرحه بابان الأول في التعريف بالمصنف (البخاري) والثاني في علم الحديث على الجملة، وجعل كل باب يحتوي على فصول، كآداب معرفة الحديث، وكيفية روايته، وكيفية كتب الحديث وضبطه، وبعض ألقاب الحديث الخ. أما الكتاب جملة فقد قسمه إلى كتب، فهناك كتاب للبيع، وآخر للشركة، وثالث للصوم، ورابع للهبة الخ. وقد وضع بعض المصطلحات في المنقول عنهم: فحرف الحاء (ح) يشير إلى القاضي عياض، وهكذا. كما أنه نقل كثيرا عن أستاذه محمد بن علي أبهلول (1).
__________
(1) الخزانة العامة بالرباط، رقم ك 1775 في حوالي 300 ورقة وبخط جيد، وهناك نسخة أخرى برقم ك 1065 غير جيدة وغير كاملة ويبلغ الموجود منها 416 صفحة. ومنه نسخة أيضا في المكتبة الملكية بالرباط رقم 5714 (1). ومن الملاحظ أن أبا راس قد أوضح أن عبد الرحمن المجاجي كان تلميذا لابني علي أبهلول، وهما =
__________
(1) الخزانة العامة بالرباط، رقم ك 1775 في حوالي 300 ورقة وبخط جيد، وهناك نسخة أخرى برقم ك 1065 غير جيدة وغير كاملة ويبلغ الموجود منها 416 صفحة. ومنه نسخة أيضا في المكتبة الملكية بالرباط رقم 5714 (1). ومن الملاحظ أن أبا راس قد أوضح أن عبد الرحمن المجاجي كان تلميذا لابني علي أبهلول، وهما =
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
10:52 AM
08-25-2016
وهناك تآليف أخرى في علم الحديث والسنة، من ذلك تأليف عبد العزيز الثميني الذي سماه (مختصر حاشية مسند الربيع بن حبيب) وهو في ثلاثة أجزاء. وحاشية أحمد بن عمار على صحيح البخاري. وقد عرف ابن عمار السند وفضله على الأمة الإسلامية، مستعيرا تعريفه من محمد بن أبي حاتم بن المظفر 0 وكان ابن عمار من المسندين المعروفين في وقته. وسنذكر ثبته فيما بعد (1). ومثله عيسى الثعالبي الذي وضع رجزا سماه (مضاعفة ثواب هذه الأمة) (2). ولعل عنوان الرجز غير كامل، ولعل الثعالبي قد قام بشرحه وإبراز أفكاره وإثراء عمله بالاستشهادات. وهناك عمل آخر ينسب إلى قاسم بن محمد ساسي البوبي سماه (المنحة الإلهية في الآيات الإسرائية) (3). كما ينسب إلى أحمد بن ثابت البجائي عمل في الحديث هو (التفكر والاعتبار في الصلاة على النبي المختار) (4). أما محمد بن أحمد الشريف الجزائري فقد وضع رسالة في الطب النبوي سماها (المن والسلوى في تحقيق معنى حديثا لا عدوى). وقد حلل فيها معنى الحديث من جميع النواحي. وأهداها بنفسه إلى السلطان العثماني في وقته أحمد باشا (سنة 1149) (5). كما نظم محمد بن علي المعروف بأقوجيلي (القوجيلي) الجزائري منظومة سماها (عقد الجمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع)،
__________
= محمد وأبو على، وليس لوالدهما. انظر (عجائب الأسفار)، مخطوط الجزائر، 138. ولا ندري الآن ما إذا كان عبد الرحمن المجاجي هو نفسه مؤلف (التعريف بأهل بدر) الذي يذكر مؤلفه أنه عبد الرحمن بن علي الراشدي. المعرض الثالث لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات (مركز الرباط، 1971).
(1) محمد بن أبي شنب (وصول صحيح البخاري إلى أهل مدينة الجزائر) محاضر. مؤتمر المستشرقين 14، الجزائر 1905.
(2) بروكلمان 2/ 939. وهو في علم الحديث.
(3) بروكلمان 2/ 691. ولعل هذا العمل من تآليف أحمد البوني.
(4) بروكلمان 2/ 939. ولا نعرف الآن عصر البجائي.
(5) اطلعنا على هذه الرسالة في مكتبة كوبروللو بإسطانبول، وهي في 13 ورقة وخطها رقعي وجيد، ورقمها 69.
وهناك تآليف أخرى في علم الحديث والسنة، من ذلك تأليف عبد العزيز الثميني الذي سماه (مختصر حاشية مسند الربيع بن حبيب) وهو في ثلاثة أجزاء. وحاشية أحمد بن عمار على صحيح البخاري. وقد عرف ابن عمار السند وفضله على الأمة الإسلامية، مستعيرا تعريفه من محمد بن أبي حاتم بن المظفر 0 وكان ابن عمار من المسندين المعروفين في وقته. وسنذكر ثبته فيما بعد (1). ومثله عيسى الثعالبي الذي وضع رجزا سماه (مضاعفة ثواب هذه الأمة) (2). ولعل عنوان الرجز غير كامل، ولعل الثعالبي قد قام بشرحه وإبراز أفكاره وإثراء عمله بالاستشهادات. وهناك عمل آخر ينسب إلى قاسم بن محمد ساسي البوبي سماه (المنحة الإلهية في الآيات الإسرائية) (3). كما ينسب إلى أحمد بن ثابت البجائي عمل في الحديث هو (التفكر والاعتبار في الصلاة على النبي المختار) (4). أما محمد بن أحمد الشريف الجزائري فقد وضع رسالة في الطب النبوي سماها (المن والسلوى في تحقيق معنى حديثا لا عدوى). وقد حلل فيها معنى الحديث من جميع النواحي. وأهداها بنفسه إلى السلطان العثماني في وقته أحمد باشا (سنة 1149) (5). كما نظم محمد بن علي المعروف بأقوجيلي (القوجيلي) الجزائري منظومة سماها (عقد الجمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع)،
__________
= محمد وأبو على، وليس لوالدهما. انظر (عجائب الأسفار)، مخطوط الجزائر، 138. ولا ندري الآن ما إذا كان عبد الرحمن المجاجي هو نفسه مؤلف (التعريف بأهل بدر) الذي يذكر مؤلفه أنه عبد الرحمن بن علي الراشدي. المعرض الثالث لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات (مركز الرباط، 1971).
(1) محمد بن أبي شنب (وصول صحيح البخاري إلى أهل مدينة الجزائر) محاضر. مؤتمر المستشرقين 14، الجزائر 1905.
(2) بروكلمان 2/ 939. وهو في علم الحديث.
(3) بروكلمان 2/ 691. ولعل هذا العمل من تآليف أحمد البوني.
(4) بروكلمان 2/ 939. ولا نعرف الآن عصر البجائي.
(5) اطلعنا على هذه الرسالة في مكتبة كوبروللو بإسطانبول، وهي في 13 ورقة وخطها رقعي وجيد، ورقمها 69.
الموضوع:
تاريخ الجزائر الثقافي.doc الجــــزء الثاني بقسم
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وهي منظومة في مخرجي أحاديث الجامع الصحيح للبخاري وعدد الأحاديث التي لكل منهم، ومن هو المكثر ومن هو المقل في السند على ما أورده ابن حجر. وزاد عليه القوجيلي التعريف بالوفاة وتكملة تراجم الرواة (1). وقد قام أحمد بن قاسم البوني باختصار مقدمات فتح الباري على البخاري (2). كما جمع محمد بن أبي الحسن بن محمد العربي التلمساني حوالي خمسمائة حديث ووضعها في مائة واثني عشر بابا وسمى ذلك (الهادي للمهتدي) (3). ويمكن القول إنه برغم عناية الجزائريين بالحديث، وبصحيح البخاري خصوصا، فإن تآليفهم فيه لا تقارن هذه العناية. حقا إن لهم أعمالا أخرى في السيرة النبوية عموما وبعض الأعمال المستمدة من الأحاديث، ولكن يظل ميدان التأليف في علم الحديث يكاد يكون خاليا إلا من بعض الأمور التقليدية مثل الشروح والحواشي والرسائل الصغيرة والأراجيز، ولا شك أن هناك بعض الأعمال التي فاتنا التنبيه عليها. ولعل في جهود الجزائريين في ميدان الأثبات والفهارس والإجازات ما يعوض هذا النقص في التأليف في علم الحديث.
الأثبات
شاع في الجزائر خلال العهد المدروس حفظ الحديث وإسناده وقراءته وإقراؤه. كما شاعت كتابة الأثبات أو (الفهارس أو البرامج) التي كان العالم يسجل فيها مروياته في الحديث بالسند، والكتب التي قرأها مثل صحيح
__________
(1) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، مجموع رقم 52 من ورقة 29 - 47. وبناء على هذا المصدر فإن القوجيلي قد توفي سنة 1080. انظر عنه فصل الشعر أيضا.
(2) نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا) رقم 450. وعنوانه هناك هو (مختصر مقدمات فتح الباري). وهو بخط المؤلف بتاريخ 1113. انظر أيضا فهرس الفهارس 1/ 169، وبروكلمان 2/ 715، انظر أيضا ترجمة أحمد البوني في هذا الفصل.
(3) نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا) رقم 5681 مجموع. وقد كتبه مؤلفه سنة 1156.انظر أيضا بروكلمان 2/ 611.
الأثبات
شاع في الجزائر خلال العهد المدروس حفظ الحديث وإسناده وقراءته وإقراؤه. كما شاعت كتابة الأثبات أو (الفهارس أو البرامج) التي كان العالم يسجل فيها مروياته في الحديث بالسند، والكتب التي قرأها مثل صحيح
__________
(1) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، مجموع رقم 52 من ورقة 29 - 47. وبناء على هذا المصدر فإن القوجيلي قد توفي سنة 1080. انظر عنه فصل الشعر أيضا.
(2) نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا) رقم 450. وعنوانه هناك هو (مختصر مقدمات فتح الباري). وهو بخط المؤلف بتاريخ 1113. انظر أيضا فهرس الفهارس 1/ 169، وبروكلمان 2/ 715، انظر أيضا ترجمة أحمد البوني في هذا الفصل.
(3) نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا) رقم 5681 مجموع. وقد كتبه مؤلفه سنة 1156.انظر أيضا بروكلمان 2/ 611.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
البخاري وغيره من الكتب الستة المشهورة، كما يسجل شيوخه الذين درس عليهم، ولا سيما شيوخه في علم الحديث. وكانت هذه الأثبات تتداول بين العلماء ولا تعرف حدودا لا في البلد الواحد ولا خارجه، فهي تتنقل مع الحجاج أو ترسل بالبريد أو تحفظ عن ظهر قلب أو تكتب مطولة أو مختصرة في شكل إجازات، كما سنرى. وكانت الأثبات ورواية علم الحديث وإجادة السند مما يتفاخر به العلماء ويتباهون به فيما بينهم. ويعتبر الثبت الغني بالشيوخ والإجازات والقراءات علامة على تبحر العالم في علمه وعلى بلوغه ما يشبه الكمال عندهم. لذلك قل كتاب الأثبات لقلة الأكفاء في علم الحديث وكثر، من جهة أخرى، طلاب الإجازات وسهل منحها، لأنها تعتبر شهادات علمية ومدخلا للكفاءة في التدريس ونحوه. وكان يكفي أن يقال عن فلان إنه (حافظ) حتى تشرئب إليه الأعناق وتقطع إليه المسافات لنيل الإجازة منه ورواية الحديث وغيره عنه.
وإذا نظرنا إلى الناحية الشكلية فإن الثبت يكتب إما كسجل تاريخي شخصي، وإما لمنحه إجازة لأحد العلماء الراغبين. ولدينا الآن نماذج للنوعين. ولكن الإجازة قد تكون اختصارا لما في الثبت من مطولات. مثلا، كتب أحمد بن عمار ثبته مطولا ولكنه عندما أجاز عالم دمشق محمد خليل المرادي اكتفى بتعداد القليل من شيوخه ومروياته. وكذلك فعل ابن العنابي مع محمد بيرم التونسي. وكان العلماء يعتقدون أنهم بهذه الطريقة (كتابة الأثبات ومنح الإجازات) يحافظون على علم الحديث رواية ويصلون السند بعضه ببعض مهما تباعدت الحقب. والواقع أنهم بذلك خلقوا استمرارية واضحة بين الأجيال في هذا الفرع الهام من فروع المعرفة الإسلامية. ويكفي أن يقال مثلا أن ابن باديس في القرن الرابع عشر الهجري كان يروي الحديث عن أحمد الونشريسي في القرن العاشر، بينما لم يجتمعا ولم يتتلمذ أحدهما على الآخر وإنما وقعت للأول رواية الحديث عن طريق السند من الثاني. ومن أشهر الجزائريين الذين رويت عنهم الأحاديث سعيد قدورة وأحمد بن عمار وعلي بن الأمين وعيسى الثعالبي وسعيد المقري.
وإذا نظرنا إلى الناحية الشكلية فإن الثبت يكتب إما كسجل تاريخي شخصي، وإما لمنحه إجازة لأحد العلماء الراغبين. ولدينا الآن نماذج للنوعين. ولكن الإجازة قد تكون اختصارا لما في الثبت من مطولات. مثلا، كتب أحمد بن عمار ثبته مطولا ولكنه عندما أجاز عالم دمشق محمد خليل المرادي اكتفى بتعداد القليل من شيوخه ومروياته. وكذلك فعل ابن العنابي مع محمد بيرم التونسي. وكان العلماء يعتقدون أنهم بهذه الطريقة (كتابة الأثبات ومنح الإجازات) يحافظون على علم الحديث رواية ويصلون السند بعضه ببعض مهما تباعدت الحقب. والواقع أنهم بذلك خلقوا استمرارية واضحة بين الأجيال في هذا الفرع الهام من فروع المعرفة الإسلامية. ويكفي أن يقال مثلا أن ابن باديس في القرن الرابع عشر الهجري كان يروي الحديث عن أحمد الونشريسي في القرن العاشر، بينما لم يجتمعا ولم يتتلمذ أحدهما على الآخر وإنما وقعت للأول رواية الحديث عن طريق السند من الثاني. ومن أشهر الجزائريين الذين رويت عنهم الأحاديث سعيد قدورة وأحمد بن عمار وعلي بن الأمين وعيسى الثعالبي وسعيد المقري.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ومن الجزائريين الذين انتقل منهم علم الحديث إلى علماء آخرين نذكر محمد التنسي وابن مرزوق المعروف بالكفيف، ومحمد بن يوسف السنوسي وعبد الرحمن الثعالبي ومحمد بن عبد الكريم المغيلي وأحمد الونشريسي (1). وكان لهؤلاء تلاميذ أخذوا عنهم علم الحديث جيلا بعد جيل. وقد اشتهروا (بالحفظ) وهي الظاهرة العامة التي تحدثنا عنها. ولذلك أشير إلى محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي بأنه (الإمام المحدث الحافظ) وسماه بعضهم (ببقية الحفاظ). ومهما يكن من شيء فإن ثبت التنسي قد وصل إلى العهد العثماني عن طريق سعيد قدورة وأحمد المقري وغيرهما.
ومن الذين تركوا (ثبتا) أوائل العهد العثماني محمد شقرون بن أحمد الوهراني. وقد قيل إن ثبته يقع (في جزء لطيف) مما يبرهن على كثرة شيوخه ومروياته. والمعروف عن الوهراني أنه قد ألف في علوم أخرى أيضا وكان واسع الاطلاع بحكم الدراسة والتنقل (2). ولا نعرف أن عمر الوزان وعبد الرحمن الأخضري وسعيد المقري قد تركوا أثباتا بشيوخهم وأسانيدهم. وقد اشتهر في القرن الحادي عشر عدد من العلماء الذين ولعوا بالحديث رواية ودراية وتركوا وراءهم مروياتهم وشيوخهم في فهارس تحمل أسماءهم أو نقلوا مروياتهم إلى تلاميذهم فأخذوها عنهم مشافهة. وكان حظ بعض التلاميذ أوفر من حظ الأساتذة في تسجيل هذه الآثار. ولعل أبرز من سجل المرويات وولع بالحديث دراية ورواية أبو مهدي عيسى الثعالبي الذي ترك سجلا حافلا بذلك. ولأهمية عمله سنفرد له ترجمة في هذا الفصل. وقد كان أحمد المقري، رغم ولوعه بالأدب والتاريخ، قد أخذ سند الحديث عن
__________
(1) عن هؤلاء العلماء انظر الفصل الأول من الجزء الأول. باسثناء ابن مرزوق الكفيف الذي لم نذكره هناك. وهو من مشاهير المسندين أيضا حتى سماه معاصره أحمد الونشريسي (بالحافظ المصقع). وقد أخذ العلم عن والده محمد بن مرزوق الحفيد وعبد الرحمن الثعالبي، كما حج وأخذ عن علماء المشرق والمغرب. وتوفي سنة 901. وله (ثبت) يرويه عنه العلماء. انظر عنه (فهرس الفهارس) 1/ 197.
(2) (دليل مؤرخ المعرب) 2/ 300. توفي الوهراني حوالي 929.
ومن الذين تركوا (ثبتا) أوائل العهد العثماني محمد شقرون بن أحمد الوهراني. وقد قيل إن ثبته يقع (في جزء لطيف) مما يبرهن على كثرة شيوخه ومروياته. والمعروف عن الوهراني أنه قد ألف في علوم أخرى أيضا وكان واسع الاطلاع بحكم الدراسة والتنقل (2). ولا نعرف أن عمر الوزان وعبد الرحمن الأخضري وسعيد المقري قد تركوا أثباتا بشيوخهم وأسانيدهم. وقد اشتهر في القرن الحادي عشر عدد من العلماء الذين ولعوا بالحديث رواية ودراية وتركوا وراءهم مروياتهم وشيوخهم في فهارس تحمل أسماءهم أو نقلوا مروياتهم إلى تلاميذهم فأخذوها عنهم مشافهة. وكان حظ بعض التلاميذ أوفر من حظ الأساتذة في تسجيل هذه الآثار. ولعل أبرز من سجل المرويات وولع بالحديث دراية ورواية أبو مهدي عيسى الثعالبي الذي ترك سجلا حافلا بذلك. ولأهمية عمله سنفرد له ترجمة في هذا الفصل. وقد كان أحمد المقري، رغم ولوعه بالأدب والتاريخ، قد أخذ سند الحديث عن
__________
(1) عن هؤلاء العلماء انظر الفصل الأول من الجزء الأول. باسثناء ابن مرزوق الكفيف الذي لم نذكره هناك. وهو من مشاهير المسندين أيضا حتى سماه معاصره أحمد الونشريسي (بالحافظ المصقع). وقد أخذ العلم عن والده محمد بن مرزوق الحفيد وعبد الرحمن الثعالبي، كما حج وأخذ عن علماء المشرق والمغرب. وتوفي سنة 901. وله (ثبت) يرويه عنه العلماء. انظر عنه (فهرس الفهارس) 1/ 197.
(2) (دليل مؤرخ المعرب) 2/ 300. توفي الوهراني حوالي 929.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
شيوخه من المغرب والمشرق، كما عرفنا. وتضمن كتابه (روض الآس العاطر الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس) مجموعة من شيوخه في السند. وذكر بعض الباحثين أن للمقري أيضا (فهرسة) بأسانيده (1). وقد كان المقري في معارفه الكثيرة وطموحه البعيد ومحفوظه الغزير نقطة مضيئة في ظلام الثقافة الجزائرية خلال العهد العثماني (2).
وشهد القرن الثاني عشر أيضا موجة أخرى من العناية بالحديث رواية ودراية على يد مجموعة من العلماء، منهم المنور التلمساني الذي لا نكاد نعرف له تآليف غير مجموعة من الإجازات التي منحها له شيوخه في المغرب والمشرق. ومن شيوخه في الجزائر مصطفى الرماصي. وأما مشائخه في المشرق فقد ذكر منهم عبد الحي الكتاني أبا عبد الله محمد المسناوي وستة آخرين. وقد حصل الكتاني على معظم إجازات المنور. والأوصاف التي أطلقت على هذا الشيخ تدل على باعه الطويل في علم الحديث والسند حتى أن محمد مرتضى الزبيدي قال عنه: (العالم الفاقد للأشباه .. عالم قطر المغرب). ولعل هذا الإعجاب بالشيخ المنور يعود إلى كونه من الذين أجازوا الزبيدي أيضا. وقد توفي المنور بمصر أثناء عودته من الحج سنة 1172. ويؤكد الكتاني أن علماء الجزائر في وقته كانوا يروون مرويات المنور في الحديث (3).
وكان المنور التلمساني معاصرا لأحمد بن عمار الذي يعتبر من مسندي العصر ومن المؤلفين في السند أيضا. كان ابن عمار أديبا فقيها بالدرجة الأولى، ولكن تأثير العصر جعله يعيش عيشة العلماء الفقهاء أيضا. فأخذ الطريقة الشادلية عن المنور التلمساني، وأخذ (طريق القوم) عن
__________
(1) الكتاني (فهرس الفهارس) 2/ 13. انظر أيضا (خلاصة الأثر) 1/ 305. وله سند برواية صحيح البخاري مع إجازته لعيسى العجلوني في دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 335 مجموع.
(2) ستفرد للمقري ترجمة في فصل الأدب من هذا الجزء.
(3) الكتاني، 2/ 9. انظر عنه أيضا في الإجازات.
وشهد القرن الثاني عشر أيضا موجة أخرى من العناية بالحديث رواية ودراية على يد مجموعة من العلماء، منهم المنور التلمساني الذي لا نكاد نعرف له تآليف غير مجموعة من الإجازات التي منحها له شيوخه في المغرب والمشرق. ومن شيوخه في الجزائر مصطفى الرماصي. وأما مشائخه في المشرق فقد ذكر منهم عبد الحي الكتاني أبا عبد الله محمد المسناوي وستة آخرين. وقد حصل الكتاني على معظم إجازات المنور. والأوصاف التي أطلقت على هذا الشيخ تدل على باعه الطويل في علم الحديث والسند حتى أن محمد مرتضى الزبيدي قال عنه: (العالم الفاقد للأشباه .. عالم قطر المغرب). ولعل هذا الإعجاب بالشيخ المنور يعود إلى كونه من الذين أجازوا الزبيدي أيضا. وقد توفي المنور بمصر أثناء عودته من الحج سنة 1172. ويؤكد الكتاني أن علماء الجزائر في وقته كانوا يروون مرويات المنور في الحديث (3).
وكان المنور التلمساني معاصرا لأحمد بن عمار الذي يعتبر من مسندي العصر ومن المؤلفين في السند أيضا. كان ابن عمار أديبا فقيها بالدرجة الأولى، ولكن تأثير العصر جعله يعيش عيشة العلماء الفقهاء أيضا. فأخذ الطريقة الشادلية عن المنور التلمساني، وأخذ (طريق القوم) عن
__________
(1) الكتاني (فهرس الفهارس) 2/ 13. انظر أيضا (خلاصة الأثر) 1/ 305. وله سند برواية صحيح البخاري مع إجازته لعيسى العجلوني في دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 335 مجموع.
(2) ستفرد للمقري ترجمة في فصل الأدب من هذا الجزء.
(3) الكتاني، 2/ 9. انظر عنه أيضا في الإجازات.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
عبد الوهاب العفيغي بمصر. ولعله أخذ أيضا غير ذلك من عهود الطرق الصوفية عندما كان في الحجاز. أما الحديث، ولا سيما صحيح البخاري، فقد رواه عن خاله محمد بن سيدي هدى الجزائري ومحمد بن سيدي الهادي. كما روى علم الحديث عن علماء بمصر والحرمين وسجل بعضهم في إجازته لمحمد خليل المرادي الشامي. وقد عد له الكتاني تسعة أساتذة على الأقل يروى عنهم بأسانيدهم. وتنقل ابن عمار كثيرا بين الجزائر ومصر وتونس والحرمين، كما سنرى. وكان له نشاط أدبي في كل هذه البلدان.
وقد جمع تلميذه إبراهيم السيالة التونسي إجازات شيخه ومروياته فإذا هي تبلغ نحو الكراستين وتسمى: (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد). وعندما اطلع عليها ابن عمار سنة 1204 أجازه بها ووضع عليها خطوطه وختمه. وقد اطلعنا نحن على خط وختم ابن عمار في إجازاته للمرادي سنة 1205، وهي الإجازة التي كتبها بنفسه. وكان لرواية الحديث بطريقة ابن عمار تأثير على علماء العصر حتى أن معظم علماء الجزائر يروون عنه، ومنهم أبو راس وعبد الرحمن بن الحفاف (1) ومصطفى الكبابطي وأحمد بوقندورة وغيرهم (2) ولابن عمار تلاميذ كثيرون من المشرق والمغرب. فبالإضافة إلى من ذكر، هناك أحمد الغزال المغربي، وعمر بن عبد الكريم المعروف بابن عد الرسول المكي الحنفي شيخ الإسلام (3)، وغيرهما.
والمعروف أن أبا راس الناصر كان من أكثر العلماء إنتاجا في عصره. وكان إنتاجه متنوعا تنوع ثقافته. ومن الصعب دراسته في باب معين، ولكننا
__________
(1) كان حيا سنة 1213 إذ وجدناه يحضر مجلس البخاري بالعاصمة دراية ورواية ويتقاضى عن ذلك ريالا في كل شهر، الأرشيف دفتر (288) 41 - 228 mi .
(2) الكتاني، 2/ 26، 1/ 82 - 83 والحاج صادق (المولد عند ابن عمار) 289. انظر ترجمة ابن عمار في فصل الأدب من هذا الجزء.
(3) عن هذا الأخير انظر (فيض الملك المتعالي) لعبد الوهاب عبد الستار، 2/ 93. مخطوط بمكتبة الحرم الشريف.
وقد جمع تلميذه إبراهيم السيالة التونسي إجازات شيخه ومروياته فإذا هي تبلغ نحو الكراستين وتسمى: (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد). وعندما اطلع عليها ابن عمار سنة 1204 أجازه بها ووضع عليها خطوطه وختمه. وقد اطلعنا نحن على خط وختم ابن عمار في إجازاته للمرادي سنة 1205، وهي الإجازة التي كتبها بنفسه. وكان لرواية الحديث بطريقة ابن عمار تأثير على علماء العصر حتى أن معظم علماء الجزائر يروون عنه، ومنهم أبو راس وعبد الرحمن بن الحفاف (1) ومصطفى الكبابطي وأحمد بوقندورة وغيرهم (2) ولابن عمار تلاميذ كثيرون من المشرق والمغرب. فبالإضافة إلى من ذكر، هناك أحمد الغزال المغربي، وعمر بن عبد الكريم المعروف بابن عد الرسول المكي الحنفي شيخ الإسلام (3)، وغيرهما.
والمعروف أن أبا راس الناصر كان من أكثر العلماء إنتاجا في عصره. وكان إنتاجه متنوعا تنوع ثقافته. ومن الصعب دراسته في باب معين، ولكننا
__________
(1) كان حيا سنة 1213 إذ وجدناه يحضر مجلس البخاري بالعاصمة دراية ورواية ويتقاضى عن ذلك ريالا في كل شهر، الأرشيف دفتر (288) 41 - 228 mi .
(2) الكتاني، 2/ 26، 1/ 82 - 83 والحاج صادق (المولد عند ابن عمار) 289. انظر ترجمة ابن عمار في فصل الأدب من هذا الجزء.
(3) عن هذا الأخير انظر (فيض الملك المتعالي) لعبد الوهاب عبد الستار، 2/ 93. مخطوط بمكتبة الحرم الشريف.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
سنفرد لأبي راس دراسة في فصل التاريخ لغلبة هذا العلم على إنتاجه. وحسبنا هنا منه إنتاجه في سند علم الحديث. ذلك أنه قد أخذ هذا العلم على كثير من العلماء في المغرب والمشرق أيضا لكثرة أسفاره وتتلمذه هنا وهناك.
ومن الذين أخذ عنهم في الجزائر أحمد بن عمار وعلي بن الأمين، ومحمد بن جعدون، ومحمد بن مالك، ومحمد بن الشاهد، وأحمد العباسي، أما في المشرق فمن أبرز أساتذته محمد مرتضى الزبيدي ومحمد الأمير.
وقد خص أبو راس، الزبيدي بثبت سماه (السيف المنتضى فيما رويته عن الشيخ مرتضى)، وأدرج الجميع في عمله المعروف بـ (لب أفياخي في تعداد أشياخي) الذي لخصه في رحلته (فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته). وفي هذه الرحلة عدد أبو راس أيضا فضل الله عليه في التأليف والمشيخة ونحو ذلك. كما أنه ذكر هناك تآليفه الأخرى في علم الحديث.
ومن المعاصرين لأبي راس أبو طالب محمد المعروف بابن الشارف المازوني الذي توفي سنة 1233 بمازونة عن نيف ومائة سنة. والمازوني يشبه محمد المنور التلمساني في كونه غير معروف بتآليفه. فأسانيده التي وصلت إلينا توجد في مجلد وسط، حسب تعبير الكتاني، وقد جمعها عبد القادر بن المختار الخطابي الجزائري وسماها (الكوكب الثاقب في أسانيد الشيخ أبي طالب). والخطابي من سلالة المازوني ومن سلالة أبي راس أيضا. وقد تنقل الشيخ الخطابي بين الجزائر وتونس ومصر، وفي مصر أكمل تأليفه المذكور، ولعله توفي فيها أيضا سنة 1236. وقد رأى الكتاني نسخة من (ثبت) أبي طالب في مازونة (1).
ويشترك الطاهر المشرفي وحمودة المقايسي مع ابن الشارف المازوني ومحمد المنور في قلة الإنتاج والشهرة بين المعاصرين برواية الحديث وحفظ السند. فقد كان للطاهر بن عبد القادر المشرفي المعروف بابن دح (ثبت)
__________
(1) الكتاني 1/ 382.
ومن الذين أخذ عنهم في الجزائر أحمد بن عمار وعلي بن الأمين، ومحمد بن جعدون، ومحمد بن مالك، ومحمد بن الشاهد، وأحمد العباسي، أما في المشرق فمن أبرز أساتذته محمد مرتضى الزبيدي ومحمد الأمير.
وقد خص أبو راس، الزبيدي بثبت سماه (السيف المنتضى فيما رويته عن الشيخ مرتضى)، وأدرج الجميع في عمله المعروف بـ (لب أفياخي في تعداد أشياخي) الذي لخصه في رحلته (فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته). وفي هذه الرحلة عدد أبو راس أيضا فضل الله عليه في التأليف والمشيخة ونحو ذلك. كما أنه ذكر هناك تآليفه الأخرى في علم الحديث.
ومن المعاصرين لأبي راس أبو طالب محمد المعروف بابن الشارف المازوني الذي توفي سنة 1233 بمازونة عن نيف ومائة سنة. والمازوني يشبه محمد المنور التلمساني في كونه غير معروف بتآليفه. فأسانيده التي وصلت إلينا توجد في مجلد وسط، حسب تعبير الكتاني، وقد جمعها عبد القادر بن المختار الخطابي الجزائري وسماها (الكوكب الثاقب في أسانيد الشيخ أبي طالب). والخطابي من سلالة المازوني ومن سلالة أبي راس أيضا. وقد تنقل الشيخ الخطابي بين الجزائر وتونس ومصر، وفي مصر أكمل تأليفه المذكور، ولعله توفي فيها أيضا سنة 1236. وقد رأى الكتاني نسخة من (ثبت) أبي طالب في مازونة (1).
ويشترك الطاهر المشرفي وحمودة المقايسي مع ابن الشارف المازوني ومحمد المنور في قلة الإنتاج والشهرة بين المعاصرين برواية الحديث وحفظ السند. فقد كان للطاهر بن عبد القادر المشرفي المعروف بابن دح (ثبت)
__________
(1) الكتاني 1/ 382.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
أيضا يرويه العلماء ويتداولونه، وهو الثبت الذي كان قد أجاز به تلميذه ابن عبد الله سقط الذي سنتحدث عنه. ورغم أن الطاهر المشرفي قد تولى القضاء في وهران في أواخر العهد العثماني فإننا لا نعرف عن حياته الآن إلا القليل. ومن ذلك أنه هو شارح (النصيحة الزروقية) في التصوف، وانه كان قد أخذ العلم بفاس وأن من شيوخه بالإجازة عبد القادر بن شقرون والطيب بن كيران، وكلاهما قد أجازه إجازة عامة شملت كل ما عندهما. وقد توفي المشرفي بوهران ولكننا لا ندري الآن متى كان ذلك (1). ومن جهة أخرى لا ندري ما حجم هذا الثبت ولا ما اشتمل عليه من المسائل.
أما حمودة بن محمد المقايسي فيبدو أكثر ثقافة من سابقه أو على الأقل نعرف نحن عنه أكثر مما نعرف عن زميله. فقد ولد بمدينة الجزائر ولعله أخذ بها العلم، ثم توجه إلى المشرق حيث تتلمذ على عدد من الشيوخ ذوي الشهرة الواسعة عندئذ، كالزبيدي ومحمد الأمير وحسن العطار ومحمد الدسوقي وحجازي بن عبد المطلب العدوي، كما أذنوا له بالتدريس هناك. وكان الأزهر في الوقت الذي درس فيه حمودة المقايسي يعج بالأفكار والتيارات فتأثر بذلك. ثم حل بتونس ولكنه عاد إلى بلاده يحمل بعض هذه التيارات والأفكار فلم يستطع أن ينشرها، لأسباب لا نعرفها، فاشتغل، بدلا من التدريس ونشر الأفكار، بصنعة المقايس التي كان ينال منها رزقه، وقد مات فقيرا في الجزائر أيضا سنة 1245. ومن الذين أجازوا المقايسي محمد مرتضى الزبيدي الذي عمم له الإجازة وسماه فيها (الشيخ الصالح الوجيه الورع الفاضل المفيد السيد الجليل والماجد النبيل). كما أجازه محمد الأمير وكذلك الدسوقي والعدوى. وممن أجازوه من الجزائريين محمد بن عبد الرحمن الأزهري منشئ الطريقة الرحمانية. ولعل ذلك كان أثناء إقامتهما معا في مصر. وقد جمع المقايسي أسانيده في (ثبت) خاص (2).
__________
(1) الكتاني 1/ 350، انظر أيضا (فيض الملك المتعال) 2/ 57.
(2) الكتاني 1/ 256 وتعريف الخلف 2/ 140. لا ندري متى عاد المقايسي إلى الجزار، والظاهر أن ذلك كان بعد سنة 1212 لأنه كان بالقاهرة في هذا التاريخ.
أما حمودة بن محمد المقايسي فيبدو أكثر ثقافة من سابقه أو على الأقل نعرف نحن عنه أكثر مما نعرف عن زميله. فقد ولد بمدينة الجزائر ولعله أخذ بها العلم، ثم توجه إلى المشرق حيث تتلمذ على عدد من الشيوخ ذوي الشهرة الواسعة عندئذ، كالزبيدي ومحمد الأمير وحسن العطار ومحمد الدسوقي وحجازي بن عبد المطلب العدوي، كما أذنوا له بالتدريس هناك. وكان الأزهر في الوقت الذي درس فيه حمودة المقايسي يعج بالأفكار والتيارات فتأثر بذلك. ثم حل بتونس ولكنه عاد إلى بلاده يحمل بعض هذه التيارات والأفكار فلم يستطع أن ينشرها، لأسباب لا نعرفها، فاشتغل، بدلا من التدريس ونشر الأفكار، بصنعة المقايس التي كان ينال منها رزقه، وقد مات فقيرا في الجزائر أيضا سنة 1245. ومن الذين أجازوا المقايسي محمد مرتضى الزبيدي الذي عمم له الإجازة وسماه فيها (الشيخ الصالح الوجيه الورع الفاضل المفيد السيد الجليل والماجد النبيل). كما أجازه محمد الأمير وكذلك الدسوقي والعدوى. وممن أجازوه من الجزائريين محمد بن عبد الرحمن الأزهري منشئ الطريقة الرحمانية. ولعل ذلك كان أثناء إقامتهما معا في مصر. وقد جمع المقايسي أسانيده في (ثبت) خاص (2).
__________
(1) الكتاني 1/ 350، انظر أيضا (فيض الملك المتعال) 2/ 57.
(2) الكتاني 1/ 256 وتعريف الخلف 2/ 140. لا ندري متى عاد المقايسي إلى الجزار، والظاهر أن ذلك كان بعد سنة 1212 لأنه كان بالقاهرة في هذا التاريخ.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وكان علي بن عبد القادر بن الأمين يعتبر في عصره من أعيان العلماء.
ورغم أنه تولى الإفتاء عدة مرات، فإن شهرته كانت تقوم على العلم وليس على الجاه والوظيفة. فقد كان علوي النسب أندلسي الأصل، كما أنه كان شاذلي الطريقة، على عادة معظم علماء الجزائر في وقته. وهو من مواليد الجزائر ولكنه أخذ العلم بها وبالمشرق ولا سيما مصر، وهو يروي عن شيوخ كثيرين ذكرهم في إجازته للشيخ السنوسي الراشدي سنة 1189. كما إنه كتب (ثبتا) في نحو الكراسة ضمنه مروياته وشيوخه. وقد قيل عن ابن الأمين إنه كان (مجدد رونق العلم) بالجزائر. وهو أستاذ محمد بن محمود بن العنابي الذي روى عنه (ثبت الجوهري) بالإجازة، وكان ابن الأمين قد رواه أيضا بالإجازة عن شيخه أحمد الجوهري. وقد قال ابن العنابي عن أستاذه أنه كان يجيز كل من أدرك حياته، وقد توفي ابن الأمين بالجزائر سنة 1236 (1).
ويعتبر ابن العنابي من تلاميذ علي بن الأمين لا في الدراسة عليه فقط ولكن في تقليده في منح الإجازات أيضا. ولا نريد هنا أن نستوفي حياة ابن العنابي ما دمنا قد فصلناها في كتابنا عنه (2). والذي يهمنا هنا هو وضع ابن العنابي بين معاصريه في علوم الحديث وروايتها. فقد ولد بالجزائر سنة 1189 وأخذ بها العلم عن مشائخ ذكرهم في (ثبته) المعروف (بثبتالجزائري) ومنهم والده وعلي بن الأمين. كما أنه أخذ العلم في مصر والحرمين. وكان ابن العنابي قد زار أيضا المغرب وتونس وإسطانبول. وفي الأزهر جلس للتدريس والتأليف ومنح الإجازات. ومن الذين خصهم بثبته
__________
(1) الكتاني 2/ 173. انظر (ثبت الجزائري) لابن العنابي، دار الكتب المصرية، تيمور، مصطلح حديث، 167، وكذلك رقم 597، ورقم (118 تيمور). وانظر كتابي (المفتي الجزائري ابن العنابي). وأخبار ابن الأمين مبثوثة في الأرشيف، لاسيما سنوات توليه الإفتاء وعلاقت بالعلماء المعاصرين. انظر مثلا (288) - 41 - mi 228.
(2) المفتي الجزائري (ابن العنابي) الجزائر 1977.
ورغم أنه تولى الإفتاء عدة مرات، فإن شهرته كانت تقوم على العلم وليس على الجاه والوظيفة. فقد كان علوي النسب أندلسي الأصل، كما أنه كان شاذلي الطريقة، على عادة معظم علماء الجزائر في وقته. وهو من مواليد الجزائر ولكنه أخذ العلم بها وبالمشرق ولا سيما مصر، وهو يروي عن شيوخ كثيرين ذكرهم في إجازته للشيخ السنوسي الراشدي سنة 1189. كما إنه كتب (ثبتا) في نحو الكراسة ضمنه مروياته وشيوخه. وقد قيل عن ابن الأمين إنه كان (مجدد رونق العلم) بالجزائر. وهو أستاذ محمد بن محمود بن العنابي الذي روى عنه (ثبت الجوهري) بالإجازة، وكان ابن الأمين قد رواه أيضا بالإجازة عن شيخه أحمد الجوهري. وقد قال ابن العنابي عن أستاذه أنه كان يجيز كل من أدرك حياته، وقد توفي ابن الأمين بالجزائر سنة 1236 (1).
ويعتبر ابن العنابي من تلاميذ علي بن الأمين لا في الدراسة عليه فقط ولكن في تقليده في منح الإجازات أيضا. ولا نريد هنا أن نستوفي حياة ابن العنابي ما دمنا قد فصلناها في كتابنا عنه (2). والذي يهمنا هنا هو وضع ابن العنابي بين معاصريه في علوم الحديث وروايتها. فقد ولد بالجزائر سنة 1189 وأخذ بها العلم عن مشائخ ذكرهم في (ثبته) المعروف (بثبتالجزائري) ومنهم والده وعلي بن الأمين. كما أنه أخذ العلم في مصر والحرمين. وكان ابن العنابي قد زار أيضا المغرب وتونس وإسطانبول. وفي الأزهر جلس للتدريس والتأليف ومنح الإجازات. ومن الذين خصهم بثبته
__________
(1) الكتاني 2/ 173. انظر (ثبت الجزائري) لابن العنابي، دار الكتب المصرية، تيمور، مصطلح حديث، 167، وكذلك رقم 597، ورقم (118 تيمور). وانظر كتابي (المفتي الجزائري ابن العنابي). وأخبار ابن الأمين مبثوثة في الأرشيف، لاسيما سنوات توليه الإفتاء وعلاقت بالعلماء المعاصرين. انظر مثلا (288) - 41 - mi 228.
(2) المفتي الجزائري (ابن العنابي) الجزائر 1977.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
المذكور إبراهيم السقا وعبد القادر الرافعي (1).
ومن مسندي أوائل القرن الماضي زيد العابدين المشرفي المعروف بابن عبد الله سقط. وقد لعب هذا الشيخ دورا في الأحداث التي جرت بين الجزائريين والفرنسيين. وتهمنا هنا الناحية العلمية من حياته. فقد تثقفبالجزائر على عدد من شيوخ الناحية الغربية، ومنهم أبو راس، ثم رحل إلى المشرق فأخذ العلم إجازة من بعض العلماء هناك. وقد وصفه أبو حامد المشرفي في كتابه (ياقوتة النسب الوهاجة) أنه كان كثير الحفظ حتى أنه كان يحفظ صحيح البخاري متنا وإسنادا كما كان يحفظ صحيح مسلم، بالإضافة إلى حفظ السيرة النبوية والأخبار والتواريخ وشيوخ المذهب. وله (فهرسة) تشهد له بذلك. ومن جهة أخرى ذكر له الكتاني مجموعة من الشيوخ الذين قرأ عليهم وأجازوه بالمغرب والمشرق (2).
الإجازات
إذا كانت الإجازة تعتبر (شهادة كفاءة) أو تأهيل يستحق بها المجاز لقب الشيخ أو الأستاذ في العلوم المجاز بها، فإنها بتقادم العهد أصبحت لا تعني كل هذا، لتساهد المجيزين في منحها. فلم يعد هناك تحقق من المجازين في كفاءتهم ودرايتهم بالعلوم ولا من أخلاقهم وسلوكهم، كما أن الإجازة لم تعد تقيد بالقراءة والمشافهة أو حتى بالجزء المقروء من الكتاب، فقد أصبحت
__________
(1) دار الكتب المصرية، تيمور، مصطلح حديث، 167، 597. وإجازته للسقا تاريخها 1242.
(2) الكتاني 2/ 15. ولعل ابن عبد الله سقط هو نفسه الذي قيل إن محمد النفزي الفاسي، مفتي المالكية بمكة والمتوفى بها سنة 1245، قد أجازه. فقد وجدت في فهرسة النفزي إجازة لمن اسمه أبو محمد عبد القادر الشهير بابن عبد الله (كذا ولم ترد معها عبارة سقط) المشرفي الراشدي المعسكري، وهذا الفهرس قد جمعه أحمد بن محمد بن عجيبة المتوفى سنة 224 1. دار الكتب المصرية، مصطلح حديث (مجاميع 7، ش).
ومن مسندي أوائل القرن الماضي زيد العابدين المشرفي المعروف بابن عبد الله سقط. وقد لعب هذا الشيخ دورا في الأحداث التي جرت بين الجزائريين والفرنسيين. وتهمنا هنا الناحية العلمية من حياته. فقد تثقفبالجزائر على عدد من شيوخ الناحية الغربية، ومنهم أبو راس، ثم رحل إلى المشرق فأخذ العلم إجازة من بعض العلماء هناك. وقد وصفه أبو حامد المشرفي في كتابه (ياقوتة النسب الوهاجة) أنه كان كثير الحفظ حتى أنه كان يحفظ صحيح البخاري متنا وإسنادا كما كان يحفظ صحيح مسلم، بالإضافة إلى حفظ السيرة النبوية والأخبار والتواريخ وشيوخ المذهب. وله (فهرسة) تشهد له بذلك. ومن جهة أخرى ذكر له الكتاني مجموعة من الشيوخ الذين قرأ عليهم وأجازوه بالمغرب والمشرق (2).
الإجازات
إذا كانت الإجازة تعتبر (شهادة كفاءة) أو تأهيل يستحق بها المجاز لقب الشيخ أو الأستاذ في العلوم المجاز بها، فإنها بتقادم العهد أصبحت لا تعني كل هذا، لتساهد المجيزين في منحها. فلم يعد هناك تحقق من المجازين في كفاءتهم ودرايتهم بالعلوم ولا من أخلاقهم وسلوكهم، كما أن الإجازة لم تعد تقيد بالقراءة والمشافهة أو حتى بالجزء المقروء من الكتاب، فقد أصبحت
__________
(1) دار الكتب المصرية، تيمور، مصطلح حديث، 167، 597. وإجازته للسقا تاريخها 1242.
(2) الكتاني 2/ 15. ولعل ابن عبد الله سقط هو نفسه الذي قيل إن محمد النفزي الفاسي، مفتي المالكية بمكة والمتوفى بها سنة 1245، قد أجازه. فقد وجدت في فهرسة النفزي إجازة لمن اسمه أبو محمد عبد القادر الشهير بابن عبد الله (كذا ولم ترد معها عبارة سقط) المشرفي الراشدي المعسكري، وهذا الفهرس قد جمعه أحمد بن محمد بن عجيبة المتوفى سنة 224 1. دار الكتب المصرية، مصطلح حديث (مجاميع 7، ش).
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
تمنح بالمراسلة والسماع، كما أنها أصبحت تعطي مطلقة في كل العلوم وكل الكتب التي تعلمها المجيز سواء قرأها المجاز أم لا. وهذا التساهل نتج عنه ضعف مستوى التعليم لأن المجازين أصبحوا يتصدرون للتدريس ويمنحون بدورهم الإجازات لغيرهم في علوم وكتب لم يدرسوها على أحد.
ومن جهة أخرى خضعت الإجازات لنوع من المجاملات بين العلماء، فطالب الإجازة (يستدعي) المجيز ببيت شعر أو بقطعة أو برسالة يطلب منه الإجازة ويصفه بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان كالبحر والمحيط والشمس والكوكب، ويتردد المجيز قليلا (وهو تردد تقليدي أيضا لأن العادة جرت كذلك) وقد يعتذر بأنه ليس من فرسان هذا الفن، لكنه في النهاية يستجيب للإطراء والمدح فيقلد جيد المجيز بألقاب أخرى فيها التنبؤ والتوسم كالشاب الأريب، وعنوان النجابة، والهلال الذي سيصبح بدرا، ونحو ذلك. ومن الذين انتقدوا التساهل في منح الإجازات، ولا سيما عند المشارقة، الشيخ عبد الكريم الفكون. فقد لاحظ مرة أن بلديه علي بن داود الصنهاجي القسنطيني قد قرأ على الشيخ سالم السنهوري المصري وأجازه هذا وهو (أي الصنهاجي) لا علم له سوى (حفظ بعض المسائل المشهورة من الطهارة وبعض العبادات وبعض المعاملات التي لا تجهل في الغالب. ولا بحث معه ولا تدقيق ولا نظر، والعجب إجازة الشيخ المذكور له. ولا حول ولا قوة إلا باللهء (1).
ولكن العادة جرت أن لا تكون الإجازة إلا بعد القراءة على الشيخ المجيز وملازمته أياما وشهورا بل أعواما في بعض الأحيان، ومناظرته في بعض المسائل. وقد يقرأ الطالب على الشيخ بعض مؤلفاته، أو بعض الكتب الأخرى كصحيح البخاري أو الكتب الستة، وبعض التفسير ونحو ذلك. فهذا عيسى الثعالبي قد لازم شيخه علي بن عبد الواحد الأنصاري أكثر من عشر سنوات. وهذا عمر المانجلاتي قد لازم الأنصاري أيضا أربع عشرة سنة.
__________
(1) (منشور الهداية) مخطوط.
ومن جهة أخرى خضعت الإجازات لنوع من المجاملات بين العلماء، فطالب الإجازة (يستدعي) المجيز ببيت شعر أو بقطعة أو برسالة يطلب منه الإجازة ويصفه بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان كالبحر والمحيط والشمس والكوكب، ويتردد المجيز قليلا (وهو تردد تقليدي أيضا لأن العادة جرت كذلك) وقد يعتذر بأنه ليس من فرسان هذا الفن، لكنه في النهاية يستجيب للإطراء والمدح فيقلد جيد المجيز بألقاب أخرى فيها التنبؤ والتوسم كالشاب الأريب، وعنوان النجابة، والهلال الذي سيصبح بدرا، ونحو ذلك. ومن الذين انتقدوا التساهل في منح الإجازات، ولا سيما عند المشارقة، الشيخ عبد الكريم الفكون. فقد لاحظ مرة أن بلديه علي بن داود الصنهاجي القسنطيني قد قرأ على الشيخ سالم السنهوري المصري وأجازه هذا وهو (أي الصنهاجي) لا علم له سوى (حفظ بعض المسائل المشهورة من الطهارة وبعض العبادات وبعض المعاملات التي لا تجهل في الغالب. ولا بحث معه ولا تدقيق ولا نظر، والعجب إجازة الشيخ المذكور له. ولا حول ولا قوة إلا باللهء (1).
ولكن العادة جرت أن لا تكون الإجازة إلا بعد القراءة على الشيخ المجيز وملازمته أياما وشهورا بل أعواما في بعض الأحيان، ومناظرته في بعض المسائل. وقد يقرأ الطالب على الشيخ بعض مؤلفاته، أو بعض الكتب الأخرى كصحيح البخاري أو الكتب الستة، وبعض التفسير ونحو ذلك. فهذا عيسى الثعالبي قد لازم شيخه علي بن عبد الواحد الأنصاري أكثر من عشر سنوات. وهذا عمر المانجلاتي قد لازم الأنصاري أيضا أربع عشرة سنة.
__________
(1) (منشور الهداية) مخطوط.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ولكن بضعف العناية بالإجازة أصبح التلميذ لا يقطع المسافات لحضور درس أستاذه ولا يتحمل عناء السفر والغربة، وأصبح المشائخ يمنحون الإجازة لتلاميذهم عن طريق السماع بهم، وبدل أن تكون الإجازة خاصة مقيدة بالجزء المقروء أو المسموع أصبحت عامة مطلقة في كل المرويات والمقروءات. وأحيانا نجد بعض المجيزين يجيزون غيرهم بكل ما كانوا قد أجيزوا به. ومن الملاحظ أيضا أن الإجازة التي كانت خاصة بالعلم قد انتقلت أيضا إلى الطرق الصوفية. فقد وجدنا شيوخا يجيزون تلاميذهم بالسبحة والضيافة والخرقة الصوفية ونحو ذلك من مظاهر الدخول في حضرة الشيخ والتتلمذ عليه في الطريقة التي يسلكها. ولكن الذي يعنينا في هذا الفصل هو الإجازة العلمية وليس الإجازة الصوفية.
وهناك ثلاثة أصناف من الإجازة: إجازة الجزائريين للجزائريين، وإجازة الجزائريين لغيرهم، وإجازة علماء المسلمين لعلماء الجزائر. ومن الطبيعي أننا لن نحصي، في أي صنف من هذه الأصناف، عدد الإجازات، لأن ذلك يكاد يكون مستحيلا، ولكن الهدف هو سوق نماذج من كل صنف للتعرف على اهتمام الجزائريين بعلم الحديث خصوصا وطلب العلم عموما. فالإجازة، مهما انتقدنا التساهل في منحها، كانت عنوانا على كسب نصيب من العلم بالنسبة للمستجيز وعلامة على التبحر والتخصص في نفس العلم بالنسبة لمانحها. ولما كان الجزائريون كثيرا ما خرجوا من بلادهم لطلب العلم في البلدان الإسلامية فمن الواضح أنهم كانوا من طلاب الإجازة في الغالب وليس من مانحيها. ومع ذلك فلو أحصينا عدد الجزائريين الذين منحوا الإجازات في المشرق والمغرب لاندهشنا لكثرتهم.
ومن الغريب أن العلماء الجزائريين لم يجيزوا بعضهم البعض إلا قليلا. من ذلك إجازة محمد الزجاي لأحمد بن محمد الشريف المعروف بابن سحنون مؤلف (الثغر الجماني). فقد ذكر هو في هذا الكتاب نص الإجازة مخافة ضياعها، كما قال. وبناء عليه فإن ابن سحنون قد لازم الزجاي ومجلسه العلمي عدة أيام وليال. فقد قرأ عليه صحيح البخاري وكبرى
وهناك ثلاثة أصناف من الإجازة: إجازة الجزائريين للجزائريين، وإجازة الجزائريين لغيرهم، وإجازة علماء المسلمين لعلماء الجزائر. ومن الطبيعي أننا لن نحصي، في أي صنف من هذه الأصناف، عدد الإجازات، لأن ذلك يكاد يكون مستحيلا، ولكن الهدف هو سوق نماذج من كل صنف للتعرف على اهتمام الجزائريين بعلم الحديث خصوصا وطلب العلم عموما. فالإجازة، مهما انتقدنا التساهل في منحها، كانت عنوانا على كسب نصيب من العلم بالنسبة للمستجيز وعلامة على التبحر والتخصص في نفس العلم بالنسبة لمانحها. ولما كان الجزائريون كثيرا ما خرجوا من بلادهم لطلب العلم في البلدان الإسلامية فمن الواضح أنهم كانوا من طلاب الإجازة في الغالب وليس من مانحيها. ومع ذلك فلو أحصينا عدد الجزائريين الذين منحوا الإجازات في المشرق والمغرب لاندهشنا لكثرتهم.
ومن الغريب أن العلماء الجزائريين لم يجيزوا بعضهم البعض إلا قليلا. من ذلك إجازة محمد الزجاي لأحمد بن محمد الشريف المعروف بابن سحنون مؤلف (الثغر الجماني). فقد ذكر هو في هذا الكتاب نص الإجازة مخافة ضياعها، كما قال. وبناء عليه فإن ابن سحنون قد لازم الزجاي ومجلسه العلمي عدة أيام وليال. فقد قرأ عليه صحيح البخاري وكبرى
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
السنوسي، وأكثر القرآن الكريم، ومعظم جمع الجوامع للسبكي، وجوهرة الأخضري وسلمه، وحواشي السعد ومتنه وألفية ابن مالك وشروحها، ورسالة الوضع، ونخبة ابن حجر (1). ومن هذه المواد نعرف ماذا كان يدرس الشيخ الزجاي أيضا، كما نعرف برنامج الدراسات في العهد العثماني لأن هذه المواد تكاد تكون هي البرنامج الأساسي في مختلف الأقاليم.
وبهذا الصدد نذكر أن أحمد الزروق البوني قد أجاز الورتلاني صاحب الرحلة كما أن محمد بن عبد الرحمن الأزهري قد أجاز حمودة المقايسي. وتذكر المصادر أيضا أن يحيى الشاوي قد تلقى إجازتين من مواطنه محمد السعدي بن محمد بهلول، الأولى إجازة بقراءته عليه موطأ الإمام مالك وبعض صحيح البخاري وبعض صحيح مسلم ورواية الكتب الثلاثة المذكورة بسنده عن شيوخه فيها (2). والثانية ما يسمونه بالمصافحة. فقد أجاز محمد السعدي للشاوي مصافحة الفقيه محمد العربي يوسف الفاسي له بزاوية محمد بن أبي بكر الدلائي (3). كما ذكر شعبان بن عباس المعروف بابن عبد الجليل القسنطيني أن شيخه المفتي محمد بن علي الجعفري القسنطيني أيضا قد أجازه إجازة عامة بعد سنة 1139 إثر القراءة عليه (سنين عديدة). كما ذكر الكتب التي قرأها عليه كالألفية وخليل وألفية العراقي والمحلى في الأصول وصغرى السنوسي والفلك والبخاري (4).
وطالما جلس علماء الجزائر لتلقي العلم على بعضهم بعضا، ومع ذلك لا نكاد نجد أنهم قد منحوا الإجازات لبعضهم. فمجالس سعيد قدورة وسعيد المقري وعمر الوزان وبموراس ونحوهم كانت عامرة ومع ذلك فإن الإجازات
__________
(1) (الثغر الجماني) مخطوط باريس، ص 39 - 40.
(2) انظر دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 335، ضمن مجموع.
(3) نفس المصدر، رقم 313 ورقم 366.
(4) نص هذه الإجازة في مخطوط بمكتبة المولود بن الموهوب عند السيد ماضوي عبد الرحمن، وهي في عدة صفحات ولكنها مبتورة، ويدعى محمد بن علي الجعفري بالبوني أيضا، وهو تلميذ أحمد ساسي البوني.
وبهذا الصدد نذكر أن أحمد الزروق البوني قد أجاز الورتلاني صاحب الرحلة كما أن محمد بن عبد الرحمن الأزهري قد أجاز حمودة المقايسي. وتذكر المصادر أيضا أن يحيى الشاوي قد تلقى إجازتين من مواطنه محمد السعدي بن محمد بهلول، الأولى إجازة بقراءته عليه موطأ الإمام مالك وبعض صحيح البخاري وبعض صحيح مسلم ورواية الكتب الثلاثة المذكورة بسنده عن شيوخه فيها (2). والثانية ما يسمونه بالمصافحة. فقد أجاز محمد السعدي للشاوي مصافحة الفقيه محمد العربي يوسف الفاسي له بزاوية محمد بن أبي بكر الدلائي (3). كما ذكر شعبان بن عباس المعروف بابن عبد الجليل القسنطيني أن شيخه المفتي محمد بن علي الجعفري القسنطيني أيضا قد أجازه إجازة عامة بعد سنة 1139 إثر القراءة عليه (سنين عديدة). كما ذكر الكتب التي قرأها عليه كالألفية وخليل وألفية العراقي والمحلى في الأصول وصغرى السنوسي والفلك والبخاري (4).
وطالما جلس علماء الجزائر لتلقي العلم على بعضهم بعضا، ومع ذلك لا نكاد نجد أنهم قد منحوا الإجازات لبعضهم. فمجالس سعيد قدورة وسعيد المقري وعمر الوزان وبموراس ونحوهم كانت عامرة ومع ذلك فإن الإجازات
__________
(1) (الثغر الجماني) مخطوط باريس، ص 39 - 40.
(2) انظر دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 335، ضمن مجموع.
(3) نفس المصدر، رقم 313 ورقم 366.
(4) نص هذه الإجازة في مخطوط بمكتبة المولود بن الموهوب عند السيد ماضوي عبد الرحمن، وهي في عدة صفحات ولكنها مبتورة، ويدعى محمد بن علي الجعفري بالبوني أيضا، وهو تلميذ أحمد ساسي البوني.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الصادرة عنهم لتلاميذهم لا تكاد تذكر. وقد قيل إن يحيى الشاوي قد اضطر إلى أن يسافر مع شيخه عيسى الثعالبي مسافة (ثماني مراحل) إلى أن درس عليه علم المنطق، ولكننا لا نجدهم يتحدثون عن كون الثعالبي قد أجاز الشاوي في هذا العلم (1). ونعرف أن أبا راس قد ورد على مدينة الجزائر وأخذ العلم على ابن عمار وغيره فيها، ولكننا لا نعرف أن هناك إجازة من ابن عمار لأبي راس. فيبدو أن علماء البلد الواحد لا يمنحون عادة الإجازات لبعضهم، وكأن الإجازة لا تأتي إلا نتيجة اغتراب وسفر طويل وتتلمذ على غير أهل البلد. ومن جهة أخرى نعرف أن عيسى الثعالبي قد روى مرويات ثلاثة شيوخ على الأقل من الجزائر وهم سعيد قدورة، وعلي الأنصاري، وعبد الكريم الفكون. وقد ترجم لثلاثتهم في ثبته.
ومن الطريف أن نذكر إجازة أحمد بن قاسم البوني لابنه أحمد الزروق (الذي أشركه فيها مع محمد بن علي الجعفري القسنطيني - البوني الأصل -) (2). ولعل أطرف من ذلك إجازة محمد قدورة لأخيه أحمد قدورة. ولدينا نص طلب الإجازة الذي تقدم به الأخ لأخيه، على عادتهم في ذلك، وهو في عشرين بيتا، ونحن نكتفي منه بهذه الأبيات المعبرة، فقد قال أحمد قدورة يخاطب أخاه الذي كان عندئذ مفتي المالكية بالعاصمة:
قطب الزمان ونخبة الفضلاء ... وسلالة النجباء والعلماء
شيخ الجزائر، حبرها وخطيبها ... وإمامها حقا بغير مراء
جل السعيد (3) محمد العلم الذي ... أحيا العلوم بفطنة وذكاء
إلى أن يقول:
تلميذكم ومحبكم بل عبدكم ... طلب الإجازة منكم بوفاء
__________
(1) (خلاصة الأثر) للمحبي 3/ 241.
(2) اطلعت على هذه الإجازة في مكتبة زاوية طولقة واستفدت منها وطلب نسخها فلم أحصل على طائل.
(3) يعني والدهما المفتي سعيد بن إبراهيم قدورة. انظر ترجمته في فصل التعليم من الجزء الأول.
ومن الطريف أن نذكر إجازة أحمد بن قاسم البوني لابنه أحمد الزروق (الذي أشركه فيها مع محمد بن علي الجعفري القسنطيني - البوني الأصل -) (2). ولعل أطرف من ذلك إجازة محمد قدورة لأخيه أحمد قدورة. ولدينا نص طلب الإجازة الذي تقدم به الأخ لأخيه، على عادتهم في ذلك، وهو في عشرين بيتا، ونحن نكتفي منه بهذه الأبيات المعبرة، فقد قال أحمد قدورة يخاطب أخاه الذي كان عندئذ مفتي المالكية بالعاصمة:
قطب الزمان ونخبة الفضلاء ... وسلالة النجباء والعلماء
شيخ الجزائر، حبرها وخطيبها ... وإمامها حقا بغير مراء
جل السعيد (3) محمد العلم الذي ... أحيا العلوم بفطنة وذكاء
إلى أن يقول:
تلميذكم ومحبكم بل عبدكم ... طلب الإجازة منكم بوفاء
__________
(1) (خلاصة الأثر) للمحبي 3/ 241.
(2) اطلعت على هذه الإجازة في مكتبة زاوية طولقة واستفدت منها وطلب نسخها فلم أحصل على طائل.
(3) يعني والدهما المفتي سعيد بن إبراهيم قدورة. انظر ترجمته في فصل التعليم من الجزء الأول.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
بجميع ما تروونه عن والد ... أو غيره من سائر العلماء وقد جاء في النص أيضا:
عمرت دهرا للعلوم تبثها ... بالكتب والتدريس والإملاء وبقيت فردا لارتقاء منابر ... للوعظ والتذكير والإيضاء (1) وقد منح الجزائريون كثيرا من الإجازات لغيرهم من علماء المسلمين. ولنذكر هنا بعض ذلك فقط. فإذا عدنا إلى رحلة ابن زاكور المغربي إلى الجزائر وجدنا فيها نماذج من هذه الإجازات والطريقة التي حصل بها ابن زاكور عليها، وأسلوب منحها وكفاءة شيوخه فيها. وقد ذكر ابن زاكور على الأقل ثلاثة من مشاهير علماء الجزائر في القرن الحادي عشر، وهم عمر المانجلاتي، ومحمد بن عبد المؤمن، ومحمد بن سعيد قدورة. وبناء على ابن زاكور فإن المانجلاتي قد درس العلم بجد واجتهاد وانقطاع، وأن شيوخه قد درسوه أيضا على مشائخ جلة من المشرق والمغرب قراءة وإجازة وإعلاما، وإنه بالرغم من أنه لا يشعر بأنه مؤهل لمنح الإجازة فقد أجاب غرض ابن زاكور. وقد اتبع المانجلاتي الأسلوب المتعارف عليه، وهو الاعتذار، لكونه غير مؤهل لهذه الدرجة (ولكن خلت الديار فساد غير مسود) وأن الزمان قد تغير (وتحولت الأحوال واشتغل البال) (2).
والإجازة الثانية من علماء الجزائر لابن زاكور هي إجازة محمد بن عبد المؤمن. وقد كان محمد بن عبد المؤمن يسمى بـ (أديب العلماء وعالم الأدباء) لجمعه بين الأدب والفقه (3). وقد وصفه ابن زاكور بأنه (ممن ضرب
__________
(1) (جليس الزائر وأنيس السائر) منسوب لأحد أفراد عائلة قدورة. مخطوط بالمكتبة الوطنية، غير مرقم، اشترته المكتبة من الشيخ المهدي البوعبدلي وفي كلمة (إيضاء) خروج عن القواعد.
(2) ابن زاكور (الرحلة) 8. وقد سبق الحديث في فصل التعليم من الجزء الأول عن المواد التي درسها المانجلاني وكانت الإجازة بتاريخ 1094.
(3) انظر عنه رحلة ابن حمادوش، فقد أورد له نص عقد زواج كتبه ابن عبد المؤمن بمناسبة زواج عبد الرحمن المرتضى الشريف، وأصبح العقد مثالا يحتذيه الموثقون =
عمرت دهرا للعلوم تبثها ... بالكتب والتدريس والإملاء وبقيت فردا لارتقاء منابر ... للوعظ والتذكير والإيضاء (1) وقد منح الجزائريون كثيرا من الإجازات لغيرهم من علماء المسلمين. ولنذكر هنا بعض ذلك فقط. فإذا عدنا إلى رحلة ابن زاكور المغربي إلى الجزائر وجدنا فيها نماذج من هذه الإجازات والطريقة التي حصل بها ابن زاكور عليها، وأسلوب منحها وكفاءة شيوخه فيها. وقد ذكر ابن زاكور على الأقل ثلاثة من مشاهير علماء الجزائر في القرن الحادي عشر، وهم عمر المانجلاتي، ومحمد بن عبد المؤمن، ومحمد بن سعيد قدورة. وبناء على ابن زاكور فإن المانجلاتي قد درس العلم بجد واجتهاد وانقطاع، وأن شيوخه قد درسوه أيضا على مشائخ جلة من المشرق والمغرب قراءة وإجازة وإعلاما، وإنه بالرغم من أنه لا يشعر بأنه مؤهل لمنح الإجازة فقد أجاب غرض ابن زاكور. وقد اتبع المانجلاتي الأسلوب المتعارف عليه، وهو الاعتذار، لكونه غير مؤهل لهذه الدرجة (ولكن خلت الديار فساد غير مسود) وأن الزمان قد تغير (وتحولت الأحوال واشتغل البال) (2).
والإجازة الثانية من علماء الجزائر لابن زاكور هي إجازة محمد بن عبد المؤمن. وقد كان محمد بن عبد المؤمن يسمى بـ (أديب العلماء وعالم الأدباء) لجمعه بين الأدب والفقه (3). وقد وصفه ابن زاكور بأنه (ممن ضرب
__________
(1) (جليس الزائر وأنيس السائر) منسوب لأحد أفراد عائلة قدورة. مخطوط بالمكتبة الوطنية، غير مرقم، اشترته المكتبة من الشيخ المهدي البوعبدلي وفي كلمة (إيضاء) خروج عن القواعد.
(2) ابن زاكور (الرحلة) 8. وقد سبق الحديث في فصل التعليم من الجزء الأول عن المواد التي درسها المانجلاني وكانت الإجازة بتاريخ 1094.
(3) انظر عنه رحلة ابن حمادوش، فقد أورد له نص عقد زواج كتبه ابن عبد المؤمن بمناسبة زواج عبد الرحمن المرتضى الشريف، وأصبح العقد مثالا يحتذيه الموثقون =
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
11:02 AM
08-25-2016
بسهم وافر من العلم. العالم الفقيه اللوذعي جامع الفضائل). وبعد اعتذار ابن عبد المؤمن لعدم أهليته أجاز ابن زاكور بما أجازه به شيخاه علي الشرملسي المصري وأحمد بن تاج الدين نزيل المدينة، كما أجازه بمنظومته في العقائد والفروع وطلب منه أن يشرحها إذا تمكن (1). أما محمد بن سعيد قدورة فقد أجاز ابن زاكور إجازة مطلقة عامة (في جميع مقروءاتي معقولا ومنقولا توحيدا ونحوا) ولم يذكر قدورة أي شيخ من أشياخه وإنما اكتفى بقوله: (فليحدث بذلك إن أحب عن أشياخي إلى المؤلفين) (2).
وقبل ابن زاكور منح أحمد العبادي التلمساني الإجازة لابن عسكر مؤلف (دوحة الناشر). وقد عاش الشيخ العبادي حياة متقلبة نتيجة تقلب ظروف العصر. فبعد استيلاء العثمانيين على تلمسان والاضطرابات التي رافقت ذلك هاجر إلى المغرب فأقام في فاس وزار مراكش وأكرمه السلطان عبد الله الغالب (توفي سنة 981) إكراما خاصا. ولكنه ما لبث أن عاد إلى تلمسان واستقر نهائيا، كما يقول ابن عسكر، في مليانة. وقد ذكر ابن عسكر نص إجازته له في مؤلفه (3). ولم يكن العبادي سوى نموذج من الجزائريين الذين منحوا الإجازة لبعض علماء المغرب. فالحدود العلمية بين الجزائر والمغرب تكاد تكون غير موجودة. ويكفي أن نشير هنا إلى مكانة أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد وأحمد المقري ومحمد الكماد بين المغاربة. ولنشر أيضا إلى إجازة عيسى الثعالبي للعياشي، وإجازة سعيد المقري لأحمد بن القاضي صاحب (جذوة الاقتباس) (4).
__________
= لما فيه من أدب وشريعة، وكان قد درس في المشرق أيضا، وكان حسني النسب.
(1) ابن زاكور (الرحلة)، 17.
(2) نفس المصدر، 28.
(3) ترجمته والإجازة في (دوحة الناشر) النص الفرنسي، ص 200 - 202. وكان والد العبادي من علماء تلمسان أيضا، هاجر إلى فاس وتولى التدريس بالقرويين، ثم عاد أيضا إلى تلمسان حيث توفي حوالي 1524 م (931) هـ. أما ابنه فلا نعرف متى توفي بالضبط.
(4) ذكر ذلك أحمد المقري في (روضة الآس) 268، وتاريخ الإجازة هو سنة 1009.
بسهم وافر من العلم. العالم الفقيه اللوذعي جامع الفضائل). وبعد اعتذار ابن عبد المؤمن لعدم أهليته أجاز ابن زاكور بما أجازه به شيخاه علي الشرملسي المصري وأحمد بن تاج الدين نزيل المدينة، كما أجازه بمنظومته في العقائد والفروع وطلب منه أن يشرحها إذا تمكن (1). أما محمد بن سعيد قدورة فقد أجاز ابن زاكور إجازة مطلقة عامة (في جميع مقروءاتي معقولا ومنقولا توحيدا ونحوا) ولم يذكر قدورة أي شيخ من أشياخه وإنما اكتفى بقوله: (فليحدث بذلك إن أحب عن أشياخي إلى المؤلفين) (2).
وقبل ابن زاكور منح أحمد العبادي التلمساني الإجازة لابن عسكر مؤلف (دوحة الناشر). وقد عاش الشيخ العبادي حياة متقلبة نتيجة تقلب ظروف العصر. فبعد استيلاء العثمانيين على تلمسان والاضطرابات التي رافقت ذلك هاجر إلى المغرب فأقام في فاس وزار مراكش وأكرمه السلطان عبد الله الغالب (توفي سنة 981) إكراما خاصا. ولكنه ما لبث أن عاد إلى تلمسان واستقر نهائيا، كما يقول ابن عسكر، في مليانة. وقد ذكر ابن عسكر نص إجازته له في مؤلفه (3). ولم يكن العبادي سوى نموذج من الجزائريين الذين منحوا الإجازة لبعض علماء المغرب. فالحدود العلمية بين الجزائر والمغرب تكاد تكون غير موجودة. ويكفي أن نشير هنا إلى مكانة أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد وأحمد المقري ومحمد الكماد بين المغاربة. ولنشر أيضا إلى إجازة عيسى الثعالبي للعياشي، وإجازة سعيد المقري لأحمد بن القاضي صاحب (جذوة الاقتباس) (4).
__________
= لما فيه من أدب وشريعة، وكان قد درس في المشرق أيضا، وكان حسني النسب.
(1) ابن زاكور (الرحلة)، 17.
(2) نفس المصدر، 28.
(3) ترجمته والإجازة في (دوحة الناشر) النص الفرنسي، ص 200 - 202. وكان والد العبادي من علماء تلمسان أيضا، هاجر إلى فاس وتولى التدريس بالقرويين، ثم عاد أيضا إلى تلمسان حيث توفي حوالي 1524 م (931) هـ. أما ابنه فلا نعرف متى توفي بالضبط.
(4) ذكر ذلك أحمد المقري في (روضة الآس) 268، وتاريخ الإجازة هو سنة 1009.
الموضوع:
تاريخ الجزائر الثقافي.doc الجــــزء الثاني بقسم
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
أما عن العلاقة بين علماء الجزائر وتونس كما تصورها الإجازات فقد كانت أيضا وطيدة ولكننا لا نحفظ منها إلا القليل. ورغم رحيل الجزائريين إلى تونس لطلب العلم والإقامة والتجارة فإن القليل من علماء تونس قد زاروا الجزائر نسبيا خلال العهد العثماني. ولعل ذلك يعود إلى اكتفاء علماء تونس الذاتي من طلب العلم. فلهم جامع الزيتونة يروي غلتهم، وهم إذا أرادوا المزيد فالشرق أمامهم، ولم تكن الجزائر تقدم لهم شيئا تقريبا مما كانوا يطلبون. ومع ذلك فإننا نجد الورتلاني وأبا راس يتحدثان عن علاقاتهم الوثيقة مع علماء تونس. ثم إن أحمد بن عمار قد أجاز تلميذه إبراهيم السيالة التونسي كما ذكرنا آنفا. كما أن ابن العنابي قد أجاز محمد بيرم وغيره.
وقد كان منح الإجازات للسلاطين والوزراء أمرا غير شائع، ولكن محمد بن أحمد الشريف الجزائري قد منح أحد الوزراء العثمانيين إجازة شملت الأحاديث النبوية والمؤلفات. وهذا الوزير هو أحمد باشا نعمان الذي تولى، بالإضافة إلى منصب الوزير في بلاده، وظيفة شيخ الحرم بالحجاز. وأثناء ذلك كان محمد بن أحمد الشريف مجاورا ومدرسا بمكة، فطلب منه الباشا الإجازة فيما سمعه منه ففعل. وقد قال المجيز عن ذلك: (فأسعفته في ذلك، وأتحفته بما هنالك، تطييبا لخاطره وتنشيطا لفكره وناظره).
وبعد البسملة والتصلية افتتح محمد الشريف إجازته بقوله: (أما بعد فقد طلب من هذا العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير، أيام المجاورة بالحرم المكي، وذلك سنة 1154، أربع وخمسين ومائة وألف، إنسان عين الفضائل والمفاخر، وسلالة فضلاء الوزراء كابر عن كابر. عمدة السلطنة العثمانية، وليث غياهبها الباهر. ورئيس الغزاة المجاهدين، فكم قصم سيفه من كافر وفاجر، فهل أتاك خبر الفيش (1) (؟) وما شتت فيه من شمول
__________
(1) كذا، ولعلها الفنش التي تعني النصارى، وتطلق في الجزائر غالبا على الإسبان.
وقد كان منح الإجازات للسلاطين والوزراء أمرا غير شائع، ولكن محمد بن أحمد الشريف الجزائري قد منح أحد الوزراء العثمانيين إجازة شملت الأحاديث النبوية والمؤلفات. وهذا الوزير هو أحمد باشا نعمان الذي تولى، بالإضافة إلى منصب الوزير في بلاده، وظيفة شيخ الحرم بالحجاز. وأثناء ذلك كان محمد بن أحمد الشريف مجاورا ومدرسا بمكة، فطلب منه الباشا الإجازة فيما سمعه منه ففعل. وقد قال المجيز عن ذلك: (فأسعفته في ذلك، وأتحفته بما هنالك، تطييبا لخاطره وتنشيطا لفكره وناظره).
وبعد البسملة والتصلية افتتح محمد الشريف إجازته بقوله: (أما بعد فقد طلب من هذا العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير، أيام المجاورة بالحرم المكي، وذلك سنة 1154، أربع وخمسين ومائة وألف، إنسان عين الفضائل والمفاخر، وسلالة فضلاء الوزراء كابر عن كابر. عمدة السلطنة العثمانية، وليث غياهبها الباهر. ورئيس الغزاة المجاهدين، فكم قصم سيفه من كافر وفاجر، فهل أتاك خبر الفيش (1) (؟) وما شتت فيه من شمول
__________
(1) كذا، ولعلها الفنش التي تعني النصارى، وتطلق في الجزائر غالبا على الإسبان.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الكوافر، وبدد فيه من دماء تلك المناحر، وهو الذي حاز قصبات السبق لا يدانيه في الذكاء والسياسة مناظر، نجل الوزارة وقائم مقامها وقطب رحاها وعليه مدارها، حضرة مولانا ولي النعم أبو الخيرات أحمد باشا نعمان باشا زاده، دام عزه ورفعته وحفت بالحفظ والعناية حضرته، سماع بعض الأحاديث والإجازة فيها وغيرها كسند السبحة والضيافة ونحوها، وهو إذاك شيخ الحرم الشريف زاده الله شرفا، فأسعفته في ذلك وأتحفته بما هنالك تطييبا لخاطره، وتنشيطا لفكره وناظره، والله تبارك وتعالى المسؤول في التوفيق والقبول، وبه أستعين، فأقول: سمع منا الوزير المشار إليه ..) (1).
وبعد أن يسرد الأحاديث التي سمعها منه يذكر أيضا مؤلفاته التي بلغت أحد عشر مألفا (إلى غير ذلك مما لنا من تقييد وتقرير، وبيان وتحرير، وبسط وتفسير). ومعظم مؤلفالت محمد الشريف تحوم حول الأحاديث النبوية والتصوف. ومن ذلك (جامع الأصول المنيفة من مسند أحاديث أبي حنيفة) الذي قال عنه أنه جعله في التبويب والترتيب نظير موطأ الإمام مالك. وكان محمد الشريف يوقع تآليفه هكذا (خادم العلم والعلماء الشيخ محمد بن أحمد الشريف الجزائري مولدا ومنشأ الأزميري وطنا وملجأ) فهو إذن من الجزائريين الذين يعودون إلى أصول عثمانية ويعتنقون المذهب الحنفي. وقد هاجر إلى المشرق وجاور بمكة واستوطن أزمير لأسباب لا نعلمها الآن. وقد نعرض إلى بعض مؤلفاته في فصل التصوف.
وتعتبر إجازة البوني والراشدي لمحمد مرتضى الزبيدي إجازة بالمراسلة، لأنهما لم يجتمعا به، الأول من عنابة والثاني من قسنطينة. وقد ذكر الكتاني أن الزبيدي قد ترجم للراشدي في (معجمه) وسماه فيه (شيخنا الإمام المحدث الصوفي النظار) (2). وبناء على الزبيدي فإن الراشدي قد توفي سنة 1194. وممن أجازوا الزبيدي أيضا من الجزائريين محمد المنور
__________
(1) هذه الإجازة مصورة، عن النسخة الأصلية من إسطانبول.
(2) الكتاني، 1/ 172.
وبعد أن يسرد الأحاديث التي سمعها منه يذكر أيضا مؤلفاته التي بلغت أحد عشر مألفا (إلى غير ذلك مما لنا من تقييد وتقرير، وبيان وتحرير، وبسط وتفسير). ومعظم مؤلفالت محمد الشريف تحوم حول الأحاديث النبوية والتصوف. ومن ذلك (جامع الأصول المنيفة من مسند أحاديث أبي حنيفة) الذي قال عنه أنه جعله في التبويب والترتيب نظير موطأ الإمام مالك. وكان محمد الشريف يوقع تآليفه هكذا (خادم العلم والعلماء الشيخ محمد بن أحمد الشريف الجزائري مولدا ومنشأ الأزميري وطنا وملجأ) فهو إذن من الجزائريين الذين يعودون إلى أصول عثمانية ويعتنقون المذهب الحنفي. وقد هاجر إلى المشرق وجاور بمكة واستوطن أزمير لأسباب لا نعلمها الآن. وقد نعرض إلى بعض مؤلفاته في فصل التصوف.
وتعتبر إجازة البوني والراشدي لمحمد مرتضى الزبيدي إجازة بالمراسلة، لأنهما لم يجتمعا به، الأول من عنابة والثاني من قسنطينة. وقد ذكر الكتاني أن الزبيدي قد ترجم للراشدي في (معجمه) وسماه فيه (شيخنا الإمام المحدث الصوفي النظار) (2). وبناء على الزبيدي فإن الراشدي قد توفي سنة 1194. وممن أجازوا الزبيدي أيضا من الجزائريين محمد المنور
__________
(1) هذه الإجازة مصورة، عن النسخة الأصلية من إسطانبول.
(2) الكتاني، 1/ 172.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
التلمساني المتوفى سنة 1172. وقد أجاز يحيى الشاوي عددا من علماء المشرق منهم المحبي صاحب (خلاصة الأثر) بعد أن درس عليه هو وجماعة من الشاميين تفسير سورة الفاتحة من البيضاوي، والألفية والعقائد ونحوها. وكانت الإجازة نظما ذكره المحبي (1). وممن أجازهم الشاوي أيضا محمد بن زيد الدين الكفيري، وذلك بأسانيده ومروياته عن مشائخه في كتب الموطأ
وصحيح البخاري وغيرها (2). كما أجاز تقي الدين الحسني بالإجازة التي منحه إياها شيخه محمد السعدي البهلول (3). ولا شك أن الشاوي قد أجاز غير هؤلاء أيضا (4).
أما ابن عمار فقد منح سنة 1205 إجازة إلى مفتي الشام عندئذ محمد خليل المرادي. وقد ذكر ابن عمار في هذه الإجازة بعض شيوخه في مصر وفي الحرمين كما ذكر العلوم التي تلقاها عنهم، بالإضافة إلى بعض الأثبات. فمن مشائخه بمكة عمر بن أحمد، وبالمدينة حسن بن محمد سعيد، وبمصر محمد الحفني، ومن هذه الإجازة نعرف أن ابن عمار يروي الحديث عن عيسى الثعالبي بطريق محمد الحفني (5). وبالإضافة إلى إبراهيم السقا وعبد القادر الرافعي منح ابن العنابي الإجازة إلى محمد بيرم التونسي ومحمد بن علي الطحاوي المصري وغيرهما. وقد عرفنا أنه كان يقلد أستاذه ابن الأمين في منح الإجازة لكل من أدرك حياته. وكان أحمد المقري قد منح الإجازات أيضا لعلماء المشرق. وقد روى هو أنه أجاز أحمد الشاهين
__________
(1) (خلاصة الأثر) 4/ 486. وقد هاجم الشاوي الفلاسفة في هذا النظم، وعدد الأبيات خمسة عشر.
(2) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، ضمن مجموع رقم 313، وهي بخط المجيز نفسه.
(3) نفس المصدر، رقم 335 ضمن مجموع.
(4) جاء صاحب الأعلام 9/ 214، بلوحة رقم 1460 من إجازة للشاوي بدار الكتب المصرية (313 مصطلح) وعليها خط الشاوي.
(5) إجازة ابن عمار للمرادي من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق. انظر مقالتي (إجازة ابن عمار الجزائري للمرادي الشامي) في مجلة (الثقافة) عدد 45، 1978.
وصحيح البخاري وغيرها (2). كما أجاز تقي الدين الحسني بالإجازة التي منحه إياها شيخه محمد السعدي البهلول (3). ولا شك أن الشاوي قد أجاز غير هؤلاء أيضا (4).
أما ابن عمار فقد منح سنة 1205 إجازة إلى مفتي الشام عندئذ محمد خليل المرادي. وقد ذكر ابن عمار في هذه الإجازة بعض شيوخه في مصر وفي الحرمين كما ذكر العلوم التي تلقاها عنهم، بالإضافة إلى بعض الأثبات. فمن مشائخه بمكة عمر بن أحمد، وبالمدينة حسن بن محمد سعيد، وبمصر محمد الحفني، ومن هذه الإجازة نعرف أن ابن عمار يروي الحديث عن عيسى الثعالبي بطريق محمد الحفني (5). وبالإضافة إلى إبراهيم السقا وعبد القادر الرافعي منح ابن العنابي الإجازة إلى محمد بيرم التونسي ومحمد بن علي الطحاوي المصري وغيرهما. وقد عرفنا أنه كان يقلد أستاذه ابن الأمين في منح الإجازة لكل من أدرك حياته. وكان أحمد المقري قد منح الإجازات أيضا لعلماء المشرق. وقد روى هو أنه أجاز أحمد الشاهين
__________
(1) (خلاصة الأثر) 4/ 486. وقد هاجم الشاوي الفلاسفة في هذا النظم، وعدد الأبيات خمسة عشر.
(2) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، ضمن مجموع رقم 313، وهي بخط المجيز نفسه.
(3) نفس المصدر، رقم 335 ضمن مجموع.
(4) جاء صاحب الأعلام 9/ 214، بلوحة رقم 1460 من إجازة للشاوي بدار الكتب المصرية (313 مصطلح) وعليها خط الشاوي.
(5) إجازة ابن عمار للمرادي من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق. انظر مقالتي (إجازة ابن عمار الجزائري للمرادي الشامي) في مجلة (الثقافة) عدد 45، 1978.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الدمشقي بتأليفه (إضاءة الدجنة) بطلب منه، كما أجازه بغيرها (1).
وبالمقابل، تلقى علماء الجزائر الإجازات من علماء المسلمين في المشرق والمغرب، وهذا هو الكثير الغالب. ولا نريد أن نعدد الإجازات وأصحابها فليس ذلك من هدفنا هنا، ولكننا ننبه إلى أن بعض الإجازات التي سنشير إليها قد تضمنت في الغالب العلوم كلها، كما يقول الورتلاني، ولم تكن خاصة بعلم الحديث وحده، وأحيانا كانت تتناول الفقه والتوحيد والتصوف، وكلها في الواقع علوم مشتركة. وقد كانت إجازات علماء المالكية في مصر والحرمين لعلماء الجزائر كثيرة الورود لاتفاق المذهب. أما علماء المغرب العربي فالمذهب بينهم واحد، لذلك أجاز عدد من علماء المغرب أحمد المقري قبل رحيله إلى المشرق. ومنهم أحمد بن القاضي صاحب (جذوة الاقتباس) وأحمد بن أبي القاسم التادلي ومحمد القصار وأحمد بابا التمبكتي (2). ومن جهة أخرى سجل عبد الرزاق بن حمادوش في رحلته مجموعة من الإجازات التي منحها له بعض علماء المغرب في عهده، وهم أحمد الورززي ومحمد بن عبد السلام البناني وأحمد بن المبارك وأحمد السرايري (3). كما أخذ محمد المنور التلمساني إجازة من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (4). وأثناء مرور عبد القادر بن شقرون الفاسي على نواحي بسكرة في طريقه إلى الحج أجاز الفقيه خليفة بن حسن القماري سنة 1192 (أو 1193) بعد أن قرأ أجزاء من نظمه المشهور لخليل. ووصف المجاز بأنه من فرسان البراعة وأنه على خلق حسن (5).
__________
(1) (نفح الطيب) 3/ 181.
(2) ذكر المقري ذلك في كتابه (روض الآس) في تراجم العلماء المنكورين. انظر كذلك فهرس دار الكتب المصرية تيمور، 171، مصطلح الحديث.
(3) ابن حمادوش (الرحلة) مخطوطة. انظر دراستي عنه في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). ج 1، ط. 3 1990.
(4) فهرس دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 181 مجموع.
(5) من نسخة خطية في مكتبة الصادق قطايم بقمار، بوادي سوف. انظر أيضا رسالة =
وبالمقابل، تلقى علماء الجزائر الإجازات من علماء المسلمين في المشرق والمغرب، وهذا هو الكثير الغالب. ولا نريد أن نعدد الإجازات وأصحابها فليس ذلك من هدفنا هنا، ولكننا ننبه إلى أن بعض الإجازات التي سنشير إليها قد تضمنت في الغالب العلوم كلها، كما يقول الورتلاني، ولم تكن خاصة بعلم الحديث وحده، وأحيانا كانت تتناول الفقه والتوحيد والتصوف، وكلها في الواقع علوم مشتركة. وقد كانت إجازات علماء المالكية في مصر والحرمين لعلماء الجزائر كثيرة الورود لاتفاق المذهب. أما علماء المغرب العربي فالمذهب بينهم واحد، لذلك أجاز عدد من علماء المغرب أحمد المقري قبل رحيله إلى المشرق. ومنهم أحمد بن القاضي صاحب (جذوة الاقتباس) وأحمد بن أبي القاسم التادلي ومحمد القصار وأحمد بابا التمبكتي (2). ومن جهة أخرى سجل عبد الرزاق بن حمادوش في رحلته مجموعة من الإجازات التي منحها له بعض علماء المغرب في عهده، وهم أحمد الورززي ومحمد بن عبد السلام البناني وأحمد بن المبارك وأحمد السرايري (3). كما أخذ محمد المنور التلمساني إجازة من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (4). وأثناء مرور عبد القادر بن شقرون الفاسي على نواحي بسكرة في طريقه إلى الحج أجاز الفقيه خليفة بن حسن القماري سنة 1192 (أو 1193) بعد أن قرأ أجزاء من نظمه المشهور لخليل. ووصف المجاز بأنه من فرسان البراعة وأنه على خلق حسن (5).
__________
(1) (نفح الطيب) 3/ 181.
(2) ذكر المقري ذلك في كتابه (روض الآس) في تراجم العلماء المنكورين. انظر كذلك فهرس دار الكتب المصرية تيمور، 171، مصطلح الحديث.
(3) ابن حمادوش (الرحلة) مخطوطة. انظر دراستي عنه في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). ج 1، ط. 3 1990.
(4) فهرس دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 181 مجموع.
(5) من نسخة خطية في مكتبة الصادق قطايم بقمار، بوادي سوف. انظر أيضا رسالة =
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وقد عرفنا أن الورتلاني قد حصل على إجازات كثيرة من شيوخ مصر أثناء إقامته بالأزهر، بعضهم أجازه بالعلوم وبعضهم أجازه بأوراد الطريقة الشاذلية. فهذا الشيخ البليدي قد أجازه في سائر العلوم، وهذا عبد الوهاب العفيفي قد أجازه إجازة مطلقة في العلوم العقلية والنقلية، وهو الذي لقنه الذكر على الطريقة الشانلية (وقد أخذنا عنه الطريق ورسم الحقيقة وإنه لقننا الأذكار وجددنا عليه العهد في الطريقة الشاذلية المحصنة). أما (سلطان العارفين) الشيخ الحفناوي فقد أجاز الورتلاني في المعقول والمنقول (1). ولوجمعت إجازات الورتلاني من علماء مصر وغيرهم لجاءت ربما في كتاب، لأن بعضهم قد أجازه بخط يده وبعضهم قد أجازه بخطوط تلاميذه، ولكن معظم إجازات الورتلاني كانت عن طريق القراءة والملازمة. وقد حضر معه بعض ذلك معاصره ومواطنه أحمد بن عمار.
وقد نشر إبراهيم اللقاني في القرن الحادي عشر الإجازة بين الجزائريين. ذلك أن كثيرا منهم قد نوهوا به وتلقوا عليه العلم. ويبدو أنه كان ذابئع الصيت متمكنا في الفقه المالكي. ومما يلفت النظر أن إبراهيم اللقاني لم يمنح الإجازة لعالم جزائري بعينه ولكنه منح إجازة لمجموعة من علماء الجزائر، مثل علي بن مبارك القليعي (2) وسعيد قدورة وسحنون (3) رفيق سيدي علي البهلول (4). وقد تضمنت الإجازة غيرهم بالطبع ولكننا للأسف لم
__________
= (إتحاف القاري بسيرة خليفة بن حسن القماري) تأليف محمد الطاهر التليلي القماري. مخطوطة.
(1) الورتلاني (الرحلة) 289.
(2) لا شك أنه من مدينة القليعة القريبة من مدينة الجزائر والمشهورة بأسرة سيدي علي مبارك المشتغلة بالتصوف.
(3) الظاهر أنه هو سحنون الونشرسي شارح (السراج) للأخضري، وسيأتي الحديث عنهفي فصل العلوم من هذا الجزء.
(4) يبدو أنه من أسرة أبهلول التي كانت لها زاوية بنواحي تنس. انظر ترجمة سعيد قدورةفي فصل التعليم من الجزء الأول.
وقد نشر إبراهيم اللقاني في القرن الحادي عشر الإجازة بين الجزائريين. ذلك أن كثيرا منهم قد نوهوا به وتلقوا عليه العلم. ويبدو أنه كان ذابئع الصيت متمكنا في الفقه المالكي. ومما يلفت النظر أن إبراهيم اللقاني لم يمنح الإجازة لعالم جزائري بعينه ولكنه منح إجازة لمجموعة من علماء الجزائر، مثل علي بن مبارك القليعي (2) وسعيد قدورة وسحنون (3) رفيق سيدي علي البهلول (4). وقد تضمنت الإجازة غيرهم بالطبع ولكننا للأسف لم
__________
= (إتحاف القاري بسيرة خليفة بن حسن القماري) تأليف محمد الطاهر التليلي القماري. مخطوطة.
(1) الورتلاني (الرحلة) 289.
(2) لا شك أنه من مدينة القليعة القريبة من مدينة الجزائر والمشهورة بأسرة سيدي علي مبارك المشتغلة بالتصوف.
(3) الظاهر أنه هو سحنون الونشرسي شارح (السراج) للأخضري، وسيأتي الحديث عنهفي فصل العلوم من هذا الجزء.
(4) يبدو أنه من أسرة أبهلول التي كانت لها زاوية بنواحي تنس. انظر ترجمة سعيد قدورةفي فصل التعليم من الجزء الأول.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
نطلع عليها. وقد قال في آخر الإجازة (أجزت لمن ذكر ولأولادهم ولأهل قطرهم .. جميع ما مر التنبيه عليه وجميع ما يجوز لي وعني روايته من مقروء ومسموع ومجاز ومكاتبه ووجادة ومراسلة وأصول وفرع ومعقول ومنقول) (1) فهي إجازة عامة في نوعها وفي هدفها لأنها لا تتعلق بنوع معين من العلم ولا بعالم واحد في الجزائر.
ولمحمد مرتضى الزبيدي أيضا تأثير على علماء الجزائر بطريق الإجازة. فهو من الذين اشتهروا بالتبحر في العلوم والتأليف فيها ونشر الإجازة بين المعاصرين. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه قد أجاز أبا راس وحمودة المقايسي. ولعله قد أجاز أيضا أحمد بن عمار وغيره من علماء الجزائر الذين ترددوا على مصر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وقد ذكر الكتاني أن للزبيدي إجازة عامة لأهل قسنطينة تقع في مجلد صغير، وله أخرى لأهل الراشدية (2). وكان محمد الأمير (وهو جزائري الأصل) قد أجاز أبا راس وغيره من الجزاريين واشتهر علماء مصريون آخرون بمنح الإجازات للجزائريين مثل: علي بن سالم السنهوري، وعلي الشرملسي وعلي الأجهوري ومحمد البابلي ومحمد الزرقاني وأحمد الجوهري. فقد أخذ محمد بن عبد الكريم الجزائري عن البابلي والزرقاني (3). وأخد محمد بن عبد المؤمن، كما عرفنا، عن الشرملسي (4). وأخذ محمد المنور التلمساني عن أحمد المجيري (5). كما أخذ علي بن الأمين عن أحمد الجوهري (6).
__________
(1) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 19 م ضمن مجموع. وقد توفي إبراهيم اللقاني سنة 1041.
(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 408.
(3) الجبرتي، 1/ 68. وبناء عليه فقد أخذ محمد بن عبد الكريم أيضا عن مغفتي تعز محمد الحبشي.
(4) ابن زاكور (الرحلة) /23.
(5) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، مجموع رقم 181، والإجازة بخط المجيز سنة 1168. وقد توفي المجيري الملوي سنة 1181.
(6) ذكر ذلك ابن الأمين نفسه في رسالته المسماة (أما بعد). مخطوط. انظر فصل اللغة =
ولمحمد مرتضى الزبيدي أيضا تأثير على علماء الجزائر بطريق الإجازة. فهو من الذين اشتهروا بالتبحر في العلوم والتأليف فيها ونشر الإجازة بين المعاصرين. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه قد أجاز أبا راس وحمودة المقايسي. ولعله قد أجاز أيضا أحمد بن عمار وغيره من علماء الجزائر الذين ترددوا على مصر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وقد ذكر الكتاني أن للزبيدي إجازة عامة لأهل قسنطينة تقع في مجلد صغير، وله أخرى لأهل الراشدية (2). وكان محمد الأمير (وهو جزائري الأصل) قد أجاز أبا راس وغيره من الجزاريين واشتهر علماء مصريون آخرون بمنح الإجازات للجزائريين مثل: علي بن سالم السنهوري، وعلي الشرملسي وعلي الأجهوري ومحمد البابلي ومحمد الزرقاني وأحمد الجوهري. فقد أخذ محمد بن عبد الكريم الجزائري عن البابلي والزرقاني (3). وأخد محمد بن عبد المؤمن، كما عرفنا، عن الشرملسي (4). وأخذ محمد المنور التلمساني عن أحمد المجيري (5). كما أخذ علي بن الأمين عن أحمد الجوهري (6).
__________
(1) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 19 م ضمن مجموع. وقد توفي إبراهيم اللقاني سنة 1041.
(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 408.
(3) الجبرتي، 1/ 68. وبناء عليه فقد أخذ محمد بن عبد الكريم أيضا عن مغفتي تعز محمد الحبشي.
(4) ابن زاكور (الرحلة) /23.
(5) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، مجموع رقم 181، والإجازة بخط المجيز سنة 1168. وقد توفي المجيري الملوي سنة 1181.
(6) ذكر ذلك ابن الأمين نفسه في رسالته المسماة (أما بعد). مخطوط. انظر فصل اللغة =
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
عيسى الثعالبي
كل المصادر التي ترجمت لعيسى الثعالبي لا تذكر إلا تاريخ وفاته بمكة سنة 1080. فتاريخ ميلاده إذن غير معروف، ولكننا نعرف أنه ولد بالجزائر في موطن أجداده الثعالبة الذين كانت إمارتهم تمتد من نواحي مليانة غربا إلى سهول وادي يسر شرقا. وهو من نسل عبد الرحمن الثعالبي دفين مدينة الجزائر الشهير. وكانت حياته الأولى متقلبة لم تعرف الاستقرار لأنه خالط أثناءها أهل الحكم، ولم يكن الحكم عندئذ مستقرا. ومن حسن حظ الثعالبي أنه نجا برأسه من الحوادث التي عاصرها في بلاده. ولكن الجزء الثاني من حياته الذي قضاه في المشرق كان هادئا انقطع فيه للعلم والدراسة والتدريس والتأليف واقتناء الكتب.
تلقى الثعالبي العلم إذن بمسقط رأسه فترة من الوقت ثم قدم إلى العاصمة لمتابعة دروسه. وكانت العاصمة في بداية القرن الحادي عشر تحتضن عددا من العلماء ذكرنا بعضهم فيما مضى (1). ولم تكن شهرة سعيد قدورة قد وصلت ما وصلت إليه من الذيوع ومع ذلك تتلمذ الثعالبي عليه وروى عنه الحديث بالخصوص. وقد قال المحبي أن الثعالبي قد روى عن قدورة الحديث المسلسل بالأولية والضيافة على الأسودين التمر والماء وتلقين الذكر ولبس الخرقة والمصافحة والمشابكة. ومن ثمة نعرف أن الثعالبي قد بدأ بداية تصوفية كما أنه قد اتصل بعلم الحديث اتصالا قويا وهو ما يزال في شبابه الباكر. وقد نقل الثعالبي مروياته عن قدورة إلى الأجيال اللاحقة فيما سيكتبه من إجازات.
ولكن الذي أثر على عيسى الثعالبي هو علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي، وهو، كما عرفنا، معاصر لقدورة. فقد لازمه الثعالبي أكثر من
__________
= والنثر من هذا الجزء. والرسالة محققة ومنشور ة حديثا.
(1) انظر ترجمة سعيد قدورة في فصل التعليم من الجزء الأول.
كل المصادر التي ترجمت لعيسى الثعالبي لا تذكر إلا تاريخ وفاته بمكة سنة 1080. فتاريخ ميلاده إذن غير معروف، ولكننا نعرف أنه ولد بالجزائر في موطن أجداده الثعالبة الذين كانت إمارتهم تمتد من نواحي مليانة غربا إلى سهول وادي يسر شرقا. وهو من نسل عبد الرحمن الثعالبي دفين مدينة الجزائر الشهير. وكانت حياته الأولى متقلبة لم تعرف الاستقرار لأنه خالط أثناءها أهل الحكم، ولم يكن الحكم عندئذ مستقرا. ومن حسن حظ الثعالبي أنه نجا برأسه من الحوادث التي عاصرها في بلاده. ولكن الجزء الثاني من حياته الذي قضاه في المشرق كان هادئا انقطع فيه للعلم والدراسة والتدريس والتأليف واقتناء الكتب.
تلقى الثعالبي العلم إذن بمسقط رأسه فترة من الوقت ثم قدم إلى العاصمة لمتابعة دروسه. وكانت العاصمة في بداية القرن الحادي عشر تحتضن عددا من العلماء ذكرنا بعضهم فيما مضى (1). ولم تكن شهرة سعيد قدورة قد وصلت ما وصلت إليه من الذيوع ومع ذلك تتلمذ الثعالبي عليه وروى عنه الحديث بالخصوص. وقد قال المحبي أن الثعالبي قد روى عن قدورة الحديث المسلسل بالأولية والضيافة على الأسودين التمر والماء وتلقين الذكر ولبس الخرقة والمصافحة والمشابكة. ومن ثمة نعرف أن الثعالبي قد بدأ بداية تصوفية كما أنه قد اتصل بعلم الحديث اتصالا قويا وهو ما يزال في شبابه الباكر. وقد نقل الثعالبي مروياته عن قدورة إلى الأجيال اللاحقة فيما سيكتبه من إجازات.
ولكن الذي أثر على عيسى الثعالبي هو علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي، وهو، كما عرفنا، معاصر لقدورة. فقد لازمه الثعالبي أكثر من
__________
= والنثر من هذا الجزء. والرسالة محققة ومنشور ة حديثا.
(1) انظر ترجمة سعيد قدورة في فصل التعليم من الجزء الأول.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
عشر سنوات ملازمة ظله، ودرس عليه علوما شتى منها صحيح البخاري دراية ورواية، وبعض كتاب الشفاء، وألفية العراقي في مصطلح الحديث. كما درس عليه الفقه وأصوله في الكتب التالية: مختصر خليل والرسالة، وتحفة الحكام لابن عاصم، وجمع الجوامع للسبكي الخ (1). وقد سجل الثعالبي ما قرأه على شيخه الأنصاري وغير. في ثبته المعروف (بكنز الرواة) الذي
سنعرض له. وارتبطت الصلة بين الثعالبي والأنصاري حتى تجاوزت العلم إلى الصلات الاجتماعية والسياسية. فقد زوجه شيخه ابنته وقربه من باشوات الجزائر، ولا سيما يوسف باشا، الذي حظي عنده الثعالبي بمكانة مرموقة، كما حظي عنده الأنصاري، حتى أصبح الثعالبي وكأنه هو كاتب الباشا الخاص (2).
ولكن الأمور قد تطورت في غير صالح الثعالبي فقد طلق زوجه بأمر والدها، كما يقول العياشي (الذي لا شك أنه روى ذلك عن الثعالبي نفسه) ومع ذلك لم تنقطع صلته بأستاذه. ثم توفي الأنصاري بالطاعون سنة 1057 فخسر الثعالبي سندا قويا. ووقعت ثورة ضد الحكم العثماني في شرق البلاد أدت إلى ضعضعة هذا الحكم ولا سيما سمعة يوسف باشا ولي نعمة الثعالبي. وقد أدى ذلك أيضا إلى وضع الباشا في السجن عدة مرات من زملائه المنافسين له والجنود الناقمين عليه لعدم دفع المرتبات لهم. ومن الرسالة التي كتبها الثعالبي لصديقه وأستاذه عالم عنابة علي بن محمد ساسي البوني، ندرك أنه قد رافق يوسف باشا في حملته ضد الثوار (الثورة المعروفة بثورة ابن الصخري) (3). وسواء رافق الثعالبي الباشا في هذه الحملة أو في حملات أخرى سابقة، فإنه قد برهن من خلال الرسالة على أنه قد شارك ضد الثورة. فهو يتحدث بضمير المؤيد للعثمانيين ضد الثوار ويصف المعارك (دون أن يذكر تاريخا) وكأنه حاضر لها ومشارك فيها. وقد كتب رسالته من نقاوس، ولكنه ذكر أيضا
__________
(1) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 240.
(2) العياشي (الرحلة) 2/ 128. انظر أيضا ترجمة علي بن عبد الواحد الأنصاري في فصل التعليم من الجزء الأول.
(3) انظر فقرة الثورات ضد العثمانيين في الفصل الثاني من الجزء الأول.
سنعرض له. وارتبطت الصلة بين الثعالبي والأنصاري حتى تجاوزت العلم إلى الصلات الاجتماعية والسياسية. فقد زوجه شيخه ابنته وقربه من باشوات الجزائر، ولا سيما يوسف باشا، الذي حظي عنده الثعالبي بمكانة مرموقة، كما حظي عنده الأنصاري، حتى أصبح الثعالبي وكأنه هو كاتب الباشا الخاص (2).
ولكن الأمور قد تطورت في غير صالح الثعالبي فقد طلق زوجه بأمر والدها، كما يقول العياشي (الذي لا شك أنه روى ذلك عن الثعالبي نفسه) ومع ذلك لم تنقطع صلته بأستاذه. ثم توفي الأنصاري بالطاعون سنة 1057 فخسر الثعالبي سندا قويا. ووقعت ثورة ضد الحكم العثماني في شرق البلاد أدت إلى ضعضعة هذا الحكم ولا سيما سمعة يوسف باشا ولي نعمة الثعالبي. وقد أدى ذلك أيضا إلى وضع الباشا في السجن عدة مرات من زملائه المنافسين له والجنود الناقمين عليه لعدم دفع المرتبات لهم. ومن الرسالة التي كتبها الثعالبي لصديقه وأستاذه عالم عنابة علي بن محمد ساسي البوني، ندرك أنه قد رافق يوسف باشا في حملته ضد الثوار (الثورة المعروفة بثورة ابن الصخري) (3). وسواء رافق الثعالبي الباشا في هذه الحملة أو في حملات أخرى سابقة، فإنه قد برهن من خلال الرسالة على أنه قد شارك ضد الثورة. فهو يتحدث بضمير المؤيد للعثمانيين ضد الثوار ويصف المعارك (دون أن يذكر تاريخا) وكأنه حاضر لها ومشارك فيها. وقد كتب رسالته من نقاوس، ولكنه ذكر أيضا
__________
(1) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 240.
(2) العياشي (الرحلة) 2/ 128. انظر أيضا ترجمة علي بن عبد الواحد الأنصاري في فصل التعليم من الجزء الأول.
(3) انظر فقرة الثورات ضد العثمانيين في الفصل الثاني من الجزء الأول.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
قسنطينة (التي بقي فيها يوسف باشا حوالي سنة) وذكر قجال التي جرت فيها معركة كبيره بين جيش اشبن الصخري وجيش العثمانيين، كما ذكر نواحي الزاب التي زارها أيضا يوسف باشا متتبعا آثار ابن الصخري (1).
كان الثعالبي إذن في غمرة الأحداث التي جرت بالجزائر حوالي منتصف القرن الحادي عشر (17 م) وقد وجد نفسه أخيرا بدون سند. فبعد وفاة شيخه الأنصاري ووفاة ولي نعمته يوسف باشا، أصبح خائفا على نفسه. فهو لم يعد إلى مدينة الجزائر التي استولى فيها على الحكم خصوم يوسف باشا. ويبدو أنه لم يطل الإقامة في قسنطينة أيضا لأنها كانت تشهد هي أيضا موجة من العنف والاضطراب. ولا شك أنه قد اتصل فيها بشيخ الإسلام عندئذ، عبد الكريم الفكون وروى عنه الحديث ونحوه (2). ولكنه لم يلبث أن غادر قسنطينة إلى حيث يكون بعيدا عن العيون، وقد أورد العياشي أن الثعالبي ظل يتنقل بين زواوة وقسطينة وبسكرة، وأنه في الأخيرة قد أقام عند الشيخ أحمد بن المبارك التواتي، كبير أولاد سيدي ناجي عندئذ، وعندما توفي الشيخ التواتي حوالي سنة 1060 لم يبق للثعالبي إلا أن يغادر الجزائر مغادرة نهائية حيث وجد نفسه، كما يقول العياشي، (الذي لا شك أنه كان ينقل عن الثعالبي نفسه) بدون أهل وإخوان.
غادر الثعالبي الجزائر سنة 1061 قاصدا الحج. وكثيرا ما كان قصد الحج وسيلة للخروج أو الهروب من الجزائر. ومهما كان الأمر فقد يكون الثعالبي مر بعنابة ومكث عند أسرة البوني التي كانت تتمتع بسمعة هائلة في عنابة ونواحيها. ولكننا لا نملك الوثائق على ذلك (3). ومن المؤكد أن الثعالبي قد مر بتونس ولعله أقام فيها بعض الوقت والتقى ببعض علمائها.
__________
(1) أورد الرسالة مترجمة إلى الفرنسية السيد فايسات (روكاي)، 1867، 339.
(2) كان الفكون من أنصار العثمانيين أيضا مثل الثعالبي، وقد ترجم له الثعالبي في ثبته (كنز الرواة). فالفكون إذن كان من شيوخ الثعالبي.
(3) كانت أسرة البوني (وهي من العلماء والمرابطين) تؤيد العثمانيين أيضا. انظر مراسلاتها مع يوسف باشا وغيره. مخطوط باريس 6724.
كان الثعالبي إذن في غمرة الأحداث التي جرت بالجزائر حوالي منتصف القرن الحادي عشر (17 م) وقد وجد نفسه أخيرا بدون سند. فبعد وفاة شيخه الأنصاري ووفاة ولي نعمته يوسف باشا، أصبح خائفا على نفسه. فهو لم يعد إلى مدينة الجزائر التي استولى فيها على الحكم خصوم يوسف باشا. ويبدو أنه لم يطل الإقامة في قسنطينة أيضا لأنها كانت تشهد هي أيضا موجة من العنف والاضطراب. ولا شك أنه قد اتصل فيها بشيخ الإسلام عندئذ، عبد الكريم الفكون وروى عنه الحديث ونحوه (2). ولكنه لم يلبث أن غادر قسنطينة إلى حيث يكون بعيدا عن العيون، وقد أورد العياشي أن الثعالبي ظل يتنقل بين زواوة وقسطينة وبسكرة، وأنه في الأخيرة قد أقام عند الشيخ أحمد بن المبارك التواتي، كبير أولاد سيدي ناجي عندئذ، وعندما توفي الشيخ التواتي حوالي سنة 1060 لم يبق للثعالبي إلا أن يغادر الجزائر مغادرة نهائية حيث وجد نفسه، كما يقول العياشي، (الذي لا شك أنه كان ينقل عن الثعالبي نفسه) بدون أهل وإخوان.
غادر الثعالبي الجزائر سنة 1061 قاصدا الحج. وكثيرا ما كان قصد الحج وسيلة للخروج أو الهروب من الجزائر. ومهما كان الأمر فقد يكون الثعالبي مر بعنابة ومكث عند أسرة البوني التي كانت تتمتع بسمعة هائلة في عنابة ونواحيها. ولكننا لا نملك الوثائق على ذلك (3). ومن المؤكد أن الثعالبي قد مر بتونس ولعله أقام فيها بعض الوقت والتقى ببعض علمائها.
__________
(1) أورد الرسالة مترجمة إلى الفرنسية السيد فايسات (روكاي)، 1867، 339.
(2) كان الفكون من أنصار العثمانيين أيضا مثل الثعالبي، وقد ترجم له الثعالبي في ثبته (كنز الرواة). فالفكون إذن كان من شيوخ الثعالبي.
(3) كانت أسرة البوني (وهي من العلماء والمرابطين) تؤيد العثمانيين أيضا. انظر مراسلاتها مع يوسف باشا وغيره. مخطوط باريس 6724.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ولا نعرف بأي طريق حج الثعالبي بحرا أو برا، ولكنه على كل حال أدى الفريضة وجاور بمكة سنتي 1062 - 1063، وأخذ العلم عن مشائخ الحرم، ثم قصد مصر فمكث بها سنتي 1064 - 1065، وأخذ عن علمائها، وخصوصا علي الأجهوري ومحمد البابلي والخفاجي، وأخذ الطريقة أيضا عن أبي الحسن علي المصري ودرس عليه. وكان يلتقي بالمغاربة ويساعدهم على شق طريقهم، كما فعل مع العياشي في حجته الأولى سنة 1064 (1). وفي السنة الموالية (1065) عاد الثعالبي إلى مكة واستوطنها وهناك أخذ يدرس للناس الحديث وغيره متسلحا بعلوم متعددة وأساليب متنوعة ساعدته على جلب الناس إليه. وبعد أن مكث سنوات عزبا تزوج من جارية اشتراها، كما يقول المحبي، وأنجب منها أولادا. وذكر العياشي أنه هنأه بواحد منهم أثناء حجته الثانية سنة 1073 (2).
أخذ الثعالبي الحديث وبعض الطرق الصوفية على عادة معظم العلماء في وقته. فعندما كان بالجزائر أخذ عن شيخه سعيد قدورة، كما عرفنا، الأحاديث المسلسلة ولبس الخرقة والمصافحة والمشابكة ونحوها من مظاهر الصوفية. ولا ندري إن كان قد أخذ، وهو في الجزائر أيضا، بعض الطقوس والأوراد. غير أنه لما كان بمصر سنة 1065 قصد الصعيد لأخذ الطريقة على الشيخ أبي الحسن علي المصري. ولا ريب أن هذه كانت هي الطريقة الشاذلية. وفي الحجاز أخذ الثعالبي الطريقة النقشبندية على الشيخ صفي الدين القشاشي المدني. فقد ذكر العياشي أنه قد تلقى من الثعالبي بطريق الإجازة مبادئ هذه الطريقة، وأنه ألبسه الخرق الثماني المنصوص عليها عند أصحابها. وهي الخرق التي لبسها الثعالبي بدوره على يد الشيخ القشاشي المذكور. ولكن الثعالبي، كما لاحظ العياشي، لم يكن متنطعا ولا متصلبا في تصوفه، فلم يكن ضد التصوف بالمرة كما كان بعض الفقهاء، ولم
__________
(1) في هذه الحجة التقى العياشي أيضا بعبد الكريم الفكون، فهل التقى الثلاثة (الفكون والثعالبي والعياشي) في مصر؟
(2) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 240. والعياشي (الرحلة) 2/ 138.
أخذ الثعالبي الحديث وبعض الطرق الصوفية على عادة معظم العلماء في وقته. فعندما كان بالجزائر أخذ عن شيخه سعيد قدورة، كما عرفنا، الأحاديث المسلسلة ولبس الخرقة والمصافحة والمشابكة ونحوها من مظاهر الصوفية. ولا ندري إن كان قد أخذ، وهو في الجزائر أيضا، بعض الطقوس والأوراد. غير أنه لما كان بمصر سنة 1065 قصد الصعيد لأخذ الطريقة على الشيخ أبي الحسن علي المصري. ولا ريب أن هذه كانت هي الطريقة الشاذلية. وفي الحجاز أخذ الثعالبي الطريقة النقشبندية على الشيخ صفي الدين القشاشي المدني. فقد ذكر العياشي أنه قد تلقى من الثعالبي بطريق الإجازة مبادئ هذه الطريقة، وأنه ألبسه الخرق الثماني المنصوص عليها عند أصحابها. وهي الخرق التي لبسها الثعالبي بدوره على يد الشيخ القشاشي المذكور. ولكن الثعالبي، كما لاحظ العياشي، لم يكن متنطعا ولا متصلبا في تصوفه، فلم يكن ضد التصوف بالمرة كما كان بعض الفقهاء، ولم
__________
(1) في هذه الحجة التقى العياشي أيضا بعبد الكريم الفكون، فهل التقى الثلاثة (الفكون والثعالبي والعياشي) في مصر؟
(2) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 240. والعياشي (الرحلة) 2/ 138.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
يكن متدروشا تماما كما كان كثير من المتصوفة، بل كان بين بين. فقد جمع العلم إلى الزهد في حالة تذكرنا بنسيبه عبد الرحمن الثعالبي. ولذلك كان مقبولا عند أهل الظاهر والباطن. ورغم أنه كان فقيرا في معظم أوقاته فإنه كان في المشرق لا يسأل الناس شيئا ولا يغشى أبواب الأمراء، كما كان يفعل أحمد المقري ويحيى الشاوي. ومع ذلك لم يعش كل حياته محروما فقيرا. فقد أقبلت عليه الدنيا بعض الإقبال، ونال بسطة في الرزق، غير أن ذلك، فيما يبدو، كان في أخريات أيامه.
وصف الثعالبي مترجموه بأنه كان ذا ملكة واسعة في علم الحديث، وأنه كان مسند الدنيا في وقته، كما وصفوه بالذكاء الحاد وقوة الهيبة في التدريس والتمكن من الفقه المالكي. ومن الذين عاصروه وترجموا له العياشي المغربي والمحبي الشامي. وكلاهما أعجب به أشد الإعجاب. وإذا كان المحبي قد سمع به فقط فإن العياشي قد التقى به في حجتيه وأخذ عنه وشاهد مجلسه ولاحظ تمكنه في العلوم المذكورة. كما خالطه اجتماعيا. لذلك يمكن أن نعتبر ما أورده عنه نوعا من الترجمة الشخصية له أثناء حياته، وبعض ذلك كان من إملاء أو من وحي الثعالبي نفسه. كما أن إجازات الثعالبي لغيره تعتبر من المصادر الأولى عنه. ومن ذلك إجازته للشيخ أحمد بن سعيد الدلائي سنة 1068 بمكة، وهي الإجازة التي عدد فيها أساتذته الذين أخذ عنهم الحديث (الكتب الستة) في مصر، وخصوصا علماء الأزهر المالكية أمثال علي الأجهوري ويوسف الفيشي (1). وبالإضافة إلى إجازته للعياشي والمحبي والدلائي، أجاز الثعالبي أيضا محمد بن محمد العيثاوي الدمشقي الذي توفي مثله سنة 1080. وهي الإجازة التي كتب فيها الثعالبي أنه (لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) (2)، كما أجاز إبراهيم بن
__________
(1) توجد هذه الإجازة ضمن مجموع رقم 286 تيمور، دار الكتب المصرية، حديث ص 248 - 254 وهي ناقصة من الوسط.
(2) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 335، ضمن مجموع، وهي بخط الثعالبي نفسه كتبها سنة 1075.
وصف الثعالبي مترجموه بأنه كان ذا ملكة واسعة في علم الحديث، وأنه كان مسند الدنيا في وقته، كما وصفوه بالذكاء الحاد وقوة الهيبة في التدريس والتمكن من الفقه المالكي. ومن الذين عاصروه وترجموا له العياشي المغربي والمحبي الشامي. وكلاهما أعجب به أشد الإعجاب. وإذا كان المحبي قد سمع به فقط فإن العياشي قد التقى به في حجتيه وأخذ عنه وشاهد مجلسه ولاحظ تمكنه في العلوم المذكورة. كما خالطه اجتماعيا. لذلك يمكن أن نعتبر ما أورده عنه نوعا من الترجمة الشخصية له أثناء حياته، وبعض ذلك كان من إملاء أو من وحي الثعالبي نفسه. كما أن إجازات الثعالبي لغيره تعتبر من المصادر الأولى عنه. ومن ذلك إجازته للشيخ أحمد بن سعيد الدلائي سنة 1068 بمكة، وهي الإجازة التي عدد فيها أساتذته الذين أخذ عنهم الحديث (الكتب الستة) في مصر، وخصوصا علماء الأزهر المالكية أمثال علي الأجهوري ويوسف الفيشي (1). وبالإضافة إلى إجازته للعياشي والمحبي والدلائي، أجاز الثعالبي أيضا محمد بن محمد العيثاوي الدمشقي الذي توفي مثله سنة 1080. وهي الإجازة التي كتب فيها الثعالبي أنه (لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) (2)، كما أجاز إبراهيم بن
__________
(1) توجد هذه الإجازة ضمن مجموع رقم 286 تيمور، دار الكتب المصرية، حديث ص 248 - 254 وهي ناقصة من الوسط.
(2) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 335، ضمن مجموع، وهي بخط الثعالبي نفسه كتبها سنة 1075.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
حامد القاكي بحديث الرحمة المسلسل والصيانة والمصافحة والمشابكة وتلقين الذكر .. وغير ذلك (1). وللثعالبي تلاميذ كثيرون في علم الحديث إما أخذوه عنه مباشرة بالدرس والإجازة وإما بطريقة غير مباشرة.
وإذا كان الثعالبي مشهورا برواية الحديث ووفرة العلوم والذكاء والدرس المهاب فإنه غير مشهور بكثرة التأليف. ويبدو أنه ممن كانوا منقطعين للقراءة والتدريس، ومع ذلك فقد ترك بعض الأعمال ذات القيمة الكبيرة في موضوعها. من ذلك فهرسته أو ثبته المعروف (بكنز الرواة) الذي ترجم فيه لشيوخه من المغاربة والمشارقة. كما ينسب إليه (رجز في مصاعفة ثواب هذه الأمة) (2).
ويعتبر (كنز الرواة) العمل الرئيسي الذي كتبه الثعالبي. فقد تتبع من أجله خزائن الكتب الكبيرة في مصر والحجاز واستخرج منها نوادر التآليف وقيد الكثير منها، ودرس تلك المصنفات والمجاميع والمسانيد والأجزاء بحسب أزمنة مؤلفيها، فكان يختار من كل كتاب أعلى ما فيه، وضبط من الأسماء والأنساب ما قل أن يوجد عند غيره، وأبان عن طرق الرواية التي كانت مخفية عند غيره (فهو نادرة الوقت ومسند الزمان) (3). وقد حصل العياشي على نسخة غير تامة من (كنز الرواة) وأجازه بها الثعالبي. وقد أعجب العياشي بهذا الفهرس أشد الإعجاب فقال إن الثعالبي قد (سلك فيه مسلكا عجيبا ورتبه ترتيبا غريبا جمع فيه من غرائب الفوائد شيئا كثيرا، وهو إلى الآن لم يكمل، وإذا من الله بإكماله يطلع في عدة أجزاء). وقد رتبه الثعالبي على أسماء شيوخه فيعرف بكل منهم ويذكر ما له من المؤلفات والمقروءات والشيوخ، ثم يذكر ما قرأه هو على كل شيخ من العلوم والمؤلفات، ويوضح سند الشيخ في الكتاب الذي يدرسه عليه، كما يترجم
__________
(1) نفس المصدر، رقم (173 طلعت)، مصطلح الحديث.
(2) بروكلمان 2/ 939.
(3) العياشي (الرحلة) 2/ 132. عن الثعالبي انظر أيضا (نشر الشمثاني) للغقادري 2/ 204 (الترجمة الفرنسية).
وإذا كان الثعالبي مشهورا برواية الحديث ووفرة العلوم والذكاء والدرس المهاب فإنه غير مشهور بكثرة التأليف. ويبدو أنه ممن كانوا منقطعين للقراءة والتدريس، ومع ذلك فقد ترك بعض الأعمال ذات القيمة الكبيرة في موضوعها. من ذلك فهرسته أو ثبته المعروف (بكنز الرواة) الذي ترجم فيه لشيوخه من المغاربة والمشارقة. كما ينسب إليه (رجز في مصاعفة ثواب هذه الأمة) (2).
ويعتبر (كنز الرواة) العمل الرئيسي الذي كتبه الثعالبي. فقد تتبع من أجله خزائن الكتب الكبيرة في مصر والحجاز واستخرج منها نوادر التآليف وقيد الكثير منها، ودرس تلك المصنفات والمجاميع والمسانيد والأجزاء بحسب أزمنة مؤلفيها، فكان يختار من كل كتاب أعلى ما فيه، وضبط من الأسماء والأنساب ما قل أن يوجد عند غيره، وأبان عن طرق الرواية التي كانت مخفية عند غيره (فهو نادرة الوقت ومسند الزمان) (3). وقد حصل العياشي على نسخة غير تامة من (كنز الرواة) وأجازه بها الثعالبي. وقد أعجب العياشي بهذا الفهرس أشد الإعجاب فقال إن الثعالبي قد (سلك فيه مسلكا عجيبا ورتبه ترتيبا غريبا جمع فيه من غرائب الفوائد شيئا كثيرا، وهو إلى الآن لم يكمل، وإذا من الله بإكماله يطلع في عدة أجزاء). وقد رتبه الثعالبي على أسماء شيوخه فيعرف بكل منهم ويذكر ما له من المؤلفات والمقروءات والشيوخ، ثم يذكر ما قرأه هو على كل شيخ من العلوم والمؤلفات، ويوضح سند الشيخ في الكتاب الذي يدرسه عليه، كما يترجم
__________
(1) نفس المصدر، رقم (173 طلعت)، مصطلح الحديث.
(2) بروكلمان 2/ 939.
(3) العياشي (الرحلة) 2/ 132. عن الثعالبي انظر أيضا (نشر الشمثاني) للغقادري 2/ 204 (الترجمة الفرنسية).
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
قليلا لمؤلف الكتاب (فاستوفى بذلك تواريخ غالب الأئمة المؤلفين وأسانيد مؤلفاتهم). ويروي العياشي أيضا أن الثعالبي هو الذي طلب منه كتابة خطبة (كنز الرواة) واقتراح اسم له. وقد كتب العياشي الخطبة وأضاف إليها قصيدة دالية في مدح شيخه الثعالبي. أما الكتاب فقد سماه العياشي (كنز الرواة المجموع في درر المجاز ويواقيت المسموع) (1).
وقد أكمل الثعالبي (كنز الرواة) بعد سفر العياشي، فجاء في مجلدين.
وقد وصفه الكتاني، الذي حصل منه على المجلد الأول المنسوخ سنة 1075، أي خمس سنوات قبل وفاة الثعالبي. بأنه (أعظم الكنوز وأثمنها وأوعاها). وقال الكتاني أيضا إن النسخة التي حصل عليها فيها خطوط للمؤلف نفسه بالمقابلة والتصحيح (2). وهذا دليل آخر على أن (كنز الرواة) لم يكن قد كمل نهائيا أو على الأقل لم يبيض في شكله الأخير. فهل تم ذلك
قبل حياة المؤلف؟ لا نستطيع أن نؤكد ذلك الآن لأننا لم نطلع عليه. والجدير بالذكر هو أن الثعالبي قد ترجم، فيمن ترجم، لشيوخه الجزائريين في (كنز الرواة)، ونعرف إلى الآن أنه قد ترجم فيه لسعيد قدورة وعلي بن عبد الواحد الأنصاري وعبد الكريم الفكون. ولعله قد ترجم لغيرهم الذين التقى أيضا بهم كالشيخ أحمد بن المبارك التواتي وعلي بن محمد ساسي البوني، ولا شك أن هذا الكتاب مصدر هام لأسانيد الحديث والرواة والمشائخ الذين أخذ عنهم ولكن اسم هذا الفهرس ما يزال محيرا، فالعياشي والكتاني (الذي نقل عن العياشي) لم يذكراه إلا بعنوان (كنز الرواة) بل إن العياشي هو الذي اقترح اسمه على الثعالبي، كما سبق, أما المحبي فلم يذكر هذا العنوان إطلاقا بل ذكر بدلا منه عنوانا آخر، وهو (مقاليد الأسانيد)، وهو التأليف الوحيد الذي
__________
(1) العياشي (الرحلة) 2/ 137. ذكر السيد محمد المنوني (مكتبة الراوية الحمزية - المغرب) (مجلة تطوان) 8، إن نسخة من هذا الكتاب بخط مشرقي توجد في المكتبة المذكورة رقم 192 مجموع.
(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 377.
وقد أكمل الثعالبي (كنز الرواة) بعد سفر العياشي، فجاء في مجلدين.
وقد وصفه الكتاني، الذي حصل منه على المجلد الأول المنسوخ سنة 1075، أي خمس سنوات قبل وفاة الثعالبي. بأنه (أعظم الكنوز وأثمنها وأوعاها). وقال الكتاني أيضا إن النسخة التي حصل عليها فيها خطوط للمؤلف نفسه بالمقابلة والتصحيح (2). وهذا دليل آخر على أن (كنز الرواة) لم يكن قد كمل نهائيا أو على الأقل لم يبيض في شكله الأخير. فهل تم ذلك
قبل حياة المؤلف؟ لا نستطيع أن نؤكد ذلك الآن لأننا لم نطلع عليه. والجدير بالذكر هو أن الثعالبي قد ترجم، فيمن ترجم، لشيوخه الجزائريين في (كنز الرواة)، ونعرف إلى الآن أنه قد ترجم فيه لسعيد قدورة وعلي بن عبد الواحد الأنصاري وعبد الكريم الفكون. ولعله قد ترجم لغيرهم الذين التقى أيضا بهم كالشيخ أحمد بن المبارك التواتي وعلي بن محمد ساسي البوني، ولا شك أن هذا الكتاب مصدر هام لأسانيد الحديث والرواة والمشائخ الذين أخذ عنهم ولكن اسم هذا الفهرس ما يزال محيرا، فالعياشي والكتاني (الذي نقل عن العياشي) لم يذكراه إلا بعنوان (كنز الرواة) بل إن العياشي هو الذي اقترح اسمه على الثعالبي، كما سبق, أما المحبي فلم يذكر هذا العنوان إطلاقا بل ذكر بدلا منه عنوانا آخر، وهو (مقاليد الأسانيد)، وهو التأليف الوحيد الذي
__________
(1) العياشي (الرحلة) 2/ 137. ذكر السيد محمد المنوني (مكتبة الراوية الحمزية - المغرب) (مجلة تطوان) 8، إن نسخة من هذا الكتاب بخط مشرقي توجد في المكتبة المذكورة رقم 192 مجموع.
(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 377.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ذكره له، رغم أنه قال إن له (مؤلفات) أخرى (1). ونفس العنوان وهو (مقاليد الأسانيد) قد نسبه إليه أيضا أحمد بن عمار في إجازته لمحمد خليل المرادي سنة 1205، ولم ينسب إليه غيره (2). وتنسب بعض المصادر الأخرى إلى الثعالبي عنوانا جديدا لفهرسه وهو (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد) (3) وهو نفس العنوان المنسوب أيضا لفهرس أحمد بن عمار (4). ومن الواضح أن (مقاليد الأسانيد) هو عنوان جديد (لكنز الرواة) أطلقه عليه المؤلف نفسه بعد الفراغ من تأليفه، عوضا عن العنوان الذي اقترحه عليه العياشي. فقد عرفنا أن المحبي وهو معاصر الثعالبي قد أشار إلى (المقاليد) ولم يشر إلى (كنز الرواة) مما يدل على أن فهرس الثعالبي قد أصبح متداولا عندهم بالعنوان الجديد، وقد رأينا أيضا أن ابن عمار، وهو من المطلعين المشهود لهم، قد نقل نفس الشيء. أما (منتخب الأسانيد) الذي لم نطلع عليه، فهو، على ما يبدو، فهرس محمد البابلي، أستاذ الثعالبي. ذلك أن الثعالبي قد قال عند الانتهاء من جمع أسانيد شيخه (وهنا انتهى ما من الله تعالى به على العبد من (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد). وقد ذكر فيه الثعالبي، كما قال، ما روى عن شيخه (مقتصرا من طرق الإسناد على أمتنها وأقربها وأعرفها) (5). ولكن يظل (منتخب الأسانيد) المنسوب أيضا إلى ابن عمار يثير الحيرة والشك. فهو إما عنوان مكرر، وكثيرا ما يقع هذا، وإما أن يكون قد نسب إلى ابن عمار خطأ، ويكون ثبته يحمل عنوانا آخر.
بقي أن نشير إلى أن الدرعي قد نسب إلى عيسى الثعالبي تأليفا آخر فيأسانيد الإمام مالك في الفقه. وهو (إتحاف ودود وإسعاف بمقصد محمود).
__________
(1) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 243.
(2) الإجازة منشورة في كتابنا (تجارب في الأدب)، الجزائر 1983.
(3) انظر مثلا تيمور، حديث، دار الكتب المصرية، رقم 286.
(4) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 82.
(5) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 79.
بقي أن نشير إلى أن الدرعي قد نسب إلى عيسى الثعالبي تأليفا آخر فيأسانيد الإمام مالك في الفقه. وهو (إتحاف ودود وإسعاف بمقصد محمود).
__________
(1) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 243.
(2) الإجازة منشورة في كتابنا (تجارب في الأدب)، الجزائر 1983.
(3) انظر مثلا تيمور، حديث، دار الكتب المصرية، رقم 286.
(4) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 82.
(5) دار الكتب المصرية، مصطلح الحديث، رقم 79.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
12:23 PM
08-25-2016
فبعد أن أشار الدرعي إلى كونه يروي مرويات الثعالبي قال عنه: (جمع .. سلسلة الفقه على مذهب الإمام مالك جمعا لم يسبق إليه بعد ما حارت فيه فحول الأئمة كما هو معروف. فرفع الأسانيد من طريق شيخه الأنصاري إلى مشاهير أئمة المذهب المتأخرين ثم إلى من فوقهم في الشهرة والزمان على أسلوب غريب إلى أن وصلها إلى الإمام مالك ثم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). ثم ذكر
الدرعي ما جمعه الثعالبي في هذا الباب بلفظه على طوله (إذ هو ما يغتبط به لندارته ونفاسته وعزته وسلامته) (1).
والذي لا شك فيه أن عيسى الثعالبي، بسيرته العلمية ومؤلفاته وتأثيره الروحي على معاصريه، كان عملاقا في القرن الحادي عشر. فقد كان على رأس الأربعة الذين أحرزوا مكانة عالمية (في العالم الإسلامي) في وقتهم، وهم سعيد قدورة، وأحمد المقري، وعبد الكريم الفكون، ويحيى الشاوي. ولاشتغال الثعالبي خصوصا بالحديث وعلومه والسند ورجاله، ولانتمائه إلى حركة الزهد الإيجابي في ذلك الوقت نال رضى أهل الظاهر والباطن، سواء كانوا من علماء الكتاب والسنة أو من رجال التصوف. ولا غرابة بعد ذلك أن نقرأ في (خلاصة الأثر) أن للناس في الثعالبي عقيدة كبيرة وأن له بعض الكرامات. وإذا كانت هذه هي عقائد الناس فيه فهو لم يدع شيئا من ذلك على ما نعلم، فقد كان يملأ وقته بالتدريس والمطالعة في المكتبة الكبيرة التي جمعها وفي التأليف، وكل هذا في الوقت الذي كان فيه أدعياء التصوف في بلاده يستغلون العامة على جهل ويملأون الدنيا دروشة وخرافات. فعيسى الثعالبي، كنسيبه عبد الرحمن، قد جمع بين الزهد والعلم، وهذا غاية الصلاح.
أحمد البوني
وهناك عالم آخر بالحديث ورجاله لم يبلغ مبلغ الثعالبي فيه ولكنه
__________
(1) الدرعي (الرحلة) مخطوط المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 997 1، ورقة 99 - 104. وعن الثعالبي انظر أيضا بروكلمان 2/ 691، والأعلام 5/ 294.
فبعد أن أشار الدرعي إلى كونه يروي مرويات الثعالبي قال عنه: (جمع .. سلسلة الفقه على مذهب الإمام مالك جمعا لم يسبق إليه بعد ما حارت فيه فحول الأئمة كما هو معروف. فرفع الأسانيد من طريق شيخه الأنصاري إلى مشاهير أئمة المذهب المتأخرين ثم إلى من فوقهم في الشهرة والزمان على أسلوب غريب إلى أن وصلها إلى الإمام مالك ثم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). ثم ذكر
الدرعي ما جمعه الثعالبي في هذا الباب بلفظه على طوله (إذ هو ما يغتبط به لندارته ونفاسته وعزته وسلامته) (1).
والذي لا شك فيه أن عيسى الثعالبي، بسيرته العلمية ومؤلفاته وتأثيره الروحي على معاصريه، كان عملاقا في القرن الحادي عشر. فقد كان على رأس الأربعة الذين أحرزوا مكانة عالمية (في العالم الإسلامي) في وقتهم، وهم سعيد قدورة، وأحمد المقري، وعبد الكريم الفكون، ويحيى الشاوي. ولاشتغال الثعالبي خصوصا بالحديث وعلومه والسند ورجاله، ولانتمائه إلى حركة الزهد الإيجابي في ذلك الوقت نال رضى أهل الظاهر والباطن، سواء كانوا من علماء الكتاب والسنة أو من رجال التصوف. ولا غرابة بعد ذلك أن نقرأ في (خلاصة الأثر) أن للناس في الثعالبي عقيدة كبيرة وأن له بعض الكرامات. وإذا كانت هذه هي عقائد الناس فيه فهو لم يدع شيئا من ذلك على ما نعلم، فقد كان يملأ وقته بالتدريس والمطالعة في المكتبة الكبيرة التي جمعها وفي التأليف، وكل هذا في الوقت الذي كان فيه أدعياء التصوف في بلاده يستغلون العامة على جهل ويملأون الدنيا دروشة وخرافات. فعيسى الثعالبي، كنسيبه عبد الرحمن، قد جمع بين الزهد والعلم، وهذا غاية الصلاح.
أحمد البوني
وهناك عالم آخر بالحديث ورجاله لم يبلغ مبلغ الثعالبي فيه ولكنه
__________
(1) الدرعي (الرحلة) مخطوط المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 997 1، ورقة 99 - 104. وعن الثعالبي انظر أيضا بروكلمان 2/ 691، والأعلام 5/ 294.
الموضوع:
تاريخ الجزائر الثقافي.doc الجــــزء الثاني بقسم
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
يستحق التنويه والتعريف، وهو أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني. والبوني ينتسب إلى أسرة عريقة في العلم والتصوف، وهو تميمي النسب، كما كان يضيف ذلك إلى اسمه في المخطوطات التي رأيناها له. والذي يعنينا هنا ليس نسب البوبي ولكن مساهمته في الحياة الثقافية، ولا سيما علم الحديث الذين نحن بصدده. ولما كان البوني قد أخذ الحديث على جده بالدرجة الأولى، ولما كان جده قد جمع بين الفقه والتصوف فقد رأينا أن نسوق كلمة عن جده أيضا.
كان محمد بن إبراهيم ساسي البوني من أبرز مرابطي وعلماء القرنالحادي عشر في عنابة، كما عرفنا (1) فقد كان تلميذا للشيخ طراد، مرابط عنابة ونواحيها، ثم انفرد هو بالفقه والتصوف حتى أصبح، كما يقول معاصره الفكون، مسموع القول عند الخاصة والعامة. وقد أشرنا إلى بعض نفوذه الروحي في المنطقة وسلوكه الصوفي واستعماله الإنشاد والموسيقى والشعر والحضرة الصوفية. ومن الخاصة الذين كان محمد ساسي مسموع الكلمة عندهم يوسف باشا حاكم الجزائر أثناء ثورة ابن الصخري في شرق البلاد. وقد كانت عنابة ونواحيها قد تأثرت بهذه الثورة، فبعث الباشا إلى محمد ساسي يطلب تدخله لدى الأهالي، ويشير عليه باستعمال نفوذه الروحي لديهم، ويعلمه بأنه ما تخلى عن حرب الإسبان في وهران إلا لأن الأحوال في شرق البلاد قد أوجبت ذلك. فكان رد محمد ساسي عليه هو طلب العفو على الأهالي وعدم استعمال القوة ضدهم. وقد استجاب الباشا لطلبه ولكنه أخبره بأنه لم يفعل ذلك إلا مراعاة لقيمته عنده وقيمته لدى السكان ولمكانته الدينية (2).
__________
(1) انظر عنه فصل المرابطين من الجزء الأول. وقد تحدث عنه الفكون في (منشور الهداية).
(2) هذه المراسلات بالمكتبة الوطنية - باريس، رقم 6724، وقد ترجم السيد فايسات إلى الفرنسية رسالتي الباشا إلى محمد ساسي، انظر (روكاي) 1867، ص 344 - 348، ولكنه لخص فقط رسالة محمد ساسي إلى الباشا. انظر دراستي لهذه المراسلات في (الثقافة) عدد 51، 1979.
كان محمد بن إبراهيم ساسي البوني من أبرز مرابطي وعلماء القرنالحادي عشر في عنابة، كما عرفنا (1) فقد كان تلميذا للشيخ طراد، مرابط عنابة ونواحيها، ثم انفرد هو بالفقه والتصوف حتى أصبح، كما يقول معاصره الفكون، مسموع القول عند الخاصة والعامة. وقد أشرنا إلى بعض نفوذه الروحي في المنطقة وسلوكه الصوفي واستعماله الإنشاد والموسيقى والشعر والحضرة الصوفية. ومن الخاصة الذين كان محمد ساسي مسموع الكلمة عندهم يوسف باشا حاكم الجزائر أثناء ثورة ابن الصخري في شرق البلاد. وقد كانت عنابة ونواحيها قد تأثرت بهذه الثورة، فبعث الباشا إلى محمد ساسي يطلب تدخله لدى الأهالي، ويشير عليه باستعمال نفوذه الروحي لديهم، ويعلمه بأنه ما تخلى عن حرب الإسبان في وهران إلا لأن الأحوال في شرق البلاد قد أوجبت ذلك. فكان رد محمد ساسي عليه هو طلب العفو على الأهالي وعدم استعمال القوة ضدهم. وقد استجاب الباشا لطلبه ولكنه أخبره بأنه لم يفعل ذلك إلا مراعاة لقيمته عنده وقيمته لدى السكان ولمكانته الدينية (2).
__________
(1) انظر عنه فصل المرابطين من الجزء الأول. وقد تحدث عنه الفكون في (منشور الهداية).
(2) هذه المراسلات بالمكتبة الوطنية - باريس، رقم 6724، وقد ترجم السيد فايسات إلى الفرنسية رسالتي الباشا إلى محمد ساسي، انظر (روكاي) 1867، ص 344 - 348، ولكنه لخص فقط رسالة محمد ساسي إلى الباشا. انظر دراستي لهذه المراسلات في (الثقافة) عدد 51، 1979.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ورغم أن محمد ساسي قد أثار بعض علماء الوقت ضده لمبالغته في التصوف واستعمال بعض الطرق غير السليمة لجلب المال فإن حفيده أحمد بن قاسم ساسي، قد لاحظ أن الفقه والتصوف قد غلبا على جده (حتى امتزجا فيه). وقد عدد له بعض التآليف التي لا تخرج عن التصوف والتي سنعرض إليها في حينها. أما الفقه فلم يذكر له منه شيئا رغم أنه قال إن له غير ذلك من التآليف، كما أنه لم يذكر له تأليفا في علم الحديث. ومهما كان الأمر فإن علاقة أحمد البوني بعلم التصوف علاقة وطيدة إذا حكمنا من أثر جده فيه. ولعل ما قاله عن جده من أن الفقه والتصوف قد امتزجا فيه يصدق أكثر عليه هو. ذلك أن تآليفه الكثيرة قد جمعت فعلا بين التصوف والفقه وغيرهما من العلوم. فقد ألف أحمد البوني تآليف كثيرة بلغت، كما أخبر بنفسه، أكثر من مائة تأليف، بدون المنظومات والمقطوعات. وهو الذي كتب تأليفا خاصا سماه (التعريف بما للفقير من التواليف.). ومن هذه التآليف ما كمل ومنها ما لم يكمل، ومنها الشعر والنثر، كما أن منها ما يدخل في باب الحديث والسنة وما يتناول غير ذلك. وقد اطلعنا على بعض أعماله فكان منها القصير الذي لا يتجاوز الكراسة ومنها الوسط والطويل.
وقد ولد أحمد البوني سنة 1063 وتوفي سنة 1139. وكان له ولدان أشهرهما أحمد الزروق الذي ذكره هو في الألفية الصغرى وخصه بالإجازة التي سنتعرض إليها، وأشار إليه ابن حمادوش في رحلته، كما أنه هو الذي أجاز الزبيدي سنة 1179 بالمراسلة من عنابة، كما أجاز الورتلاني. فقد كان أحمد الزروق أيضا من مشاهير عصره، ولكنه كان أقل تأليفا من والده.
وتثقف أحمد البوني إذن على والده وجده وأفراد عائلته، وبرع في عدة علوم، منها علم الحديث. وكانت بينه وبين علماء قسنطينة علاقات علمية ولكننا لا نعرف ما إذا كانت قد بلغت مبلغ التلمذة. ومن الذين كان يتصل بهم في قسنطينة بركات بن باديس. وقد ساح البوني طويلا وطلب العلم في
وقد ولد أحمد البوني سنة 1063 وتوفي سنة 1139. وكان له ولدان أشهرهما أحمد الزروق الذي ذكره هو في الألفية الصغرى وخصه بالإجازة التي سنتعرض إليها، وأشار إليه ابن حمادوش في رحلته، كما أنه هو الذي أجاز الزبيدي سنة 1179 بالمراسلة من عنابة، كما أجاز الورتلاني. فقد كان أحمد الزروق أيضا من مشاهير عصره، ولكنه كان أقل تأليفا من والده.
وتثقف أحمد البوني إذن على والده وجده وأفراد عائلته، وبرع في عدة علوم، منها علم الحديث. وكانت بينه وبين علماء قسنطينة علاقات علمية ولكننا لا نعرف ما إذا كانت قد بلغت مبلغ التلمذة. ومن الذين كان يتصل بهم في قسنطينة بركات بن باديس. وقد ساح البوني طويلا وطلب العلم في
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
تونس وفي مصر، ولا سيما مدينة رشيد التي التقى بعلمائها وأجاز فيها حسن بن سلامة الطيبي في الحديث (1). وذهب أيضا إلى الحج لأنه كتب رحلة حجازية ما تزال مفقودة سماها (الروضة الشهية في الرحلة الحجازية). وقد ذكر فيها بعض أشياخه. ورجع إلى عنابة وأصبحت له مكانة عالية بين معاصريه الخاصة والعامة. وقد رأينا أن له مراسلات مع الباشا محمد بكداش والباشا حسين خوجة الشريف. كما أن عبد الرحمن الجامعي المغربي قد نزل عنده وأخذ عليه وطلب منه الإجازة، ووصفه بأوصاف تدل على مكانته عندئذ. وقد حضر الجامعي مجلس إقرائه الحديث من الصحيحين مع مشائخ عنابة وبحضور ولديه. ومن الأوصاف التي أطلقها عليه الجامعي قوله: (الشيخ الرباني العالم العرفاني). وترجم له الجامعي في رحلته المسماة (نظم الدرر المديحية). ومن تآليف البوني في الحديث والسنة النبوية عموما ما يلي: (نظم الخصائص النبوية)، و (إظهار نفائس ادخاري المهيآت لختم كتاب البخاري)، و (تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة) و (نفح الروانيد بذكر بعض المهم من الأسانيد) وغيرها (2).
تعرض أحمد البوني لشيوخه في علم الحديث في عدة مناسبات. فقد ذكرهم في رحلته الحجازية وعددهم أكثر من عشرين، وهي الرحلة التي نصح ابنه الناس بالاطلاع عليها لأن (فيها طرفا وظرفا) (3). وذكر عددا من شيوخه أيضا في الألفية الصغرى المعروفة باسم (الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة) (4)، ولا سيما شيوخه من عنابة والمغرب وتونس. والمصدر الثالث لشيوخه هو تأليفه (التعريف بما للفقير من التواليف) المشار إليه. أما المصدر
__________
(1) روى ذلك الجبرتي 1/ 266، وقد ذكره الجبرتي أيضا هكذا: أحمد بن قاسم البوني.
(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 170.
(3) تعليق أحمد الزروق على (فتوى في الحضانة) لوالده. مخطوط المكتبة الوطنية - الجزائر، رقم 2160.
(4) نشرت كاملة في (التقويم الجزائري) سنة 1913، ص 87 - 128. أما الألفية الكبرى فقد تضمنت ثلاثة آلاف بيت.
تعرض أحمد البوني لشيوخه في علم الحديث في عدة مناسبات. فقد ذكرهم في رحلته الحجازية وعددهم أكثر من عشرين، وهي الرحلة التي نصح ابنه الناس بالاطلاع عليها لأن (فيها طرفا وظرفا) (3). وذكر عددا من شيوخه أيضا في الألفية الصغرى المعروفة باسم (الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة) (4)، ولا سيما شيوخه من عنابة والمغرب وتونس. والمصدر الثالث لشيوخه هو تأليفه (التعريف بما للفقير من التواليف) المشار إليه. أما المصدر
__________
(1) روى ذلك الجبرتي 1/ 266، وقد ذكره الجبرتي أيضا هكذا: أحمد بن قاسم البوني.
(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 170.
(3) تعليق أحمد الزروق على (فتوى في الحضانة) لوالده. مخطوط المكتبة الوطنية - الجزائر، رقم 2160.
(4) نشرت كاملة في (التقويم الجزائري) سنة 1913، ص 87 - 128. أما الألفية الكبرى فقد تضمنت ثلاثة آلاف بيت.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الرابع فهو إجازته لولده أحمد الزروق ومحمد بن علي الجعفري مفتي قسنطينة (1). وقد اطلعنا نحن على هذه الإجازة وأخذنا منها. ولذلك نود أن نتوقف قليلا عندها.
فقد كتب أحمد البوني هذه الإجازة في أخريات أيامه. وبعد أن عرف علم الحديث قال إنه أخذه عن والده، محمد ساسي، ويحيى الشاوي وأحمد العيدلي الزواوي الملقب بالصديق، وأبي القاسم بن مالك اليراثني الزواوي أيضا، وهؤلاء جميعا من الجزائريين، كما ذكر غيرهم من التونسيين والمصريين والمغاربة. وقد بلغ الجميع ثلاثة عشر شيخا، واكتفى البوني بذلك منهم (خوف الإطالة) ثم ذكر كتب الحديث التي أخذها عن هؤلاء، وفصل القول فيها. وعدد أيضا بعض تآليفه، ثم أحال القارئ على كتابه (التعريف). والإجازة التي اطلعنا عليها مكتوبة سنة 1140 أي بعد وفاته مباشرة (2) وقد قال الكتاني ان النسخة التي اطلع عليها منها تقع في نحو أربع كراريس (اشتملت على فوائد وغرائب عدد فيها شيوخه وأسانيد الستة وبعض المصنفات المتداولة في العلوم أتمها سنة 1136) (3).
وهكذا يتبين أن أسرة البوني قد جمعت بين العلم والصلاح وسيطرت روحيا على عنابة ونواحيها مدة طويلة بلغت القرنين تقريبا. ومن أبرز أعضائها محمد ساسي وأحمد ساسي وأحمد الزروق. ولكن أكثرهم شهرة وتأليفا وعناية بالحديث هو أحمد البوني. كما أن أسرة البوني كانت على علاقة طيبة مع العثمانيين حفاظا على المصلحة المشتركة التي تعرضنا لها في فصل آخر. وقد ساهمت هذه الأسرة وغيرها من الأسر العلمية الجزائرية في
__________
(1) أشرنا في الإجازات إلى أن الجعفري قد أجاز بدوره تلميذه شعبان بن عباس المعروف بابن عبد الجليل أو جلول. انظرها.
(2) اطلعنا عليها في زاوية طولقة، وطلبنا من الأستاذ عبد القادر العثماني مدير المعهد/ الزاوية نسخة منها، فوعد بذلك. والإجازة من نسخ مبارك بن محمد القلعي القسنطيني، وتقع في حوالي ثلاثين ورقة.
(3) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 171.
فقد كتب أحمد البوني هذه الإجازة في أخريات أيامه. وبعد أن عرف علم الحديث قال إنه أخذه عن والده، محمد ساسي، ويحيى الشاوي وأحمد العيدلي الزواوي الملقب بالصديق، وأبي القاسم بن مالك اليراثني الزواوي أيضا، وهؤلاء جميعا من الجزائريين، كما ذكر غيرهم من التونسيين والمصريين والمغاربة. وقد بلغ الجميع ثلاثة عشر شيخا، واكتفى البوني بذلك منهم (خوف الإطالة) ثم ذكر كتب الحديث التي أخذها عن هؤلاء، وفصل القول فيها. وعدد أيضا بعض تآليفه، ثم أحال القارئ على كتابه (التعريف). والإجازة التي اطلعنا عليها مكتوبة سنة 1140 أي بعد وفاته مباشرة (2) وقد قال الكتاني ان النسخة التي اطلع عليها منها تقع في نحو أربع كراريس (اشتملت على فوائد وغرائب عدد فيها شيوخه وأسانيد الستة وبعض المصنفات المتداولة في العلوم أتمها سنة 1136) (3).
وهكذا يتبين أن أسرة البوني قد جمعت بين العلم والصلاح وسيطرت روحيا على عنابة ونواحيها مدة طويلة بلغت القرنين تقريبا. ومن أبرز أعضائها محمد ساسي وأحمد ساسي وأحمد الزروق. ولكن أكثرهم شهرة وتأليفا وعناية بالحديث هو أحمد البوني. كما أن أسرة البوني كانت على علاقة طيبة مع العثمانيين حفاظا على المصلحة المشتركة التي تعرضنا لها في فصل آخر. وقد ساهمت هذه الأسرة وغيرها من الأسر العلمية الجزائرية في
__________
(1) أشرنا في الإجازات إلى أن الجعفري قد أجاز بدوره تلميذه شعبان بن عباس المعروف بابن عبد الجليل أو جلول. انظرها.
(2) اطلعنا عليها في زاوية طولقة، وطلبنا من الأستاذ عبد القادر العثماني مدير المعهد/ الزاوية نسخة منها، فوعد بذلك. والإجازة من نسخ مبارك بن محمد القلعي القسنطيني، وتقع في حوالي ثلاثين ورقة.
(3) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 171.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الإنتاج الفقهي أيضا مساهمة واضحة.
الفقه
وعندما نتحدث عن الإنتاج الفقهي في الجزائر فمن الطبيعي أننا سنركز على إنتاج الفقه المالكي. ذلك أن معظم سكان الجزائر يتبعون مذهب الإمام مالك. ولكن منذ مجيء العثمانيين انتشر المذهب الحنفي أيضا، كما عرفنا، وظهر علماء كتبوا ودرسوا وأفتوا على قواعد الإمام أبي حنيفة. وإذا كانت معظم التآليف في أصول وفروع الإمام مالك فإن ذلك لا يعني حينئذ أنه لم يكن لعلماء المذهب الحنفي تآليف وآراء. فأسرة ابن العنابي كانت حنفية وقد تركت بعض التآليف الهامة. وعبد القادر الراشدي كان مفتي الحنفية وألف أيضا في ذلك. والشاعر المفتي ابن علي كان على المذهب الحنفي وقد كان له تأثير في الحياة الأدبية، بالإضافة إلى الفقه، كما سنعرف، لذلك فإننا سنتعرض لإنتاج الفقهاء الجزائريين سواء كانوا على مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك. ومن جهة أخرى فإن بعض علماء الإباضية في الجزائر قد ألفوا أعمالا في الفقه على مذهبهم جديرة بالدرس، وهي جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي الجزائري.
ورغم الجو المحافظ الذي كان يسود الجزائر خلال العهد العثماني فإن بعض الفقهاء كانوا (متحررين) في تناولهم للمسائل الفقهية ولقضايا العصر والحياة الاجتماعية بصفة عامة، حقا إن أساس الانطلاق في التفكير الفقهي هو مختصر خليل على الخصوص ثم مختصر ابن الحاجب والرسالة، ولكن بعض الفقهاء كانوا يفسرون هذه المصادر تفسيرا غير جامد إذا ما اعترض طريقهم معترض، ويمكن أن نذكر من هؤلاء (المتحررين) عبد الكريم الفكون، وأحمد المقري ويحيى الشاوي وأحمد بن عمار. أما من الحنفية فنذكر ابن علي وابن العنابي وعبد القادر الراشدي، وقد كان بعض الفقهاء يفتي أيضا بالشاذ كما عرفنا، ووقف آخرون من الدخان والقهوة والموسيقى
الفقه
وعندما نتحدث عن الإنتاج الفقهي في الجزائر فمن الطبيعي أننا سنركز على إنتاج الفقه المالكي. ذلك أن معظم سكان الجزائر يتبعون مذهب الإمام مالك. ولكن منذ مجيء العثمانيين انتشر المذهب الحنفي أيضا، كما عرفنا، وظهر علماء كتبوا ودرسوا وأفتوا على قواعد الإمام أبي حنيفة. وإذا كانت معظم التآليف في أصول وفروع الإمام مالك فإن ذلك لا يعني حينئذ أنه لم يكن لعلماء المذهب الحنفي تآليف وآراء. فأسرة ابن العنابي كانت حنفية وقد تركت بعض التآليف الهامة. وعبد القادر الراشدي كان مفتي الحنفية وألف أيضا في ذلك. والشاعر المفتي ابن علي كان على المذهب الحنفي وقد كان له تأثير في الحياة الأدبية، بالإضافة إلى الفقه، كما سنعرف، لذلك فإننا سنتعرض لإنتاج الفقهاء الجزائريين سواء كانوا على مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك. ومن جهة أخرى فإن بعض علماء الإباضية في الجزائر قد ألفوا أعمالا في الفقه على مذهبهم جديرة بالدرس، وهي جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي الجزائري.
ورغم الجو المحافظ الذي كان يسود الجزائر خلال العهد العثماني فإن بعض الفقهاء كانوا (متحررين) في تناولهم للمسائل الفقهية ولقضايا العصر والحياة الاجتماعية بصفة عامة، حقا إن أساس الانطلاق في التفكير الفقهي هو مختصر خليل على الخصوص ثم مختصر ابن الحاجب والرسالة، ولكن بعض الفقهاء كانوا يفسرون هذه المصادر تفسيرا غير جامد إذا ما اعترض طريقهم معترض، ويمكن أن نذكر من هؤلاء (المتحررين) عبد الكريم الفكون، وأحمد المقري ويحيى الشاوي وأحمد بن عمار. أما من الحنفية فنذكر ابن علي وابن العنابي وعبد القادر الراشدي، وقد كان بعض الفقهاء يفتي أيضا بالشاذ كما عرفنا، ووقف آخرون من الدخان والقهوة والموسيقى
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
والزندقة ونحوها من القضايا موقفا مرنا بينما وقف منها آخرون موقفا صلبا، وقد وجدنا بعض الفقهاء قد غلب عليهم الأدب فقالوا الشعر في الغزل ونحوه كما فعل ابن علي، وهو أستاذ ابن عمار. ولكن بعض الفقهاء قد غلب عليهم التصوف والدروشة فانعزلوا عن المجتمع وعاشوا في تفكيرهم الضيق وأهملوا الدين الصحيح العملي. وقد ذكرنا نماذج من هؤلاء وأولئك في الجزء الأول.
وليس بوسعنا في هذا المجال أن نعرض لكل إنتاج الفقهاء من تآليف مطولة ومختصرة خلال ثلاثة قرون. إن محاولة ذلك تكاد تكون مستحيلة. فالإنتاج غزير ومتعدد المشارب تعدد قضايا الفقه نفسها. ومن جهة أخرى فنحن لم نطلع على كل هذا الإنتاج الذي لا يكاد يخلو منه زمن ولا مكتبة. ثم إن بعض هذا الإنتاج لا يستحق الدراسة لكونه تكرارا أو استنساخا. ويكاد كل من جلس من الفقهاء لتدريس الفقه يملي أو يؤلف لتلاميذه كراسة أو أكثر شرحا أو حاشية على مختصر خليل وما في معناه كالرسالة، حتى كثرت هذه الإملاءات والتأليف كثرة المدرسين أنفسهم. ولكننا لا نكاد نعثر على جديد في ذلك لا في الفكرة ولا في المنهج. فالفقيه كان بالدرجة الأولى يحاول أن يفيد طلابه الحاضرين ولم يكن يؤلف لغيرهم من العلماء أو من الأجيال التالية. وسنرى أن هذه الظاهر تتكرر في النحو أيضا وغيره من المواد ذات الطابع التدرسي. فهذه المواد قد غلب عليها ما يمكن أن نسميه بمرض الشرح والحاشية، وهو في الواقع مرض العلم في العصر كله.
ونود أن ننبه إلى أننا نتناول هنا الفقه بمعناه الواسع الذي يشمل الأصول والفرائض والفتاوى والأحكام وغيرها مما يتصل بالعبادات والمعاملات. وقد جعلنا ذلك كله تحت عنوانين الأول التآليف الفقهية، والثاني الفتاوى والآراء.
الأثار الفقهية:
ومن الملاحظ سيطرة مختصر الشيخ خليل على مختلف الدراسات
وليس بوسعنا في هذا المجال أن نعرض لكل إنتاج الفقهاء من تآليف مطولة ومختصرة خلال ثلاثة قرون. إن محاولة ذلك تكاد تكون مستحيلة. فالإنتاج غزير ومتعدد المشارب تعدد قضايا الفقه نفسها. ومن جهة أخرى فنحن لم نطلع على كل هذا الإنتاج الذي لا يكاد يخلو منه زمن ولا مكتبة. ثم إن بعض هذا الإنتاج لا يستحق الدراسة لكونه تكرارا أو استنساخا. ويكاد كل من جلس من الفقهاء لتدريس الفقه يملي أو يؤلف لتلاميذه كراسة أو أكثر شرحا أو حاشية على مختصر خليل وما في معناه كالرسالة، حتى كثرت هذه الإملاءات والتأليف كثرة المدرسين أنفسهم. ولكننا لا نكاد نعثر على جديد في ذلك لا في الفكرة ولا في المنهج. فالفقيه كان بالدرجة الأولى يحاول أن يفيد طلابه الحاضرين ولم يكن يؤلف لغيرهم من العلماء أو من الأجيال التالية. وسنرى أن هذه الظاهر تتكرر في النحو أيضا وغيره من المواد ذات الطابع التدرسي. فهذه المواد قد غلب عليها ما يمكن أن نسميه بمرض الشرح والحاشية، وهو في الواقع مرض العلم في العصر كله.
ونود أن ننبه إلى أننا نتناول هنا الفقه بمعناه الواسع الذي يشمل الأصول والفرائض والفتاوى والأحكام وغيرها مما يتصل بالعبادات والمعاملات. وقد جعلنا ذلك كله تحت عنوانين الأول التآليف الفقهية، والثاني الفتاوى والآراء.
الأثار الفقهية:
ومن الملاحظ سيطرة مختصر الشيخ خليل على مختلف الدراسات
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الفقهية المالكية في الجزائر. فإذا حكمنا من أنواع الشرح والحواشي التي وضعت حوله كدنا نقول بأنه يأتي في المقام الثالث بعد القرآن الكريم وصحيح البخاري، بل إننا إذا حكمنا من وفرة الإنتاج حوله وجدناه يفوق الأولين عدا. فقد عرفنا أن التآليف المتعلقة بالتفسير والحديث كانت في جملتها قليلة وغير أصيلة. ولم يكن خليل بن إسحاق مصدرا للفقه والتشريع في الجزائر فحسب بل كان مصدرا للتبرك به أيضا. ولعل هذه النظرة الصوفية هي التي جعلت الفقهاء، وقد غلب على أكثرهم التصوف، يخلطون بين خليل الفقيه المشرع وبين خليل الصوفي الدرويش. فهذا ابن مريم، صاحب (البستان)، قد ترجم في القرن الحادي عشر لخليل بن إسحاق المصري في كتاب يتناول علماء وصلحاء تلمسان (تبركا به) (1). وهذا في الواقع يدل على تحول في الدراسات الفقهية نفسها. فيحيى بن موسى المغيلي المازوني صاحب (نوازل مازونة)، الذي عاش في القرن التاسع لم يكد يذكر الشيخ خليل في مؤلفه، على طوله وأهميته، بل كان يستمد آراءه ونوازله من وحي العصر ومن مصادر الفقه الإسلامي الأخرى (2).
أنجبت تلمسان في عهودها الزاهرة أعظم الفقهاء الذين عرفتهم الجزائر تدريسا وتأليفا. وفي بداية العهد العثماني وطيلة القرن العاشر جلبت فاس إليها معظم الباقين في تلمسان ونواحيها. ومن أبرز العائلات العلمية التلمسانية التي اهتمت بالفقه عائلة الونشريسي والمغيلي والمقري والعقباني. ومعظم أفراد هذه العائلات كانوا يترددون بين تلمسان وفاس كما عرفنا. وقد ظلت مازونة أيضا تنافس تلمسان في ميدان الفقه، فأنجبت هي الأخرى بعض رجال هذا العلم، ومن أهم خريجي مدرستها في آخر العهد العثماني أبو راس الناصر.
أما الشرق الجزائري ففقهاؤه المؤلفون قليلون بالقياس إلى غيره.
__________
(1) (البستان)، 96.
(2) جاك بيرك، دراسة عن النوازل في مجلة (أنال) سبتمبر - أكتوبر 1970، 1330.
أنجبت تلمسان في عهودها الزاهرة أعظم الفقهاء الذين عرفتهم الجزائر تدريسا وتأليفا. وفي بداية العهد العثماني وطيلة القرن العاشر جلبت فاس إليها معظم الباقين في تلمسان ونواحيها. ومن أبرز العائلات العلمية التلمسانية التي اهتمت بالفقه عائلة الونشريسي والمغيلي والمقري والعقباني. ومعظم أفراد هذه العائلات كانوا يترددون بين تلمسان وفاس كما عرفنا. وقد ظلت مازونة أيضا تنافس تلمسان في ميدان الفقه، فأنجبت هي الأخرى بعض رجال هذا العلم، ومن أهم خريجي مدرستها في آخر العهد العثماني أبو راس الناصر.
أما الشرق الجزائري ففقهاؤه المؤلفون قليلون بالقياس إلى غيره.
__________
(1) (البستان)، 96.
(2) جاك بيرك، دراسة عن النوازل في مجلة (أنال) سبتمبر - أكتوبر 1970، 1330.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ورغم شهرة بعضهم في التدريس والتأليف فإنه لا أحد منهم يضاهي مثلا أحمد الونشريسي في مؤلفاته الفقهية. وإذا كانت فاس قد امتصت عددا من علماء الجزائر خلال العهد العثماني فإن تونس لم تفعل ذلك لأن البلدين كانا يخضعان لنفس النظام السياسي. ولكن تونس كانت معبرا يعبره العلماء الجزائريون في رحلتهم إلى الحج أو طلب العلم في المشرق الإسلامي، فعبرها أحمد المقري وأبو راس ومحمد بن العنابي وأحمد البوني وأحمد بن عمار. وقد امتصت عواصم المشرق أيضا عددا من هؤلاء العلماء كما عرفنا.
رغم مكانة بعض علماء مدينة الجزائر العلمية فإن أحدا منهم لم يستطع أن ينافس في الفقهيات زملاءهم علماء غرب الجزائر أو شرقها. فإذا انحدرنا جنوبا وجدنا عبد العزيز الثميني قد جاء بعمل في الفقه الإباضي جدير بأن يقاس بعمل الونشريسي في الفقه المالكي. كما أن خليفة بن حسن بقمار قد تميز بنظمه لخليل ولفت إليه الأنظار بمساهمته في الفقه عموما. ولكن مهما قيل في هذا التوزيع الجغرافي للإنتاج الفقهي فإنه لا يدل إلا على خطوط سريعة قد تظهر الأيام أعمالا أخرى تعدل من هذه الخريطة.
ولنبدأ إذن بمدرسة تلمسان. ويجب أن ننبه هنا إلى أننا لا نعني تلمسان المدينة فقط ولكن تلمسان باعتبارها مدرسة لتخريج المثقفين والمشرعين. وعلى هذا الأساس يقف أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد في طليعة فقهائها. الأول في كتبه التي تعرضنا إليها (1). والثاني في كتبه (النور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن أنس) الذي لخص فيه كتاب والده (إيضاح السالك)، وشرحه على مختصر ابن الحاجب الفقهي الذي جعله في أربعة مجلدات، وشرحه المطول على الرسالة. ولكن عبد الواحد لا يمكن أن يقاس بوالده في الفقه، فقد تغلبت عليه روح الأدب أيضا، فكان شاعرا مجيدا (لا يقارعه أحد من أهل عصره) (2). وكانت له أيضا أزجال وموشحات
__________
(1) انظر ذلك في الفصل الأول من الجزء الأول.
(2) (سلوة الأنفاس) 4/ 146. وقد تولى عبد الواحد الونشريسي وظائف علمية عالية في المغرب كالفتوى والخطابة والتدريس.
رغم مكانة بعض علماء مدينة الجزائر العلمية فإن أحدا منهم لم يستطع أن ينافس في الفقهيات زملاءهم علماء غرب الجزائر أو شرقها. فإذا انحدرنا جنوبا وجدنا عبد العزيز الثميني قد جاء بعمل في الفقه الإباضي جدير بأن يقاس بعمل الونشريسي في الفقه المالكي. كما أن خليفة بن حسن بقمار قد تميز بنظمه لخليل ولفت إليه الأنظار بمساهمته في الفقه عموما. ولكن مهما قيل في هذا التوزيع الجغرافي للإنتاج الفقهي فإنه لا يدل إلا على خطوط سريعة قد تظهر الأيام أعمالا أخرى تعدل من هذه الخريطة.
ولنبدأ إذن بمدرسة تلمسان. ويجب أن ننبه هنا إلى أننا لا نعني تلمسان المدينة فقط ولكن تلمسان باعتبارها مدرسة لتخريج المثقفين والمشرعين. وعلى هذا الأساس يقف أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد في طليعة فقهائها. الأول في كتبه التي تعرضنا إليها (1). والثاني في كتبه (النور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن أنس) الذي لخص فيه كتاب والده (إيضاح السالك)، وشرحه على مختصر ابن الحاجب الفقهي الذي جعله في أربعة مجلدات، وشرحه المطول على الرسالة. ولكن عبد الواحد لا يمكن أن يقاس بوالده في الفقه، فقد تغلبت عليه روح الأدب أيضا، فكان شاعرا مجيدا (لا يقارعه أحد من أهل عصره) (2). وكانت له أيضا أزجال وموشحات
__________
(1) انظر ذلك في الفصل الأول من الجزء الأول.
(2) (سلوة الأنفاس) 4/ 146. وقد تولى عبد الواحد الونشريسي وظائف علمية عالية في المغرب كالفتوى والخطابة والتدريس.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
مما أدى إلى مقتله سنة 995 (1).
وكاد يحدث لمحمد بن عبد الكريم المغيلي ما حدث لعبد الواحد الونشريسي. فقد كان المغيلي أيضا يتدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية ليس في المغرب فحسب بل في إفريقية جنوب الصحراء أيضا (2) فنصح أمراء السودان وقاوم نفوذ اليهود ولا سيما في توات، وكان كثير المراسلات مع علماء عصره في القضايا التي كانت تهمه. وهو لهذا كان في حاجة إلى آراء الفقهاء فيما كان بصدده من مشاكل. وقد ألف هو عدة تآليف في الفقه أيضا منها (شرح مختصر خليل) وحاشية عليه أيضا، وشرح آخر على بيوع الآجال من ابن الحاجب. وإذا حكمنا على ما اطلعنا عليه له من تآليف في غير الفقه حكمنا بأن تآليفه صغيرة الحجم ومطبوعة بمزاجه الحاد وحركته الدائبة. ولعل له في الفقه آراء صائبة تتماشى مع مزاجه أيضا في تفسير مختصر خليل بالخصوص.
وقد جعل الشيخ مصطفى الرماصي (حاشية على شرح التتائي لمختصر خليل) (3) وكان من الفقهاء البارزين في وقته، أما الذي خدم مختصر خليل خدمة كبيرة محمد بن عبد الرحمن بن الحاج اليبدري التلمساني صاحب (ياقوتة الحواشي على شرح الإمام الخراشي) التي تقع في أربعة أجزاء كبار.
وقد اطلعنا نحن على نسخة من هذه الحاشية بخط مؤلفها وهو خط جيد وجميل. ومما قاله في آخر القسم الأول (قال كاتبه ومؤلفه كان الفراغ من تبييض هذه الحاشية المباركة في شهر الله جمادي الأولى سنة اثنين وسبعين ومائة وألف على يد كاتبه ومؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن الحاج اليبدري وفقه الله). ولكننا وجدنا في آخر الجزء الرابع منه هذه العبارة (هذا ما يسر الله تعالى من هذه الحاشية .. وكان الفراغ من تبييضها 6 شعبان سنة 1179).
__________
(1) انظر عنه أيضا (الإعلام بمن حل بمراكش) 4/ 157.
(2) عن المغيلي انظر الفصل الأول من الجزء الأول.
(3) توجد منه نسخة في مكتبة تطوان رقم 9.
وكاد يحدث لمحمد بن عبد الكريم المغيلي ما حدث لعبد الواحد الونشريسي. فقد كان المغيلي أيضا يتدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية ليس في المغرب فحسب بل في إفريقية جنوب الصحراء أيضا (2) فنصح أمراء السودان وقاوم نفوذ اليهود ولا سيما في توات، وكان كثير المراسلات مع علماء عصره في القضايا التي كانت تهمه. وهو لهذا كان في حاجة إلى آراء الفقهاء فيما كان بصدده من مشاكل. وقد ألف هو عدة تآليف في الفقه أيضا منها (شرح مختصر خليل) وحاشية عليه أيضا، وشرح آخر على بيوع الآجال من ابن الحاجب. وإذا حكمنا على ما اطلعنا عليه له من تآليف في غير الفقه حكمنا بأن تآليفه صغيرة الحجم ومطبوعة بمزاجه الحاد وحركته الدائبة. ولعل له في الفقه آراء صائبة تتماشى مع مزاجه أيضا في تفسير مختصر خليل بالخصوص.
وقد جعل الشيخ مصطفى الرماصي (حاشية على شرح التتائي لمختصر خليل) (3) وكان من الفقهاء البارزين في وقته، أما الذي خدم مختصر خليل خدمة كبيرة محمد بن عبد الرحمن بن الحاج اليبدري التلمساني صاحب (ياقوتة الحواشي على شرح الإمام الخراشي) التي تقع في أربعة أجزاء كبار.
وقد اطلعنا نحن على نسخة من هذه الحاشية بخط مؤلفها وهو خط جيد وجميل. ومما قاله في آخر القسم الأول (قال كاتبه ومؤلفه كان الفراغ من تبييض هذه الحاشية المباركة في شهر الله جمادي الأولى سنة اثنين وسبعين ومائة وألف على يد كاتبه ومؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن الحاج اليبدري وفقه الله). ولكننا وجدنا في آخر الجزء الرابع منه هذه العبارة (هذا ما يسر الله تعالى من هذه الحاشية .. وكان الفراغ من تبييضها 6 شعبان سنة 1179).
__________
(1) انظر عنه أيضا (الإعلام بمن حل بمراكش) 4/ 157.
(2) عن المغيلي انظر الفصل الأول من الجزء الأول.
(3) توجد منه نسخة في مكتبة تطوان رقم 9.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وهذا يدل على أن اليبدري قد بدأ عمله قبل سنة 1172 وانتهى منه تصحيحا وتنقيحا سنة 1179.
وقد أوضح في البداية دافع تأليفه لحاشية طويلة على شرح الخرشي على خليل. فقال إن هذا الشرح رغم شيوعه بين الناس ورغم (كثرة خيراته وخلوه من الحشو) فإنه مفرط في الإيجاز حتى كاد يكون من الألغاز (فلا يهتدي إلى فوائده إلا بتعب وعناية، ولا يستكشف خفيات أسراره إلا بنظر دقيق ودراية). وهناك عامل آخر دفع اليبدري إلى القيام بعمله وهو أن العصر كان عصر مشاغل شغلت العلماء عن البحث وطلب الصعب من المسائل حتى عجزوا عن إدراك خفايا مختصر خليل وشرحه. فالهمم (قد ضعفت .. في هذا الزمان، وكثرت فيه الهموم والأحزان، وقل فيه الساعون من الأخوان، خصوصا بلدنا تلمسان) فقصروا عن فهم أسراره وإدراك عبارته وخفاياه. أما العامل الثالث لتأليفه فهو أن بعض زملائه قد طلبوا منه ذلك فلم يسعه إلا الاستجابة، وقد وصف هؤلاء الزملاء بأنهم طلاب حقيقة فرجوه أن يضع على شرح الخرشي حاشية (تبين ما خفي من معانيه، وتوضح ما أشكل من تراكيب كلامه ومبانيه، وتذلل المعاني الصعاب، وتميز القشر عن اللباب) فأجابهم إلى ذلك رغم انشغاله وقلقه و (كف الناظر) (1).
أما منهجه في هذا الكتاب فقد حاول أن يجعل الحاشية وسطا بين الإيجاز غير المخل والإطناب غير الممل، وخصوصا أنه جرده من الحشو. فقد قال إنه سلك فيه طريقة (الإيجاز غير المخل .. صارفا وجهي عن الإطالة بنقل الفروع .. معرضا عن التعرض لما ليس من مسائل الكتاب). عند شروعه في التحشية اتبع المنهج الذي كان سائدا في عصره أيضا فهو يفسر ألفاظ الشرح ملتزما الخطة التي ذكرها. ولم يقسم الكتاب إلى أبواب أو فصول وإنما اتبع في ذلك خطة الخرشي نفسه في المباحث التي وضعها.
__________
(1) قد تعني هذه العبارة أن المؤلف قد كف بصره، فإذا كان هذا صحيحا فإن العبارة لا تتماشى مع عبارته السابقة قال كاتبه ومؤلفه الخ.
وقد أوضح في البداية دافع تأليفه لحاشية طويلة على شرح الخرشي على خليل. فقال إن هذا الشرح رغم شيوعه بين الناس ورغم (كثرة خيراته وخلوه من الحشو) فإنه مفرط في الإيجاز حتى كاد يكون من الألغاز (فلا يهتدي إلى فوائده إلا بتعب وعناية، ولا يستكشف خفيات أسراره إلا بنظر دقيق ودراية). وهناك عامل آخر دفع اليبدري إلى القيام بعمله وهو أن العصر كان عصر مشاغل شغلت العلماء عن البحث وطلب الصعب من المسائل حتى عجزوا عن إدراك خفايا مختصر خليل وشرحه. فالهمم (قد ضعفت .. في هذا الزمان، وكثرت فيه الهموم والأحزان، وقل فيه الساعون من الأخوان، خصوصا بلدنا تلمسان) فقصروا عن فهم أسراره وإدراك عبارته وخفاياه. أما العامل الثالث لتأليفه فهو أن بعض زملائه قد طلبوا منه ذلك فلم يسعه إلا الاستجابة، وقد وصف هؤلاء الزملاء بأنهم طلاب حقيقة فرجوه أن يضع على شرح الخرشي حاشية (تبين ما خفي من معانيه، وتوضح ما أشكل من تراكيب كلامه ومبانيه، وتذلل المعاني الصعاب، وتميز القشر عن اللباب) فأجابهم إلى ذلك رغم انشغاله وقلقه و (كف الناظر) (1).
أما منهجه في هذا الكتاب فقد حاول أن يجعل الحاشية وسطا بين الإيجاز غير المخل والإطناب غير الممل، وخصوصا أنه جرده من الحشو. فقد قال إنه سلك فيه طريقة (الإيجاز غير المخل .. صارفا وجهي عن الإطالة بنقل الفروع .. معرضا عن التعرض لما ليس من مسائل الكتاب). عند شروعه في التحشية اتبع المنهج الذي كان سائدا في عصره أيضا فهو يفسر ألفاظ الشرح ملتزما الخطة التي ذكرها. ولم يقسم الكتاب إلى أبواب أو فصول وإنما اتبع في ذلك خطة الخرشي نفسه في المباحث التي وضعها.
__________
(1) قد تعني هذه العبارة أن المؤلف قد كف بصره، فإذا كان هذا صحيحا فإن العبارة لا تتماشى مع عبارته السابقة قال كاتبه ومؤلفه الخ.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
فهناك مبحث في الحج، وآخر في الزكاة، وآخر في النكاح، إلى غير ذلك من المباحث الفقهية المعروفة. وكثيرا ما كان المحشي يتدخل برأيه الخاص في الموضوع، وطريقته في ذلك هي أن يضيف عبارة (قلت) إلى النص (1). ونظن أن عمل اليبدري في حجمه ومنهجه يعتبر آخر تأليف في موضوعه أثناء العهد الذي ندرسه.
رقد أسهم في هذا الباب أيضا محمد الطالب الذي يقول عن نفسه إنه التلمساني منشأ ودارا الجزيري (الجزائري؟) أصلا ونجارا، بوضع شرح كبير على مختصر خليل سماه (فتح الجليل في شرح مختصر خليل). وقد نوه في الديباجة بعلم الفقه والأحكام وذكر أن مختصر خليل من أشهر التآليف في هذا العلم. وبرر لجوءه إلى وضع شرحه كون بعض من تناولوا خليل قد أطنبوا فيه، وبعضهم اختصروه اختصارا شديدا مثل الخرشي في شرحه الصغير. لذلك جاء هو (محمد الطالب) ليضع شرحا بين الإطناب الممل والإيجاز المخل، كما هي العبارة الشائعة عند الشراح. وقد اعتمد محمد الطالب على مصادر معينة ذكرها مثل حاشية البناني (وشيخ شيوخنا محمد المصطفى (الرماصي القلعي) في حاشيته)، وعلى الخرشي والشبرخيتي وعبد الباقي والأجهوري وابن غازي. وقد رمز إلى كل مؤلف من هؤلاء بحرف في صلب الكتاب. ويبدو أن محمد الطاب نفسه قد توسع فيما أراد الاختصار (2). وما دمنا نتحدث عن شروح خليل ودارسيه فلنذكر بأن عبد الرحمن المجاجي، الذي سبق ذكره، قد تناول أيضا أحكام المغارسة التي أهملها الشيخ خليل (3).
__________
(1) اطلعنا على هذا المخطوط في المكتبة الملكية بالرباط، رقم 1811.
(2) اطلعنا على نسخة المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2048، وهي غير كاملة، ومع ذلك بلغت 655 ورقة، وهي تنتهي بمسائل الحج، وخطه صعب القراءة ولعله هو خط المؤلف، والظاهر أن محمد الطالب من أهل القرن الثاني عشر.
(3) نسخة منه في الخزانة العامة - الرباط رقم (1) 459، ويغلب على الظن أن هذا التأليف مطبوع في فاس طبعة حجرية.
رقد أسهم في هذا الباب أيضا محمد الطالب الذي يقول عن نفسه إنه التلمساني منشأ ودارا الجزيري (الجزائري؟) أصلا ونجارا، بوضع شرح كبير على مختصر خليل سماه (فتح الجليل في شرح مختصر خليل). وقد نوه في الديباجة بعلم الفقه والأحكام وذكر أن مختصر خليل من أشهر التآليف في هذا العلم. وبرر لجوءه إلى وضع شرحه كون بعض من تناولوا خليل قد أطنبوا فيه، وبعضهم اختصروه اختصارا شديدا مثل الخرشي في شرحه الصغير. لذلك جاء هو (محمد الطالب) ليضع شرحا بين الإطناب الممل والإيجاز المخل، كما هي العبارة الشائعة عند الشراح. وقد اعتمد محمد الطالب على مصادر معينة ذكرها مثل حاشية البناني (وشيخ شيوخنا محمد المصطفى (الرماصي القلعي) في حاشيته)، وعلى الخرشي والشبرخيتي وعبد الباقي والأجهوري وابن غازي. وقد رمز إلى كل مؤلف من هؤلاء بحرف في صلب الكتاب. ويبدو أن محمد الطاب نفسه قد توسع فيما أراد الاختصار (2). وما دمنا نتحدث عن شروح خليل ودارسيه فلنذكر بأن عبد الرحمن المجاجي، الذي سبق ذكره، قد تناول أيضا أحكام المغارسة التي أهملها الشيخ خليل (3).
__________
(1) اطلعنا على هذا المخطوط في المكتبة الملكية بالرباط، رقم 1811.
(2) اطلعنا على نسخة المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2048، وهي غير كاملة، ومع ذلك بلغت 655 ورقة، وهي تنتهي بمسائل الحج، وخطه صعب القراءة ولعله هو خط المؤلف، والظاهر أن محمد الطالب من أهل القرن الثاني عشر.
(3) نسخة منه في الخزانة العامة - الرباط رقم (1) 459، ويغلب على الظن أن هذا التأليف مطبوع في فاس طبعة حجرية.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وفي العاصمة اعتنى بعض الفقهاء بالتأليف في خليل أيضا وفي المسائل الفقهية على العموم. ومن هؤلاء سعيد قدورة ومحمد بن عبد المؤمن. ولكننا لم نطلع على عمل لهما في مستوى عمل اليبدري مثلا. فقدورة، الذي كاد يكون له شرح أو حاشية على كل مسألة كان يدرسها للطلاب، قد وضع أيضا شرحا على خطبة المختصر لخليل (1)، كما وضع حاشية على شرح اللقاني لخطبة خليل (2). وقد حاول محمد بن عبد المؤمن، وهو أديب وشاعر أيضا، وضع أرجوزة جمع فيها بين العقائد والفروع الفقهية، وهي تقع في نحو تسعة وسبعين بيتا. وهي أرجوزة سهلة واضحة تدل على تمكن صاحبها من صناعة النظم. وكان قد طلب من ابن زاكور، الذي أجازه بها، أن يشرحها إذا تمكن (3). ولكننا لا ندري ما إذا تمكن ابن زاكور من ذلك، كما أننا لا ندري ما إذا كان الناظم نفسه قد قام بشرحها، وخصوصا الجزء الخاص بالفروع، وهو الذي يهمنا هنا. ولكن مهما بلغت براعة ابن عبد المؤمن في النظم والتمكن من الفقه فإن عمله ليس بذي بال إذا وضع إلى جانب أعمال الونشريسي أو الثميني أو اليبدري.
وقد عرف إقليم قسنطينة مشاركة أيضا في الفقه وفروعه. وكانت مدن قسنطينة وبجاية وعنابة وبسكرة مركز هذا النشاط. فقد وضع يحيى الفكون حاشية على المدونة ضمنها، كما قال حفيده عبد الكريم الفكون، نوازل ووقائع قل أن توجد في المطولات. وقد أكملها لأن حفيده يقول انها مسودة بخطه، أي خط المؤلف نفسه. وكان يحيى الفكون من فقهاء قسنطينة ولكنه التجأ إلى تونس، على كبر سنه، أثناء الاضطرابات التي حدثت في بلاده. وفي تونس تولى الفتوى والإمامة بجامع الزيتونة. بينما كان ابنه قاسم الفكون متوليا إمامة جامع سوق البلاط بتونس أيضا. وقد رجع قاسم الفكون إلى
__________
(1) رقم 370، خزانة ابن يوسف بمراكش.
(2) رقم 275، مكتبة تطوان، ضمن مجموع، وأيضا الخزانة العامة بالرباط، رقم 2758 د.
(3) ابن زاكور، 17 - 21.
وقد عرف إقليم قسنطينة مشاركة أيضا في الفقه وفروعه. وكانت مدن قسنطينة وبجاية وعنابة وبسكرة مركز هذا النشاط. فقد وضع يحيى الفكون حاشية على المدونة ضمنها، كما قال حفيده عبد الكريم الفكون، نوازل ووقائع قل أن توجد في المطولات. وقد أكملها لأن حفيده يقول انها مسودة بخطه، أي خط المؤلف نفسه. وكان يحيى الفكون من فقهاء قسنطينة ولكنه التجأ إلى تونس، على كبر سنه، أثناء الاضطرابات التي حدثت في بلاده. وفي تونس تولى الفتوى والإمامة بجامع الزيتونة. بينما كان ابنه قاسم الفكون متوليا إمامة جامع سوق البلاط بتونس أيضا. وقد رجع قاسم الفكون إلى
__________
(1) رقم 370، خزانة ابن يوسف بمراكش.
(2) رقم 275، مكتبة تطوان، ضمن مجموع، وأيضا الخزانة العامة بالرباط، رقم 2758 د.
(3) ابن زاكور، 17 - 21.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
قسنطينة وتولى بها القضاء بعد وفاة والده قتيلا بتونس سنة 941 (1). وهناك تعليق صغير كتبه عمر الوزان على قول خليل (وخصصت نية الحالف) (2). وكذلك كتب يحيى بن سليمان المعروف بالأوراسي بعض التقاييد. وكان قد تولى الافتاء. والتدريس بقسنطينة كما عرفنا، غير أن اشتغاله بالتصوف ثم لجوءه الى الثورة ضد العثمانيين قد سبب اضطرابا في حياته العلمية (3).
ومن جهة أخرى قام عبد الرحمن الأخضري بوضع مختصر في فقه العبادات (4)، وهو المختصر الذي شرحه عبد اللطيف المسبح شرحا كان موضع نقد عبد الكريم الفكون (الحفيد) الذي عمد إلى شرح مختصر الأخضري أيضا. وقد سمى الفكون شرحه (الدرر على المختصر) قائلا عنه (نبهنا على فوائد فيه لم توجد في المطولات، ونكت حسان قل أن تلفى في غير، وتنبيهات وفروع. وربما نبهنا على ما طغى به قلم شارحه المذكور (يعني المسبح). أما شرح المسبح على المختصر للاخضري فلا نعرف عنوانه الآن.
وقد اعتنى الشيخ موسىى الفكيرين القسنطيني بالتوضيح لابن الحاجب خصوصا، فكان له إدراك لأبحاثه حتى قيل إنه كان (آخر مدرس في ابن الحاجب في قسنطينة، لم يدرس فيه أحد البتة (بعده) بل كثر الاعتناء بالمختصر الخليلي) (5).
__________
(1) (منشور الهداية) 12 - 15. ضرب أحد الجنود الشيخ يحيى الفكون فقتله وكان ذلك أيام غارة شارلكان على تونس، انظر أيضا ترجمتنا لعبد الكريم الفكون في الفصل 5 من الجزء الأول. وكذلك (منشور الهداية).
(2) نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا) رقم 178 مجموع.
(3) (منشور الهداية)، 26 - 28.
(4) مطبوع في كتيب بالجزائر، 1342، ويذكر الجيلالي 2/ 328 أن شرح المسبح على مختصر الأخضري مطبوع بمصر.
(5) الوزير السراج (الحلل السندسية في الأخبار التونسية) 2/ 248. وقد توفي الفكيرين بقسنطينة بالطاعون سنة 1954. انظر عنه أيضا (منشور الهداية).
ومن جهة أخرى قام عبد الرحمن الأخضري بوضع مختصر في فقه العبادات (4)، وهو المختصر الذي شرحه عبد اللطيف المسبح شرحا كان موضع نقد عبد الكريم الفكون (الحفيد) الذي عمد إلى شرح مختصر الأخضري أيضا. وقد سمى الفكون شرحه (الدرر على المختصر) قائلا عنه (نبهنا على فوائد فيه لم توجد في المطولات، ونكت حسان قل أن تلفى في غير، وتنبيهات وفروع. وربما نبهنا على ما طغى به قلم شارحه المذكور (يعني المسبح). أما شرح المسبح على المختصر للاخضري فلا نعرف عنوانه الآن.
وقد اعتنى الشيخ موسىى الفكيرين القسنطيني بالتوضيح لابن الحاجب خصوصا، فكان له إدراك لأبحاثه حتى قيل إنه كان (آخر مدرس في ابن الحاجب في قسنطينة، لم يدرس فيه أحد البتة (بعده) بل كثر الاعتناء بالمختصر الخليلي) (5).
__________
(1) (منشور الهداية) 12 - 15. ضرب أحد الجنود الشيخ يحيى الفكون فقتله وكان ذلك أيام غارة شارلكان على تونس، انظر أيضا ترجمتنا لعبد الكريم الفكون في الفصل 5 من الجزء الأول. وكذلك (منشور الهداية).
(2) نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا) رقم 178 مجموع.
(3) (منشور الهداية)، 26 - 28.
(4) مطبوع في كتيب بالجزائر، 1342، ويذكر الجيلالي 2/ 328 أن شرح المسبح على مختصر الأخضري مطبوع بمصر.
(5) الوزير السراج (الحلل السندسية في الأخبار التونسية) 2/ 248. وقد توفي الفكيرين بقسنطينة بالطاعون سنة 1954. انظر عنه أيضا (منشور الهداية).
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وقد عرفنا أن معظم مؤلفات البوني في الفقه كانت نظما أو مختصرة.
وبينما كان زملاؤه العلماء يحاولون شرح مختصر خليل وتوضيحه عمد البوني إلى نظم مسائل خليل. ولا شك أنه بذلك قد سهل حفظه على التلاميذ ولكنه لم يساعدهم على فهمه واستيعابه. ومن الذين نظموا مختصر خليل أيضا خليفة بن حسن القماري الآتي ذكره. وهناك رجز في الفقه نظمه أحمد الطيب الرحموني أحد أتباع الطريقة الرحمانية. وقد قيل إن هذا الرجز كان مستعملا بين قضاة جرجرة. وكان الرحموني مدرسا في الزاوية الرحمانية بآيت إسماعيل، وقد نظم رجزه سنة 1212 (1).
عبد العزيز الثميني:
والمؤلف الذي يمكن أن يقاس عمله في الفقه الإباضي بعمل أحمد الونشريسي في الفقه المالكي، هو عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني. ولا تظهر حياة الثميني الأولى أي شيء غير عادي فيه. فقد ولد في بني يزقن بميزاب سنة 1130 وتعلم، كما يتعلم أمثاله في ذلك الوقت، فحفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم، وحين بلغ سن النضج دخل التجارة على عادة الميزابيين عموما. وسيكون لهذه المهنة أثرها على آرائه واهتماماته في الفقه، فهو من الفقهاء العمليين. وقد عرفنا أن بعض العلماء كانوا يمارسون التجارة في غير ميزاب أيضا. وهناك عاملان وجها حياة الثميني وجهة جديدة، الأول ما رآه في مجتمعه من الفساد والعصبية وانتشار بعض البدع الضارة فحز كل هذا في نفسه وعزم على تغييره بجميع الوسائل. والثاني ورود الشيخ يحيى بن صالح الأفضلي من جزيرة جربة بعد أن مكث فيها طويلا. وقد تصدر الأفضلي للتدريس وتخريج التلاميذ الذين يحملون رسالته في الإصلاح. وهنا التقت إرادة الشيخ (يحيى بن صالح) وإرادة التلميذ (عبد العزيز الثميني) في وجوب العمل على إصلاح المجتمع في تلك النواحي. وقد وجد الشيخ في تلميذه الرغبة الملحة والذكاء الوقاد والغيرة على الإصلاح فاحتضنه وساعده
__________
(1) ديلفان (المجلة الإفريقية)، 1874، 420، ويملك ديلفان نسخة من هذا الرجز.
وبينما كان زملاؤه العلماء يحاولون شرح مختصر خليل وتوضيحه عمد البوني إلى نظم مسائل خليل. ولا شك أنه بذلك قد سهل حفظه على التلاميذ ولكنه لم يساعدهم على فهمه واستيعابه. ومن الذين نظموا مختصر خليل أيضا خليفة بن حسن القماري الآتي ذكره. وهناك رجز في الفقه نظمه أحمد الطيب الرحموني أحد أتباع الطريقة الرحمانية. وقد قيل إن هذا الرجز كان مستعملا بين قضاة جرجرة. وكان الرحموني مدرسا في الزاوية الرحمانية بآيت إسماعيل، وقد نظم رجزه سنة 1212 (1).
عبد العزيز الثميني:
والمؤلف الذي يمكن أن يقاس عمله في الفقه الإباضي بعمل أحمد الونشريسي في الفقه المالكي، هو عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني. ولا تظهر حياة الثميني الأولى أي شيء غير عادي فيه. فقد ولد في بني يزقن بميزاب سنة 1130 وتعلم، كما يتعلم أمثاله في ذلك الوقت، فحفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم، وحين بلغ سن النضج دخل التجارة على عادة الميزابيين عموما. وسيكون لهذه المهنة أثرها على آرائه واهتماماته في الفقه، فهو من الفقهاء العمليين. وقد عرفنا أن بعض العلماء كانوا يمارسون التجارة في غير ميزاب أيضا. وهناك عاملان وجها حياة الثميني وجهة جديدة، الأول ما رآه في مجتمعه من الفساد والعصبية وانتشار بعض البدع الضارة فحز كل هذا في نفسه وعزم على تغييره بجميع الوسائل. والثاني ورود الشيخ يحيى بن صالح الأفضلي من جزيرة جربة بعد أن مكث فيها طويلا. وقد تصدر الأفضلي للتدريس وتخريج التلاميذ الذين يحملون رسالته في الإصلاح. وهنا التقت إرادة الشيخ (يحيى بن صالح) وإرادة التلميذ (عبد العزيز الثميني) في وجوب العمل على إصلاح المجتمع في تلك النواحي. وقد وجد الشيخ في تلميذه الرغبة الملحة والذكاء الوقاد والغيرة على الإصلاح فاحتضنه وساعده
__________
(1) ديلفان (المجلة الإفريقية)، 1874، 420، ويملك ديلفان نسخة من هذا الرجز.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
12:32 PM
08-25-2016
________________________________________
على شق طريقه. وصعد الثميني في مجتمعه إلى أن اعترف له بالإمامة العلمية ومشيخة المسجد وأصح رئيسا للمجلس الذي كان يعتبر السلطة العليا في ميزاب كلها.
غير أنه لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد عناء وجهد وبعد أن ألف. عمله الكبير الذي نحن بصدده وهو كتاب (النيل وشفاء العليل). فقد قيل إنه اعتكف على التأليف في بيته مدة ثمانية عشر عاما. فماذا ألف غير الكتاب المذكور؟ الواقع أنه رغم شهرته بكتاب (النيل) فإنه قد أثرى المكتبة الإسلامية والدراسات الفقهية على الخصوص بمادة غزيرة. فمن مؤلفاته (التكميل لما أخل به كتاب النيل) الذي سنتعرض له في مكان آخر، و (الورد البسام في رياض الأحكام) وهو أيضا في الفقه ومتمم للكتاب الأول. وله مؤلفات أخرى في التوحيد والاجتماع والحديث والمنطق، كما أن له مجموعة من الفتاوى. ويلاحظ على مؤلفاته الأخيرة أنه اتبع فيها طريقة علماء عصره وهي شرح كلام الغير أو التحشية عليه أو اختصاره أو نحو ذلك. فكتابه (التاج) مثلا، الذي قيل إنه في عشرة مجلدات، قد اختصر فيه كتابا. لخميس العماني المسمى (منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين). ولكن يلاحظ على مؤلفات الثميني أنها تعالج موضوعات عملية مباشرة مع استقلال في الرأي وحسن اختيار للموضوع. من ذلك معالجته لقضايا المجتمع التي ذكرناها في كتابه (التاج في حقوق الأزواج). ويبدو أن روح التصوف لم تطغ على الشيخ الثميني كما طغت على بعض فقهاء عصره. فتناوله لعلم الكلام في كتابه (النور) وأهمية الصلاة في كتابه (الأسرار النورانية) كان على ما يبدو تناولا علميا لا صوفيا (1).
جمع الثميني مادة كتابه (الذيل) من مصادر الفقه الإباضي الأخرى وجعله مختصرا لمسائلها وأقرب منها إلى فهم المعاصرين. ولذلك انتقد
__________
(1) انظر عنه مقدمة كتاب (النيل)، الجزائر 1967. وبروكلمان 2/ 697، وقد توفي الثميني سنة 1223.
________________________________________
على شق طريقه. وصعد الثميني في مجتمعه إلى أن اعترف له بالإمامة العلمية ومشيخة المسجد وأصح رئيسا للمجلس الذي كان يعتبر السلطة العليا في ميزاب كلها.
غير أنه لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد عناء وجهد وبعد أن ألف. عمله الكبير الذي نحن بصدده وهو كتاب (النيل وشفاء العليل). فقد قيل إنه اعتكف على التأليف في بيته مدة ثمانية عشر عاما. فماذا ألف غير الكتاب المذكور؟ الواقع أنه رغم شهرته بكتاب (النيل) فإنه قد أثرى المكتبة الإسلامية والدراسات الفقهية على الخصوص بمادة غزيرة. فمن مؤلفاته (التكميل لما أخل به كتاب النيل) الذي سنتعرض له في مكان آخر، و (الورد البسام في رياض الأحكام) وهو أيضا في الفقه ومتمم للكتاب الأول. وله مؤلفات أخرى في التوحيد والاجتماع والحديث والمنطق، كما أن له مجموعة من الفتاوى. ويلاحظ على مؤلفاته الأخيرة أنه اتبع فيها طريقة علماء عصره وهي شرح كلام الغير أو التحشية عليه أو اختصاره أو نحو ذلك. فكتابه (التاج) مثلا، الذي قيل إنه في عشرة مجلدات، قد اختصر فيه كتابا. لخميس العماني المسمى (منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين). ولكن يلاحظ على مؤلفات الثميني أنها تعالج موضوعات عملية مباشرة مع استقلال في الرأي وحسن اختيار للموضوع. من ذلك معالجته لقضايا المجتمع التي ذكرناها في كتابه (التاج في حقوق الأزواج). ويبدو أن روح التصوف لم تطغ على الشيخ الثميني كما طغت على بعض فقهاء عصره. فتناوله لعلم الكلام في كتابه (النور) وأهمية الصلاة في كتابه (الأسرار النورانية) كان على ما يبدو تناولا علميا لا صوفيا (1).
جمع الثميني مادة كتابه (الذيل) من مصادر الفقه الإباضي الأخرى وجعله مختصرا لمسائلها وأقرب منها إلى فهم المعاصرين. ولذلك انتقد
__________
(1) انظر عنه مقدمة كتاب (النيل)، الجزائر 1967. وبروكلمان 2/ 697، وقد توفي الثميني سنة 1223.
الموضوع:
تاريخ الجزائر الثقافي.doc الجــــزء الثاني بقسم
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
عبارة السلف وقال إن عبارة الخلف أوضح من عبارتهم (فإن عبارة الخلف وإن قصر ذراعها أوضح من عبارة السلف وإن طال باعها). وقد أوضح في المقدمة كيف كان يدور في خلده عمل اختصار في الفقه الإباضي يحتوي على فتاوي مشاهير المذهب، (لا مخلا ولا مملا ولا مانعا). كما روى الظروف الصعبة التي كانت تحيط به في شكوى تذكرنا بشكوى أبي راس، المعاصر له، من الزمان فقال: (اختلست لجمعه من أثناء الأيام فرصا، مع ما أكابد وأتجرع من الزمان غصصا .. في أيام دهش وتموج فتن، على عجل وتتابع محن). وقد سمى كتابه (النيل) (رجاء من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به .. كما نفع بالنيل) (1). وبعد الانتهاء منه عرضه على شيخه يحيى بن صالح وصححه عليه.
يقع كتاب (النيل) في ثلاثة أجزاء ويشتمل كل جزء على عدة كتب. ومجموع الكتب في الأجزاء الثلاثة اثنان وعشرون كتابا. وكل كتاب يحمل أحد عناوين أبواب الفقه المعهودة. فهناك كتب الطهارة، والصلاة، والإيجارات، والرهن، والهبة، والشفعة، والنفقات الخ. وكل كتاب يحتوي على خاتمة. و (النيل)، رغم أن مؤلفه رغب في أن يكون عمله غير مخل، قد وجده بعض المختصين معقدا لإيجازه الشديد أحيانا. ولعل ذلك راجع إلى كون الثميني نفسه قد نقحه واختصره مرتين بعد أن أتمه. ومهما كان الأمر فقد عكف بعض علماء الإباضية على شرح كتاب (النيل) أيضا. ومن ذلك الشرح الذي وضعه عليه محمد بن يوسف أطفيش والذي بلغ فيه عشر مجلدات طبعت كلها (2)، كما تناوله آخرون بالحاشية أو بالنظم. فهو رغم اختصاره، أصبح مصدرا لا غنى عنه في الفقه الإباضي، وقد اعتبره بعض
__________
(1) يبدو أن الناشرين هم الذين أطلقوا عليه اسم (النيل وشفاه العليل). أما المؤلف فقد اكتفى بكلمة (النيل)، وقد طبع الكتاب أول مرة في مصر سنة 1305. انظر عنه شرح محمد بن يوسف أطفيش عليه في الأجزاء اللاحقة من الكتاب.
(2) طبعت الأجزاء السبعة الأولى سنة 1306 والثلاثة الباقية سنة 1343، وكلها بمصر. انظر لاحقا.
يقع كتاب (النيل) في ثلاثة أجزاء ويشتمل كل جزء على عدة كتب. ومجموع الكتب في الأجزاء الثلاثة اثنان وعشرون كتابا. وكل كتاب يحمل أحد عناوين أبواب الفقه المعهودة. فهناك كتب الطهارة، والصلاة، والإيجارات، والرهن، والهبة، والشفعة، والنفقات الخ. وكل كتاب يحتوي على خاتمة. و (النيل)، رغم أن مؤلفه رغب في أن يكون عمله غير مخل، قد وجده بعض المختصين معقدا لإيجازه الشديد أحيانا. ولعل ذلك راجع إلى كون الثميني نفسه قد نقحه واختصره مرتين بعد أن أتمه. ومهما كان الأمر فقد عكف بعض علماء الإباضية على شرح كتاب (النيل) أيضا. ومن ذلك الشرح الذي وضعه عليه محمد بن يوسف أطفيش والذي بلغ فيه عشر مجلدات طبعت كلها (2)، كما تناوله آخرون بالحاشية أو بالنظم. فهو رغم اختصاره، أصبح مصدرا لا غنى عنه في الفقه الإباضي، وقد اعتبره بعض
__________
(1) يبدو أن الناشرين هم الذين أطلقوا عليه اسم (النيل وشفاه العليل). أما المؤلف فقد اكتفى بكلمة (النيل)، وقد طبع الكتاب أول مرة في مصر سنة 1305. انظر عنه شرح محمد بن يوسف أطفيش عليه في الأجزاء اللاحقة من الكتاب.
(2) طبعت الأجزاء السبعة الأولى سنة 1306 والثلاثة الباقية سنة 1343، وكلها بمصر. انظر لاحقا.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الإباضيين في مكانة مختصر خليل في المذهب المالكي.
خليفة بن حسن القماري:
ومن أشهر من نظم خليل واعتنى بالفقه المالكي عناية خاصة خليفة بن حسن القماري. وقد ولد هذا الشيخ بقمار إحدى بلدات وادى سوف، وعاش حياته العلمية متنقلا بين مسقط رأسه وبين بسكرة وسيدي عقبة وخنقة سيدي ناجي. ولا ندري إن كان قد رحل إلى تونس وغيرها لطلب العلم أيضا والحج. ورغم عزلته فقد ظل ينهل من مصادر تونس وقسنطينة. وهناك مصادر أخرى لغذائه الروحي وهو ركب الحج المغربي الذي كان يسلك طريق الصحراء في ذهابه وعودته. ودليلنا على ذلك تلك المراسلات التي دارت بين خليفة بن حسن وبين علماء الخنقة وبسكرة من جهة، وملاقاته لبعض علماء المغرب أثناء مرورهم بالزيبان وإجازتهم له. ومن هؤلاء عبد القادر بن أحمد بن شقرون القاسي الذي لقي خليفة بن حسن في بسكرة أثناء توجه الفاسي إلى الحج. فقد سماه (الفقيه الفاضل، الجامع لأشتات الفضائل، المشارك المتقن، والبارع المتفنن، ذا الخلق الحسن، سيدي خليفة بن حسن). وقال الفاسي عن نظم الشيخ خليفة العبارات الآتية التي كتبها على نسخة المؤلف، وهي (وقد أطلعني على نظمه الجليل، لمختصر أبي الدنيا خليل، المكتوب هذا على أول ورقمة منه. فطالعت منه البدء والختام، ومواضع منه أنبأتني على أنه مقدام، من فرسان البراعة وأئمة اليراعة، إذ هو نظم عذب الموارد مهذب المقاصد سلس العبارة رائق الإشارة .. وقد طلب مني .. أن أوقع عليه ما تيسر. فأسعدته إسعاد محب صادق، فرقمت له هذه الحريفات ..). وكان ذلك سنة 1193 بمدينة بسكرة (1)، ويدلنا هذا النص على شيئين الأول قيمة هذا النظم في نظر أحد فقهاء المغرب المعروفين، والثاني الصلة العلمية التي كانت تربط علماء المغرب والجزائر.
وقد كان من عادة علماء القرى والمناطق النائية الخروج لركب الحاج
__________
(1) (إتحاف القاري) تأليف محمد الطاهر التليلي القماري، وهو مخطوط.
خليفة بن حسن القماري:
ومن أشهر من نظم خليل واعتنى بالفقه المالكي عناية خاصة خليفة بن حسن القماري. وقد ولد هذا الشيخ بقمار إحدى بلدات وادى سوف، وعاش حياته العلمية متنقلا بين مسقط رأسه وبين بسكرة وسيدي عقبة وخنقة سيدي ناجي. ولا ندري إن كان قد رحل إلى تونس وغيرها لطلب العلم أيضا والحج. ورغم عزلته فقد ظل ينهل من مصادر تونس وقسنطينة. وهناك مصادر أخرى لغذائه الروحي وهو ركب الحج المغربي الذي كان يسلك طريق الصحراء في ذهابه وعودته. ودليلنا على ذلك تلك المراسلات التي دارت بين خليفة بن حسن وبين علماء الخنقة وبسكرة من جهة، وملاقاته لبعض علماء المغرب أثناء مرورهم بالزيبان وإجازتهم له. ومن هؤلاء عبد القادر بن أحمد بن شقرون القاسي الذي لقي خليفة بن حسن في بسكرة أثناء توجه الفاسي إلى الحج. فقد سماه (الفقيه الفاضل، الجامع لأشتات الفضائل، المشارك المتقن، والبارع المتفنن، ذا الخلق الحسن، سيدي خليفة بن حسن). وقال الفاسي عن نظم الشيخ خليفة العبارات الآتية التي كتبها على نسخة المؤلف، وهي (وقد أطلعني على نظمه الجليل، لمختصر أبي الدنيا خليل، المكتوب هذا على أول ورقمة منه. فطالعت منه البدء والختام، ومواضع منه أنبأتني على أنه مقدام، من فرسان البراعة وأئمة اليراعة، إذ هو نظم عذب الموارد مهذب المقاصد سلس العبارة رائق الإشارة .. وقد طلب مني .. أن أوقع عليه ما تيسر. فأسعدته إسعاد محب صادق، فرقمت له هذه الحريفات ..). وكان ذلك سنة 1193 بمدينة بسكرة (1)، ويدلنا هذا النص على شيئين الأول قيمة هذا النظم في نظر أحد فقهاء المغرب المعروفين، والثاني الصلة العلمية التي كانت تربط علماء المغرب والجزائر.
وقد كان من عادة علماء القرى والمناطق النائية الخروج لركب الحاج
__________
(1) (إتحاف القاري) تأليف محمد الطاهر التليلي القماري، وهو مخطوط.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
المغربي وملاقاة العلماء الذين يرافقونه والأخذ عنهم وربط الصلات العلمية معهم. وقد ذكر العياشي أنه تراسل مع بعض علماء الجزائر أثناء مروره بهذه النواحي أيضا. ويبدو أن سمعة خليفة بن حسن كانت ذائعة في عصره. فهذا الناصري الدرعي صاحب الرحلة الكبرى قد سجل انطباعه أيضا عن ملاقاته بالشيخ خليفة. وقال إنه كان قد سمع به ولم يلقه أثناء ذهاب الركب إلى الحج لأن خليفة بن حسن عندئذ كان في بلاده. أما عند عودة الركب فقد خرج الشيخ خليفة إلى سيدي عقبة للقاء علماء المغرب. وقد حكم الدرعي على منظومة خليفة بن حسن حكما يختلف قليلا عن حكم الفاسي. وهذا نص ما كتبه الدرعي عن هذا اللقاء في رحلته (وكان ممن اجتمعنا به في هذه البلدة المباركة (سيدي عقبة) العالم العلامة المسن البركة، سيدي خليفة بن الحسن السوفي، نسبة إلى سوف، قرى صحراوية على خمس مراحل من بسكرة، وكنا سمعنا به ولم نلقه لمغيبه ببلده (أثناء الذهاب إلى الحج)، وجاء بقصد ملاقات (كذا) الركاب النبوية على عادتهم، وأوقفني على نظمه لأبي المودة خليل، وزاد عليه بعض قيود وتنبيهات. وهو نظم سلس لا بأس به، غير أن صاحبه غير متمكن في الصناعة العروضية، وإنما للنظم عنده سجية، وهو زهاء ثمانية آلاف بيت) (1).
سمى خليفة بن حسن نظمه المذكور (جواهر الإكليل في نظم مختصر الشيخ خليل). وكان قد فرغ من نظمه سنة 1192، عندما أصبح طاعنا في السن. ولم يكن له سوى هذا النظم، الذي امتاز بسلاسته ودقته، بل ألف غير ذلك في الفقه أيضا. فله كتاب يعرف بـ (الكنش) أو الكناش، جمع فيه مسائل فقهية هامة على شاكلة النوازل والفتاوى، وقد قدره من رآه بثلاثمائة صفحة من الحجم الكبير. كما ألف شرحا على السنوسية، ونظم الأجرومية،
__________
(1) الرحلة الكبرى للناصري، مخطوطة مصورة، الخزانة العامة بالرباط، رقم 2651 د، ص 497، أما محمد الطاهر التليلي في (إتحاف القاري) فقد قال إن عدد أبيات النظم (9817) سبعة عشر وثمانمائة وتسعة آلاف بيت. فأبيات الجزء الواحد حوالي خمسة آلاف بيت.
سمى خليفة بن حسن نظمه المذكور (جواهر الإكليل في نظم مختصر الشيخ خليل). وكان قد فرغ من نظمه سنة 1192، عندما أصبح طاعنا في السن. ولم يكن له سوى هذا النظم، الذي امتاز بسلاسته ودقته، بل ألف غير ذلك في الفقه أيضا. فله كتاب يعرف بـ (الكنش) أو الكناش، جمع فيه مسائل فقهية هامة على شاكلة النوازل والفتاوى، وقد قدره من رآه بثلاثمائة صفحة من الحجم الكبير. كما ألف شرحا على السنوسية، ونظم الأجرومية،
__________
(1) الرحلة الكبرى للناصري، مخطوطة مصورة، الخزانة العامة بالرباط، رقم 2651 د، ص 497، أما محمد الطاهر التليلي في (إتحاف القاري) فقد قال إن عدد أبيات النظم (9817) سبعة عشر وثمانمائة وتسعة آلاف بيت. فأبيات الجزء الواحد حوالي خمسة آلاف بيت.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وله قصيدة في معرفة الأثر، وفتاوي وآراء اجتماعية سنعرض لبعضها بعد حين (1)، وما تزال آثار خليفة بن حسن القماري لم تجمع ولم تطبع باستثناء نظمه المذكور، فهو مطبوع.
...
أما في الفقه الحنفي فلا نعرف أن علماء هذا المذهب قد ألفوا فيه أعمالا هامة. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى أن معظم القضاة الحنفية كانوا في أول الأمر يأتون من المشرق لمدة قصيرة. وحين أصبحوا يعينون من العائلات التي نشأت في الجزائر كانوا يعتمدون غالبا في أحكامهم وفتاواهم على شروح وحواشي المشارقة. ومن المعروف أن عائلة ابن العنابي قد ساهمت في التأليف على مذهب أبي حنيفة. ولنذكر هنا تأليف محمد بن محمود بن العنابي المعروف (بشرح الدر المختار)، وهو العمل الذي قرظه محمد بيرم التونسي الحنفي أيضا، ولكننا لا ندري ما إذا كان ابن العنابي قد أكمل عمله، والغالب أنه فعل لأنه عاش فترة طويلة بعد تقريظ الجزء الذي انتهى منه. وقد تناولنا ذلك في كتابنا عنه (2)، وتحتوي المكتبة الوطنية بالجزائر على بعض النصوص في الفقه الحنفي لبعض العلماء الجزائريين مثل الرسالة التي كتبها علي بن محمد الجزائري بعنوان (رسالة في الصلوات) (3).
النوازل والفتاوى والفرائض
وبالإضافة إلى ما ذكرنا ترك علماء الجزائر تآليف في الفتاوى والوقف والفرائض وغيرها من القضايا التي تمس جوانب الدين المختلفة. ورغم أن الباحثين قد نسبوا إلى محمد بن العنابي فتاوي كثيرة فإنها على كل حال غير
__________
(1) (إتحاف القاري). وقد قال التليلي عن الكنش ان الأيام قد عبثت به، وأن آخر العهد به أنه في حيازة السيد محمد بن السائح الغريبي, وقد قام سليمان الباروني بطبع (جواهل الإكليل) في مصر أوائل هذا القرن.
(2) انظر كتابنا (المفتي الجزائري ابن العنابي)، الجزائر، 1977. ط 2، 1992.
(3) دوحة الناشر (الترجمة الفرنسية)، 219 - 221.
...
أما في الفقه الحنفي فلا نعرف أن علماء هذا المذهب قد ألفوا فيه أعمالا هامة. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى أن معظم القضاة الحنفية كانوا في أول الأمر يأتون من المشرق لمدة قصيرة. وحين أصبحوا يعينون من العائلات التي نشأت في الجزائر كانوا يعتمدون غالبا في أحكامهم وفتاواهم على شروح وحواشي المشارقة. ومن المعروف أن عائلة ابن العنابي قد ساهمت في التأليف على مذهب أبي حنيفة. ولنذكر هنا تأليف محمد بن محمود بن العنابي المعروف (بشرح الدر المختار)، وهو العمل الذي قرظه محمد بيرم التونسي الحنفي أيضا، ولكننا لا ندري ما إذا كان ابن العنابي قد أكمل عمله، والغالب أنه فعل لأنه عاش فترة طويلة بعد تقريظ الجزء الذي انتهى منه. وقد تناولنا ذلك في كتابنا عنه (2)، وتحتوي المكتبة الوطنية بالجزائر على بعض النصوص في الفقه الحنفي لبعض العلماء الجزائريين مثل الرسالة التي كتبها علي بن محمد الجزائري بعنوان (رسالة في الصلوات) (3).
النوازل والفتاوى والفرائض
وبالإضافة إلى ما ذكرنا ترك علماء الجزائر تآليف في الفتاوى والوقف والفرائض وغيرها من القضايا التي تمس جوانب الدين المختلفة. ورغم أن الباحثين قد نسبوا إلى محمد بن العنابي فتاوي كثيرة فإنها على كل حال غير
__________
(1) (إتحاف القاري). وقد قال التليلي عن الكنش ان الأيام قد عبثت به، وأن آخر العهد به أنه في حيازة السيد محمد بن السائح الغريبي, وقد قام سليمان الباروني بطبع (جواهل الإكليل) في مصر أوائل هذا القرن.
(2) انظر كتابنا (المفتي الجزائري ابن العنابي)، الجزائر، 1977. ط 2، 1992.
(3) دوحة الناشر (الترجمة الفرنسية)، 219 - 221.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
مجموعة في كتاب واحد، وهي متفرقة هنا وهناك، كما أنها لا تشتمل على فتاوى غيره في القضايا التي تناولها على نحو ما فعل الونشريسي مثلا. ويكاد يكون كل عالم بشؤون الدين، والفقه على الخصوص، قد جمع بعض الفتاوى التي تقل أو تكثر حسب مكانته وحسب نظرة الناس إليه وكثرة وتلاميذه. وليس من غرضنا هنا إحصاء هذه الفتاوى. فقد نسبت إلى أحمد بن الحاج البجائي التلمساني مجموعة من الفتاوى، وروى له ابن عسكر فتوى طويلة دليلا على إتقانه لهذا الفن (1)، ونسبت إلى محمد بن أحمد المعروف بالكمال عدة أجوبة على نوازل فقهية مختلفة، ولكننا لا نعرف ما إذا كانت هذه الأجوبة مجموعة ومحفوظة (2) ومن ضمن ما ترك عبد العزيز الثميني مجموعة من الفتاوى، كما عرفنا. وذكر صاحب (نيل الابتهاج) لعمر الوزان فتاوى في الفقه والكلام (أبدع فيهما ما شاء) (3). وهناك بعض الفتاوى ذات الموضوع المحدد كرأي أحد العلماء في قضية معينة عرضت له أو سئل عنها. ولدينا من هذه الفتاوى نماذج كثيرة لا نريد أن نأتي هنا على كل ما عرفناه منها، فقد تناول محمد شقرون الوهراني في عمله المسمى (الجيش الكمين لقتال من كفر عامة المسلمين) (4) قضية إيمان المقلد في العقائد العاجز عن معرفة الله بالبراهين (هل إيمانه صحيح أو هو كافر وإيمانه فاسد)؟ وبعد أن ذكر الوهراني آراء العلماء اللذين كفروا عامة المسلمين لأنهم مؤمنون بالتقليد، وحكموا باستباحة أموالهم وفساد عقود زواجهم وغير ذلك - أجاب هو إجابة انتهى فيها إلى صحة إيمان المقلدين من العامة. وقد أورد أوجه الخلاف الناشب بين العلماء حول هذه القضية ناقلا ذلك عن المشاهير منهم أمثال الماتريدي وأحمد بن زكري والقاضي عياض
__________
(1) دوحة الناشر (الترجمة الفرنسية)، 219 - 221.
(2) (سلوة الأنفاس) 2/ 30 - 31.
(3) أحمد بابا (نيل الابتهاج)، ص 197.
(4) نسخة منه في المكتبة الوطنية بالجزائر، رقم 2301 في 9 ورقات، مجموع، وهو مؤلف سنة 920، وأخرى بالخزانة العامة بالرباط، رقم 2775 د.
__________
(1) دوحة الناشر (الترجمة الفرنسية)، 219 - 221.
(2) (سلوة الأنفاس) 2/ 30 - 31.
(3) أحمد بابا (نيل الابتهاج)، ص 197.
(4) نسخة منه في المكتبة الوطنية بالجزائر، رقم 2301 في 9 ورقات، مجموع، وهو مؤلف سنة 920، وأخرى بالخزانة العامة بالرباط، رقم 2775 د.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وابن رشد. ورغم اعتراف الوهراني بأن المسألة خلافية فإنه انتهى إلى الأخذ برأي أهل السنة، كما يقول، ونبذ آراء المعتزلة ونحوهم. والملاحظ أن الرأي الذي وصل إليه الوهراني قد سانده فيه، بشهادات مكتوبة، أربعة من علماء تلمسان وهم. إبراهيم بن أحمد الوجديجي ومحمد بن عيسى وأحمد بن ملوكة ومحمد بن العباس. والوهراني المذكور هو نفسه صاحب الفتوى المشهورة التي أفتى فيها مسلمي الأندلس بالبقاء تحت الضغط وإخفاء دينهم والتظاهر بالنصرانية. وقد احتلت قضية اليهود مكانا بارزا في تكفير العلماء خلال العهد العثماني.
وكان العلماء بصفة عامة ناقمين على تدخل اليهود الاقتصادي والسياسي في الدولة، ولكن حماية بعض الباشوات والبايات لهم قد جعل العلماء يبلعون نقمتهم. ويظهر ذلك من بعض الفتاوى التي قد تبدو قاسية ضد اليهود. فقد عرفنا موقف عبد الكريم الفكون (الجد) من قضية المسمى المختاري الذي تطاول على الرسول (صلى الله عليه وسلم) والذي أفتى الشيخ بقتله رغم حماية السلطة السياسية في قسنطينة له. وأفتى الشيخ محمد الولي الحفي بإحراق اليهود والنصارى إذا أعلنوا سب الرسول (صلى الله عليه وسلم)، معتمدا في ذلك على مجموعة من الأحاديث والروايات التاريخية. وقد وضع رسالة في ذلك سماها (السيف الممدود في عنق من أعان اليهود) (1)، وأسهم محمد بن أحمد الكماد في هذه الحملة بإصدار جواب ضمن أجوبة علماء فاس بإبطال ما اشتهر به يهودها من عهد منسوب لرسول الله (2).
ولأحمد البوني فتوى في الحضانة كتبها سنة 1113 ونسخها ولده أحمد الزروق سنة 1145. ونحن نسوق بعض هذه الفتوى لا لموضوعهاولكن للأفكار التي وردت فيها والتي تلقي ضوءا على تفكير البوني وبعض
__________
(1) المكتبة الوطنية - الجزائر، رقم 2198 في خمس ورقات، وهي مكتوبة سنة 1172 بعد حادثة وقعت عندئذ.
(2) انظر مخطوط رقم 2120 د، الخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع. وانظر أيضا عن هذه الفضية (إتحاف أعلام الناس) 1/ 339.
وكان العلماء بصفة عامة ناقمين على تدخل اليهود الاقتصادي والسياسي في الدولة، ولكن حماية بعض الباشوات والبايات لهم قد جعل العلماء يبلعون نقمتهم. ويظهر ذلك من بعض الفتاوى التي قد تبدو قاسية ضد اليهود. فقد عرفنا موقف عبد الكريم الفكون (الجد) من قضية المسمى المختاري الذي تطاول على الرسول (صلى الله عليه وسلم) والذي أفتى الشيخ بقتله رغم حماية السلطة السياسية في قسنطينة له. وأفتى الشيخ محمد الولي الحفي بإحراق اليهود والنصارى إذا أعلنوا سب الرسول (صلى الله عليه وسلم)، معتمدا في ذلك على مجموعة من الأحاديث والروايات التاريخية. وقد وضع رسالة في ذلك سماها (السيف الممدود في عنق من أعان اليهود) (1)، وأسهم محمد بن أحمد الكماد في هذه الحملة بإصدار جواب ضمن أجوبة علماء فاس بإبطال ما اشتهر به يهودها من عهد منسوب لرسول الله (2).
ولأحمد البوني فتوى في الحضانة كتبها سنة 1113 ونسخها ولده أحمد الزروق سنة 1145. ونحن نسوق بعض هذه الفتوى لا لموضوعهاولكن للأفكار التي وردت فيها والتي تلقي ضوءا على تفكير البوني وبعض
__________
(1) المكتبة الوطنية - الجزائر، رقم 2198 في خمس ورقات، وهي مكتوبة سنة 1172 بعد حادثة وقعت عندئذ.
(2) انظر مخطوط رقم 2120 د، الخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع. وانظر أيضا عن هذه الفضية (إتحاف أعلام الناس) 1/ 339.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
علماء عصره. فقد وردت عليه من قسنطينة رسالة يطلبون فيها منه إبداء رأيه كتابة في قضية حضانة انقسم حولها العلماء، وهي طفل ماتت أمه وألف أباه ألفة كبيرة، وعندما طالبت به جدته لأمه (وهي حاضنته الشرعية) أبى وبكى، فما الحكم؟ فقد أفتى البعض ببقائه مع والده وأفتى آخرون بنقله إلى جدته، وكل فريق أيد رأيه بنقول علمية وشرعية. وقد أجاب البوني بأن الوالد أحق بالطفل في هذه الحالة. وأضاف أنه ليس للجدة حق أصلا وإن كان المشهور أن الحضانة حق لها، واستدل لرأيه بأقوال خليل وشراحه من المتأخرين، كما استدل بالعقل، وبرر البوني أخذه برأي المتأخرين بقول القائل:
قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ... ويرى (1) للأوائل التقديما
إن ذاك القديم كان جديدا ... وسيبقى هذا الجديد قديما
واستدل أيضا برأي ابن مالك وبالأمثال التي تذهب إلى أن العلم منحة إلهية يرزق بها الله من يشاء، وهي غير مقصورة على الأولين، ورفض البوني الاعتقاد في القول القائل (ما ترك الأول للآخر شيئا) (2)، ولا شك أن هذا رأي مهم أدلى به البوني قد لا يتناسب مع ما نسب إليه من القول بإسقاط التدبير. وهو يدل على أن روح الاجتهاد والحرية العقلية ما تزال حية حتى عند أمثال البوني الذين جمعوا بين الفقه والتصوف.
وقد عرفنا أن قضية تناول الدخان قد شغلت بعض العلماء فألفوا فيها وأفتوا. ومن الذين أفتوا فيها أحمد المقري الذي توجد أجوبته في ذلك مجموعة مع أجوبة غيره (3)، وألف فيها عبد القادر الراشدي وعبد الكريم الفكون. ولعل الفكون هو أشهر من كتب في هذا الموضوع. فعمله الذي سماه (محدد السنان في نحور إخوان الدخان) يشتمل على عدة كراريس. وقد ضمنه مباحث اجتهادية ونقولا من الفقهاء. وهاجم فيه متناولي الدخان وحكم بتحريمه لأنه، في نظره، يحدث (نشوة وطربا) كالحشيشة. ومن الذين
__________
(1) في الأصل (يرى) مكتوبة بالألف الممدودة.
(2) (فتوى في الحضانة) المكتبة الوطنية - الجزائر، رقم 2160، وهي بخط جيد.
(3) أجوبة في اجتناب الدخان، المكتبة الملكية بالرباط، رقم 7579 مجموع.
قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ... ويرى (1) للأوائل التقديما
إن ذاك القديم كان جديدا ... وسيبقى هذا الجديد قديما
واستدل أيضا برأي ابن مالك وبالأمثال التي تذهب إلى أن العلم منحة إلهية يرزق بها الله من يشاء، وهي غير مقصورة على الأولين، ورفض البوني الاعتقاد في القول القائل (ما ترك الأول للآخر شيئا) (2)، ولا شك أن هذا رأي مهم أدلى به البوني قد لا يتناسب مع ما نسب إليه من القول بإسقاط التدبير. وهو يدل على أن روح الاجتهاد والحرية العقلية ما تزال حية حتى عند أمثال البوني الذين جمعوا بين الفقه والتصوف.
وقد عرفنا أن قضية تناول الدخان قد شغلت بعض العلماء فألفوا فيها وأفتوا. ومن الذين أفتوا فيها أحمد المقري الذي توجد أجوبته في ذلك مجموعة مع أجوبة غيره (3)، وألف فيها عبد القادر الراشدي وعبد الكريم الفكون. ولعل الفكون هو أشهر من كتب في هذا الموضوع. فعمله الذي سماه (محدد السنان في نحور إخوان الدخان) يشتمل على عدة كراريس. وقد ضمنه مباحث اجتهادية ونقولا من الفقهاء. وهاجم فيه متناولي الدخان وحكم بتحريمه لأنه، في نظره، يحدث (نشوة وطربا) كالحشيشة. ومن الذين
__________
(1) في الأصل (يرى) مكتوبة بالألف الممدودة.
(2) (فتوى في الحضانة) المكتبة الوطنية - الجزائر، رقم 2160، وهي بخط جيد.
(3) أجوبة في اجتناب الدخان، المكتبة الملكية بالرباط، رقم 7579 مجموع.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
هاجمهم الفكون العلماء المشارقة عموما لتساهلهم في مسائل الدخان ونحوها، وقال إنهم يتناولون الدخان في المساجد وأنهم لا يعظمونها لأنهم ينامون فيها ويحلقون رؤوسهم فيها. وخص الفكون عليا الأجهوري بالهجوم لقوله بأن مسألة التدخين تتعلق بأمزجة الأشخاص، فإن أسكر فهو حرام وإن لم يسكر فهو حلال، ورغم نقد الفكون لأهل التصوف في كتابه (منشور الهداية) فإنه في كتابه (محدد السنان) قد بنى تحريم الدخان على رأي الفقهاء والصوفية. فقال إن (غالب المتورعين من الفقهاء، ومعهم جميع الصوفية أرباب البصائر الصافية يصرحون بالتحريم). وهو يعتقد أن الفقهاء إذا اختلفوا في مسألة وكان معهم الصوفية فالذي يجب الأخذ به هو الرأي الذي معه الصوفية (لأن الله يؤيدهم وهوى النفوس مفقود منهم فلا ينطقون إلا عن حق وصواب) (1)، ومن الواضح أن الفكون هنا يقصد المتصوفين الحقيقيين الذين عقد لهم فصلا خاصا في كتابه (منشور الهداية) وليس المتصوفين الدجالين الذين سماهم هناك أدعياء الولاية.
وألف في نوازل الأرض وعمارتها وما يتصل بذلك عدد من علماء الجزائر أيضا. ومن هؤلاء عبد العزيز الثميني في كتابه (التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل)، وهو عمل في أحكام عمارة الأرض من تشييد المنازل والمدن والقرى وفتح الطرقات وغرس البساتين وتقسيم المياه وأحكام الشركات في العقار والمنقولات وحدود الملكية وتحديد المضرات وأحكامها وأحكام المشاع. وكان الثميني قد اختصر به كتاب (أصول الأرضين)
لأحمد بن محمد بن أبي بكر (2).
__________
(1) العياشي (الرحلة) 2/ 396 - 403 وقد أشار الفكون نفسه عدة مرات إلى (محدد السنان) في كتابه (منشور الهداية). انظر مثلا ترجمة المقري وترجمة محمد وارث الهاروني. وبذلك يكون الفكون قد ألف (محدد السنان) في منتصف عمره تقريبا، أي حوالي سنة 1035. وتوجد نسخة من هذا الكتاب في المكتبة الملكية - الرباط، وقد حصلنا منها على مصورة. انظر كتابنا (شيخ الإسلام)، ط. بيروت، 1906.
(2) مجلة (المنهاج) ج 8، ثعبان 1344، 467، وهذا الكتاب مطبوع مع ترجمة للثميني =
وألف في نوازل الأرض وعمارتها وما يتصل بذلك عدد من علماء الجزائر أيضا. ومن هؤلاء عبد العزيز الثميني في كتابه (التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل)، وهو عمل في أحكام عمارة الأرض من تشييد المنازل والمدن والقرى وفتح الطرقات وغرس البساتين وتقسيم المياه وأحكام الشركات في العقار والمنقولات وحدود الملكية وتحديد المضرات وأحكامها وأحكام المشاع. وكان الثميني قد اختصر به كتاب (أصول الأرضين)
لأحمد بن محمد بن أبي بكر (2).
__________
(1) العياشي (الرحلة) 2/ 396 - 403 وقد أشار الفكون نفسه عدة مرات إلى (محدد السنان) في كتابه (منشور الهداية). انظر مثلا ترجمة المقري وترجمة محمد وارث الهاروني. وبذلك يكون الفكون قد ألف (محدد السنان) في منتصف عمره تقريبا، أي حوالي سنة 1035. وتوجد نسخة من هذا الكتاب في المكتبة الملكية - الرباط، وقد حصلنا منها على مصورة. انظر كتابنا (شيخ الإسلام)، ط. بيروت، 1906.
(2) مجلة (المنهاج) ج 8، ثعبان 1344، 467، وهذا الكتاب مطبوع مع ترجمة للثميني =
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وفي هذا النطاق ألف محمد المصطفى بن زرفة برسم الباي محمد بن عثمان الكبير كتابا سماه (الاكتفاء في حكم جوائز الأمراء والخلفاء) تناول فيه أحكام الأرض المفتوحة عنوة وصلحا، وتجارة الأمراء وهداياهم والديون ونحو ذلك مما كان يشغل بال الباي المذكور ويثير بعض الخلافات بينه وبين علماء وقته. وقد قسم ابن زرفة كتابه، الذي ألفه سنة 1199، إلى أربعة فصول أو أقسام، وتكلم في الفصول الثلاثة على حقوق الأمراء (مثلا - البايات) في مسائل الضرائب والهدايا والتجارة وأوضاع أملاك المدينين وغير ذلك. وأما الفصل الرابع فقد خصصه لموارد بيت المال وطريقة استعمالها، وطريقة توزيع غنائم الحرب، وأحوال الأعراب المغلوبين بقوة السلاح على أرضهم ومصير هذه الأرض إذا كانت مفتوحة عنوة أو صلحا. وأكثر ابن زرفة من النقود على الفقهاء المتقدمين من أهل المشرق والأندلس والمغرب. ولا شك أن ابن زرفة، الذي كان كاتب الباي وقاضيه، قد حاول أن يبرر أعمال الباي وأن يعطيه سلاحا فقهيا. يعتمد عليه في معاملة الثوار وإسكات العلماء ونحو ذلك من الأمور التي كانت تثير الجدل (1).
وهناك مؤلفات أخرى وفتاوي أصدرها أصحابها بعد ممارسات في شؤون الحياة. من ذلك (تقييد) عبد الرحمن الأخضري فيما يجب على المكلف (2)، وفتوى خليفة بن حسن القماري في العمل بمعرفة أثر السارق المتهم، وذلك بعدة مراسلات بينه وبين علماء الخنقة حول هذه النقطة.
__________
= كتبها حفيده محمد الثميني.
(1) ذكر هذا الكتاب وعرف به السيد أرنست ميرسيي في (روكاي) 1898، 312 - 340، وقد حلل بعض أجزائه تحليلا بعيدا عن الحقيقة، واعتمد في ذلك على نسخة هوداس من كتاب (الاكتفاء) وقد أشار إلى وجود هذا الكتاب أحمد بن سحنون مؤلف (الثغر الجماني) ومعاصر ابن زرفة في بلاط الباي محمد الكبير. وقد رأينا كيف تحصل المستشرق هوداس على الرحلة القمرية وكتاب الاكتفاء لابن زرفة.
(2) الخزانة العامة بتطوان، رقم 125 مجموع.
وهناك مؤلفات أخرى وفتاوي أصدرها أصحابها بعد ممارسات في شؤون الحياة. من ذلك (تقييد) عبد الرحمن الأخضري فيما يجب على المكلف (2)، وفتوى خليفة بن حسن القماري في العمل بمعرفة أثر السارق المتهم، وذلك بعدة مراسلات بينه وبين علماء الخنقة حول هذه النقطة.
__________
= كتبها حفيده محمد الثميني.
(1) ذكر هذا الكتاب وعرف به السيد أرنست ميرسيي في (روكاي) 1898، 312 - 340، وقد حلل بعض أجزائه تحليلا بعيدا عن الحقيقة، واعتمد في ذلك على نسخة هوداس من كتاب (الاكتفاء) وقد أشار إلى وجود هذا الكتاب أحمد بن سحنون مؤلف (الثغر الجماني) ومعاصر ابن زرفة في بلاط الباي محمد الكبير. وقد رأينا كيف تحصل المستشرق هوداس على الرحلة القمرية وكتاب الاكتفاء لابن زرفة.
(2) الخزانة العامة بتطوان، رقم 125 مجموع.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وقد أجابهم الشيخ خليفة بقصيدة أوضح فيها ضرورة العمل فقهيا بما ذكر، فأذعنوا لرأيه (1)، كما ألف مصطفى بن رمضان العنابي كتابا اسمه (الروض البهيج في أحكام العزوبة والتزويج) بعد أن وقعت له أمور في زواجه (2).
ومن علماء هذه الأسرة محمد ابن العنابي الذي أفتى كثيرا في مسائل العصر وجمعت له من ذلك مجموعات ما تزال محفوظة في المكتبات العامة والخاصة، كما أنه ألف كتابا هاما في موضوعه وهو ضرورة منافسة الأوروبيين في تقدمهم الصناعي والتقني والعسكري والأخذ عنهم في ذلك وتجاوزهم فيه، وهو كتاب (السعي المحمود في نظام الجنود). وقد أكثر فيه من نقول العلماء واستعمل فيه القياس في مسائل عديدة، وطالب سلاطين آل عثمان بتجديد الدولة وإصلاح النظم، كما أيدهم في القضاء على الإنكشارية وهاجم الفقهاء المتزمتين. وما دمنا قد تناولنا هذا الكتاب بالتحليل والدرس والنقد في مكان آخر فلنكتف منه هنا بهذا المقدار (3).
ويتصل بعلم الفقه موضوع التركات والأوقاف والفرائض. ولا نعرف أن هناك تأليفا خاصا بقضايا الوقف غير رسالة أحمد بن عمار المسماة (رسالة في مسألة وقف) (4)، وهي جديرة بالقراءة والتأمل لاحتوائها أيضا على آراء اجتهادية هاجم فيها ابن عمار الجمود العقلي في وقته وضعف العارضة عند علماء عصره، وهناك أيضا (رسالة في الوقف) كتبها محمد
__________
(1) محمد الطاهر التليلي (إتحاف القاري)، مخطوط، والمقصود بالأثر هنا تتبع أثر رجل السارق على الأرض الرخوة أو الرملية والحكم عليه بمقتضاه.
(2) يوجد بعضه مخطوطا في مكتبة جامع البرواقية. انظر عنه أيضا كتابنا (المفتي الجزائري ابن العنابي).
(3) درسناه وحددنا مواضع نسخه وحياة مؤلفه في كتابنا (المفتي الجزائري ابن العنابي). وقد ألفه سنة 1242 ولذلك تناولناه ضمن إنتاج العهد العثماني.
(4) هذه الرسالة منشورة ضمن (المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية)، تونس 1910.
ومن علماء هذه الأسرة محمد ابن العنابي الذي أفتى كثيرا في مسائل العصر وجمعت له من ذلك مجموعات ما تزال محفوظة في المكتبات العامة والخاصة، كما أنه ألف كتابا هاما في موضوعه وهو ضرورة منافسة الأوروبيين في تقدمهم الصناعي والتقني والعسكري والأخذ عنهم في ذلك وتجاوزهم فيه، وهو كتاب (السعي المحمود في نظام الجنود). وقد أكثر فيه من نقول العلماء واستعمل فيه القياس في مسائل عديدة، وطالب سلاطين آل عثمان بتجديد الدولة وإصلاح النظم، كما أيدهم في القضاء على الإنكشارية وهاجم الفقهاء المتزمتين. وما دمنا قد تناولنا هذا الكتاب بالتحليل والدرس والنقد في مكان آخر فلنكتف منه هنا بهذا المقدار (3).
ويتصل بعلم الفقه موضوع التركات والأوقاف والفرائض. ولا نعرف أن هناك تأليفا خاصا بقضايا الوقف غير رسالة أحمد بن عمار المسماة (رسالة في مسألة وقف) (4)، وهي جديرة بالقراءة والتأمل لاحتوائها أيضا على آراء اجتهادية هاجم فيها ابن عمار الجمود العقلي في وقته وضعف العارضة عند علماء عصره، وهناك أيضا (رسالة في الوقف) كتبها محمد
__________
(1) محمد الطاهر التليلي (إتحاف القاري)، مخطوط، والمقصود بالأثر هنا تتبع أثر رجل السارق على الأرض الرخوة أو الرملية والحكم عليه بمقتضاه.
(2) يوجد بعضه مخطوطا في مكتبة جامع البرواقية. انظر عنه أيضا كتابنا (المفتي الجزائري ابن العنابي).
(3) درسناه وحددنا مواضع نسخه وحياة مؤلفه في كتابنا (المفتي الجزائري ابن العنابي). وقد ألفه سنة 1242 ولذلك تناولناه ضمن إنتاج العهد العثماني.
(4) هذه الرسالة منشورة ضمن (المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية)، تونس 1910.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ابن العنابي (1)، وهي في موضوع واقف نص على أن من مات قبل الاستحقاق يقوم ولده مقامه. أما سعيد بن محمد العقباني التلمساني، الذي كان خطيب وقاضي تلمسان خلال القرن الحادي عشر، فقد وضع شرحا خصصه للإرث ونحوه. وقد قسم الكتاب إلى أبواب تناول فيها الولاء والإقرار والوصايا والمناسخة الخ. كما شرح الألفاظ لغة واصطلاحا، وذكر الأحكام وطرق التوصل إلى حل التركات، ويبدو أن عمله عبارة عن شرح هذه لأحد أعمال القلصادي في الفرائض، فالنسخة التي اطلعنا عليها متآكلة الأطراف وعليها حواشي لبعضهم (2).
ويتصل علم الفرائض اتصالا وثيقا بالفقه والحساب معا. لذلك وجدنا عددا من العلماء المشتغلين به كانوا أيضا مشتغلين بالحساب. وسنشير إلى هذه العلاقة في الفصل الخاص بالعلوم. فقد نظم عبد الرحمن الأخضري متن (الدرة البيضاء) في خمسمائة بيت، وهي في الفرائض والحساب. وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: الحساب، والتركات، والقسمة. وكان الأخصري قد بدأ الشرع ثم سرقت منه النسخة ولكنها أعيدت له بعد مدة. والمعروف أنه أكمل شرح القسم الثاني على الأقل. أما الأول فليس من المؤكد أنه هو الذي شرحه، وكذلك القسم الثالث. وقد نصت طبعة القاهرة سنة 1891 للدرة البيضاء على أن القسم الثاني قد شرحه الأخضري بنفسه وكذلك القسم الثالث ما عدا الفصول الثلاثة الأخيرة. أما القسم الأول فقد نصت على أن الأخضري لم يشرحه، ولكنها لم تذكر من شرحه: فهل هو شرح عبد اللطيف المسبح؟ لقد ذكر الفكون أن عبد اللطيف المسبح المرداسي قد شرح (الدرة البيضاء) أو على الأقل أكمل ما لم يشرحه الأخضري منها (3). وقد اعتنى
__________
(1) نسخة منها في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا (قسم يهودا)، رقم 2199.
(2) اطلعنا على نسخة باريس، مخطوطات رقم 5312، وهي في 141 ورقة.
(3) الفكون (منشور الهداية)، 16. انظر أيضا لوسياني (السلم)، الجزائر 1921، 10 - 11. وقد ترجم الفكون لعبد اللطيف المسبح الذي كان معاصرا لجده، وأصل عائلة المسبح من مرداس.
ويتصل علم الفرائض اتصالا وثيقا بالفقه والحساب معا. لذلك وجدنا عددا من العلماء المشتغلين به كانوا أيضا مشتغلين بالحساب. وسنشير إلى هذه العلاقة في الفصل الخاص بالعلوم. فقد نظم عبد الرحمن الأخضري متن (الدرة البيضاء) في خمسمائة بيت، وهي في الفرائض والحساب. وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: الحساب، والتركات، والقسمة. وكان الأخصري قد بدأ الشرع ثم سرقت منه النسخة ولكنها أعيدت له بعد مدة. والمعروف أنه أكمل شرح القسم الثاني على الأقل. أما الأول فليس من المؤكد أنه هو الذي شرحه، وكذلك القسم الثالث. وقد نصت طبعة القاهرة سنة 1891 للدرة البيضاء على أن القسم الثاني قد شرحه الأخضري بنفسه وكذلك القسم الثالث ما عدا الفصول الثلاثة الأخيرة. أما القسم الأول فقد نصت على أن الأخضري لم يشرحه، ولكنها لم تذكر من شرحه: فهل هو شرح عبد اللطيف المسبح؟ لقد ذكر الفكون أن عبد اللطيف المسبح المرداسي قد شرح (الدرة البيضاء) أو على الأقل أكمل ما لم يشرحه الأخضري منها (3). وقد اعتنى
__________
(1) نسخة منها في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا (قسم يهودا)، رقم 2199.
(2) اطلعنا على نسخة باريس، مخطوطات رقم 5312، وهي في 141 ورقة.
(3) الفكون (منشور الهداية)، 16. انظر أيضا لوسياني (السلم)، الجزائر 1921، 10 - 11. وقد ترجم الفكون لعبد اللطيف المسبح الذي كان معاصرا لجده، وأصل عائلة المسبح من مرداس.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
المسبح ببعض أعمال الأخضري الأخرى كشرحه على (مختصر) الأخضري في العبادات وآداب الدين، وهو (أي المختصر) الذي شرحه الفكون أيضا. وقد سمى المسبح شرحه (عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان). وكان قد أكمله سنة 985 (1).
ويبدو أن علم الفرائض قد تدهور بمرور الزمن، وكان ذلك نتيجة ضعف العناية بالحساب والرياصيات عموما. وهذا ما جعل الفكون في القرن الحادي عشر يحكم بانقراض علم الفرائض تقريبا. فقد لاحظ وهو يتحدث عن محمد بن نعمون بأنه كان يعتمد على ولديه في الدرس وفي مسائل الوثائق والفرائض، لأن ثلاثتهم (معهم معرفة مبادئ الفرائض قسمة وبعض مسائل وصايا الصحيح ومناسخات دون ما عدى ذلك من أبوابها ومشكلاتها لانقراض العلم في كل الأقطار فيما أعلمه، اللهم إلا ما شذ) (2)، غير أن علم الفرائض قد شهد نهضة قوية على يد عبد الرزاق بن حمادوش في القرن الثاني عشر، لأنه كان منشغلا بالعلوم، كالطب والرياضيات والفلك، وألف عدة تآليف، كما سنعرف في فصل العلوم. ويظهر اهتمامه بعلم الفرائض والوثائق من النماذج والجداول التي ساقها في رحلته. فقد ضرب هناك عدة أمثلة وأظهر كيفية حل المشاكل الفرضية بسهولة ويسر وبطريقة مختصرة، وكان في ذلك معتدا بنفسه وعلمه حتى أنه سخر ممن لا يتقن هذه المعلومات البسيطة في نظره (3)، ومن الذين عاصروا ابن حمادوش وكتبوا في الفرائض أيضا محمد بن عبد الرحمن بن حسين العنابي. فقد وجدت له شرحا في هذا الموضوع طبقا للمذهب الحنفي، ولم نستطع أن نتوصل إلى عنوان هذا الشرح (4).
__________
(1) توجد نسخة من هذا الشرح في مكتبة زاوية طولقة، في حوالي مائة ورقة.
(2) الفكون (منشور الهداية)، 61.
(3) انظر دراستنا عن ابن حمادوش ورحلته في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، أبريل 1975، وكذلك في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر).
(4) نسخة منه في مكتبة البرواقية، وقد كتبه المؤلف سنة 1185.
ويبدو أن علم الفرائض قد تدهور بمرور الزمن، وكان ذلك نتيجة ضعف العناية بالحساب والرياصيات عموما. وهذا ما جعل الفكون في القرن الحادي عشر يحكم بانقراض علم الفرائض تقريبا. فقد لاحظ وهو يتحدث عن محمد بن نعمون بأنه كان يعتمد على ولديه في الدرس وفي مسائل الوثائق والفرائض، لأن ثلاثتهم (معهم معرفة مبادئ الفرائض قسمة وبعض مسائل وصايا الصحيح ومناسخات دون ما عدى ذلك من أبوابها ومشكلاتها لانقراض العلم في كل الأقطار فيما أعلمه، اللهم إلا ما شذ) (2)، غير أن علم الفرائض قد شهد نهضة قوية على يد عبد الرزاق بن حمادوش في القرن الثاني عشر، لأنه كان منشغلا بالعلوم، كالطب والرياضيات والفلك، وألف عدة تآليف، كما سنعرف في فصل العلوم. ويظهر اهتمامه بعلم الفرائض والوثائق من النماذج والجداول التي ساقها في رحلته. فقد ضرب هناك عدة أمثلة وأظهر كيفية حل المشاكل الفرضية بسهولة ويسر وبطريقة مختصرة، وكان في ذلك معتدا بنفسه وعلمه حتى أنه سخر ممن لا يتقن هذه المعلومات البسيطة في نظره (3)، ومن الذين عاصروا ابن حمادوش وكتبوا في الفرائض أيضا محمد بن عبد الرحمن بن حسين العنابي. فقد وجدت له شرحا في هذا الموضوع طبقا للمذهب الحنفي، ولم نستطع أن نتوصل إلى عنوان هذا الشرح (4).
__________
(1) توجد نسخة من هذا الشرح في مكتبة زاوية طولقة، في حوالي مائة ورقة.
(2) الفكون (منشور الهداية)، 61.
(3) انظر دراستنا عن ابن حمادوش ورحلته في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، أبريل 1975، وكذلك في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر).
(4) نسخة منه في مكتبة البرواقية، وقد كتبه المؤلف سنة 1185.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وهكذا يتضح أن مساهمة الجزائريين في العلوم الشرعية مساهمة هامة.
ولو عثر على كل مؤلفاتهم أو جلها، ودرست دراسة متخصصة ونقدية لخرجنا من ذلك بتراث غزير. وعسى أن يتواصل البحث في هذا الموضوع الجليل. ذلك أننا عرفنا أن أساس التفكير الجزائري خلال العهد العثماني كان قائما على العلوم الشرعية. فدراسة هذه العلوم إذن ستكشف أكثر فأكثر عن نوعية هذا التفكير ومكانته.
ولو عثر على كل مؤلفاتهم أو جلها، ودرست دراسة متخصصة ونقدية لخرجنا من ذلك بتراث غزير. وعسى أن يتواصل البحث في هذا الموضوع الجليل. ذلك أننا عرفنا أن أساس التفكير الجزائري خلال العهد العثماني كان قائما على العلوم الشرعية. فدراسة هذه العلوم إذن ستكشف أكثر فأكثر عن نوعية هذا التفكير ومكانته.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الفصل الثاني
علم الكلام - التصوف - المنطق
علم الكلام - التصوف - المنطق
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
في عصر ساد فيه التصوف كل شيء في الحياة تقريبا، لا يمكن أن يكون إنتاج علمائه إلا مصبوغا بالزهد والموعظة والالتزام بمبادئ المتصوفين والزهاد (1). ولا يضارع إنتاج الجزائريين في التصوف والمواعظ إلا إنتاجهم الأدبي الذي تلون أيضا بلون التصوف، كما سنرى. ويتصل بالتصوف علم الكلام والمنطق. ولذلك تناولناهما في هذا الفصل أيضا. وليس هناك كتب فلسفية بالمعنى الدقيق للكلمة، فإذا وجدنا شيئا من ذلك، كالجدل والمطارحات ونحوها أدرجناها في هذا الفصل أيضا لصلتها بالمنطق والكلام. أما المواعظ والأذكار ونحوها فقد أضفناها إلى التصوف. ونظرا لأهمية يحيى الشاوي في علم الكلام والردود أفردنا له ترجمة في هذا الفصل.
علم الكلام
شاع لدى الجزائريين استعمال تعبير علم الكلام وعلم التوحيد على حد سواء. وكانوا يعتبرون هذا العلم من أهم العلوم بل هو أهمها. فقد عرفه مصطفى الرماصي في القرن الثاني عشر بما يلي: (علم الكلام أوثق العلوم دليلا، وأوضحها سبيلا، وأشرفها فوائد، وأنجحها مقاصد، إذ به تعرف ذات الحق وصفاته، ويصرف عنه ما لا يليق به ولا تقبله ذاته) (2). ورغم هذا
__________
(1) انظر الفصل السادس من الجزء الأول.
(2) الرماصي (حاشية على أم البراهين للسنوسي) ك 2499 الخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع، في حوالي 300 صفحة، قارن هذه المقالة بمقالة محمد السنوسي أيضا عن علم الكلام في الفصل الأول من الجزء الأول.
علم الكلام
شاع لدى الجزائريين استعمال تعبير علم الكلام وعلم التوحيد على حد سواء. وكانوا يعتبرون هذا العلم من أهم العلوم بل هو أهمها. فقد عرفه مصطفى الرماصي في القرن الثاني عشر بما يلي: (علم الكلام أوثق العلوم دليلا، وأوضحها سبيلا، وأشرفها فوائد، وأنجحها مقاصد، إذ به تعرف ذات الحق وصفاته، ويصرف عنه ما لا يليق به ولا تقبله ذاته) (2). ورغم هذا
__________
(1) انظر الفصل السادس من الجزء الأول.
(2) الرماصي (حاشية على أم البراهين للسنوسي) ك 2499 الخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع، في حوالي 300 صفحة، قارن هذه المقالة بمقالة محمد السنوسي أيضا عن علم الكلام في الفصل الأول من الجزء الأول.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الإلحاح من الرماصي على ضرورة تعلم علم الكلام فإن الورتلاني، الذي عاش في نفس العصر، قد روى أن علماء الخنقة كانوا لا يتعلمون علم الكلام لأنه في نظرهم لا يحتاج إلى دليل. ولعل بعض العلماء كان يهرب من التعمق في علم الكلام لأن ذلك يؤدي في نظرهم إلى الكفر أو الخروج عن الدين. وليست الخلافات المذهبية والفلسفية إلا نتيجة لمدارسة علم الكلام والتعمق فيه والتمادي في الاستباط والبحث عن الأدلة.
والعقائد السائدة لدى الجزائريين هي عقائد الأشعري، وهي عقائد جمهور أهل السنة (1). وكانت مؤلفات محمد بن يوسف السنوسي في العقائد هي المصدر المحلي لدراسة علم الكلام. وقد اصطبغت هذه المؤلفات بالصبغة الصوفية. ورغم أن السنوسي كان يجمع بين علمي الظاهر والباطن فإن شارحيه ومحشيه ودارسي مؤلفاته قد مالوا، تبعا لروح العصر، إلى علوم الباطن. وقد أصبح كل من خالف هذا التيار يتهم بالتجسيم والاعتزال والإيمان بظواهر النصوص، ومن ثمة يحكم عليه بالكفر والزندقة. حدث هذا لعبد القادر الراشدي مفتي قسنطينة في القرن الثامن عشر الميلادي (2)، فقد اتهمه علماء بلده بالكفر والإلحاد لقوله بالتجسيم. وقد انتصر محمد بن الترجمان للأشعري ضد الماتريدي في رسالته (الدر الثمين) التي سنتحدث عنها. وفي إجابته عن قضية تتعلق برؤية الله في الدنيا والآخرة، صرف ابن العنابي الرأي القائل بالمشاهدة الحسية في الدنيا إلى أنه رأى المعتزلة وأنه لا يقول هو به بل يتبع رأي أهل السنة (لوضوح أدلتهم) (3).
__________
(1) من المفيد أن يطالع المرء المناقشة التي دارت في المغرب بين ابن حمادوش الجزائري وأحمد الورززي المغربي حول الاستدلال على أفضلية الأنبياء على الملائكة أو العكس وحول مذهب الأشاعرة وغيرهم، وقد كان الورززي متهما بالأخذ برأي المعتزلة، ابن حمادوش (الرحلة) مخطوطة.
(2) (تعريف الخلف برجال السلف) 2/ 219.
(3) ابن العنابي (مسألة في التوحيد) جواب له على سؤال في هذا الموضوع، ك 1089 الخزانة العامة - الرباط، مجموع.
والعقائد السائدة لدى الجزائريين هي عقائد الأشعري، وهي عقائد جمهور أهل السنة (1). وكانت مؤلفات محمد بن يوسف السنوسي في العقائد هي المصدر المحلي لدراسة علم الكلام. وقد اصطبغت هذه المؤلفات بالصبغة الصوفية. ورغم أن السنوسي كان يجمع بين علمي الظاهر والباطن فإن شارحيه ومحشيه ودارسي مؤلفاته قد مالوا، تبعا لروح العصر، إلى علوم الباطن. وقد أصبح كل من خالف هذا التيار يتهم بالتجسيم والاعتزال والإيمان بظواهر النصوص، ومن ثمة يحكم عليه بالكفر والزندقة. حدث هذا لعبد القادر الراشدي مفتي قسنطينة في القرن الثامن عشر الميلادي (2)، فقد اتهمه علماء بلده بالكفر والإلحاد لقوله بالتجسيم. وقد انتصر محمد بن الترجمان للأشعري ضد الماتريدي في رسالته (الدر الثمين) التي سنتحدث عنها. وفي إجابته عن قضية تتعلق برؤية الله في الدنيا والآخرة، صرف ابن العنابي الرأي القائل بالمشاهدة الحسية في الدنيا إلى أنه رأى المعتزلة وأنه لا يقول هو به بل يتبع رأي أهل السنة (لوضوح أدلتهم) (3).
__________
(1) من المفيد أن يطالع المرء المناقشة التي دارت في المغرب بين ابن حمادوش الجزائري وأحمد الورززي المغربي حول الاستدلال على أفضلية الأنبياء على الملائكة أو العكس وحول مذهب الأشاعرة وغيرهم، وقد كان الورززي متهما بالأخذ برأي المعتزلة، ابن حمادوش (الرحلة) مخطوطة.
(2) (تعريف الخلف برجال السلف) 2/ 219.
(3) ابن العنابي (مسألة في التوحيد) جواب له على سؤال في هذا الموضوع، ك 1089 الخزانة العامة - الرباط، مجموع.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
وتبعا لانتشار المذاهب الإسلامية والمبالغة في التصوف شاعت في الجزائر أيضا تفسيرات كثيرة تتخذ علم الكلام منطلقا لها. فبالإضافة إلى ذات الله وصفاته درس علماء الكلام إيمان العالم وإيمان المقلد، واختلفوا حول ذلك، كما اختلفوا حول تعلق قدرة الله تعالى بالحيز أو لا. فهذا محمد البوزيدي، أحد علماء قسنطينة في القرن الحادي عشر (17 م) كان، كما يقول الفكون، صاحب دعوة كبيرة في علم الكلام. فكان يدرس عقائد السنوسي ومختصر ابن الحاجب الفقهي. وكان يقول بأن (المقلد غير مؤمن وأن العامة مختلف في إيمانها) كما كان يقول إن (قدرة الله لا تتعلق بتحيز الجوهر). ويبدو أن البوزيدي لم يكن وحده في هذا التفسير، فقد أكد الفكون أن (هذا مذهب سرى في جل أهل المغرب سريان النار في الهشيم) (1). ولا ندري من أين جاء هذا المذهب إلى أهل المغرب، ولكن من المؤكد أنه ليس مذهبا جديدا.
سيطرت إذن مؤلفات محمد السنوسي في التوحيد سيطرة تامة على الدارسين لهذا العلم طيلة العهد العثماني. ولم يكن ذلك مقصورا على الجزائر وحدها بل تجاوزها إلى معظم الأقطار العربية والإسلامية، غير أن الذي يهمنا هنا هو سيطرة هذه المؤلفات على الدارسين في الجزائر. وأهم مؤلفات السنوسي المشار إليها هي ما يعرف بالعقائد السنوسية، وهي العقيدة الصغرى والعقيدة الوسطى والعقيدة الكبرى، ولكن أهم الجميع هي الأولى لوضوحها واختصارها، وهي المعروفة أحيانا باسم (أم البراهين). وليس معنى هذا أن العقيدتين الأخريين لم يهتم بهما الدارسون، ولكن معناه أن جهودهم قد تركزت في التدريس والشرح حول العقيدة الصغرى، ويليها العقيدة الوسطى فالكبرى. فأنت لا تكاد تجد عالما خلال هذا العهد لم يدرس لطلابه (صغرى السنوسي)، كما كانت تسمى، أو يتناولها بالشرح والتحشية وأحيانا بشرح المشروح وتحشية المحشى. وقد كثرت هذه الشروح
__________
(1) (منشور الهداية)، كلمة (هشيم) مكتوبة في الأصل (العجم) وذلك سبق قلم، كما يقولون.
سيطرت إذن مؤلفات محمد السنوسي في التوحيد سيطرة تامة على الدارسين لهذا العلم طيلة العهد العثماني. ولم يكن ذلك مقصورا على الجزائر وحدها بل تجاوزها إلى معظم الأقطار العربية والإسلامية، غير أن الذي يهمنا هنا هو سيطرة هذه المؤلفات على الدارسين في الجزائر. وأهم مؤلفات السنوسي المشار إليها هي ما يعرف بالعقائد السنوسية، وهي العقيدة الصغرى والعقيدة الوسطى والعقيدة الكبرى، ولكن أهم الجميع هي الأولى لوضوحها واختصارها، وهي المعروفة أحيانا باسم (أم البراهين). وليس معنى هذا أن العقيدتين الأخريين لم يهتم بهما الدارسون، ولكن معناه أن جهودهم قد تركزت في التدريس والشرح حول العقيدة الصغرى، ويليها العقيدة الوسطى فالكبرى. فأنت لا تكاد تجد عالما خلال هذا العهد لم يدرس لطلابه (صغرى السنوسي)، كما كانت تسمى، أو يتناولها بالشرح والتحشية وأحيانا بشرح المشروح وتحشية المحشى. وقد كثرت هذه الشروح
__________
(1) (منشور الهداية)، كلمة (هشيم) مكتوبة في الأصل (العجم) وذلك سبق قلم، كما يقولون.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
والحواشي على صغرى السنوسي حتى أصبحت بشكل ظاهرة في حد ذاتها، وكأن الفكر الفلسفي والديني قد تجمد عندها فلم يعد قادرا على الخوض في مسائل التوحيد إلا من خلال عمل السنوسي.
وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن شروح عقائد السنوسي نشير إلى عمل آخر في التوحيد كان أيضا قد شغل العلماء في العهد المذكور، ونعني به منظومة أحمد بن عبد الله الجزائري، المعروفة باسم (المنظومة الجزائرية). وكان الجزائري معاصرا للسنوسي، كما عرفنا، وقد نظمها وهو ما يزال شابا (1)، وأرسل بها إلى محمد السنوسي بتلمسان لشرحها فقام هذا بشرح المنظومة شرحا ظل هو أيضا مصدرا آخر هاما للتقليد بين العلماء في هذا الميدان (2). ورغم سهولة (المنظومة الجزائرية) وقربها من عقول الدارسين الشادين، فإن شرح السنوسي عليها هو الذي حببها للعلماء والطلاب على حد سواء، وقد أخذت، هي الأخرى، شهرة واسعة ليس في الجزائر فحسب بل في العالم الإسلامي أيضا، إذ لا تكاد تخلو مكتبة قديمة من مخطوطة منها. ويمكن القول، بدون مبالغة، إن دراسة التوحيد في الجزائر خلال العهد العثماني كانت تقوم على إنتاج السنوسي والجزائري، بالإضافة إلى (إضاءة الدجنة) لأحمد المقري.
وكما شرح السنوسي منظومة الجزائري شرح أيضا أرجوزة محمد بن عبد الرحمن الحوضي المعروفة (بواسطة السلوك) (3). وقد عرف فيها
__________
(1) هذا ما أكده أحمد بن ساسي البوني في إجازته لابنه، وقد تعرضنا إليها. انظر ترجمة البوني في الفصل الأول من هذا الجزء.
(2) هناك نسخ كثيرة لهذا الشرح، منها نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر التي تعود إلى سنة 884 (1479)، وهي في 268 ورقة تحت رقم 2178، وعن السنوسي والجزائري انظر الفصل الأول من الجزء الأول.
(3) بروكلمان 2/ 992، وتوجد منها نسخة في المكتبة الوطنية بالجزائر رقم 899، منسوخة بقلم عبد القادر بن عمر الحارثي سنة 938، ولعله كان من تلاميذ الحوضي، انظر عن الحوضي الفصل الأول من الجزء الأول.
وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن شروح عقائد السنوسي نشير إلى عمل آخر في التوحيد كان أيضا قد شغل العلماء في العهد المذكور، ونعني به منظومة أحمد بن عبد الله الجزائري، المعروفة باسم (المنظومة الجزائرية). وكان الجزائري معاصرا للسنوسي، كما عرفنا، وقد نظمها وهو ما يزال شابا (1)، وأرسل بها إلى محمد السنوسي بتلمسان لشرحها فقام هذا بشرح المنظومة شرحا ظل هو أيضا مصدرا آخر هاما للتقليد بين العلماء في هذا الميدان (2). ورغم سهولة (المنظومة الجزائرية) وقربها من عقول الدارسين الشادين، فإن شرح السنوسي عليها هو الذي حببها للعلماء والطلاب على حد سواء، وقد أخذت، هي الأخرى، شهرة واسعة ليس في الجزائر فحسب بل في العالم الإسلامي أيضا، إذ لا تكاد تخلو مكتبة قديمة من مخطوطة منها. ويمكن القول، بدون مبالغة، إن دراسة التوحيد في الجزائر خلال العهد العثماني كانت تقوم على إنتاج السنوسي والجزائري، بالإضافة إلى (إضاءة الدجنة) لأحمد المقري.
وكما شرح السنوسي منظومة الجزائري شرح أيضا أرجوزة محمد بن عبد الرحمن الحوضي المعروفة (بواسطة السلوك) (3). وقد عرف فيها
__________
(1) هذا ما أكده أحمد بن ساسي البوني في إجازته لابنه، وقد تعرضنا إليها. انظر ترجمة البوني في الفصل الأول من هذا الجزء.
(2) هناك نسخ كثيرة لهذا الشرح، منها نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر التي تعود إلى سنة 884 (1479)، وهي في 268 ورقة تحت رقم 2178، وعن السنوسي والجزائري انظر الفصل الأول من الجزء الأول.
(3) بروكلمان 2/ 992، وتوجد منها نسخة في المكتبة الوطنية بالجزائر رقم 899، منسوخة بقلم عبد القادر بن عمر الحارثي سنة 938، ولعله كان من تلاميذ الحوضي، انظر عن الحوضي الفصل الأول من الجزء الأول.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
الحوضي علم التوحيد أيضا بأنه (أشرف العلوم) وأنه أساس جميع العلوم. وفيها نظم جميع مسائل التوحيد المتعارف عليها، وجعلها سهلة مفهومة التعبير قريبة المعنى (يقرأها الصبيان في المكاتب) وتؤدي إلى إدراك قضايا التوحيد حتى يخرج قارئها من التقليد الأعمى في معرفة الله، كما أنه جعلها في متناول الكبار المنصفين من العلماء لاختصارها لمسائل المطولات. وقد كان الحوضي شاعرا بالسليقة ولذلك كانت أرجوزته سلسة العبارة وجيدة.
ورغم أن أحمد بن زكرى التلمساني، المعاصر للسنوسي أيضا، قد اشتهر، كما عرفنا، بدراسة التوحيد والتأليف فيه، فإن شهرته فيه لم تبلغ شهرة زميله السنوسي. ومع ذلك فقد كانا فرسي رهان في هذا الميدان. فقد ألف أحمد بن زكري رجزا في التوحيد سماه (محصل المقاصد به تعتبر العقائد)، وهو الذي وصفه ابن عسكر بأنه عمل بلا نظير (1)، وهو أيضا الرجز الذي اعتذر السنوسي عن شرحه قائلا إنه لا أحد يقدر على ذلك سوى الناظم نفسه. ورغم صعوبة عمل ابن زكرى فقد قام الورثلاني في القرن الثاني عشر بشرح (محصل المقاصد)، ولكنه أخبر أنه لم يتمه.
فإذا عدنا إلى عقائد السنوسي، وجدنا أن شراحها كثيرون، ومن أوائل من شرح العقيدة الصغرى تلميذه ومترجمه محمد بن عمر الملالي (2)، كما تناولها أحمد بن أغادير الذي كان، كما يقول ابن عسكر، من جبال بني راشد. ونحن لا نعرف عن هذا الشرح أكثر مما ذكره عنه صاحب (دوحة الناشر). فقد قال إن كتب ابن أغادير كانت منبعا للباحثين، ولا سيما في علم التوحيد والشريعة، كما أنه قد نسب إليه (تعاليق) لا ندري موضوعها.
ولكن شهرة ابن أغادير ظلت كشهرة السنوسي وابن زكرى، تقوم على علم
__________
(1) (دوحة الناشر) لابن عسكر (الترجمة الفرنسية)، 205، وعن ابن زكرى انظر الفصل الأول من الجزء الأول.
(2) الخزانة الملكية بالرباط، رقم 9073، مجموع، والشرح في حوالي 26 ورقة.
ورغم أن أحمد بن زكرى التلمساني، المعاصر للسنوسي أيضا، قد اشتهر، كما عرفنا، بدراسة التوحيد والتأليف فيه، فإن شهرته فيه لم تبلغ شهرة زميله السنوسي. ومع ذلك فقد كانا فرسي رهان في هذا الميدان. فقد ألف أحمد بن زكري رجزا في التوحيد سماه (محصل المقاصد به تعتبر العقائد)، وهو الذي وصفه ابن عسكر بأنه عمل بلا نظير (1)، وهو أيضا الرجز الذي اعتذر السنوسي عن شرحه قائلا إنه لا أحد يقدر على ذلك سوى الناظم نفسه. ورغم صعوبة عمل ابن زكرى فقد قام الورثلاني في القرن الثاني عشر بشرح (محصل المقاصد)، ولكنه أخبر أنه لم يتمه.
فإذا عدنا إلى عقائد السنوسي، وجدنا أن شراحها كثيرون، ومن أوائل من شرح العقيدة الصغرى تلميذه ومترجمه محمد بن عمر الملالي (2)، كما تناولها أحمد بن أغادير الذي كان، كما يقول ابن عسكر، من جبال بني راشد. ونحن لا نعرف عن هذا الشرح أكثر مما ذكره عنه صاحب (دوحة الناشر). فقد قال إن كتب ابن أغادير كانت منبعا للباحثين، ولا سيما في علم التوحيد والشريعة، كما أنه قد نسب إليه (تعاليق) لا ندري موضوعها.
ولكن شهرة ابن أغادير ظلت كشهرة السنوسي وابن زكرى، تقوم على علم
__________
(1) (دوحة الناشر) لابن عسكر (الترجمة الفرنسية)، 205، وعن ابن زكرى انظر الفصل الأول من الجزء الأول.
(2) الخزانة الملكية بالرباط، رقم 9073، مجموع، والشرح في حوالي 26 ورقة.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
التوحيد (1). وحوالي نفس الفترة قام الشيخ عمر الوزان في قسنطينة بشرح الصغرى أيضا (2). ومن تلاميذ الوزان عبد الرحمن الأخصري، الذي شرح أيضا صغرى السنوسي، وهو الشرح المذكور ضمن مؤلفاته (3). وقد عرف الأخضري بنظم العلوم المختلفة ومنها مسائل التوحيد، وينسب إليه رجز في ذلك أيضا. ولكن ليس من المعروف ما إذا كان قد شرحه بنفسه.
ومن الذين كتبوا عن العقيدة الصغرى للسنوسي وتناولوها بالتدريس والتعليق، سعيد قدورة. فقد كان من مشاهير المدرسين، كما سبق. وكان لا يكاد يترك علما يدرسه لطلابه إلا ووضع عليه شرحا أو حاشية. ومن ذلك شرحه لعقيدة السنوسي. فقد درسها لطلابه متنا وشرحا، ثم بدا له أن يضيف إلى شرح السنوسي نفسه فوائد كان قدورة يستحسنها وزوائد كان قد قيدها من هنا وهناك، وقرر أن يجعل كل ذلك (حاشية) على الشرح المذكور. وقد اتبع قدورة في حاشيته نفس الأسلوب المتبع عندئذ وهو شرح الألفاظ والمعاني والاستنتاج بالتعاليق الدينية وما يجر إليه الظرف من أحكام (4).
وهناك عالم آخر لم يبلغ شهرة قدورة ولكنه لا يقل عنه ورعا وعلما، وهو مصطفى الرماصي. فقد وضع أيضا حاشية على شرح صغرى السنوسي. وبعد أن أشار إلى أن الصغرى عظيمة الفائدة (لبركة مؤلفها) وأن السنوسي أشهر من ألف في عمل الكلام رغم كثرة المعتزين به، قال إن بعض المعاصرين من إخوانه قد طلبوا منه وضع حاشية عليها فأجابهم إلى طلبهم.
__________
(1) (دوحة الناشر) 222، وبناء عليه فإن ابن أغادير مات في بداية العقد الخامس من القرن العاشر.
(2) (نيل الابتهاج) 197.
(3) انظر لوسياني ترجمة (السلم)، 5 - 6، وقد عد الورثلاني حوالي ثلاثين تأليفا للأخضري. انظر أيضا (العقد الجوهري) لأحمد بن داود، وهو مخطوط خاص، وكذلك الخزانة العامة بالرباط، رقم د 3228.
(4) المكتبة الملكية بالرباط، رقم 4496 مجموع، والمكتبة الوطنية بتونس (ح. ح. عبد الوهاب)، رقم 18713.
ومن الذين كتبوا عن العقيدة الصغرى للسنوسي وتناولوها بالتدريس والتعليق، سعيد قدورة. فقد كان من مشاهير المدرسين، كما سبق. وكان لا يكاد يترك علما يدرسه لطلابه إلا ووضع عليه شرحا أو حاشية. ومن ذلك شرحه لعقيدة السنوسي. فقد درسها لطلابه متنا وشرحا، ثم بدا له أن يضيف إلى شرح السنوسي نفسه فوائد كان قدورة يستحسنها وزوائد كان قد قيدها من هنا وهناك، وقرر أن يجعل كل ذلك (حاشية) على الشرح المذكور. وقد اتبع قدورة في حاشيته نفس الأسلوب المتبع عندئذ وهو شرح الألفاظ والمعاني والاستنتاج بالتعاليق الدينية وما يجر إليه الظرف من أحكام (4).
وهناك عالم آخر لم يبلغ شهرة قدورة ولكنه لا يقل عنه ورعا وعلما، وهو مصطفى الرماصي. فقد وضع أيضا حاشية على شرح صغرى السنوسي. وبعد أن أشار إلى أن الصغرى عظيمة الفائدة (لبركة مؤلفها) وأن السنوسي أشهر من ألف في عمل الكلام رغم كثرة المعتزين به، قال إن بعض المعاصرين من إخوانه قد طلبوا منه وضع حاشية عليها فأجابهم إلى طلبهم.
__________
(1) (دوحة الناشر) 222، وبناء عليه فإن ابن أغادير مات في بداية العقد الخامس من القرن العاشر.
(2) (نيل الابتهاج) 197.
(3) انظر لوسياني ترجمة (السلم)، 5 - 6، وقد عد الورثلاني حوالي ثلاثين تأليفا للأخضري. انظر أيضا (العقد الجوهري) لأحمد بن داود، وهو مخطوط خاص، وكذلك الخزانة العامة بالرباط، رقم د 3228.
(4) المكتبة الملكية بالرباط، رقم 4496 مجموع، والمكتبة الوطنية بتونس (ح. ح. عبد الوهاب)، رقم 18713.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
ولم يذكر الرماصي المنهج الذي سار عليه في تعليقه بل دخل مباشرة في عمله فبدأ يبين ألفاظ ومعاني كلام السنوسي. فكلامه إذن كلام تقليدي، وإنما أضاف إليه معارفه الخاصة وأسلوبه. وهذه الحاشية تعتبر جهدا ضخما إذا حكمنا من حجمها (1).
وقام الورتلاني بشرح وتحشية عمل السنوسي أيضا. فالورثلاني، كما عرفنا، كان مولعا بعلم التوحيد، وقد ناقش فيه علماء الخنقة وانتصر له وبين أنه ضرورى لمعرفة الله، وأنه ضروري أيضا للمتصوف. وكان السنوسى، الذي يسمونه أحيانا (شيخ الموحدين) قد قال عن علم الكلام (ليس علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته إلا علم التوحيد وبه يفتح له في فهم العلوم كلها. وعلى قدر معرفته به يزداد خوفه منه تعالى وقربه منه) (2). لذلك وضع الورثلاني شرحا على خطبة أو مقدمة شرح السنوسي على صغراه، كما وضع حاشية على شرح السكتاني المراكشي على صغرى السنوسي أيضا. وقد أخبر الورثلاني في رحلته أنه أطلع الشيخ الحطاب في مصر على هذين العملين فاستحسنهما، وكان ذلك أثناء توجهه إلى الحج (3). ومن هذه الإشارة نفهم أن الورثلاني قد أكمل الشرح والحاشية. والورثلاني من العلماء القلائل الذين وضعوا أيضا شرحا على وسطى السنوسي. وهذا كله يبرهن على عنايته بعلم التوحيد.
ولكن الورثلاني لم يكن وحده في هذه العناية. فقد عرفنا أن معظم العلماء كانوا يدرسون علم التوحيد ويكتبون فيه. ومن هؤلاء ابن مريم. فهو تبعا لمدرسة السنوسي، قد جمع أيضا بين التصوف وعلم الكلام وألف في الاثنين. ومن تآليفه في علم الكلام (كشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل
__________
(1) الخزانة العامة بالرباط، ك 2499، مجموع، والنسخة التي اطلعنا عليها نسخها يحيى بن عبد القادر بن شهيدة بتلمسان سنة 1236، وقد انتهى الرماصي من حاشيته سنة 1105، وتبلغ حوالي ثلاثمائة صفحة.
(2) روى ذلك ابن مريم في (البستان) 277.
(3) الورتلاني (الرحلة) 284.
وقام الورتلاني بشرح وتحشية عمل السنوسي أيضا. فالورثلاني، كما عرفنا، كان مولعا بعلم التوحيد، وقد ناقش فيه علماء الخنقة وانتصر له وبين أنه ضرورى لمعرفة الله، وأنه ضروري أيضا للمتصوف. وكان السنوسى، الذي يسمونه أحيانا (شيخ الموحدين) قد قال عن علم الكلام (ليس علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته إلا علم التوحيد وبه يفتح له في فهم العلوم كلها. وعلى قدر معرفته به يزداد خوفه منه تعالى وقربه منه) (2). لذلك وضع الورثلاني شرحا على خطبة أو مقدمة شرح السنوسي على صغراه، كما وضع حاشية على شرح السكتاني المراكشي على صغرى السنوسي أيضا. وقد أخبر الورثلاني في رحلته أنه أطلع الشيخ الحطاب في مصر على هذين العملين فاستحسنهما، وكان ذلك أثناء توجهه إلى الحج (3). ومن هذه الإشارة نفهم أن الورثلاني قد أكمل الشرح والحاشية. والورثلاني من العلماء القلائل الذين وضعوا أيضا شرحا على وسطى السنوسي. وهذا كله يبرهن على عنايته بعلم التوحيد.
ولكن الورثلاني لم يكن وحده في هذه العناية. فقد عرفنا أن معظم العلماء كانوا يدرسون علم التوحيد ويكتبون فيه. ومن هؤلاء ابن مريم. فهو تبعا لمدرسة السنوسي، قد جمع أيضا بين التصوف وعلم الكلام وألف في الاثنين. ومن تآليفه في علم الكلام (كشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل
__________
(1) الخزانة العامة بالرباط، ك 2499، مجموع، والنسخة التي اطلعنا عليها نسخها يحيى بن عبد القادر بن شهيدة بتلمسان سنة 1236، وقد انتهى الرماصي من حاشيته سنة 1105، وتبلغ حوالي ثلاثمائة صفحة.
(2) روى ذلك ابن مريم في (البستان) 277.
(3) الورتلاني (الرحلة) 284.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
التوحيد)، وشرح له على مختصر الصغرى للسنوسي (1). كما قام الشيخ خليفة بن حسن القماري بشرح الصغرى أيضا، والظاهر أنه شرح كبير لأنه قد قسمه إلى خمسة أقسام وجعل كل قسم أجزاء، وهكذا (2). ورغم عناية ابن حمادوش بالفلك والطب فإنه تأثر بتيار العصر فكتب شرحا على العقيدة الكبرى سماه (مباحث الذكرى في شرح العقيدة الكبرى). وقد قال إنه مزج به ألفاظها واستخرج به نضارها (فجاء بحمد الله يرضي الناظرين ويعين القاصرين، مشتملا على خمسة وستين مبحثا)، وأخبر ابن حمادوش أن شرحه قد اشتمل على تسع عشرة كراسة (3). وقد وضع محمد بن عبد المؤمن أرجوزة في العقائد والفروع، كما سبق، وجعل جزأها الأول في العقائد أو علم الكلام وبدأها بقوله:
الله موجود قديم باقي ... مخالف للخلق بالإطلاق
وقائم بنفسه وأحد ... ذاتا وفعلا صفة يعتقد
ثم الوجود صفة نفسية ... والخمسة الأخرى غدت سلبية
وأرجوزة ابن عبد المؤمن، بقسميها، سهلة واضحة، لأن صاحبها أيضا من العلماء الأدباء والأدباء العلماء كما يقول ابن حمادوش. وقد أجاز ابن عبد المؤمن بهذه الأرجوزة الرحالة المغربي ابن زاكور ورخص له في شرحها إذا أراد (4).
وقد أصبحت (إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة) لأحمد المقري تنافس عقيدة السنوسي في الأهمية. فقد عرفنا أن المقري كان من المبرزين في الحديث والتوحيد بالإضافة إلى الأدب والتاريخ، وهو على خلاف معظم علماء عصره لم يكن من المتصوفة. كتب المقري (إضاءة الدجنة) نظما بلغ فيه حوالي خمسمائة بيت تناول فيها أصول الدين وقضايا التوحيد. وقام
__________
(1) ذكر ذلك ضمن كتبه في (البستان) 314.
(2) محمد الطاهر التليلي (إتحاف القاري)، مخطوط خاص.
(3) ابن حمادوش (الرحلة)، وهي الآن مطبوعة.
(4) ابن زاكور (الرحلة) 17.
الله موجود قديم باقي ... مخالف للخلق بالإطلاق
وقائم بنفسه وأحد ... ذاتا وفعلا صفة يعتقد
ثم الوجود صفة نفسية ... والخمسة الأخرى غدت سلبية
وأرجوزة ابن عبد المؤمن، بقسميها، سهلة واضحة، لأن صاحبها أيضا من العلماء الأدباء والأدباء العلماء كما يقول ابن حمادوش. وقد أجاز ابن عبد المؤمن بهذه الأرجوزة الرحالة المغربي ابن زاكور ورخص له في شرحها إذا أراد (4).
وقد أصبحت (إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة) لأحمد المقري تنافس عقيدة السنوسي في الأهمية. فقد عرفنا أن المقري كان من المبرزين في الحديث والتوحيد بالإضافة إلى الأدب والتاريخ، وهو على خلاف معظم علماء عصره لم يكن من المتصوفة. كتب المقري (إضاءة الدجنة) نظما بلغ فيه حوالي خمسمائة بيت تناول فيها أصول الدين وقضايا التوحيد. وقام
__________
(1) ذكر ذلك ضمن كتبه في (البستان) 314.
(2) محمد الطاهر التليلي (إتحاف القاري)، مخطوط خاص.
(3) ابن حمادوش (الرحلة)، وهي الآن مطبوعة.
(4) ابن زاكور (الرحلة) 17.
تاريخ التسجيل: Aug 2016
رقم العضوية : 15
المشاركات: 1,246
:
:
بتدريسها في مكة ومصر ودمشق، وأجاز بها بعض العلماء الذين كانوا يحضرون درسه فيها، ومنهم أحمد الشاهين بدمشق. وقد لخص المقري كل ذلك في هذه الأبيات:
وإنني كنت نظمت فيه ... لطالب عقيدة تكفيه
سميتها (إضاءة الدجنة) ... وقد رجوت أن تكون جنه
وبعد أن أقرأتها بمصر ... ومكة بعضا من أهل العصر
درستها لما دخلت الشاما ... بجامع في الحسن لا يسامي (1)
ولأهميتها وسلاستها قام عدد من العلماء بشرحها. ولا يعرف أن ناظمها قد شرحها بنفسه اللهم إلا إملاءاته على طلابه حين تدريسها. فقد أخبر المقري أن معاصره عبد الكريم الفكون القسنطيني كان ينوي وضع تقييد على (إضاءة الدجنة) (2). ولا ندري إن كان الفكون قد قام فعلا بذلك، فقد رأيناه شديد النقد للمقري في أخلاقه، كما أن الفكون لم يذكر ذلك في مؤلفاته التي أشار إليها في كتابه (منشور الهداية). والغالب على الظن أنه لم يفعل. ولكن الذي قام بشرحها فعلا وأعجب بصاحبها هو محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي. وذكر محمد بن الأعمش دافعه في وضع شرح على (إضاءة الدجنة) وهو كون المقري قد جعلها (في نظم عجيب وأسلوب غريب. ونفخ فيها ما في المطولات بأوجز لفظ وأحسن ترتيب). والملاحظ أن ابن الأعمش قد اعتمد في شرحه على عقائد السنوسي أيضا (3). وهناك شروم أخرى على إضاءة الدجنة (4).
__________
(1) (نفح الطيب) 3/ 101، وهو يشير بـ (فيه) إلى علم الكلام وبالجامع إلى الجامع الأموي بدمشق.
(2) نفس المصدر 3/ 240.
(3) المكتبة الوطنية - باريس، رقم 2443 مجموع، واسم شرح الشنقيطي هو (فتوحات ذي الرحمة والمنة في شرح إضاءة الدجنة).
(4) نفس المصدر، رقم 5432، مجموع.
وإنني كنت نظمت فيه ... لطالب عقيدة تكفيه
سميتها (إضاءة الدجنة) ... وقد رجوت أن تكون جنه
وبعد أن أقرأتها بمصر ... ومكة بعضا من أهل العصر
درستها لما دخلت الشاما ... بجامع في الحسن لا يسامي (1)
ولأهميتها وسلاستها قام عدد من العلماء بشرحها. ولا يعرف أن ناظمها قد شرحها بنفسه اللهم إلا إملاءاته على طلابه حين تدريسها. فقد أخبر المقري أن معاصره عبد الكريم الفكون القسنطيني كان ينوي وضع تقييد على (إضاءة الدجنة) (2). ولا ندري إن كان الفكون قد قام فعلا بذلك، فقد رأيناه شديد النقد للمقري في أخلاقه، كما أن الفكون لم يذكر ذلك في مؤلفاته التي أشار إليها في كتابه (منشور الهداية). والغالب على الظن أنه لم يفعل. ولكن الذي قام بشرحها فعلا وأعجب بصاحبها هو محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي. وذكر محمد بن الأعمش دافعه في وضع شرح على (إضاءة الدجنة) وهو كون المقري قد جعلها (في نظم عجيب وأسلوب غريب. ونفخ فيها ما في المطولات بأوجز لفظ وأحسن ترتيب). والملاحظ أن ابن الأعمش قد اعتمد في شرحه على عقائد السنوسي أيضا (3). وهناك شروم أخرى على إضاءة الدجنة (4).
__________
(1) (نفح الطيب) 3/ 101، وهو يشير بـ (فيه) إلى علم الكلام وبالجامع إلى الجامع الأموي بدمشق.
(2) نفس المصدر 3/ 240.
(3) المكتبة الوطنية - باريس، رقم 2443 مجموع، واسم شرح الشنقيطي هو (فتوحات ذي الرحمة والمنة في شرح إضاءة الدجنة).
(4) نفس المصدر، رقم 5432، مجموع.
|
إضافة رد
|

|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
 الإعلانات النصية |
|||
|
|||||


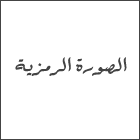




 العرض العادي
العرض العادي
