تاريخ التسجيل: Oct 2019
رقم العضوية : 154
المشاركات: 1,917
:
:
http://www.shamela.ws
تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
الكتاب: كتاب العين
المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ)
المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي
الناشر: دار ومكتبة الهلال
عدد الأجزاء: 8
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
حاول منه العرضُ طولاً سَلْهَبا ... أكْتَدَ دُعْميَّ الحوامي جسزبا
ودُعْمِيُّ كلِّ شيءٍ أشدُّه وأكْثَرُهُ. والدَّعْمُ: تقويةُ الشيءِ الواهنِ، نحو: الحائط المائل فتدعَمه بدِعامةٍ من خلفه، وبه يشبّه الرّجل السيّد يقال: دِعامةُ العشيرة، أي: به يتقوَّوْن. ودعائم الأمور: ما كان قوامها.
معد: الْمَعِدَةُ: [ما] «15» يستوعبُ الطعام من الإنسان، والمِعْدَةُ لغةٌ. قال: «16»
معداً وقلْ لجارتَيْك تمعدا ... إنّي أرى المعد عليها أجودا
قال هذا ساقٍ يسقي إبِلَهُ فاستعان بجاريته إذ لا أعوان له يقول: امعدْ ونادِ جاريتك. والمَعْدُ: أن تأخذَ الشيء من الرّجل ويأخذَهُ منك. والمَعْدُ: نزعُ الماء من البئر. ومُعِدَ الرّجل فهو [مَمْعُودٌ «17» ] ، أي: دويت معدته فلم يستمرىء ما يأكل واشتكاها. ويجوز جمعه على المِعَدِ. مَعَدّ: اسم أبي نزار. والتّمعدُدُ: الصبر على عيشهم في سفر وحضر. تَمَعْدَدَ فلانٌ. وكذلك إذا عاد إليهم بعد التحوّل عنهم إلى غيرهم.
__________
(15) زيادة اقتضاها السياق.
(16) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في المراجع.
(17) ص، ط: معمود. س: معود.
(2/61)
________________________________________
والمَعَدُّ مشددة الدّال: اللحم الذي تحت الكتف، أو أسفل منه قليلاً، من أطيب لحم الجنب «18» . ويقال: المَعَدّان من الفرس ما بين كتفيه إلى مؤخر متنيه. قال ابن أحمر «19» :
وإمّا زالَ سرجٌ عن معدٍّ ... وأَجْدِرْ بالحوادثِ أن تكونا
وقال «20» :
وكأنّما تحتَ المعدِّ ضئيلةٌ ... ينفي رُقادَكَ لَدْغُها وسِمامُها
ومَثَلٌ تضربه العرب: قد يأكلُ المعدّيّ أكل السوء، وهو في الإشتقاق يخرج على مَفْعَل، وعلى تقدير فَعَلٍّ على مثال عَلَدٍّ ونحوه، ولم يشتقّ منه فِعْلٌ. مَعْدان: اسم رجل، ولو اشتق منه من سعة المعدة فقيل: معدان واسع المعدة لكان صواباً. والمُعَيْديْ: رجل من كنانة صغير الجثة عظيم الهيبة قال له النّعمان: أن تسمع بالمعَيْديْ خير من أن تراه فذهب مثلا. والمعد: الجَذْبُ. مَعَدْته مَعْداً. ويقال: امْعَدْ دَلْوَكَ، أي: انزَعْها وأَخْرِجْها من البئر. قال الراجز «21» :
يا سعدُ يا ابن عَمَل يا سَعْدُ ... هل يُروِيَنْ ذَوْدَكَ نَزْعٌ معد
__________
(18) س: الجيب، وهو تصحيف.
(19) البيت في التهذيب 2/ 261 والرواية فيه: فإما زل.
(20) البيت في التهذيب 2/ 261، والرواية فيه: سمها وسمامها. وفي اللسان (معد) والرواية فيه: سمها وسماعها.
(21) القائل: (أحمد بن جندل السعدي) كما في المحكم 2/ 30 واللسان (معد) . غير أن الرواية في اللسان: يا ابن عمر. والثاني في التهذيب 2/ 259 بدون عزو.
(2/62)
________________________________________
والمَعْدُ: الغضّ من الثّمار. والتَّمَعْدُدُ: التّردُّد في الّلصوصيّة.
دمع: دَمِعَتِ العينُ تدمَعُ دَمَعاً ودَمْعاً ودُمُوعاً. من قال: دمعت قال: دمعا، ومن قال: دَمَعَتْ قال: دَمْعاً. وعين دامعة، والدّمْع: ماؤها. والدَّمْعَة القطرة. والمَدْمَعُ: مجتمع الدّمع في نواحيها. يقال: فاضت مدامعي ومدامع عيني. والماقيان من المدامع، وكذلك المؤخّران. وامرأة دَمِعَةٌ: سريعة الدمعة والبكاء، وإذا قلت: ما أكثر دَمْعَتَها خفّفت، لأنّ ذلك تأنيث الدمع. قال «22» :
قد بليت مهجتي وقد قرح المد ... مع ...
ويقال للماء الصّافي: كأنّه دمعة. والدَّمّاع من الثّرى ما تراه يتحلّب عنه النّدى، أو يكاد. قال «23» :
من كلِّ دمَّاعِ الثَّرَى مُطَلَّلِ ... يُثِرْنَ صيفيّ الظّباءِ الغُفَّلِ
ودُمّاعُ الكَرْمِ ما يسيل منه أيّام الربيع. والدَّمّاعُ: ما تحرّك من رأس الصبيّ إذا ولد ما لم «24» يشتدّ، وهي اللّمّاعة والغاذية أيضاً. وشجّة دامعة: تسيل دما.
__________
(22) هكذا في النسخ ولم نقف عليه في المراجع التي بين أيدينا.
(23) لم نهتد إلى القائل. والأول في المحكم 2/ 32 وفي اللسان (دمع) بلا عزو أيضا.
(24) نفس المصدر السابق.
(2/63)
________________________________________
باب العين والتاء والذال معهما ذ ع ت يستعمل فقط
ذعت: ذَعَتُّ فلاناً أَذْعَتُهُ ذَعْتاً إذا أخذتَ برأسه ووَجْهِهِ فمعكتَهُ في التراب مَعْكاً كأنّك تَغُطُّه في الماء، ولا يكون الذّعتُ إلا كذلك. ويقال: الذّعتُ: الخَنْقُ. ذَعَتّه: خَنَقْته، حتى قَتَلْته.
(2/64)
________________________________________
باب العين والتاء والراء معهما ع ت ر- ت ر ع- ر ت ع مستعملات
عتر: عَتَرَ الرّمْحُ يَعْتِرُ عَتْراً وعَتَراناً، أي: اضطرب وتراءد في اهتزاز. قال «1» :
من كلِّ خَطّيٍّ إذا هُزَّ عَتَرْ
والعَتِيرة: شاة تذبح ويصب دمها [على رأ] «2» س الصَّنَم. والعاتِرُ: الذي يَعْتِرُ شاةً، يفعلونه في الجاهليّة، وهي المعتورة. قال «3» :
فَخَرَّ صريعاً مِثْلَ عاتِرةِ النُّسْكِ
أراد الشاةَ المعتورةَ. وربما أدخلوا الفاعل على المفعول إذا جعلوه صاحب واحد ذلك الوصف. كقولهم: أَمْرٌ عارفٌ، أي: معروفٌ، ولكن أرادوا أمراً ذا معرفةٍ، كما تقول: رجل كاس، أي: ذو كسوة، ونحوه وقوله: فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ «4» *، أي: مرضيّة. وجمعه عتائر وعتيرات. قال «5» :
عتائر مظلوم الهدي المذبح
__________
(1) الرجز في المحكم 2/ 32. بلا عزو.
(2) تتمة من اللسان (عتر) وهي في الأصل (ص) : بياض. في ط: ومهلهل. وفي س: مهلهد.
(3) لم نهتد إلى القائل. والشطر في التهذيب 2/ 263 وفي المحكم 2/ 32.
(4) سورة القارعة 7.
(5) لم نهتد إلى القائل ولا القول.
(2/65)
________________________________________
وأمّا العِتْر فاختلف فيه. قالوا: العِتْر مثل الذِّبْح، ويقال: هو الصّنم الذي كان تُعْتَرُ له العتائر في رجب. قال زهير «6» :
كناصبِ العِتْرِ دمَّى رأسَهُ النُّسُكُ
يصف صقراً وقطاة، ويُروَى: كَمَنْصِبِ العِتْر، يقول: كمنصب ذلك الصَّنَم أو الحجر الذي يُدَمَّى بدم العتيرة. ومن روى: كناصب العتر يقول: إنّ العاتر إذا عتر عتيرته دمّى نفسه ونصبه إلى جنب الصّنم فوق شرف من الأرض ليعلم أنه ذبح لذلك. وعِترةُ الرجل: أصله. وعِتْرَةُ الرَّجلِ أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمّه دِنْياً. وعِتْرةُ الثّغرِ إذا رقّت غروب الأسنان ونقيت وجَرَى عليها الماء فتلك العِتْرة. ويقال: إنّ ثغرَها لذو أُشْرَةٍ وعِتْرَةٍ. وعِتْرَةُ المسحاةِ: خشبتها التي تسمى يد المسحاة. عتوارة: اسم رجل من بني كنانة. والعِتْرَةُ أيضاً: بقلة إذا طالت قطع أصلها، فيخرج منه لبنٌ. قال «7» :
فما كنت أخشَى أن أقيم خلافهم ... لستة أبيات كما ينبت العِتْرُ
لأنه إذا قطع أصله نبتتت من حواليْه شُعَبٌ ستّ أو ثلاث، ولأن أصل العتر أقلّ من فرعه، وقال: لا تكون العترة أبداً كثيرة إنّما هنّ شجرات بمكان، وشجرات بمكان لا تملأ الوادي، ولها جراء شبهُ جراءِ العُلْقَة. والعُلْقَة شجرة يدبغ بها الأُهُب. والعِتْرَةُ [نبتة «8» ] طيبة يأكلها الناس ويأكلون جراءها.
__________
(6) ديوانه ص 178. وصدر البيت فيه:
فزل عنها ووافى رأس مرقبة
(7) البريق (عياض بن خويلد) . ديوان الهذليين 3/ 59.
(8) زيادة اقتضاها السياق.
(2/66)
________________________________________
ترع: التَّرَعُ: امتلاء الإِناء. تَرِعَ يَتْرَعُ تَرَعاً، وأترعته. قال جرير «9» :
فهنا كم ببابه رادحات ... من ذرى الكوم مترعات ركود
وقال «10» :
فافترش الأرض بسيلٍ أترعا
أي: ملأ الأرض ملءً شديداً. وقال بعضهم: لا أقول تَرِعَ الإناء في موضع الإمتلاء، ولكن أترع. ويقولون: تَرِعَ الرجلُ، أي: اقتحم الأمور مرحاً ونشاطاً، يَتْرَعُ تَرَعاً. قال «11» :
الباغيَ الحرب يسعى نحوها تَرِعاً ... حتى إذا ذاق منها جاحماً بردا
ترعاً، أي: ممتلئاً نشيطاً، جاحماً، أي: لهباً ووقوداً. وإنّه لمتَتَرِّعٌ إلى كذا، أي: متسّرع.
وقول رسول الله ص: إنّ مِنْبَري على تُرْعَةٍ من تُرَعِ الجنّة «12» .
يقال: هي الدّرجة، ويقال: هي البابُ، كأنّه قال: إنّ مِنْبَري على باب من أبواب الجنّة. والتُّرعَةُ، والجماعةُ التُّرَعُ: أفواه الجداول تفجر من الأنهار فيها وتُسْكَرُ إذا ساقوا الماء.
رتع: الرَّتْعُ: الأكل والشّرب في الربيع رغدا.
__________
(9) ليس في ديوانه، ولم نقف عليه فيما بين أيدينا من مراجع.
(10) (رؤبة) ديوانه. أرجوزة 33 ب 180 ص 92.
(11) لم نهتد إلى القائل، والبيت في التهذيب 2/ 267، وفي اللسان (ترع) .
(12) الحديث في التهذيب 2/ 266 والرواية فيه: إن منبري هذا..
(2/67)
________________________________________
رَتَعَتِ الإبلُ رَتْعاً، وأَرْتَعْتُها: ألقيتها في الخصب. قال العجّاج «13» :
يرتاد من أربا لهنَّ الرُّتَّعا
فأمّا إذا قلت: ارْتَعَتِ الإبل ترتعي فإنّما هو تفتعل من الرّعي نالت خصباً أو لم تنل، والرَّتْعُ لا يكون إلا في الخصب، وقال الفرزدق «14» :
اِرْعَيْ فزارةُ، لا هناكِ المَرْتَعُ
وقال الحجاج للغضبان: سمنت قال: أسمنني القَيْدُ والرَتَعَةَ، كما يقال: العز والمنعة والنجاة والأمنة. وقال «15» :
أبا جعفر لما تولَّيت أرتعوا ... وقالوا لدُنْياهُمْ أفيقي فدرّت
وقوم مُرتعون وراتعون. ورَتَعَ فلان في المال إذا تقلّب فيه أكلاً وشرباً. وإِبِلٌ رِتاع.
__________
(13) ليس في ديوانه.
(14) ديوانه 1/ 408 وصدر البيت:
ومَضَتْ لَمْسَلَمَةَ الرِّكابُ مُوَدَّعاً.
والرواية فيه فارعي.
(15) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول.
(2/68)
________________________________________
باب العين والتّاء والّلام معهما ع ت ل- ت ل ع يستعملان فقط
عتل: العَتَلَةُ: حديدةٌ كحد فأس عريضة ليست بمتعقّفة الرأس كالفأس، ولكنها مستقيمة مع الخشبة، في أصلها خشبة يحفر بها الأرض والحيطان. ورجل عُتُلٌّ أي: أكولٌ مَنُوع. والعَتْلُ: أن تأخذ بتلبيب رجل فَتَعْتِلَهُ، أي: تجرّه إليك، وتذهب به إلى حبس أو عذاب. وتقول: لا أَنْعتِلُ «1» معك، أي: لا أَنْقاد معك. وأخذ فلان بزمام النّاقة فَعَتَلَها، وذلك إذا قَبَض على أصْلِ الزِّمام عند الرأس فقادها قوداً عنيفاً. وقال بعضهم: العتلة عصاً من حديد ضخمةٌ طويلةٌ لها رأسٌ مُفَلْطَح مثل قَبيعةِ السيف مع البناة يهدمون بها الحيطان. والعَتَلَةُ: الهراوة الغليظة من الخشب، والجميع عَتَلٌ. قال الراجز «16» :
__________
(1) هذا من س. في الأصل بياض، وفي ط: (لأن المعتل) وهو تحريف.
(16) لم نهتد إليه.
(2/69)
________________________________________
وأينما كنت من البلاد ... فاجتنبنّ عرمَ الذّوّاد
وضّرْبَهم بالعَتَلِ الشِّداد
يعني عرامهم وشِرّتهم.
تلع: التَّلَعُ: ارتفاع الضّحى. وتَلَعَ النّهار ارتفع. قال «17» :
وكأنّهم في الآل إذ تَلَع الضّحى
وتَلَع فلان إذا أخرج رأسه من كل شيء كأن فيه وهو شبهُ طَلَعَ، غير أنّ طَلَعَ أعمُّ. وتَلَعَ الشاةُ يعني الثورَ، أي: أخرج رأسَه من الكناس. وأَتْلَعَ رأسَهُ، فنظر إتلاعاً، لأنّ فعلَه يجاوز، كما تقول: أطْلَعَ رأسه إطلاعاً. قال ذو الرّمة «18» :
كما أَتْلَعَتْ من تحتِ أَرْطَى صريمةٍ ... ألى نبأةِ الصوتِ الظِّباءُ الكوانِسُ
والأتلع من كلّ شيء: الطويلُ العُنُقِ. والأنثَى: تلعاء. والتّلِعُ والتَّرِعُ هو الأتلع، لأن الفَعِلَ يدخُلُ على الأَفْعَل. قال «19» :
وعَلَّقوا في تِلَعِ الرأسِ خَدِبْ
يعني بعيراً طويل العنق. وسيد تَلِعٌ، ورجلٌ تَلِعٌ، أي كثيرُ التلفّت حوله. ولزم فلانٌ مكانه فما يتتلّع، أي ما يرفع رأسه للنّهوض ولا يريد البراح. قال أبو ذؤيب «20» :
__________
(17) لم نهتد إلى القائل، والبيت في التاج، وعجزه فيه:
سفن تعوم قد ألبست إجلالا
(18) ديوانه. ق 36 ب 23 ص 1127 ج 2.
(19) الرجز في المحكم 2/ 37، واللسان (تلع) .
(20) ديوان الهذليين 1/ 6.
(2/70)
________________________________________
فوردن والعيوق مقعد رابىء ... الضُّرَباءِ فوقَ النَّظْمِ لا يتتلَّعُ
ويقال: إنّه لَيتتالَعُ في مشيِهِ إذا مدَّ عُنُقه ورفَع رأسَه. ومُتالع: اسم جبل بالحمى. ومُتالع اسم موضع بالبادية. قال لبيد «21» :
دَرَسَ المَنَا بمُتالعٍ فَأَبانِ ... فتقادَمَتْ بالحُبْسِ فالسُّوبانِ
والتّلعةُ: أرضٌ مرتفعة غليظة، وربما كانت مع غِلَظِها عريضة يتردّد فيها السّيلُ ثم يدفع منها إلى تلعةٍ أسفلَ منها. قال النابغة «22» :
فالتِّلاعُ الدَّوافِعُ
ويقال: التَّلعَةُ مقدار قفيزٍ من الأرض، والذي يكون طويلاً ولا يكون عريضاً. والقرارة أصغرُ من «23» التّلعة، والدّمعة أصغر من ذلك. ورجلٌ تليع، وجيدٌ تليع، أي: طويل. قال:
جيدٍ تليعٍ تزينه الأطواق
__________
(21) ديوانه. ق 16 ب 1 ص 138. المنا: منزل. والرواية فيه: وتقادمت.
(22) ديوانه. ق 3 ب 1 ص 42. وتمام البيت:
عفا حسم من فرتنا فالفوارع ... فجنبا أراك فالتلاع الدوافع
(23) (الأعشى ديوانه. ق 32 ب 6 ص 209. وتمامه فيه:
ديوانه. ق 32 ب 6 ص 209. وتمامه فيه:
يوم تبدي لنا قتيلة عن جيدٍ ... تليعٍ تَزينُهُ الأَطْواقُ
(2/71)
________________________________________
باب العين والتاء والنون معهما ع ن ت- ن ع ت- ن ت ع مستعملات ع ت ن- ت ن ع- ت ع ن مهملات
عنت: العَنَتُ: إدخالُ المشقّةِ على إنسانٍ. عَنِتَ فلان، أي: لَقِيَ مشقّة. وتَعَنَّتُّه تَعَنُّتاً، أي: سألتُه عن شيءٍ أردتُ به اللَّبْسَ عليه والمشقّة. والعظم المجبورُ يصيبه شيءٌ فيُعْنِتُه إعناتاً، قال «1» :
فأَرْغَمَ الله الأنوفَ الرُّغَّما ... مَجدوعَها والعَنِتَ المُخَشَّما
المُخَشَّمُ: الذي قد كُسِرَتْ خياشيمُه مرّة بعد مرّة. والعَنَتُ: الإثْمُ أيضاً. والعُنْتُوتُ: ما طال من الآكام كلّها.
نعت: النَّعْتُ: وصفُكَ الشيءَ بما فيه. ويُقالُ: النَّعْتُ وصف الشيءِ بما فيه إلى الحسن مذهبُه، إلا أن يتكلّفَ متكلّفٌ، فيقول: هذا نعت سوء. فأمّا العرب العاربة فإنما تقول لشيءٍ إذا كان على استكمال النّعت: هو نعتٌ كما ترى، يريد التّتمة. قال:
أمّا القطاةُ فإنّي سوف أّنْعَتُها ... نَعْتاً يُوافِقُ نَعْتي بعضَ ما فيها
__________
(1) (رؤبة) ديوانه- أرجوزة 89 ب 14، 15 ص 184.
(2/72)
________________________________________
سكاء مخطومة في ريشها طَرَقٌ ... حُمْرٌ قوادمُها سُود خوافيها «2»
البيتان لامرىء القيس «3» . ويقال: صلماء «4» أصحّ من سكّاء، لأن السّكك قِصَرٌ في الأذن. فلو قال: صلماء لأصاب. و [النعت] «5» : كل شيء كان بالغاً. تقول: هو نعت، أي: جيّد بالغ. والنعت: الفرس «6» الذي هو غاية في العتق والروع إنه لنعت ونعيت. وفرس نعتة، بيّنة النّعاتة وما كان نعتاً، ولقد نعت، أي: تكلف فعله. يقال: نعت نعاتة. واستنعته، أي استوصفته. والنعوت: جماعة النّعت، كقولك: نعت كذا ونعت كذا. وأهل النحو يقولون: النعت خلف من الاسم يقوم مقامه. نَعَتُّه أَنْعَتُه نعتاً، فهو منعوت.
نتع: نَتَعَ العَرَقُ نتوعاً، وهو مثل نَبَعَ، إلاّ أن نَتَعَ في العرق أحسن.
__________
(2) البيتان في اللسان (طرق) بدون عزو والرواية فيه: سود قوادمها صهب خوافيها ومعهما بيتان آخران في التاج (طرق) نسبا في كتاب الطير لأبي حاتم إلى الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي أو ابن عباس على الشك. وعن ابن الكلبي: هما للعباس بن يزيد بن الأسود. والرواية فيه:
سود قوادمها كدر خوافيها.
(3) ليسا في ديوانه.
(4) ط وس: سلماء بالسين وهو تصحيف.
(5) زيادة اقتضاها السياق.
(6) في النسخ الثلاث: والفرس النعت وما أثبتناه فمما اقتضاه السياق.
(2/73)
________________________________________
باب العين والتاء والفاء معهما ع ف ت يستعمل فقط
عفت: العفت في الكلام كاللّكْنَةَ. عَفَتَ الكلامَ يَعْفِتُهُ عَفْتاً. وهو أن يكسرَهُ، وهي عربيّةٌ كعربيّةِ الأعجميّ أو الحبشيّ أو السّنديّ ونحوه إذا تكلّف العربيّة. وقال ابن القِرِّيَّةِ: لا يَعرِفُ العربيةَ هؤلاء الجراجمة الطمطمانيّون الذين يلفتونها لفتاً ويعفتونها عفتاً.
(2/74)
________________________________________
باب العين والتاء والباء معهما ع ت ب- ت ع ب- ت ب ع- ب ت ع مستعملات
عتب: العَتَبَةُ: أُسْكُفَّةُ البابِ. وجعلها ابراهيم ع كناية عن امرأة إسماعيل إذ أمره بإبدال عَتَبَتِه. وعتباتُ الدَّرَجة وما يشبهها من عتبات الجبال وأشراف الأرض وكلّ مَرْقاةٍ من الدرج عَتَبَة، والجميع العَتَب. وتقول: عتّب لنا عتبة، أي: اتَّخذ عَتَبات: أي: مَرْقَيات. والعتَب ما دخل في أمرٍ يُفْسِدُهُ ويُغَيِّرُهُ عن الخلوص. قال خلف بن خليفة «1» :
فما في حُسْنِ طاعتنا ... ولا في سمعِنا عَتَبُ
وحُمِلَ فلانٌ على عَتَبَةٍ كريهة، وعلى «2» عَتَبٍ كريهٍ من البلاء والشّرّ. والعتَب: التواءٌ عند الضريبة. قال امرؤ القيس «3» :
مُجَرَّبَ الوَقْعِ غَيْرَ ذي عتب
__________
(1) البيت في المحكم 2/ 40، وفي اللسان (عتب) غير منسوب.
(2) في النسخ: وكل. وما أثبتناه فمن حكاية الأزهري عن الليث.
(3) ليس في ديوانه. والبيت في المحكم 2/ 40، وفي اللسان (عتب) بدون عزو، وصدر البيت فيهما:
أعددت للحرب صارما ذكرا
(2/75)
________________________________________
يصف السيف، وقال المتلمّس «4» :
يُعْلَى على العَتَبِ الكريه ويُوبَسُ
أي: يكره ويرد عليه. والفحل المعقول، أو الظالع إذا مشى على ثلاث قوائم كأنّه يَقْفِزُ يقال: يَعْتِبُ عَتَباناً، وكذلك الأقطع إذا مشى على خشبة، وهذا تشبيه كأنّه ينزو من عتبة إلى عَتَبة. والعَتْبُ: الموجدة. عَتَبْتُ على فلان عَتْباً ومَعْتِبَةً، أي: وجدت [عليه] . قال «5» :
عتبتُ على جُمْلٍ ولستُ بشامتٍ ... بجُمْلٍ وإن كانتْ بها النَّعلُ زَلَّتِ
وأعتبني، أي ترك ما كنت أجِد [عليه] «6» ورجع إلى [مرضاتي] «7» والاسم: العُتْبَى. تقول: لك العُتبى. والتّعاتب إذا وصفا موجِدَتها، وكذلك المعاتبة إذا لامك واستزادك، قال «8» :
إذا ذهب العِتابُ فليس حبٌّ ... ويَبْقَى الحبُّ ما بقيَ العِتابُ
وأعطاني فلان العُتْبَى، أي أعتبني. قال «9» :
لك العُتْبَى وحبّايا خليلي
واستعتب، أي: طلب أن يعتب.
__________
(4) الشطر في التهذيب 2/ 278، وفي اللسان (عتب) بدون عزو.
(5) لم نهتد إليه.
(6) زيادة اقتضاها السياق.
(7) في الأصل، أي: ص: مسراتي. في ط: في س: سيرتي.
(8) البيت في اللسان (عتب) بدون عزو أيضا. والرواية فيه: ود ... الود.
(9) لم نهتد إليه.
(2/76)
________________________________________
وما وجدت في قوله وفعله عتباناً، إذا ذكر أنّه قد أعتبك، ولم يُرَ لذلك بيان. قال أبو الأسود في الإستعتاب «10» :
فعاتبته ثم راجعته ... عتاباً رفيقاً وقولاً أصيلا
فألفيته غيرَ مستعتب ... ولا ذاكِرِ الله إلاّ قليلا
نصب ذكر الله على توهّم التنوين، أي: ذاكرٍ الله. وعُتَيْبَة وعتّابة من أسماء النّساء، وعُتْبَة وعتّاب ومُعَتِّب من أسماء الرجال «11» وعَتِيب اسم قبيلة.
تعب: التَّعَبُ: شدّة العناء. والإِعجال في السّير والسَّوق والعمل. تَعِبَ يَتْعَبُ تَعَباً. فهو تَعِبٌ. وأتْعَبْتُه إتعاباً [فهو] «12» مُتْعَبٌ، ولا يقال: متعوبٌ. وإذا أعْتِبَ العظم المجبور، وهو أوّل بُرْئِه قيل أُتْعِبَ ما أُعْتِبَ. قال ذو الرمة «13» :
إذا ما رآها رأية هيض قلبه ... بها كانهياضِ فيِ المُتْعَبِ المتتمّم
يعني أنّه تتمّم جبره بعد الكسر.
__________
(10) ديوان ص 203 ورواية البيت الأول فيه:
فذكرته ثم عاتبته ... عتابا رقيقا وقولا جميلا
(11) أصل العبارة المحصورة بين الزاويتين هنا، في النسخ: عتيبة من أسماء الناس وعتابة وعتيبة ومعتب وعيب اسم قبيلة وهي هنا مضطربة كما ترى، وقد عدلت كما هي بين الزاويتين من حكايات اللغويين عن الليث أو عن الخليل في العين.
(12) زيادة اقتضاها السياق.
(13) ديوانه. ق 38 ب 15 ص 1173 ج 2. والرواية فيه:
إذا نال منها نظرة هيض قلبه ...
(2/77)
________________________________________
تبع: التّابع: التالي «14» ، ومنه التتبّعُ والمتابعة، والإتّباع، يتبَعه: يتلوه. تَبِعَه يَتْبَعُهُ تَبَعاً. والتَّتَبُّعُ: فعلك شيئاً بعد شيء. تقول: تتبّعتُ علمه، أي: اتّبعت آثاره. والتّابعة: جِنِّيَّة تكون مع الإنسان تتبعه حيثما ذهب. وفلانٌ يتابع الإِماء، أي: يُزانيهنَ. والمتابعة أن تُتْبِعَهُ هواك وقلبك. تقول: هؤلاء تبع وأتباع، أي: مُتَّبِعُوك ومتابعوك على هواك. والقوائم يقال لها تَبَعٌ. قال أبو دؤاد «15» :
وقوائم تَبَعٌ لها ... من خلفها زَمَعٌ مُعَلَّقْ
يصف الظبية. وقال «16» :
يَسْحَبُ اللَّيْل نجوماً طُلَّعا ... وتواليها بطيئات التَّبَع
والتّبيع: العِجْلُ المُدْرك من ولد البقر الذّكر، لأنه يتبع أمّه بعدوٍ. والعدد: أَتْبِعَة، والجميع: أتابيع. وبَقَرٌ مُتْبِعٌ، أي: خلفها تبيع. وتَبِعْتُ شيئاً، واتّبعْتُ سواء.
__________
(14) في ص: التا. وفي ط: الد. أما في س فقد سقطت هذه الكلمة منها.
(15) البيت في التهذيب 2/ 282. وفي المحكم 2/ 43 إلا أن الرواية فيه:
من خلفها زمع زوائد
وجاءت الروايتان كلتاهما في اللسان (تبع) على عادته في جمع الروايات.
(16) لم نهتد إليه.
(2/78)
________________________________________
وأَتْبَعَ فلانٌ فلاناً إذا تَبِعَه يُريد شرّا. قال الله عزّ ذِكْرُهُ: فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ «17» والتّتابُعُ ما بين الأشياء إذا فعل هذا على إثر هذا لا مهلة بينهما كتتابع الأمطارِ والأمورِ واحدا خلف آخر، كما تقول: تابع بين الصلاة والقراءة، وكما تقول: رميته بسهمين تِباعاً وولاءً ونحوه. قال «18» :
متابعة تذبّ عن الجواري ... تتابع بينها عاماً فعاما
والتَّبيع: النَّصير «19» . والتَّبِعَةُ هي التَّباعَةُ، وهو اسم الشيء الذي لك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها. والتُّبَّعُ والتُّبُّعُ: الظلّ، لأنه مُتَّبعٌ حيثما زال. قال الفرزدق «20» :
نرد المياه قديمة وحديثة ... وِرْدَ القَطاةِ إذا اسْمِأَلَّ التُّبَّعُ
والتُّبَّعُ ضربٌ من اليعاسيب، أحسنها وأعظمها، وجمعها: تبابيع. تُبَّع: اسم ملكٍ من ملوك اليمن، وكان مؤمناً، ويقال: تُبّت اشتقّ لهم هذا الاسم من تُبَّع ولكن فيه عُجْمة، ويقال: هم من اليمن وهم من وضائع تبّع بتلك البلاد. والتّبيع الذي له عليك مال يتابعك به، أي: يطالبك.
__________
(17) سورة الأعراف 175.
(18) لم نهتد إليه.
(19) بعده كلمة هكذا رسمت في النسخ: (المثام) ولم يقع لنا مفادها.
(20) ليس في ديوانه والبيت في المحكم 2/ 43 منسوب إلى (الجهينية) . وفي اللسان (تبع) منسوب إلى (سعدى الجهنية) ترثي أخاها أسعد. والرواية فيهما:
يرد المِياهَ حَضيرةً ونَفيضةً ... وِرْدَ القطاة إذا اسمأل التبع
(2/79)
________________________________________
وأتبعت فلاناً على فلان، أي: أحلته عليه، ونحو ذلك.
بتع: البِتْعُ والبِتَعُ معاً: نبيذ يتّخذ من العسل كأنّه الخَمْرُ صلابةً. وأما البَتِعُ فالشديدُ المفاصلِ والمواصل من الجسد. قال سلامة بن جندل «21» :
يرقى الدسيع إلى هاد له بَتِعٍ ... في جُؤْجُؤٍ كَمَداكِ الطِّيبِ مخضوبِ
أي: شديد موصول. وقال رؤبة: «22»
وقَصَباً فَعْماً وعُنْقاً أَبْتَعا
أي: صلبا، ويروى: أرسعا.
__________
(21) ديوانه. ق 1 ب 11 ص 106 والرواية فيه: تم الدسيع.
(22) ديوانه: (أبيات مفردات) . رقمه 57 ص 178. والرواية فيه: ورسغا أبتعا.
(2/80)
________________________________________
باب العين والتاء والميم معهما ع ت م- ع م ت- م ت ع مستعملات ت م ع- ت ع م- م ع ت مهملات
عتم: عتّم الرّجلُ تعتميا إذا كفّ عن الشيء بعد ما مضى فيه. قال حُمَيْد «23» :
عَصاهُ منقارٌ شديدٌ يلطمُ ... مجامعَ الهامِ ولا يُعَتّمُ
يصف الفيل. عصا الفيل منقاره، لأنّه يضرب به كلّ شيء. وقوله: لا يعتّم، أي: لا يكفّ ولا يهمل. وحملت على فلان فما عتّمت، أي: ضربته فما تنهنهت وما نكلت ولا أبطأت. وعَتَمْتُ فأنا عاتِمٌ، أي: كففت. قال «24» :
ولستُ بوقّافٍ إذا الخيلُ أَحْجَمَتْ ... ولستُ عن القرن الكميّ بعاتمِ
والعاتم: البطيء. قال «25»
ظعائنُ أمّا نيلهن فعاتم
__________
(23) ليس في ديوان حميد بن ثور الهلالي، فلعله (لحميد الأرقط) .
(24) لم نهتد إليه.
(25) لم نهتد إليه.
(2/81)
________________________________________
وفي الحديث «26» : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ناول سلمان كذا وكذا وديّة فَغَرَسَها فما عَتَّمتْ منها وَديَّة،
أي، ما أبطأتْ حتى عَلِقَتْ. والعَتَمَةُ: الثُلُثُ الأوّلُ من الليل بعد غيبوبة الشَّفَق. أَعْتَمَ القوم إذا صاروا في ذلك الوقت، وعتّموا تعتيماً ساروا في ذلك الوقت، وأوردوا أو أصدروا في تلك السّاعة. قال «27»
يَبْني العُلَى ويبتني المكارما ... أقراهُ «28» للضَّيفِ يثوبُ عاتِما
والعُتْمُ: الزّيتونُ يُشْبِهُ البرّي لا يَحْمِلُ شيئاً.
عمت: العَمْتُ: أن تَعْمِتَ الصّوفَ فتلُفّ بعضَه على بعضٍ مستطيلاً أو مستديراً، كما يفعلُه الذي يغزلُ الصّوفَ فيُلقيه في يده أو نحو ذلك، والاسمُ: العَميتُ، وثلاثة أَعْمِتَةٍ، وجمعه: عُمُتٌ. قال «29» :
يظَلُّ في الشّاء يرعاها ويَحْلُبُها ... ويَعْمِتُ الدّهرَ إلاّ ريْثَ يَهْتَبِدُ
ورجل عمّات وامرأة عمّاتة إذا كانت جيدة العَمْت. وعمَّتَ الصّوفَ تعميتاً. وعَمْتُ الصّوفِ أن تعمِتَه عمائت. والعميتة: [ما] «30» ينفش [من] «31» الصوف، ثم يمدّ، ثم يُجْعل حبالا، يلقى بعضه على بعض، ثم يغزل «32» .
__________
(26) ورد الحديث في التهذيب 2/ 228.
(27) الرجز في اللسان غير منسوب أيضا.
(28) ط: اقرأه س: قراءة.
(29) البيت في التهذيب 2/ 290، وفي اللسان (عمت) بدون عزو.
(30) في النسخ: أن.
(31) زيادة اقتضاها السياق.
(32) سقطت من س.
(2/82)
________________________________________
قال:
حتى تطير ساطعاً سختيتا ... وقطعاً من وَبَر عميتا
وقيل: العَمْتُ: أن تضربَ ولا تُبالي من أصابَ ضربُك.
متع: متع النَّهارُ متوعاً. وذلك قبل الزّوال. ومتع الضّحى. إذا بلغ غايته عند «33» الضحى الأكبر. قال «34» :
وأدركْنا بها حَكَمَ بنَ عمرٍو ... وقد مَتَعَ النَّهارُ بنا فزالا
والمتاعُ: ما يَستمتع به الإنسانُ في حوائجه من أمتعة البيت ونحوه من كلّ شيء. والدنيا متاعُ الغرور، وكلّ شيء تمتعت به فهو متاع، تقول: إنّما العيشُ متاعُ أيّام ثم يزول [أي بقاء أيام] «35» ومتّعك اللهُ به وأَمْتَعَكَ واحدٌ، أي: أبقاك لتستمتع به فيما تحب من السرور والمنافع. وكلّ من متّعته شيئاً فهو له متاعٌ ينتفع به. ومُتعةُ المرأةِ المطلّقةِ إذا طلّقها زوجُها. متّعها مُتعةً يعطيها شيئاً، وليس ذلك بواجب، ولكنّه سُنّة. قال الأعشى «36» يصف صيّاداً:
حتّى إذا ذرَّ قرنُ الشمسِ صبَّحها ... من آل نبهانَ يبغي أهلَه مُتَعا
أي: يبغيهم صيداً يتمتعون به، ومنهم من يكسر في هذا خاصّة، فيقول: المِتعة. والمُتعةُ في الحجّ: أن تضمَّ عُمْرَةً إلى الحجّ فذلك التّمتع. ويلزمُ لذلك «37» دمٌ لا يجزيه غيره.
__________
(33) في س: عن.
(34) لم نقف على القائل. في ص: يبغي لأهله. وهو وهم من الناسخ.
(35) زيادة من التهذيب من رواية له عن الليث.
(36) في الديوان ص 105 والرواية فيه:
ذؤال بنهان يبغي صحبه المتعا
(37) في س وط: ذلك.
(2/83)
________________________________________
باب العين والظاء والراء معهما يستعمل ر ع ظ فقط
رعظ: الرُّعْظُ من السّهم: الموضعُ الذي يدخُل فيه سِنْخ النَّصْل. وفوقه الذي عليه لفائف العَقَبِ. ورُعِظَ السّهمُ فهو مرعوظ إذا انكسر رُعْظُه. قال «1» :
ناضلني وسهمُهُ مرعوظُ
ويقال: أُرْعِظَ فهو مُرْعَظٌ. يعني: مرعوظ. ويقال: إنّ فلاناً لَيكسِرُ عليك أَرْعاظَ النّبلِ غضباً. أبو خيرة: المرعوظ الموصوف بالضعف.
__________
(1) لم نقف على الراجز. في ط: فاضلني بالفاء.
(2/84)
________________________________________
باب العين والظاء واللاّم معهما ع ظ ل، ل ع ظ، ظ ل ع مستعملات
عظل: عَظَل يَعْظُلُ الجراد والكلاب وكلّ ما [يلازم] «2» في السّفاد. والاسم العِظال. قال «3» :
يا أمّ عمرٍو أبشري بالبشرى ... موت ذريع وجراد عَظْلَى
أي: يَسْفِد «4» بعضُها بعضاً. وعاظلها فعظلها، أي: غلبها. قال جرير «5» :
كلابٌ تعاظل سود الفقاح...............
لعظ: جاريةٌ مُلَعَّظة: طويلة سمينة.
__________
(2) من التهذيب في روايته عن الليث وفي الأصول: يلزم.
(3) لم نقف على الراجز.
(4) من س. في ص وط: أسفد.
(5) ليس في ديوانه والبيت في التهذيب واللسان والتاج غير منسوب، وتمامه:
لم تحم شيئا ولم تصطد
(2/85)
________________________________________
ظلع: الظَّلْع: الغَمْزُ، كأنّ برجله داءً فهو يظلع. قال كثير «6» :
وكنتُ كذاتِ الظَّلْعِ لمّا تحاملتْ ... على ظّلْعِها يومَ العثارِ استقلتِ
يصف عشقه، أخبر أنّه كان مثل الظالع من شدة العشق فلمّا تحامل على الهّجْر استقلّ حين حمل نفسَهُ على الشِّدّة، وهو كإنسان أو دابّة يصيبها حمر، فهي أقلّ ما تركب تغمز صدرها، ثم يستمرّ يقول: لمّا رأى الناس، وعَلِمَ أنّه لا سبيلَ له إليها حَمَلَ نفسَهُ على الصّبر فأطاعته. ودابّةٌ ظالعٌ، وبِرْذَوْنٌ ظالعٌ، الذّكرُ والأنثى فيه سواء.
__________
(6) البيت من قصيدته التائية. انظر الأمالي 2/ 108.
(2/86)
________________________________________
باب العين والظاء والنون معهما ع ن ظ، ظ ع ن، ن ع ظ مستعملات
عنظ: العُنْظُوانُ نباتٌ إذا استكثر منه البعيرُ وَجِعَ بطنُه. عَظِيَ البعير عظىً فهو عظٍ «1» . النون زائدة، وأصل الكلام: العين والظاء والواو، ولكنّ الواو إذا بنيت منه فَعِلَ «2» قلت: عَظِيَ مثل رَضِيَ، فالياء هو الواو وكسرته الضاد المكسورة، والدليل عليه الرِّضوان. قال «3» :
حرَّقها وارسُ عُنْظُوانِ ... فاليومُ منها يومُ أَرْوَنانِ
وارس ثمرُهُ. والمُورِسُ [الذي] «4» خرج وارسه. وقال «5» :
ماذا تقول نبتها تَلَمَّسُ ... وقد دعاها العُنظوان المُخْلِسُ
والعُنْظُوانَةُ: الجرادةُ الأنثى، والجمعُ «6» العنظوانات.
__________
(1) في (ط وس) : عظى. وفي (ص) : معظي والصواب ما أثبتناه.
(2) من (ص) . في (س وط) : الفعل.
(3) من (س) وقد سقطت من (ص وط) . والرجز في اللسان (عنظ) وهو غير منسوب أيضا.
(4) في الأصول: (أي) .
(5) الرجز من (ط وس) . أما (ص) فقد سقط الرجز منها.
(6) من (ص) . في (س وط) : والجميع.
(2/87)
________________________________________
ظعن: ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْناً وظُعوناً وظَعَناً وهو الشخوص. والظَّعينةُ: المرأةُ، سُمّيت به لأنّها تَظْعَنُ إذا ظَعَنَ زوجُها، وتقيم إذا أقام. ويقال: لا بل الظّعينةُ الجملُ الذي يعتمل ويركب، وسمّيت ظعينةً لأنّها راكبتُه، كما سُمّيتْ المزادةُ راوية وإنما الرواية البعيرُ. قال «7» :
تَبَيَّنْ خليلي هل ترى من ظعائن ... لميّة أمثالِ النّخيلِ المَخَارِفِ
والنّساء لا يُشَبَّهْنَ بالنخيل، وإنما تُشَبَّهُ بها الإِبل التي عليها الأحمال فهذا يبيّن لك أن الظَّعينةَ قد تكون البعير الذي يعتمل. والظُّعُنُ: رجالٌ ونساءٌ جماعة.
نعظ: نَعَظَ ذكرُ الرّجلِ يَنْعَظُ نَعْظاً ونُعُوظاً. وأَنْعَظَهُ [يُنْعِظُهُ] «8» . وهو أن ينتشر ما عند الرّجل، ومن المرأة الاهتياج إذا علاها الشبق. يقال: أنعظت المرأة.
__________
(7) البيت (للفرزدق) . ديوانه 2/ 13 (صادر) .
(8) في (ص) و (ط) : منعظه. وفي (س) : منعظة. وما أثبتناه أصوب.
(2/88)
________________________________________
باب العين والظاء والفاء معهما يستعمل من وجوهها ف ظ ع فقط
فظع: فَظُعَ الأمر يَفْظُعُ فَظاعةً. وأَفْظَعَ إفْظاعاً. وأمرٌ فظيع، أي: عظيم. وأفظعني هذا الأمرُ وفَظِعْتُ به: واستفظعته رأيتُه فظيعاً. وأفْظَعْتُه أيضاً.
(2/89)
________________________________________
باب العين والظاء والباء معهما ع ظ ب يستعمل فقط
عظب: عَظَبَ الطائرُ يَعْظِبُ عَظْباً وهو سرعةُ تحريكِ الزِّمِكَّى.
(2/90)
________________________________________
باب العين والظاء والميم معهما ع ظ م، م ظ ع، مستعملان
عظم: العِظام: جمع العَظْم، وهو قَصَب المفاصل. والعِظم: مصدر الشيء العظيم. عَظُم الشيء عِظَماً فهو عظيم. والعَظَامَةُ: مصدرُ الأمرِ العظيمِ. عَظُمَ الأمرُ عَظامَةً. وعَظَّمَهُ يُعَظِّمُهُ تعظيماً، أي: كبّره. وسمعت خبراً فأَعْظَمتُه، أي: عَظُمَ في عيني. ورأيت شيئاً فاستعظمته. واستعظمْتُ الشيء: أخذت أُعَظِّمُهُ. واستعظمتُه: أنكرته. وعُظْمُ الشيءِ: أعظمُهُ وأكبرُهُ ومُعْظَمُ «1» الشيءِ أكْثَرُهُ. مثل مُعْظَم الماء وهو تبلّده. والعُظْم: جلّ الشيء وأكثره. والعَظَمَةُ من [التَعَظُّمِ] «2» والزّهو والنّخوة. وعَظُمَ الرّجُلُ عّظامةً فهو عظيمٌ في الرأي والمجد. والعظيمةُ: المُلِمَّةُ النّازلةُ الفظيعة. قال «3» :
__________
(1) من (س) . في (ص) و (ط) معظمه.
(2) هذا من التهذيب في روايته عن الليث في الأصول: التعظيم.
(3) عجز البيت كما في المحكم 2/ 52 واللسان (عظم) :
وإلا فإني لا إخالك ناجيا
والبيت غير منسوب.
(2/91)
________________________________________
فإن تنجُ منها تَنْجُ من ذي عظيمة................
وتقول: لا يتعاظمني ذلك، أي: لا يَعْظُمُ في عيني.
مظع: مَظَعَ الرّجُلُ الوتَرَ يَمْظَعُ مَظْعاً، وهو أن يمسحَ الوتَرَ بخُرَيْقةٍ أو قطعةِ شعر حتى يقوّمَ متنَه. ويمْظَعُ «4» الخشبةَ يملّسُها حتى ييبّسَها، وكلّ شيء نحوه. والمَظْعُ الذّبولُ. مَظَعَه مشقه «5» حتى يبسه.
__________
(4) في الأصول. مظع وما أثبتناه أنسب.
(5) من (س) . في (ص) و (ط) مشقة.
(2/92)
________________________________________
باب العين والذال والرّاء معهما ع ذ ر، ذ ع ر، ذ ر ع مستعملات
عذر: عَذَرْتُه عَذْراً ومَعْذِرَةً. والعُذْرُ اسمٌ، عذرته بما صنع عَذْراً ومَعْذِرة وعَذَرْتُه من فلانٍ، أي: لُمْتُ فلاناً ولم أَلُمْهُ. قال «1» :
يا قوم من يعذر من عجرد ... القاتل النفس على الدانق
وعذيرُ الرّجل ما يروم ويحاول مما يعذر عليه إذا فعله. قال العجاج «2» :
جاريَ لا تَسْتَنكري عَذيري
ثم فسّره فقال:
سَعْيي وإشفاقي على بعيري
وعَذِيري من فلان، أي من يَعْذِرُني منه. قال «3» :
عَذيرَكَ من سعيدٍ كلّ يوم ... يُفجّعنا بفُرْقته سعيد
__________
(1) لم نقف على القائل.
(2) ديوانه ص 221 (دمشق) .
(3) لم نقف على القائل ولا على القول في غير الأصول.
(2/93)
________________________________________
أي: أعذر من سعيد. واعتذر فلانٌ اعتذاراً وعِذرةً. قال «4» :
ها إن تا عِذْرةٌ.
واعتذر من ذنبه فَعَذَرْته. وأعْذَرَ فلان، أي: أبلى عذراً فلا يلام. واعتذر إذا بالغ فيه. وعذر الرجل تعذيرا إذا لم يبالغ في الأمر وهو يريك أنّه يبالغ فيه. وأهلُ العربية يقولون: المُعْذِرُونَ الّذين لهم عُذْر بالتخفيف، وبالتثقيل «5» الذين لا عُذْرَ لهم فتكلّفوا عُذْراً. وتعذّر الأمرُ إذا لم يستقمْ. قال «6» :
............. تعذّرت ... عليّ وآلتْ حَلْفَةً لم تَحَلَّلِ
وأَعْذَرَ إذا كثُرَتْ ذنوبُه وعيوبُه «7» . والعِذارُ عَذار اللّجام، عَذَرْتُ الفرسَ، أي: ألجمتُه أَعذِره. وعذَّرته تعذيراً، يقال: عَذِّرْ فرسَك يا هذا. وعذَّرْتُ اللّجامَ جعلتُ له عِذاراً. وما كان على الخدّين من كيّ أو كّدْحٍ طولاً فهو عِذارٌ.
__________
(4) من بيت (للنابغة) في ديوانه ص 26 وتمام البيت:
ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت ... فإن صاحبَها قد تاهَ في البلد
(5) المعذرون. قال تعالى من سورة التوبة: وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ.
(6) من معلقة (امرىء القيس) . ديوانه ص 12 وتمام البيت:
ويوما على ظهر الكثيب تعذّرت ... عليّ وآلتْ حَلْفَةً لم تحلل
(7) قبل هذه العبارة وبعد بيت (امرىء القيس) . غير الخليل يروي
عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. ويروى يعذروا
والظاهر أنه تعليق أدخله النساخ في الأصل.
(2/94)
________________________________________
والإِعذار: طعام الختان. والعِذارُ طعامٌ تدعو إليه إخوانك لشيء تستفيده، أو لحدَثٍ كالخِتانِ ونحوه سوى العُرس. أعذرتُ الغلام ختنته. قال «8» :
تلوية الخاتن زب المعذر
والمعذور مثله «9» . وحمارٌ عَذَوَّرٌ. أي: واسعُ الجوف. قال يصف الملك أنه واسع عريض «10» :
وحاز لنا اللهُ النبوّة والهدى ... فأعطى به عزا وملكا عذورا
والعُذْرة عُذْرة الجارية العذراء وهي التي لم يَمْسَسْها رجل. والعُذْرَة داء يأخذ في الحلق. قال «11» :
غَمْزَ الطبيب نغانِغَ المَعْذور
والعُذْرةُ نجمٌ إذا طلع اشتدّ الحرّ. قال الساجع: إذا طلعتِ العُذْرةُ لم تبق بعمان سرّة وكانت عكّة نكرة. والعُذْرةُ: الخُصْلَةُ من عرف الفرس أو ناصيته، والجميع العُذَر. قال ينعت فرساً «12» :
سَبِط العُذْرةِ ميّاح الحضر
ويروى: مياع.
__________
(8) الرجز في التهذيب 2/ 310. غير منسوب. وفي اللسان (عذر) غير منسوب أيضا. ورواية اللسان: ... المعذور.
(9) من (س) . في (ص) و (ط) : قال والمعذور..
(10) لم نقف على القائل، ولا على القول في غير الأصول.
(11) (جرير) ديوانه 2/ 858 وصدر البيت:
غمز ابن مرة يا فرزدق كينها
(12) لم نقف على الراجز، ولا على الرجز في غير الأصول.
(2/95)
________________________________________
والعذراء: شيء من حديد يعذّب به الإنسان لاستخراج مالٍ أو لإقرارِ بشيء. والعَذِرةُ: البَدَا، أعذر الرّجلُ إذا بدا «13» وأحدث من الغائط. وأصل العَذِرَةُ فِناءُ الدار ثم كنّوا عنها باسم الفِناء، كما كُنِّيَ بالغائط، وإنّما أصل الغائط المطمئنّ من الأرض. قال «14» :
لعمري لقد جرَّبتكم فوجّدْتكم ... قباحَ الوجوهِ سيِّئي العَذِرات
يريد الأفنية، أنّها ليست بنظيفة. والعاذرُ والعَذِرَةُ هما البَدَا أيضاً، وهو حَدَثه. قال بشار يهجو الطرماح:
فقلت له لا دهل ملقمل بعد ما ... ملا ينفق التّبان منه بعاذر
يقول: خاف المهجُوُّ من الجمل فكلَّمَهُ الهاجي بكلام الأنباط. قوله: لا دهل، أي لا تَخَفْ بالنبطية، والقمل: الجمل. ومُعَذَّرُ الجمل ما تحت العِذار من الأذنين. ومَعْذِرُهُ ومَعْذَرَهُ، كما تقول: مَرْسِنُهُ ومَرْسَنَهُ «15» .
ذعر: ذُعِرَ الرّجُلُ فهو مذعور منذعر، أي: أخيف. والذُّعْرُ: الفَزَع، وهو الاسم. وانْذَعَرَ القومُ تفرقوا.
ذرع: الذِّراعُ من طَرَف المِرْفَق إلى طرف الإِصْبَع الوُسْطَى.
__________
(13) في الأصول: 8 بدا، والصواب ما أثبتناه.
(14) (الحطيئة) ديوانه ص/ 332 (البابي الحلبي) .
(15) (مرسنة) الثانية من (س) فقد سقطت من (ص) و (ط) .
(2/96)
________________________________________
ذَرَعْتُ الثوب أذْرَعُ ذَرْعاً بالذِّراع والذِّراعُ السّاعد كلّه، وهو الاسم. والرّجُلُ ذارِعٌ. والثَّوبُ مذروعٌ. وذرعتُ الحائط ونحوه. قال «16» :
فلمّا ذَرَعْنا الأرضَ تسعين غلوة............... ....
والمُذَرَّع: الممسوح بالأذْرع. ومنهم من يؤنّث الذِّراع، ومنهم من يذكّر، ويصغّرونه على ذُرَيْع فقط «17» . والرّجلُ يُذَرِّعُ في ساحته تذريعاً إذا اتّسع، وكذلك يتذرّع أي: يتوسع كيف شاء. وموتٌ ذريعٌ، أي: فاشٍ، إذا لم يتدافنوا، ولم أسمع له فِعْلاً. وذَرَعَهُ القَيْء، أي: غلبه. ومِذارِعُ الدّابّة قوائمها، ومَذارِعُ الأرض نواحيها. وثوب موشى المذراع. والذَّرَع ولدُ البقرة، بقرةٌ «18» مُذْرِعٌ، وهنّ مُذْرِعاتٌ ومذاريع، أي: ذوات ذِرْعان. قال الأعشى «19» :
كأنها بعد ما أفضى النِّجادُ بها ... بالشّيِّطَيْنِ مَهاةٌ تبتغي ذَرَعا
والذِّراعُ سِمَةُ بني ثعلبة من اليمن، وأناس من بني مالك بن سعد من أهل الرّمال. وذِراعُ العامل: صدر القناة. وأَذْرِعاتٌ: مكان تنسب إليه الخمور.
__________
(16) لم نقف على القائل ولا على القول.
(17) من (س) . في (ص) و (ط) : قط.
(18) من (س) . في (ص) و (ط) : بقر.
(19) ديوانه ص 105، في (س) النجباء وفي (ص) و (ط) : النجأ.
(2/97)
________________________________________
والذَّريعةُ جملٌ يُخْتَلُ به الصّيدُ، يمشي الصّيادُ إلى جنبه فإذا أمكنه الصيدُ رمى وذلك [الجملُ] «20» يسيّب أوّلاً مع الوحش حتى يأتلفا. والذريعةُ حلقةٌ يتعلّم عليها الرّمي. والذّريعةُ الوسيلةُ. والذِّراعُ من النّجوم، وتقول العرب: إذا طلع الذّراع أمرأَتِ الشّمسُ الكُراع. واشتدّ منها الشُّعاع. ويقال للثور مُذَرَّعٌ إذا كان في أكارعه لُمَعٌ سودٌ. قال ذو الرمة «21» :
بها كل خوّارٍ إلى كلِّ صَعْلةٍ ... ضهول ورفض المذرعات القراهب
والمِذراع الذِّراع يُذْرَعُ به الأرض والثياب. ومَذارِعُ القرى: ما بَعُدَ من الأمصار.
__________
(20) زيادة من المحكم يقتضيها السياق.
(21) ديوانه 1/ 188.
(2/98)
________________________________________
باب العين والذال واللاّم معهما ع ذ ل، ل ذ ع يستعملان فقط
عذل: عَذَلَ يَعْذِلُ عَذْلاً وعَذَلاً، وهو اللّوم، والعُذّال الرّجال، والعُذّلُ النساء. قال «1» :
يا صاحبيَّ أقلاّ اللّومَ والعَذَلا ... ولا تقولا لشيء فات ما فعلا
والعاذِلُ: اسم العِرْق الذي يخرج منه دم الاستحاضة.
لذع: لَذَعَ يَلْذَعُ لَذْعاً كلَذْعِ النار أي: كحُرْقَتِها، ولَذَعْتُه بلساني، والقرحة تلتَذِعُ إذا قيّحتْ، ويلْذَعُها القيحُ. قال «2» :
وفي الجَمْر لَذْعٌ كجمرِ الغَضَى
والطائر يلذَعُ الجناحَ إذا رَفْرَفَ به ثمّ حرّك جناحَيْهِ ومشَى مشيا قليلا.
__________
(1) لم تهتد إلى القائل.
(2) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول.
(2/99)
________________________________________
باب العين والذّال والنّون معهما يستعمل ذ ع ن فقط
ذعن: يقال: أَذْعَنَ إِذْعاناً، وذَعِنَ يذْعَن أيضاً، أي: انقاد وسَلِسَ. ناقةٌ مِذعانٌ سَلِسَةُ الرأسِ منقادةٌ لقائدها. وفي القرآن: مُذْعِنِينَ أي: طائعين. قال «1»
............... .... ... وقرّبت مذعاناً لموعاً زمامُها
__________
(1) (ذو الرمة) ديوانه 2/ 1327 وصدر البيت:
فعاجا علندى ناجيا ذا براية
ورواية الديوان: وعرجت مكان قربت.
(2/100)
________________________________________
باب العين والذّال والفاء معهما ذ ع ف يستعمل فقط
ذعف: الذُّعافُ سمٌّ ساعة. وطعام مَذْعوفٌ جعل فيه الذُّعاف. قال رزاح:
وكنّا نمنعُ الأقوامَ طرّا ... ونسقيهم ذُعافاً لا كميتا
(2/101)
________________________________________
باب العين والذّال والباء معهما ع ذ ب، ب ذ ع يستعملان فقط
عذب: عَذُبَ الماءُ عُذوبةً فهو عَذْبٌ طيب، وأَعْذبتُه إعذاباً، واستعذبته، أي: أسقيته وشربته عَذْباً. وعَذَبَ الحمار يَعْذِبُ عَذْباً وعُذوباً فهو عاذِبٌ عَذوبٌ لا يأكل من شدة العطش. ويقال للفرس وغيره: عَذوبٌ إذا بات لا يأكل ولا يشرب، لأنه ممتنع من ذلك. ويَعْذِبُ الرّجل فهو عاذِبٌ عن الأكل، لا صائم ولا مُفْطِرٌ. قال عَبِيد «1» :
وتَبَدَّلوا اليَعْبوبَ بعدَ إلَههم ... صنماً فَقَرّوا يا جَديلَ وأَعْذِبوا
وقال حُمَيْد «2» :
إلى شجرٍ ألمَى الظّلال كأنّه ... رواهبُ أَحْرَمْنَ الشراب عذوب
__________
(1) (عبيد بن الأبرص) ديوانه ص 3.
(2) (حميد بن ثور الهلالي.) ديوانه ص 57. في الأصول: إلى شجر الماء.
(2/102)
________________________________________
وتقول: أعذبتُه إعذاباً، وعذّبتُه تعذيباً، كقولك: فطّمته عن هذا الأمر، وكلّ من مَنَعْتَهُ شيئاً فقد أعْذَبْتَهُ. قال «3» :
يَسُبُّ قومَك سبّاً غير تعذيب
أي: غير تفطيم. والعذوب والعاذب الذي ليس بينَه وبين السّماء سِتْر. قال النابغة الجعديّ «4» :
فبات عَذوباً للسّماءِ كأنّه ... سهيلٌ إذا ما أفردَتْهُ الكواكبُ
والمعذّب قد يجيء اسماً ونعتاً للعاشق. وعَذَبَةُ السَّوط: طَرَفُه. قال «5» :
مثلُ السّراحِينِ في أعناقِها العَذَبُ
يعني أطراف السُّيور التي قد قلّدت بها الكلاب. والعَذَبَةُ في قضيب البعير أَسَلَتُه. أي: المستدقّ من مقدّمه، ويجمع على عَذَب. وعذَبة شِراك النعل: المرسلة من الشّراك. والعُذَيْبُ: ماء لبني تميم.
بذع: البَذَعُ: شبه الفَزَع. والمبذوع كالمفزوع. قال الأعرابيّ: بُذِعُوا فأبْذَعَرُّوا. أي: فَزِعوا فتفرّقوا.
__________
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(4) البيت في المحكم 2/ 61 وفي اللسان (عذب) .
(5) (ذو الرمة) ديوانه 1/ 98. وصدر البيت:
غضف مهرتة الأشداق ضارية
(2/103)
________________________________________
باب العين والذّال والميم معهما ع ذ م، م ذ ع يستعملان فقط
عذم: عَذَمَ يَعْذِم عَذْماً، والاسم العذيمة وهو الأخذ باللسان، واللوم. قال الرّاجز «1» :
يظَلُّ مَنْ جاراه في عذائم ... من عنفوان جَرْيِهِ العُفاهمِ
أي: في ملامات. وفرسٌ عَذُومٌ، وعَذِمٌ، أي: عضوض. والعُذّامُ: شَجَرٌ من الحَمْضِ يَنْتَمِىءُ، وانتماؤه انشداخه إذا مَسسْتَه. له ورق كورق القاقُلّ، الواحدة عُذّامة.
مذع «2» : مَذَعَ لي فلانُ مَذْعَةً من الخَبَر إذا أخبرك عن الشيء ببعضِ خَبَره ثم قَطَعَهُ، وأخذ في غيره، ولم يتمّمه. والمُذّاعُ: الكذّابُ يكذِبُ لا وفاءَ له. ولا يحفظ أحدا بالغيب.
__________
(1) الرجز في التهذيب 2/ 323 وفي المحكم 2/ 62 غير معزو. وفي اللسان (عذم) و (عفهم) ونسب إلى (غيلان) . في (س) : من جراه.
(2) قال الأزهري 2/ 324 عند ترجمته ل (مذع) : أهمله الليث، وهو كما ترى.
(2/104)
________________________________________
باب العين والثاء والرّاء معهما ع ث ر، ث ع ر، ر ع ث، ر ث ع مستعملات
عثر: عَثَرَ الرّجل يَعْثُرِ [ويَعْثُرُ] عثوراً، وعثر الفرس عِثاراً إذا أصاب قوائمه شيء، فيُصرع أو يَتَتَعْتَعُ. دابّة عثور: كثيرة العثار. وعثرَ الرّجل يعثرُ عثراً إذا اطلّع على شيء لم يطلّع عليه غيره. وأعثرت فلاناً على فلانٍ أي: أطلعته عليه، وأعثرته على كذا. وقوله عزّ وجل «1» : فَإِنْ عُثِرَ «2» أي: اطُّلِعَ. والعِثْيَرُ: الغبار السّاطع. والعَثْيَرُ الأثَرُ الخفيُّ، وما رأيت له أثرا ولا عثيرا. والعثير: ما قلبت من ترابٍ أو مَدَرٍ أو طينٍ بأطراف أصابع رجلَيْكَ إذا مشيت لا يرى من القدم غيره. قال «3» :
............... ...... ... عَيْثَرْتَ طَيْرَكَ لو تَعيفُ
يقول: وقعت عليها لو كنت تعرف، أي: جزتَ بما أنت لاقٍ «4» لكنّك لا تعرف.
__________
(1) من (س) . في (ص) و (ط) : (وقوله) فقط.
(2) المائدة 107: فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً.
(3) من بيت (للمغيرة بن حبناء التميمي) ، وتمام البيت، كما في المحكم 2/ 65 واللسان (عثر) :
لعمر أبيك يا صخر بن ليلى ... لقد عثيرت طيرك لو تعيف
(4) في (س) : جزات بما تلاقي. في (ص) و (ط) : جزت بما انتلاق ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2/105)
________________________________________
والعاثور: المتالِف. قال «5» :
وبلدةٍ كثيرةِ العاثُورِ
ثعر: الثَّعْرُ والثُّعْرُ، لغتان، لَثىً «6» يخرج من غصن شجرة السَّمُر، يقال: هو سمٌّ. والثُّعْرور «7» : الغليظ القصير من الرّجال. والثعارير: ضربٌ من النّبات يشبه الأذْخِرَ يكون بأرض الحجاز.
رعث: الرَّعْثةُ: تلتلة تتّخذ من جُفِّ الطَّلْعِ يُشْرَبُ بها. والرِّعاثُ: ضربٌ من الخَرَزِ والحليّ. قال «8» :
إذا علقت خافَ الجنان رِعاثها
وقال «9» :
رقراقة كالرشأ المُرَعَّثِ
أي في عنقها قلائد كالرِعاث. وكلّ مِعْلاقٍ كالقُرط والشّنْف ونحوه في آذان أو قلادة فهو رِعاثٌ، وربّما علّقت في الهودج رُعُثٌ كثيرة، وهي ذباذب يُزَيَّنُ بها الهودجُ. ورَعْثَةُ الدّيك عُثْنونُهُ. أنشد أبو ليلى «10» :
ماذا يُؤَرّقُني والنّومُ يَطْرُقُني ... من صوتِ ذي رَعَثاتٍ ساكنِ الدّارِ
__________
(5) (العجاج) ديوانه ص 225، والرواية فيه: بل بلدة مرهوبة العاثور.
(6) في (س) : لما.
(7) في (ص) و (ط) والثعارير والثعرور. وفي (س) والثعارير.
(8) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول.
(9) (رؤبة) ديوانه ص 27 والرواية فيه:
دارا لذاك الرشأ المرعث
ورواية اللسان كرواية الأصول.
(10) (الأخطل) كما جاء في اللسان. وليس في ديوانه.
(2/106)
________________________________________
وَرَعِثَتِ العَنْز تَرْعَثُ رَعَثاً إذا ابيضّت أطرافُ رَعْثَتِها. أي: زَنَمَتها.
رثع: رجل رَثِعٌ، وقوم رَثِعون، وقد رَثِعَ رَثَعاً، وهو الطّمع والحرص.
(2/107)
________________________________________
باب العين والثاء واللام معهما ع ل ث، ث ع ل مستعملان فقط
علث: العَلْثُ: الخَلْطُ. يقال: عَلَثَ يَعْلِثُ عَلْثاً، واعتلث. ويقال للزّنْد إذا لم يُورِ واعتاص: عُلاثة، ويقال: إنّما هو علث والعُلاثُ اسمه. قال «1» :
وإنّي غير معتلث الزناد
أي: غير صلد الزّند. أي: أنا صافي النّسب. واعْتَلَث زنداً أخذه من شجرٍ لا يدري أيوري أم لا. واعتلث سهماً أتّخذه بغير حذاقة. عُلاثَةُ: اسم رجل، ويقال: بل هو الشيء الذي يَجْمع من هنا وهناك.
ثعل: الثُّعْلُ: زيادة السّنّ أو دخول سنّ تحت سنّ في اختلاف من المّنْبِت. ثَعِلَ ثَعَلاً فهو أَثْعَلُ والأنثى ثَعْلاء، وربما كان الثُّعْل في أطباء الناقة، والبقرة، وهي زيادة في طُبْيِها فهي ثَعْلاء. والأَثْعَلُ: السيّد الذي له فضول.
__________
(1) الشطر في التهذيب 2/ 328 وفي اللسان (علث) غير معزو.
(2/108)
________________________________________
والثُّعلول: الرّجلُ الغضبانُ. قال «2» :
وليس بثُعْلولٍ إذا سِيل واجتُدي ... ولا بَرٍماً يوماً إذا الضّيفُ أوهما
والأنثى من الثعالب ثُعالة، ويقال للذّكر أيضاً ثعالة. قال رافع «3» : الثعل دُوَيْبة صغيرة تكون في السّقاء إذا خبث ريحُه. ويقال للرّجل إذا سبّ: هذا الثّعل والكعل، أي: لئيم ليس بشيء، والكعل: كسرة تمر يابس لا يكاد أحدٌ يكسره ولا يأكله وأصله تشبيه بتلك الدّوَيْبَة فاعلم.
عثل «4» : يقال: رجل عِثْوَلٌ، أي: طويل اللحية، ولِحْيةٌ عثولة «5» : [ضخمة «6» ] .
__________
(2) البيت في التهذيب 2/ 329، واللسان (ثعل) غير معزو أيضا.
(3) هذا القول إلى آخره مثبت في (ص) و (ط) بعد ترجمة (علث) . أما في (س) فالقول في موضعه.
(4) هذا من (س) فقط وليس في (ص) ولا (ط) . وقال الأزهري في التهذيب عند ترجمته (عثل) : أهمله الليث.
(5) (س) : عثولية والصواب ما أثبتناه.
(6) زيادة من المحكم 2/ 66 اقتضاها السياق.
(2/109)
________________________________________
باب العين والثاء والنون معهما ع ث ن، ع ن ث يستعملان فقط
عثن: العُثانُ: الدُّخانُ. عَثَنَ النار يَعْثُنُ عَثْناً، وعَثّنَ يُعَثّنُ تعثيناً، أي: دخّن تدخيناً. وعَثِنَ البيتُ يَعْثَنُ عَثَناً إذا عبق به ريح الدُّخْنة، وعَثَّنْتُ البيتَ والثّوبَ بريح الدُّخْنة والطِّيب تعثيناً، أي: دخّنتُه. وعُثْنونُ اللّحية طولُها وما تحتها من الشّعر. والعُثْنونُ: شُعَيْراتٌ عند مَذْبَحِ البعير. وجمعُه: عَثانين. وعُثْنونُ السَّحابِ: [ما تدلّى من هَيْدَبِها] «1» . و [عثنون] «2» الرّيحِ: هَيْدَبُها في أوائلها إذا أقبلت تجُرُّ الغبارَ جرّاً، ويقال: هو أوّلُ هبوبها. ويقال: العِثْنُ: يبيسُ الكلأ.
عنث: العُنْثُ أصلُ تأسيس العُنْثُوة وهي يبيسُ الحلِيّ خاصّة إذا اسودّ وبلي. ويقال: عُنْثَة، وشبه الشاعر شَعَرات اللّمّة به فقال «3» :
عليه من لِمّتِهِ عِناثٌ
ويروى عَناثي مثل عناصي في جماعة عنثوة.
__________
(1) زيادة من التهذيب 2/ 330 من روايته عن الليث.
(2) زيادة لتقويم العبارة.
(3) الرجز في التهذيب 2/ 331 والمحكم 2/ 69 واللسان (عنث) غير معزو أيضا.
(2/110)
________________________________________
باب العين والثّاء والباء معهما ع ب ث، ث ع ب، ب ث ع، ب ع ث مستعملات
عبث: عَبِثَ يَعْبَثُ عَبَثاً فهو عابث بما لا يعنيه، وليس من باله، أي: لاعب. وعَبَثْتُ الأقِطَ أَعْبِثُهُ عَبْثاً فأنا عابث، أي: جفّفته في الشمس. والاسم: العبيث. والعبيثة والعبيث: الخلط «1» .
ثعب: ثَعَبْتُ الماء أَثْعَبُهُ ثَعْباً، أي فجّرته فانثعب، ومنه اشتقّ المَثْعَبُ وهو المِرْزاب. وانثعب الدم من الأنف. والثُّعبانُ: الحيّة الطويل الضّخم، ويقال: أُثْعُبان. قال «2» :
على نهجٍ كثُعْبانِ العرين
والأُثْعُبانُ الوجهُ الضَّخْم الفَخْمُ في حُسْنٍ وبياضٍ. قال الرّاجز «3» :
إنّي رأيتُ أُثْعُباناً جَعْدا ... قد خرجتْ بعدي وقالتْ نكدا
__________
(1) بعده بلا فصل: وهو بالفارسية ترف ترين، وهو المصل أيضا في بعض اللغات. اقتطعناها، لأنها، فيما يبدو، زيادة من النساخ.
(2) لم نقف على الراجز ولا على الرجز في غير الأصول.
(3) البيت في المحكم 2/ 70 وفي اللسان (ثعب) غير معزو أيضا.
(2/111)
________________________________________
والثُّعَبَةُ: ضربٌ من الوزغ لا تلقى أبداً إلا فاتحةً فاها شبه سامّ أبرص، غير أنها خضراء الرأس والحلق جاحظة العينين، والجميع: الثُّعَب. والثَّعْبُ: الذي يجتمع في مسيل المطر من الغُثاء. وربما قالوا: هذا ماء ثَعْبٌ، أي: جارٍ، للواحد، ويجمع على ثُعْبان.
بثع: البَثَعُ: ظهور الدّم في الشّفتين خاصّة. شفة باثِعةٌ كاثِعةٌ، أي: يتبثع فيها الدم، [و] «4» كادت تنفطر من شدّة الحُمرة، فإذا كان بِالغَيْن «5» فهو في الشّفتين وغيرهما من الجسد كلّه، وهو التَّبثّغ.
بعث: البَعْثُ: الإِرسالُ، كبعث الله من في القبور. وَبَعَثْتُ البعيرَ أرسلتُه وحللت عِقالُه، أو كان باركاً فَهِجْتُهُ. قال «6» :
أُنيخها ما بدا لي ثم أَبْعَثُها ... كأنها كاسر في الجو فتخاء
وبعثته من نومه فانبعث، أي: نبّهته. ويومُ البَعْثِ: يومُ القيامة. وضرب البَعْثُ على الجند إذا بعثوا، وكل قوم بُعِثوا في أمرٍ أو في وَجْه فهم بَعْثٌ. وقيل لآدم: ابعَثْ بَعْثَ النار فصار البَعْثُ بَعْثاً للقوم جماعة. هؤلاء بَعْثٌ مثل هؤلاء سفر وركب.
__________
(4) زيادة اقتضاها تقويم العبارة.
(5) في النسخ الثلاث: (والياء) ويبدو أنها زيادة.
(6) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(2/112)
________________________________________
باب العين والثاء والميم معهما ع ث م، ث ع م مستعملان فقط
عثم: عَثَمْتُ عظمَهُ أَعْثِمُهُ عَثْماً إذا أسأت جَبْرَهُ وبقيَ فيه وَرَمٌ أو عِوَج، [وعَثِمَ عَثَماً «1» ] فهو عَثِمٌ، وبه عَثَمٌ كهيئة المشمش. قال «2» :
وقد يقطع السيف اليماني وجفنه ... شباريق أعشار عثمن على كَسْرِ
والعَيْثام: شجرة بيضاء طويلة جداً، الواحدة عَيْثامة «3» . والعَيْثُومُ الضّخم من كلّ شيء الشّديد. ويقال للفيلة الأنثى عَيْثوم، ويقال للذّكر أيضاً عيثوم، ويُجمع عياثيم. قال «4» :
وقد أَسِيرُ أمامَ الحيِّ تحمِلُني ... والفَضْلَتَيْنِ كِنازُ اللحم عيثوم
__________
(1) زيادة من المحكم 2/ 71.
(2) البيت في المحكم 2/ 72، واللسان عثم غير معزو أيضا.
(3) بعد (عيثامة) : تسميه الفرس سبيذ دال أسقطناه لأنه زيادة مقحمة إقحاما.
(4) البيت في التهذيب 2/ 336، واللسان (عثم) غير منسوب أيضا.
(2/113)
________________________________________
أي: قوّية ضخمة شديدة. والعَثَمْثَمُ: الطويل من الإبل في غِلَظٍ، ويُجمع على عَثَمْثَمات، ويوصف به الأسد والبغل لشدّة وَطْئهما.
ثعم: الثَّعْمُ: النّزع والجرّ. ثَعَمْتُه: نزعته. وتَثَعَّمَتْ فلاناً أرضُ بني فلانٍ إذا أعجبتْهُ وجَرَّتْه إليها ونَزَعَتْهُ.
(2/114)
________________________________________
باب العين والرّاء واللام معهما ر ع ل مستعمل فقط
رعل: الرّعْلُ: شدّةُ الطَّعْن «1» . رَعَلَهُ بالرّمح، وأَرْعَلَ الطَّعْنَ. قال الأعراب: الرَّعْلُ الطّعنُ ليس بصحيح إنّما هو الإرعال، وهو السُّرعةُ في الطّعن. وضرب أرعَلُ، وطعنٌ أَرْعَلُ أي: سريع. قال «2» :
يَحمي إذا اخْترط السيوفَ نساءنا ... ضربٌ تطيرُ له السّواعدُ أَرْعَلُ
ورَعْلَةُ الخيل: القِطْعَةُ «3» التي تكون في أوائلها غير كثير. والرِّعالُ: جماعة. قال «4» :
كأنّ رِعالَ الخيلِ لمّا تبدّدت ... بوادي جرادِ الهبوةِ المُتَصَوّب
والرَّعيلُ: القطيعُ أيضاً منها. والرَّعْلَةُ النّعامة، سُمّيت بها لأنّها لا تكاد تُرى إلا سابقةً للظليم. والرَّعْلَةُ: أوّل كلّ جماعة ليست بكثيرة.
__________
(1) في (س) : الوطي، وهو تحريف.
(2) لم نقف على القائل.
(3) من المحكم 2/ 73. في (ص) و (ط) : القطيع، وفي (س) : القطع.
(4) لم نقف على القائل.
(2/115)
________________________________________
وأراعيل في كلام رؤبة: أوائل الرّياح، حيث يقول «5» :
تُزْجي أراعيلَ الجَهامِ الخُورِ
وقال «6» :
جاءت أراعيل وجئت هَدَجا ... في مدرعٍ لي من كساءٍ أَنْهَجا
والرَّعْلَةُ: القُلْفَةُ وهي الجِلْدةُ من أُذُنِ الشّاةِ تُشْتَقُّ فَتُتْرَكُ مُعلّقةً في مُؤَخَّر الأذُن.
__________
(5) ليس في ديوان رؤبة. والرجز في المحكم 2/ 73 واللسان (رعل) منسوب إلى (ذي الرمة) .
(6) لم نهتد إليه.
(2/116)
________________________________________
باب العين والراء والنون معهما ع ر ن، ر ع ن، ن ع ر مستعملات
عرن: عَرِنَتِ الدّابّةُ عَرَناً فهي عَرونٌ، وبها عَرَنٌ وعُرْنَةٌ وعِران، على لفظ العِضاض والخِراط، وهي داءٌ يأخُذُ في رِجل الدّابّة فوق الرُّسْغِ من آخره مثل سَحَجٍ في الجلد يُذْهِب الشَّعر. والعِرانُ: خَشَبة في أنفِ البعير. قال «1» :
وإن يَظْهَرْ حديثُك يُؤتَ عَدْواً ... برأسك في زناق أو عِرانِ
والعَرَنُ «2» قروح تأخذ في أعناق الإبل وأعجازها. والعرنين: الأنف. قال ذو الرمة «3» :
تثني النقاب على عرنين أرنبة ... شماء مارنها بالمسْكِ مَرْثوم
عُرَيْنة: اسم حيّ من اليمن، وعَرين: حيّ من تميم. قال جرير «4» :
بَرِئْتُ إلى عُرَيْنَة من عرين
__________
(1) اللسان (زنق) غير منسوب أيضا.
(2) من (ص) في (ط) و (س) : العرون.
(3) ديوانه 1/ 395.
(4) ديوانه ص 475. وصدر البيت:
عرين من عرينة ليس منا
(2/117)
________________________________________
والعَرِينُ: مأوى الأسد. قال «5» :
أَحَمَّ سَراةِ أعلَى اللّونِ منه ... كَلَوْنِ سَراةِ ثُعْبانِ العَرين
قال: هذا زمامٌ وإنّما حمّمتْهُ الشّمس ولوّحتْ لَوْنَه، والثُعْبانُ على هذه الصفة.
رعن: رَعُنَ الرّجلُ يَرْعَنُ رَعَناً فهو أَرْعَنُ، أي: أهوج، والمرأة رعناء، إذا عُرِفَ الموق والهوج في منطقها. والرَّعنُ من الجبال ليس بطويل، ويجمع على رُعُون ورِعان، قال «6» :
يعدل عنه رعُنِ كلِّ ضدٍّ ... عن جانِبَيْ أجْرَد مُجْرَهِدِّ
أي عريان مستقيم، وقال «7» :
يَرْمينَ بالأبصارِ أنْ رعنٌ بدا
ويقال هو الطّويل. وجيشٌ أرعنُ: كثير. قال «8» :
أَرْعَنَ جرّارٍ إذا جرَّ الأَثَرْ
ورُعِنَ الرّجل إذا غثي عليه كثير. قال «9» :
كأنّه من أوار الشمس مرعون
أي: مغشي عليه من حرّ الشّمس.
__________
(5) (الطرماح) ديوانه 530 والرواية فيه أحم سواد.
(6) (رؤبة) ديوانه 49 والرواية فيه: يعدل عند.. وعن حافتي أبلق ...
(7) لم نقع على الراجز.
(8) (العجاج) - ديوانه ص 16.
(9) التهذيب 2/ 341، واللسان (رعن) ، وصدره:
باكره قانص يسعى بأكلبه
(2/118)
________________________________________
رُعَيْنٌ: جبلٌ باليَمَن، وفيه حِصْن يقال لملكه: ذو رُعَيْنٍ يُنْسَبُ إليه. وكان المسلمون يقولون للنّبيّ صلى الله عليه وآله: أَرْعِنا سمعك، أي: اجعل إلينا سمعك. فاستغنمت اليهود ذلك، فقالوا ينحون نحو المسلمين: يا محمد راعِنا، وهو عندهم شتم، ثمّ قالوا فيما بينهم: إنّا نشتم «10» محمّداً في وجهه، فأنزل الله: لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا «11» ، فقال سعد لليهود: لو قالها رجل منكم لأضرِبَنَّ عُنُقَه.
نعر: نَعَرَ الرّجلُ يَنْعَرُ نعيراً، وهو صوتٌ في الخيشوم. والنُّعرة: الخيشوم. نعر النّاعر، أي: صاح الصائح. قال «12» :
وبَجَّ كلَّ عاندٍ نَعورِ
بَجَّ أي: صبّ فأكْثَرَ، يعني: خروج الدّماء من عِرْقٍ عانِدٍ لا يَرْقأُ دَمُه. نَعَرَ عِذرقُه نُعُوراً وهو خروج الدّم. والناعور: ضَرْبٌ من الدِّلاء. والنُّعَرَةُ: ذبابُ الحمير، أزرق يقع في أنوف الخيل والحمير. قال امرؤ القيس «13» :
فظلّ يُرَنِّحُ في غَيْطَلٍ ... كما يستدير الحِمارُ النَّعِرْ
قال «14» :
وأحذريات يعييها النعر
__________
(10) من (س) . (ص) و (ط) : بالشتم.
(11) البقرة 105.
(12) (العجاج) ديوانه ص 240.
(13) ديوانه ص 162.
(14) لم يقع لنا القائل، ولم نجد القول في غير الأصول.
(2/119)
________________________________________
والنُّعَرَةُ: ما أَجَنَّتْ حُمُرُ الوحش في أرحامها قبل أن يَتمَّ خَلْقُه. قال رؤبة «15» :
والشَّدَنيّاتُ يساقِطْنَ النُّعَرْ ... حُوصَ العُيونِ مُجْهِضاتٍ ما اسْتَطَرْ
يصفُ رِكاباً ترمي بأّجِنَّتِها من شدّة السّير. ورجلٌ نعور: شديد الصوت. ورجل نعر: غضبان. وو امرأة غَيْرَى نَعْرَى، يعني بالنَّعرى: الغضبى «16» . وأمّا نغِرة بالغين فمُحمارّة الوجه مُتغيِّرة متربّدة اللّون. ويقال للمرأة الفحّاشة: نعارة.
__________
(15) ليس في ديوان رؤبة. هو العجاج، ديوانه ص 22.
(16) في النسخ الثلاث: غضبانة.
(2/120)
________________________________________
باب العين والرّاء والفاء معهما ع ر ف، ع ف ر، ر ع ف، ر ف ع، ف ر ع مستعملات
عَرَفَ: عَرَفت الشىءَ مَعْرِفَةً وعِرْفاناً. وأَمْرٌ عارفٌ، معروفٌ، عَرِيفٌ. والعُرْفُ: المعروف. قال النّابغة «17» :
أبَى اللهُ إلا عَدْلَهُ وقَضاءَهُ ... فلا النُّكْرُ مَعْروفٌ ولا العُرْفٌ ضائع
والعَريفُ: القيّم بأمرِ قومٍ عرّفَ عليهم، سُمّي به لأنّه عُرِفَ بذلك الاسم. ويوم عَرَفَة: موقفُ النّاس بعَرَفات، وعَرَفات جبل، والتَّعريفُ: وقوفهم بها وتعظيمهم يوم عَرَفَة. والتعريف: أن تصيب شيئاً فتعرفه إذا ناديت من يعرف هذا. والاعْترافُ: الإقرار بالذّنب، والذلُ، والمهانة، والرضَى به. والنفسُ عَرُوفٌ إذا حُمِلَتْ على أمرٍ بسأتْ به، أي: اطمأنَّت. قال «18» :
فآبوا بالنِّساءِ مُرَدَّفاتٍ ... عوارفَ بعْدَ كَنٍّ وائتجاح
__________
(17) ديوانه ص 53، والرواية فيه: ووفاءه.
(18) في التهذيب 2/ 344، واللسان (عرف) بدون عزو أيضا.
(2/121)
________________________________________
الائتجاح من الوجاح وهو السّتر، أي: معترفات بالذّلّ والهون «19» . والعَرْفُ: ريحٌ طيّبٌ، تقول: ما أطيب عَرْفَهُ، قال الله عز وجل: عَرَّفَها لَهُمْ
«20» ، أي: طيّبها، وقال «21» :
ألا رُبَّ يومٍ قد لَهَوْتُ وليلةٍ ... بواضحة الخدّين طيّبة العَرْف
ويقال: طار القَطا عُرْفاً فعُرْفا، أي: أولاً فأولاً، وجماعة بعد جماعة. والعُرْف: عُرْفُ الفَرَس، ويجمع على أَعْرَاف. ومَعْرَفَةُ الفرس: أصل عرفه. والعرف: نبات ليس بحمض ولا عضاة، وهو من الثمام. قال شجاع: لا أعرفه ولكن أعرف العرف وهو قرحة الأكلة، يقال: أصابته عُرْفة.
عفر: عَفَرْته في التراب أعفره عفرا، وهو متعفّر الوجه في التّراب. والعفر: التّراب. وعفّرتُه تعفيراً، واعتفرته اعتفاراً إذا ضربت به الأرض فَمَغَثْتُه فانعفر، قال «22» :
تَهْلِكُ المِدْراةُ في أكنافِه ... وإذا ما أرسلَتْه يَنْعَفِرْ
أي: يسقط على الأرض.
__________
(19) ورد في النسخ الثلاث نص بعد كلمة (الهون) يبدو أنه أقحم إقحاما، لأنه فضلة وزيادة لا يقتضيها السياق، ولا يحتاج إليه الشاهد فضلا عما فيه من إرتباك، والنص هو: يقول كان فرسان هذه النساء قد ائتجحوا افتخروا وكروا ثم غلبوا بعد ذلك وأخذت سبيهم.
(20) سورة (محمد) 6.
(21) لم نقع على القائل، ولا على القول في غير الأصول.
(22) البيت في التهذيب 2/ 351 غير معزو أيضا. وفي اللسان (عفر) معزو إلى المرار.
(2/122)
________________________________________
يَعْفُر: اسم رجل. والعُفرة في اللون: أن يضرب إلى غيره في حمرة، كلون الظّبي الأعْفَر، وكذلك الرّمل الأعفر. قال الفرزدق «22» :
يقول لي الأنباط إذْ أنا ساقط ... به لا بظبيٍ بالصَّريمة أعفرا
واليعفور: الخشف، لكثرة لزوقه بالأرض. ورجل عِفْرٌ وعِفْرِيَةٌ. وعِفارِيَةٌ وعِفْريتٌ: بيّن العَفارة، يوصف بالشيطنة. وشيطان عِفْرِيةٌ وعِفْريتٌ وهم العَفارِيَة والعَفارِيتُ، وهو الظّريف الكيّس، ويقال للخبيث: عِفِّرِّي، أي: عِفِرّ وهم العفريون وأسد عفرنى ولبوءة عَفَرناةٌ وهي الشّديدة قال الأعشى «23» :
بذاتِ لَوْثٍ «24» عَفَرْناةٍ إذا عَثَرَتْ
وعِفْرِيةُ الرأس: الشّعر الذي عليه. وعِفْرِيةُ الديك مثله. وأمّا ليثُ عِفِّرين فدُوَيْبَّة مأواها التّراب السّهل في أصول الحيطان. تُدَوِّرُ دُوّارة ثم تندسّ في جوفها، فإذا هِيج رمَى بالتّراب صُعُدا. ويُسمَّى الرّجل الكامل من أبناء خمسين: ليثَ عِفِرِّين. قال: وابنُ العَشْر لعّابٌ بالقُلِينَ، وابنُ العِشرينَ باغي نِسِين، أي: طالب نساء، وابنُ الثلاثين أسْعَى السّاعينَ، وابنُ الأربعين أبطشُ الباطشينَ، وابنُ الخمسين ليث عِفِرّين. وابنُ الستين مؤنس الجَليسينَ، وابنُ السّبعينَ أحكمُ الحاكمين، وابنُ الثّمانينَ أسرعُ الحاسبينَ، وابنُ
__________
(22) ديوانه 1/ 201 ولكن الرواية فيه:
أقول له لما أتاني نعية ... به لا بظبي بالصريمة أعفرا
(23) ديوانه ص 103.
(24) في (س) و (ط) : ليث، وفي (ص) بياض، والصواب ما أثبتناه. وعجز البيت:
فالتَّعْسُ أَدْنَى لها من أن أقول: لعا
(2/123)
________________________________________
التّسعين واحد الأرذلينَ، وابنُ المائة لاجا ولاسا، أي: لا رجل ولا امرأة. والعَفارَة: شجرة من المَرْخ يُتَّخذُ منها الزّند، ويُجمع: عَفاراً. ومَعافر: العرفط يَخْرجُ منه شبه صَمْغٍ حُلوٍ يُضيّع بالماء فيشرب. ومَعافر: قبيلةٌ من اليَمَن. ولقيته عن عُفْرٍ، أي بعد حين. وأنشد «25» :
أعِكْرِم أنت الأصل والفرعُ والذي ... أتاك ابن عمّ زائراً لك عن عُفْرَ
قال أبو عبد الله: يقال: إنّ المُعَفَّر المفطوم شيئاً بعد شيءٍ يُحْبَس عنه اللبن للوقت الذي كان يرضَعُ شيئاً، ثمّ يعاد بالرَّضاع، ثمّ يُزادُ تأخيراً عن الوقت، فلا تزالُ أمُّه به حتّى يصبر عن الرَّضاع، فَتَفْطمه فِطاماً باتًّا.
رعف: رَعَفَ يَرْعُفُ رُعافاً فهو راعف. قال «26» : تضمَّخْنَ بالجاديّ حتّى كأنّما الأنوفُ إذا استعرضتَهُنَّ رواعفُ والرَّاعفُ: أَنْف الجبل «27» ، ويجمع رواعف. والرّاعِفُ: طرف الأرْنَبَة. والرّاعِف: المتقدم. وراعوفةُ البئر وأُرْعوفَتُها، لغتان،: حجر ناتىء [على رأسها «28» ] لا يستطاع قلعه، ويقال: هو حجرٌ على رأس البئر يقوم عليه المستقي.
__________
(25) لم يقع لنا المنشد ولا القائل، كما لم يقع لنا البيت في غير الأصول.
(26) لم نهتد إلى القائل.
(27) من التهذيب في روايته عن الليث 2/ 348. في النسخ الثلاث: الجمل، وهو تصحيف.
(28) زيادة من المحكم 2/ 86 لتقويم العبارة.
(2/124)
________________________________________
رفع: رفَعْته رَفْعاً فارتفع. وبَرْقٌ رافع، أي: ساطع، قال «29» :
أصاح ألم يُحْزِنْكَ ريح مريضة ... وبرق تلالا بالعقيقين رافع
والمرفوعُ من حُضْر الفَرَس والبِرْذَون دون الحُضْر وفوقَ الموضوع. يقال: ارفع من دابتك، هكذا كلام العرب. ورَفُع الرّجلُ يَرْفُعُ رَفاعةً فهو رفيعٌ [إذا شَرُف] «30» وامرأة رفيعة. والحمارُ يرفِّعُ في عَدْوِهِ ترفيعاً: [أي: عدا] «31» عَدْواً بعضُهُ أرفعُ من بعض. كذلك لو أخذت شيئاً فرفعت الأوّل فالأوّل قلت: رفَّعتُه ترفيعاً. والرَّفْعُ: نقيضُ الخَفْضِ. قال «32» :
فاخْضَعْ ولا تُنْكِرْ لربّك قُدْرةً ... فالله يخفض من يشاء ويرفع
والرّفعة نقيض الذّلّة. والرُّفاعةُ والعظامة و [الزنجبة] «33» : شيء تعظّم به المرأة عجيزتها.
فرع: فَرَعْتُ رأس الجبل، وفَرَعْتُ فلاناً: علوتُه. قال لبيد «34» :
لم أَبِتْ إلاّ عليه أو على ... مَرْقَب يَفْرَعُ أطرافَ الجَبَلْ
__________
(29) لم نهتد إلى القائل.
(30) من التهذيب 2/ 358 في روايته عن الليث.
(31) من التهذيب 2/ 358 في روايته عن الليث.
(32) لم نهتد إلى القائل.
(33) من اللسان (زنجب) . في النسخ الثلاث (الزنجتة) .
(34) ديوانه ص 190 والرواية فيه: لم أقل.
(2/125)
________________________________________
والفَرْعُ: أوّل نِتاجِ الغنم أو الإبل. وأَفْرَعَ القومُ إذا نُتِجوا في أوّل النِّتاج. ويقال: الفَرَعُ: أوّل نتاج الإبل يُسلخ جلده فَيُلْبَسُ فصيلاً آخر ثم تَعْطِفُ عليه [ناقة] «35» سوى أُمّه فتحلبُ عليه. قال أوس بن حَجَر «36» :
وشُبِّهَ الهيدب العبام من الأقوام ... سَقْباً مُجَلَّلاً فَرَعا
والفَرْعُ: أعلى كلّ شيء، وجَمْعُه: فُروعٌ. والفروع: الصّعود من الأرض. ووادٍ مُفْرِعٍ: أفْرَع أهلَه، أيْ: كفاهم فلا يحتاجون إلى نُجْعة. والفَرَعُ: المال المُعَدُّ. ويقال: فَرِعَ يَفْرَعُ فَرَعاً، ورجلٌ أَفْرَعُ: كثير الشّعر. والفارِع والفارِعة والأفرَعُ والفَرْعاء يوصف به كثرة الشّعر وطوله على الرأس. ورجلٌ مُفْرَعُ الكَتِفِ: أي: عريض. قال مرار «37» :
جَعْدةٌ فرعاءُ في جُمْجُمةٍ ... ضخْمةٍ نمرق عنها كالضّفر
وأفرع فلان إذا طال طولاً. وأَفْرَعْتُ «38» بفلانٍ فما أحمدته، أي: نزلت. وأفرع فلان في فرع قومه، قال النابغة «39» :
ورعابيب كأمثالِ الدُّمَى ... مُفْرِعات في ذِرَى عز الكرم
__________
(35) من المحكم 2/ 89.
(36) ديوانه 54 والرواية فيه: ملبسا فرعا.
(37) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(38) من (س) . (ص) و (ط) : أفرعته.
(39) ليس في ديوان النابغة، ولم نقع على البيت فيما تحت أيدينا.
(2/126)
________________________________________
وقول الشاعر «40» :
وفروعٍ سابغٍ أطرافها ... عللتها ريح مسك ذي فَنَع
يعني بالفروع: الشعور. وافْتَرَعْتُ المرأةَ: افْتَضَضْتُها. وفَرَّعْتُ أرض كذا: أي جوّلت فيها، وعلمت علمها وخبرها. وفَرْعَةُ الطّريق وفارِعَتُهُ: حواشيه. وتَفَرّعْتُ بني فلان: أي: تزوّجتُ سيّدةَ نسائهم. قال «41» :
وتفرّعنا من ابني وائلٍ ... هامةَ العزّ وخُرطومَ الكرم
فوارع: موضعٌ. والإفراعُ: التصويب. والمُفْرِعُ: الطويل من كلّ شيء. والفارعُ: ما ارتفع من الأرض من تلّ أو علم. أو نحو ذلك. فارِعٌ: اسمُ حصنٍ كان في المدينة. والفرعة: القملة الصغيرة.
__________
(40) (سويد بن أبي كاهل) اللسان- (فنع) .
(41) لم يقع لنا القائل.
(2/127)
________________________________________
باب العين والراء والباء معهما ع ر ب، ع ب ر، ر ع ب، ب ع ر، ر ب ع، ب ر ع مستعملات
عرب: العرب العاربة: الصريح منهم. والأعاريب: جماعة الأعراب. ورجل عربيّ. وما بها عَريب، أي: ما بها عربيّ. وأعرب الرجل: أفصح القول والكلام، وهو عربانيّ اللسان، أي: فصيح. وأعرب الفرس إذا خلصت عربيّته وفاتته القرافة. والإبل العِراب: هي العربية والعرب المستعربة الذين دخلوا فيهم فاستعربوا وتعرّبوا. والمرأة العَروُبُ: الضحّاكة الطّيّبةُ النّفس، وهنّ العرب. والعَروبةُ: يوم الجُمُعَة. قال «1» :
يا حسنه عبد العزيز إذا بدا ... يومَ العروبة واستقر المنير
كَنَّى عن عبد العزيز قبل أن يظهره، ثم أظهره. والعَرَبُ: النّشاطُ والأرَنُ. وعرب الرجل يعرب عربا فهو عَرِبٌ، وكذلك الفرس عرب، أي: نشيط.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2/128)
________________________________________
وعرب الرجل يعرب عربا فهو عَرِبٌ، أي: مُتْخَم. وعربت مَعِدَتُه وهو أن يدوي جوفه من العلف. والعِرْبُ: يبيس البهمى. الواحدة: عِرْبَةٌ. والتّعريب: أن تُعَرَّبَ الدّابّة فَتُكْوَى على أشاعراها في مواضع، ثم يُبْزَغُ بمبزَغٍ ليشتدّ أشعره. والعِرابَةُ والتَّعريب والإعْرابُ: أسامٍ من قولك: أعربت، وهو ما قبح من الكلام، وكرِه الإعرابُ للمُحْرِم. وعرّبت عن فلان، أي تكلّمت عنه بحجة.
عبر: عَبَّرَ يُعبِّر الرؤيا تَعبيراً. وعَبَرَها يَعْبُرُها عَبْراً وعِبارة. إذا فسّرها. وعَبَرْت النهر عُبوراً. وعِبْرُ النّهر شطّه. وناقةٌ عُبْرُ أسفارٍ. أي: لا تزال يُسافَرُ عليها. قال [الطّرمّاح] «2» :
قد تبطنت بهلواعة ... عبر أسفارٍ كَتُومِ البُغامْ
والمَعْبَرُ: شط النهر الذي هيىء للعبور. والمَعْبَرُ: مركب يعبر بك، أي: يقطع بلداً إلى بلَدٍ. والمِعْبَرَة: سفينة يُعْبَرُ عليها النّهرُ. وعَبَّرتُ عنه تعبيراً إذا عيّ من حُجّته فتكلّمتُ بها عنه. والشّعرى العَبورُ: نجم خلف الجوزاء. وعَبَّرتُ الدّنانير تعبيراً: وَزَنْتها ديناراً ديناراً. ورجلٌ عابِرُ سبيلٍ، أي مارُّ طريق. والعِبْرَةُ: الإعتبار لما مضى. والعَبيرُ: ضربٌ من الطيب.
__________
(2) ديوانه 407 (دمشق) ، واللسان (هلع) والرواية في اللسان: غبر بالغين المعجمة. ونسب البيت في النسخ الثلاث إلى (لبيد،) وليس في ديوانه.
(2/129)
________________________________________
وعَبْرَة الدّمع: جريُه، ونفسه أيضاً. عَبِرَ فلان يَعْبَرُ عَبَراً من الحزن، وهو عَبْرانُ عَبِرٌ، وامرأة عَبْرَى عَبِرَةٌ. واستعبر، أي: جرت عَبْرَتُهُ. والعُبْرِيُّ: ضربٌ من السِّدْر. ويقال: العُبْرِيُّ: الطويل من السِّدْر الذي له سوق. والضّال: ما صغر منه. قال العجّاج «3» :
لاثٌ بها الأشاءُ والعُبْرِيّ
وقال «4» :
..... ... ضروبَ السِّدرِ عُبْرِيّاً وضالا
والعُبْرُ: قبيلة، قال «5» :
وقابلتِ العُبْر نصف النهار ... ثمّ تولّت مع الصّادر
وقوم عَبيٌر، أي: كثيرٌ. والعِبْرانِيّة لغة اليهود.
رعب: الرُّعْبُ: الخوف. رَعَبْتُ فلاناً رُعْباً ورُعُباً فهو مرعوب مُرْتَعِبٌ، أي: فَزِع. والحمام الرّعبيّ والرّاعبيّ: يُرَعِّبُ في صوته ترعيباً، وهو شدّة الصوت. ويقال: إنّه لشديد الرَّعب. قال:
ولا أجيب الرعب إن دعيت
__________
(3) ديوانه 324 (بيروت) .
(4) (ذو الرمة) ديوانه 3/ 1530، وصدر البيت:
قطعت إذا تجوفت العواطي
(5) لم نهتد إلى القائل.
(2/130)
________________________________________
ورعّبْتُ السّنامَ ترعيباً. إذا قطّعته تِرْعيبةً تِرْعيبةً. والرّعبة: القِطعة من السّنامِ ونحوه. قال «6» :
ثمّ ظلِلنا في شواءٍ رُعْبَبُه
وقال «7» :
كأنَّهنّ إذا جرّدنَ تِرْعيب
وجارية رُعبوبة. أي: شطبة تارة، ويقال: رُعبوب والجمع: الرّعابيب. قال الأخطل «8» :
قضيت لبانةَ الحاجاتِ إلاّ ... من البيضِ الرَّعابيبِ المِلاحِ
والتَّرْعابةُ: الفَروقةُ. قال «9» :
أرى كلَّ ياموف وكلّ حَزَنْبَلٍ ... وشِهْدارة تِرْعابة قد تضلّعا
الشهدارة: القصير، وهو الذي يُسْخَر منه أيضاً. وسيلٌ راعِبٌ، إذا امتلأ (منه) «10» الوادي
بعر: البَعَرُ للإِبل ولكلّ ذي ظلف إلاّ للبقر الأهليّ فإنه يَخْثِي. والوحشيّ يَبْعَرُ. ويقال: بَعَرُ الأرانب وخراها. والمِبعار: الشاة أو النّاقة تُباعِرُ إلى حالبها، وهو البُعار على فُعال [بضم الفاء] ، لأنّه عيب. وقال: بل المِبعار: الكثيرة البَعَر.
__________
(6) التهذيب 2/ 368: وأنشد الليث وكذلك اللسان (رعب) .
(7) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(8) ليس في ديوانه.
(9) لم نهتد إليه في غير الأصول، ودوناه كما جاء في الأصول.
(10) سقطت من..
(2/131)
________________________________________
والمَبْعَر حيث يكون البَعَرُ من الإِبل والشاء، وهي: المَبَاعِر. والبعيرُ البازل. والعرب تقول: هذا بَعيرٌ ما لم يَعْرِفوا، فإذا عَرَفوا قالوا للذّكر: جمل، وللأُنْثَى: ناقة، كما يقولون: إنسان فإذا عرفوا قالوا للذكر: رجل، وللأُنْثى امرأة.
ربع: رَبَعَ يَرْبَعُ رَبْعاً. ورَبَعْتُ القومَ فأنار رابِعُهم. والرِّبْعُ من الوِرْدِ: أن تُحْبَسَ الإبلُ عن الماءِ أربعةَ أيّامٍ ثم تردَ اليومَ الخامسَ «11» . قال «12» :
وبلدةٍ تُمسِي قَطاها نُسَّسا ... روابِعاً وبعدَ رِبْعٍ خُمَّسا
ورَبَعْت الحجر بيديّ رَبْعاً إذا رفعته عن الأرض بيدك. ورَبَعْتُ الوتَرَ إذا جعلته أربعَ طاقاتٍ. قال «13»
كقوس الماسخيّ يرنّ فيها ... من الشّرعيّ مربوع متين
وقال لبيد «14» :
رابط الجأش على فرجهم ... أعطف الجون بمربوع متل
وقال «15» :
أنزعها تبوّعا ومتّا ... بالمَسَدِ المربوعِ حتى ارفتّا
__________
(11) في النسخ الثلاث: يوم الخامس.
(12) (العجاج) ديوانه 127.
(13) لم نهتد إلى قائله، ولم يقع لنا البيت في غير الأصولين.
(14) ديوانه ص 186.
(15) لم نهتد إلى الراجز.
(2/132)
________________________________________
يعني الزّمام [أي] : أنه على أربعِ قُوَى. ومربوع مثل رمحٍ ليس بطويل ولا قصير. وتقول: ارْبَعْ على ظلعك، وارْبَعْ على نفسك، أي انتظر. قال «16» :
لو أنهم قبل بينهم رَبَعوا
والرَّبْعُ: المنزلْ والوطنُ. سمّي رَبْعاً، لأنّهم يَرْبَعون فيه، أي: يطمئنّون، ويقال: هو الموضع الذي يرتبعون فيه في الرّبيع. والرُّبَعُ: الفصيل الذي نُتِجَ في الرّبيع. ورجلٌ رَبْعَة ومَرْبوع الخلق، أي: ليس بطويل ولا قصير. والمِرباعُ كانت العرب إذا غزت أخذ رئيسُهم رُبْعَ الغنيمةِ، وقَسَمَ بينهم ما بقي. قال «17» :
لك المِرباعُ منها والصّفايا ... وحُكْمُكَ والنَّشيطةُ والفُضولُ
وأوّل الأسنان الثّنايا ثم الرَّباعيات، الواحدة: رَباعيَة. وأَرْبَعَ الفرس: ألقى رَباعِيَتَهُ من السّنة الأخرى. والجميع: الربع والأثني: رَباعيَة. والإِبل تعدو أربعة، وهو عَدْوٌ فوق المشي فيه مَيَلان. وأرْبَعَتِ الناقةُ فهي مُرْبعٌ إذا استغلق رَحِمُها فلم تقبل الماء. والأربِعاء والأربِعاوان والأربِعاوات مكسورة الباء حُمِلَتْ على أسعِداء. ومن فتح الباء حمله على قصباء وشبهه «18» والرّبيعة: البيضة من السّلاح. قال «19» :
ربيعته تلوح لدى الهياج
__________
(16) (الأحوص) ديوانه ص 121 وصدره:
ما ضر جيراننا إذ انتجعوا
(17) التهذيب 2/ 369، والمحكم 2/ 98 والصحاح (ربع) وهو منسوب إلى عبد الله بن عنمة الضبي.
(18) في (س) وشبهاء.
(19) لم يقع لنا القائل ولا القول في غير الأصول.
(2/133)
________________________________________
ورُبِعَتِ الأرضُ فهي مربوعة من الرّبيع. وارْتَبَعَ القوْم: أصابوا ربيعاً، ولا يقال: رُبِعَ. وحمّى ربع تأتي في اليوم الرابع. والمِرْبَعَةُ: خَشَبَةٌ تشال بها الأحمال، فتوضع على الإبل. قال «20» :
أين الشَّظاظانِ وأين المِرْبَعة
قال شجاع: الرَّبَعَةُ أقصى غايةِ العادي. يقال: مالك ترتبع إليّ، أي: تعدو أقصى عَدْوك. رَبَعَ القوم في السّير. أي: رفعوا. قال «21»
واعْرَوْرَتِ العُلُطَ العُرْضيَّ تركضه ... أم الفوارس بالدئداء والرَّبَعَة
وقال «22» :
ما ضرَّ جيراننا إذ ارتبعوا ... لو أنّهم قبلَ بَيْنِهِمْ رَبعوا
هذا من قولهم: إرْبَعْ على نفسك. ويقال: الرّبعة: عَدْوٌ فوق المشي فيه مَيَلان. والرَّبْعَةُ: الجُونةُ. قال خلف بن خليفة «23» :
محاجم نضدن في ربعة
__________
(20) لسان العرب (ربع) بدون عزو.
(21) البيت في التهذيب 2/ 372 واللسان (ربع) وقد نسب فيه إلى (أبي دواد الرؤاسي) .
(22) (الأحوص) ديوانه 121.
(23) لم نقع عليه في غير الأصول.
(2/134)
________________________________________
برع: بَرَعَ يَبْرُعُ بَرْعاً، وهو يتبرّع من قبل نفسه بالعطاء، إذا لم يطلب عوضاً. قالت الخنساء «24» :
جَلْدٌ جميلٌ أريبٌ بارعٌ وَرِعٌ ... مأوى الأرامِلِ والأيتامِ والجار
__________
(24) ليس في ديوانها ولا في الظان التي رجعنا إليها.
(2/135)
________________________________________
باب العين والرّاء والميم معهما ع ر م، ع م ر، ر ع م، م ع ر، ر م ع، م ر ع مستعملات
عرم: عَرَمَ الإنسانُ يَعْرُمُ عَرامةً فهو عارِمٌ. وعَرُم يَعْرُم. قال صقر بن حكيم «1» :
إنّي امرؤٌ يَذُبُّ عن مَحارمي ... بسطةُ كفٍّ ولسانٍ عارمِ
وعُرامُ الجيشِ: حدُّهم وشِرَّتُهم وكَثْرتُهم. قال سَلامَة بنُ جَنْدَل «2» :
وإنّا كالحصى عَدَداً وإنّا ... بنو الحربِ التي فيها عُرامُ
وقال «3» :
وليلةِ هَوْلٍ قد سَرَيْتُ وفِتْيةٍ ... هَدَيْتُ وجمعٍ ذي عُرامٍ مُلادِسِ
والعَرِمُ: الجُرَذُ الذّكَرُ. والعُرْمَةُ: بياضٌ بمرَمّة الشاة، عنقها بيضاء وسائرها أسود. والعَرَمَةُ الكُدْسُ المدوسُ الذي لم يُذَرَّ بعد كهيئة الأزج.
__________
(1) التهذيب 2/ 390، واللسان- عرم، غير منسوب.
(2) ديوانه- ص 251، والمحكم 2/ 104.
(3) التهذيب 2/ 390 واللسان (عرم) غير منسوب أيضا.
(2/136)
________________________________________
قال شجاع: لا أقول: نعجة عَرْماء، ولكن ماعزة عرماء ببطنها بياض. والعَرَمْرَمُ: الجيشُ الكثير. وجبلٌ عَرَمْرَمٌ، أي: ضخم. قال «4» :
أداراً بأجْمادِ النَّعام عَهِدْتُها ... بها نَعَماً حَوْماً وعِزّاً عَرَمْرَمَا
والعَرَمْرَمْ الشّديدْ العجمةِ الذي لا يُفصح.
عمر: العَمْرُ: ضربُ من النَّخْلِ وهو السَّحُوقُ الطويلُ. والعَمْرُ: ما بدا من اللِّثة، ومنه اشتقّ اسم عمرو. والعُمْرُ عُمْرُ الحياة. وقول العرب: لعَمْرُكَ، تحلف بعمره، وتقول: عَمْرَكَ الله أن تفعل كذا. هذا إن تحلفه بالله، أو تسأله طول عُمره. عَمَرَ النّاس وعّمَّرهُمُ الله تعميراً. وتقول: إنّك عَمْري لظريف. وعَمَرَ النّاس الأرض يَعْمُرُونَها عِمارةً، وهي عامرة معمورة ومنها العُمْران. واستعمر الله النّاسَ ليَعْمُروها. والله أعمر الدّنيا عمْراناً فجعلها تعمر ثمُ يُخَرِّبُها. والعِمارة: القبيلة العظيمة. والعُمورُ: [حي من عبد القيس] «5» . قال «6» :
فلولا كان أسعد عبد قيسٍ «7» ... أعاديها لعادتني العمور
والحاجُّ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً. والعَمْرَةُ: خَرَزَةٌ حمراء كثيرة الماء طويلة تكون في القرط.
__________
(4) المحكم 2/ 105، واللسان (عرم) غير منسوب أيضا.
(5) من المحكم 2/ 109، واللسان (عمر) في النسخ الثلاث: (اسم أبي حي من قيس) .
(6) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(7) من (س) . في (ص) و (ط) : (ابن بكر) .
(2/137)
________________________________________
والإفلاس يُكنى أبا عَمْرَة «8» .
رعم: رَعَمَتِ الشّاةُ تَرْعَمُ فهي رَعومٌ، وهو داءٌ يأخذُ في أنفها فيسيل منه شيء، فيقال لذلك الشيء: رُعام رَعُوم: اسم امرأة تشبيهاً بالشّاة الرّعوم. قال الأخطل «9» :
صَرَمَتْ أمامةُ حَبْلَنا وَرَعُومُ ... وبدا المُجَمْجَمُ منهما، المَكْتومُ
رُعْم: اسم امرأة. قال «10» :
ودع عنك رُعْماً قد أتى الدّهر دونها ... وليس على دهر لشيء معول
معر: مَعِرَ الظُّفْرُ مَعَراً. إذا أصابه شيءٌ فَنَصَلَ. قال «11» :
بوقاح مجمر غير مَعِرْ
وقال «12» :
تتّقي الأرضَ بمرثومٍ مَعِرْ
وتَمَعَّرَ لَوْنُهُ إذا تغيّر، وعَرَتْه صفرةٌ من غضبٍ. ورجل أَمْعَرُ، وبه مُعْرَة، وهو لون يضرب إلى الحمرة والصفرة، وهو أقبح الألوان.
__________
(8) من (س) . في (ص) و (ط) : أباعمرو. في التهذيب 2/ 388، والمحكم 2/ 109. واللسان (عمر) : أبوعمرة.
(9) ديوانه 1/ 380 والرواية فيه: حبلها.
(10) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(11) لم يقع لنا الراجز. ولا الرجز في غير الأصول.
(12) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز في غير الأصول.
(2/138)
________________________________________
ومَعِرَ رأس الرّجل إذا ذهب شعره، وأَمْعَر أيضاً بالألف. قال «13» :
والرأس منك مبيّن الإِمْعارِ
ويقال: رجلٌ أَمْعَرُ، أي: قليل الشعر، مثل أَزْعَر. وأَمْعَرَت الأرضُ إذا لم يكن فيها نبات، وأرض مَعِرَة مثل زَعِرَة: قليلة النبات غليظة. ومَعِرَتِ الأرضُ وأمْعَرَتْ لغتان. قال الكميت «14» :
أصبحت ذا تلعة خضراء إذْ مَعِرَتْ ... تلك التلاع من المعروف والرّحب
وأَمْعَرْنا في هذا البلد، أي: وقعنا في أرض مَعِرَة.
رمع: رَمَعَ يَرْمَعُ رَمْعاً ورَمَعاناً وهو التحرّك «15» . وتقول: مرّ بي يرمع رمعاً ورمعاناً مثل: رسم يرسم رسماً «16» ورسماناً. والرَّمّاعةُ: الاست، لترمُّعِها، أي: تحرّكها. والرَّمّاعةُ التي تتحرك من رأس الصبيّ المولود [من يافوخه من رقّته] «17» . واليَرْمَعُ: الحصى البيض التي تتلألأ في الشمس، الواحدة بالهاء. قال رؤبة «18» :
حتى إذا أحمى النهار اليرمعا
__________
(13) لم يقع لنا القائل ولا القول كاملا.
(14) ليس في مجموعة أشعاره، ولا فيما بين أيدينا من مصادر.
(15) (ص) غير واضحة، (ط) التحرف.
(16) سقطت من (ص) و (ط) .
(17) من التهذيب 2/ 393 من روايته عن الليث.
(18) ما في ديوان رؤبة هو:
بالبيد إيقاد الحزور اليَرْمَعا
(2/139)
________________________________________
مرع: مرُعَ يَمْرَعُ مُرْعاً والمَرْعُ الاسم، وهو الكلأ. ويقال: أرض مَرِعَةٌ مُمْرِعة. مثل خَصِبَة مُخْصِبة. وأَمْرَعَ القومُ: أصابوا مَرْعاً. قال «19» :
فلما هبطناه وأَمْرَعَ سربنا ... أسال علينا البطن بالعدد الدثر
وأَمْرَعَ المكانُ والوادي، أي: أكلآ.
__________
(19) لم نهتد إلى القائل.
(2/140)
________________________________________
باب العين واللاّم والنّون معهما ع ل ن، ل ع ن، ن ع ل مستعملات
علن: عَلَنَ الأمرُ يَعْلُنُ عُلُوناً وعَلانِيَةً، أي: شاع وظهر. وأعلنته إعلاناً. قال «1» :
قد كنت وَعَّزْت إلى علاء ... في السر والإعْلانِ والنَّجاءِ
ويقال للرّجُل: استسرّ ثم استعلَنَ. لا يقال: أعلن إلاّ للأمر والكلام، وأمّا استعلن فقد يجوز في كلّ ذلك. واعْتلَنَ الأمر، أي: اشتهر. ويقولون: استعلِنْ يا رجل، أي: أَظْهِرْ. والعِلان: المُعالَنة، يُعْلِنُ كلُّ واحدٍ لصاحبه ما في نفسه. قال «2» :
وإعلاني لمن يبغي عِلاني
لعن: اللّعن: التّعذيب، والمُلَعّنُ: المعذّب، واللَّعِينُ المشتوم المسبوب «3» . لَعَنْتُه: سَبَبْتُه. ولَعَنَهُ اللهُ: باعده.
__________
(1) اللسان (وعز) ، غير معزو أيضا.
(2) التهذيب 2/ 396 عن الليث، واللسان (علن) ، وصدر البيت فيهما:
وكفي عن أذى الجيران نفسي
(3) في النسخ الثلاث: المسبب.
(2/141)
________________________________________
واللَّعِينُ: ما يُتّخذ في المزارع كهيئة رجل. واللَّعْنَةُ في القرآن: العذابُ. وقولهم: أبيت اللَّعْنَ، أي: لا تأتي أمراً تُلْحَى عليه وتُلْعَنُ. واللّعنة: الدّعاء عليه. واللُّعَنَةُ: الكثيرُ اللّعن، واللُّعْنَةُ: الذي يلعنه النّاس. والْتَعَنَ الرّجُل، أي: أنصف في الدّعاء على نفسِه وخَصْمِه، فيقول: على الكاذب منّي ومنك اللَّعْنة. وتلاعَنوا: لَعَنَ بعضهم بعضا، واشتقاق مُلاعَنة الرّجل امرأته منه في الحكم. والحاكم يُلاعِنُ بينهما ثم يُفَرِّق. قال جميل «4» :
إذا ما ابنُ ملعونٍ تَحدَّر رشْحُه ... عليكِ فموتي بعد ذلك أوذري
والتلاعُنُ كالتَّشاتُم في اللفظ، وكلّ فعل على [تفاعل] «5» فإن الفعل يكون منها، غير أن التّلاعُنَ ربّما استعمل في فعل أحدهما، والتَّلاعُنُ يقع فعل كلّ واحدٍ منهما بنفسه ويجوز أن يقع كلُّ واحدٍ بصاحبه فهو على معنيين.
نعل: النَّعْل: ما جُعِلَتْ وقاية من الأرض. نَعِل يَنْعَل نعلاً، وانتعل بكذا: [إذا لبس النّعل] «6» . والتنعيل: أن يُنَعّل حافر البِرْذَوْن بطبقٍ من حديد يقيه الحجارة، [وكذلك خُفّ البعير بالجلد] «7» لئلا يحفى.
__________
(4) ديوانه ص 101.
(5) في النسخ: (مفاعل) .
(6) زيادة من التهذيب 2/ 398 من روايته عن الليث.
(7) زيادة من التهذيب 2/ 398 من روايته عن الليث.
(2/142)
________________________________________
ويقال: لا يقال إلاّ أَنْعلت. ويوصف حمار الوحش فيقال: ناعِلٌ، لصلابته. قال «8» :
يركب قيناه وقيعا ناعلا
يقول: صلبُ من توقيع الحجارةِ حتّى كأنّه مُنْتَعِلٌ من وَقاحته. ورجلٌ ناعل: ذو خفّ ونَعْل، وكذلك مُنْعِل. وكذلك يقال: أنْعَلتُ الفرس. ونَعْلُ السيف: الحديدة التي في أسفل جفنه. قال «9» :
إلى ملك لا ينصف السّاق نعله
والنَّعلُ من الأرض: شبه أكمة صلب يبرق حصاه، لا ينبت شيئاً، ويجمع النّعال، ونعلها غِلَظُها. قال «10» :
كأنّهمْ حَرْشَفٌ مَبْثُوثٌ ... بالجوِّ إذ تَبْرُقُ النِّعالُ
يعني: نعال الحرة.
__________
(8) ديوانه/ 125.
(9) (ذو الرمة) ديوانه 2/ 1266 وعجز البيت:
أَجَلْ لا، وإنْ كانت طوالا محامله
والرواية فيه: (ترى سيفه) مكان (إلى ملك) .
(10) (امرؤ القيس) ديوانه 193.
(2/143)
________________________________________
باب العين واللاّم والفاء معهما ع ل ف، ع ف ل، ف ع ل، ل ف ع، ف ل ع مستعملات
علف: عَلَفْتُ الدّابةَ أَعْلِفُها عَلْفاً، أي: أطعمتها العَلَف. والمِعْلَفُ: موضع العَلَف. والدّابة تعتلف، أي: تأكل، وتستعلِفُ، أي: تطلب العَلَفَ بالحمحمة. والشّاة المُعَلَّفة هي التي تسمّن. علّفتها تعليفاً [إذا أكثرت تعهّدها بإلقاء العَلَفِ لها] «1» . (وعلوفة الدّوابّ كأنّه جَمْعٌ وهو شبيهٌ بالمصدر وبالجمع أُخرى) «2» . والعُلَّفُ: ثمرُ الطّلح، مشددة اللاّم، الواحدة بالهاء. والعِلافِيّ، منسوب، وهو أعظم الرِّحال آخرة وواسطاً «3» . وجمعه: عِلافيّات. قال ذو الرّمة «4» :
أحمُّ عِلافيٌّ وأبيضُ صارمٌ ... وأَعْيَسُ مَهْرِيٌّ وأروع ماجد
__________
(1) ما بين المعقوفتين من التهذيب من روايته عن الليث وما يقابله في النسخ مضطرب.
(2) جعلت بين قوسين لأنها مضطربة.
(3) من التهذيب في روايته عن الليث 2/ 400. في النسخ الثلاث: واسطة.
(4) ديوانه 2/ 1109، والرواية فيه (وأشعث ماجِدُ) .
(2/144)
________________________________________
وقال «5» :
شعب العِلافيّاتِ بين فروجهم ... والمحصناتُ عوازبُ الأطهار
قوله بين فروجهم، أي قد ركبوها ونساؤهم عوازب منهن إذا طهرن لا يغشونهنَّ، لأنّهم أبداً على الأسفار. وشيخ عُلْفوفٌ: كثيرُ الشَّعَرِ واللّحمِ، ويقال: هو الكبير السّنّ.
عفل: عَفِلَتِ المرأةُ عَفَلاً فهي عَفْلاءُ. وعَفِلَتِ النّاقةُ. والعَفَلُ والعَفَلَةُ الاسم، وهو شيء يخرج في حياء النّاقة شِبهُ أَدَرة.
فعل: فَعَلَ يَفْعَلُ فَعْلاً وفِعْلاً، فالفَعْلُ: المصدر، والفِعْل: الاسم، والفَعالُ اسمٌ للفِعل الحسَن، مثل الجود والكرم ونحوه. ويقرأ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ «6» بالنصب. والفَعَلَةُ: العَمَلَةُ، وهم قوم يستعملون الطّينَ والحَفْر وما يشبه ذلك من العمل.
لفع: لفع الشّيبُ الرأس يلفع لفعاً، أي: شمل المشيب الرأس. قال سويد «7» :
كيف يرجون سقاطي بعد ما ... لفع الرأس مشيب وصلع
__________
(5) لم نهتد إلى القائل.
(6) الأنبياء 73.
(7) لم نهتد إلى القائل.
(2/145)
________________________________________
وتلفّع الرّجلُ، إذا شمله الشيبُ، كأنّه غطّى على سوادِ رأسِه ولحيته. قال رؤبة بن العجاج «8» :
إنّا إذا أمر العدى تَتَرَّعا ... وأجمعت بالشر أن تلفعا
أي: تلبّس بالشّر، يقول: يشمل شرُّهم النّاسَ. وقال «9» :
وقد تلفع بالقور العساقيل
يعني: تلفع السّرابُ على القَارَةِ. وإذا اخضرَّ الرَعيُ واليبيسُ، وانتفعَ المالُ بما يأكل. قيل: قد تَلَفَّعَ المالُ. ولُفِّعَتْ «10» فهي مُلَفَّعَة. واللِّفاعُ: خمارٌ للمرأة يَسْتُرُ رأسَها وصَدْرَها، والمرأة تَتَلَفَّعُ به. وتقول: لَفِّعَتِ المزادةُ فهي مُلَفَّعَة، أي: ثنيتها فجعلت أَطِبَّتَها في وَسَطها، فذلك تَلْفِيعُها.
فلع: فَلَعَ رأسَه بحجرٍ يَفْلَعُ فَلْعاً فهو مَفْلوعٌ، أي مشقوق، فانْفَلَعَ، أي: انشقّ. قال طفيل «11» :
نَشُقُّ العِهادَ الحُوَّ لم تُرْعَ قبلنا ... كما شُقَّ بالمُوسَى السَّنامُ المفلع
وتفلعت البطيخة، وتفلعت العَقِبُ ونحوه. ويُقال في الشتم: لَعَنَ الله فِلْعَتَها. ويقال للمرأة: يا فَلْعَاءُ، ويا فَلْحاء، أي: يا منشقة.
__________
(8) ديوانه 91. في النسخ الثلاث: (العجاج) .
(9) (كعب بن زهير) ديوانه 16 وصدره:
كأنّ أَوْبَ ذراعيها وقد عرقت
(10) في النسخ الثلاث (وألفعت) ولم نجد (ألفع) .
(11) (طفيل الغنوي) كما في اللسان (فلع) .
(2/146)
________________________________________
باب العين واللاّم والباء معهما ع ل ب، ع ب ل، ل ع ب، ب ع ل، ب ل ع مستعملات
علب: عَلِبَ النّباتُ يَعْلَبُ عَلَباً فهو عَلِبٌ. وهو الجاسي. واللحم يَعْلَبُ ويستَعْلَبُ إذا لم يكن رخصاً. واسْتَعْلَبْتُ البقل، أي: وجدْتُه عَلِباً. والعلبة الشيخ الكبير المهزول. والعُلْبُ: الضبُّّ الضّخْمُ المُسِنُّ. والعِلْباءُ: عَصَبُ العُنُق، وهما عِلباوان، وهُنَّ عَلاَبيُّ. ورمْح مُعَلَّبٌ، أي: مجلُوزٌ بعَصَبِ العِلْباء. والعُلْبَةُ من خشب كالقَدَح يُحْلَبُ فيها. ويقال: عَلَّبْتُ السّيفَ بالعَلابيّ تَعْليباً، وهو سيف مُعَلَّبٌ ومَعْلوبٌ. قال «1» :
وسيفُ الحارثِ المعْلوبُ أَرْدَى ... حُصَيْناً في الجبابرةِ الرَّدِينا
وبعير أَعْلَبُ، وقد عَلِبَ عَلَباً، وهو داء يأخذ في جانِبَيْ عنقه تُرِمُ منه الرَّقَبَةُ وتنحني، تقول: قد حز علباويه، وعلبابيه وبالواو أجود. والعِلابُ سمة في طول العُنُق، ربّما كان شبراً، ورُبّما كان أقصر.
__________
(1) (الكميت) - شعره 2/ 129.
(2/147)
________________________________________
وعَلَبْتُ الشيءَ أَعْلُبُهُ عَلْباً وعُلُوباً إذا أثّرت فيه. قال ابن الرَّقاع «2» :
يتبعْنَ ناجية كأنّ بِدَفِّها ... من غَرْضِ نِسْعتها عُلُوبَ مواسم
عبل: العَبْلُ: الضَّخم، عَبُلَ يَعْبُلُ عَبالةً. قال «3» :
خبطناهم بكلّ أزجّ لام ... كمرضاخ النّوى عَبْلٍ وقاحِ
وحَبْلٌ أَعْبَلُ، وصخرة عَبْلاء، أي: بيضاء. وقد عَبِلَ عَبَلاً فهو أعبل. قال أبو كبير الهذليّ «4» :
أخرجت منها سلقة مهزولة ... عجفاء يَبْرُقُ نابُها كالأَعْبَلِ
أي: كحجرٍ أبيضَ صلب من حجارة المرو. والعَبَلُ: ثمر الأرطى، الواحدة بالهاء.
لعب: لَعِبَ يَلْعَبُ لَعِباً ولَعْباً، فهو لاعبٌ لُعَبَةٌ، ومنه التَّلعُّب. ورجل تِلِعّابة- مشددة العين- أي: ذو تلعُّبٍ. ورجل لُعَبَة، أي: كثير اللَّعِبِ، ولُعْبَة، أي: يُلْعَبُ به كلُعْبَة الشّطْرَنْجِ ونحوها. قال الرّاجز «5» :
العَبْ بها أو اعْطِني ألعب بها ... إنك لا تُحْسِنُ تَلعاباً بها
والمَلْعَبُ حيث يُلْعَبُ. والمِلْعَبَةُ: ثوبٌ لا كُمَّ له، يلعب فيها الصبي.
__________
(2) التهذيب 2/ 407، واللسان (علب) .
(3) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(4) ليس في قصيدة أبي كبير اللامية، والذي فيها هو قوله:
صديان أخذي الطرف في ملمومة ... لون السحاب بها كلون الأعبل
(5) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز في غير الأصول.
(2/148)
________________________________________
واللّعّاب من يكونُ حرفتُه اللَّعِب.. ولُعابُ الصّبيّ: ما سال من فيه، لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْباً، ولعابُ الشّمس: السّراب. قال «6» :
في صحن يهماء يهتَفُّ السّهامُ بها ... في قَرْقَرٍ بلُعاب الشّمسِ مَضْروجِ
قال شجاع: المضروج من نعت القَرْقَر، يقول: هذا القرقر قد اكتسَى السّراب، وأعانه ذائب من شُعاع الشّمس، فقوّى السّراب. ولعاب الشّمس أيضاً: شعاعُها. قال «7» :
حتى إذا ذاب لعابُ الشّمسِ ... واعترف الرّاعي ليومٍ نجسِ
ومُلاعِبُ ظِلِّهِ: طائر بالبادية. ومُلاعِبا ظِلّيهِما، والثلاثة: ملاعباتُ ظِلالِهِنَّ. وتقول: رأيت ثلاثة مُلاعِباتِ أظلالٍ لَهُنَّ، ولا تَقُلْ أظلالَهنّ، لأنّه يصيرُ معْرِفَةً. قال شجاع: مُلاعِبُ ظلِّهِ عندنا: الخطّاف.
بعل: البَعْلُ: الزّوجُ. يقال: بَعَلَ يَبْعَلُ بَعْلاً وبُعَولة فهو بَعْل مستبعل، وامرأة مستبعل، إذا كانت تحظَى عند زوجها، والرّجل يتعرّس لامرأته يطلب الحُظْوَة عندها: والمرأة تتبعّل لزوجها إذا كانت مطيعةً له. والبَعْلُ: أرضٌ مرتفعة لا يُصيبُها مطر إلاّ مرّةً في السّنة. قال سلامة بن جندل «8» :
إذا ما عَلَوْنا ظهرَ بَعْلٍ عَريضَةٍ ... تَخالُ علينا قَيْضَ بَيْضٍ مفلق
__________
(6) (ذو الرمة) ديوانه 2/ 992.
(7) لم نهتد إلى الراجز.
(8) المحكم 2/ 112 واللسان (بعل) . وديوانه 164 إلا أن الرواية فيه: (نشز) وهو وهم من المحقق.
(2/149)
________________________________________
ويقال: البَعْلُ من الأرضِ التي لا يَبْلُغُها الماءُ إنْ سيق إليها لارتفاعها. ورجل بَعِلٌ، وقد بَعِل يَبْعَلُ بَعَلاً إذا كان يصير عند الحرب كالمبهوت من الفرق والدّهش. قال أعشى هَمْدان:
فجاهَدَ في فُرسانِهِ ورجالِهِ ... وناهَضَ لم يَبْعَلْ ولم يتهيّب
وامرأة بَعْلَةٌ: لا تُحسنُ لبسَ الثّياب. والبَعْلُ من النَّخل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها. قال عبد الله بن رَواحة «9» :
هنالك لا أبالي سقيَ نَخْل ... ولا بَعْلٍ وإنْ عَظُمَ الإِتاءُ
الإِتاء: الثّمرة. والبَعْلُ: الذّكر من النّخل، والنّاس يسمّونه: الفّحْل. قال النّابغة «10» :
من الواردات الماء بالقاعِ تستقي ... بأذنابِها قبلَ استقاءِ الحناجِر
أراد بأذنابها: العروق. والبَعْلُ: صَنَمٌ كان لقومِ إلياس. قال الله عز وجل: أَتَدْعُونَ بَعْلًا والتّباعُلُ والمُباعَلَةُ والبِعالُ: مُلاعَبة الرّجلِ أهلَه، تقول: باعَلَها مُباعَلة،
وفي الحديث: أيّام شرب وبعالٍ «11» .
__________
(9) المحكم 2/ 123، واللسان (بعل) . والرواية فيهما: لا أبالي نخل بعل ... ولا سقي..
(10) ديوانه ص 145، والرواية فيه: من الشارعات الماء ... بأعجازها مكان بأذنابها.
(11) تمام الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أيام التشريق، فقال:
إنها أيام أكل وشرب وبعال.
التهذيب 2/ 414.
(2/150)
________________________________________
بلع: بَلِعَ الماءَ يَبْلَعُ بَلْعاً، أي شرب. وابتلعَ الطّعامَ، أي: لم يَمضغْهُ. والبُلَعَةُ من قامة البكرة سَمُّها وثَقْبُها، ويُجمعُ على بُلَع. والبالوعةُ والبَلُّوعةُ: بئر يُضَيَّقُ رأسُها لماءِ المطر. والمَبلع: موضعُ الابتلاع من الحَلْق. قال «12» :
تأمّلوا خَيْشومَه والمَبْلَعا
والبُلَعَةُ والزُّرَدَةُ: الإنسان الأكول. ورجل متبلّع إذا كان أكولاً. وسَعْدُ بَلْعٌ: نجم يجعلونه معرفة. ورجلٌ بَلْعٌ، أي: كأنّه يبتلِعُ الكلامَ. قال رؤبة «13» :
بَلْعٌ إذا استنطقتني صموت
__________
(12) لم نهتد إلى الراجز. غير أن لرؤبة ما يقاربه، وهو قوله:
ما ملئوا أشداقه والمبلعا.
(13) ديوانه 26.
(2/151)
________________________________________
باب العين واللاّم والميم معهما ع ل م، ع م ل، م ع ل، ل م ع مستعملات
علم: عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْماً، نقيض جَهِلَ. ورجل علاّمة، وعلاّم، وعليم، فإن أنكروا العليم فإنّ الله يحكي عن يوسف إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ «1» ، وأدخلت الهاء في علامة للتّوكيد. وما عَلِمْتُ بخبرك، أي: ما شعرت به. وأعلمته بكذا، أي: أَشْعَرْتُه وعلّمته تعليماً. والله العالِمُ العَليمُ العلاّمُ. والأَعْلَمُ: الذي انشقّتْ شَفَتُه العُليا. وقوم عُلْمٌ وقد عَلِمَ عَلَماً. قال عنترة «2» :
تمكو فَريصَتُه كشِدْقِ الأعلَمِ
والعَلَمُ: الجبل الطّويل، والجميع: الأعلام. قال «3» :
قال ابنُ صانعةِ الزّروب لقومه ... لا أستطيعُ رواسيَ الأَعْلامِ
__________
(1) يوسف 55.
(2) ديوانه 24. وصدر البيت:
وخليل غانية تركت مجدلا
(3) لم نهتد إلى القائل. ولم نجد القول في غير الأصول.
(2/152)
________________________________________
ومنه قوله [تعالى] : فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ
«4» *، شبه السّفن البحرية بالجبال. والعَلَمُ: الرّاية، إليها مجمعُ الجُند. والعَلَمُ: عَلَمُ الثّوبِ ورَقْمُه. والعَلَمُ: ما يُنْصَبُ في الطّريق، ليكون علامةً يُهْتَدَى بها، شِبْه الميل والعَلامَة والمَعْلَم. والعَلَم: ما جعلته عَلَماً للشيء. ويُقرأ: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ «5» ، يعني: خروج عيسَى ع، ومن قرأ لعلم يقول: يعلم بخروجه اقتراب السّاعة. والعالَم: الطّمش، أي الأنام، يعني: الخلق كلّه، والجمع: عالَمون. والمَعْلَمُ: موضعُ العلامة. والعَيْلَمُ: البحر، والماء الذي عليه الأرض، قال «6» :
في حوض جيّاش بعيدٍ عَيْلَمُهْ
ويقال: العيلم: البئر الكثيرة الماء، قال «7» :
يا جَمَّةَ العَيْلَم لَنْ نُراعي ... أورد من كلّ خليفٍ راعي
الخليف: الطّريق. والعُلامُ: الباشِقُ. عُلَيْمٌ: اسمُ رجل.
عمل: عَمِلَ عَمَلاً فهو عاملٌ. واعتمل: عمل لنفسه. قال «8» :
إنّ الكريمَ وأبيك يَعْتَمِلْ ... إنْ لم يجد يوما على من يتكل
__________
(4) الشورى 32 والرحمن 24.
(5) الزخرف 61.
(6) (رؤبة) ديوانه 159 والرواية فيه: خسيف.
(7) لم نهتد إلى الراجز.
(8) بعض الأعراب، كما في الكتاب 1/ 443.
(2/153)
________________________________________
والعمالة: أجر ما عمل لك. والمعاملة: مصدر عاملْته مُعامَلةً. والعَمَلَةُ: الذين يعملون بأيديهم ضروباً من العَمَل حَفْراً وطيناً ونحوه. وعاملُ الرُّمْحِ: دون الثّعلب قليلاً ممّا يلي السِّنان وهو صّدْرُه. قال «9» :
أطعَنُ النَّجلاء يَعْوي كَلْمُها ... عامل الثّعلب فيها مُرْجَحِنْ
وتقول: أعطِهِ أَجْرَ عملته وعمله. ويقال: كان كذا في عملة فلانٍ علينا، أي: في عمارته. ورجُلٌ عِمِّيلٌ: قويّ على العمل. والعَمولُ: القويُّ على العمل، الصابر عليه، وجمعه: عُمُلٌ. وأَعْمَلْتُ إليك المطيَّ: أَتْعبتُها. وفلان يُعْمِلُ رأيه ورُمْحَه وكلامه ونحوه [عَمِلَ به] «10» . والبنّاء يستعمل اللّبِنَ إذا بنَى. واليَعْمَلَةُ من الإبل: اسم مشتقّ من العمل، ويجمع: يَعْمَلات، ولا يقال إلاّ للأنثى، وقد يُجمع باليعامل، قال «11» :
واليَعْمَلاتُ على الوَنَى ... يَقْطَعْنَ بيداً بعدَ بيدِ
معل: مَعَلْت الخُصْيَةَ إذا استخرجتها من أرومتها وصَفَنِها.
__________
(9) لم نهتد إلى القائل.
(10) من المحكم لتوضيح المعنى. 2/ 127.
(11) لم نهتد إلى القائل فيما بين أيدينا من مصادر.
(2/154)
________________________________________
لمع: لَمَعَ بثوبه يلمع لمعا، للإنذار، أي: للتحذير. وأَلْمَعَتِ النّاقةُ بذَنَبِها فهي ملمعة، و [هي] «12» مُلْمِعٌ أيضاً: قد لَحِقَتْ. قال لبيد بن ربيعة «13» :
أو مُلْمِعٌ وَسَقَتْ لأحْقَبَ لاحَهُ ... طَرْدُ الفُحول وزَرُّها وكِدامُها
ويقال: أَلْمَعَتْ إذا حملتْ، ويقال: ألْمَعَتْ إذا تحرَّك ولدُها في بطنها. وتلمَّع ضرعُها إذا تلوّن ألواناً عند الإنزال. قال أبو ليلى: يقال: لَمَعَ ضَرْعُها إذا ظهر. واللُّمَعُ: التّلميع في الحجر، أو الثّوب ونحوه من ألوانٍ شتَّى، تقول: إنّه لحجرٌ مُلَمّعٌ، الواحدة: لُمْعة. قال لبيد «14» :
مَهْلاً أبيت اللّعنَ لا تأكُلْ معَهْ ... إنّ استَهُ من بَرَصٍ مُلَمَّعه
يقول: هو منقّط بسواد وبياض. ويقال: لَمْعَة سوادٍ أو بياضٍ أو حُمرة. يَلْمَع: اسم البَرْق الخُلَّب. واليلمَعُ: السّراب. واليلمعُ: الملاّذُ الكذّاب، ويقال: ألْمَعِيٌّ، لغة فيه، وهو مأخوذ من السّراب قال أبو ليلى: اليَلْمَعيّ من القوم: الدّاعي الذي يَتَظَنَّى الأمور ولا يكاد يخطىء ظنّه، قال أوس بن حجر «15» :
__________
(12) زيادة من التهذيب 2/ 423.
(13) ديوانه 304، والرواية فيه: (ضربها) مكان (زرها) .
(14) ديوانه 343.
(15) ديوانه ص 53. والرواية فيه: الألمعي.
(2/155)
________________________________________
اليَلْمَعيّ الذي يَظُنُّ بكَ الظّنَّ كأنْ قد رأى وقد سَمِعا واللِّماعُ جمعُ اللُّمْعَة من الكلأ. والْتمعْتُ الشيء ذهبتُ به، وأمّا قول الشاعر «16» :
أَبَرْنا منْ فَصيلتِهِمْ لِماعاً
أي: السّيّد اللاّمع، وإن شئت فمعناه. التمعناهم، أي: استأصلناهم.
__________
(16) (القطامي) ديوانه 36 والرواية فيه: فصيلته وصدر البيت:
زمان الجاهلية كل حي.
(2/156)
________________________________________
باب العين والنّون والفاء معهما ع ن ف، ع ف ن، ن ع ف، ن ف ع، ف ن ع مستعملات
عنف: العُنْف: ضدّ الرفق. عَنَفَ يَعْنُفُ عَنْفاً فهو عنيفٌ. وعنّفته تعنيفاً، ووجدت له عليك عُنْفاً ومشقّة. وعُنْفُوانُ الشّباب: أوّل بهجته، وكذلك النّبات. قال «1» :
تلومُ امْرأً في عُنْفُوانِ شبابهِ ... وتتركُ أشياعَ الضّلالةِ حُيَّرا
وقال «2» :
وقد دعاها العُنْفُوان المخلس
واعتَنَفْتُ الشيءَ كرهتُه.
عفن: عَفِنَ الشيءُ يَعْفَنُ عَفَناً فهو عَفِنٌ، وهو الشيء الذي فيه نُدُوَّةٌ يُحبس في موضع فيفسد فإذا مَسَسْتَه تفتّت. وعَفِنَ الخُبْزُ أيضاً إذا فسد وعشش.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2) لم نهتد إلى الراجز.
(2/157)
________________________________________
نعف: النَّعْفُ من الأرض: المكانُ المرتفع في اعتراض، ويقال: ناحية من الجبل، وناحية من رأسه. والرّجل ينتعِفُ إذا ارتقى نَعْفاً. قال العجّاج «3» :
والنَّعْفُ بين الأُسْحُمانِ الأطولِ
وقال رؤبة «4» :
بادرْنَ ريح مطر وبَرْقا ... وظلمة الليل نِعافاً بُلْقا
والنَّعْفُ: ذُؤابة النَعل. والنَّعَفَةُ: أَدَمَة تضطربُ خلْف مؤخّر الرّحْل.
نفع: النّفع: ضدّ الضَّرّ. نفعه نَفْعاً، وانتفعت بكذا. والنَّفْعة في جانبَي المزادة، يشقّ الأديمُ فيجعل في كلّ جانبٍ نَفْعة. نُفَيْعٌ: اسم رجل.
فنع: الفَنَعُ: نشرُ المسكِ ونَفْحَتُهُ، ونشرُ الثّناءِ الحسَن. يقال: له «5» فَنَعٌ في الجود، قال «6» :
وفروعٍ سابِغٍ أطرافُها ... عللتها ريح مسك ذي فَنَع
أي: ذي نَشْر. ومال ذو فَنَعٍ، وذو فَنَأٍ «7» ، أي: ذو كَثْرةٍ. والفنع أكثر وأعرف.
__________
(3) ديوانه 140، وفيه (عند) مكان (بين) .
(4) ليس في ديوانه.
(5) سقطت (له) من (ط) و (س) .
(6) (سويد بن أبي كاهل) . كما في التهذيب 3/ 4.
(7) في النسخ الثلاث: فناع، وهو تصحيف.
(2/158)
________________________________________
باب العين والنّون والباء معهما ع ن ب، ع ب ن، ن ع ب، ن ب ع، مستعملات
عنب: رجل عانب: ذو عِنَب كثير، كما يقال: لابن وتامر، أي كثير اللّبن والتّمر، الواحدة: عِنَبَةٌ ويجمع أَعْناباً. والعُنّاب: ثَمَرٌ، والعُنَابُ الجبلُ الصغير الأسودُ. وظبيٌ عَنَبانٌ: نشيط، ولم أسمع للعَنَبانِ فِعلاً. قال «1» :
يشتدّ شدّ العَنَبانِ البارحِ
والعِنَبَةُ: قُرْحة تُعْرفُ بهذا الاسم. والعُنابُ: المطر، ويجمع أَعْنِبة.
عبن: العَبَنُّ [والعَبَنَّى] «2» : الجملُ الشّديدُ الجسيمُ. وناقةٌ عَبَنَّة وعَبَنّاة، ويُجمع: عَبَنَّيات. ورَجُلٌ عَبَنُّ الخلق: أي ضَخْمُه وجَسيمُه. قال حميد بن ثور «3» :
وفيها عَبَنُّ الخَلْقِ مختلف الشَّبا ... يقول المُماري طالَ ما كان مقرما
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2) من التهذيب 3/ 7 من روايته عن الليث.
(3) ديوانه 32 والرواية فيه: (أمين) مكان (وفيها) .
(2/159)
________________________________________
نعب: نَعَبَ الغُرابُ يَنْعَبُ نعيباً ونعَباناً، وهو صوته. وفرسٌ مِنْعَبٌ: جوادٌ. وناقة نعّابة، أي: سريعة.
نبع: نَبَعَ الماءُ نَبْعاً ونُبُوعاً: خرج من العين، ولذلك سمّيت العين يَنْبوعاً. والنّبع: شجرٌ يُتَّخذُ منها القِسيّ. يُنابِعَى: اسم مكان ويجمع: يَنابِعات. قال «4» :
سقَى الرحمنُ حَزْنَ يَنابِعاتٍ ... من الجوزاء أنواء غزارا
__________
(4) لم نهتد إلى القائل.
(2/160)
________________________________________
باب العين والنون والميم معهما ع ن م، ن ع م، م ع ن، م ن ع مستعملات
عنم: العَنَمُ: شجر من شجر السّواك، ليّن الأغصان لطيفها، كأنها بنان جارية. الواحدة: عَنَمة. ويقال: العَنَمُ: شوك الطّلح. والعَنَمةُ: ضَرْبٌ من الوزغ مثل العَظاية إلاّ أنّها أحسن منها وأشدّ بياضاً. قال رؤبة «1» :
يبدين أطرافاً لطافاً عَنَمُهْ
نعم: نَعِمَ يَنْعَمُ نَعْمةً فهو نَعِمٌ ناعمٌ بيّنُ المَنْعَم. قال «2» :
هذا أوانِي وأوانِكنَّهْ ... ليس النّعيم دائماً لكنَّهْ
والنَّعماءُ اسم النَّعمةِ. والنَّعيمُ: الخفضُ والدَّعة. والنِّعْمةُ: اليد الصّالحة، وأنعم الله عليه.
__________
(1) ديوانه 150.
(2) لم نهتد إلى الراجز.
(2/161)
________________________________________
وجارية ناعمةٌ مُنَعَّمةٌ، وأَنْعَمَ الله بك عيناً، ونَعِمَ بك عيناً، أي: أقرّ بك عَيْنَ من تحبّ. وتقول: نُعْمَةُ عينٍ، ونعماء عين، ونُعام عَين. والنّعمة: المسرّة. ونعم الرّجلُ فلانٌ، وإنه لنعما وإنه لنعيم. نَعَمْ: كقولك: بَلَى، إلاّ أنّ نَعَمْ في جواب الواجب. والنُّعَامَى: اسم ريح الجنوب. قال «3» :
مَرَتْهُ الجَنُوبُ فلمْ يعترفْ ... خِلافَ النُّعامَى من الشَّام ريحا
والنَّعامُ الذَّكَرُ وهو الظّليم. والنّعامة: الخشبةُ المُعْتَرِضة على الرّجامين تتعلق عليها البكرة، وهما نعامتان. وزعموا أنّ ابن النَّعامة من الطُّرُقِ كأنّه مركبُ النَّعامة. قال «4» :
ويكون مركبُكِ القَعودُ ورَحْلَهُ ... وابنُ النَّعامَةِ عندَ ذلك مركبي
ويقال: ليس ابنُ النَّعامةِ هاهنا الطريق، ولكنّه صدرُ القَدَم. وهو الطّريقُ أيضاً. ويقال: قد خَفَّتْ نَعامَتُهم، أي: استمرّ بِهِمُ السّيرُ. والنَّعَمُ: الإِبلُ إذا كثرت. وزَعَم المفسّرون أنّ النَّعَمَ الشّاءُ والإبلُ، في قول الله عز وجلّ: وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً «5» . والنَّعائِمُ: من منازِل القَمَر.. والأَنْعَمانِ: واديانِ. وتقول: دَقَقْتُهً دقّاً نِعِمّاً، أي زدته على الدّقّ. وأحْسَنَ وأَنْعَمَ، أي زاد على الإحسان.
__________
(3) (أبو ذؤيب) ديوان الهذليين 132. وفيه (النعامى) مكان (الجنوب) .
(4) (عنترة) ديوانه 33.
(5) الأنعام 142.
(2/162)
________________________________________
يَنْعَمُ: حيّ من اليمن. نَعْمانُ: أرض بالحجاز أو بالعراق. وفلان من عَيْشِهِ في نُعْمٍ. نُعَيْمٌ ونُعمانُ: اسمان.
معن: أمْعَنَ الفرسُ ونحوه إمعاناً، إذا تباعد يعدو. ومَعَنَ يَمْعَنُ مَعْناً أيضا. والماعون يفسر بالزكاة والصّدقة. ويقال: هو أسقاط البيت، نحو الفَأْس، والقِدْر، والدلو.. مَعْنٌ: اسم رجل.
منع: مَنَعْتُه أَمْنَعُه مَنْعاً فامْتَنَعَ، أي: حُلتُ بينه وبين إرادته. ورجل منيع: لا يُخْلَصُ إليه، وهو في عزٍّ ومَنَعَةٍ، ومنعة- يخفّف ويثقّل، وامرأة منيعة: متمنّعة لا تُؤاتى على فاحشة، قد مَنُعَتْ مَناعةً، وكذلك الحصن ونحوه. ومَنُعَ مَناعةً «6» إذا لم يُرَمْ. [ومَناعِ بمعنى امنَعْ] «7» قال «8» :
مَناعِها من إبلٍ مَناعِها
__________
(6) من التهذيب 3/ 19 عن العين.
(7) من المحكم 2/ 146 لتقويم العبارة.
(8) لم يقع لنا الراجز، وهو من شواهد الكتاب 1/ 123.
(2/163)
________________________________________
باب العين والفاء والميم معهما ف ع م يستعمل فقط
فعم: يقال: فَعُمَ فَعامَةً وفُعُومةً، فهو فَعْمٌ، أي: ملآن. قال كعب بن زهير «1» :
فَعْمٌ مُقَلَّدُها عَبْلٌ مُقَيَّدُها ... في خَلْقِها عن بناتِ الفَحْلِ تفضيل
وامرأة فعمة السّاق، فَعُمَتْ فَعَامَةً وفُعُومةً، أي: مستوية الكعب، غليظة السّاق. قال «2» :
فعم [مخلخلها] «3» وعث مؤزرها ... عذب مقبلها طعم السَّدا فوها
وأَفْعَمْتُ البيتَ بريحِ العُود. وافْعَوْعَمَ النّهر والبحر، أي: امتلأ. قال «4» :
مُفْعَوعِمٌ صَخِبُ الآذيّ مُنبعِقُ ... كأن فيه أكف القوم تَصطّفِقُ
يعني النّهر. وأفعمته فهو مُفْعَمٌ. وأفعمَ المِسْكُ البيتَ. وقوله في البيت الأول: طعم السَّدا: السَّدا: البلح.
__________
(1) ديوانه ص 10 والرواية فيه:
ضخم مقلدها نعم مقيدها
(2) المحكم 2/ 147 واللسان (فعم) .
(3) من المحكم 2/ 147 واللسان (فعم) . في النسخ الثلاث: (مقلدها) ولعله سهو.
(4) نسب في اللسان إلى (كعب) وليس في ديوان كعب بن زهير.
(2/164)
________________________________________
باب العين والباء والميم معهما ع ب م يستعمل فقط
عبم: العبام: الرّجل الغليظ الخَلْقُ. في حمق عَبُمَ يَعْبُمُ عَبامَةً [فهو عَبامٌ] «1» . قال «2» :
فأنكرتُ إنكار الكريم ولم أكن ... كفَدْمٍ عَبامٍ سيل نسيا فجمجما
__________
(1) من التهذيب 2/ 21 عن العين.
(2) لم نهتد إلى القائل، ولم نقف على القول في غير الأصول.
(2/165)
________________________________________
باب الثلاثي المعتل
(2/167)
________________________________________
باب العين والهاء و (واي) معهما ع وهـ، هـ وع، هـ ي ع مستعملات
عوه: التّعويه والتّعريس: نومة خفيفة عند وجه الصّبح. عوّهت تَعْويهاً. قال رؤبة «1» :
شأزٍ بمن عَوَّهَ جَدْبِ المنطق ... تبدو لنا أعلامُهُ بعدَ الغَرَقْ
وتقولُ: عَوَّهْتُ بالجَحْشِ تعويهاً إذا دَعَوتَه لِيَلْحَقَ بك. تقول: عَوْهِ عَوْهِ. وعاهِ عاهِ: زجرٌ للإبل [لتحتبس] «2» وربّما قالوا: عَيْهِ عَيْهِ، وقد يقولون: عَهْ عَهْ، وعَهْعَهْتُ بها. وأَعاهَ الزَّرْعُ، وأعاهَ القومُ إذا أصابَ زرْعَهُم خاصّةً عاهةٌ وآفةٌ من اليَرَقان ونحوه فأفْسَدَهُ. قال: «3»
قذف المجنّبِ بالعاهاتِ والسَّقَمِ
وقال بعضُهم: عِيةَ الزَّرْعُ فهو مَعُوهٌ.
__________
(1) ديوانه 104.
(2) من التهذيب 3/ 22 في نقله عن العين.
(3) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى تمام القول.
(2/169)
________________________________________
هوع: هاعَ يَهُوعُ هَوْعاً وهُواعاً إذا جاءه القيء ومن غير تكلّف. قال «4» :
ما هاعَ عمرٌو حين أدْخَلَ حَلْقَهُ ... يا صاحِ ريش حمامة بل قاء
وإذا تكلّف ذلك قيل: تهوَّع، فما خرجَ من حلقِهِ فهو هُواعة. تقول: لأَهوِعَنَّهُ أَكْلَهُ، أي: لأَستخرجنّ من حَلْقِهِ ما أَكَلَ.
هيع: الهاعُ: سوء الحرص. هاعَ يَهاعُ هيعة وهاعاً. وقال بعضهم: هاع يَهِيعُ هُيُوعاً وهَيْعَةً وهَيَعاناً. وقال أبو قيس بن الأسْلَتِ «5» :
الكَيْسُ والقُوّةُ خيرٌ من الإشفاق ... والفَهّةِ والهاع
ورجلٌ هاعٌ، وامرأة هاعة إذا كان جباناً ضعيفاً. والهَيْعَةُ: الحَيْرَة. رجل مُتَهيّعٌ هائع، أي: حائر. وطريق مَهْيَعٌ، مَفْعَلٌ من التّهيُّعِ، وهو الانْبساطُ، ومن قال: فَعْيَل فقد أخْطأ، لأنه ليس في كلام العرب فعيل إلا وصدرُه مكسورٌ نحو: حِذْيَم وعِثْيَر. وبلَدٌ مَهْيَعٌ أيضاً، أي، واسع، قال أبو ذُؤَيب:
فاحْتَثَّهُنَّ من السَّواءِ وماؤه ... بَثْرٌ وعانَدَهُ طريقٌ مهْيَعُ
ويُجْمَعُ مهايع بلا همز.
__________
(4) لم نهتد إلى القائل.
(5) المحكم 2/ 151، واللسان (هيع) .
(2/170)
________________________________________
والسّراب يَتَهَيَّعُ على وجهِ الأرضِ، أي: ينبسِطُ. تهيّع السّرابُ وانْهاع انهياعاً. والهَيْعَةُ: أرضٌ واسعةٌ مبسوطة. والهَيعةُ سَيَلانُ الشيءِ والمصبوبِ على وجهِ الأرضِ، هاعَ يَهِيعُ هيعاً. وماءً هائع. والرّصاص يَهيعُ في المِذْوَبِ.
وفي الحديث: كلّما سمع هيعةً طار إليها «6»
، أي: صوتاً يُفْزَع منه ويُخافُ، وأصله من الجزع.
__________
(6) اللسان (هيع) وتمام الحديث:
خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلّما سمع هيعةً طار إليها.
في (ط) : طاب وهو تصحيف.
(2/171)
________________________________________
باب العين والخاء و (واي) معهما خ وع يستعمل فقط
خوع: الخَوْعُ: جبلٌ أبيض بين الجبال، قال رؤبة «7» :
كما يَلُوحُ الخوع بين الأجبال
__________
(7) نسب البيت في الصحاح واللسان (خدع) إلى (رؤبة) أيضا، وحكى اللسان عن ابن بري أنه (للعجاج) .
(2/172)
________________________________________
باب العين والقاف و (واي) معهما ع وق، وع ق، ع ق و، ق ع و، وق ع، ع ق ي، ع ي ق مستعملات
عوق: عاقه فاعتاقَهُ وعوَّقَهُ في الكثرة والمبالغة يَعوقُهُ عَوْقاً. قال أبو ذؤيب «8» :
ألا هلْ إلى أُمِّ الخويلدِ مُرْسَلٌ ... بلى خالدٌ إن لم تَعُقْهُ العَوائِقُ
والواحدة: عائقة. وقال أميّة بن أبي الصلت:
تَعرِفُ ذاك النّفوس حتّى إذا هَمَّتْ بخيرٍ عاقت عوائقها
ورجل عُوقَةٌ: ذو تعويق وتربيث للنّاس عن الخير، ويجوز عَقاني في معنى عاقني على القلب قال «9» :
لَعاقَك عن دُعاءِ الذّئبِ عاقي
والعوق الذي لا خير فيه وعنده. قال رؤبة «10» :
__________
(8) ديوان الهذليين 151، والرواية فيه:
ألا هل أتى أم الحويرث ...
(9) اللسان (عوق) غير منسوب أيضا، وصدره:
فلو أني رميتك من قريب
(10) ديوانه 173.
(2/173)
________________________________________
فَداكَ منهم كلُّ عَوْقٍ أصلدِ
والعَوَقَةُ: حيّ من اليمن. قال «11» :
إنّي امرؤ حنظليّ في أرومتها ... لا من عَتِيك ولا أخواليَ العَوَقَه
ويعوق: اسم صنم كان يعبد زمن نوح عليه السلام. وعُوقٌ والدُعُوجٍ. وعوق: موضع بالحجاز. قال «12» :
فعوق فرماح فاللوى ... من أهلِهِ قَفْرُ
ويقال: كان يعوق رجلاً من صالحي أهلِ زمانِهِ قبلَ نوحٍ. فلما مات جزع عليه قومُه فأتاهم الشيطان في صورة إنسان فقال: أمثله لكم في مِحْرابِكم حتى تروه كلّما صلّيتم. ففعلوا ذلك. وشيّعه من بعده من صالحيهم، ثم تمادى بهم الأمْرُ إلى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناماً يعبدونها من دون الله. وأمّا عيّق فمن أصواتِ الزّجر. عيّق يُعَيّق في صوته.
وعق: رجلٌ وعقة لعقة، أي: سيىء الخُلُق. ورجلٌ وَعِقٌ: فيه حِرْصٌ، ووُقوعٌ في الأمر بجهلٍ. تقول: إنه لَوَعِقٌ لَعِقٌ. قال رؤبة «13» :
مخافة الله وأَنْ يُوَعَّقا
أي: أن يقال: إنّك لَوَعِقٌ، وبه وعقة شديدة.
__________
(11) اللسان (عوق) وغير منسوب، ونسبه (التاج- عرق) إلى (المغيرة بن حيفاء) . ولعله (ابن حبناء) .
(12) اللسان (عوق) غير منسوب أيضا.
(13) ليس في ديوانه.
(2/174)
________________________________________
والوَعيقُ: صوت يخرُجُ من حياء الدّابّة إذا مَشَتْ. وَعَقَتْ تَعِقُ، وهو بمنزلة الخَقِيقِ من قُنْب الذّكر. يقال: عُواق ووُعاق، وهو العَويقُ والوَعيقُ. قال «14» :
إذا ما الرّكبُ حلَّ بدارِ قومٍ ... سمعتَ لها إذا هَدَرَتْ عواقا
عقو: العَقْوَةُ: ما حولُ الدّارِ والمَحَلَّة. تقول: ما بعَقْوَةِ هذه الدّار أحدٌ مثل فلان، وتقولُ للأسَد ما يطور بعقوته أحد. والرّجلُ يحفر البئر فإذا لم ينبط من قعرها اعتقى يَمْنَةً ويَسْرةً، وكذلك إذا اشتقّ الإنسان في الكلام فيعتقي منه. والعاقي كذلك، وقلّما يقولون: عقا يعقو. قال «15» :
ولقد دربت بالاعتقاء ... والاعتقام فنلت نجحا
يقول: إذا لم يأته الأمر سهلاً عقم فيه وعقا حتّى ينجح.
قعو: القَعْو: شبه البَكْرة، وهو الدّموك يستقي عليها الطيّانون. قال «16» :
له صريفٌ صريفَ القَعْوِ بالمَسَدِ
ويقال: القَعْو: خشبتان تكونان كنّا في البكرة تضمّانه يكون فيهما المِحْوَر.
__________
(14) اللسان والتاج (عوق) غير منسوب فيهما أيضا.
(15) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(16) (النابغة الذبياني) ديوانه ص 6، وصدر البيت:
مقذومة بدخيس النحض بازلها
(2/175)
________________________________________
والقَعا: رَدَّةٌ في رأسِ أَنْفِ البَعير، وهو أن تُشْرِفَ الأَرْنَبَة، ثم تقعي نحو القصبة. قِعيَ الرّجل قَعاً، وأَقْعَتْ أرنبتُه، وأَقْعَى أنفُه. ورجل أَقْعى وامرأةٌ قَعْواء وقد يقعي الرّجل في جلوسه كأنّه مُتَساندٌ إلى ظهْرِه. والذّئب يُقعي، والكلب يقعي. إقعاء مثله سواء، لأنّ الكلبَ يُقْعي على اسْتِه. والقَعْو: إرسالُ الفحل نفسَهُ على النّاقةِ في ضِرابِها. قَعا عليها يَقْعُو قُعُوّاً إذا أناخها ثم علاها.
وقع: الوَقْعُ: وَقْعَةُ الضَّرب بالشّيء. ووَقْعُ المطرِ، ووَقْعُ حوافِرِ الدّابَّةِ، يعني: ما يُسْمَعُ من وَقعِه. ويقال للطّير إذا كان على أرضٍ أو شجرٍ: هنّ وقوعٌ ووُقَّعٌ. قال الرّاعي:
كأنّ على أثباجها حين شوّلَتْ ... بأَذْنابِها قبّا من الطّيْر وُقَّعا
والواحد: واقعٌ. والنَّسْرُ الواقع سُمّي به كأنه كاسرٌ جناحيه من خلفه، وهو من نجوم العلامات التي يُهْتَدَى بها، قريب من بنات نَعش، بحيالِ النَّسْرِ الطّائر. والمِيقعةُ: المكانُ الذي يقَعُ عليه الطّائر. ويقال: وقعت الدّوابُّ والإبل، أي: ربضَتْ تشبيهاً بوقوع الطّير. قال «17» :
وَقَعْنَ وقوعَ الطّير فيها وما بها ... سوى جرّة يرجعنها متعلل
وقد وقَّعَ الدّهرُ بالنّاس، والواقِعةُ: النازلةُ الشَّديدةُ من صُروفِ الدّهْر، وفلانٌ وُقَعَةٌ في الناس، ووقّاعٌ فيهم [أي يغتابهم] «18» . ووَقَعَ الشيءُ يَقَعُ وقوعا، أي: هويا.
__________
(17) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(18) زيادة لتوضيح المراد.
(2/176)
________________________________________
وواقعنا العدوّ، والاسم: الوقيعة. والوِقاعُ: المواقعة في الحرب. ووَقَعَ فلان في فلان، وقد أظهر الوقيعة فيه [إذا عابه] «19» . والوَقيعُ من مناقع الماء في متون الصخور. ووقائع العرب: أيّامُها التي كانت فيها حروبُهُمْ. والتَّوقيعُ في الكتاب: إلحاقُ شيءٍ فيه. وتوقّعتُ الأمرَ، أي: انتظرتُه. والتوقيع: رَمْيٌ قريبٌ لا تُباعِدُهُ كأنّك تُريدُ أن تُوقِعَهُ على شيء، وكذلك توقيع الإزكان، تقول: وَقِّعْ أي: ألقِ ظنّك على كذا. والتّوقيعُ: سَحْجٌ بأطرافِ عِظام الدّابّة من الرّكوب وربّما تحاصّ عنه الشَّعَرُ. قال الكميت «20» :
إذا هما ارتدفا نَصّا قعودهما ... إلى التي غبها التَّوْقيعُ والخَزَلُ
يقالُ: دابّة مُوَقَّعة. والتّوقيع: أثَرُ الرّحل على ظهر البعير. يقال: بعيرٌ موقّع، قال «21» :
ولم يُوَقَّعْ برُكوبٍ حَجَبُهْ
وإذا أصابَ الأرضَ مطرٌ مُتَفَرِّقٌ فذلك توقيع في نباتها. والتّوقيعُ: إقبال الصَّيْقَل على السيف يحدّده بميقعته، وربما وُقِّعَ بحَجَرٍ. وحافِرٌ وَقيعٌ: مقطّط السّنابك. والوقيعُ من السُّيوف وغيرها: ما شُحِذ بالجحر، قال يصف حافر الحمار «22» :
يركب قيناه وقيعا ناعلا
__________
(19) زيادة من نقول الأزهري عن العين 3/ 35 من التهذيب.
(20) ليس في مجموع شعر الكميت.
(21) التهذيب 3/ 35، اللسان (وقع) .
(22) (رؤبة) ديوانه 135.
(2/177)
________________________________________
وقال الشّماخ يصف إبلاً حدادَ الأسْنانِ «23» :
يغادين العِضاه بمقنعات ... نواجذهن كالحدأ الوقيع
وقد وَقِعَ الرّجل يَوْقَعُ وَقعاً. إذا اشتكى قدميه من المشي على الحجارة. قال «24» :
كلَّ الحِذاءِ يَحْتَذي الحافي الوَقِعْ
ووقَّعَتْهُ الحجارةُ توقيعاً، كما توقّع الحديدةُ تُشْحَذُ وتُسَنُّ. واستوقَع السَّيفُ: إذا أنَى له الشَّحْذُ. والميقَعَةُ: خَشَبَةُ القصّارين يُدَقُّ عليها الثياب بعد غسلها «25» . والتوقيع: أثر الدم والسحج. والتّوقيعُ بالظن شبه الحزر والتّوهُّم. والمَوْقِعُ: موضِعٌ لكلّ واقع، وجمعُه: مَواقِعُ. قال «26» :
أنا شُرَيْقٌ وأبو البلادِ ... في أبلٍ مصنوعة تلادِ
تربّعتْ مَواقِعَ العِهادِ
عقي: عقّيتم صبيّكم، أي: سقيتموه عَسَلاً، أو دواءً ليَسْقُطَ عنه عِقْيُهُ، وهو ما يخرج من بطن الصبيّ حين يولد، أسودُ لزجٌ كالغِراء. يقال: عقَى يَعْقي عَقْياً. والعِقْيانُ ذَهَبٌ ينبُتُ نَباتاً وليس مما يُذابُ من الحجارة. قال «27» :
كلّ قوم صيغه من آنك ... وبنو العبّاسِ عقيان الذّهب
__________
(23) اللسان (وقع) والرواية فيه: يباكرن.
(24) (جساس بن قطيب) ، اللسان (وقع) .
(25) في النسخ الثلاث: غسله.
(26) لم نقف على الرجز في غير الأصول.
(27) لم نقف عليه في غير الأصول.
(2/178)
________________________________________
ويقال: عَقَّى بسهمه تعقيةً إذا رمى به بعد ما يستبعد العدوّ
. عيق: العيّوق: كوكبٌ بحيال الثّريّا إذا طلع عُلِمَ أنّ الثّريّا قد طلعت. قال «28» :
تراعى الثّريّا وعيّوقها ... ونجم الذّراعين والمرزم
وعَيُّوقٌ: فَيْعول، يحتمل أن يكون من (عيق) ومن (عوق) ، لأنّ الواو والياء فيه سواء.
__________
(28) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(2/179)
________________________________________
باب العين والكاف و (واي) معهما ع ك و، وع ك، ك وع، وك ع مستعملات
عكو: عَكَوْتُ ذَنَب الدّابّةِ عَكْواً إذا عطفت الذَّنَب عند العُكوة، وعَقَدْتُهُ. والعُكْوَة: أصْلُ الذَّنَبِ، حيث عَرِيَ من الشَّعَر، ويقال: هو ما فضل عن الوَرِكَيْنْ من أصلِ الذَّنَبِ قدر قبضة. بِرْذَوْنٌ مَعْكُوٌّ، أي: معقودُ الذَّنَب. وجمعُ العُكْوَةِ: عُكىً. قال «1» :
هَلَكْتَ إن شَرِبْتَ في إكْبابِها ... حتّى تُوَلّيكَ عُكَى أذنابِها
وشاة عكواء إذا ابيضّ ذَنَبُها وسائِرُها أسود، ولو استعمل فعل [لهذا] «2» لقيل: عَكِيَ يَعكَى «3» فهو أَعْكَى، ولم أسمعْ له ذلك.
وعك «4» : الوَعْكُ: مَغْثُ المَرْض. وعكته الحُمّى، أي دكّته «5» وهي تَعِكُهُ. قال «6» :
__________
(1) اللسان (عكا) .
(2) زيادة اقتضاها السياق.
(3) من التهذيب في روايته عن الليث 3/ 39. في (ص) عكي عكى. وفي (ط) و (س) : عكا عكا.
(4) هذا من (س) فقد سقط كله من (ص) و (ط) .
(5) من التهذيب في حكايته عن الليث 3/ 43 في (س) دلكته. وهي محرفة عن دكته.
(6) لم نهتد إلى القائل.
(2/180)
________________________________________
كأنّ به تَوْسيمَ حُمّى تصيبه ... طروقاً وأعباط من الورد واعك
ورجلٌ موعوك: محموم. وأوعكَتِ الكلابُ الصَّيدَ، أي: مرّغته. قال رؤبة في الكلاب والثّور «7» :
عوابس في وَعْكَةٍ تحت الوَعِكْ
أي: تحت واعكتها، أي: صوتها. والوَعْكَةُ: معركة الأبطال إذا أخذ بعضُهم بعضاً، وأَوْعَكَتِ الإبل إذا ازدحمت فركب بعضُها بعضاً عند الحوض، وهي الوَعْكَةُ. قال «8» :
نحن جلبنا الخيل من مرادها ... من جانب السّقيا إلى نضادها
فصبّحت كلباً على أحدادها ... وَعْكَة وردٍ ليس من أورادها
أي: لم يكن لها بورد، وكان وردها غير ذلك.
كوع: «9» : الكوع والكاع، زعم أبو الدّقَيْش أنهما طرفا الزندين في الذّراع ممّا يلي الرُّسغ. والكوع منهما طرف الزند الذي يلي الإبهام وهو أخفاهما، والكاعُ طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الكرسوع.
__________
(7) ما في ديوان رؤبة هو قوله: ولم تزل في وعكة اليوم الوعك.
(8) لم نقع على الراجز. ولا على الرجز. وأثبتناه كما جاء في (س) .
(9) وهذا أيضا سقط من (ص) و (ط) وما أثبتناه فمن (س) .
(2/181)
________________________________________
ورجلٌ أكوعُ وامرأة كوْعاء، أي: عظيم الكاع. قال «10» : دواحسٌ في رُسْغِ عَيْرٍ أكوعا ويقال: الكوعُ يَبسٌ في الرُّسغَيْن، وإقبال إحدى اليدين على الأخرى. بعيرٌ أكوع، وناقة كَوْعاء. كاعَ يكُوعُ كَوْعاً، وتصغير الكاع: كُوَيْع، وأكْوَعُ اسم رجل.
وكع: الوَكْع: ضربة العقرب بإِبرتها. قال «11» :
كأنّما يرى بصريح النصح وكع العقارب
والأوكع: المائل. والوَكَعُ: ميلانُ صدرِ القدم نحو الخِنْصِر، ورُبّما كان في إبهام اليد والرّجل، والنّعت: أوكع، ووَكْعاء، وأكثره في الإماء اللّواتي يكددْنَ بالعمل. ويقال: الأوكع والوكعاء: للأحمق [والحمقاء] «12» . وفرسٌ وَكِيعٌ. وَكُعَ يَوْكُعُ وَكَاعَةً، أي: صَلُبَ واشتدّ إهابُه. قال سليمان بن يزيد «13» :
عَبْلٌ وكيع ضليع مقرب أرن ... للمقربات أمام الخيل مفترق
وسقاء وَكِيعٌ: صُلْبٌ غليظٌ، وفَرْوٌ وكيعٌ: متينٌ. ومَزادةٌ وَكِيعةٌ: قُوِّرَتْ فأُلْقي ما ضَعُفَ من الأديم وبقي الجيّد فَخَرِزَ، والجميع: وكائع. واستوكع السّقاءُ متن واشتدت مخارزه بعد ما جعل فيه الماء «14» .
__________
(10) التهذيب 3/ 42 واللسان (كوع) غير منسوب أيضا.
(11) (القطامي) ديوانه ص 47 إلا أن الرواية فيه:
سرى في جليد الليل حتى كأنما ... تخزم بالأطراف شوك العقارب
(12) من التهذيب 3/ 42 فقد سقطت من النسخ الثلاث.
(13) التاج (وكع) - (سليمان بن يزيد العَدَويّ) .
(14) ما بين القوسين من (س) وقد سقط كله من (ص) و (ط) .
(2/182)
________________________________________
باب العين والجيم و (واي) معهما ع ج و، ع وج، ج وع، وج ع، ع ي ج مستعملات
عجو: العجوة: تمرٌ بالمدينة، يقال: [إنّه] غرسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمّ تعجو وَلَدَها، أي: تؤخّر رضاعه عن مَواقيته، ويُورِثُ ذلك وَهَناً في جسمِه.. ومنه: المعاجاة، وهو ألا يكون للأمّ لبنٌ يُرْوِي صبيّها فتعاجيه بشيء تعلّله به ساعة. قال الأعشى «1» :
مشغقا قلبها عليه فما تعجوه ... إلاّ عُفافةٌ وفُواقُ
وكذلك إن ربّى الولدَ غيرُ أمّه. والاسم: العُجْوةُ، والفِعل: العَجْو، واسم الولد: عَجيٌّ، والأنثى عَجيّة والجميع: العُجايا. قال يصف أولاد الجراد «2» :
إذا ارتحلت عن منزلٍ خلّفتْ به ... عُجايا يحاثى بالتراب دفينها
__________
(1) ديوانه 221، وصدر البيت فيه:
ما تعادى عنه النهار ولا تعجوه............... .......
(2) التهذيب 3/ 45.
(2/183)
________________________________________
ويروى: صغيرها. وإذا منع اللبن عن الرضيع، واغتذى بالطعام قيل: قد عُوجيَ. قال الإصبع «3» :
إذا شئتَ أبصرتَ من عَقْبِهِمْ ... يتامَى يُعاجَوْنَ كالأَذْؤُبِ
والعُجاية: عَصَبٌ مركّبٌ فيه فُصوص من عظام كأمثال فُصوص الخاتم عند رُسْغ الدّابّة، إذا جاع أحدهم دقّه بين فهرَيْن فأكله، ويُجمع: عُجايات وعُجىً. قال «4» :
شمّ العُجاياتِ يَتركْنَ الحصى زِيَماً
يصف أخفافها بالصّلابة، وعُجاياتها بالشّمم، وأشدّ ما يكون للدّابّة إذا كان أشمّ العُجاية.
عوج: عَوْجُ كلّ شيء: تعطّفه، من قضيب وغير ذلك. وتقول: عُجْتُه أَعُوجُهُ عَوْجاً فانعاج، قال «5» :
وانعاجَ عُودي كالشَّظيفِ الأَخْشنِ
والعِوَجُ الاسم اللازم منه الذي تراه العيون من خشب ونحوه، والمصدر من عَوِجَ يَعْوَجُ: العَوَجُ فهو أَعْوَجُ، والأنثى: عَوْجاء، وجمعه: عُوجٌ. قال أبو عبد الله: يقال من العِوَج: عَوِج يَعْوَجُ عَوَجاً، ومن العَوْج: اعوجّ اعوجاجاً [فهو مُعْوَجٌّ] وعوّجَ الشيءَ فهو مُعَوَّجٌ.
__________
(3) التهذيب 3/ 45 غير منسوب، ونسبه اللسان إلى (النابغة الجعدي) وقال: وأنشد الليث (للنابغة الجعدي) وذكر البيت.
(4) (كعب بن زهير) ديوانه 14 وعجز البيت:
لم يقهن رءوس الأكم تنعيل
(5) (رؤبة) ديوانه 161.
(2/184)
________________________________________
والخيولُ الأعوجيّةُ منسوبة إلى فرس كان في الجاهلية سابقاً، ويقال: كان لغنيّ. قال طفيل «6» :
بناتُ الوَجيهِ والغُرابِ ولاحقٍ ... وأَعْوجَ تَنْمي نِسْبةَ المتنسِّبِ
ويقال: أعوجيّ من بنات أعوج. والعوج: القوائم من الخيل التي في أرجلها تحنيب. والعائج الواقف. والعاج: أنياب الفِيَلَة، لا يُسمّى غير النّاب عاجاً. وناقة عاج إذا كانت مذعان السّير، ليّنة الانعطاف. قال ذو الرّمة:
تقدُّ بيَ المَوْماةَ عاجٌ كأنّها
وإذا عجعجت بالناقةِ قلت: عاجِ عاجِ خفض بغير تنوين. وإن شئت جزمت على توهُّم الوقْف. وعجعجتُها: أنختها. وعُوج بنُ عُوقٍ، يقال: إنّه صاحبُ الصَّخرةِ، الذي قتله موسى عليه السّلام، ويقال: إنّه إذا قام كان السّحابُ له مئزراً، وكان من فراعنةِ مِصْر.
جوع: «7» الجوع: اسم جامعٌ للمخمصة. والفعل: جاع يجوع جوعاً. والنعت: جائع، وجَوْعان، والمجاعة: عامٌ فيه جوعٌ [ويقال: أجعته وجوّعته فجاع يجوع جوعاً] «8» فالمتعدي: الإجاعة والتجويع. قال «9» :
يُدْعَى الجُنَيْدَ وهو فينا الزُّمَّلِقْ ... مُجَوَّعُ البطنِ كلابيُّ الخلق
__________
(6) اللسان (وجه) .
(7) سقطت هذه المادة وترجمتها من (ص) و (ط) .
(8) زيادة مكملة من التهذيب في روايته عن العين.
(9) التهذيب 3/ 50. وفيه: كان الجنيد..
(2/185)
________________________________________
وجع: [الوَجَعُ: اسم جامع لكل مرض مؤلم. يقال:] «10» رجل وجِعٌ وقومٌ وجاعَى، ونسوة وَجَاعَى، وقوم وَجِعَونَ. وقد وَجِعَ فلانٌ رأسه أو بطنه، وفلانٌ يَوْجَعُ رأسه. وفيه ثلاث لغات: يَوْجَعُ، ويَيْجَعُ، وياجَعُ، ومنهم من يكسر الياء فيقول: يِيجَعُ وكذلك تقول: أنا إيجَعُ، وأنت تِيجَعُ «11» . والوجعاء: اسم الدّبر. ولغة قبيحة، منهم من يقول: وجع يجع. وتوجّعت لفلان إذا رثيتَ له من مكروه نزل به. ويقال: أوجعت فلاناً ضرباً، وضربته ضرباً وجيعاً، ويُوجِعُني رأسي.
عيج: العَيْجُ: شبهُ الاكتراث للشيء والإقبال عليه. تقول: عِجْتُ به يعيج عَيْجاً، ولو قيل: عيجوجة لكان صواباً، وما عِجْتُ بقوله: لم أَكْتَرِثْ. قال «12» :
فما رأيت لها شيئا أعيج به
__________
(10) ما بين المعقوفتين من التهذيب في روايته عن الليث.
(11) ما بين القوسين من (س) فقد سقط من (ص) و (ط) أيضا.
(12) التهذيب 3/ 52، واللسان (عيج) ، غير منسوب فيهما أيضا. وعجز البيت فيهما:
إلا الثمام وإلا موقد النار
(2/186)
________________________________________
باب العين والشين و (واي) معهما ع ش و، ع ش ي، ع ي ش، ش ع و، ش وع، ش ي ع، وش ع مستعملات
عشو، عشي: العشو: إتيانك ناراً ترجو عندها خيراً وهدىً. عَشَوْتُها أَعْشُوها عَشْواً وعُشُوّا. قال الحطيئة «1» :
متى تأتِهِ تعشو إلى ضَوْءِ نارِه ... تَجِدْ خَيْرَ نارٍ عندها خيرُ مُوقِدِ
والعاشيةُ: كلُّ شيءٍ يعشو إلى ضوء نارٍ بالليل كالفَراشِ وغيره، وكذلك الإبل العواشي، قال «2» :
وعاشيةٍ حوشٍ بطانٍ ذَعَرْتُها ... بضربِ قتيلٍ وَسْطَها يَتَسَيَّفُ
وأوطأته عَشْوَة وعِشْوَةُ وعُشْوَةً- ثلاث لغات، وذلك في معنى أن تحملَه على أن يركب أمراً على غير بيانٍ. تقول: ركب فلانٌ عشوة من الأمر، وأوطأني فلان عَشْوةً، أي: حملني على أمرٍ غير رشيدٍ، ولقيته في عَشْوةِ العَتَمَة وعَشْوةِ السَّحَر. وأصله من عشواء اللّيل، والعشواء بمنزلة الظّلماء، وعَشْواء الليل ظلمته «3» .
__________
(1) ديوانه ص 249.
(2) البيت في اللسان (عشو) غير منسوب أيضا.
(3) هذه الفقرة مضطربة في النسخ الثلاث، فقومناها من نقول الأزهري عن العين.
(2/187)
________________________________________
والعِشاءُ: أوّلُ ظلام اللّيلِ، وعشّيتُ الإبل فتعشّت إذا رعيتُها اللّيلِ كلَّه. وقولهم: عش ولا تغتر، أي: عش إبلك هاهنا، ولا تطلب أفضل منه فلعلّك تغترّ. ويقال: العواشي: الإبل والغنم تُرعَى باللّيل. العشيّ، آخر النّهار، فإذا قلت: عَشِيّة فهي ليومٍ واحد، تقول: لقيتُه عشيّةَ يوم كذا، وعشيّةً من العَشِيّاتِ، وإذا صغّروا العشيّ قالوا: عُشَيشِيان، وذلك عند الشَّفَى وهو آخر ساعة من النّهار عند مُغَيْرِبان الشّمس. ويجوز في تصغير عَشيّة: عُشَيَّة، وعُشَيشِيَة. والعَشاءُ ممدود مهموز: الأكلُ في وقت العشيّ. والعِشاءُ عند العامّة بعد غروب الشّمس من لدُنْ ذلك إلى أن يولّي صدر اللّيل، وبعض يقول: إلى طلوع الفجر، ويحتجّ بما ألغز الشّاعرُ فيه:
غدونا غدوة سحرا بليل ... عشاء بعد ما انتصف النهار.
والعَشَى- مقصوراً- مصدر الأعشَى، والمرأة عَشْواءُ، ورجال عُشْوٌ، [والأعشى] هو الذي لا يبصر باللّيل وهو بالنّهار بصير، وقد يكون الذي ساء بَصَرُه من غير عمىً، وهو عَرَض حادثٌ ربّما ذهب. وتقول: هما يَعْشَيانِ، وهم يَعْشَوْن، والنّساء يَعْشَيْنَ، والقياس الواو، وتعاشَى تعاشياً مثله، لأنّ كلّ واوٍ من الفعل إذا طالت الكلمة فإنّها تقلب ياءً. وناقةٌ عَشْواءُ لا تُبصِرُ ما أمامَها فَتَخْبِطُ كلَّ شيءٍ بيدها، أو تقعُ في بئرٍ أو وهْدةٍ، لأنّها لا تَتَعاهدُ موضعَ أخْفافِها. قال زهير:
رأيتُ المنايا خبطَ عشواءَ من تُصِبْ ... تمته ومن تخطىء يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ
وتقول: إنّهم لفي عَشْواء من أمرهم، أو في عمياء.
(2/188)
________________________________________
وتعاشَى الرّجلُ في الأمر، أي: تجاهل. قال «4» :
تَعُدُ التّعاشِيَ في دينها ... هدىً لا تقبّل قُربانها
عيش: العيشُ: الحياةُ. والمعيشة: الّتي يعيش بها الإنسان من المطعم والمشرب، والعِيشة: ضربٌ من العيش، مثل: الجِلْسة، والمِشْية، وكلّ شيء يعاشُ به أو فيه فهو معاش، النّهار معاش، والأرض معاش للخلق يلتمسون فيها معايشهم. والعِيش في الشعر بطرح الهاء: العيشة. قال «5» :
إذا أمّ عِيشٍ ما تَحُلُّ إزارَها ... من الكَيْس فيها سورة وهي قاعد
بنو عيش: قبيلة، وإنّهم بنو عائشة، كما قال «6» :
عبد بني عائشة الهلابعا
وقال آخر «7» :
يا أمّنا عائش لا تراعي ... كلّ بنيك بطل شجاعِ
خَفَضَ العَيْنَ بشُفعةِ الكافِ المكسورة.
__________
(4) لم نهتد إليه.
(5) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(6) التهذيب 3/ 60 واللسان (عيش) .
(7) لم يستشهد به فيما بين أيدينا من مصادر.
(2/189)
________________________________________
شعو: الشَّعْواءُ: الغارة الفاشية. وأشعى القومُ الغارة إشعاءً، أي: أشعلوها. قال «8» :
كيف نَوْمي على الفراش ولمّا ... تشملِ الشّامَ غارةٌ شَعْواءُ
شيع وشوع: الشُّوعُ: شجرُ البانِ، الواحدة: شُوعةٌ. قال الطّرمّاح «9» :
جَنَى ثَمَرٍ بالواديين وشُوعُ
فمن قال بفتح الواو وضمّ الشين: فالواو نسق، وشُوع: شجر البان، ومن قال: وشوع بضمهما، أراد: جماعةَ وَشْعٍ «10» ، وهو زهر البقول. والشَّيْعُ: مقدارٌ من العَدَد. أقمت شهراً أو شيْعَ شهرٍ، ومعه ألفُ رجلٍ، أو شَيْعُ ذاك. والشَّيْعُ من أولاد الأسد. وشاعَ الشّيءُ يَشِيعُ مَشاعاً وشَيْعُوعَةً فهو شائعٌ، إذا ظهر وأشعْتُهُ وشعْتُ به: أذعته. وفي لغة: أشعت به. ورجلٌ مِشْياعٌ مِذْياعٌ، وهو الذي لا يكْتُمُ شيئاً. والمُشايَعةُ: متابعتُك إنساناً على أمرٍ. وشَيَّعتُ النارَ في الحَطَبِ: أضرمتُه إضراماً شديداً، قال رؤبة «11» :
شدّا كما يشيّع التَّضْرِيمُ
__________
(8) لم نهتد إلى القائل، ولم نقف على القول في غير الأصول.
(9) ديوانه 295، وصدر البيت:
وما جلس أفكار أطاع لسرحها.
(10) في (س) : وشيع، وليس صوابا.
(11) اللسان (شيع) وهو غير منسوب.
(2/190)
________________________________________
والشّياعُ: صوتُ قَصَبةِ الرّاعي. قال «12» :
حَنِين النّيبِ تَطْرَبُ للشِّياعِ
وشيَّع الرّاعي في الشِّياعِ: نَفَخَ في القَصَبة. ورجل مُشَيَّعُ القَلبِ إذا كان شجاعاً، قد شُيّع قلبه تشييعاً إذا ركب كلَّ هولٍ، قال سليمان: «13»
مُشَيَّع القلبِ ما منْ شأنِهِ الفَرَقُ
وقال الرّاجز «14» :
والخزرجيُّ قلبُه مُشَيَّعُ ... ليس من الأمر الجليل يَفْزَعُ
والشِّيعةُ: قوم يتشيّعون، أي: يهوون أهواء قوم ويتابعونهم. وشيعةُ الرّجلِ: أصحابه وأتباعه. وكلّ قومٍ اجتمعوا على أمرٍ فهم شيعة وأصنافهم: شِيَع. قال الله [تعالى] : كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ
«15» . أي: بأمثالِهِمْ من الشِّيَعِ الماضية. وشَيَّعْتَ فلاناً إذا خرجت معَه لتُودِّعَه وتُبْلِغَه منزِلَهُ. والشِّياعُ: دعاءُ الإبل إذا استأخرت. قال «16» :
وألاّ تخلدَ الإبل الصّفايا ... ولا طول الإهابة والشِّياعِ
__________
(12) اللسان (شيع غير منسوب أيضا، ونسبه التاج إلى (قيس بن ذريح،) وصدره:
إذا ما تذكرين يحن قلبي
(13) لم نهتد إلى البيت، ولعل سليمان هذا هو سليمان بن يزيد العَدَويّ.
(14) لم نهتد إلى الراجز.
(15) سبأ 54.
(16) لم نقف على القائل.
(2/191)
________________________________________
وشع: الوَشِيعَةُ: خَشَبَة يُلَفُّ عليها الغَزْلُ من ألوان الوَشْي، فكلُّ لفيفةٍ وَشِيعةٌ، ومن هنالك سُمِّيتْ قَصَبَةُ الحائكِ وَشِيعَة، لأنّ الغَزْلَ يُوَشَّعُ فيه. قال ذو الرّمة «17» :
به مَلْعَبٌ من مُعْصِفاتٍ نَسَجْنَهُ ... كنَسْجِ اليَمانِي بُرْدَهُ بالوَشائِعِ
وقال «18» :
نَدْفَ القِياس القُطُنَ المُوَشَّعا
والوَشْعُ من زهر البقول: ما اجتمع على أطرافها، فهي وَشْعٌ ووُشُوع. وأَوْشَعَتِ البُقولُ خرجت زهرتها قبل أن تتفرق.
__________
(17) ديوانه 2/ 778.
(18) ديوانه 90.
(2/192)
________________________________________
باب العين والضاد و (واي) معهما ع ض و، ع وض، ض وع، ض ي ع، ض ع و، وض ع
عضو: العُضْوُ والعِضْوُ- لغتان- كلّ عظم وافر من الجسد بلحمه. والعِضة: القطعة من الشيء، عضّيت الشيء عِضةً عِضةً إذا وزّعته بكذا، قال «1» :
وليس دين الله بالمُعَضَّى
وقوله تعالى: جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ
«2» ، أي: عضةً عضةً تفرقوا فيه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
عوض: العِوَضُ معروف، يقال: عِضْتُه عِياضاً وعَوْضاً، والاسم: العِوَضُ، والمستعملُ التَّعويضُ عوّضتُه من هِبَته خيراً. واستعاضني: سألني العِوَضَ. عاوَضْتُ فلاناً بعَوَضٍ في البيع والأخذ فاعتَضْته مما أعطيته. عِياض: اسم رجل. وتقول: هذا عِياضٌ لك، أي: عِوَضٌ لك. عَوْضُ: يجري مجرى القَسَم، وبعض النّاس يقول: هو الدّهر والزّمان، يقول الرّجلُ لصاحبه: عَوْضُ لا يكون ذاك أبداً، فلو كان اسماً للزّمان
__________
(1) (رؤبة) ديوانه ص 81.
(2) الحجر 91.
(2/193)
________________________________________
إذا لجرى بالتنوين، ولكنه حرفٌ يُرادُ به قَسَم، كما أنّ أجَلْ ونَحْوَها مما لم يتمكّن في التّصريف حُمِلَ على غير الإعراب. قال الأعشى:
رضيعَيْ لِبانٍ ثديَ أم تحالفا ... بأسحمَ داجٍ عَوْضَ لا تَتَفَرَّقُ
وتقول العرب: لا أفعل ذاك عَوْضُ، أي: لا أفعله الدّهر، ونصب عوض، لأنّ الواو حفزت الضّاد، لاجتماع السّاكنين.
ضوع، ضيع: ضاعَتِ الريحُ ضوعاً: نَفَحَتْ. قال «4» :
إذا التَفَتَتْ نحوي تضوّع ريحُها
ويقال: ضاعَ يَضُوعُ، وهو التَّضوُّر، في البكاء في شِدَّةٍ ورفعِ صوتٍ. تقول: ضَرَبَهُ حتّى تَضَوَّعَ، وتضوّر. وبكاءُ الصّبيّ تضوُّعٌ أكْثَرَهُ، قال «5» :
يَعِزُّ عليها رقبتي ويسوؤها ... بكاه فتثني الجيدَ أن يتضوّعا
وأضاعَ الرّجلُ إذا صارت له ضَيْعَةٌ يشتغِلُ بها، وهو بِمَضِيعَةٍ وبمَضيع إذا كان ضائعاً وأضاع إذا ضيّع. والضُّوَعُ: طائر من طير اللّيل من جنسِ الهامِ إذا أَحَسَّ بالصّباح صَدَحَ «6» . وضَيْعةُ الرّجلِ: حِرْفَتُه، تقول: ما ضَيْعَتُك؟ أي: ما حِرْفَتُك؟ وإذا أخذ الرّجلُ في أمور لا تَعنيه تقول: فَشَتْ عليك الضَّيعة، أي: انتشرتْ
__________
(4) (امرؤ القيس) ديوانه ص 15 وعجز البيت:
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل
(5) (امرؤ القيس) ديوانه ص 241 وفيه (ريبتي) مكان (رقبتي) .
(6) من التهذيب 3/ 7 في نقله عن العين. في الأصول: صرخ ولعله تصحيف.
(2/194)
________________________________________
حتّى لا تدري بأيّ أمرٍ تأخذ. وضاعَ عيالُ فلانٍ ضَيْعَةً وضِياعاً، وتركهم بمَضْيَعَةٍ، وبمَضِيعَةٍ وأضاعَ الرّجلُ عياله وضيعهم إضاعة ونضييعا، فهو مُضِيعٌ، ومُضَيِّع
ضعو: الضَّعْوَةُ: شَجَرٌ تكون بالبادية، والضَّعة أيضاً بحذف الواو، ويجمع ضَعَوات قال «7» :
مُتَّخِذاً في ضَعَواتٍ تَوْلَجا
وقال يصف رجلاً شهوان اللّحم «8» :
تتوقُ باللّيل لشَحْمِ القَمعَه ... تثاؤبَ الذّئبِ إلى جنبِ الضّعة
وضع: الوضاعةُ: الضَّعَةُ. تقول: وَضُعَ [يَوْضُعُ] وَضاعة. والوضيعة: نحو وضائع كسرى، كان ينقل قوماً من بلادهم ويسكنهم أرضاً أخرى حتّى يصيروا بها وَضِيعَةً أبداً. والوَضيعةُ أيضاً: قوم من الجند يُجْعَلُ أسماؤهم في كورة لا يغزون منها. والوضيعةُ: ما تَضَعُه من رأسِ مالكَ. والخيّاط يُوضِّعُ القُطنَ على الثّوب توضيعاً قال «9» :
كأنَّه في ذرى عمائمهم ... موضع من مَنادِفِ العَطَبِ
وتقول: في كلامه توضيعٌ إذا كان فيه تأنيثُ كلامِ النِّساءِ.
__________
(7) (جرير) ديوانه 1/ 187.
(8) لسان العرب (قمع) غير منسوب.
(9) لم نهتد إلى القائل.
(2/195)
________________________________________
والوَضْعُ: مصدرُ قولِك: وَضَعَ يَضَعُ. والدّابّة تضع السّير وضعاً [وهو سير دون] «10» . وتقول: هي حسنة الموضوع. وأوضعها راكبها. قال الله عزّ وجلّ: وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ «11» . والمُواضَعَةُ: أن تُواضِعَ أخاك أمراً فتناظره فيه. وفلان وضعه دخوله في كذا فاتضع والتواضع: التذلل.
__________
(10) زيادة من التهذيب من روايته عن العين. لتوجيه العبارة وتوضيح المعنى.
(11) التوبة 47.
(2/196)
________________________________________
باب العين والصاد و (واي) معهما ع ص و، ع ص ي، ع وص، ع ي ص، ص ع و، ص وع، وص ع، مستعملات
عصو، عصي: العصا: جماعة الإسلام، فمن خالفهم فقد شقّ عصا المسلمين. [والعصا: العود، أنثى] عصا وعَصَوان وعِصِيّ. وعَصِيَ بالسّيف: أخذه أخذ العصا، أو ضرب به ضربه بالعصا. وعصا يعصو لغة. قال «1» :
وإنَّ المشرفيةَ قد عَلِمْتُمْ ... إذا يَعْصَى بها النَّفرُ الكرامُ
والعصا: عرقوة الدّلو، والإثنان عَصَوانِ، قال «2» :
فجاءتْ بنَسْجِ العنكَبُوتِ كأنّما ... على عصويها سابري مشبرق
وإذا انتهى المسافرُ إلى عُشْبٍ، وأزمع المُقامَ قيل: ألقى عصاه، قال «3» :
فألقَتْ عصاها واستقرّت بها النَّوَى ... كما قرّ عيناً بالإياب المسافر
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2) (ذو الرمة) ديوانه 1/ 496.
(3) التهذيب 3/ 77. المحكم 2/ 215 غير منسوب أيضا، ونسبه ابن بري، كما جاء في اللسان (عصا) إلى (عبد ربه السلمي) .
(2/197)
________________________________________
وذهب هذا البيت مَثَلاً لكلّ من وافقه شيء فأقام عليه، وكانت هذه امرأة كلّما تزَّوجتْ فارقَتْ زَوْجَها، ثم أقامتْ على زوجٍ. وكانتْ علامةُ إبائها أنَّها لا تكشِفُ عن رأسها، فلمّا رضيت بالزّوْجِ الأخير، ألقتْ عصاها، أي: خمارها. وتقول: عَصَى يَعْصي عِصياناً ومَعْصية. والعاصي: اسم الفصيل خاصّة إذا عصى أمّه في اتّباعها.
عوص، عيص: العَوَص: مصدر الأَعْوص والعَويص. اعتاص هذا الشيء إذا لم يُمكِنْ. وكلام عَويصٌ، وكلمةٌ عَوْصاءُ. قال الرّاجز «4» :
يا أيها السائل عن عَوْصائها
وتقول: أَعْوَصْتُ في المنطق، وأَعْوَصْتُ بالخَصْمِ إذا أدخلت في الأمرِ ما لا يُفْطَنُ له، قال لبيد «5» :
فلقد أُعْوِصُ بالخَصْمِ وقد ... أملأُ الجَفْنَةَ من شَحْمِ القُلَلْ
واعتاصتِ النّاقةُ: ضَربَها الفَحْلُ فلم تحمِلْ من غَير علّة. والمَعِيص، كما تقول: المَنْبِت: اسمُ رجلٍ. قال «6» :
حتّى أنالَ عُصَيَّةَ بن مَعِيصِ
والعِيصُ: مَنْبِتُ خِيار الشَّجَرِ. قال «7» :
فما شجرات عيصك في قريش ... بعشات الفروع ولا ضواحي
__________
(4) لم نهتد إلى الراجز.
(5) ديوانه 177.
(6) البيت في التهذيب 3/ 81 واللسان (عيص) غير منسوب فيهما، وصدره:
ولأثأرن ربيعة بن مكدم
(7) (جرير) ديوانه 1/ 90.
(2/198)
________________________________________
وأعياص قريش: كرامُهم يتناسبون إلى عِيص، وعيص في آبائهم عيص بن إسحاق، ويقال: عيصاً. وقيل: العِيصُ: السِّدْرُ الملتفّ.
صعو: الصَّعو: صِغارُ العصافير، والأنثى: صَعْوة، وهو أحمر الرأس والجميع: الصِّعاء. ويقال: صَعْوةٌ واحدة وصَعْوٌ كثير، ويقال: بل الصَّعْو والوَصْع واحدٌ، مثل: جَذَبَ وجَبَذَ.
صوع: الصّواع: إناء يُشْرَبُ فيه. وإذا هيّأَتِ المرأةُ موضِعاً لنَدْفِ القطن قيل: صوَّعَتْ موضِعاً، واسم الموضع: الصّاعة. والكَمِيُّ يَصُوعُ أقرانَه إذا حازهم من نواحيهم. والرّاعي يَصوعُ الإبلَ كذلك. وانصاع القوم فذهبوا سراعاً وهو من بنات الواو، وجعله رؤبة من بنات الياء حيث يقول «8» :
فظلّ يكسوها الغُبارَ الأصْيَعَا
ولو ردّ إلى الواو لقال: أَصْوَعا. وتَصَوَّعَ النّباتُ إذا صار هَيْجاً. والتّصوّعُ: تَقَبُّضُ الشَّعر. والصّاعُ: مِكيالٌ يأخذ أربعةَ أمدادٍ، وهي من بنات الواو.
وصع: الوَصْعُ والوَصَعُ: من صغار العصافير خاصّة، والجمع: وِصْعانٌ،
وفي الحديث: إن العرش على مَنْكِبِ إسرافيل، وإنّه ليتواضع لله حتّى يصيرَ مثل الوَصَعِ «9» .
والوَصِيعُ: صوت العصفور.
__________
(8) ديوانه 90.
(9) المحكم 2/ 218، واللسان (وصع) .
(2/199)
________________________________________
باب العين والسين و (واي) معهما ع س و، ع وس، ع ي س، س ع ي، س وع، س ي ع، ي س ع، وس ع، وع س
عسو: عسا الشّيخ يَعْسو عَسْوَةً، وعَسِيَ يَعْسَى عسىً إذا كَبِرَ، قال رؤبة «1» :
يهوُون عن أركانِ عزٍّ أَدْرَما ... عن صامل عاس إذا ما اصلخمما
قوله: عن صاملٍ، أي: عن عزٍّ كأنّه جبل صامل، أي: صُلْب. وعسا الليل: اشتدت ظلمته. قال «2» :
وأطعن اللّيلَ إذا اللّيل عسا
أي: أظلم. وعَسِيَ النبات يعسى عسى، إذا غلظ. قال الرّاجز يصف راعياً وإبلاً «3» :
فظل ينحاها ظماءً خمّسا ... أسعف ضرب قد عسا وقوّسا
عسَى في القرآنِ من الله واجبٌ، كما قال في الفتح وفي جمع يوسف وأبيه: عسَيْت، وعسِيت بالفتح والكسر، وأهلُ النّحوِ يقولون: هو فعل
__________
(1) ديوانه 184.
(2) العجاج ديوانه 129، والرواية فيه: غسا بالعين المعجمة. وعسا وغسا بمعنى.
(3) لم نقف على الراجز، ولا على الرجز في غير الأصول.
(2/200)
________________________________________
ناقص، ونقصانه أنك لا تقول منه فَعل يَفْعلُ، و (ليس) مثله، ألا ترى أنك تقول: لَسْتُ ولا تقول: لاس يَليس. وعسَى في الناس بمنزلة: لعلّ وهي كلمة مطمعة، ويستعملُ منه الفعل الماضي، فيقال: عَسَيْت وعَسَيْنا وعَسَوْا وعَسَيا وعسَيْنَ- لغة- وأُمِيتَ ما سواه من وجوه الفعل. لا يقال يفعل ولا فاعل ولا مفعول
. عوس: العَوْس والعَوَسانُ: الطَّوَفان باللّيل. والذّئْبُ يَعُوسُ: يَطْلُبُ شيئاً يأكلُه. والأعوس الصيقل، ويقال لكلّ وصّافٍ للشيء: هو أَعْوَسُ وصّافٌ، قال جرير «4» :
يا ابن القُيُونِ وذاكَ فِعْلُ الأَعْوَسِ
عيس: العَيَسُ: عَسْبُ الجملِ، أي: ضرابه. والعَيَسُ والعِيسَةُ: لونٌ أبيضُ مشرب صفاءً في ظُلْمة خفيّة. يقال: جملٌ أَعْيَسُ، وناقة عَيْساء. والجمعُ: عِيسٌ قال رؤبة «5» :
بالعيس تمطوها قياقٍ تَمْتَطي
والعَرَبُ خصّت بالعيس عِراب الإبلِ البيض خاصّة. وبناء عِيسَةٍ: فُعْلة على قياس كُمْتَةٍ وصُهْبَة، ولكنْ قَبُح الياءُ بعد الضّمّة فكُسِرَتِ العين على الياء. ظبيٌ أعيس. وعيسَى: [اسم نبي الله صلوات الله عليه] «6» يجمع: عِيسُونَ بضمّ السّين، والياء «7» ساقطة، وهي زائدة، وكذلك كلّ ياء زائدة في آخر
__________
(4) ديوانه ص 359 (صادر) غير أن الرواية فيه غير ذلك، فالشطر في الديوان: وذاك فعل الصيقل فالروي لام.. إلا أن يكون الشطر لغير جرير.
(5) ديوانه 84.
(6) زيادة من التهذيب 3/ 94 من روايته عن العين.
(7) يعني الألف في آخره المرسومة ياء.
(2/201)
________________________________________
الاسم تسقط عند واو الجمع، ولم تعقب فتحة. فإن قلت: ما الدليل على أن ياء عيسى زائدة؟ قلت: هو من العَيَس، وعيسى شبهُ فُعلَى، وعلى هذا القياس: مُوسَى.
سعي: السَّعْيُ: عَدْوٌ ليس بشديد. وكلُّ عملٍ من خيرٍ أو شَرٍّ فهو السَّعْيُ. يقولون: السّعيُ العملُ، أي: الكسب. والمسْعاة في الكَرَم والجود. والسّاعي: الذي يُوَلّى قَبْضَ الصَّدَقات. والجمع: سعاةٌ قال:
سَعَى عِقالاً فلم يَتْرُكْ لنا سَبَداً ... فكيف لو قد سعى عمرٌو عقالَينْ
والسِّعاية: أن تَسعَى بصاحبك إلى والٍ أو مَنْ فوقَه. والسِّعاية: ما يُسْتَسْعَى فيه العبدُ من ثَمَنِ رقَبتِه إذا أُعْتِق بعضُه، وهو أن يكلَّفَ من العَملِ ما يُؤدّي عن نفسِه ما بقي.
سوع: سُواعٌ: اسم صَنَمٍ في زمن نوح فَغَرَّقَهُ الطُّوفانُ، ودَفَنَهُ، فاستثاره إبليسُ لأهْلِ الجاهليّةِ فكانوا يعبدونه من دون الله عزّ وجلّ. والسّاعة تُصغّر سُوَيْعة، والسّاعة القيامة.
سيع: السّيعُ الماء الجاري على وجه الأرض. تقول: قد انساعَ إذا جرى. وانساعَ الجَمَدُ إذا ذابَ وسالَ. قال «9» :
من شِلّها ماءُ السراب الأسيعا
__________
(9) (رؤبة) - ديوانه 89. والرواية فيه: ترى بها ماء السراب الأسعيا.
(2/202)
________________________________________
والسياعُ تطيينُك بالجَصِّ أو الطّينِ، أو القِير، كما تُسَيّعُ به الحبّ أو الزّق أو السُّفُن تَطْليه طلْياً رفيقاً. قال يُشَبِّهُ الخَمْرَ بالوَرْسِ «10» :
كأنّها في سِياعِ الدَّنِّ قِندِيد
يجوزُ في السّين النَّصب والكسر. والمِسْيَعَةُ: خَشَبةٌ مُمَلَّسَةٌ يُطَيَّنُ بها. والفعل: سَيَّعْتُه تَسييعاً، أي: تطييناً. والسِّيَاع: شجر البان، وهو من شجرِ العِضاه، ثَمَرتُهُ كهيئةِ الفُسْتُق، ولِثاهُ مِثْلَ الكُنْدُر إذا جَمَد.
يسع: اليَسَع: اسم من اسماء الأنبياء، والألف واللام زائدتان.
وسع: الوُسْعُ: جِدةُ الرَّجلِ، وقدرة ذات يده. تقول: انفِقْ على قَدْرِ وُسْعِك، أي: طاقتك. وَوَسُعَ الفرس سَعَةً ووَساعَةً فهو وَساعٌ. وأَوْسَعَ الرّجل: إذا صارَ ذا سَعَةٍ في المال، فهو مُوسِعٌ وإنّه لذو سَعَةٍ في عيشه. وسَيْرٌ وَسِيعٌ ووَساعٌ. ورحمة الله وسعت كل شيء، وأَوْسَعَ الرّجُلُ صار ذا سعة في المال. وتقول: لا يَسَعُكَ، أي: لَسْتَ منهُ في سَعَةٍ.
وعس: الوَعْسُ: رملٌ أو غيره، وهو أعظم من الوعساء. والوَعْسُ: الرّملُ الذي تغيبُ فيه القوائم. والاسم: الوعساء وإذا ذكّروا قالوا: أوعسُ. قال العجاج يصف العَجُزَ «11» :
ومَيْسَنا نِيًّا لها مُمَيّسا ... ألبس دعصاً بين ظهري أوعسا
__________
(10) في اللسان والتاج (سيع) غير منسوب وغير تام.
(11) ديوانه 127.
(2/203)
________________________________________
والمِيعاسُ: المكان الذي فيه الوَعْسُ في قول جرير «12» :
حيّ الهِدَمْلَة من ذاتِ المواعيس
والمُواعَسَةُ: ضربٌ من سير الإبل في السّرعة يقولون: تَوَاعَسْنَ بالأعناق، إذا سارت ومدّت أعناقها في سعة الخطو، قال الشاعر «13» :
كَمِ اجْتَبْنَ من ليلٍ إليك وواعَسَتْ ... بنا البِيدَ أعناق المهاري الشعاشع
__________
(12) ديوانه 249 (صادر) وعجز البيت:
فالحنو أصبح قفرا غير مأنوس
(13) المحكم 2/ 219، اللسان (وعس) .
(2/204)
________________________________________
باب العين والزاي و (واي) معهما ع ز و، ع ز ي، ع وز، وع ز، ز وع، وز ع مستعملات
عزو، ع ز ي: العِزَةُ: عصبةٌ من النّاس فوقَ الحِلَقَة، والجماعةُ: عِزُونَ، ونقصانُها واو. وكذلك الثُّبة. قال في الحيّة «1» :
خُلِقَتْ نواجذُه عِزينَ ورأسُه ... كالقُرص فُلْطِحَ من طَحينِ شعيرِ «2»
وعَزِيَ الرّجلُ يَعْزَى عزاءً، ممدود. وإنّه لَعَزِيٌّ صبور. والعَزاءُ هو الصّبرُ نفسه عن كلّ ما فقدت ورزئت، قال «3» :
ألا مَنْ لِنَفْسٍ غاب عنها عزاؤها
والتّعزّي فعلُهُ، والتّعزِيَةُ فعلك به قال «4» :
وقد لمت نفسي وعزّيتها ... وباليأس والصبر عزّيتُها
والاعتزاءُ: الإتّصالُ في الدَّعْوَى إذا كانت حرب، فكل مَنِ ادَّعَى في شِعارِه أنا فلانُ بنُ فلانٍ: أو فلان الفلانيّ فقد اعتزَى إليه. وكلمةٌ
__________
(1) اللسان (عزا) وهو منسوب فيه إلى (ابن أحمر البجلي) .
(2) في النسخ (عجين) مكان شعير.
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول.
(4) لم نهتد إليه في غير الأصول.
(2/205)
________________________________________
شنعاءُ من لغة أهل الشِّحْر، يقولون: يَعْزى لقد كان كذا وكذا، ويَعْزيكَ ما كان ذلك، كما تقول: لعمري لقد كانَ كذا وكذا، ولعَمْرُكَ ما كانَ ذاك. وتقول: فلان حسَنُ العِزْوَةِ على المصائب. والعِزْوَةُ: انتماءُ الرّجلِ إلى قومه. تقول: إلى مَنْ عِزْوَتُكَ، فيقول: إلى تميم.
عوز: العَوَزُ أن يُعْوِزَك الشيء وأنت إليه مُحتاجٌ، فإذا لم تجدِ الشيء قلت: أعوزني «5» . وأَعْوَزَ الرّجلُ ساءتْ حالُه. والمِعْوَزُ والجمع مَعاوِز: الخِرَقُ التي يُلَفُّ فيها الصّبيّ ... قال حسان بن ثابت «6» :
وموءودةٍ مقرورةٍ في مَعاوزٍ ... بآمَتِها مَرْموسَةٍ لم تُوَسَّدِ
ورواية عبد الله: منذورة في معاوز. وكلّ شيءٍ لزِمَهُ عيبٌ فالعيب آمَتُهُ، وهي في هذا البيت: القلفة.
وعز: الوَعْزُ: التَّقدِمَةُ. أوعزت إليه، أي: تَقَدَّمْتُ إليه ألاّ يَفْعَل كذا، قال «7» :
قد كنت أَوْعَزْتُ إلى علاء ... في السر والإعلانِ والنَّجاء
النَّجاءُ من المناجاة.
__________
(5) في (ص) و (ط) : عوز وما أثبتناه فمن (س) .
(6) في (ص) : (مفروضة) وفي (ط) (مفروزة) وفي (س) : (معزوة) مكان (مقرورة) . وفي (ص) و (ط) : (بأمتها) وفي س (بامتها) مكان (بآمتها) . وفي (ط) مرمرسة، وفي (س) مرسومة والصواب ما أثبتنا من (ص) والمحكم 2/ 221 واللسان (عوز) .
(7) المحكم 2/ 222، واللسان (وعز) غير منسوب، والرواية فيهما (وعزت) .
(2/206)
________________________________________
زوع: الزَّوع: جَذْبُك النّاقة بالزّمام لِتَنْقاد. قال ذو الرّمة «8» :
ومائلٍ فوقَ ظهرِ الرّحْلِ قلتُ له: ... زُعْ بالزّمام وجَوْزُ اللّيل مَرْكومُ
وقال في مثل للنّساء «9» :
ألا لا تبالي العِيسُ من شدِّ كُورِها ... عليها ولا من زاعها بالخزائم
وزع: الوزع: كفُّ النَّفْس عن هواها. قال «10» :
إذا لم أزع نفسي عنِ الجَهلِ والصِّبا ... لِينفَعَها عِلْمي فقد ضَرَّها جَهْلي
والوَزوع: الوَلوع. أُوزِع بكذا، أي: أوِلع.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله موزَعاً بالسّواك،
والتَّوزيع: القِسْمة: أن يقسموا الشيء بينهم من الجزور ونحوه، تقول: وزّعتُها بينهم، وفيهم، أي: قسّمتها. وَزُوع: اسم امرأة. والوازعُ: الحابسُ للعسكر. قال عزّ وجلّ: فَهُمْ يُوزَعُونَ
«11» * أي: يُكَفُّ أوّلُهم على آخرهم. وقوله عزّ وجلّ: أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
«12» *، أي: أَلْهِمْني.
__________
(8) ديوانه 1/ 420 والرواية فيه: وخافق الرأس مثل السيف ...
(9) (ذو الرمة) ديوانه 3/ 1915 (ملحق الديوان) .
(10) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(11) النمل 17.
(12) النمل 19.
(2/207)
________________________________________
باب العين والطّاء و (واي) معهما ع ط و، ط وع، ع ي ط، ي ع ط مستعملات
عطو: العَطاء: اسمٌ لما يُعْطَى، وإذا سمّيت الشيء بالعطاء من الذّهب والفضّة قلت: أَعْطِيَة، وأَعْطِيَات: جمع الجمع. والعَطْوُ: التّناوُلُ باليدِ. قال امرؤ القيس «1» :
وتَعْطو برَخْصٍ غيرِ شَثْنٍ كأنه ... أساريع ظبي أو مَساويكُ إسْحِلِ
والظّبيُ العاطي: الرافع يديه إلى الشّجرة ليتناول من الورق. قال «2» :
تحكُّ بقَرنَيْها برير أراكة ... وتعطو بظلفيها إذا الغُصْنُ طالَها
يقال: ظبيٌ عاطٍ، وعَطُوٌّ، وجَدْيٌ عطوٌّ، ومنه اشتُقَّ الإعطاءُ. والمُعاطاةُ: المُناوَلَةُ. عاطى الصبيُّ أهلَه إذا عَمِلَ لهم وناولَ ما أرادوا. والتَّعاطي: تناولُ ما لا يحقّ. تعاطَى فلان: ظلمك، قال الله عزّ وجلّ: فَتَعاطى فَعَقَرَ «3» ، قالوا: قام الشّقيّ على أطرافِ أصابع رجلَيْه، ثمّ رفع يدَيْه فضربَها فعقرها،
__________
(1) ديوانه 17.
(2) لم نهتد إلى القائل.
(3) القمر 29.
(2/208)
________________________________________
ويقال: بل تَعاطيهِ جُرْأتُهُ، كما تقول: تعاطى أمراً لا ينبغي له.. والتَّعاطي أيضاً في القُبَل.
طوع: طاع يَطُوع طوعاً فهو طائع. والطَّوْعُ: نقيض الكَرْه، تقول: لَتَفْعَلَنَّهُ طوعاً أو كَرْهاً. طائعاً أو كارِهاً، وطاع له إذا انقاد له. إذا مضَى في أمرك فقد أطاعك، وإذا وافقك فقد طاوعك. قال يصف دلواً «4» :
أحلِفُ بالله لَتُخْرِجِنَّهْ ... كارِهةً أو لتطاوِعِنَّهْ
أو لَتَرينَّ بيَ المُرِنَّهْ
أي: الصّائحة. والطّاعة اسم لما يكون مصدره الإطاعة، وهو الإنقياد، والطّواعِيَةُ اسم لما يكون مصدره المطاوعة. يقال: طاوعتِ المرأة زوجَها طَواعيةً حَسَنةً، ولا يقال: للرعيّة ما أحسن طَواعِيَتَهُم للرّاعي، لأنَّ فعلَهم الإطاعة، وكذلك الطّاقة اسم الإِطاقة والجابة اسم الإِجابة، وكذلك ما أشْبَهَهُ، قال «5» :
حَلَفْتُ بالبيتِ وما حَوْلَهُ ... من عائذٍ بالبيت أَوْ طاعي
أراد: أو طائع فقلبه، مثل قِسِيّ، جعل الياء في طائع بعد العين، ويقال: بل طرح الياءَ أصلاً، ولم يُعِدْها بعد العين، إنّما هي: طاع،
__________
(4) لم نهتد إلى الراجز.
(5) المحكم 2/ 224. واللسان (طوع) .
(2/209)
________________________________________
كما تقول: رجلٌ مالٌ وقال، يراد به: مائل، وقائل، مثل قول أبي ذؤيب «6» :
وسوّد ماءُ المَرْدِ فاها فلونُهُ ... كلَوْنِ الرَّمادِ وهي أدماءُ سارُها
أي: سائرها. وقال أصحابُ التّصريف: هو مثل الحاجة، أصلها: الحائجة. ألا ترى أنّهم يردّونها إلى الحوائج، ويقولون: اشتُقّت الاستطاعة من الطّوع. ويقال: تَطاوَعْ لهذا الأمر حتّى تستطيعه. وتطوّع: تكلّف استطاعته، وقد تطوّع لك طوعاً إذا انقاد، والعرب تحذف التّاء من استطاع، فتقول: اسطاع يَسطيع بفتح الياء، ومنهم من يضمّ الياء، فيقول: يُسْطِيعُ، مثل يُهريق. والتَّطوُّعُ: ما تبرّعت به ممّا لا يلزمك فريضته. والمُطّوِّعة بكسر الواو وتثقيل الحرفين: القوم الذين يتطوّعون بالجهاد يخرجون إلى المُرابَطات. ويقال للإبل وغيرها: أطاعَ لها الكلأ إذا أصابتْ فأكلَتْ منه ما شاءت، قال الطرمّاح «7» :
فما سرحُ أبكارٍ أطاعَ لِسَرْحِهِ
والفَرَس يكون طوعَ العِنانِ، أي: سَلِس العِنانِ. وتقول: أنا طَوْعُ يدِكَ، أي: منقادٌ لكَ، وإنَّها لطوعُ الضّجيع. والطّوْعُ: مصدرُ الطائعِ. قال «8» :
طَوْعَ الشَّوامِتِ مِنْ خوف ومن صرد
__________
(6) ديوان الهذليين ص 24، والرواية فيه: كلون النوور.
(7) ديوانه، ص 295 والرواية فيه: فما جلس أبكار ... وعجز البيت:
جَنَى ثَمَرٍ بالواديين وشُوعُ
(8) النابغة ديوانه ص 8 وصدر البيت:
فارتاع من صوت كلاب فبات له
(2/210)
________________________________________
عيط: جملٌ أَعْيَطُ، وناقةٌ عَيْطاء: طويلُ الرّأسِ والعُنُقِ. وتُوصَفُ به حُمُر الوَحْشِ. قال العجّاج يصفُ الفَرَس بأنّه يعقر عليه «9» :
فهو يكب العيط منها للذقن
وكذلك القَصْرُ المنيف أَعْيَطُ لطوله، وكذلك الفأرة عَيْطاء. قال «10» :
نحنُ ثقيفٌ عِزُّنا منيعُ ... أَعْيَطُ صعْبُ المرتَقَى رفيع
واعتاطت النّاقة إذا لم تَحْمِلْ سنوات من غير عقر، وربّما كان اعتياطها من كثرة شحمها، وقد تعتاط المرأة أيضاً. وناقةٌ عائط، قد عاطت تعيط عياطاً في معنى حائل. ونُوقٌ عِيطٌ وعوائطُ. والتعيّط: تنبّع الشيء من حجرٍ أو عود يَخْرُجُ منه شِبْهُ ماءٍ فيُصَمَّغُ، أو يَسِيلُ. وذِفْرَى الجَمَل يَتَعَيَّطُ بالعَرَق الأسود. قال «11» :
تعَيَّطُ ذِفراها بجَوْنٍ كأنّه ... كُحَيْلٌ جَرَى من قُنْفُذِ اللّيتِ نابعُ
وقال في العائط بالشحم «12» :
قدّد من ذات المدكّ العائط
وعِيطِ: كلمة يُنادَى بها الأشِرُ عند السُّكر، ويُلْهَجُ بها عند الغلبة، فإذا لم يَزِدْ على واحدة مدّه وقال: عيَّط، وإن رجّع قال: عطعط.
__________
(9) ليس في ديوانه، ولم نقف عليه في غير الأصول.
(10) لم نهتد إلى الراجز.
(11) (جرير) ديوانه 290 (صادر) والرواية فيه: تغيض مكان تعيط. وفي النسخ: (الليل) مكان (الليت) .
(12) هذا من (س) ، ولم يتبين لنا معناه. أما (ص) و (ط) فالعبارة فيهما أكثر اضطرابا فقد جاءت العبارة فيهما: قال في العائط: وبالشحم قد دمها نيها وبالمد [بياض] العائط.
(2/211)
________________________________________
يعط: يَعاطِ: زجرُك الذّئبَ إذا رأيته. قلت: يَعاطِ يَعاطِ. ويقال: يَعَطْتُ به، وأَيْعَطْتُ به، وياعَطْتُه. قال «13» :
صُبَّ على شاءِ أبي رِباطِ ... ذُؤالةٌ كالأَقْدُحِ الأمْراطِ
يدنو إذا قيلَ له: يَعاطِ
وبعض يقول: يِعاط، وهو قبيحٌ، لأنَّ كسر الياء زاده قبحاً، وذلك أنّ الياء خُلِقَتْ من الكسرة، وليس في كلامِ العربِ فَعال في صدرها ياء مكسورة في غير اليِسار بمعنى الشّمال، أرادوا أن يكون حذوهما واحداً، ثم اختلفوا فمنهم من يهمز، فيقول: إسار. ومنهم من يفتح الياء فيقول: يَسار، وهو العالي من كلامهم.
__________
(13) التهذيب 3/ 107 واللسان (يعط) .
(2/212)
________________________________________
باب العين والدّال و (واي) معهما ع د و، ع ود، د ع و، وع د، ود ع، يدع
عدو: العَدْوُ: الحُضْرُ. عدا يعدو عدواً وعدوّاً، مثقلةً، وهو التعدّي في الأمر، وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه، ويقرأ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً «1» على فُعُول في زنة: قُعُود. وما رأيت أحداً ما عدا زيداً، أي: ما جاوز زيداً، فإن حذفت (ما) خفضته على معنى سوى، تقول: ما رأيت أحداً عدا زيد. وعدا طورَه، وعدا قدرَه، أي: جاوز ما ليس له. والعدوان والإعتداء والعداء، والعدوى والتعدّي: الظُّلْمُ البراح. والعَدْوَى: طلبك إلى والٍ ليُعْدِيَك على من ظلمك، أيْ: ينتقم لك منه باعتدائه عليك. والعَدْوَى: ما يقال إنّه يُعْدِي من جَرَب أو داء.
وفي الحديث: لا عَدْوَى ولا هامةِ ولا صفرَ ولا غُولَ ولا طيرَةَ «2»
أي: لا يُعْدي شيءٌ شيئاً. والعَدْوَةُ: عَدْوَةُ اللّص أو المغيرِ. عدا عليه فأخذ ماله، وعدا عليه بسيفِه فضربه، ولا يُريدُ عَدْواً على الرّجلينِ، ولكنْ من الظّلم.
__________
(1) الأنعام 108.
(2) اللسان (عدا) .
(2/213)
________________________________________
وتقول: عَدَتُ عوادٍ بيننا وخُطُوب، وكذلك عادت، ولا يُجْعَلُ مصدره في هذا المعنى: معاداة، ولكن يقال: عدى مخافةَ الإلتباس. وتقول: كُفَّ عنّي يا فلانُ عاديتَكَ، وعادية شرّك، وهو ما عَداك من قِبَلِهِ من المكروه. والعاديةُ: الخيلُ المغيرة. والعادية: شُغْلٌ من أشغال الدّهر تَعْدوك عن أمورك. أي: تشغلك. عداني عنك أمر كذا يعدوني عداءً، أي: شَغَلني. قال:
وعادك أن تلاقيها العداء
أي: شغلك. ويقولون: عادك معناه: عداك، فحذف الألف أمام الدال، ويقال: أراد: عاودك. قال «3» :
إنّي عداني أن أزورميا ... صهب تغالى فوق نيّ نيّا
والعَداءُ والعِداءُ لغتان: الطَّلْقُ الواحد، وهو أن يعادي الفرس أو الصيّاد بين صيدين ويصرع أحدهما على أثر الآخر، قال «4» :
فعادَى عِداءً بين ثَوْرٍ ونَعْجَةٍ
وقال «5» :
يَصْرَعُ الخَمْسَ عَداءً في طَلَقْ
يعني يصرع الفرس، فمن فتح العين قال: جاوز هذا إلى ذاك، ومن كسر العين قال: يعادي الصيد، من العَدْو. والعَداء: طَوارُ الشيء. تقول: لَزِمتُ عَداء النّهر، وعَداءَ الطريق والجبل، أي: طواره.
__________
(3) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(4) (امرؤ القيس) ديوانه ص 52، وعجز البيت:
وبين شبوب كالقضيمة قرهب
(5) الشطر في التهذيب 3/ 114 واللسان (عدا) غير منسوب، وفي الأصول منسوب إلى (رؤية) ، وليس له.
(2/214)
________________________________________
ويقال: الأكحل عرْقٌ عَداءَ السّاعد. وقد يقال: عِدْوة في معنى العَداء، وعِدْو في معناها بغير هاء، ويجمع [على أفعال فيقال] أعداء النهر، وأعداء الطريق. والتَّعداء: التَّفعال من كلّ ما مرَّ جائز. قال ذو الرّمة «6» :
مِنْها على عُدْوَاءِ النَّأيِ تَسْتقيمُ
والعِنْدَأْوَة: التواءٌ وعَسَرٌ [في الرِّجْلِ] «7» . قال بعضهم: هو من العَداءِ، والنون والهمزة زائدتان، ويقال: هو بناء على فِنْعالة، وليس في كلام العرب كلمة تدخل العين والهمزة في أصل بنائها إلاّ في هذه الكلمات: عِنْدأْوة وإمَّعة وعَباء، وعَفاء وعَماء، فأمّا عَظاءة فهي لغة في عَظاية، وإن جاء منه شيء فلا يجوز إلاّ بفصل لازم بين العين والهمزة. ويقال: عِنْدَأوة: فِعْلَلْوة، والأصلُ أُمِيتَ فِعْلُهُ، لا يُدرى أمن عَنْدَى يُعْنَدي أم عدا يعدو، فلذلك اختلف فيه. وعدّى تَعْدِيَةً، أي: جاوز إلى غيره. عدّيتُ عنّي الهمَّ، أي: نحّيتُه. وتقول للنّازل عليك: عدِّ عنّي إلى غيري. وعَدِّ عن هذا الأمر، أي: دعْهُ وخذ في غيره. قال النّابغة «8» :
فعدِّ عمّا تَرَى إذ لا ارتجاعَ لَهُ ... وانْمِ القُتُودَ على عَيْرانَةٍ أُجُدِ
وتعدّيتُ المفازَةَ، أي: جاوزتُها إلى غيرها. وتقول للفعل المجاوِزِ: يتعدّى إلى مفعولٍ بعد مفعول، والمجاوز مثل ضرب عمرو بكراً،
__________
(6) ديوانه 1/ 384 والرواية فيه (الدار) مكان (النأي) . وصدر البيت فيه:
هام الفؤاد لذكراها وخامره
(7) زيادة من التهذيب 3/ 118. لتوضيح المعنى.
(8) ديوانه ص 5.
(2/215)
________________________________________
والمتعدّي مثل: ظنّ عمرو بكراً خالداً. وعدّاه فاعله، وهو كلام عامّ في كل شيء. والعَدُوُّ: اسمٌ جامعٌ للواحد والجميع والتّثنية والتّأنيث والتّذكير، تقول: هو لك عدوٌّ، وهي وهما وهم وهنَّ لك عدوٌّ، فإذا جعلته نعتاً قلت: الرّجلانِ عدوّاك، والرّجالُ أعداؤك. والمرأتان عدوتاك، والنسوة عداوتك، ويجمع العدوّ على الأعداء والعِدَى والعُدَى والعُداة والأعادي. [وتجمع العَدوّة على] عَدَايا. وعدْوانُ حيّ من قيس، قال «9» :
عَذيرَ الحيِّ من عدوان ... كانوا حَيَّةَ الأرْضِ
والعَدَوان: الفَرس الكثير العَدْوِ. والعَدَوان: الذّئب الذي يعدو على النّاس كلّ ساعة، قال يصف ذئباً قد آذاه ثمّ قتله بعد ذلك «10» :
تذكرُ إذْ أنت شديدُ القَفْز ... نَهْد القصيرَى عَدَوان الجمز
والعداوء: أرضٌ يابسةُ صُلْبة، وربما جاءت في جوف البئر إذا حُفِرَت، وربّما كانت حجراً حتى يحيد عنها الحفّار بعضَ الحَيْد. قال العجّاج يصفُ الثّور وحَفْرَهُ الكِنَاسَ «11» :
وإن أصاب عُدَوَاءَ احْرَوْرَفا ... عنها وولاّها الظُّلوفَ الظُّلَّفا
والعُدوة: صلابة من شاطىء الوادي، ويقال: عِدوة، ويقرأ: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا بالكسر والضم.
__________
(9) (ذو الإصبع العدواني) - الكتاب 1/ 390. ديوانه 46.
(10) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز في غير الأصول.
(11) ديوانه ص 500.
(2/216)
________________________________________
عَدّي: فَعيلٌ من بنات الواو، والنسبة: عَدَوِيّ، ردّوا الواو كما يقولون: عَلَوِيّ في النسبة إلى عَلِيّ. والعَدَويّة من نَباتِ الصّيف بعد ذهاب الرّبيع يَخْضرُّ صغار الشّجر فترعاه الإبلُ. والعَدَويَّة: من صغارِ سِخال الغَنَم، يقال: هي بناتُ أربعينَ يوماً فإذا جُزَّتْ عنها عقيقتُها ذَهَبَ عنها هذا الاسم. ومَعْدي كرب، مَنْ جَعَلَهُ مَفْعِلاً فإنّه يكون له مخرجٌ من الواو والياء جميعاً، ولكنّهم جعلوا اسمين اسماً واحداً فصار الإعرابُ على الباء وسكّنوا ياء مَعْدِي لتحرُّكِ الدّال، ولو كانت الدّال ساكنة لنصبوا الياء، وكذلك كلُّ اسمينِ جعلا اسماً واحداً، كقول الشاعر «12» :
... عرّدت ... بأبي نَعَامَةَ أمُّ رَأْلٍ خَيْفَقُ
عود: العَوْدُ: تثنيةُ الأمرِ عَوْداً بَعْدَ بَدْءٍ، بدأ ثم عاد. والعَوْدَةُ مرّة واحدة،
كما يقول: ملك الموت لأهل الميّت: إنّ لي فيكم عَوْدة ثمّ عَوْدة حتّى لا يبقى منكم أحد.
وتقول: عاد فلانٌ علينا معروفُه إذا أحسن ثمّ زاد قال «13» :
قد أحْسَنَ سعدٌ في الذي كان بيننا ... فإنْ عادَ بالإحْسانِ فالعَوْدُ أحمدُ
وقول معاوية: لقد متّتْ برحِمٍ عَوْدة. يعني: قديمة. قد عَوَّدَتْ، أي: قَدُمَتْ، فصارت كالعَوْدِ القديم من الإبل.
__________
(12) لسان العرب (عرد) غير منسوب، وصدر البيت:
لما استباحوا عبد رب عردت
(13) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(2/217)
________________________________________
وفلان في مَعادة، أي: مُصيبة، يغشاه النّاس في مناوِح، ومثله: المَعاوِد: والمَعاوِد المآتم. والحجّ مَعادُ الحاجّ إذا ثنّوا يقولون في الدّعاء:
اللهمَّ ارزُقنا إلى البيتِ مَعاداً أو عَوْداً.
وقوله لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ «14» يعني مكّة، عِدَةً للنبيّ صلى الله عليه وآله أن يَفْتحها ويَعودَ «15» إليها. ورأيت فلانا ما يبدىء وما يُعيد، أي: ما يتكلّم بباديةٍ ولا عاديةٍ. قال عبيد بن الأبرص «16» :
أقفر من أهله عبيد ... فاليوم لا يبدي ولا يُعِيدُ
والعادةُ: الدُّرْبة في الشيء، وهو أن يتمادى في الأمر حتّى يصيرَ له سجيّة. ويقال للرَّجُل المواظب في الأمر: مُعاوِد. في كلامِ بَعْضِهِم: الْزَموا تُقى الله واستعيدوها، أي: تعوّدوها، ويقال: معنى تَعَوَّدَ: أعاد. قال الرّاجز «17» :
لا تَستطيعُ جَرَّه الغَوامِضُ ... إلاّ المُعِيداتُ بهِ النّواهِضُ
يعني: النّوق التي استعادتِ النَّهْضَ بالدّلو. ويقال للشّجاع: بطلٌ مُعاوِدٌ، أي: قد عاوَدَ الحربَ مرَّةً بعد مرّةٍ. وهو معيدٌ لهذا الشيء أي: مُطيقٌ له، قد اعتاده. والرّجال عُوّاد المريض، والنّساء عُوَّد، ولا يُقال: عُوّاد. واللهُ العَوَّادُ بالمغفرة، والعبد العَوَّاد بالذّنوب.. والعَوْدُ: الجَمَلُ المُسِنّ وفيه سَورة،
__________
(14) القصص 85.
(15) هذا من (س) .. (ص) و (ط) : حتى يعود.
(16) ديوانه 45.
(17) المحكم 2/ 232، واللسان (عود) غير منسوب فيهما أيضا.
(2/218)
________________________________________
أي بقيّة، ويجمع: عِوَدة، وعِيَدة لغة، وعوّد تعويداً بلغ ذلك الوقت، قال «18» :
لا بُدَّ من صَنْعا وإنْ طال السَّفَرْ ... وإنْ تحنّى كلّ عَوْدٍ وانْعقَرْ
والعَوْدُ: الطّريقُ القديم. قال «19» : عَوْدٌ على عَوْدٍ لأقْوامٍ أُوَل يريد: جمل على طريقٍ قديم. والعَوْدُ: يوصف به السُّودَدُ القديم. قال الطرماح «20» :
هل المجدُ إلاّ السُّودَدُ العَوْدُ والنَّدَى ... ورَأْبُ الثَّأَى والصّبرُ عندَ المُواطِن
والعُوْدُ: الخشبةُ المُطَرّاة يدخن به. والعُودُ: ذو الأوتار الذي يضرب به، والجميع من ذلك كلّه: العِيدان، وثلاثة أعواد، والعَوَّادُ: متّخذُ العِيدان. والعِيدُ: كلُّ يومِ مَجْمَعٍ، من عاد يعود إليه، ويقال: بل سُمِّيَ لأنّهم اعتادوه. والياءُ في العيد أصلها الواو قُلبت لِكَسْرَةِ العَيْن. قال العجاج يصف الثور الوحشيّ ينتابُ الكِناس «21» :
يَعْتاد أرباضاً لها آريُّ ... كما يَعودُ العيدَ نَصْرانيُّ
وإذا جمعوه قالوا: أعْياد، وإذا صغّروه قالوا: عُيَيْد، وتركوه على التّغيير. والعِيدُ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّث. والعائدة: الصّلة والمعروف، والجميع:
__________
(18) الشطر الأول في المخصص 15/ 111 واللسان (صنع) والشطر الثاني في التصريح على التوضيح 2/ 293 والرواية فيه (ودبر) .
(19) المحكم 2/ 233 غير منسوب أيضا، ونسب في اللسان (عود) إلى بشير بن النكث.
(20) ديوانه ص 516 والرواية فيه (اللها) مكان (الندى) .
(21) ديوانه 322 والرواية فيه (واعتاد) مكان (يعتاد) .
(2/219)
________________________________________
عوائد. وتقول: هذا الأمر أَعْوَد عليك من غيره. أي: أرفقُ بك من غيره. وفَحْلٌ مُعيدٌ: مُعتادٌ للضِراب. وعوّدتُه فتعوَّد. قال عنترة يَصِفُ ظليماً يَعْتادُ بيضَه كلَّ ساعة «22» :
صَعْلٍ يَعودُ بذْي العُشَيْرَةِ بيضَهُ ... كالعَبْد ذي الفَرْوِ الطويلِ الأصْلَمِ
والعِيدِيّةُ: نجائبُ منسوبة إلى عاد بن سام بن نوح عليه السّلام، وقبيلته سُمّيت به. وأمّا عاديّ بن عاديّ فيقال: ملك ألف سنة، وهزم ألف جيش وافتضّ ألفَ عذراءَ، ووجد قبيل الإسلام على سريرٍ في خرقٍ تحتَ صخرةٍ مكتوبٍ عليها على طَرَفِ السّرير قِصَّتُه «23» . قال زهير «24» :
ألم تَرَ أنّ اللهَ أَهْلَكَ تُبّعاً ... وأَهْلَكَ لُقمانَ بن عادٍ وعادِيا
وأمّا عادٌ الآخرة فيقال إنّهم بنو تميم ينزلون رمالَ عالِجٍ، وهم الذين عَصَوا الله فمسخهم نسناساً لكلّ إنسان منهم يدٌ ورجلٌ من شِقٍّ ينقز نقز الظّبْي. فأمّا المسخُ فقد انقرضوا، وأمّا الشَّبُه الذي مُسِخوا عليه فهو على حاله «25» . ويقال للشيء القديم: عاديّ يُنْسَبُ إلى عادٍ لقِدَمِهِ. قال «26» :
عادِيّة ما حُفِرَتْ بعدَ إرَمْ ... قام عليها فتيةٌ سود اللمم
__________
(22) ديوانه ص 21 وهو من معلقته.
(23) أكبر الظن أن المحصور بين أقواس التنصيص ليس من كلام الخليل. ولكنه من زيادات النساخ.
(24) ديوانه ص 288.
(25) أكبر الظن أن المحصور بين أقواس التنصيص ليس من كلام الخليل. ولكنه من زيادات النساخ.
(26) لم نهتد إلى الراجز، ولا إلى الرجز فيما بين أيدينا من مظان.
(2/220)
________________________________________
دعو: الدِّعْوَةُ: ادّعاء الولد الدّعيّ غير أبيه، ويدّعيه غير أبيه. قال «27» :
ودِعْوَة هاربٍ من لُؤْمِ أصلٍ ... إلى فحْلٍ لغير أبيه حوب
يقال: دَعيٌّ بيّنُ الدِّعْوَة. والادّعاء في الحرب: الاعتزاء. ومِنْه التّداعي، تقول: إليّ أنا فُلان.. والادعاء في الحرب أيضاً أنْ تقولَ يال فلان. والادّعاء أن تدّعي حقًّا لك ولغيرك، يقال: ادّعَى حقًّا أو باطلاً. والتّداعي: أن يدعوَ القومُ بعضُهم بعضاً.
وفي الحديث: دع داعيةَ اللّبنِ «28»
يعني إذا حلبت فدعْ في الضّرع بقيّةً من اللّبن. والدّاعيةُ: صريخ الخَيْلِ في الحروب. أجيبوا داعيةَ الخيل. والنّادبة تدعو الميت إذا نَدَبتْهُ. وتقول: دعا الله فلاناً بما يكره، أي: أنزل به ذلك. قال «29» :
دعاكَ اللهُ من قَيْسٍ بأفعَى ... إذا نام العيونُ سرتْ عليكا
وقوله عز وجل: تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى «30» ، يقال: ليس هو كالدّعاء، ولكنّ دعوتَها إيّاهم: ما تَفْعَلُ بهم من الأفاعيل، يعني نار جهنّم. ويقال: تداعَى عليهم العدوُّ من كلّ جانبٍ: [أَقْبَل] . وتداعَتِ الحيطانُ إذا انقاضَّتْ وتَفَرَّزَتْ. وداعَيْنا عليهم الحيطانَ من جوانبها، أي: هدمناها عليهم.
__________
(27) لم نهتد إلى القائل.
(28) التهذيب 3/ 121.
(29) المحكم 2/ 235، واللسان (دعا) . في الأصول: (فيش) مكان (قيس) .
(30) المعارج 17.
(2/221)
________________________________________
ودواعي الدّهر: صُروفُهُ. وفي هذا الأمر دعاؤه، أي: دعوى قسحة. وفلانٌ في مَدْعاة إذا دُعيَ إلى الطّعام. وتقول: دعا دُعاءً، وفلانٌ داعي قومٍ وداعية قومٍ: يدعو إلى بيعتهم دعوة. والجميعُ: دُعاةٌ.
وعد: [الوَعْدُ والعِدَةُ يكونان مصدراً واسماً. فأمّا العِدَةُ فتُجْمع: عِدات، والوعد لا يجمع] «31» . والموعِدُ: موضع التّواعُدِ وهو الميعادُ. والمَوْعِدُ مصدرُ وَعَدْتُهُ، وقد يكون الموعِدُ وقتاً للعدة «32»
، والموعدة: اسم للعدة. قال جرير «33» :
تُعَلِّلُنا أُمامةُ بالعِداتِ ... وما تَشْفي القُلوبَ الصّادياتِ
والميعاد لا يكون إلاّ وقتاً أو موضعاً. والوعيد من التّهدّد. أوعدته ضرباً ونحوه، ويكون وعدته أيضاً من الشّرّ. قال الله عزّ وجلّ: النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا «34» . ووعيد الفحل إذا همّ أن يصول. قال أبو النجم:
يرعد أن يوعدَ قلب الأعزل
ودع: الوَدْعُ والوَدْعَةُ الواحدة: مناقفُ صغار تخرج من البحر يزيّن به العثاكل، وهي بيضاء. في بطنها مَشْقٌ كشقِّ النواة، وهي جوف، في جوفها دُوَيْبة كالحَلَمة. قال ذو الرّمة «35» :
كأنّ آرامها والشّمسُ ماتعةٌ ... وَدْعٌ بأرجائِهِ فذ ومنظوم
__________
(31) نص من العين حفظه الأزهري في التهذيب 3/ 133، وسقط من الأصول.
(32) في الأصول: للحين، وما أثبتناه فمن التهذيب 3/ 134 عن العين.
(33) ديوانه 69.
(34) الحج 72.
(35) ديوانه 1/ 416، والرواية فيه (أدمانها) مكان آرامها) ، و (فض) مكان (فذ) .
(2/222)
________________________________________
والدَّعَةُ: الخفض في العيش والرّاحة. رجُلٌ مُتَّدع: صاحب دَعَةٍ وراحة. ونال فلان من المكارم وادعاً، أي: من غير أن تكلّف من نفسه مشقّة. يقال وَدُعَ يَوْدُعُ دَعَةً، واتَّدع تُدَعَة مثل اتَّهم تُهَمَة واتَّأد تُؤَدَة. قال «36» :
يا رُبَّ هيجا هي خيرٌ من دَعَه
والتَّوديعُ: أن تودّع ثوباً في صوان، أي في موضع لا تصل إليه ريح، ولا غبار. والمِيدَعُ: ثوب يُجْعل وقايةً لغيره، ويوصف به الثّوبُ المبتذَلُ أيضاً الذي يصان فيه، فيقال: ثوبٌ مِيدَعٌ، قال «37» :
طرحتُ أثوابيَ إلا الميدعا
والوداع: توديعُك أخاك في المسير. والوَداعُ: التَّرْك والقِلَى، وهو توديعُ الفِراق، والمصدر من كلٍّ: توديع قال «38» :
غداة غدٍ تودّع كلّ عين ... بها كُحُلٌ وكلّ يدٍ خضيبِ
وقوله تعالى: ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى
«39» أي: ما تَرَكَكَ. والمودوعُ: المودَّع. قال «40» :
إذا رأيت الغرب المودوعا
__________
(36) (لبيد) - ديوانه 340.
(37) لم نقف عليه.
(38) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(39) الضحى 3.
(40) لم نهتد إليه.
(2/223)
________________________________________
والعرب لا تقول: وَدَعتُهُ فأنا وادع. في معنى تركتُه فأنا تارك. ولكنّهم يقولون في الغابر: لم يدع، وفي الأمر: دعْه، وفي النّهي: لا تدعه، إلاّ أن يُضطّر الشّاعرُ، كما قال «40» :
وكانَ ما قدّموا لأنفُسِهِمْ ... أكْثَرَ نفعاً منَ الّذي وَدَعُوا
أي تركوا ... وقال الفرزدق «41» :
وعضّ زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحت أو مجلف
فمن قال: لم يدع، تفسيره، لم يترك، فإنّه يضمر في المسحت والمجلف ما يرفعه مثل الذي ونحوه، ومن روى: لم يُدَعْ في معنى: لم يُتْرَكُ فسبيلُه الرّفعُ بلا علّة، كقولك: لم يُضْرَبْ إلاّ زيدٌ، وكان قياسُه: لم يُودَعْ ولكنّ العربَ اجتمعتْ على حذف الواو فقالتْ: يَدَع، ولكنّكَ إذا جَهِلْتَ الفاعل تقول: لم يُودَعْ ولم يُوذَرْ وكذلك جميعُ ما كانَ مِثلَ يودع وجميع هذا الحدّ على ذلك. إلاّ أنّ العرب استخفّت في هذين الفعلين خاصّة لما دخل عليهما من العلّة التي وصفنا فقالوا: لم يُدَعْ ولم يُذَرْ في لغة، وسمعنا من فصحاء العرب من يقول: لم أُدَعْ وراءً، ولم أُذَرْ وراءً. والمُوادَعَةُ: شِبْهُ المُصالَحَة، وكذلك التَّوادُعْ. والوَديعةُ: ما تستودعه غيرَك ليحفظَه، وإذا قلت: أَوْدَعَ فلانٌ فلاناً شيئاً فمعناه: تحويل الوديعة إلى غيره:
وفي الحديث: ما تَقولُ في رجلٍ استُودِعَ وديعةً فأودَعَها غيرَه قال: عليه الضّمان.
وقول الله عزّ وجلّ: فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ «42» . يُقال: المستودَع: ما في الأرحام.
__________
(40) المحكم 2/ 238 واللسان والتاج، غير منسوب أيضا.
(41) ليس في ديوانه (صادر) . وهو في نزهة الألباء ص 20 (أبو الفضل) .
(42) الأنعام 98.
(2/224)
________________________________________
ووَدْعان: موضعٌ بالبادية. وإذا أمرت بالسكينةِ والوَداع قلت: تَوَدَّعْ، واتدع. ويقال: عليك بالمودوع من غير أن تجعلَ له فِعلاً ولا فاعلاً على جهةِ لفظِه، إنّما هو كقولك: المعسور والميسور، لا تقول: منه عسرت ولا يسرت. ووَدُعَ الرّجُلُ يَوْدُع وداعةً، وهو وادعٌ، أي: ساكن. والوَديعُ: الرَّجُلْ الساكن الهادىء ذو التَّدعة. ويقال: ذو وَداعةٍ. ووَدَاعة: من أسماء الرجال. والأودعُ: اسم من أسماء اليربوع.
يدع: الأَيْدَع: صبغ أحمر، وهو خشب البَقَّم. تقول: يَدَّعتُه [وأنا أُيَدِّعُهُ] «44» تَيْديعاً قال «45» :
فنحا لها بمُذَلَّقَيْنِ كأنّما ... بهما من النَّضْحِ المُجَدَّحِ أَيْدَعُ
__________
(44) زيادة من التهذيب 3/ 142 عن العين.
(45) (أبو ذؤيب) ديوان الهذليين 1/ 13.
(2/225)
________________________________________
باب العين والتاء و (واي) معهما ع ت و، ت وع، ت ي ع، تستعمل فقط
عتو: عتا عُتُوّاً وعِتِيّاً إذا استكبر فهو عاتٍ، والملك الجبار عاتٍ، وجبابرة عتاة. وتَعَتَّى فلانٌ، وتَعَتَّتْ فُلانة إذا لم تُطِعْ. قال العجاج «1» :
بأمره الأرض فما تعتَّتِ
أي: فما عَصَتْ «2»
توع: التَّوْعُ: كسرك لبا أو سمناً بكسرة خبز ترفعه بها. تقول: تُعْتُه فأنا أتوعُه توعاً.
تيع: التَّيْعُ: ما يسيل على الأرض من جمد إذا ذاب، ونحوه. وتاعَ الماء تيعا إذا تتيع على وجه الأرض، أي: انبسط في المكان الواسع فهو تائع
__________
(1) ديوانه 266 والرواية فيه: بإذنه الأرض وما تعتت
(2) جاء في النسخ بعد قوله: (فما عصت) ما يأتي: وتهته في الأمر إذا تعمق فيه قال: [والقائل (رؤبة) - ديوانه 165] :
بعد لَجَاجٍ لا يكادُ يَنْتَهي ... عَنِ التَّصابي وعن التعته
فحذفناه لأنه لا صلة له بهذا الباب إنما هو من باب العين والهاء والتاء معهما، وقد مر بنا في بابه ص 104 من الجزء الأول وما نظنه إلا من وهم النساخ.
(2/226)
________________________________________
مائِع. والرّجُلُ يَتَتَايَعُ في الأمر إذا بقي فيه. والبعير يَتَتايَعُ في مشيه إذا حرّك ألواحه حتى يكاد يتفكّكُ. والسكران يتتايع: يرمي بنفسه إذا لجّ وتهافت. والتَّتايُعْ: رميُك بنفسك في الشيء من غير ثبت. والتَّتَيُّعُ: القيء، وهو مُتَتَيِّعٌ. وقد تاع، إذا قاء، وأتاعه غيره، أي: قيّأه.
(2/227)
________________________________________
باب العين والظاء و (واي) معهما ع ظ ي، وع ظ، مستعملان
عظي: العَظايَةُ على خلقة سام أبرص، أو أُعَيظِم منهُ شيئاً، والذّكر يقال له اللحم غير أنه إذا لم تَرَ قوائمها ظَنَنْتَ أن رأسها رأسُ حيّةٍ. وتجمع: عَظاء، وثلاث عَظايات، والعَظاءَةُ: لغة فيها.
وعظ: العِظَةُ: الموعظة. وَعَظْتُ الرّجلَ أَعِظُهُ عِظَةً وموعظة: واتَّعَظَ: تقبّل العِظَةَ، وهو تذكيرُك إيّاه الخيرَ ونحوَه ممّا يرقُّ له قلبُهُ. ومن أمثالِهم المعروفة: لا تَعِظيني وتَعَظْعَظي، أي: اتَّعظي أنتِ ودَعي موعظتي.
(2/228)
________________________________________
باب العين والذال و (واي) معهما ع ذ ي، ع وذ، ذ ي ع مستعملات
عذي: العِذْيُ: موضع بالبادية. والعَذَاةُ: الأرضُ الطيّبةُ التربةِ الكريمةُ المنْبِتِ. قال «1» :
بأرضٍ هجان الترب وسمية الثرى ... عَذاةٍ نَأَتْ عنها المُلوحَةُ والبَحْرُ
والعِذْيُ: اسمٌ للموضِعِ الذي ينبت في الشّتاء والصّيف من غير سقيٍ. ويقال: العِذْيُ: الزّرع الذي لا يُسقَى إلاّ من المطر لبعده من المياه، الواحدة،: عَذاة. ويقال: العِذْي واحد وجمعُهُ: أَعْذاء.
عوذ: أعوذ بالله، أي: ألجأ إلى الله، عَوْذاً وعِياذا. ومعاذَ الله: معناه: أعوذُ بالله، ومنه: العَوْذَةُ، والتّعويذ. والمعاذة الّتي يُعَوَّذُ بها الإنسان من فَزَعٍ أو جُنون. وكلّ أنثى عائِذٌ إذا وضعت مدّة سبعةِ أيّامٍ، والجميع: عُوذ، من قَول لبيد «2» :
__________
(1) (ذو الرمة) - 1/ 575.
(2) ديوانه ص 299 وصدر البيت فيه:
والعين ساكنة على أطلائها
(2/229)
________________________________________
عُوذاً تَأَجَّلَ بالفَضاءِ بِهامُها
ذيع: الذَّيْعُ: إشاعةُ الأمر. أذعته فذاع. ورجل مِذياع مِشياعٌ لا يستطيع كتمانَ شيءٍ وقوم مذاييع، وأذعت به، الباء دخيل،! معناه: أذعته.
(2/230)
________________________________________
باب العين والثاء و (واي) معهما ع ث و، ع ث ي، وع ث، ع ي ث مستعملات
عثو: العَثا: لون إلى السّواد [مع كثرة شعر] «1» . والأَعْثَى: الكثير الشّعر. والأَعْثَى: الضبع الكبير، والأنثى: عَثْواء، وفي لغة: عثياء والواو أصوب. والجميعُ: العُثْوُ، ويقال: العُثْيُ، والعِثْيانُ: اسم الذَّكر من الضِّباع.
عثي: عَثِيَ يَعْثَى في الأرض عِثيّاً وعَثَياناً: أفسد.
وعث: الوَعْثُ من الرّمل: ما غابتْ فيه القوائمُ. ومنه اشتُقَّ وَعْثاء السَّفَر، يعني: المشقّة. وأَوْعَثَ القومُ: وقعوا في الوَعْثِ. قال «2» :
وَعْثاً وُعُوراً وقِفافاً كُبَّسا
عيث: عاثَ يَعيثُ عيثاً، أي: أَسْرَعَ في الفسادِ. تقول: إنّك لأَعْيَثُ في المال
__________
(1) زيادة من المحكم لتوضيح الترجمة.
(2) (العجاح) ديوانه 128.
(2/231)
________________________________________
من السّوس في الصَّيف. والذِّئْبُ يعيث في الغنم فلا يأخذ شيئاً إلاّ قتله. قال «3» :
والذّئبُ وسْطَ غنَمي يَعيثُ
والتَّعيِيثُ: طلبُ الأعمى الشَّيء، وطلبُ الرّجُلِ الشّيء في الظُّلْمة. والتَّعييثُ: إدخالُ الرّجلِ يدَهُ في الكنانةِ يَطْلُبُ سَهماً. قال أبو ذويب «4» :
فَعَيَّثَ في الكِنانَةِ يَرْجِعُ
__________
(3) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(4) ديوان الهذليين 1/ 9 والبيت هو:
فبدا له أقراب هذا رائغا ... عجلا فَعَيَّثَ في الكِنانَةِ يَرْجِعُ
(2/232)
________________________________________
باب العين والرّاء والواو معهما ع ر و، ع ر ي، ع ور، ع ي ر، ر ع و، ر ع ي، وع ر، ر وع، ر ي ع، ور ع، ي ع ر
عرو: عري: عراه أمرٌ يَعْرُوه عَرْواً إذا غشيه وأصابه، يقال: عراه البرد، وعَرَتْهُ الحُمَّى، وهي تَعْروه إذا جاءته بنافض، وأخذته الحُمَّى بعُرَوائها. وعُرِيَ الرّجلُ فهو مَعْروّ، واعتراه الهمّ. عام في كل شيء، حتى يقال: الدّلف يعتري الملاحة.
ويقال: ما مِنْ مؤمنٍ إلا وله ذَنْبٌ يعتريه
قال أعرابيّ إذا طلع السّماك فعند ذلك يعروك ما عداك من البرد الذي يغشاك. وعَرِيَ فلانٌ عِرْوَةً وعِرْيَةً شديدة وعُرْيا فهو عُريانٌ والمرأة عُريانة، ورجل عارٍ وامرأة عارية. والعُريان من الخيل: فرس مقلّص طويل القوائم. والعُريان من الرّمل ما ليس عليه شجر. وفرسٌ عُرْيٌ: ليس على ظهره شيءٌ، وأفراس أَعْراء، ولا يقال: رجلٌ عُرْيٌ، واعْرَوْرَيْتُ الفَرَسَ: ركبته عُرْياً، ولم يجىء افعوعل مجاوز غير هذا. والعَراء: الأرضُ الفضاءُ التي لا يُسْتَتَرُ فيها بشيء، ويجمع: أَعْراء، وثلاثة أَعْرِيَةٍ والعرب تُذكّره فتقول: انتهينا إلى عَراءٍ من الأرضِ واسعٍ
(2/233)
________________________________________
باردٍ، ولا يُجْعَلُ نعتاً للأرض. وأعراءُ الأرض: ما ظهر من مُتُونها. قال «1» :
وبلدٍ عاريةٍ أَعْراؤُهُ
وقال «2» :
أو مُجْنَ عنه عُرِيَتْ أَعْراؤُهُ
واعْرَوْرَى السّرابُ ظهورَ الآكامِ إذا ماج عنها فأعراها. ماج عنها: ذهب عنها، ويقال: بل إذا علا ظهورها. والعَراءُ: كلّ شيء أَعْرَيْتَهُ من سُتْرته، تقول: استُرْهُ من العَراء، ويُقال: لا يُعَرَّى فلانٌ من هذا الأمر أي: لا يُخَلَّصُ، ولا يُعَرَّى من الموت أحدٌ، أي: لا يُخَلَّص. قال «3» :
وأحْداثُ دهرٍ ما يُعَرَّى بَلاؤُها
والعَرِىّ: الريح الباردة. [يقال] : ريحٌ عَرِيَّةٌ، ومساءٌ عَرِيٌّ، وليلةٌ عريّة ذات ريح باردة قال ذو الرمة «4» :
وهل أحطِبَنَّ القوم وهي عريَّةٌ ... أصول ألاءٍ في ثَرَى عمدٍ جَعْدِ
والعُرْوةُ: عروةُ الدلو وعروة المزادة وعروة الكوز. والجمع: عُرَى. والنّخلة العريّة: التي عُزِلَتْ عن المساومة لحرمة أو لِهِبَةٍ إذا أينع ثمر النَّخل، ويجمع: عَرايا.
وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخّص في العَرايا «5» .
وعرّيت الشيء: اتخذت له عروة كالدلو ونحوه.
__________
(1) التهذيب 3/ 159 واللسان (عرا) غير منسوب أيضا.
(2) اللسان (عرا) غير منسوب أيضا. وفي (س) : أو لجن. وفي اللسان: أو مجز.
(3) لم نهتد إليه.
(4) ليس في ديوانه، ولم نقف عليه فيما بين أيدينا من مصادر.
(5) التهذيب 3/ 155.
(2/234)
________________________________________
وجارية حسنة المُعَرَّى، أي: [حسنة عند تجريدها من ثيابها] «6» والجميع: المعاري: والمعاري مبادىء رءوس العظام حيث تعرّى العظام عن اللحم. ويُقال: المعاري: اليدان والرجلان والوجه لأنّه بادٍ أبداً. قال أبو كبير الهُذَليّ يصف قوماً ضربوا على أيديهم وأرجلهم حتى سقطوا «7» :
متكوّرين على المعاري بينهم ... ضرب كتعطاط المزَاد الأنجل
والعُرْوَةُ من النّبات: ما تبقَى له خُضْرةٌ في الشتاء تتعلّقُ بها الإبلُ حتى تُدْرِكَ الرّبيعَ. وهي العُلْقَة. قال «8» :
خَلَعَ الملوكَ وآب تحتَ لوائِهِ ... شَجَرُ العُرَى وعُراعِرُ الأقوام
ويقال: العُرْوة: الشّجر الملتفّ الذي تَشْتُو فيه الإبلْ فتأكل منه، وتبرك في أَذْرائه.
عور: عير: عارتِ العَيْنُ تَعار عَوَاراً، وعَوِرَتْ أيضاً، واعْوَرَّتْ. يعني ذهاب البصر [منها] . قال «9» :
ورُبّة سائلٍ عنّي حفيٍّ ... أعارت عينه أم لم تعارا
والعُوَّارُ: ضربٌ من الخطاطيف، أسود طويل الجناحين.
__________
(6) من التهذيب 3/ 160 عن العين. أما عبارة النسخ فمضطربة.
(7) ديوان الهذليين 2/ 96.
(8) (المهلهل) التهذيب 3/ 159. المحكم 2/ 244.
(9) التهذيب 3/ 170 غير منسوب أيضا، ونسب ابن بري فيما يروي اللسان (عور) إلى (عمرو بن أحمر الباهلي) .
(2/235)
________________________________________
والعُوَّارُ: الرّجُلُ الجبانُ السّريعُ الفِرار، وجمعُه عواوير. قال «10» :
غيرُ ميلٍ ولا عواويرَ في الهيجا ... ولا عُزَّلٍ ولا أكْفالِ
والعرب تُسمّي الغُرابَ أعور، وتصيح به فتقول: عوير عوير. قال «11» :
يطير عُوَيْر أن أنوّه باسمه ... عُوَيْر............... .....
وسمّي أعور لحدّة بصره، كما يكنّى الأَعْمَى بالبصير، ويقال: بل سمّي [أعور] لأنّ حدقته سوداء. قال «12» :
وصحاحُ العيونِ يُدْعَوْنَ عُورا
ويقال: انظر إلى عينه العَوْراء، ولا يقال: العمياء، لأنّ العَوَرَ لا يكون إلاّ في إحدى العينين، يقال: اعورّت عينُه، ويخفف فيقال: عُوِرَتْ، ويقال: عُرْت عينه، وأعْوَرَ الله عَيْنَ فلان. والنعت: أَعْوَرُ وعَوْراءُ، والعَوْراء: الكلمة تَهْوِي في غيرِ عقلٍ ولا رُشْدٍ. قال «13» :
ولا تنطق العوراء في القومِ سادراً ... فإنّ لها فاعلمْ من الله واعيا
ويقال: العَوْراء: الكلمةُ القبيحةُ الّتي يمتعضُ منها الرجال ويَغضبون. قال كعب بن سعد الغنويّ «14» :
وعَوْراءَ قد قيلت فلم ألتفِتْ لها ... وما الكَلِمُ العُوْراُن لي بقتول
__________
(10) الأعشى- ديوانه ص 11.
(11) لم نهتد إليه.
(12) التهذيب 3/ 171 واللسان (عور) .
(13) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(14) لسان العرب (عور) ، المحكم 2/ 247 غير منسوب.
(2/236)
________________________________________
ودجلة العَوْراء بالعراق بمَيْسان. والعُوارُ: خَرْقٌ أو شَقٌّ يكون في الثَّوب. والعَوْرَة: سوءة الإنسان، وكلّ أمرٍ يُسْتَحْيَ منه فهو عَوْرة. قال «15» :
في أناسٍ حافظي عَوْراتِهم
وثلاثُ ساعاتٍ في الليلِ والنَّهارِ هنَّ عَوْراتٌ، أمَرَ الله الولدان والخدم ألا يدخلوا إلا بتسليم: ساعة قبلَ صلاةِ الفَجْر، وساعة عندَ نِصْفِ النَّهار، وساعة بعدَ صلاةِ العشاء الآخرة.
والعَوْرةُ في الثّغور والحروب والمساكن: خَلَلٌ يُتخوَّفُ منه القَتْل. وقوله عزّ وجلّ: إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ
«16» . أي: ليستْ بحريزة، ويقرأ عَوِرَة بمعناه. [ومن قرأ: عَوِرة. ذكّر وأنّث. ومن قرأ: عَوْرة قال في التّذكير والتّأنيث والجمع (عَوْرة) كالمصدر. كقولك: رجل صومٌ وامرأة صوم ونسوةٌ صَوْمٌ ورجالٌ صوم، وكذلك قياس العَوْرة: والعَوَرُ: تركُ الحقّ. قال العجاج «17» :
وَعَوَّرَ الرَّحمنُ مَنْ وَلَّى العَوَر
ويقال: تردُ على فلانٍ عائرة عين من المال وعائرة عينين، أي: ترد عليه إبلٌ كثيرة كأنّها من كثرتها تملأ العينين، حتى تكاد تَعُورها. وسلكت مفازة فما رأيت فيها عائِرَ عَيْنٍ، [أي: أحداً يَطْرِفُ العينَ فَيَعُوُرها] «18» . وعَوَّرَ عينَ الرَّكِيَّة [أَفْسَدها حتى نضبَ الماء] «19» .
__________
(15) لم نهتد إليه.
(16) الأحزاب 13.
(17) ديوانه ص 4.
(18) من المحكم 2/ 247 لتوضيح المعنى.
(19) كذلك.
(2/237)
________________________________________
وعُوَيْر: اسم موضعٍ بالبادية. وسَهْمٌ عائِرٌ: لا يُدرَى من أينَ أتَى «20» . والعَيْرُ: الحمار الأهليّ والوحشيّ. والجمع أعيار، والمعيوراء ممدوداً: جماعة من العَيْر، وثلاث كلمات جِئْنَ ممدوداتٍ: المعيوراء والمعلوجاء والمشيوخاء على مَفْعُولاء، ويقولون: مَشْيَخَة، أي مَفْعَلَة ولم يجمعوا مثل هذا. والعَيْر: العظم الباقي في وسط الكتف، والجميع: العِيَرة. وعَيْرُ النّعل: وسطه. قال «21» :
فصادف سَهمُه أحجارَ قُفٍّ ... كسرْنَ العَيْرَ منه والغِرارا
والعَيْرَ: جبلٌ بالمدينة. والعَيْرُ: اسم موضعٍ كان خِصباً فغيَّره الدهر فأقفره، وكانتِ العربُ تَستوحِشُهُ. قال «22» :
وواد كجوف العير قفر مَضِلّةٍ ... قطعت بسامٍ ساهمِ الوجْهِ حسّان
ولو رأيت في صخرة نتوء، حرفاً ناتئاً خلقةً كان ذلك عَيْراً له. والعِيارُ: فِعْلُ الفرسِ العائرِ، أو الكلبِ العائرِ عارَ يَعِيرُ عِياراً وهو ذهابه كأنّه مُنْفَلِتٌ من صاحبه. وقصيدة عائرة: سائرة. ويقال: ما قالت العرب بيتاً أَعْيَرَ من قول شاعر هذا البيت:
ومن يلقَ خيراً يحمَدِ الناسُ أمرَه ... ومن يغوِ لا يَعْدَمْ على الغي لائما
__________
(20) من قوله وقوله عز وجل إلى قوله من أين أتى من (س) أما (ص) و (ط) فقد سقط النص منهما.
(21) (الراعي) اللسان (عير) .
(22) (امرؤ القيس) - ديوانه ص 92، اللسان (عير) . والبيت في الأصول:
وواد كجوف العير قفر قطعته ... به الذئب يعوي كالخليع المعيل
ويبدو أنه ملفق، فليس في ديوانه من هذا البحر والروي مثل هذا البيت.
(2/238)
________________________________________
والعارُ: كلّ شيء لزم به سُبّة أو عَيْب. تقول: هو عليه عارٌ وشَنارٌ. والفعل: التّعيير، والله يُغَيِّر ولا يُعَيِّر. والعارِيَّةُ: ما استعرت من شيء، سمّيت به، لأنّها عارٌ على من طلبها، يقال: هم يتعاورون من جيرانِهم الماعُونَ والأمتعة. ويقال: العارِيَّة من المعاوَرَة والمناوَلَة. يتعاورون: يأخُذونَ ويُعطُون. قال ذو الرّمة «23» :
وسِقْطٍ كعَيْنِ الديك عاورت صحبتي ... أباها وهيّأنا لموقِعها وَكْرا
والعيار: ما عايرت به المكاييل. والعيار صحيح وافر تام. عايَرْتُه. أي: سوّيته عليه فهو المِعْيار والعيار. وعيّرتُ الدّنانيرَ تعييراً، إذا ألقيت ديناراً فتُوازِنُ به ديناراً ديناراً. والعِيار والمِعيار لا يقال إلا في الكَيْل والوَزْن. وتعاوَرَ القوم فلاناً فاعتوروه ضرباً، أي: تعاونوا فكلّما كفّ واحد ضرب الآخر، وهو عامّ في كلّ شيء. وتعاورتِ الرّياحُ رسماً حتى عفّته، أي: تواظبت عليه. قال «24» :
دِمنةٌ قفرة تعاورها الصيف ... بريحَيْن من صَباً وشمالِ
والعائر: غَمَصَةٌ تَمُضُّ العينَ كأنّما فيها قذى وهو العُوَّار. قالت الخنساء «25» :
قذًى بعينك أم بالعينِ عُوَّار
__________
(23) ديوانه 3/ 1426 والرواية فيه: عاورت صاحبي.
(24) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(25) ديوانها ص 47 وعجز البيت:
أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار
والبيت مطلع القصيدة.
(2/239)
________________________________________
وهي عائرة، أي ذات عُوَّار، ولا يقال في هذا المعنَى: عارتْ، إنّما هو كقولك: دارِعٌ ورامح، ولا يقال: دَرَعَ، ولا رَمَحَ. ويقال: العائرة: بَثْرَة في جفن العين الأسفل. ويقال: عارت عينه من حزن أو غيره، قال كثيّر:
بعينٍ مُعَنّاةٍ بعزّةَ لم يَزَلْ ... بها منذُ ما لم تلقَ عزّةَ عائرُ
رعو: رعي: ارْعَوَى فلانٌ عن الجهْلِ ارعِواءً حسناً، ورَعْوَى حسنة وهو نزوعه عن الجهل وحسن رجوعه. قال «26» :
إذا ارعَوى عاد إلى جهله ... كذي الضنى عاد إلى نكسه
ورعَى يرعَى رَعْياً. والرّعيُ: الكَلأ. والرّاعي يَرْعاها رعايةً إذا ساسَها وسَرَحَها. وكلُّ من وليَ من قومٍ أمراً فهو راعِيهم. والقوم رَعيّتُهُ. والرّاعي: السّائسُ، والمَرْعيُّ: المَسُوس. والجميع: الرِّعاء مهموز على فِعالٍ رواية عن العرب قد أجمَعَتْ عليه دونَ ما سواه. ويجوز على قياس أمثاله: راعٍ ورُعاة مثل داعٍ ودُعاة. قال «27» :
فليس فِعْلٌ مثلَ فعلي ولا المرعي ... في الأقْوامِ كالرّاعي
والإبل ترعى وترتعي.
__________
(26) لم نهتد إلى القائل.
(27) (أبو قيس الأسلت) . التهذيب 3/ 162 واللسان (رعي) والرواية فيهما: ليس قطا مثل قطي....
(2/240)
________________________________________
وراعيتُ أُراعي، معناه: نظرت إلى ما يصير [إليه] أمري. وفي معناه: يجوز: رعيت النجوم، قالت الخنساء «28» :
أرعَى النُّجومَ وما كُلِّفْتُ رِعْيَتَها ... وتارة أَتَغشَّى فَضْلَ أَطْماري
رعيت النّجومَ، أي: رَقَبْتُها، وفلان يَرْعَى فلاناً إذا تعاهد أمرَه. قال القطامي «29» :
ونحن رعية وهم رعاة ... ولولا رعيهم شنع الشَّنارُ
والرّعيان: الرّعاة. والمَرْعَى: الرّعي أي المصدر، والموضِع. واسْتَرعيتُه: ولّيتُه أمراً يَرْعاه. وإبل راعية، وتُجمَعُ رَواعي. والإرعاء: الإبقاء على أخيك. وأَرْعَى فلانٌ إلى فلانٍ، أي: استمع، وروي عن الحسن: راعنا بالتنوين وبغير التنوين ويُفَسَّرُ في باب (رعن) . ورجل تِرْعِيَّة: لم تزل صنعته وصنعة آبائه الرِّعاية. قال «30» :
يسوقها تِرْعِيَّةٌ جافٍ فضل
وأَرْعيتُ فلاناً، أي أعطيتُه رِعْيةً يرعاها.
وعر: الوعْرُ: المكانُ الصُّلْب وَعُرَ يَوْعُر ووَعَرَ يَعِرُ وَعْراً ووُعوراً والجمع: وُعُورٌ. وتوعّر المكانُ. وفلانٌ وَعْرُ المعروف: قليلُه. قال الفرزدق «31» :
وَفَتْ ثمّ أدّتْ لا قليلا ولا وعرا
__________
(28) ديوانها ص 58.
(29) ديوانه ص 142.
(30) لم نهتد إلى القائل.
(31) ديوانه ص 323، وصدر البيت فيه:
إليكم: وتلقونا بني كل حرة
(2/241)
________________________________________
أي: وَلَدَتْ فأنجبتْ، وأكثرت، يعني: أمّ تميم. واستوعر القومُ طريقَهم. وأوعروا، أي، وقعوا في الوَعْر.
روع: الرَّوْعُ: الفزع. راعني هذا الأمرُ يَرُوعني، وارتَعْت له، وروَّعَني فتروَّعْت منه. وكذلك كلُّ شيء يَروعُك منه جمالٌ أو كثرةٌ. تقول: راعني فهو رائعٌ. وفرس رائع: كريم يروعك حسنُه، وفرسٌ رائع بيّن الرَّوْعة. قال «32» :
رائعةُ تحمل شيخاً رائعاً ... مجرَّباً قد شهِدَ الوقائعا
والأرْوَعُ من الرّجال: من له جسم وجهارة وفضلٌ وسُودَد، وهو بيّنُ الرَّوَع. والقياس في اشتقاق الفعل منه: رَوِعَ يَرْوَعُ رَوَعاً. ورُوعُ القلب: ذِهْنُه وخَلَدُه. يُقال: رجع إليه رُوعُه ورُواعُهُ إذا ذهب قلبه ثم ثاب إليه.
ورع: الوَرَعُ: شدّةُ التَحَرَّجِ. ورّعْهُ: اكفُفْهُ كفّاً. ورجلٌ وَرِعٌ متورَعٌ. [إذا كان متحرجاً] «33» . والوَرَعُ: الجبان، ورُعَ يَوْرُعُ وَراعةً. ومن التّحرّج: وَرِعَ يَرِعُ رِعَةً. وسمّي الجبانُ وَرَعاً لإحجامه ونكوصه، ومنه يقال: وَدَّعْتُ الإبلَ عن الحوض، إذا رَدَدْتُها فارتدت.
وفي
__________
(32) المحكم: 2/ 250 واللسان (ووع) .
(33) زيادة من التهذيب لتوضيح المعنى.
(2/242)
________________________________________
الحديث: ورّعوا اللّص ولا تُراعوه «34» .
أي ردّوه بتعرّضٍ له، أو بثنية، ولا تنتظروا ما يكون من أمره. قال «35» :
وقال الذي يرجو العُلالَة وَرِّعُوا ... عن الماء لا يطرق وهن طوارِقُهْ
يعر: اليَعْرُ واليَعْرَةُ: الشّاة تُشَدُّ عندَ زُبْيَة الذّئب. واليُعارُ: صوت من أصوات الشّاء شديد. يَعَرَتْ تَيْعَرُ يُعاراً. قال «36» :
تيوساً بالشَّظيّ لها يُعار
واليَعور «37» : الشّاة التي تبولُ على حالِبها، وتُفْسِدُ اللَّبنَ «38» .
ريع: الرَّيْع: فضل كلّ شيء على أصله، نحو الدّقيق وهو فضلُهُ على كَيْلِ البُرّ، ورَيْعُ البَذْرِ: فضل ما يَخْرُجُ من النُّزْلِ على أصلِ البَذْر. والرَّيْع: رَيْع الدّرع، أي: فضل كُمَتِها على أطرافِ الأنامل. قال قيس بن الخطيم «39» :
مُضَاعَفَةً يَغْشَى الأناملَ رَيْعُها ... كأن قَتِيرَيْها عيونُ الجنادبِ
__________
(34) التهذيب 3/ 175 وروايته فيه ورع اللص ولا تراعه.
(35) (الراعي) المحكم 2/ 252 واللسان (ورع) .
(36) اللسان (يعر) غير منسوب أيضا وصدره فيه:
وأما أشجع الخنثى فولوا
(37) قال الجوهري: هذا الحرف هكذا جاء. وقال الأزهري: شاة يعور إذا كانت كثيرة اليعار.
(38) ترجمة الكلمات الثلاث الأخيرة من (س) فقد سقطت من (ص) و (ط) .
(39) ديوانه ص 82. والرواية فيه: فضلها.
(2/243)
________________________________________
وراع يَرِيعُ رَيْعاً، أي: رجع في كلّ شيء. والإبل إذا تفرّقت فصاح بها الرّاعي راعت إليه، أي: رجعت، قال «40» :
تَرِيعُ إلى صوتِ المُهيبِ وتتّقي
ورَيْعانُ كلِّ شيء أوّلُه وأفضلُه. ورَيْعانُ الشَّباب صدرُه. ورَيْعانُ المطر أوّلُهُ. والرِّيعُ: هو السّبيل سُلِكَ أو لم يُسْلَكْ، قال «41» :
كظهْرِ التُّرس ليس بهنّ رِيعُ
__________
(40) (طرفة) ديوانه ص وعجز البيت فيه:
بذي خصل روعات أكلف ملبد
(41) لسان العرب (ريع) منقوص وغير منسوب أيضا.
(2/244)
________________________________________
باب العين واللام و (واي) معهما ع ل و، ع ول، ع ي ل، ل ع و، وع ل، ل وع، ل ي ع، ول ع، ي ع ل مستعملات
علو: العُلُوٌّ للهِ سبحانَه وتَعَالَى عن كلِّ شيء فهو أعلى وأعظم مما يُثْنَى عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والعلو: أصل البناء. ومنه العَلاءُ والعُلُوّ، فالعَلاءُ الرِّفْعَةُ، والعُلُوُّ العظمة والتجبّر. [يقال] : علا مَلِكٌ في الأرض [أي: طغَى وتعظّم] . قال الله عزّ وجلّ: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ «1» . ورجلٌ عالي الكعب، أي: شريف. قال «2» :
لمّا عَلا كَعْبُكَ لي عَلِيتُ
[وتقول] لكلّ شيء علا: علا يَعْلو علوا، و [تقول] في الرِّفعة والشرف: عَلِيَ يَعْلى عَلاءً. والعَلْياء: رأسُ كلّ جَبَلٍ مُشْرِف. قال «3» :
تحملن بالعلياء من فوق جرثم
__________
(1) القصص 4.
(2) (رؤبة) ديوانه ص 25.
(3) (زهير) ديوانه ص 9 وهو من معلقته، وصدر البيت:
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن
(2/245)
________________________________________
والعالية: القناة المستقيمة. والجمع: العوالي. [ويُسمّى أعلى القناة: العالية. وأسفلُها: السّافِلَة] «4» . والمَعْلاةُ: كَسْبُ الشَّرَفِ من المعالي. والعالية من محلّة العرب: الحجاز وما يليها، والنّسبة إليها: عُلْويّ. وعُلْوُ كلّ شيء أعلاه تَرْفَع العَيْنَ وتخفِضُ. وذهب في السّماء عُلْواً وفي الأرض سُفْلاً. والعُلْوُ والسُّفْلُ: أعلى كلّ شيء وأسفله. و [يقال] : سِفْلُ الدّارِ وعِلْوُها، وسُفْلُها وعُلْوُها. وفلان من عِلْية الناس، أي: من أهل الشَّرَفْ. وهؤلاء عِلْيَةُ قومهم. مكسورة العين، على فِعْلَة خفيفة. والعُلِّيَّة: الغُرفة على بناء حُرّيّة، في التّصريف على: فُعُّولة. وعاليةُ الوادي: أعلاه، وسافلتُه: أسفلُه، وفي كلّ شيء كذلك، عُلْيا مضر، وسُفْلى مضر. إذا قلت: عُليا قلت: سُفْلَى، وإذا قلت: عُلْو قلت: سفل. والسماوات العُلَى. الواحدة عُلْيا. وتِعْلَى: اسم امرأة. قال «5» :
سلامُ اللهِ يا تِعْلَى ... عليكِ، الملك الأَعْلَى
والثّنايا العُلْيا، والثّنايا السُّفْلَى. والله تبارَكَ وتعالَى هو العليّ العالي المتعالي ذو العُلَى والمعالي تعالَى عمّا يقولُ الظالمون علوا كبيرا. و (على) : صفة من الصّفات، وللعرب فيه ثلاث لغات: على زيدٍ مال، وعليك مال. ويقال: علاك، أي: عليك. ويقولون: كنت على
__________
(4) من التهذيب 3/ 187 عن العين.
(5) لم نقف عليه.
(2/246)
________________________________________
السّطح، وكنت في أعلَى السّطح. ويقولون: في موضع أعلى عالٍ، وفي موضع أعلى علٍ. قال أبو النجم «6» :
أقبُّ من تحتُ عريضٌ من علِ
وقد ترفعُه العربُ في الغاية فيقولون: من علُ. قال عبد الله بن رَواحة:
شهِدْتُ فلم أكذبْ بأنّ محمّداً ... رسول الذي سوّى السماوات من علُ
ويقال: اعْلُ عن مَجْلِسِك. فإذا قام فقد علا عنه. وتعلّتِ المرأة فهي تتعلَّى إذا طَهُرت من نفاسها. وتقول: يا رجل تعالَهْ، الهاءُ صِلَة، فإذا وصلتَ طرحتَ الهاء. فتقول: تعالَ يا رجلُ، وتعاليا وتعالَوْا، وأماتوا هذا الفعل سوى النّداء. وعَلْوَى: اسم فرس كان في الجاهلية. والعلاوة: رأس الجمل وعُنُقه. والعلاوة: رأس الرّجل وعُنُقه. والعلاوة: ما يحمل على البعير والحمار فوق العِدْلينِ بعد تمام الوقر، والجميع: علاوات. وتقول: أعطيك ألفاً وديناراً علاوة. والجمع العَلاوَى على وزن فَعالَى، كالهِراوَة والهَراوَى.
وقال أبو سفيان: اعلُ هُبَل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: الله أَعْلَى وأَجَلّ.
وعَلِيّ: اسم على فعيل، إذا نُسِبَ إليه قيل: عَلَويّ. والمُعَلَّى: القِدْحُ الأوّل يخرج في الميسر. وكلّ من قهر امرأً أو عدوّاً فقد علا واعتلاه واستعلى عليه. والفَرَسُ إذا جرى في الرّهان وبلغ الغاية، قيل: استعلَى على الغاية واستولى. ويقال: عُلْوان الكتاب، وأظنه غلطاً، وإنّما هو عُنوان. والعِليانْ: الذّكر من الضّباع. والبعير الضخم أيضا.
__________
(6) اللسان (علا) .
(2/247)
________________________________________
وعِلِّيِّينَ: جماعة علِّيٍّ في السماء السابعة يُصْعَدُ إليه بأرواحِ المؤمنين. والعَلاةُ: النّاقة الصُّلبة تُشَبّهُ بالعَلاة وهي السّندان.
عول: العَوْلُ: ارتفاع الحساب في الفرائض. والعالةُ: الفريضة. تَعُول عَوْلاً. ويقالُ للفارض: اعلُ الفريضة. والعَوْلُ: الميل في الحكم، أي: الجَوْر. والعَوْل: كلّ أمرٍ عالكَ. قالت الخنساء «7» :
يُكلّفُه القومُ ما عالَهُمْ ... وإن كان أصْغَرَهُمْ مَولدا
والعَوْلة من العَويل، وهو البكاء. أعْوَلَتِ المرأة إعوالاً، وهو شدّة صياحِها عند بكاء أو مكروه نزل بها. والعَوْل أيضاً: المُعَوَّل. عَوَّلَ عليه: اقتصر عليه، ولم يختر عليه. وعوّلتُ عليه: استعنتُ به، ومعناه: صيّرتُ أمري إليه. وتقول: أبفلانٍ تعوّل عليّ وبكذا إذا نازعك في أمرٍ يتطاول عليك. قال «8» :
وليس على دهرٍ لشيءٍ مُعَوَّل
وقال «9» :
عندي ولا في القومِ من مُعوّل
والعَوْل: قُوتُ العِيال. هو يَعُولهم عولاً. والمِعْوَل: حديدة ينقر بها الجبال، قال «10» :
أنيابها كالمعاول
__________
(7) ديوانها ص 30. وما في الأصول:
ويكفي العشير ما عالها.
(8) لم نهتد إليه.
(9) لم نهتد إليه.
(10) لم نهتد إليه.
(2/248)
________________________________________
عيل: العيالُ: جماعة عيِّل. ورجل مُعيل ومُعَيَّل: كثير العيال. قال «11» :
ووادٍ كجوفِ العير قفر قطعته ... به الذئب يعوي كالخليع المعيل
والعَيلة الحاجة. عال الرّجل يعيل عَيلة إذا احتاج
وفي الحديث: ما عال مقتصد ولا يَعيل «12»
، وقال «13» :
من عال يوماً بعدها فلا انجبر ... ولا سقى الماء ولا رعى الشَّجر
عَيْلان: اسم أبي قيس بن عَيْلان بن مُضَر.
لعو: كلبة لَعْوَة، وامرأة لَعْوَة، وذئبة لَعْوَة، أي: حريصة تقاتل عمَّا تأكل. والجمع: اللعوات واللعاء. وتيعى العسلُ ونحوه: تعقّد. لعاً: كلمة تقال عند العثرة. قال الأخطل «14» :
ولا هدى اللهُ قيساً من ضَلالتها ... ولا لَعاً ذَكْوانَ إن عَثَرُوا
وعل: الوَعِلُ وجمعه الأوعال، وهي الشّاءُ الجبلية. وقد استوعلتْ في الجبال، ويقال: وَعِل ووَعْل. ولغة للعرب: وُعِل بضمّ الواو وكسر العين من
__________
(11) الصدر (لامرىء القيس) وهو في ديوانه 92 أما عجز البيت فليس في ديوانه وقد تقدم ذلك عند ترجمة (العير) .
(12) لسان العرب (عيل) .
(13) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز غير الأصول.
(14) ديوانه 1/ 205.
(2/249)
________________________________________
غير أن يكونَ ذلك مُطّرِداً، لأنه لم يجيء في كلامهم: فُعِل اسماً إلا دُئل، وهو شاذّ. والوَعْل- خفيف- بمنزلة بُدّ، كقولك: ما بدٌّ من ذلك ولا وَعْل، وِعالٌ: اسم جبل. وَعْلَة: اسم رجل.
لوع: اللَّوْعة: حُرقة يجدها الرّجل من الحُزْنِ والوَجْد. ورجل هاعٌ لاع، أي: حريص سيىء الخلق، والفعل من هذا: لاع يلوعُ لَوْعاً ولُووعاً. ويُجْمَعُ على الألواع واللاّعين. والمرأة اللاّعة، ويقال: اللاّعة- بلامين-: التي تُغازِلُك ولا تُمكِّنُك. قال أبو خيرة: هي اللاّعة بهذا المعنَى، والأوّل قول أبي الدُّقيش.
ليع: لاعني الهمُّ والحزنُ فالْتَعْتُ التياعاً: أي: أَحْزَنَني فَحَزِنْت.
ولع: الوَلَعُ: نفس الولوع. تقول: أُولِع بكذا وَلُوعاً وإيلاعاً إذا لجّ، وتقول: وَلِعَ يَوْلَعُ وَلَعاً. ورجُلٌ ولِعٌ ووَلُوعٌ ولاعةٌ. والمُوَلَّعُ: الذي أصابه لُمَعٌ من برصٍ في وجهه والله ولَّع وجهه، أي: بَرَّصَهُ. قال: «15»
كأنّها في الجلد تَوْليعُ البهق
__________
(15) (رؤبة) ديوانه 104.
(2/250)
________________________________________
والوليع: الطلع ما دام في قِيقاتِه كأنّه اللّؤلؤ في شدّة بياضه، الواحدة: وَلِيعَة. قال «16» :
تَبَسَّمُ عن نيّر كالوليع ... يُشقِّقُ عنهُ الرّقاةُ الجُفوفا
الجفوف: القشور. والرُّقاة الذين يَرْتَقون النَّخْل.
يعل: اليَعْلول واليَعاليل من السَّحاب: قِطَعٌ بيضٌ. قال «17» :
تجلو الرياح القذى عنه وأَفْرَطَةُ ... من صَوْبِ ساريةٍ بيض يعاليل
__________
(16) التهذيب 3/ 200.
(17) (كعب بن زهير) ديوانه 7.
(2/251)
________________________________________
باب العين والنون و (واي) معهما ع ن و، ع ن ي، ع ون، ع ي ن، ن ع و، ن ع ي، وع ن، ن وع، ن ي ع مستعملات
عنو: العاني: الأسير، أقرّ بالعُنُوِّ والعَناء وهما مصدران قال «1» :
ابني أمية إني عنكما عاني ... وما العنا غير أني مرعش فاني
قوله: عانٍ، أي: ماسور، أي ليس عُنُوّي إلاّ أنّي مرعش. ويقال للأسير: عنا يعنو وعَنِيَ يَعْنَى إذا نشب في الإسار. قال «2» :
ولا يُفكّ طَوالَ الدّهر عانيها
وتقول: أَعْنُوه، أي أَبْقُوهُ في الإسار. والعاني: الخاضع المُتَذَلِّل. قال الله عزّ وجلّ: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ «3» وهي تَعْنو عُنُوّاً. وجئت إليك عانياً: أي: خاضعاً كالأسير المرتهن بذنوبه. والعنوة: القهر. أخذها عنوة، أي: قهراً بالسّيف. والعاني مأخوذ من العنوة، أي: الذلة.
__________
(1) لم نهتد إليه في غير الأصول.
(2) لم نقف عليه في غير الأصول.
(3) طه 111.
(2/252)
________________________________________
والعُنوان: عُنوان الكتاب، وفيه ثلاث لغات: عَنْوَنْتُ، وعنّنْتُ وعَيَّنْتُ، وعنوان الكتاب مُشْتَقٌّ من المعنى، يقال.
عني: عناني الأمر يَعْنيني عِناية فأنا مَعنيّ به. واعتنيت بأمره. وعنت أمور واعتنّت، أي: نزلت ووقعت. قال رؤبة «4» :
إني وقد تَعْني أمور تَعْتَنِي
ومَعْنَى كلّ شيء: مِحْنَتُهُ وحالُه الذي يصير إليه أمره. والعناء: التّعنِيَةُ والمشقّة. عنَّيته تُعَنّيه. والمُعَنَّى: كان أهلُ الجاهلية إذا بلغت إبل الرّجل مائة عمدوا إلى البعير الذي أَمْأَتْ به إبلُه فأَغْلَقوا ظهرَهُ لئلا يُرْكَب ولا يُنْتَفَعُ بظهرِهِ ليَعْلَمَ أن صاحبها مميء وإغلاق ظهره أن يُنْزَع منه سناسِنُ من فِقْرتَه، ويعقر سنامه. قال الفرزدق «5» :
غلبتك بالمفقىء والمُعَنِّي ... وبيت المُحْتَبَى والخافقاتِ
والعَنِيّةُ: الهناء، وقيل: بل هي بول يُعقد بالبعر. قال أوس بن حجر «6» :
كأنّ كُحَيْلاً مُعْقَداً أو عَنِيَّةً
عون: كلّ شيء استعنت به، أو أعانك فهو عَوْنُك. والصّوم عَوْنٌ على العبادة. وتقول: هؤلاءِ عَوْنُك، الذّكر والأنثى والجميع سواء، ويجمع أَعْوان. وأَعَنْته إعانة. وتَعاوَنوا أي: أعان بعضهم بعضا.
__________
(4) ديوانه 163.
(5) ديوانه ص 110.
(6) ديوانه 67 وعجز البيت:
على رجع ذفراها من الليت، واكف
(2/253)
________________________________________
ورجل مِعْوان: حسن المعونة. والمَعُونة على مَفْعُلة في القياس عند من جعله من العَوْن. وعند أناس هي: فَعُولة من الماعون، الفاعول. والعَوَان: البقرة النَّصَف في سنّها. والحربُ العَوانُ التي كانت قبلها حرب بَكْر، وهي أوّل وقعةٍ، ثمّ تكون عَوَاناً كأنّها ترفع من حالٍ إلى حالٍ أشدَّ منها. ويقال للمرأة النَّصَف: عَوَان قال:
نواعم بين أبكار وعون
والعانةُ: القطيع من حُمُر الوَحْش، وتجمع على عانات وعُون. وعانات: موضع من ناحية الجزيرة تُنْسب إليه الخمر العانيّة. وعانة الرّجل: إسْبُهُ من الشَّعَر على فرجه، وتصغيره: عُوَيْنة.
عين: العَيْن النّاظرة لكلّ ذي بصر. وعَيْنُ الماء، وعَيْنُ الرُّكبة. والعينُ من السّحاب ما أقبل عن يمينِ القِبْلة، وذلك الصُّقْع يُسمَّى العَيْن. يقال: نشأتْ سَحابةٌ من قِبَل العَيْن فلا تكادُ تُخْلِفُ. وعَيْنُ الشّمس: صيخدها. ويقال لكلّ رُكْبَةٍ عينانِ كأنّهما نُقرتان في مُقَدّمها. والعَينْ: المال العتيد الحاضر. يقال: إنه لَعَيّن غير (دين) «7» ، أي: مالٌ حاضر. ويقال: إنّ فلاناً لكريم عَينْ الكريم. ويقال: لا أطلبْ أثراً بعد عَينْ، أي: بعد مُعايَنَة. ويُقال: العَيْن: الدّينار، قال أبو المِقْدام «8» :
حبشيّ له ثمانون عيناً ... بين عَيْنَيْهِ قد يَسوقُ إفالا
وعِنْتُ الشّيء بعينه فأنا أَعينُه عَيْناً، وهو مَعْيونٌ، ويقال: مَعِينٌ
__________
(7) في (ص) : بياض وفي (ط) و (س) : عين.
(8) التهذيب 3/ 208، واللسان (عين) .
(2/254)
________________________________________
ورجل مِعيانٌ: خبيثُ العَيْن، قال في المعيون: «9»
قد كان قومُك يَحْسَبونك سيّداً ... وإخالُ أنّك سيّدٌ مَعْيونُ
والعَيْنُ: المَيْلُ في الميزان، تقول: أَصْلِحْ عَيْنَ ميزانِك. والعَيْنُ الذي تبعثه لتجسُّسِ الخبر، ونسميه العربُ ذا العُيَيْنَتَيْنِ، وذا العِيَيْنَتَيْنِ وذا العُوَيْنَتَيْنِ كلّه بمعنى واحد. ورأيته عِياناً، أي: مُعايَنَةً. وتَعَيَّن السِّقاءُ، أي: بَلِيَ ورقَّ منه مواضع [فلم يُمْسِكِ الماء] «10» ، قال القطاميّ «11» :
ولكنّ الأديمَ إذا تفرَّى ... بِلًى وتَعَيُّناً غَلَبَ الصَّناعا
وتَعَيَّنَ الشَّعِيبُ، أي: المزادة. والعِينةُ: السَّلَف، وتعيّن فلانٌ من فلانٍ عِينة، وقد عيّنه فلانٌ تَعييناً. والعِينُ: بَقَرُ الوحش وهو اسم جامع لها كالعِيس للإبل. ويُوصَفُ بسَعَةِ العَيْنَ، فيقال: بقرة عَيْناءُ وامرأة عَيْناء، ورجلٌ أَعْيُنَ، ولا يقال: ثورٌ أَعْيُنُ. وقيلَ: يقال ذلك. ورُوِي عن أبي عمرو. وهو حسَنُ العِينة والعَيَنِ، والفعل: عَيِنَ عَيَناً. والعَيَنُ: عظم سواد العَيْن في سَعَتها. ويقال: الأَعْيَنُ: اسم للثَّورِ وليس بنعتٍ. وهؤلاءِ أعيانُ تومهم، أي أشرافُ قومهم. ويُقال لكلّ إخوةٍ لأبٍ وأمٍ، ولهم إخوةٌ لأمّهات شتَّى: هؤلاءِ أعيانُ إخوتهم. والماء المَعِين: الظّاهر الذي تراه العُيون. وثوبٌ مُعَيَّن: في وَشْيِهِ ترابيعُ صغارٌ تُشْبِهُ عيون الوحش.
__________
(9) لم نهتد إليه.
(10) زيادة من التهذيب 3/ 206 لتوضيح المعنى.
(11) ديوانه- ص 34.
(2/255)
________________________________________
وأولاد الرّجل من الحرائر: بنو أعيان، ويقال: هم أعيان.
نعو: النَّعْوُ: الشَّقُ في مشْفَر البعير الأعلَى من قول الطّرمّاح «12» :
خَريعَ النَّعْوِ مُضطّرِبَ النَّواحي ... كأخلافِ الغَريفةِ ذا غُضُونِ
نعي: نَعَى يَنْعَى نُعْياً. وجاء نَعِيُّه بوزن فَعِيل. وهو خَبَرُ المَوْت. والنّعي: نداءُ النّاعي. وانتشار ندائه. والنَّعيُّ أيضاً: الرّجل الذي يَنْعَى. قال «13» :
قامَ النَّعيُّ فأَسْمَعا ... ونَعَى الكريمَ الأَرْوَعا
والإستِنْعَاءُ: شبهُ النّفار. واسْتَنْعَى القومُ إذا كانوا مُجتمعين فتفرّقوا لشيءٍ فَزِعوا منه. واسْتَنْعَتِ النّاقةُ، أي: عَدَتْ بصاحبها نافرةً. ويقال: يا نَعاءِ العربَ، أي: يا من نَعَى العربَ. قال الكُمَيْت «14» :
نعاءِ جُذاماً غَيْرَ مَوْتٍ ولا قَتْلِ ... ولكنْ فِراقاً للدعائم والأصل
يذكر انتقال جُذامٍ بنسبهم. وفيه لغة أخرى، يا نُعيان العرب، وهو مصدر نَعَيْتُه نُعْياً ونعيانا.
__________
(12) ديوانه 534. في النسخ: ذي غضون، وكذلك في اللسان (خرع) و (نعو) مع نصب الصفات قبله.
(13) التهذيب 3/ 219. اللسان (نعى) ، في (س) : قال.
(14) ليس في مجموع شعر الكميت، ولكنه في التهذيب 3/ 218، واللسان (نعى) .
(2/256)
________________________________________
وعن: الوَعْنَةُ: جمعُها: الوِعان، بياضٌ تراهُ على الأرض تعلم به أنّه وادي النمل، لا يُنْبِتُ شيئاً. قال «15» :
كالوِعانِ رُسُومُها
وتَوعَّنتِ الغنم: أخذ فيها السِّمَنُ أيّامَ الرّبيع. وكانت تلبية الجاهليّة:
وعن إليك عانية ... عبادل اليمانية
على قلاص ناجيه
نوع: النّوع والأنواع جماعة كلّ ضربٍ وصنف من الثّياب والثّمار والأشياء حتّى الكلام. والنُّوَع: الجُوع، ويقال: هو العطش وبالعطش أشبه، لقول العرب عليه الجوع والنوع، وجائع نائع. ولو كان الجوع نوعاً لم يحسن تكريره. وقال آخر: إذا اختلف اللّفظان كرّروا والمعنى واحد.
ينع: يَنَعَتِ الثّمرةُ يُنْعاً ويَنَعاً. وأَيْنَعَ إيناعاً. والنَّعتُ: يانِعٌ ومونع.
__________
(15) في اللسان (وعن) : كالوعان رسومها وفي التاج كذلك، منقوص غير منسوب.
(2/257)
________________________________________
باب العين والفاء و (واي) معهما ع ف و، ف ع د، ع ي ف، ي ف ع مستعملات
عفو: العفو: تركُكَ إنساناً استوجَبَ عُقوبةً فعفوتَ عنه تعفُو، والله العَفُوُّ الغَفور. والعَفْوُ: أحَلُّ المالِ وأطيبُه. والعَفْوُ: المعروف. والعُفاةُ: طُلاّبُ المعروف، وهم المُعْتَفُونَ. واعْتَفَيتُ فلاناً: طَلَبتُ مَعروفَه. والعافيةُ من الدَّوابِّ والطَّيْر «1» : طُلاّب الرِزقِ، اسمٌ لهم جامع.
وجاء في الحديث: مَن غَرَسَ شجرةً فما أَكَلَتِ العافيةُ منها كُتِبَتْ له صَدَقةٌ «2» .
والعافيةُ: دِفاعُ الله عن العبد المَكارِه. والإستِعفاءُ: أن تَطْلُبَ إلى من يُكَلِّفُك أمراً أن يُعفيك منه أي يَصرِفُه عنك. والعَفاءُ: التُّرابُ. والعَفاءُ: الدُّروسُ، قال:
__________
(1) في اللسان: والعافية: طلاب الرزق من الإنس والدواب، والطير.
(2) في اللسان:
وفي الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة.
وجاء أيضا في حديث أم مبشر الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لي فقال: من غرسه أمسلم أم كافر؟ قلت: لا بل مسلم، قال: ما من مسلم يغوس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طائر أو سبع إلا كانت له صدقة.
(2/258)
________________________________________
على آثار مَن ذَهَبَ العَفاءُ «3»
تقول: عَفَتِ الدِّيار تَعفُو عُفُوّاً، والرِّيحُ تَعفُو الدارَ عَفاءً وعُفُوّاً وتَعَفَّتِ الدارُ والأثَرُ تَعَفّيَاً. والعَفْو والعِفَو والجميع عِفْوة «4» : الحُمُر الأَفْتاء والفَتيات، والأنثى عِفَوَة ولا أعلم واواً مُتحركة بعد حرف متحرك في في آخِر البناء غيرَ هذا، وأن [لُغَة] «5» قيس بها جاءت «6» وذلكم أنَّهم كَرهوا عِفاة في موضع فِعَلة وهم يريدون الجماعة فيلتبس بوُحْدان الأسماء فلو تكلَّف متكلّف أن يَبنيَ من العَفو اسماً مفرداً على فِعلة لقال عِفاة. وفيه قول آخر: يقال همزة العَفاء والعَفاءة ليست بأصلية إنما هي واوٌ أو ياء لا تُعرَف لأنّها لم تُصَرَّف ولكنّها جاءت أشياء في لغات العرب ثَبَتَت المَدَّة في مؤنثّها نحو العَماء والواحدة العَماءة ليست في الأصل مهموزة ولكنّهم إذا لم يكن بين المذكّر والمؤنّث فرقٌ في أصل البناء همَزوا بالمدّة كما تقول: رجلٌ سَقّاء وامرأة سقّاءة وسقّاية. قيل أيضاً، من ذهب إلى أن أصله ليس بمهموز «7» . والعِفاء ما كَثُر من الريش والوَبَر. ناقةٌ ذات عِفاء كثيرةُ الوَبَر طويلتُه قد كادَ ينسِل للسُقوط. وعِفاء النَّعامة: الريشُ الذي قد عَلا الزِّفَّ الصِّغار، وكذلك الدّيك ونحوه من الطَّير، الواحدة عِفاءة بمَدَّة وهمزة، قال «8» :
__________
(3) عجز بيت (زهير) وصدره:
تحمل أهلها عنها فبانوا
والبيت في شرح ديوان زهير ص 58 وفي اللسان. وفي الأصول المخطوطة: على آثار ما ذهب العفاء.
(4) في اللسان: والعفو والعفو والعفو والعفا والعفا تبصرهما: الحجش. وفي التهذيب: ولقد الحمار. والجمع أعفاء وعفاء وعفوة.
(5) ما بين المعقوفين من اللسان وهو شيء يقتضيه السياق وهو الفعل جاءت.
(6) كذا في ط وس في ص: كان.
(7) في الأصول المخطوطة: بمهموزة.
(8) لم نهتد إلى القائل،
(2/259)
________________________________________
أُجُدٌ مُؤَثَّفةٌ كأنَّ عِفاءَها ... سِقْطانِ من كَنَفَيْ ظَليمٍ جافِلِ
وعِفاءُ السّحاب: كالخَمْل «9» في وجهه لا يكاد يُخلِف «10» ، ولا يقال للواحدة عِفاءة حتى تكونَ كثيرة فيها كثافة.
فعو: الأفعى: حَيَّةٌ رَقشاءُ طويلةُ العُنُق عريضة الرَّأس، لا ينفَعُ منها رُقْيَة ولا تِرْياق، وربّما كانتْ ذاتَ قَرْنَيْن. والأُفْعُوانُ: الذَّكَرُ.
عوف: العَوْفُ: الضَّيْف، وهو الحالُ أيضاً «11» : تقول: نِعْمَ عَوْفُك أي ضَيْفُكَ. والعَوْفُ: اسم من أسماء الأسد لأنّه يَتَعَوَّف باللَّيْل فيَطلُب. ويقال: كلُّ مَن ظَفِرَ في اللَّيْل بشيءٍ «12» فالذي يَظفَر به عُوافتُه. وعُوافةُ وعَوْفٌ «13» من أسماء الرّجال. ويقال: العَوْفُ الأَيْرُ. ويقال: العَوْف نَبْتٌ
عيف: عافَ الشَّيءَ يَعَافُه عِيافةً «14» إذا كَرِهَه من طعام أو شراب. والعَيُوفُ من الإبِلِ: الذي يَشَمُّ الماءَ فيَدَعُه وهو عطشان. والعِيافة زَجْرُ الطَّيْر، وهو أَنْ تَرَى طَيْراً أو غراباً فَتَتَطَيَّرَ، تقول: ينبغي أنْ يكون كذا فإنْ لم تَرَ شيئاً قُلتَ بالحَدْس فهو عِيافة. ورجل عائف يَتَكَهَّن، قال: عَثَرَت طيرك أو تعيف.
__________
(9) كذا في (ط) و (ص) في (س) : كل ما تحمد.
(10) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة: يخفف.
(11) في اللسان: وخص بعضهم به الشر.
(12) كذا في س في ط وص: فهو الذي.
(13) كذا في الأصول المخطوطةفي اللسان: وعرف وعويف: من أسماء الرجال.
(14) في اللسان: عاف الشيء يعافه عيفا وعيافة وعيافا وعيفانا.
(2/260)
________________________________________
يفع: اليَفاعُ: التلُّ المُنيفُ. وكلُّ شيءٍ مُرتَفع يَفاع. وغُلامٌ يَفَعة «15» وقد أيْفَعَ ويَفَعَ أي شَبَّ ولم يبلُغ. والجارية يَفَعَة والأيفاع جمعه.
__________
(15) في اللسان: وغلام يافع ويفعة وأفعة ويفع: شاب.
(2/261)
________________________________________
باب العين والباء و (واي) معهما ع ب ا، ع بء، ع ي ب، وع ب، ب وع، ب ع و، ب ي ع مستعملات
عبا: العباية: ضرب من الأكسية فيه خُطوط سُود كبار والجميع العَباء، والعَباءة لغة. وما ليس فيه خُطوطٌ وجِدّة فليس بعَباءة، قال:
نَجَا دَوْبَل في البئر واللَّيل دامِسٌ ... ولولا عباءته «1» لزار المقابرا
والعَبا، مقصور،: الرجل العَبام في لغة وهو الجافي العَيُّ «2» .
عبء: العِبْء: كلّ حِمْلٍ من غُرْمٍ أو حَمالةٍ، والجميع الأَعْباء، قال:
وحَمْلُ العِبْء عن أعناق قَومي ... وفِعلي في الخُطوبِ بما عَناني «3»
__________
(1) كذا ورد، ولا يستقيم الوزن إلا بإسكان التاء، وهذا من أقبح الضرورات. ولم نهتد إلى الشاهد في المعجمات المشهورة ولا في كتب اللغة والأدب.
(2) نقل الأزهري عن الليث: العبا مقصور الرجل العبام، وهو الجافي العيي.. قال الأزهري: ولم أسمع العبا بمعنى العبام لغير الليث (تهذيب اللغة 3/ 235) وفي اللسان، العيي أيضا. وفيه: رَجُلٌ عَيٌّ بوزن فَعْلٍ، وهو أكثر من عيي.
(3) لم نجد الشاهد.
(2/262)
________________________________________
وما عَبَأَت به شيئاً: أي لم أياله ولم ارتفع «4» . وما أعبَأُ بهذا الأمر: أي ما أصنع به كأنَّك تَستقلُّه وتَستَحقِرهُ. تقول: عَبَأَ يَعْبَأُ عَبْأً وعَباءً، وعَبَأتُ الطِيبَ أعبوه عَبْأً وأُعَبِّئُهُ تَعْبِئةً إذا هَيَّأتُه في مواضعه، وكذلك الجيش «5» إذا ألبستُهم السلاحَ وهَيَّأتُهم للحرب، قال:
وداهيةٍ يُهالُ الناسُ منها ... عَبَأتُ لشدِّ شِرَّتِها عَلَيّا «6»
وتقول في ترخيم اسم مثل عبد الرَّحمن وعبد الرَّحيم وعبد الله وعُبَيْد الله عَبْوَيْهِ مثل عَمْرَوَيْةِ «7» .
عيب: العَيْبُ والعَابُ لغتان، ومنه المَعَابُ. ورجُلٌ عَيّابٌ: يَعيبُ النّاسَ، وكذلك عَيّابة «8» : وقَّاعَةٌ في الناس، قال:
قد أَصْبَحَتْ لَيْلَى قليلاً عابُها «9»
وعابَ الشّيء: إذا ظَهَرَ فيه عَيب. وعابَ الماءُ: إذا ثَقَبَ الشَّطَّ فَخَرَجَ منه، مُجاوزُه ولازمهُ واحد. وعَيْبَة المَتاعِ يجمَعُ عِياباً. والعِيابُ: المِنْدَف «10» ، لم يعرفوه. والعِيابُ: الصُّدورُ أيضاً واحدُها عَيْبة.
وفي الحديث: إنَّ بينَنا وبَينَكم عَيْبةً مكفُوفَةً «11»
يُريد صَدْراً نَقِيّاً من الغِلِّ والعداوة، مَطْوِيًّا على الوفاء. قال بِشْر بن أبي خازم:
__________
(4) كذا في الأصول المخطوطة ولكن لم نجد قوله ولم أرتفع في المعجمات.
(5) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة: الخيل. وقد اخترت ما في اللسان لصحته بقرينة الضمير في ألبستهم وهيأتهم.
(6) لم نهتد إلى قائل الشاهد.
(7) كذا في ص في ط وس: غبرويه.
(8) في اللسان: وعيبة بضم ففتح.
(9) لم نظفر بالشاهد.
(10) وفي اللسان: قال الأزهري لم أسمعه لغير الليث.
(11) وفي اللسان: قال الأزهري وقرأت بخط شمر:
وإن بيننا وبينهم عيبة مكفوفة.
(2/263)
________________________________________
وكادتْ عِيابُ الوُدِّ منَّا ومنكم ... وإنْ قيل أبناءُ العُمُومةِ تَصْفَرُ «12»
أي تخلو من المَحبَّة.
وعب: الوَعْبُ: إيعابُكَ الشَّيْءَ في الشيء. واستَوْعَبَ الجِرابُ الدقيقَ.
وفي الحديث: إنَّ النِّعْمةَ الواحدَة تَستَوعِبُ جميعَ عَمَلِ العبد يومَ القِيامة
أيْ تَأتي عليه.
بوع: البَوعُ «13» والبَاعُ لغتان، ولكنْ يُسَمَّى البَوعُ في الخِلقة، وبَسْطُ الباع في الكَرَم ونحوه فلا يقال إلاّ كريمُ الباع، قال:
لهُ في المجْدِ سابقةٌ وباعٌ 1»
والبَوعُ أيضاً مصدر باع يَبُوع بَوعاً، وهو بَسْطُ الباع في المَشْيِ والتناوُلِ، وفي الذَّرع. [والإبِل] «15» تَبُوعُ في سيرها. وقال في بَسطِ الباع:
لقد خِفتُ أن ألْقَى المنايا ولم أَنَلْ ... من المالِ ما أسْمُو به وأَبُوعُ «16»
أيْ أمُدُّ به باعي.
__________
(12) لم نجده في الديوان، وأضافه محقق الديوان (عزة حسن) في ملحق الديوان. وهو منسوب إلى (بشر) في أساس البلاغة وفي اللسان (عيب) من غير عزو، والبيت مع بيت آخر في كتاب المعاني الكبير ص 527 منسوبان إلى (الكميت) .
(13) في اللسان والبوع بفتح الباء وهي كلمة ثالثة.
(14) لم يرد في المعجمات الأخرى ولا في كتب اللغة التي أفدنا منها.
(15) الكلمة زيادة من اللسان ومكانها في ص فراغ.
(16) (الطرماح) ديوانه/ 314 والرواية فيه:
وشيبني أن لا أزال مناهضا ... بغير ثرا أثرو به وجبوع
(2/264)
________________________________________
بعو: البَعْوُ: الجُرْمُ «17» ، قال «18» :
وإِبسالي بَنِيَّ بغَير جُرْمٍ ... بَعَوناهُ ولا بِدمٍ مُراقِ
وبَعَوا من فلان أي حقروا وتجرءوا «19» .
بيع: العَرَبُ تقول: بِعتُ الشيءَ بمعنى اشتريته. ولا تَبعْ بمعنى لا تَشْتر. وبِعتُه فابْتاعَ أي اشتَرَى. والبَيّاعات: الأشياءُ التي يُتَبايَع بها للتجارة. والإبتياع: الإشتراء. والبَيْعة: الصَّفْقة على إيجابِ البَيع وعلى المُبايَعَةِ والطَّاعة، [وقد] «20» تَبايَعوا على كذا. والبَيْعُ اسم يَقَع على المَبيعِ، والجميع البُيوع. والبَيِّعان: البائع والمشتري. والبِيعةُ: كنيسة النَّصارَى وجَمعُها بِيَع، قال الله عزّ وجلّ: [لَهُدِّمَتْ «21» ] صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ.
__________
(17) في اللسان: الجناية والجرم.
(18) (هو عوف بن الأحوص الجعفري) (اللسان) .
(19) لم نجد قوله: بعوا من فلان إلى آخره في سائر المعجمات.
(20) كذا في اللسان وهي مما يقتضيها السياق.
(21) تمام الآية وهي ضرورية. انظر سورة الحج الآية 40.
(2/265)
________________________________________
باب العين والميم و (واي) معهما ع م ي، م ع و، ع وم، ع ي م، م ي ع مستعملات
عمي: العَمَى: ذَهابُ البَصرَ، عَمِيَ يَعْمَى عَمىً. وفي لغة اعمايَّ يَعمايُّ اعمِيياء، أرادوا حَذْوَ ادهَامَّ ادهيماماً فأخرجوه على لفظٍ صحيح كقولك ادهامَّ: اعمايَّ. ورَجُلٌ أعْمَى وامرأة عَمْياءُ لا يَقَعُ على عَيْنٍ واحدةٍ. وعَمِيَت عَيْناهُ. وعَينانِ عَمياوان. وعَمْياوات يَعني النساء. ورجالُ عُمْيٌ. ورَجُلٌ عَمٍ، وقَومٌ عَمُون من عَمَى القَلْب، وفي هذا المعنى [يُقال] «1» ما أعماه، ولا يُقال، من عَمَى البَصرَ، ما أعماه لأنّه نَعْتٌ ظاهرٌ تُدركُه الأبصار. ويقال: يجوز فيما خَفِيَ من النُّعوت وما ظَهَرَ خلا نَعْتٍ يكون على أَفْعَلَ مُشَدَّد الفعل مثل اصفَرَّ واحمرَّ. والعَمايَةُ: الغَوايةُ وهي اللَّجاجة. والعَمايَةُ والعَماء: السَّحابُ الكثيفُ المُطبِقُ، ويقال للَّذي حَمَلَ الماءَ وارتَفَعَ، ويقال للَّذي هَراقَ ماءَه ولما يَتَقَطَّع، تَقَطَّعَ الجَفْل «2» والجَهامُ. والقِطعةُ منها عماءة، وبَعضٌ يُنكِره ويَجعَلُ العَماءَ اسماً جامعاً. وقال الساجعُ: أشَدُّ بَرْدِ الشِّتاء شَمالٌ جِرْبِياءُ في غِبِّ السَّماء تحت ظِلِّ عَماء.
__________
(1) زيادة يقتضيها السياق، وكذا في اللسان.
(2) كذا وردت في اللسان مرة وقد جاءت الجفال مرة أخرى.
(2/266)
________________________________________
والعَمْيُ على لفظ الرَّمْيُ: رَفْعُ الأمواجِ القَذَى والزَّبَد في أعاليه، قال:
رَهَا «3» زَبَداً يَعمِي به المَوْج طاميا
والبعيرُ إذا هَدَرَ عَمَى بلغامِه على هامتِه عَمْياً. والتَّعمِيَة: أن تُعَمِّي شيئاً على إنسانٍ حتى تُلْبَه عليه لَقْماً «4» ، وجمع العَماء أعماء كأنه جعل العماء اسماً ثمّ جمعه على الأعماء، قال رؤبة «5» :
وبَلَدٍ عاميةٍ اعماؤُهُ «6»
والعُمِّيَةُ: الضَّلالة، وفي لغة عِمِّيَة. والاعتماء: الاختيار، قال:
سيل بينَ النّاسِ أيًّا يَعْتمي «7»
والمَعامي: الأرضُ المجهُولة.
معو: المَعْوُ: الرُّطَبُ الذي أَرْطَبَ بُسْرُه أجمَعُ، الواحدةُ مَعْوَة لا تَذنيبَ فيها ولا تَجزيع. والمُعاء: من أصواتِ السنانير، معا يمعو أومغا يَمْغُو لونان «8» أحدُهما من الآخر، وهُما أرفَعُ من الصئي.
__________
(3) كذا في اللسان وفي الأصول المخطوطة: زها. ولم نهتد إلى قائل البيت.
(4) كذا في الأصول المخطوطة أما في اللسان: تلبيسا. واللقم: سد فم الطريق ونحو ذلك.
(5) كذا في ديوان رؤبة واللسان في الأصول المخطوطة: العجاج.
(6) كذا روي الرجز في اللسان والديوان في الأصول المخطوطة:
وبلدة عامية أعماؤه
وتكملته:
كأن لون أرضه سماؤه
(7) كذا في الأصول المخطوطة: ولم نجده في سائر المعجمات.
(8) كذا في ص وط واللسان في س: لغتان.
(2/267)
________________________________________
معي: ومَعًى ومِعًى واحدٌ، ومِعَيانِ وأمعاءٌ وهو الجميعُ ممّا في البَطْن ممّا يتردَّدُ فيه من الحَوايا كُلِّها. والمِعَى: من مَذانب الأرض، كُلُّ مِذْنَبٍ يُناصي مِذْنَباً بالسَّنَد، والذي في السَّفْح هو الصُّلْب، قال:
تحبو إلى أصلابه أمعاؤه «9»
[وهما مَعاً وهم مَعاً «10» ، يُريدُ به جماعة. ورجل إمَّعَة على تقدير فِعَّلة: يقول لكلٍ أنا مَعَك، والفعل نَأْمَعَ «11» الرجُلُ واسْتَأْمَعَ «12» . ويقال للَّذي يتردَّدُ في غير ضَيعَةٍ إمَّعَة،
وفي الحديث: اغْدُ عالِماً أو مُتَعَلِّماً ولا تَغْدُ إمَّعَة] .
عوم: العَوْمُ: السِّباحة. والسَّفينةُ والإبِلُ والنُّجُوم تَعُومُ في سيرها، قال:
وهُنَّ بالدَّوِّ «13» يَعُمْنَ عَوْماً
وفَرَس عَوّام: يَعُومُ في جَرْيه. والعامُ: حَوْلٌ يأتي على شَتْوةٍ وصَيْفَةٍ، ألِفُها واو، ويُجمَع على الأعوام. ورَسْمٌ عامِيٌّ أو حَوْليٌّ: أتَى عليه عامٌ، قال العجّاج:
مِن أنْ شَجاكَ طَلَلٌ عامِيُّ «14»
والعامَةُ: تُتَّخَذُ من أغصان الشَّجر ونحوه، تُعْبَر عليها الأنهار كعُبُور السُّفُن، وهي تَموجُ فوْقَ الماء، وتُجمَعُ عامات. والعام والعومة
__________
(9) الرجز (لرؤبة) في ديوانه ص 4:
تحبو إلى أصلابه أمعاؤه ... والرمل في معتلج أنقاؤه
(10) أدرجت الكلمة في مادة (معع في اللسان وفي غيره من المعجمات كالتهذيب مثلا. وكذلك إمعة ولا مكان لها في معي.
(11) لم نجد الفعل في المعجمات المتيسرة.
(12) لم نجد الفعل في المعجمات المتيسرة.
(13) كذا في اللسان وسائر المظان اللغوية، في الأصول المخطوطة: الدوم.
(14) الرجز في الديوان ص 311.
(2/268)
________________________________________
والعامَةُ: هامَةُ الراكب إذا بدا لك رأسُه في الصَّحْراء وهو يَسيرُ. ويقال: لا يُسَمَّى رأسُه عامةً حتّى تَرَى عِمامةً عليه. والإعتِيامُ: اصطِفاء خِيارِ مالِ الرَّجُل، يُقال: اعتَمْتُ فلاناً، واعتَمْتُ أَفْضَلَ مالِهِ. والمَوْتُ يَعْتامُ النُّفُوس، قالَ طَرَفة:
أَرَى المَوْتَ مِعْيَامَ الكِرامِ ويَصْطَفي ... عَقيلةَ حالِ الفاحِشِ المُتَشَدِّدِ «15»
عيم: العَيْمانُ: الذي يَشْتَهي اللَّبَنَ شَهْوَةً شَديدةً، والمرأة عَيْمَى. وقد عِمْتُ إلى اللَّبَن عَيْمَةً شديدة وعَيَماً «16» شديداً. وكل مَصْدرٍ مثلهُ ممّا يكون فَعْلان وفَعْلى، فإذا أَنَّثْتَ المصدر فقُلْ على فَعْلةٍ خفيفة، وإذا طَرَحْتَ الهاءَ فَثَقِّلْ نحو الحَيَرْ والحَيرَة.
ميع: مَاعَ الماءُ يميع مَيْعاً إذا جرى على وجه الأرض جَرْياً مُنْبسطاً في هيئته، وكذلك الدَّمُ. وأَمَعْتُه إماعةً، قال «17» :
بساعِدَيْهِ جَسَدٌ مُوَرَّسُ ... منَ الدِّماءِ مائِعٌ ويُبَّسُ
والسَّرابُ يَميعُ. ومَيْعَةُ الشَّبابِ: أوَّلُه ونشاطه. والمَيْعَة والمائعة: من العِطْر. والمَيْعَة: اللبنى «18» .
__________
(15) ورواية البيت في كتاب السبع الطوال لابن الأنباري وغيره من مصادر الشعر الجاهلي، واللسان:
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي............... .............
(16) في الأصول واللسان: عيما بسكون الياء والصواب الذي يقتضيه قول الخليل، فتح الياء.
(17) في اللسان: وأنشد الليث والرجز فيه يبدأ لقوله:
كأنه ذو لبد دلهمس............... ..........
(18) اللبنى واللبن: شجر.
(2/269)
________________________________________
باب اللَّفيف من العين
اللَّفيفُ: أنْ تلفَّ الحَرْف بالحَرْف أي تُدْغم لأنَّ العَيَّ أصْلُهُ العَوْيُ فاستتْقلوا إظهارَ الواو مع الياء المتحرِّكة.. فحوَّلُوها ياء وأدغمُوها فيها.
عوي: عَوَتِ السِّباعُ تَعْوي عَوًى «1» . وللكلْب عُواءٌ، وهو صوْتٌ يمُدُّهُ وليس بنَبْح. وعَوَيْتُ الحَبْلَ عيّاً: لوَيْتُهُ. وعَوَيْتُ رأس النّاقة «2» : أي عُجْتُها فانْعَوَى. والناقةُ تَعْوي بُرَتها في سيْرها: أيْ تلويها «3» بخَطْمها، قال «4» :
تَعْوي البُرَى مُسْتوفِضاتٌ وفْضا
وعَوَى فلانٌ قَوْماً واسْتَعْوَى: دَعاهُم إلى الفِتنة. وعَوَيْتُ المُعْوَجَّ حتّى أقَمْتُه. والمُعاويَةُ: الكَلْبَةُ المُسْتحرِمةُ تَعْوي إليهنَّ ويَعْوِينَ، يُقال: تَعاوَى الكِلابُ. والعَوَّاءُ: نَجْمٌ في السَّماءِ يُؤَنَّث، (يُقال لها عَوَّاء) «5» ،
__________
(1) لم يرد هذا المصدر في كتب اللغة وفيها أن العواء هو المصدر، ليس غير. وأضيف أن بناء فعل مصدرا للثلاثي المكسور العين والماضي مفتوحها في المضارع، خاص في الأكثر بالأعراض والصفات والعيوب والحلية. ولم نجد هذا المصدر إلا في الأصول المخطوطة التي لدينا من كتاب العين.
(2) كذا في ص وس وقد سقطت من ط.
(3) كذا في س أما في ص وط: تلويه.
(4) (رؤبة) ديوانه/ 80.
(5) سقط ما بين القوسين من س.
(2/270)
________________________________________
ويقال: إذا طَلَعَتِ العَوّاءُ جَثَمَ الشِّتاءُ وطابَ الصِّلاءُ، وهي من نُجُوم السُّنْبُلة من أنْواء البَرْدِ في الرَّبيع، إذا طلعت وسَقَطَتْ جاءَتْ بالبَرد، ويُقالُ لها عواء البرد. والعواء والعَوَّة «6» ، لغتان: الدُبُرْ، قال:
فهلاّ شَدَدْتَ العَقْدَ أو بِتَّ طاوِياً ... ولم يَفْرَحِ العَوّا كما يَفْرَحُ القَتْبُ
وقال:
قِياماً يُوارُون عَوّاتِهم ... بِشَتْمي وعَوّاتُهُمْ أظْهَرُ
عا، مقصُورٌ، زَجْرُ الضئين، ورُبّما قالوا: عو وعاي، كلّ ذلك يُخفَّف، فإذا استُعملَ فِعْلُه قيل: عَاعَى يُعاعِي مُعَاعاةً»
وعَاعاةً «8» ، ويُقالُ أيضاً، عَوْعَى يُعَوْعِي «9» عَوْعَاةً وعَيْعَى يُعَيْعِي «10» عَيْعاة وعِيعاء «11» مصدرٌ لكلّ تلك اللغات، قال «12» :
وإنّ ثِيابي من ثِيابِ مُحَرَّقٍ ... ولم أَسْتَعِرْها من مُعاعٍ وناعِقِ
عيي: والعِيُّ مصدر العَيِّ، وفيه لغتان: رَجُلٌ عَيٌّ بوزن فَعْلٍ وعَيِيٌّ بوزنِ فَعيل «13» قال العجّاج:
لا طائِشٌ فاقٌ ولا عيي «14»
__________
(6) كذا في اللسان وما يقتضيه الشاهدان المذكوران، في الأصول المخطوطة: العوا ولم نهتد إلى القائل لكل من الشاهدين. وقال محقق (اللسان) عن عجز البيت الأول: قوله: ولم يفرح ... هكذا في الأصل. ولعل الصواب: لم يقرح.
(7) كذا في القياس واللسان في الأصول المخطوطة: عاعاة.
(8) هذا هو القياس وكذا في اللسان في الأصول المخطوطة: عيعا.
(9) سقط من الأصول المخطوطة.
(10) سقط من الأصول المخطوطة.
(11) سقط من الأصول المخطوطة.
(12) لم نهتد إلى القائل.
(13) كذا في ص وقد سقط في ط وس.
(14) لم نجد الرجز في الديوان.
(2/271)
________________________________________
وقال آخر «15» :
لنا صاحِبٌ لا عَيِيُّ اللسانِ ... فيَسْكُتُ عنّا ولا غافِلُ
وقد عيَّ عن حُجَّته عِيّاً، وعَيِيتُ بهذا الأَمْر وعنه، إذا لم أَهْتَدِ لوجههِ، وأعياني الأَمْرُ أنْ أضْبِطَه. والدَّاءُ العَياءُ: الذي لا دَواءَ له. ويقال: الدَّاءُ العَياء الحُمْقُ. والإعْياءُ: الكَلالُ. والمُعاياة: أن تَأتي بكَلام، لا يُهْتَدَى له. والفَحْلُ العَياءُ: الذي لا يَهتَدِي لضراب الشَّوْل. والعَيَاياءُ من الإبل: الذي لا يَضْرِبُ ولا يُلْقِحُ، وكذلك من الرِّجال.
وعي: وَعَى يَعِي وَعْياً: أيْ حَفِظ حديثاً ونحوه. وَوَعَى العَظْمُ: إذا انجَبَرَ بعدَ كَسْرٍ، قال
دلاث دلعثي «16» ، كأن عظامه ... وعت في محال الزور بعدَ كُسُورِ «17»
وقال أبو الدُّقَيْش: وَعَتِ المِدَّةُ في الجُرْحِ، ووَعَتْ جايئَتُه يَعْني مِدَّتُه. وأَوْعَيتُ شَيئاً في الوِعاء وفي الإِعاءِ، لغتان. والواعِيةُ: الصُّراخُ على المَيِّتِ ولم أسمع منه فعلا. والوَعَلأ «18» : جَلَبَةٌ وأصْواتٌ للكِلابِ إذا جَدَّتْ في الطَّلَبِ وهَرَبَتْ «19» . قال:
عَوابِساً في وعكة تحت الوعا «20»
__________
(15) لم نجد البيت ولا قائله.
(16) كذا في الأصول المخطوطة، في اللسان: دلعثى (مقصور) وهو سهو.
(17) البيت في اللسان والتاج: دلعث.
(18) كذا في س في ص وط: الوعاء.
(19) كذا في ص في ط: هرت.
(20) لم نهتد إلى الراجز.
(2/272)
________________________________________
جَعَلَه آسْماً من الواعِية. وإذا أَمَرْتَ من الوَعَى قُلْتَ: عِهْ، الهاءُ عِمادٌ للوُقُوفِ الإبتِداءُ والوُقُوفُ على حرف واحد. والوَعْوَعَةُ: من أصواتِ الكلاب وبنات آوَى وخَطيبْ وَعْوَعٌ: نَعْتٌ له حَسَنٌ، قالت الخنساء:
هو القَرْمُ واللَّسِنُ الوَعْوَعُ «21»
رَجُل وَعْواعٌ، نَعْتٌ قبيحٌ: أي مِهْذار، قال:
نِكْسٌ من القوم ووغواه وعيّ «22»
وكَقَول الآخَر:
تَسْمَعُ للمَرْءِ به وَعْواعا
وتقولُ: وَعْوَعَتِ الكلبة وَعْوَعةً، والمصدَرُ الوَعْواع، لا يُكْسَرُ على وِعْواع نحو زِلْزال كراهيةً للكَسْر في الواو. وكذلك حكاية اليَعْيَعَة من الصَّوتِ: يَع، واليَعْياع، لا يُكْسَر. وإنَّما يَع من كَلامِ الصِّبيان وفِعالِهم، إذا رَمَى أَحَدهُم الشَّيْءَ إلى الآخَر، لأنَّ الياءَ خِلْقَتُها الكَسْرة فَيَسْتَقْبِحُونَ الواو بينَ كَسْرَتَيْن. والواو خِلْقَتُها من الضَمَّة فيستقبحون التِقاءَ كَسْرةٍ وضَمَّةٍ، ولا تَجِدها في كلام العرب في أصل البناء سِوى النَّحوْ «23» .
__________
(21) في الديوان ص 55:
هو الفارس المستعد الخطيب ... في القوم واليسر الوعوع
(22) من اللسان (وعع) . وفي الأصول:
لا نكس في القوم وعواع ولا وعق
ويروى: وعي. وهو مصحف ومحرف.
(23) انتهى كلام الليث في التهذيب بقوله: في أصل البناء، ولعل عبارة سوى النحو قد اندست سهوا.
(2/273)
________________________________________
باب الرُباعيِّ من العين
قال الخليل: سَمِعْتُ كلمةً شَنعاءَ لا تَجُوزُ في التأليف الرُباعيِّ. سُئِل أعرابيٌّ عن ناقته فقال: تَرَكْتُها تَرْعَى العُهْعُخ، فَسأَلْنا الثِقاتِ من عُلَمائهم فأنكَروا أن يكونَ هذا الإسْمُ من كلام العرب. وقال الفَذُّ منهم: هي شَجَرَةٌ يُتَدَاوَى «1» بوَرَقِها. وقال أعرابيٌّ: إنَّما هو الخُعْخُعُ، وهذا موافق لقياس العربية.
__________
(1) في التهذيب 3/ 264: يتداوى بها وبورقها. وقد ساق الخبر كله عن الليث.
(2/274)
________________________________________
هجرع: الهِجْرَعُ من وصف الكلاب السَّلُوقيّةِ الخِفافِ. والهِجْرَع: الطويلُ المَمْشُوق، الأهْوَجُ الطَّول، قال العّجّاج «1» :
أَسْعَرُ ضَرْباً وطُوالاً هجْرَعا
والهِجْرَع: الأحْمَقُ من الرجال، قال: الشاعر «2» :
فلأقْضِيَنَّ على يَزيدَ أميرِها ... بقَضاءِ لا رِخْوٍ وليس بهِجْرَعِ
وأنشد عَرّام «3» :
إذا أنتَ لم تخلِطْ مع الحِلْمِ طِيرةً ... من الجَهْلِ ضامتك اللئام الهجارع
__________
(1) الرجز (لرؤبة) . انظر الديوان ص 90، وقبله:
يقدمن سواس كلاب شعشعا
(2) البيت في التهذيب (هجرع) غير منسوب، ومثل ذلك في اللسان.
(3) وهذا مما تفرد به كتاب العين من الشواهد.
(2/275)
________________________________________
هجنع: والهَجَنَّعُ: الشيخُ الأصْلَعُ وبه قُوَّة. والظَّليمُ الأقرع. والنَّعامة. هَجَنَّعَة، قال:
جَذْباً كرأس الأقرَعِ الهَجَنَّعِ
والهَجَنَّعُ من أولاد [الإبِلِ] «4» ما يُوضَعُ في حَمارّة الصَّيْف قَلَّما يَسْلَم حتى يقرَعَ رأسُه.
عنجه: العُنْجُهُ: الجافي من الرجال، وفيه عُنْجُهِيَّة أي جَفْوةً في خُشُونة «5» مَطْعَمِه وأموره، قال حَسّانُ بنُ ثابت:
ومن عاشَ منّا عاشَ في عُنْجُهِيّةٍ ... على شَظَفٍ من عَيْشِهِ المتَنَكِّدِ
وقال رُؤبة:
بالدَّفْع عَنّي دَرْءَ كلّ عنجه «6»
والعُنْجُهةُ: القُنْفُذُةُ الضَّخْمةُ.
عجهن: والعُجاهِنُ: صديقُ الرجُل المُعْرِسِ الذي يَجرِي بيْنَه وبيْنَ أَهلِه بالرسائل، فإذا بَنَى بأهله فلا عُجاهِنَ له، قال:
ارجِعْ إلى أهْلِكَ يا عُجاهِنُ ... فقد مَضَى العرس وأنت واهن «7»
__________
(4) سقط من الأصول المخطوطة وأثبتناه من التهذيب واللسان.
(5) كذا في الأصول المخطوطة واللسان في التهذيب: جشوبة.
(6) ديوانه/ 166.
(7) الرجز في اللسان (عجهن) وروايته: ارجع إلى بيتك ...
(2/276)
________________________________________
والماشِطةُ عُجاهِنةٌ إذا لم تُفارِقْها حتى يُبْنىَ بها. والمرأةُ عُجاهِنة، وهي صديقةُ العَروس. والفِعلُ تَعَجْهَنَ تَعَجْهُناً، قال:
يُنازِعْنَ العَجاهِنَةَ الرِّئينا «8»
جمعُ العُجاهِن، قال عرّام: العُجاهِنُ من الرجال: المخلوط الذي ليس بصريح النَسَب «9» . ويقال فيه عُنْجُهيَّةٌ وعُنْزُ هْوَةٌ وهما واحد.
عمهج: العُماهِج: اللَّبَنُ الخاثِرُ من ألبان الإبِل، قال:
تُغذَى بمَحْضِ اللَّبَنِ العُماهِج
عجهم: العُجهُوم: طائرٌ من طَيْر الماء منقارُهُ كجَلَمِ الخيَاط
. علهج: المُعَلْهَج: الرجل الأحمقُ المَذِر اللئيم الحَسَب المُعجب بنفسه، قال:
فكيف تُساميني وأنت معلهج ... هذارمة جعد الأناملِ حَنْكَلُ «10»
والمُعَلْهَج: الدَّعِيّ. وقال بعض الأعراب: العَلْهَج شجر ببلادنا معروف.
__________
(8) الشطر عجز بيت (للكميت) وصدره
وينصبن القدور مسمرات
انظر اللسان (عجهن) .
(9) إذا كان عرام هو ابن الأصبغ المتوفى سنة 275 هـ فلا يمكن أن يكون ممن روى عنهم الخليل، وقد فاتنا ذكر هذه الفائدة في المرات السابقة التي ذكر فيها عرام مثل الصفحة 97، وقد يكون عرام هذا غير ابن الأصبغ
(10) في حاشية التهذيب 3/ 265 ينسب إلى الأحطل والصاغاني ينفي النسبة.
(2/277)
________________________________________
عنبج: العُنْبُج: الثقيل من الناس. العُنْبُج «199» : الضَّخْم الرخْو الثقيل من كلّ شيءٍ، وأكثر ما يوصَفُ به الضِبعان، قال:
فوَلَدَتْ أعْثى ضَرُوطاً عنبجا «200»
علهص: علهَصْتَ القارورة إذا عالجتَ صمامَها لتَستخرجه «11» . وَعَلْهَصْتَ العَيْنَ إذا استخرجْتَها من الرأس علهصةً، وهو ملاجكها بإصبَعك واستخراجُكَها من مُقلتها. وعَلْهَصتُ الرجل: عالجتهُ علاجاً شديداً. وَعَلْهَصْتُ منه شيئاً: إذا نِلْتُ شيئاً. وَلحْمٌ مُعَلْهَصٌ أي لم ينضج بعد.
علهس: قال عرّام: عَلْهَسْتُ الشَّيءَ مارَستُهُ بشدَّة «12» .
همسع: الْهَمَيسَع من الرجال: القَويّ الذي لا يُصرع جَنْبُه، ويقال للطَّويل الشَّديد هَمَيْعَ. والهَميع جَدُّ عدنانَ بن أُدَد.
علهز: العِلْهزِ كان يُفْعَلُ في الجاهلية، يُعالَج الوَتر بدماءِ الحَلَمَ فيأكلونه، قال:
وإنَّ قِرى قحطانَ قِرْفٌ وَعِلْهِزٌ ... فَأَقبَح بهذا وَيحَ نَفسِك مِن فِعْلِ 1»
والعِلْهِز: القرادُ الضَّخم: والقِرفُ: نبتُ يَنْبُتُ نبْتةَ الطَّرانيث يخرجُ مع المَطر في وقت الصَّيف وفي وقت الخريف مِثلَ جِروِ القِثّاء، إلاَّ أنَّها حمراءُ مُنْتَنَةُ الريح. قال عرّام: والعِلْهِزُ يَنبتُ ببلادِ بني سليم وهو نبت
__________
(199) أدرجت هذه المادة في حشو مادة عجرم.
(200) الرجز في التهذيب واللسان (عنبج) .
(11) إلى هنا ينتهي ما جاء عن هذه الكلمة في المعجمات الأخرى. وما بقي مما تفرد به كتاب العين.
(12) لم ترد هذه الكلمة في اللسان والتهذيب.
(13) البيت من شواهد التهذيب وهو بلا غرو.
(2/278)
________________________________________
شِبْهُ الجِراءِ إلاّ أنَّها مُعَنْقَرةٌ أي لها عُنْقُرةٌ. قال: وأقول شاةٌ مُعَلْهَزَة أي ليست بسمينة «14» .
هزلع: الهِزْلاع: السِّمْعُ الأزَلُّ. وهَزْلَعَتُه: انسِلالُهُ ومُضُيُّه.
عزهل: العُزْهُل: الذَّكَرُ من الحَمام، وجمعه عَزاهِل، قال:
إذا سَعْدانةُ الشَّعَفاتِ ناحَتْ ... عَزاهِلُها، سَمِعْتَ لها عَرينا
أي بُكاءً «15» . وقالَ بعضُهم: العَزاهيلُ الجماعةُ من الإبِلِ المهمَلة، واحدُها عُزْهول، وقالَ بعضهم: لا أعرف واحدَها، قال الشَّمّاخ:
حتّى استغاثَ بأحْوَى فوقَه حُبُكٌ ... يدعُو هَديلاً به العُزْفُ العَزاهيلُ «16»
والقولُ الأول أشبه بالصَّواب. والعَزْاهِل «17» : الأرضُ لا تُنْبِتُ شيئاً، الواحدة عُزْهُلة.
زهنع: وتقول: زَهْنَعتُ المرأة وزَتَّتُّها: زيَّنْتُها بالصَّواب!؟ «18» قال:
بني «19» تَميم زَهْنِعُوا نِساءَكم ... إنَّ فتاةَ الحَيِّ بالتزتت
__________
(14) ليس هذا المعنى في أي من المعجمات سوى كتاب العين.
(15) في اللسان: قال ابن الأعرابي: العرين الصوت.
(16) لم أجد البيت في الديوان.
(17) هذا مما تفرد به كتاب العين.
(18) وردت كلمة الصواب في ص وط ولم أجدها في س ولا في المعجمات الأخرى وأظنها من تزيد الناسخ.
(19) في ص وط: أبني تميم ... ورواية البيت في اللسان:
بني تميم زهنعوا فتاتكم............... ..........
(2/279)
________________________________________
هطلع: الهَطَلَّعُ: الرجلُ الجسيم العريض المضطَرِب الطُوال «20» . ويقال: بَوْشٌ «21» هَطَلَّع أي كثير.
عيهر: العَيْهَرَةُ: الفاجرة عَهَرَتْ وتَعَيْهَرَتْ. والعَيْهَرَةُ: الشَّديدة من الإبِلِ، والتَيْهَرَةُ «22» أيضاً. ورجلٌ عَيْهَرٌ تَيْهَر أي شديد ضخم.
هرنع: الهُرْنُوع: القَمْلةُ الضَخْمة، ويقال: هي الصغيرة. قال عرّام: لا أعرفُ الهرنوع ولكنّه الهِرَنَّعة، وهو الحِنْبجُ والهُرْنُع، قال جرير:
يَهِزُ الهَرانعَ لا يَزالُ كأنَّه «23»
هزنع: الهُزْنُوع «24» ، ويقال هو بالغين المعجمة: هو أُصُول نَباتٍ شِبْهِ الطُّرْثُوث.
هرمع: الهَرْمَعَةُ: السُّرْعة. اهْرَمَّعَ في مَشْيه ومَنْطِقِهِ كالإنهِماكِ فيه اهرمّاعاً. والعَيْن تهَرَمِّعُ إذا ذَرَفَتِ الدَّمْعَ سريعاً. والنَّعْت هَرَمَّع ومُهْرَمِّع. واهْرَمَّعَ
__________
(20) في اللسان: المضطرب الطول.
(21) في اللسان: بؤس. والبوش: الجماعة.
(22) لم نجده في المعجمات ولعله من ألفاظ الإتباع.
(23) كذا في س في ص وط: يهز الهرنع ... والبيت في التهذيب 3/ 268 وروايته:
يهز الهرانع عقده عند الخصى ... يا ذل حيث يكون من يتذلل
وكذلك في اللسان. وليس في ديوان جرير. وقد نسب في التاج إلى (الفرزدق) .
(24) لم يرد في سائر المعجمات، وهو مما تفرد به كتاب العين.
(2/280)
________________________________________
إليه الرجُل أي تَباكَى. ورجُلٌ هَرَمَّعٌ: سريعُ البُكاء، والهَلَمَّعُ لغةٌ فيه عن عَرّام. والهَلْمَعَةُ والهَرْمَعَةُ: السُّرعةُ في كلّ شيءْ.
عرهم: العُراهِم: التّارُّ الناعِمُ من كلّ شيءٍ، قال: «25»
وقَصَباً عُراهِماً عُرْهوماً «26»
وقال بعضُهم: العُراهِم الطَّويلُ الضَّخْم، قال «27» :
فَعَوَّجَتْ مُطَّرِداً عُراهِما
وقال بعضُهم: العُراهِم نعْتٌ للمؤنَّث دونَ المذكَّر. وقال آخر: الذَّكرَ عُراهِم والأُنْثى عُراهِمة.
عبهر: العَبْهَر: اسْمٌ للنَّرجِس، ويقال للياسَمين. وجاريةٌ عَبْهَرَةٌ: رقيقةُ البَشَرَة ناصعةُ البَياض، قال:
قامَتْ تُرائيكَ قَواماً عَبْهَرا «28»
العَبْهَر: الناعم من كلّ شيءٍ، قال الكميت:
مِلء عينِ السَّفيه تُبْدي لك الأشنب ... منها والعبهر الممكورا «29»
__________
(25) التهذيب 3/ 269 غير منسوب أيضا.
(26) ورواية الرجز في التهذيب:
وقصبا عفاهما عرهوما
(27) لم نهتد إليه.
(28) جاء في اللسان: وأنشد (الأزهري
قامَتْ تُرائيكَ قَواماً عَبْهَرا ... منها ووجها واضحا وبشرا
لو يدرج الذر عليه أثرا
(29) لم أجد البيت في شعر (الكميت) .
(2/281)
________________________________________
ورَجُلُ عَبْهَر أيْ ضَخْم، وامْرأةٌ عَبْهَرَةٌ، ويُجْمَعُ عَباهِر وعَباهير، قال «30» :
عَبْهَرَةُ الخَلْقِ لباخية ... تزينه بالخلق الظاهر
علهب: العَلْهَب: التَّيسُ الطويل القَرْنَيْن من الوَحْشِيَّة والإِنْسِيّة ويوصف به الثَّور الوحشيُّ، وجمعه عَلاهِب، قال جرير.
إذا قَعِسَتْ ظهورُ بنات تَيْمٍ ... تَكشَّفُ عن عَلاهِبةِ الوُعُولِ
أي عن بُظُورٍ «31» كأنَّها قُرونُ الوُعُول. والعَلْهَب: الرجُلُ الطَّويلُ، والمرأةُ بالهاء.
عبهل: ومَلِكٌ مُعَبْهَل: لا يُرَدُّ أمرُه في شَيْءٍ.
هبلع: والهِبْلَع: الأَكُولُ، العظيمُ اللَّقْم، الواسِعُ الحُنْجُور، وأنشَدَ عرّام «32» :
وُضِعَ الخزيرُ فقيلَ أينَ مُجاشِعٌ ... فشَحَا «33» جَحافِلَه جراف هبلع
__________
(30) هو (الأعشى) . ديوانه/ 139 وفيه: بلاخية.
(31) كذا في الأصول المخطوطة وفي اللسان: بطون.
(32) البيت (لجرير) . نظر الديوان ص 437، وانظر هامش مادة عجهن.
(33) كذا في س واللسان. في ص وط: فشجا.
(2/282)
________________________________________
والهِبْلَعُ من أسماء الكلابِ السَّلُوقيَّة، قال العجّاج:
والشَدُّ يدني لا حقا وهِبلَعاً «34»
هلبع: الهُلابع: اللئيمُ الجَسيمُ الكُرَّزيُّ، قال:
وقُلْتُ لا آتي «35» زُرَيْقاً طائِعاً ... عبد بني عائشة الهلابعا
هملع: الهَمَلعَّ: الرجُلُ المُتَخطِرفُ الذي يُوَقِّع وَطْأه تَوقيعاً شديداً، قال:
رأيت الهَمَلَّع ذا اللعوتين ... ليس بآبٍ «36» ولا ضَهْيَدِ
ضَهْيَد كلمة مُوَلَدة لأنَّها على بناء فَعْيَل، وليس فَعْيَل من بناء كَلام العرب، قال:
جاوَزْتُ «37» أهوالاً وتَحْتيَ شَيْقَبٌ «38» ... يَعْدو برحْلي كالفنيق هَمَلَّعُ
هنبع: الهُنْبُع والخُنْبُع: من لِباس النِّساء شِبْهُ مِقْنَعةٍ خِيط مُقدَّمُها تلبَسها الجواري. ويقال: الهُنْبُع ما صَغُر، والخُنْبُع: ما اتَّسَعَ حتّى يبلُغَ اليَدَيْن «39» ويُغطِّيهما.
__________
(34) الرجز (لرؤبة) ديوانه ص 90، وفيه: والشد يذري....
(35) كذا في س والتهذيب في ص وط: زريعا.
(36) كذا في س والتهذيب أما في ص وط ففراغ.
(37) في الأصول المخطوطة: تجاوزت.
(38) اللسان (هملع) ، غير منسوب أيضا.
(39) كذا في اللسان والتهذيب. في الأصول المخطوطة: الثديين.
(2/283)
________________________________________
عفهم: العُفاهِم: النّاقةُ الجَلْدة، ويجمَعُ عَفاهيم، قال:
يَظَلُّ من جاراه في عذائم ... من عنفوان جريه العفاهم «40»
يصفُ أوَّل شَبابه وقوّته. وفي لغة عُفاهِن، بالنُّون، والنُّون يجعَلُونَها بدلاً من اللام، يقولون: اسماعِين في اسماعيل واسرافين وقد رُوِيَ في الحديثِ بالنّون. وقال:
وقَرَّبوا كلّ وأًي عُراهِمِ ... من الجَمالِ الجِلَّة العَفاهِمِ
علهم: العُلاهِمُ والعُلاهِمةُ «41» : القويّة الشّديدة من الإبل، وجمعُه عَلاهيم.
خضرع: الخُضارِعُ: البخيل المُتَسَمِّحُ وتَأْبَى شِيمتُه السَّماحة. وهو المُتَخضرِع.
خرعب: الخُرْعُوبة «42» : القطعةُ من القَرْعة والقِثّاء والشَّحْم. الخَرْعَبَةُ: الشَّابةُ الحسَنةُ القوام، وكأنَّها خُرعُوبةٌ من خَراعيب الأغصان من بَنات سَنَنها. ويقال: جَمَل خُرْعُوب أيْ طويلٌ في حُسْن خلق.
__________
(40) التهذيب 3/ 269 ونسب فيه إلى غيلان.
(41) في التهذيب 3/ 273 العلهم بكسر فسكون ففتح فتشديد الضخم العظيم من الإبل، وأنشد:
لقد غدوت طاردا وقانصا ... أقود علهما أشق شاخصا
(42) كذا في الأصول المخطوطة واللسان في التهذيب: الخذعوبة.
(2/284)
________________________________________
خثعم: خَثْعَمٌ: اسمُ جبَل، فمن نَزَلَ به فهو خَثْعَميٌّ، وهم خَثْعَميُّون. وخَثْعَم: اسم قبيلة وافق اسمُها اسم الجبَل «43»
ختعر: الخَيْتَعُور: ما بَقيَ من السَّرابِ من آخره حتى يَتَفَرَّقَ فلا يَلْبَث أن يضمَحِلَّ. وخَتْعَرَتُه: اضْمِحلالُه. ويقال: بَل الخَيْتَعُور دُوَيْبة على وجْه الماء لا تَلْبَثُ في مواضِع «44» إلاّ رَيْثَما تَطْرِف. وكلّ شيءٍ لا يدُومُ على حالٍ ويَتَلَوَّنُ فهو خَيْتَعُور. والخَيْتَعُور: الذي يَنْزِل من الهواءِ أبيضَ كالخُيوط أو كَنَسْج العَنْكبُوت. والدُّنيا خَيْتَعُور، قال 4»
:
كُلُّ أُنْثَى وإنْ بدا لك منها ... آيةُ الحُبِّ، حُبُّها خَيْتَعُورُ
والغُول: خَيْتَعُور. والذّئبُ خَيْتَعُور لأنّه لا عَهْدَ له، قال «46» :
ماذا «47» يُتمُكَ والخَيْتَعُور ... بدارِ المَذَلَّةِ والقَسْطَلِ
ويقال: هو الداهية هاهنا.
خرفع: الخُرْفُعُ: القُطْن الذي يَفسُدُ في براعيمه.
خنبع: الخُنْبُعةُ: شِبهُ القُنْبُعة تُخاطُ كالمِقْنَعة تُغَطِّي المَتْنَيْن. والخُنْبُعُ أوسَعُ وأعرَفُ عند العامّة. والخُنْبُعَةُ: مَشَقُّ ما بين الشاربين بحيال الوترة.
__________
(43) في الأصول المخطوطة: اسمه.
(44) كذا في الأصول المخطوطة في التهذيب: موضع.
(45) لم نتبين قائل البيت في كثير من المصادر.
(46) لم نهتد إلى قائل البيت.
(47) لعله: وماذا.
(2/285)
________________________________________
قعضب: القعْضَبُ: الضَّخْم الشَّديدُ الجَريء. والقَعْضَبَةُ: استِئصال الشَّيء. وقَعْضَبٌ: اسمُ رجل كان يعمَلُ الأسِنَّة في الجاهلية، وهو الذي ذكرَه طفيل الغنوي:
وعُوْج «48» كأحْناءِ السَّراءِ مطت بها ... ضراغم «49» تهديها أسِنَّةُ قَعْضَبِ
دعشق: الدُّعْشُوقةُ: دويبة شِبْهُ خُنْفُساء. وربَّما قالوا للصَّبيَّة والمرأةِ القصيرة: يا دُعْشُوقةُ، تشبيهاً بتلك الدُّوَيْبة، وليستْ بعربيّةٍ مَحْضَةٍ لتَعْريتها من حروف الذلق والشفوية.
قعشم: والقَشْعَمُ: النَّسْرُ المُسِنُّ والرَّخَم والشَّيخُ الكبيرُ فإذا شدَّدت الميم كَسَرتَ القافَ. وكذلك بناءُ الرُّباعِيِّ المُنْبسط إذا ثُقِّلَ آخرُه كُسِرَ أوَّله كقول العجّاج:
إذ زعمت ربيعةُ القِشْعَمُّ «50»
وتُكنى الحَرْبُ أم قَشْعَم. والضَّبع يُكنى به أيضاً.
عشرق: العِشْرِقُ: حَشيش وَرَقُه شبيه بوَرَق الغار إلاّ أنَّه أعظم، إذا حَرَّكَتْه الرِّيحُ سَمِعتَ له زَجَلاً شديداً، قال الأعشى:
__________
(48) كذا في الديوان ص 5 في الأصول المخطوطة: وعرج.
(49) كذا في س وقد سقطت من ص وط. وهي في الديوان: مطارد.
(50) ديوانه/ 422.
(2/286)
________________________________________
تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت ... كما استعان «51» بريح عِشْرِقٌ زَجِلُ
ويقال: هي شَجَرة كشَجَرة الباقِلَّى لها سِنْفَة «52» كسِنْفِة الباقِلَّى وهو وِعاء «53» حَبِّهِ، أي قِشره عليه، وقال «54» :
لولا الأماضيحُ وحَبُّ العِشْرِقِ ... لَمِتُّ بالنَّزْواءِ مَوتَ الخِرْنِقِ
خَصَّ الخِرْنِق لأنّه يموتُ سريعاً.
عشنق: والعَشَنَّق: الطويلُ الجسيم. وهو العَشَنَّظ أيضاً. وامرأةً عَشَنَّقةٌ: طويلة العُنُق. ونَعامَةٌ عَشَنَّقة. والجميع عَشانِق وعَشانيق وعَشَنَّقُون «55» .
قشعر: القُشْعُر: القِثّاء بلغةِ أهل الجَوْفِ من اليَمَن. الواحدة بالهاء. ويقال: القُشَعْريرة، العَيْنُ ساكنةٌ: اقشِعْرار الجِلْد من فَزَعٍ ونحوه. وكُلُّ شيءٍ تَغَيَّر فهو مُقْشَعِرٌ. واقشَعَرَّتِ السَّنَةُ من شِدَّة المَحْل. واقشَعَرَّتِ الأرضُ من المحل، والجِلْدُ من الجَرَبِ.
__________
(51) ديوانه/ 55.
(52) كذا في س في ص وط: سنقة بالقاف وهو تصحيف.
(53) كذا في ص وط في س: دواء.
(54) لم نهتد إلى القائل.
(55) إذا كان وصفا للعاقل المذكر.
(2/287)
________________________________________
واقشَعَرَّ النَّباتُ إذا لم يجدْ رِيّاً. والقُشَعريرة مثلُ الإقشعرار، قال «56» .
أصْبَحَ البيتُ بيتُ آلِ بَيانٍ «57» ... مُقْشَعِرّاً والحيُّ حَيُّ خَلوفُ
صقعر: الصُّقْعُرُ: الماءُ المُرُّ الغَليظ.
عرقص: العُرْقُصاء والعُرَيْقِصاء: نَبات يكون بالباديةِ. وبعضٌ يقول للواحدة: عُرَيْقصانة، والجميع: عُرَيْقِصان. ومن قال: عُرَيْقصاء وعُرْقُصاء فهو في الواحدة والجميع ممدودٌ على حالٍ واحدة.
قصعر: القِنْصَعْرُ: القصير العُنُق والظَّهْر المُكَتَّل من الرجال، قال:
لا تَعْدِ لي بالشَّيْظَم السِّبَطْر ... الباسِطِ الباعِ الشَّديدِ الأسْرِ
كلُّ لئيمٍ حَمِقٍ قِنْصَعْرِ «58»
وامرأةً قِنْصَعْرة. ويقال: ضَرَبْتُه حتى اقعَنْصَرَ أي تقاصَرَ إلى الأرض.
صعفق: الصَّعافِقَةُ: قومٌ يَشْهَدون السُّوق للتِّجارة ليست لهم رءوس الأموال، فإذا اشتَرَى التُّجّار شيئاً دخلوا معهم. الواحدُ صَعْفَقٌ وصَعْفَقيٌّ، ويُجمعُ على صَعافيق وصَعافِقة، قال أبو النجم:
__________
(56) هو (أبو زبيد الطائي) كما في التهذيب واللسان.
(57) كذا في التهذيب واللسان في ص وط:
أصبح البيت بنت البنان
وفي س:
أصبح النبت نبت آل بنان
(58) كذا في الأصول المخطوطة و (اللسان أما في التهذيب فبضم القاف.
(2/288)
________________________________________
بهم «59» قَدَرنا والعزيزُ مَنْ قَدَرْ ... وآبتِ الخَيلُ وقَصَّينا الوَتَر «60»
من الصَّعافيق وأدْرَكْنا المِيَر «61»
ويقال: الصَعْفُوق اللِّصُّ الخَبيث. والصَّعْفُوقُ: اللئيم من الرجال، وكان آباؤهم عَبيداً فاسْتَعْرَبوا قال العجّاج:
من آلِ صَعْفُوقٍ وأتباعٍ أُخَرْ «62»
قال أعرابيٌّ: هؤلاء الصَّعافِقة عندَك، وهم بالحجاز مسكنهم، وهم رُذالةُ الناس. ومنهم من يقول بالسين.
صلقع، سلقع: الصَّلْقَعُ والصَّلْقَعَةُ: الإعدامُ. تقول: صَلْقَعَةُ بنُ قَلْمَعةَ: أي ليسَ عنده قليلٌ ولا كثير، لأنّه مُفْلِسٌ وأبوه مِن قَبله، فلذلك قال: ابنُ قَلْمَعة. يقال: صَلْقَعَ الرّجل فهو مُصَلْقِعٌ أي عَديم مُعدم، ويجُوز بالسين. وهو نَعْتٌ يَتْبَعُ البَلْقَعَ، يقال: بَلْقَعٌ سَلْقَعٌ وبَلاقِعُ سَلاقِعُ، ولا يُفرَدُ. والسَّلْقَعُ: الأرضُ التي ليسَ فيها شَجَرٌ ولا شَيْءٌ. والسَّلْقَعُ: المكان الحَزْنُ، والحَصَى إذا حَمِيتْ عليه الشَّمْسُ. وتقول: اسلَنْقَعَ بالبَرْقِ واسْلَنْقَعَ البَرْقُ إذا استَطارَ في الغيم، وإنَّما هي خَطْفَةٌ لا لُبْثَ لها. والسِّلِنْقاعُ: الاسم من ذلك.
__________
(59) الرجز في التهذيب واللسان على النحو الآتي:
يوم قَدَرنا والعزيزُ مَنْ قَدَرْ
(60) كذا في ص وط في س والتهذيب واللسان:
وآبت الخيل وقضينا الوطر
(61) كذا في الأصول المخطوطة، في التهذيب واللسان: المئر.
(62) وبعده:
من طامعين لا يبالون الغمر
ديوانه/ 12.
(2/289)
________________________________________
عسلق: وكل سَبعً جريءٍ على الصَّيْد فهو عَسْلَق وعَسَلَّقٌ «63» ، والأنثى بالهاء. [والجميع] «64» عَسالِق. والعَسَلَّقُ: اسمٌ للظَّليم خاصَّة، قال «65» :
بحيثُ يُلاقي الآبداتِ العَسَلَّقُ
عسقل: والعُسْقُولةُ: ضَرْبٌ من الجَبْأَةِ «66» ، وهي كَمْأَة لَونُها بين البياض والحُمْرة، ويُجْمَعُ عَساقِل، قال:
ولقد جَنَيْتُك أكمُؤاً وعَساقِلاً ... ولقد نَهيتك عن بناتِ الأَوْبَرِ
[وكان في النُسْخة كلاهما، يعني العُسْلوق والعُسقولة. ورجلٌ عَسْلَق، وامرأة بالهاء] «67» ، إذا كان خفيف المَشْي سريعاً. والعَسْقَلَةُ والعُسْقُولُ: لَمْعُ السَّراب وقِطَع السَّراب، ويجمع عَساقيلَ، قال «68» :
جَرَّدَ منها جُدَداً عَساقِلا ... تَجريدَكَ المصقُول والسَّلائلا
وعَسْقَلان «69» : موضع بالشام من الثغور «70» .
__________
(63) في الأصول المخطوطة: وعسليق، ولا وجود للعسليق في أي معجم.
(64) زيادة وهي مما يقتضيه الأمر.
(65) الشطر للراعي كما في التهذيب واللسان. وروايته في الأصول المخطوطة:
بحيث يلاقي الآبدات العسلقا
(66) كذا في س والتهذيب في ص وط: الجناة.
(67) وهذه العبارة من غير شك إضافة من الناسخ وقد حصرناها بين قوسين.
(68) هو (رؤبة بن العجاج) والرجز في (ديوانه ص 125 وروايته:
جدد منها جُدَداً عَساقِلا ... تَجريدَكَ المصقولة السلائلا
وفي ص وط: المسقول والسلائلا.
(69) كذا في س وص أما في ط: عسلقان.
(70) كان الأمر مختلطا بين اللادتين (عسلق) و (عسقل) فأرجعنا إلى كل منهما ما يخصه.
(2/290)
________________________________________
عسقف: العَسْقَفَةُ «71» : نقيض البُكاء. ويُقال: بَكَى فلانٌ وعَسْقَفَ أي جَمَدتْ عينُه فلم تَبْكِ. وكذلك إذا أرادَ البكاءَ فلم يقدِرْ عليه.
فقعس: فَقْعسُ: حَيٌّ من بني أسد.
صقعب: الصَّقْعَبُ: الطويل من الرجال.
عسقب: العِسْقِبةُ: عُنَيقيدٌ يكون منفرداً بأصل العُنْقُود الضَّخْم ويُجمعُ عَساقِب وعِسْقِب «72» .
قعمس وجعمس: القُعْمُوسُ والجُعْمُوسُ، ويقال بالصاد، قَعْمَصَ فلان إذا أبْدَى بمَرَّةٍ ووضع بمرّة. ويقال: قد تحرَّكَ قُعْمُوصُه في بَطْنه. والقُعْمُوصُ: ضربٌ من الكَمْأة.
قعسر: القَعْسَريُّ «73» : الرّجل الضَّخْمُ الشَّديدُ. وهو القَعْسَرُ أيضاً، قال العجّاج:
والدَّهْرُ بالإنسان دَوّاريُّ ... أفْنَى القرون وهو قعسري «74»
__________
(71) في اللسان: العسقبة جمود العين وقت البكاء. قال الأزهري: جعله الليث العسقفة بالفاء، والباء عندي أصوب.
(72) مثل ثمر وثمرة وقصيد وقصيدة.
(73) في التهذيب: وقال الليث: القعسري الجمل الضخم. وفي اللسان: القعسري من الرجال: الباقي على الهرم.
(74) الرجز في ديوان العجاج ص 310 وروايته فيه:
أفنى القرون وهو قسعري ... والدهر بالإنسان دواري
(2/291)
________________________________________
يصف الدَّهْرَ. والقَعْسَريُّ: الخَشَبَةُ التي تُدارُ بها الرَّحَى القصيرةُ التي تَطْحَنُ باليَد، قال:
الزَمْ بقَعْسَريِّها ... وألقِ في خُرْتيِّها «75»
تُطْعِمُكَ من نَفيِّها «76»
خُرتُيُّها: فَمُها تُلْقَى فيه اللُّهْوةُ. وعَبْدٌ قَعْسَرٌ: جَيِّدُ السَّقْيِ شديدُ النَّزْع. وقَعْسَرَ فلانٌ في مَشْيِهِ: إذا مَشَى مَشْياً مُتقاعِساً.
عقرس: عِقْرِسٌ: حيٌّ من اليمن
قنعس: القِنْعاسُ: الرّجلُ السَّيَّد المنيعُ. والقِنْعاسُ: الجَمَلُ الضَّخْمُ، قال جرير:
وابنُ اللَّبُونِ إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ ... لم يَسْتَطِعْ صَوْلةَ البُزْلِ القَناعيسِ
قنزع: القَنْزَعة والقُنْزُعة: التي تَتَّخِذُها المرأةُ على رأسها. والقَنْزَعةُ: الخصْلةُ من الشَّعر التي تُترَكُ على رأس الصَّبيّ، وتُجمَعُ قَنازِعَ، قال الكميت:
عاري المغَابِن لم يعبرُ بجُؤْجُئِه ... إلا القَنازعُ من زيزائه الزغب 7»
__________
(75) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة والتهذيب خريها. وروي خريها بالباء في اللسان.
(76) كذا في اللسان وص في التهذيب وط وس: نقيها بالقاف.
(77) لم نهتد إليه في شعر الكميت.
(2/292)
________________________________________
يقول: انْتُتِفَ شَعُر صَدرِه. والزِيزاءُ: عَظمُ الزَّوْر. والقُنْزُعة: ما يُتْرَك على قَرْنَي الرَّأس للصبيِّ من الشَّعر القصير لا من الطَّويل. والقُنْزُعةُ من الحجارة: أعظَمُ من الجَوْزة. القُنْزُعةُ «78» : المرأة القصيرةُ جداً «79» .
عنقز: العَنْقَزُ: من المَرْزَنْجُوش، قال الأخطل «80» :
ألا آسلَمْ سَلِمْتَ أبا خالدٍ ... وحيَّاكَ ربُّكَ بالعَنْقَزِ
وقال بعضهم: العَنْقَزُ جُرْدانُ الحِمار. والعَنْقَزُ: السمُّ الذُّعافُ «81»
قلعط: اقلَعَطَّ الشَّعرُ واقلَعَدَّ: وهو الجَعْدُ الذي لا يطولُ ولا يكونُ إلاّ مع صَلابةٍ. وقد اقلَعَطَّ الرّجل اقلِعْطاطاً، قال:
بأَتْلَعَ مُقْلَعِطِّ الرأسِ طاطِ «82»
أي مُنحدرٌ مُنْخَفِض، وقال غيرُه: اقْلَعَطَّ واقْلَعَدَّ واجْلَعَدَّ إذا مَضَى في البلاد على وجهه. والمُقْلَعِطُّ من الشَّعر: القصير.
__________
(78) كذا في الأصول المخطوطة واللسان أما في التهذيب: المقنزعة.
(79) جاء بعده: هذا في نسخة الحاتمي، وفي نسخة أخرى: القنزعة: المرأة الصغيرة جدا. وهذه أول إشارة إلى النسخ التي أخذت منها نسخ العين المخطوطة التي بين أيدينا وفيها نسخة الحاتمي ونسخة أخرى. وما حصر بين القوسين من كلام الناسخ.
(80) في اللسان: قال (الأخطل) يهجو رجلا. وروايته في التهذيب: أسلم سلمت ...
(81) لا توجد الذعاف في التهذيب فيما نقله عن الليث. وزاد: وقيل العنقز الداهية.
(82) كذا في التهذيب واللسان في الأصول المخطوطة: طاطي.
(2/293)
________________________________________
قمعط: اقمَعَطَّ [الرجل] «83» : عَظُم أعلى بَطْنِه وخمِصَ أسفلُه. [والقُعْمُوطة والقُمْعُوطة] «84» والبِقْعُوطة: دُحْروجة الجُعَل «85» .
قعطر: اقْعَطَرَّ الرجل: إذا انقَطَعَ نَفَسُه من بُهْرِ.
عندق: العَنْدَقةُ: مَوْضِعٌ في أسفل البَطْنِ عند السُرَّة كأنَّها ثَغْرةُ النَّحْر في الخِلْقَةِ.
عنقد: والعُنْقُودُ من العِنَب، وحَمْلُ الأراكِ والبطم ونحوه.
قردع: القردوعة: الزّاويةُ في شِعْبِ جَبَل، قال:
منَ الثَياتِلِ مَأْواها القَراديعُ
والقُرْدوعةُ أيضاً: أعلَى الجَبَل.
درقع: الدَّرْقَعَةُ: فِرارُ الرجُلِ من الشَّدة «86» ، قال:
وإنْ ثارَتِ الهَيْجاءُ وِلَّى مُدَرْقِعاً
وهو المُدَرْنقِعُ أيضاً. والدَّرْقَعَةُ: سُرعةُ المَشْيِ. جاءَ يُدَرْقِعُ أي يَمشي مَشْياً شديداً. والمُدْرَنْقِعُ في العَدْوِ.
__________
(83) مما يقتضيه السياق.
(84) مما نقله الأزهري في التهذيب عن الليث.
(85) وزاد الأزهري في التهذيب والعريقطة دويبة عريضة من ضرب الجعل عن الليث.
(86) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة والتهذيب: الشديدة.
(2/294)
________________________________________
قمعد: المُقْمَعِدُّ: الذي تُكَلِّمُه بجُهْدكَ فلا يَلينُ ولا يَنْقادُ. كَلَّمْتُه فاقْمَعَدَّ اقمِعداداً أي: انقَبَضَ. ومثله اقْمَهَدَّ.
عرقد: العَرْقَدَةُ: شدَّة فَتْلِ الحَبْلِ ونحوه من الأشياء كُلِّها.
ذعلق: الذُّعْلُوقُ «87» : نَباتٌ بالباديةِ.
قذعر: المُقْذَعِرُّ: المُتَعَرِّض للقَوْم ليدخُلَ في أمرهِم وحديثهم. ويَقْذَعِرُّ نَحوهم: يَرْمي بالكلمةِ بعد الكلمة وَيَتَزَحَّفُ نحوهم «89» وإليهم.
قذعل: والمُقْذَعِلُّ: السريع من كل شيء، قال:
إذا كُفيتُ أكْتَفي وإلاّ ... وَجَدْتَني أَرْمُلُ مُقْذَعِلاّ
قال غير الخليل «90» : المُقْذُعِلُّ السريع من كل شيء، والمقذعِرّ الخبيث اللسان مُقْذَعِلاًّ. قال: ويُروى مُشمعلاًّ «91» .
ذلقع: المُذْلَنْقِعُ «92» الذي قد انْخَلَعَ أيْ وَضَعَ جِلْبَابَ الحَياءِ فلا يبالي بشيء.
__________
(87) لم يرد هذا المعنى في التهذيب بل جاء في هذه المادة فوائد كثيرة أخرى.
(89) سقطت في التهذيب مما نقله الأزهري عن الليث.
(90) هذا مما أضافه النساخ.
(91) لقد جاء هذا في مادة منفردة بعد الكلام على (ذلقع) وآثرنا أن نرده إلى مكانه وذلك من قوله: قال غير الخليل.
(92) لم نجد هذه المادة في اللسان.
(2/295)
________________________________________
قنذع: القَنْذَعُ والقُنْذُع «93» ، بالفتح والضّمّ: الدَّيُّوثُ، وأظُنُّها بالسُّريانية.
قرثع: القَرْثَعُ: المرأةُ الجَريئةُ القليلةُ الحَياء.
قعثب: القَعْثَب: الكثير. والقُعْثُبان: دُوَيْبة كالخُنْفساء تكونُ على النَّبات، والقَعْثَبان أيضاً.
عرقب: عَرْقَبْتُ الدّابّةَ: قَطَعْتُ عُرْقُوبَها. والعُرْقُوبُ: عَقِبٌ مُوَتَّرٌ خلف الكَعْبَيْنِ، ومن الإنسانِ فُوَيق العَقِب، ومن ذَوات الأرْبَع بين مَفْصِل الوَظيف ومَفْصِل الساقِ من خَلْفِ الكَعبَيْنِ. والعُرقُوبُ من الوادي: مُنْحَنى فيه التِواءٌ شديد، قال:
ومَخُوفٍ من المناهل وحش ... ذي عراقيب آجِنٍ مدفانِ «94»
والعُرْقُوبُ: طريقٌ يكون في الجَبَل مُصَعِّداً. تَعَرْقَبْتُ الجَبَلَ: أي صَعِدتُ فيه. وعَراقيبُ الأمور: عَصاويدُها وادخال اللَّبْس فيها. وعُرْقُوبُ: رجلٌ من أهل يَثْرب أكْذَبُ أهل زَمانِه موعداً، فذَهَبَتْ مَثلاً، قال كَعْبُ بنُ زُهَير:
كانَتْ مَواعيدُ عُرْقوبٍ لها مَثَلاً ... وما مواعيدها إلا الأباطيل
__________
(93) في اللسان: القندوع والقندع (بضمتين) وبالدال، والقنذع بالضم والفتح والذال المعجمة، والقنذع (بضمتين) والقنذوع بالذال أيضا.
(94) البيت غير منسوب في اللسان والتهذيب.
(2/296)
________________________________________
وقال آخرُ:
وأكْذَبُ من عُرقُوبِ يَثْربَ لهجةً ... وأبْيَن شُؤْماً في الكَواكبِ من زُحَلْ «95»
وفي مَثَلٍ للعَرَب: مَرَّ بنا يومٌ أقْصَرُ عُرقُوبِ القَطا «96»
، يريدُ ساقَها. ويقال: أقْصَرُ من إبهامِ القَطاةِ، قال:
ويَوْمٍ كإبهامِ القَطاةِ مُمَلَّحٍ ... إليَّ صباه، مُعجِبٌ لِيَ باطِلُهْ «97»
قرعب: واقْرَعَبَّ البَرْدُ اقرِعباباً، واقْرَعَبَّ الانسانُ: أي قَعَدَ مُسْتَوْفِزاً.
عقرب: العَقْرَبُ: الأنثى والذَّكر فيه سواءٌ والغالِبُ التأنيث. ويقالُ للرّجل الذي يَقرِضُ النّاسَ: إنَّه لتدِبُّ عَقارِبُه. والعَقْرَبُ: سَيْرٌ مَضْفُورٌ في طَرَفه إبْزيمٌ يُشَدُّ به تَفَرُ الدّابّةِ في السَّرْج. والدّابّة مُعَقْرَبَةُ الخَلْقِ أي مُلَزَّزٌ مُجَمَّعٌ شديدٌ، قال العجّاج:
عَرْدَ التَراقي حَشْوَراً مُعَقْرَبا ... شَذَّبَ عن عَاناتِه ما شَذَّبا
والعَقْرَبُ: حَديدةٌ تكونُ في سَيْرٍ في مُؤَخَّر السَّرج، يُعَلَّقُ فيه الشَّيْء، أو يُكَلَّبُ به الدرْع. والعَقْرَبُ: بُرْجٌ في السَّماء، وهو بُرْجُ العَقْرَب، وطُلُوعُها في حَدِّ الشِّتاء. وقال قائل: إذا طَلَعَتِ العَقْرَبُ جَمَسَ «98» المُذَنِّب «99» وفَرَّ الأشيب ومات الحندب. قولُه: جَمَسَ أي: صارَ تمرا، ويقال:
__________
(95) لم نهتد إلى قائل البيت.
(96) في ط: أقصر مثل عرقوب القطاة.
(97) لم نهتد إلى القائل.
(98) كذا في الأصول المخطوطة، وفي اللسان (حمس) وهو تصحيف.
(99) هذا هو الوجه، وفي التهذيب واللسان: المذنب (بكسر الميم وفتح النون) .
(2/297)
________________________________________
لا بَلْ يَبقَى بُسْراً على حاله فلا يرطب، يعني: لا يَصِرُّ الجُنْدُب لِشدَّة البَرْد. والعُقْرُبان: دُوَيْبة، يُقال هو دَخَّال الآذان. ويقالُ: العَقْرَبان هو العَقْرَبُ الذَّكر.
عبقر: عَبْقَرٌ: موضعٌ بالبادية كثير الجنِّ. يقال: كأنَّهم جِنٌّ عَبْقَر، قال زهير:
بِخَيْلٍ عليها جِنَّةٌ عَبْقَريَّةٌ ... جَديرونَ يَوْماً أن يَنالوا فيَسْتَعلوا «100»
والعَبْقَرَةُ: المرأةُ التارَّةٌ الجميلةُ، قال الشاعر «101» :
تَبَدَّلَ حِصْنٌ بأزواجِهِ ... عِشاراً وعَبْقَرةً عَبْقَرا
أراد: عَبْقَرَةً عَبْقَرَةً، فذهَبَتِ الهاء في القافية وصارَت ألفاً بَدَلاً للهاء. والعَبْقَريُّ: ضربُ من البُسُط، الواحدة بالهاء، وقال بعضهم: عَباقِريّ، فإن أرادَ بذلك جَمْعَ عَبْقَريٍّ، فإنَّ ذلك لا يكون لأنَّ المنسوبَ لا يُجْمَعُ على نِسبةٍ ولا سيَّما الرباعيُّ، لا يُجْمَعُ الخثعمي بالخَثاعِميِّ ولا المُهَلَّبِيِّ بالمَهالِبيِّ، ولا يجوز ذلك ألا أن يكونَ يُنسب اسمٌ على بناء الجماعة بعدَ تَمامِ الاسم نحو شَيءٍ تنسِبُه إلى حَضاجِر وسَراويل فيقال: حضاجري وسَراويليٌّ، ويُنسب كذلك إلى عَباقِر فيقال: عَباقِريٌّ. والعَبْقَرةُ: تَلألُؤ السَّراب.
برقع: البُرْقُعُ: تَلْبَسُهُ الدَّوابُّ ونِساءُ الأعراب، فيه خَرْقان للعَيْنَين، قال «102» :
وكُنْتُ إذا ما زُرْتُ ليلى تَبَرْقَعَتْ ... فقد رابَني منها الغداة سفورها
__________
(100) شرح ديوان زهير ص 103.
(101) في التهذيب: الشاعر (مكرز بن حفص) .
(102) قائل البيت هو (توبة بن الحمير) كما في التهذيب.
(2/298)
________________________________________
فرقع: الفرقعة: [أن] تنقص الأصابع. وفَرْقَعَ أصابِعَه فَتَفَرْقَعَت. وتقول: افرَنْقِعُوا عنَّا: أي تَنَحَّوْا. وافْرَنْقَعَ: إذا قَعَدَ مُنْقَبِضاً.
عفقر: العَنْقَفير: داهِيةٌ من دَواهي الزَّمان، تقولُ: غُولٌ عَنْقَفير.
عرقل: العِرْقيلُ: صُفْرةُ البَيْض، قال الشاعر:
طِفلةٌ تَحسَبُ المَجاسِدَ منها ... زَعْفَراناً يُدافُ أو عرقيلا «103»
عنقر: العُنْقُر: أصلُ القَصَب ونحوه أوَّل ما ينبت، وهو رِخْوٌ غَضٌّ، الواحدة: عُنْقُرةٌ، وذلك قبل أن يظهَرَ في الأرضِ. ويقال لأولاد الدَّهاقين: عُنْقُر، شَبَّههُم بالعُنْقُر لترارتِهم ورُطُوبَتهم، قال «104» :
كعُنْقُرات الحائط المَسْطُور
قفعل: اقْفَعَلَّتْ أنامِلُه: إذا تَشَنَّجَتْ من بردٍ أو كبرٍ. وفي لغة: اقْلَعَفَّ اقْلِعْفافاً، قال:
رأيتُ الفَتَى يَبْلَى وإنْ طالَ عُمُره ... بِلَى الشنِّ حتى تَقْفعِلَّ أناملُه «105»
__________
(103) ويروى غرقيلا بالغين المعجمة كما في التهذيب.
(104) قائل الرجز (العجاج،) الديوان ص 223 وروايته فيه:
كعنقرات الحائط المسطور
وروايته في التهذيب:
كعنقرات الحائط المسجور
(105) لم نهتد إلى قائل البيت.
(2/299)
________________________________________
والبعيرُ يَقْلَعِفُّ إذا ضَرَبَ النّاقةَ فانضمَّ إليها يصيرُ على عُرقُوبَيْهِ مُتَعَمِّداً عليها، وهو في ضِرابِها يقال: اقْلَعَفَّها. واقْلَعَفَّ الرّجل: إذا تَقَبَّضَ. وإذا مدَدْت الشيءَ ثمَّ أرسَلْتَه فانْضَمَّ قلت: قد اقْلَعَفَّ.
عفلق: العَفْلَقُ: الفَرْجُ إذا كان واسعاً رِخواً، قال:
يا ابنَ رَطومٍ ذاتِ فَرْجٍ عَفْلَقِ
والعَفْلَقُ من الرّجال: الوَخْمُ الضَّخْم.
علقم: العَلْقَم: شَجَر الحَنْظَل، القِطْعَة: عَلْقَمةٌ.
قمعل: القُمْعُلُ: القَدَحُ الضَّخْم بلغةِ هُذَيْل، قال:
كالقُمْعُل المُنْكَبِّ فوقَ الأتْلَبِ «106»
الأتْلًب: التُّراب. يَنْعَتُ حافِرَ الفَرَس.
قعبل: «107» رجلٌ مُقَعْبَلُ القَدَمَيْن: إذا كان شديدَ القَبَل، اعْوِجاجُ صَدْرِ القَدَم مُقْبلاً إلى الأخرى وتلقبُه فتقول: يا قَعْبَل. (والقِعْبِل: ضربٌ من الكَمْأة ينبُت مُستطيلاً كأنّه عود فإذا يَبسَ وصارَ له رأسٌ مثلُ الدُّخْنَةِ «108» السَّوداء سمِّيتْ فوات الضباع) «109» .
__________
(106) الرجز في التهذيب وقبله: يلتهب الأرض بوأب حوأب. وروايته في اللسان: يلتهم الأرض ...
(107) قبل هذه الكلمة جاء في الأصول المخطوطة قال موسى وأظن أن هذه العبارة قد أدرجت سهوا من الناسخ.
(108) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب في اللسان: الدجنة.
(109) النص المحصور بين القوسين قد أدرج في غير هذا الموضع في الأصول المخطوطة.
(2/300)
________________________________________
قلعم، قلحم: القِلّعْم القِلّحْم: الشَّيْخُ الهَرِم، بالحاء أصْوَب.
عملق: عِملاقٌ: أبو العَمالِقة وهُم الجَبابرةُ الذينَ كانُوا بالشّام على عَهد مُوسَى ع-
بلقع: البَلْقَعُ: القَفْر لا شَيْءَ فيه. مَنْزِل بَلْقَعٌ ودِيارٌ بَلاقِعُ. وإذا كانت اسْماً مُنْفرداً أُنِّثَ، تقُولُ: انْتَهَيْنا إلى بَلْقَعَةٍ مَلْساءَ.
عقبل: العُقْبُول: ما يَبْثُرُ من الحُمَّى بالشَّفَتَيْن في غِبِّها. الواحِدةُ عُقبُولة، قال 11»
:
من وِرْدِ حُمَّى أسْأَرَتْ عَقابلا
ويُقالُ لصاحِب الشَّرِّ: إنَّه لذو عَقابيلَ، وذو عَواقيلَ.
عنفق: العَنْفَقَةُ: بينَ الشَّفَةِ السُّفلَى وبينَ الذَّقَن. وهي الشُّعَيْرات بينَهما، سالَتْ من مُقَدَّمة الشَّفَة السُّفلَى، تقوُل للرَّجُل: بادي العَنْفَقَةِ إذا عَرِيَ جانِباه من الشَّعر.
قنفع: القُنْفُعَةُ: القُنْفُذَةُ إذا تَقَبَّضَتْ، وقد تَقَنْفَعَتْ.
__________
(110) الرجز (لرؤبة) انظر الديوان ص 134.
(2/301)
________________________________________
القُنْفُعَةُ: الفُرْقُعَة وهي الأسْتُ بلغةٍ يمَانية، قال «111» ،
قَفَرْنِيَة كأنَّ بطَبْطَبَيْها ... وقُنْفُعِها طِلاءَ الأُرْجُوانِ «112»
والطُّبْطُبان: الثَّدْيان، وأنشد:
إذا طَحَنَتْ دُرْنيَّة «113» لعِيالها ... تَطَبْطَبَ ثَدْياها فطارَ طَحينُها
وقال هؤلاء الأعرابُ: القُنْفُعَةُ الاسْتُ. وهي العَزافةُ والعزافة والعَزّافة «114» والرَّمّاعةُ والصَّنّارةُ «115» والرمّازةُ والخَذَّافة.
قنبع: قَنْبَعَ الرجلُ في ثيابه: إذا دَخَلَ فيها. وقَنْبَعَتِ الشَّجرةَ: إذا صارت زَهْرَتُها في قُنْبُعةٍ أي في غِطاء. والقُنْبُعَةُ مثل الخُنْبَعَةِ إلا أنّها أصغَرُ.
قعنب: القَعْنَب: الشَّديدُ الصلب [من كل شيء] «116» ،
عضنك: العَضَنُّكُ: المرأةُ اللَّفّاء العَجُزِ التي ضاقَ مُلْتَقَى فَخِذَيْها مع تَرارَتِها، وذلك لكثرة اللحم.
__________
(111) اللسان (قنفع) غير منسوب أيضا.
(112) في الأصول المخطوطة: قرنبية.
(113) في ط: ذرنية (بالذال المعجمة) ، والبيت غير منسوب.
(114) لم نجد في المعجمات الموجودة هذه المادة.
(115) لا وجود للكلمة في المعجمات المتيسرة بهذه الدلالة وذلك لأن الصنارة والصفارة بالنون أو بالفاء تدلان على معان أخرى غير المنصوص عليها في كتاب العين.
(116) زيادة يقتضيها السياق، وهي كذلك في التهذيب.
(2/302)
________________________________________
عكرش: العِكْرِشُ: نبتٌ شبه قَرْنِ الثيْقَل «117» [ولكنه] «118» أشدُّ خشونةً منه، وفيه مُلُوحةٌ، لا ينبُتُ إلاّ في سَبخةٍ. والعِكْرِشةُ: الأرْنَبَةُ الضَّخمة وبها سُمِّيت الأرْنَبَةُ لأنَّها تأكل العِكرش، قال الشَّمّاخ:
تجر برأس عكرشة زموع «119»
وعِكراشٌ رجل كان أرْمَى أهلِ زمانِه، صاحِبَ قِفارٍ وفيافٍ، وله يقولُ الشاعر:
إذْ كانَ عِكْراشُ فتىً خِدْريّا ... سَمَّحَ واجْتابَ فلاةً فَيّا «120»
الخدريّ: المُقيمُ مع نسائِه لا يكادُ يَجتابُ الفَلاة.
صعلك: الصُّعْلُوكُ، وفِعْلُه التَّصَعلُكُ، ويُجمع الصَّعاليك، قال:
إن اتّباعَكَ مَوْلَى السُّوءِ تَتْبَعه ... لكالتَّصَعْلُكِ ما لم تَتَّخِذْ نَشبا «121»
وهم قومٌ لا مالَ لهم ولا اعتماد. ومُصَعْلَكُ الرَّأس: مُدَوَّر الرأس، قال «122» :
__________
(117) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب الثيل.
(118) زيادة من التهذيب.
(119) كذا في الديوان، وصدر البيت:
فما تنفك بين عريرضات
ورواية العجز في اللسان: تمد برأس عكرشة زموع.
(120) لم نجد الشاهد في أي من المعجمات. في الأصول: جدريا بالجيم ولم نجد (الجدري) بهذه الدلالة. وعكراش بن ذؤيب كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم-
(121) من الشواهد التي تفرد بها العين.
(122) (هو ذو الرمة) . والبيت في الديوان ص 398.
(2/303)
________________________________________
يُخَيِّلُ في المَرْعَى لهُنَّ بشخصِه ... مُصَعْلَكُ أعْلَى قُلَّةِ الرَّأْس نِقْنِقُ
عكنكع «123» : العَكَنْكَعُ: الذَّكر من الغِيلان، قال:
غُولٌ تَداعَى شَرِساً [عَكَنْكَاع] «124»
علكس: اعْلَنْكَسَ الشَّعرُ إذا اشتدَّ سوادُه وكَثُرَ، قال العجّاج:
بفاحِمٍ دُورِيَ حتّى اعْلَنْكَسا «125»
والمُعْلَنْكِس: من اليَبيس: ما كَثُرَ واجْتَمَعَ. والمُعْلَنْكَس: المُتَراكِم من الرَّمْل والمُعْلَنْكِس: الكثير من كلّ شيءٍ. ورجلٌ مُعْلَنْكِس: إذا كانَ مُقيماً بالبَلَد. ويقال: ما له قد اعْلَنْكَسَ. وقومٌ مُعْلَنْكسُون: مُقيمون بالبَلَد قال:
يا رُبَّ تَيْسٍ قَهَوانٍ قَهْوَسِ ... سِيقَتْ له في نَشَرٍ مُعْلَنْكِسِ
مُطبقَةَ الغَضِّ كعَيْنِ الأشْوَسِ «126»
الغضُّ «127» : يعني الكفَّةَ، ولذلك قال كعَين الأشْرَس لأن وَسَطَ الكفَّةِ يبدو منها شيءٌ صغيرٌ أو ثُقْبةٌ، فهو كعين الأشوَس لصغرَها. والقَهْوَسُ: الشَّديد المشي المجترىء باللَّيْل على السَّيْر. والقَهْوانُ: الطويل القرنين.
__________
(123) سقطت هذه المادة من س.
(124) لم نجد الشاهد. في الأصول: عكنعاع وهو تصحيف ثقيل.
(125) وقبله في الديوان ص 31: أزمان غراء تروق العنا.
(126) لم نجد الرجز في أي من المظان المتيسرة لدينا.
(127) في الأصول المخطوطة: العض.
(2/304)
________________________________________
عكلس: عكلس «128» : اسمُ رجلٍ من اليَمَن. وعَكْلَسَ الشَّعرُ: إذا سُقي الدِّهانَ ومارسَ بالأشياء حتى يكبُر ويطوُل.
عركس: اعْرَنْكَسَ الشيءُ: تَراكَم بعضه على بعض، قال العجاح يصف الإبل:
واعْرَنْكَسَتْ أهوالُهُ واعْرَنْكَسَا «129»
واعْرَنْكَسْتُ الشيءَ: حملتُ بعضه على بعض.
كرسع: الكُرْسُوعُ: حرف الزَّنْد الذي يلي الخِنْصر عند الرُّسْغ. وامرأةٌ مُكَرْسَعةٌ: ناتئةُ الكُرْسُوع تُعابُ بذلك. وبعضٌ يقول: الكُرْسُوع: عُظَيم في طَرَف الوَظيف ممَّا يَلي الرُّسْغ من وظيفِ الشَّاء ونحوها. وهو من الانسان كذلك.. واسم الطَّرَفَيْن الكاعُ والكُرْسُوع.
عكمس: ويُقالُ: عَكْمَسَ اللَّيلُ عَكْمَسَةً: إذا أظْلَمَ، قال: واللَّيلُ ليلُ السَّماكَيْن العُكامِس. وكلُّ شيءٍ كَثُفَ وتَراكَم فهو عُكامِس، قال العجّاج:
عُكامِسٌ كالسُّنْدُسِ المَنْشورِ «130»
عكسم: والعُكْسُوم: الحِمارُ بالحميرية. ويقال: هو الكسعوم «131» .
__________
(128) في التهذيب: علكس (بفتح العين) اسم رجل من أهل اليمن، وبذلك تكون المادة كلها جزء من المادة السابقة وهي علكس.
(129) وقبله في الديوان ص 129. وأعسف الليل إذا الليل غسا.
(130) وقبله في الديوان ص 232: ليل تمام تم مستحير.
(131) في التهذيب 3/ 304 قال الليث: الكعسوم الحمار بالحميرية، ويقال: بل الكُسْعُوم.
(2/305)
________________________________________
دعكس: الدَّعْكَسَةُ: لَعِبُ المَجُوس: يَدُورُونَ وقد أخذ بعضُهم يَدَ بَعْضٍ كالرَّقْص. يقال: دعكس وتدعكس بعضُهم على بعض، قال الراجز:
طافُوا به معتكفين «132» نُكَّسا ... عَكْفَ المَجُوسِ يلعَبُونَ الدَّعْكَسا
عكلط: لَبَنٌ عُكَلِط وعُجَلِط «133» : أي خاشِرٌ حامِضََّ.
علكد: العِلْكِد «134» : الشَّديد العُنُق والظَّهْر، ويقال: رَجُلٌ عَلْكدٌ وامرأةٌ عَلْكَدَةٌ، ويُثَقَّل الدال عند الإضطرار. قال:
أعيَس مَصْبُور القَرَى عِلْكَدا
كنعد: الكَنْعَدُ: ضربٌ من السَّمك البَحْريّ، ويُقال: كَنْعَد بسكون النُّون ويُلقَى تَسكين العَيْن على النُّون، قال:
قلْ لِطغامِ «135» الأزْدِ لا تَبْطَروا ... بالشيم والجريث والكنعد
__________
(132) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب واللسان: معتكسين.
(133) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: عكلد عن الليث. ومن المعلوم أن العجلط يعني أيضا اللبن الخاثر مثل العكلد.
(134) كذا في الأصول المخطوطة، والتهذيب وفي اللسان: العلكد (بكسر فسكون فكسر) والعلكد (بضم ففتح فكسر) والعلكد (بفتح فسكون ففتح) والعلكد (بضم فسكون فضم) والعلاكد بضم العين وكسر الكاف، والعلكد بكسر العين وفتح اللام مع تشديدها وإسكان الكاف، كله الغليظ الشديد العنق.
(135) من (س) . في (ص وط) : لطعام بالمهملة.
(2/306)
________________________________________
وقال «136» :
عليك بقُنْأَةٍ وبزَنْجبيلٍ ... وحلتيت وشيء من كنعد
كعدب: الكُعْدُبُ والكُعْدُبَةُ: الفَسْلُ من الرِّجال.
كعتر: كَعْتَرَ الرّجل في مشيِه: إذا تَمايل كالسَّكران.
كرتع: وكَرْتَعَ الرَّجُلُ: إذا وَقَعَ فيما لا يَعْنيه. وكَرْتَع: إذا مَشَى مَشْياً يُقارِب بينَ خطوه «137» ، وقال:
.............. يَهيمُ بها الكَرْتَعُ
عكبر: العُكْبَرة من النساء الجافية العكباء في خُلُقها. قال:
عكْباء عُكْبُرَة في بطنها ثَجَلٌ ... وفي المفاصل من أوصالها فَدَعُ «138»
كعبر: المُكَعْبَرُ: من أسْماء الرِّجال. والكُعْبَرَةُ «139» من النِّساء: الجافيةُ العِلْجَةُ العَكْباءة في خَلْقِها، قال: عكباء كُعْبُرة اللَّحْيَينْ حجمرش «140» يعني الكبيرة. الكُعْبُرةُ ويجمعُ كَعابِر: وهو عُقَدُ أنابيب الزَّرْع والسُّنْبُل ونحوه.
__________
(136) اللسان (حلت) غير منسوب أيضا. وفيه: سندروس مكان زنجبيل.
(137) كذا في س، وفي ص وط: خطويه.
(138) لم نهتد إلى القائل.
(139) كذا في الأصول المخطوطة واللسان، وفي التهذيب: العكبرة.
(140) كذا في الأصول المخطوطة واللسان، وفي التهذيب: عكباء عكبرة اللحيين ...
(2/307)
________________________________________
بركع: البَرْكَعةُ: القِيام على أربعٍ «141» ، ويُقال: تَبَرْكَعَتِ الحَمامةُ للحَمامةِ الذَّكَر، ويقال: أصبح فلان متبركعاً، أي: لا يقوم إلا على كراسيعه. قال رؤبة:
هَيْهاتَ أعْيا جدنا أن يصرعا ... ولو أرادوا غيرَه تَبَرْكَعا
14»
عكرم: العِكْرِمة: الحَمامةُ الأنْثى، قال:
وعِكْرِمة هاجَتْ لنفسي عَبْرَةً ... دَعاها دَعَتْ ساقاً لها فوق مَرْقَبِ «143» !
كثعم: كَثْعَم: من أسماء الفَهْد والنَّمِر.
كعثب: [وامرة] كَعْثَبٌ وكعْثَمٌ: الضَّخمةُ الرَّكبِ. ورَكَبٌ كَعْثَبٌ، ويقال: كثعب، وكعثم. وبعضٌ يقول: [جارية] كَثْعَبٌ: أي ذاتُ رَكَبٍ كَثْعَبٍ.
عثكل: العُثْكُولةُ «145» : ما عُلِّقَ من عِهْنٍ أو زِينةٍ فتَذَبْذَبَ في الهواء! قال:
....... كقنو النخلة المتعثكل «146»
__________
(141) كذا في س واللسان، وفي ص وط: أربعة.
(142) ديوانه/ 93 والرواية فيه: ومن أبحنا عزه تبركعا ونسب في الأصول إلى (العجاج) .
(143) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(145) في التهذيب العثكول.
(146) من عجز بيت (لامرىء القيس) وتمامه:
وفَرْعٍ يُغَشِّي المَتْنَ أَسْوَدَ فاحمٍ ... أَثِيثٍ كقِنْوِ النَّخلةِ المُتَعَثْكِلِ
(2/308)
________________________________________
والهَوْدَجُ يُعَثْكَلُ أي يُزيَّنُ بعُهُونٍ تعلَّقُ عليه فتَتَذَبْذَبُ.
بعلبك: بَعَلْبَك: اسم أرض بالشّام.
بلعك: ويقال: جَمَلٌ بَلْعَكٌ وهو البَليدُ.
علكم: العُلْكوم: الناقةُ الجَسيمةُ السَّمينةُ، قال لبيد:
بَكَرَتْ به جُرشِيَّةٌ مَقْطورة ... تَروي الحَدائِقَ بازل عُلكُومُ «147»
قوله: جُرَشية يَعْني ناقةً منسوبةً إلى جُرَش، وهو مَوْضع «148» ، والمقطورةُ المطليّةُ بالقَطِران. قال أبو الدُّقيش: عَلْكَمَتُها عِظَم سَنامِها.
عنكب: العَنْكَبوتُ بلغة أَهْل اليَمَن العَنْكَبوه والعَنْكباه، والجمع العَناكِب، وهي دَوَيبةٌ تَنْسِجُ نَسْجاً بينَ الهواء وعلى رَأْس البئر وغيرها، رَقيقاً مُتَهلْهِلاً، قال ذو الرّمة:
هي اصطَنَعْته نَحْوَها وتَعاوَنَتْ ... عَلى نَسْجها بينَ المَثابِ عناكبه «149»
__________
(147) البيت في الديوان ص 122 وروايته:
............... .. ... تروي المحاجر بازل علكوم
(148) في الديوان: أرض باليمن.
(149) ديوانه 2/ 854 والرواية فيه: انتسجته...... على نسجه.
(2/309)
________________________________________
ضرجع: الضَرْجَع: اسم من أسماء النَّمِر خاصّة
ضمعج: الضَمْعَج: الضَّخمةُ من النُّوق. وأتانٌ ضَمْعَجٌ: قصيرةٌ ضخمةٌ، ولا يقال ذلك للذَّكر، قال:
يا رب بيضاء ضِحوكٍ ضَمْعَجِ
وقال الشّماخ:
أنا ابنُ رَباحٍ وابنُ خاليَ جَدْشَنٌ ... ولم أُحْتَمَلْ في بَطْنِ سَوْداءَ ضَمْعَجِ «150»
عضفج: العِضْفَاجُ «151» : الضَّخْم السَّمين الرِخْو. وعَضْفَجَتُه: عِظَمُ بطْنه وكَثرةُ لحمه. وقد يقال: عفضاج بمعنى عِضْفاج، مقلوب.
شرجع: الشَّرجَعُ: السَّريرُ الذي يُحْمُل عليه الميّت، قال:
وساريةُ القَوْم في شَرْجَع ... ليهدى إلى حُفْرةٍ نازِحَه «152»
والمُشَرْجَع من مطارق «153» الحدادين ما لا حروفَ لنَواحيه. وكذلك
__________
(150) ليس البيت في الديوان ولكن ورد. بيت آخر فيه الكلمة موطن الشاهد وهو:
أضر بمقلاة كثير لغوبها ... كقوس السراء نهدة الجنب ضمعج
(151) خلت معجمات العربية من هذه المادة واقتصرت على مقلوبها عفضاج.
(152) لم نهتد إلى قائل البيت.
(153) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: مطارقة.
(2/310)
________________________________________
من الخَشَب إذا كانت مُرَبَّعَةً فأمرتَهُ أن يَنْحِتَ حُروفَه قُلتَ: شَرْجَعَهُ، قال:
كأن ما فات عينيها ومَذْبَحَها ... مُشَرْجَعٌ من عَلاة القَيْن مَمْطُول «154»
جرشع: الجُرْشُعُ: الضَّخم الصَّدر، قال:
جَرْشُعَةٌ إذا المَطيُّ أدْرَجَا
جعشم: الجُعْشُم: الصغيرُ البَدن القَليل اللَّحم والجسم، قال العجّاج:
ليس بجُعْشوشٍ ولا بجُعْشُمِ «155»
وقال بعضهم: الجُعْشُمُ الرّجل المُنْتَفِخ الجَنْبَيْنِ غَليظُهما، قال رؤبة:
تنجو إذا السَّيرُ استمرَّ وذَمُهْ ... وكلُّ نئّاج عُراضٍ جَعْشَمُهْ «156»
والشَجْعَمُ: الطويلُ من الأسْد مع عِظَمٍ، وكذلك من الإبِل والرِّجال.
عجلط: العُجَلِط: اللَّبن الخاثِرَ الطيِّبُ من الألبان، ويُجْمَعُ عَجالِط. وعُجالِطُ لغة، قال الراجز:
__________
(154) البيت في اللسان وروايته:
كأن ما بين عينيها ومذبحها............... ..........
وفي التهذيب:
كأن ما بين عينيها ومذبحها............... ..........
(155) وقبله في الديوان ص 293:
في صلب مثل العنان مؤدم
(156) الجعشم (بفتحتين) : الوسط.
(2/311)
________________________________________
إذا اصطَحَبْتَ لَبناً «157» عُجالِطا ... من لَبَنِ الضَّأنِ فلَسْتَ ساخِطا
عشنط: العَشَنَّط: الطَّويل من الرجال والجميع عَشَنَّطُون وعشانط. ويقال: هو الشّابُّ الظَّريفُ مع حُسْن جِسْمٍ، قال:
إذا شِئتَ أن تَلقَى مُدِلاًّ عَشَنَّطاً ... جَسُوراً إذا ما هَاجَه القَومُ يَنْشَبُ
وصفه بخِلافٍ وسوءِ خُلُقٍ.
عنشط: والعَنَشَّط أيضاً لغة، قال:
أتاكَ من الفتيان أرْوعُ ماجدٌ ... صَبُورٌ إذا ما هاجَ هَيْجَ عَنَشَّط «158»
عشزن: العَشَوْزَنُ: المُلتوي العسِرُ الخُلُق من كلّ شيء، ويُجمع على العَشاوِز بحذف النُّون. وناقةٌ عَشَوْزَنَةٌ. قال يصف القناة:
عَشَوْزنةً إذا غمزت إذا غُمِزَتْ أَرَنَّتْ ... تَشُجُّ قَفَا المُثَقِّفِ والجَبينا «159»
عشزر: العَشَنْزَرُ: الشَّديد من كلِّ شيء، قال الراجز:
__________
(157) في التهذيب: رائبا مكان (لبنا) .
(158) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب:
............... .. ... صبور على ما نابه غير عنشط
(159) (عمرو بن كلثوم) - من معلقته.
(2/312)
________________________________________
وصادفوا المدت جهارا مُشعَرا ... ضَرْباً وطَعْناً باقِراً عَشَنْزَرا «160»
شرعب: الشَرْعَبَةُ: شَقُّ اللَّحم والأديم طُولاً. والشَّرْعَبِيُّ: ضربٌ من البُرُود. والشَرْعَبةُ: قِطعةٌ كالرَّعْبلة، قال:
قَدّاً بهَدّادٍ وهَذّاً شَرْعَبا
يصف [ناب] «161» البعير. وشَرْعَبْت الأديمَ واللَّحمَ: أي شقَقْتُه طُولاً. والمشرعب: المطول. والمشرعب الطويل ورجلٌ مُشَرْعَبٌ: طويل، قال طفيل الغَنَويّ:
أسيلةُ مَجْرَى الدَّمْع خُمْصانَةُ الحَشَا ... بَرُودُ الثَّنايا ذاتُ خَلْقٍ مُشَرْعَبِ
شعفر: شَعْفَر: بَطْنٌ من بني ثَعْلَبة يقال لهم: بنو السِّعْلاة، قال الشمّاخ:
وإني لولا شَعْفُرٌ إن أرَدْتُهم ... بَعيدَيْنِ حتى بَلّدا بالصَّحاصِحِ «162»
شمعل: شَمْعَلَتْ اليهودُ شَمْعَلةً: وهي قراءتهم «163» ويقال: اشمعلت
__________
(160) في اللسان: نافذا مكان باقرا.
(161) زيادة من التهذيب.
(162) كذا في الأصول المخطوطة، وليس في ديوانه، وما في الديوان ص 104 هو: ولا شاهد فيه.
(163) في التهذيب واللسان: وهي قراءتهم إذا اجتمعوا في فهرهم.
(2/313)
________________________________________
الإبلُ: أي تَفَرَّقَتْ، ومَضَتْ مَرَحاً ونشاطاً. وناقةٌ شَمْعَلَةٌ: سريعةٌ نشيطةٌ، قال:
إذا اشمعلت سننا رسابها ... بذاتِ حَرْفَيْنِ إذا خَجا بِها «164»
يعني الغارةَ، وناقةٌ مُشْمَعِلَّةٌ مثل شَمْعلةٍ. واشمَعَلَّتِ الغارةُ إذا شَمِلتهم وتَفَرَّقَتْ في الغَزْوِ، قال:
صَبَحْتُ شَباماً غارةً مُشْمَعِلَّةً ... وأخرَى سأُهديها قَريباً لِشاكِرِ «165»
علوس: العِلَّوْس: الذِّئْب، وليس هذا من كلام العرب. قال زائدةُ: هو بالشين.
شنعب: الشِّنْعاب «166» : الرّجلُ الطويلُ الشديد.
شنعف: الشنعاف: الرّجل الطويلُ العاجز الرِّخْو.
عنفش: العِنْفِشُ: اللئيم القصيرُ. ومن النِّساء كذلك «167» ، قال الشاعر «168» :
__________
(164) التهذيب 3/ 326 وفيه (بذات خرقين) واللسان (شمعل) .
(165) التهذيب 3/ 326 وفيه: صحفت (سأهديها) إلى (شاهديها) واللسان (شمعل) .
(166) كذا في (ص وط) في س: الشنعاب: الرّجل الطويلُ العاجز الرِّخْو. وقد سقطت من (س) : (شنعف) وترجمتها.
(167) لم يرد هذا المعنى في المعجمات.
(168) ورد البيت شاهدا في عنفص في جميع المعجمات. والعنفص المرأة القليلة اللحم، البذية القليلة الحياء. ورواية البيت:
لعمرك ما ليلى بورهاء عِنْفِصٍ ... ولا عَشَّة خَلْخَالُها يتقعقع
(2/314)
________________________________________
لعمرك ما ليلى بورهاء عِنْفِشٍ ... ولا عَشَّةٍ مثل الذي يَتَعبَّسُ
عسلج: العسلوج: غُصْنٌ ابنُ سنةٍ. وجاريةٌ عُسْلوجة الشَّباب والقَوام، قال العجاج:
وبَطْنَ أيْمٍ وقواماً عُسْلُجا
والعُسالِج: ما كان رَطْباً في طُولٍ وحُسْن. وعَسْلَجَتِ الشَّجَرة: أخْرَجَتْ عَساليجَها قال طرفة:
إذا أنْبَتَ الصَّيف عَسالِيج الخَضِرْ «169»
ويقال: بل العساليجُ عُروق الشَّجَر، وهي نُجُومُها التي تَنْجُمُ من سَنَتِها فيما زُعِمَ والعَساليجُ عند العامَّة: القُضْبانُ الحديثةُ.
عسجر: العَيْسجُورُ: الناقةُ الشديدة. والعَيْسَجُور: السِّعْلاةُ. وعَسْجَرَتْها: خُبْثُها.
عجنس: العَجَنَّسُ: الجَمَلُ الضَّخْمُ، قال «170» :
يتبَعْنَ ذا هداهد عجنسا ... إذا الغرابان به تَمَرَّسا
عسجد: العَسْجَدُ: الذَّهبُ، ويقال: بل العَسْجَد اسم جامعُ للجَوْهر كُلِّه، من الدر والياقوت.
__________
(169) ديوانه/ 53، وصدر البيت فيه:
كبنات المخر يمأدن كما
وفي الأصول المخطوطة: عساليج خضر. وفي الديوان كما بدلا من إذا.
(170) الرجز في اللسان منسوب إما إلى (العجاج) ، وإما إلى (جري الكاهلي) .
(2/315)
________________________________________
جعمس: ورجُلٌ مُجَعْمِسٌ وجُعامِس: أي وَضَعَ الجُعْمُوسَ بمرَّة، وهو العَذِرة.
عجلز: العِجْلِزَةُ: الفَرَسُ الشديدةُ الخَلْق. ويقال: [أُخِذ] «171» هذا من النَّعْت من جَلْز الخَلْق، وهو غير جائز في القياس ولكنهما اسمان «172» اتفقت حُروفُهما. ونحو ذلك قد يجيء وهو متباين في أصل البناء. ولم اسمعهم يقولون للذكر من الخَيل عِجْلِز، ولكنهم يقولون للجَمَل عِجْلِز وللناقة عِجْلِزة. وهذا النَّعْت في الخيل اعرف. قال «173» :
وقُمْنَ على العَجالِز نصفَ يومٍ ... وأَدَّيْنَ الأواصِرَ والخِلالا
وعِجْلِزة: رملة.
جندع: الجُنْدُع والجَنادِعُ،
وفي الحديث: إني أخاف عليكم الجَنادِعَ والمربّات؟ «174»
يعني البلايا والآفات. والمربّات؟: الدواهي الشديدة. والجُنْدُع: الجُخْدُب وهو شِبهُ الجرادة إلا أنه أضخمَ من الجرادة.
__________
(171) زيادة من التهذيب مما نقل عن الليث أي الخليل في العين.
(172) كذا في التهذيب، وفي الأصول المخطوطة: ولكنها أسماء ...
(173) البيت (لذي الرمة) كما في التهذيب وروايته:
مررن على العجالز ... ............... ..........
وهو من الزيادات في الديوان ص 671.
(174) كذا في ص وط، وفي س: المرابات. ولا وجود لهذه الكلمة في الحديث في التهذيب واللسان فيما نقل من كلام الليث. ولم أهتد إلى حقيقة الكلمة.
(2/316)
________________________________________
عنجد: العُنْجُدُ: الزَّبيبُ، قال:
رءوس الحناظب 17» كالعنجد
شبه رءوس الخنافِس بالزَّبيب، ومن رَوَى العناظِب فهي الجراد، شَبَّه رءوسها بالزَّبيب.
دعلج: الدَّعْلَجُ: ألوان الثياب. ويقال: ضربٌ من الجواليق والخِرَجة، قال يصف الثَّور في الحشيش:
لَثِقُ القَميصِ قد احتواهُ الدَّعْلَجُ «176»
قال السُلَميّ: الدَّعْلَجُ عندنا الضَّبُّ إذا هاجَ فإنَّما هو مُقبلٌ ومُدبرٌ. والدَّعْلَجَةُ: أثَر المُقبل والمُدبر. رأيتُ دَعْلَجَتَهم: أي آثارَهم.
جعدل: الجَعْدَلُ: البعير الضَّخْم القويّ.
عجلد: والعَجَلَّدُ والعَمَلَّطُ والعُجالِدُ والعُمالِط: اللبن الخاثِرُ، قال «177» :
هل من صَبوحٍ لَبَنٍ عُجالِدِ
جلعد: الجَلْعَدُ: الناقةُ القويّة الظَّهيرة، قال «178» :
أكسُو القُتودَ ذاتَ لَوْثٍ جَلْعَدَا
__________
(175) في التهذيب واللسان: العناظب.
(176) لم نهتد إلى القائل.
(177) لم نهتد إلى القائل.
(178) لم نهتد إلى القائل.
(2/317)
________________________________________
عجرد: عَجْرَد: اسمُ رجلٍ. والعَجْرَدية: ضربٌ من الحَرُوريّة.
جمعد: جَمْعَدٌ «179» : حِجارة مَجموعةٌ.
جعدب: جُعْدُبةُ: اسم رجل من المدينة.
جنعظ: الجِنعاظةُ: الرجل الذي يَتَسَخَّط «180» عند الطعام من سُوء خُلُقه، قال:
جِنعاظةٌ بأهلِهِ قد بَرَّحا ... إنْ لم يجدْ يوماً طَعاماً مُصْلَحا «181»
جعمظ: الجَعْمَظُ: الشَّيخُ الشَّرِهُ.
جعظر: الجَعظَريُّ: الأكُول.
وفي الحديث: أبغَضُ النّاس إلى الله الجَوّاظُ الجَعْظَريُّ «182»
فالجوَّاظُ الفاجر، قال:
جواظة جعنظر جنعيظ
وجَعَنْظَرٌ وجِنعيظٌ وجَنْعَظرٌ كله سواء. والجِعْظار: الرجل القصيرُ الرِّجْلَيْن
__________
(179) في اللسان: الجمعد: حجارة مجموعة عن كراع، والصحيح الجمعرة. وجاء في التهذيب أيضا: وقال الليث: يقال للحجارة المجموعة جمعر.
(180) في التهذيب: يسخط.
(181) تكملة الرجز في التهذيب نقلا عن الليث: قبح وجها لم يزل مقبحا
(182)
الحديث في اللسان: إلا أخبركم بأهل النار؟ كل جعظري جواظ مناع جماع
(2/318)
________________________________________
الغليظ الجسم. وهو الجِعِنْظارُ أيضاً، وإن كان مع غِلَظ جسمه وترارةِ خَلْقِه أكولاً قويّاً سُمِّيَ جَعْظرياً.
عذلج: المُعَذْلَجُ: الناعمُ. وعَذْلَجَتْه النَّعمةُ، قال العجاج:
مُعَذْلجٌ بَضٌّ قُفاخِريٌّ «183»
يصف خَلْقَها.
عثجل: العَثْجَلُ: الواسعُ الضَّخم من الأسقِية والأوعية «184» ونحوها، قال الراجز يصف الناقة:
تَسقي به ذاتَ فراغٍ عثْجَلا
أي كَرْشاً واسعاً.
ثعجر: الثَّعْجَرَةُ: انصباب الدَّمْعِ المتتابع. واثْعَنْجَرَت العينُ دمعاً، واثْعَنْجَر دمعها. واثْعَنْجَرَ السَّحابُ بالمطَر، واثْعَنْجَرَ المطر تشبيه كأنّه ليس له مسلك ولا حِباسٌ يَحْبِسُه، ولو وصَفْتَ به فعل غيره لقلت ثَعْجَرَه كذا، قال امرؤ القيس عند موته:
رب جفنة مثعنجره ... وطَعْنةٍ مُسْحَنفِره
تَبقَى غداً بأَنْقَره
أي يكون ثَمَّ قَتْلى. ويعني بالمُثْعَنْجِره المملوءة ثريدا تفيض إهالته.
__________
(183) في الديوان: ص 315: مغذلج بيض قفاخري. وهو وهم من المحقق.
(184) في التهذيب: من الأساتي. وهو وهم من المحقق.
(2/319)
________________________________________
جعثن: الجِعثِن: أروحةُ الشَّجَر بما عليها من الأغصان، الواحدة جِعْثِنة، وكلُّ شَجَرةٍ تَبقى ارومتها في الشتاء من عظام الشَّجَر وصغارها فلها جِعْثِن في الأرض، وبعد ما يُنْزَعُ فهو جِعْثِن، حتى يقال لأصول الشوك على الأرض جِعْثِن حتى يقال لأصول الشوك: جِعْثِن، قال الطّرمّاح في وصف لحيَي النّاقة على الأرض «185» :
ومَوضِع مشكوكَين ألقَتْهما معاً ... كوطأة ظبي القُفِّ بين الجعاثِنِ
[وجِعْثِن: من أسماء النّساء. وتَجَعْثَن الرّجلُ إذا تجمَّع وتقبَّض. ويقال لأرومة الصِّلِّيان: جِعْثِنة] «186»
جعثم: الجُعثُومُ: الغُرمول الضَّخْم.
عرجل: العَرْجَلَةُ: القطيعُ من الخيل. وهي بلغة تميم الحَرْجلة.
عرجن: العُرجُون: أصلُ العِذْق، وهو أصفر عريضٌ يُشبهُ الهلال إذا انْمَحَقَ «187» . والعُرجُون: ضربٌ من الكَمْأة قَدْر شِبْرٍ أو دُوَيْنَ ذلك. وهو طيِّبٌ ما دام غَضّاً رطباً والجمعُ العراجِينُ. والعَرْجَنَةُ: تصوير عراجين النخل، قال «188» :
__________
(185) ديوانه 493.
(186) ما بين القوسين سقط من الأصول المخطوطة وأثبتناه من التهذيب.
(187) في التهذيب عن الليث: لما عاد دقيقا.
(188) هو (رؤبة) . والرجز في الديوان ص 161 وقبله:
أو ذكر ذات الربذ المعهن
(2/320)
________________________________________
في خِدْرِ ميّاس الدّمى مُعَرْجَنِ
أي مُصوَّر فيه صُور النَّخْل والدُّمَى.
عنجر: العَنْجورةُ «189» : غِلافُ القارُورة. وكان عَنْجورة اسم رجلٍ إذا قيلَ له: عَنْجِرْ يا عَنْجورِةُ غَضِبَ.
جعفر: الجَعْفَرُ: النَّهْرُ الكبير الواسع، قال:
تأود عسلوج على شط جَعْفَر
جرعن: اجْرَعَنَّ «190» الرجُلُ: إذا سَقَطَ عن دابّته.
عجرف: العَجْرَفِيَّة: جَفْوَةٌ في الكلام وخُرق في العقل «191» . وتكون في الجمل فيقال: عَجْرَفيُّ المَشْيِ لسُرعته. ورجلٌ فيه عَجْرَفيَّةٌ. ويقال: بعيرٌ ذو عَجاريف. والعُجْروفُ: دُوَيبة ذاتُ قوائِمَ طِوال. ويقال أيضاً: هو النَّمْلُ الذي رَفَعَتْه قوائمه عن الأرض. وعَجاريفُ الدهر: حَوادثُه قال قيس «192» :
لم تُنْسِني أُمُّ عَمَّارٍ نَوًى قَذَفٌ ... ولا عَجاريفُ دَهرٍ لا تُعَرِّيني
أي لا يُخَلِّيني ولا يتركني من أذاه.
__________
(189) في التهذيب عن الليث: العجنحرة. وفي اللسان: العنجرة.
(190) كذا في الأصول المخطوطة أما في التهذيب: ارجعن وهو تصحيف. انظر اللسان.
(191) في التهذيب عن الليث: العمل وهو تصحيف.
(192) التهذيب 3/ 321 واللسان (عجرف) غير منسوب.
(2/321)
________________________________________
عرفج: العَرْفَجُ: نباتٌ من نَبات الصَّيف ليِّنٌ أغْبَر له ثَمَرةٌ خَشْناء كالحَسَكِ، الواحدة عَرْفَجةٌ. وهو سريع الاتّقاد، قال لبيد:
مَشْمُولةٍ غلثت بنابت عرفج ... كدخان نار ساطِعٍ أسنامُها «193»
جعبر: الجَعْبَريَّةُ والجَعْبَرة أيضاً: القصيرةُ الدَميمةُ، قال: «194»
لا جَعْبريّات ولا طَهامِلا
أي قِباحُ الخِلْقة. ويقالُ: يريد طِوالاً دِقاقاً.
عجرم: العُجَرُمةُ: شجرة غليظة لها كِعابٌ كهَيْئة «195» العُقَد تُتَّخَذُ منه القِسِيّ، وهي العُجْرومة. وعَجْرَمَتها: غِلَظ عُقَدها، قال العجاج:
نَواجِلٌ مثلُ قِسِيّ العُجْرُمِ «196»
والعُجْرُمُ: أصلُ الذكر. وإنه لمُعَجْرَمٌ: إذا كان غليظ الأصل، قال رؤبة:
ينبو بشَرْخَي رَحْلِهِ مُعَجْرَمُه ... كأنّما يزفيه حاد ينهمه «197»
__________
(193) البيت في ديوان لبيد ص 306.
(194) هو (رؤبة بن العجاج) والرجز في الديوان ص 121
(195) في التهذيب عن الليث: كهنات نقلا عن مخطوطة واحدة وفي المخطوطتين الأخريين: كهيئات.
(196) كذا في الأصول المخطوطة والديوان ص 59، وفي اللسان: نواجلا.
(197) ديوانه/ 151.
(2/322)
________________________________________
مُعَجْرَمُهُ: حيث عُجْرِمَ وَسَطُه أي غَلُظَ. والعجاريم من الدّابّة «198» : مجتمع عُقَدٍ بين فَخذَيه وأصل ذَكَره. والعُجْرُم من أسماء الرّجال ومن ألقابهم القِصار. والعِجْرِم أيضاً: دُوَيبة صُلْبة كأنّها مقطوعة، تكون في الشجر وتأكلُ الحشيش.
جعمر: الجَعْمَرة «201» أن يجمعَ الحِمارُ نفسَه وجَراميزه ثم يحمل على العانة وعلى شيءٍ أراد كَدْمَه.
علجم: العُلْجُوم: الضِفدِعُ الذَكرَ. ويقالُ: البَطُّ الذكر، قال:
حتى إذا بَلَغَ الحَوْماتُ أكرُعَها ... وخَالَطَتْ مُستَنيماتِ العَلاجِيمِ
يقال: فلانٌ مُستنيم وليس بنائم ولكنه أمِنَ حتى إذا بَلَغَ حَومة الماء رَمَى بها، وهذا بالظنِّ. والعَلاجِيمُ هاهنا. الضفادِعُ. قال: ونحن نقول في لغتنا: تَيْسٌ عُلْجُوم وكُبْشٌ عُلْجُوم ووَعِلٌ عُلجُومٌ، وهي كبارُها. والعُلْجُومُ: الظُلْمَةُ المتراكمة، قال ذو الرمة:
__________
(198) كذا في الأصول المخطوطة واللسان، وفي التهذيب: عجارم.
(201) كذا في الأصول المخطوطة واللسان، وفي التهذيب الجمعرة.
(2/323)
________________________________________
أو مزنة فارق يجلو غوارِبَها ... تَبَوُّجُ البرقِ، والظَلْماءُ عُلْجُومُ
عفجل: العَفَنْجَل: الكثيرُ فُضُولِ الكلام.
عفنج: العَفَنْجَجُ من الناس: كلُّ ضَخْم اللَّهازِمِ ذو وَجَنات «202» أكُولٌ فَسْلٌ، بوزن فَعَنْلَل، ورجلٌ عَفَنْجَج مُضطرِب.
جلعب: الجَلْعَبُ: الرّجلُ الجافي الكثيرُ الشرِّ، ويقال: بل هو الجَلَعْبَى
جِلفاً جَلَعْبَى ذا جَلَب «203»
ويقال: بل هو الجَلَعباء «204» ، والمرأةُ جَلَعْباة «205» ، وهما من الإبِلِ: ما طال في هَوَجٍ وعَجْرفيَّة. والمُجْلَعِبُّ: المُسْتَعْجِلُ الماضي، وهو من نَعتِ رجل السَّوء «206» ، قال:
مُجْلَعِبّاً بينَ راوُوقٍ ودَنّ
علجن: العَلْجَنُ: الناقةُ الكِنازُ «207» اللَّحْم وكان فيها بُطءٌ «208» من عظمها، قال الراجز:
وخَلَّطَتْ ذات دلاث «209» علجن
__________
(202) وزاد في التهذيب: وألواح (عن الليث) .
(203) (اللسان) : (جلعب) .
(204) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب عن الليث: الجلعبي.
(205) في ص وط: جلعبات.
(206) في التهذيب: الشرير. وفي الأصول: الرجل السوء.
(207) كذا في س، وفي ص وط: الكبار.
(208) في ص وط: بطؤا.
(209) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب واللسان: وخلطت كل ...
(2/324)
________________________________________
جلفع: الجَلَنْفَعُ: الغَليظُ من الإبِلِ.
ضلفع: ضَلْفَعُ: موضِع، قال العجاج:
وعهد مَغْنَى دمنةٍ بضَلْفَعا «210»
عرضن: العِرَضْنَةُ والعرضنى: عدو في اشتقال، قال:
تعدو العرضنى خيلهم حَراجِلا
وامرأةٌ عِرَضْنةٌ أي ضَخمةٌ قد ذَهَبَتْ عَرْضاً من سِمَنِها.
عربض: أَسَدٌ عِرباضٌ: رَحْبُ الكَلْكَل، قال:
إنّ لنا عِرْباضةً عِرْبَضّا «211»
أي مُبالَغاً في أمره.
عرمض: العَرْمَضُ: نَبْتٌ رخْوٌ أخضَرُ كالصوف المنقُوش في الماء المُزمِن، وأظنُّه نباتاً «212» . والعَرْمَضُ أيضاً من شجرة العِضاه، لها شوك أمثالُ مَناقير الطيرْ، وهو أصلبُها عِيداناً.
عضمر: العَيْضَمُورُ: الناقةُ الضَّخمةُ مَنَعَها الشَّحْمُ أن تحملَ. والعَيْضَمُورُ: العجوزُ أيضاً
__________
(210) ليس في ديوان العجاج.
(211) رواية التهذيب واللسان:
إن لنا هواسة عربضا.
(212) في (س) : أقول: نبت ظنا.
(2/325)
________________________________________
عضرط: العِضْرِط: اللَّئيم من الرجال. والعُضْرُوط: الذي يَخدِمُكَ بطَعام بطنه، وهم العَضاريطُ والعَضارِطةُ، قال الأعشى:
وكَفَى العَضاريطُ الرِكابُ فبُدِّدَتْ ... منها لأمرِ مُؤَمَّلٍ فأزالَها «213»
ذعلب: الذِّعْلِبَة: الناقةُ الشديدةُ الباقيةُ على السير، وتجمع على ذَعالِب، قال نَهارُ بنُ تَوْسِعة:
سَتُخبِرُ قُفّالٌ غَدَت بسُروجها ... ذعالِبُ قُودٌ سَيرُهُنَّ وَجيفُ «214»
. والذِعلبةُ: النَّعامة وهي الظليم «215» الأنثى، وإنما تُشَبَّه بها الناقةُ لسرعتها. وكذلك جَمَل ذِعْلِبٌ. والذِعْلِبُ: القِطَعُ من الخِرَقِ المُتَشَقِّقَةِ، قال:
مُنْسَرِحاً إلاّ ذَعاليبَ الخِرَقْ
وتقول: إذلَعَبَّ الجَمَلُ في سيره إذلِعْباباً من النَّجاء والسرعة، قال الراجز:
ناجٍ أمام الرَّكبِ «216» مُذْلَعِبُّ
وإنَّما اشتُقَّ من الذِعْلِب. وكلُّ فعلٍ رُباعيٍّ ثُقِّلَ آخره فإنّ تَثقيله معتمدٌ على حرف من حروف الحلق.
__________
(213) كذا في الأصول المخطوطة، ورواية الديوان ص 26:
فكفى العضاريط الركاب فبددت ... منه لأمر مؤمل فأجالها
(214) لم نهتد إلى القول وفي غير الأصول.
(215) المعروف أن الظليم ذكر النعام. ولعل عبارة (وهي الظليم) زيادة من النساج، وتكون العبارة: والذعلبة: النعامة الأنثى.
(216) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: الحي.
(2/326)
________________________________________
ذعمط: قال شُجاع: الذَّعْمَط «217» من النساء: البذيئة وكذلك اللَّعْمَظ. وتقول: ذَعْمَطْتُ الشَّاةَ أي ذَبَحتُها ذَبْحاً وَحِيّاً، والذعْمَطَةُ مصدره.
عرفط: العُرفُطُ: شجرةٌ من شجر العِضاه، تأكلُه الإبلُ، الواحدة بالهاء.
عنظب: العُنْظُبُ: الجراد الذكر والأنثى عُنَظُوبة «218» .
عطرد: عُطارِد: كوكبٌ لا يُفارقُ الشَّمس. وهو كوكب الكُتّاب. وبنو عُطارِد: حيٌّ من بني سَعْدٍ.
عسطس: العَسَطُوس: شجرٌ يُشبِهُ الخَيْزُران، قال:
............... ... كأنّه ... عصا عَسَّطُوسٍ لينُها واعتدالها «219»
ويقال: هو شَجَرٌ يكون بالجزيرة. ويقال: بل العَسَطُوسُ من رءوس النصارى بالنبطية.
__________
(217) ضبطنا (الذممط) على ضبط (اللعمظ) .
(218) في الأصل: عنظوانة وهو تصحيف.
(219) البيت (لذي الرمة) وروايته في الجمهرة والمحكم واللسان (عسطس) :
على أمر منقد العفاء كأنّه ... عصا عَسَّطُوسٍ لينُها واعتدالها
وقد جاء البيت شاهدا في الكلمة وهي مشددة السين مفتوحة، وهي رواية كراع. ورواية البيت في الديوان ص 532:
............... ..... ... عصا قس قوس لينها واعتدالها
والقس: النصراني، وقوس: منارة الراهب.
(2/327)
________________________________________
عرطس: عَرْطَس الرجلُ: إذا تَنَحَّى عن القوم وذَلَّ عن مُنازعَتِهم ومُناوَأتِهم «320» ، قال الراجز:
يُوعدِني ولو رآني عَرْطَسا «221»
وفي لغة: عَرْطِزْ عنا أي تَنَحَّ عنّا.
عطمس: العَيْطَمُوس: المرأة التّارَّة، ذات قَوامٍ وألواح. ويقال لها ذلك في كلّ حال إذا كانت عاقراً. ويقال: عُطْمُوسٌ.
عطبل: عُطْبُول: جارية وَضيئةٌ فتيّةٌ حَسَنة، وجمعُها عَطابِيل وعَطابل، قال:
فسِرْنَا وخَلَّفا هُبيرةَ بعدَنا ... وقُدَّامَه البيضُ الحِسانُ العَطابِلُ «222»
عرطل: العَرْطَلُ: الطويل من كلِّ شيءٍ، قال أبو النَّجم:
وكاهلٍ ضَخْمٍ وعُنْقٍ عَرْطَلِ «223»
صنتع: حِمارٌ صُنْتُعٌ: شديد الرأس ناتىء الحاجِبَيْن عريضُ الجَبْهة. وظليم صنتع «224» .
__________
(320) كذا في ص واللسان، وفي ط وس: مساواتهم.
(221) الرجز في التهذيب واللسان، وقبله: وقد أتاني أن عبدا طبرسا.
(222) لم نهتد إلى القائل.
(223) الرجز في اللسان وروايته:
في سرطم هاد وعنق عرطل
وقد أدرجت مادة عنظب بعد هذا الرجز في س.
(224) في اللسان: وظليم صنتع أي صلب الرأس.
(2/328)
________________________________________
عترس: العِتريسُ «225» : الذكر من الغيلان. والعَتْرَسَةُ: العِلاجُ باليَدَيْن مثلُ الصِراع والعِراك،
وفي الحديث: جاءَ رجلٌ بغَريمٍ له مَصْفُودٍ إلى عُمَر فقال: أتَعْتَرسُه
أي تَغْصِبُه وتَقْهَرُه. ويقال: عَتْرَسْتُ ماله: أي أخَذْتُه عَتْرَسَةً أي غَصْباً. والعَنْتريسُ: الناقةُ الوثيقة، وقد يُوصَفُ به الفَرَسُ الجَوادُ، قال: «226»
كلُّ طِرْفٍ مُوَثَّقٍ عَنْتَريسٍ
والعَنْتَريسُ: الداهية. العَتْرَسَةُ: الغَلَبَةُ والأخْذُ من فوق.
عنتر: العَنْتَرُ: الشُجاع.
عترف: العُتْرُفان: الديك.
عضرس: العِضْرِسُ: ضَرْبٌ من النبات. وبعضٌ يقول: هو حمار الوَحْش، قال: «227»
والعَيْرُ ينفُخُ في المَكْنانِ قد كَتِنَتْ ... منه جحافِلُه والعِضْرِسِ الثُّجَرِ
المكنان: نَبات الربيع يَنْبُتُ مُتَكاوِساً أي كثير بعضه على بعض. (ويقال: العِضْرِس شجرة تشبه ثمرتها أعين الكلاب الزرق) «228»
__________
(225) في الأصول المخطوطة: العتريس من الغيلان الذكران والتصحيح من اللسان.
(226) البيت (لأبي داود) يصف فرسا، اللسان (عترس) ، وتمامه:
مستطيل الأقراب والبلعوم.
(227) قائل البيت هو (ابن مقبل) . انظر اللسان (عضرس) .
(228) ما بين القوسين أدرج بعد مادة [عنبس] في الأصول المخطوطة.
(2/329)
________________________________________
عنبس: العَنْبَسُ: من أسماء الأسد إذا نَعَتَّه قلتَ عَنْبَس وعُنابِس.
عملس: العَمَلَّسُ: الذئب الخَبيثُ، ويقال: عَمَلَّس دَلْهاث «229» ، قال الطرمّاح:
يوزِّعُ بالأمراس كلّ عَمَلَّس «230»
عرنس: العِرناسُ: طائرٌ كالحمامةِ لا تشْعُرُ به حتى يطيرَ تحت قَدَميك، قال:
لسْتُ كَمَنْ يُفْزِعُه العِرناسُ «231»
عرمس: العِرْمِسُ: اسم للصَّخْرة تُنْعَتُ به الناقةُ الصُلْبة، قال:
وَجْناءُ مُجْمَرةُ المنَاسِمِ عرِمِسٌ «232»
عنسل: العَنْسَل: الناقةُ السريعةُ الوَثيقةُ الخَلْقِ.
عربس: العِرْبِسُ والعِرْبَسيس: مَتْنٌ مُسْتَوٍ من الأرض، قال العجّاج:
وعِرْبِساً منها بسَيرِ وَهْسِ «233»
الوَهْس: الوطءُ الشديدُ. (وقال الطرمّاح في العربسيس:
__________
(229) كذا في س أما في ص وط: دلجات.
(230) رواية البيت في الأصول المخطوطة: يودع بالأمراس. أما التصحيح فهو من الديوان ص 171 والتهذيب واللسان وتمام البيت:
من المطعمات الصيد غير الشواجن
(231) لم نهتد إلى الراجز.
(232) لم نهتد إلى القائل ولا إلى تمام البيت.
(233) ليس الرجز في ديوان العجاج.
(2/330)
________________________________________
تُراكِلُ عَرْبَسيسُ المتْنِ مَرْتاً ... كظَهْر السَّيْحِ مُطَّرِدَ المتونِ
والعَرْبَسيس بفتح العين أصوَبُ من كسرها، لأن ما جاء من بناء الرُباعيِّ على مثال فَعْلَليل يُفْتَح صدرُه مثل سَلْسَبِيْل وأشباه ذلك، وإنما كسرت عَيْن عربسيس على كسرة عِرْبِس) «234» .
سلفع: السَلْفَعُ: الشُجاع الجسور. وامرأةٌ سَلْفَعٌ: أي سَليطةٌ. الرجلُ والمرأةُ فيه سَواءٌ، قال جرير:
أيّامَ زَيْنَبُ لا خفيفٌ حِلْمُها ... عند النساء ولا رءود سَلْفَعُ «235»
عسبر، عبسر: العُسْبُر: النَّمِر، والأنثى بالهاء. والعُسْبُور: وَلَدُ الكلب من الذِّئبة. والعُبْسُورة والعُبْسُرَة «236» : الناقةُ السريعة من النجائب، قال: «237» :
والمُقْفِراتُ بها الخُورُ العَباسيرُ
سبعر: وناقةٌ ذاتُ سِبعارةٍ يعني حِدَّتَها. وسَبْعَرَتُها: نشاطها إذا رفعت رأسها وخَطَرَتْ بذَنَبها وارتفعت واندفعت.
__________
(234) ما بين القوسين جاء بعد مسلفع المادة التالية.
(235) كذا رواية البيت في الأصول المخطوطة وفي الديوان ص 341:
............... .. ... همشى الحديث ولا رواد سلفع
(236) كذا في ص وط أما في التهذيب واللسان: العسبورة والعسبرة. وكذلك الشاهد:.... الخور العسابير. وجاء في اللسان أيضا: قال الأزهري: والصحيح العبسورة، الباء قبل السين في نعت الناقة، قال: وكذلك رواه أبو عبيد عن أصحابه، وكذلك ابن سيده.
(237) لم نهتد إلى القائل ولا إلى تمام القول.
(2/331)
________________________________________
سرعب: السُرْعُوبُ: اسمُ ابنِ عرْس، قال:
وثبة سُرْعُوبٍ رأَى زَبابا «238»
وهو الجُرَذ الضَّخْمُ.
سمدع: السَمَيْدَع: الشُجاع.
سعبر: السَعْبَرَةُ: البِئْرُ الكثيرةُ الماء.
سرعف: السَرْعَفةُ: حُسْنُ الغِذاء والنَّعمة. وهو سُرْعُوف ناعِم، قال العجّاج:
وقَصَبٍ لو سُرْعِفَتْ تَسَرْعَفا «239»
عمرس: يوم عَمَرَّسٌ «240» : شديد. وشَرٌّ عَمَرَّس، قال الأُرَيْقِط في وصف يومٍ ذي شَرٍّ.
عَمَرَّسٌ يَكْلَحُ عن أنيابهِ
العُمْروسُ: الجَمَلُ إذا بَلَغَ النَّزْوَ. والعَمَرَّس: الشرس الخُلُق القوي.
__________
(238) الرجز في التهذيب واللسان من غير عزو.
(239) الرجز في اللسان وفي الديوان ص 491 وقبله: بجيد أدماء تنوش العلفا.
(240) أدرجت المادة قبل أكثر من ثلاث صفحات.
(2/332)
________________________________________
زعفر: الزَّعْفَران: صِبْغٌ وهو من الطِّيبِ. والأسَدُ يُسَمَّى مُزَعْفَراً لأنَّه وَرْدُ اللَّوْن يضربُ إلى الصُفرة، قال أبو زبيد:
إذا صادَفوا دوني الوليدَ كأنَّما ... يَرَونَ بوادٍ ذا حِماسِ مُزَعْفَرا «241»
عفرز: عَفْزَرُ: اسمُ رجلٍ، قال:
[نَشِيمُ بُروقَ المُزْنِ أين مَصابُهُ ... ولا شَيْءَ يَشْفي منكِ] يا بنت عَفْزَرا
كأنّه اسمٌ أعجَميّ لذلك نَصَبَه.
زعنف: الزِّعْنِفةُ: صِنْفةٌ من ثَوب وطائفة من قبيلة يَشِذُّ ويَنْفَرِدُ. وإذا رأيت جَماعةً ليس أصلُها واحداً قُلتَ: إنَّما هم زَعانِفُ، بمنزلة زَعانِفِ الأديم، وهي في نَواحيه حيثُ تُشَدُّ فيه الأوتادُ إذا مُدَّ للدِباغ.
زبعر: رجلٌ زِبَعْرَى. وامرأة زِبَعراة: في خُلُقها شَكاسةً «242» . والزَّبْعَرُ: ضَرْبٌ من المَرْوِ. قال:
وكأنَّها الاسفِنْطُ يومَ لقِيتُها ... والضَوْمَران تَعُلُّهُ بالزَّبْعَرِ «243»
والزَّبْعَرِيّ: ضَرْبٌ من السِّهام، منسوب.
__________
(241) لم أجد البيت في شعر أبي زبيد.
(242) كذا في التهذيب وفي الأصول المخطوطة: شكس.
(243) كذا رواية البيت في س، وفي ص وط:
وشاهدنا الإسفنط يوم لقيتها............... ...
(2/333)
________________________________________
زعبل: الزَّعْبَلُ: الذي لا يَنْجُعُ فيه الغِذاء وقد عَظُمَ بَطْنُه ودَقَّ عُنُقُه، قال:
سِمْطاً يُرَبّي وِلْدَةً زَعابِلا «244»
عرزم: العَرْزَم: القويُّ الشديد من كل شيء، المُكْلَئِزُّ المجتمع، فإذا عَظُمَت الأرنَبَةُ وغَلُظَتْ قيل: اعَرَنْزَمَتْ، واللِّهْزِمَةُ كذلك إذا ضَخُمَتْ واشْتَدَّتْ قال «245» :
لقد أوقدَتْ نار الشروري بأرؤس ... عظام اللِّحَى مُعْرَنْزِماتِ اللَّهازِمِ
مرعز: المِرْعِزَّى: كالصُّوف يُخَلَّصُ من شَعْر العَنْز. وثوبٌ مُمَرْعَز. ومثلُه ما جاء على لفظه شِفْصِلَّى «246» . والمِرْعِزاء أيضاً إذا كَسَروا مَدّوا وخفَّفوا الزاي، وإذا فَتحوا الميم وكسَروا العين ثَقَّلوا الزاي وعَلَّقوا الياء مرسلة، وهذا في كلام العرب بناء نَزْرٌ. ويقال أيضاً مِرعِزى مقصوراً.
عرزل: العِرزالُ: ما يجمَعُه الأسدُ في مَأواه من شَيءٍ يُمَهِّدُه لأشباله كالعُشّ. قال زائدة: العِرزالُ جُحْرٌ لحَيّة، وذكره أبو النجم في شعره فقال:
تَلوّذ الحَيَّة في عِرزالها «247»
وعِرزالُ الصيَّاد: أهدامُه وخِرَقُه التي يمتَهدُها ويضطجع عليها في القترة، قال:
__________
(244) الرجز في اللسان (للعجاج) . وجاء فيه: قال ابن بري: الصحيح أنه (لرؤبة) ، وقبله:
جاءت فلاقت عنده الضآبلا
(245) لم نهتد إلى القائل في المصادر المتيسرة.
(246) كذا في (ص وط) . في (س) : فعللي.
(247) كذا في س، وفي ص وط:.... في عرزالها.
(2/334)
________________________________________
ما إنْ يني يفتَرِشُ العِرازلا «248»
يعني صاحبَ القُتْرة. ويقال: العِرزالُ ما يَجْمَعُ [الصائد] من القَديد في قُتْرته.
عصفر: العُصفُرُ: نباتٌ سلافتُه الجِرْيال، وهي معرَّبة. العُصْفُور: طائر ذَكَرٌ. والعُصْفُور: الذكر من الجراد. والعُصْفُور: الشِمراخ السائِلُ من غُرَّة الفَرَس لا يبلُغ الخَطْمِ. والعُصفورُ: قُطَيعةٌ من الدِماغ تحت فَرْخ الدِماغ كأنَّه بائن منه، بينَهما جُليدة تفصِلُه، قال:
ضَرْباً يُزيلُ الهامَ عن سَريره ... عن أمِّ فَرْخ الرأسِ أو عُصفورِهِ
والعُصفور في الهَوْدَج: خَشَبَةٌ تجمعُ أطرافَ خَشَباتٍ فيها، وهي كهيئة عُصفور الإكاف، وعُصفور الإكاف عند مُقَدَّمِه في أصل الذِئبة، وهي قطعة خَشَبٍ في قَدْرِ جُمع الكَفِّ وأعظم من ذلك شيئاً، مشدودة بين الحِنْوَيْن المُقَدَّمَيْن، قال الطِرمّاح:
كلُّ مَشْكوكٍ عَصافيرُه ... قانىء اللَّونِ حديث الرِمامِ «249»
يصف الهَوْدَج أي أُصْلِحَ حَديثاً. والرَمُّ: الأَسْر أيضاً، يعني أنه شُلَّ فَشُدَّ العُصفورُ من الهودج.
__________
(248) زيادة من اللسان.
(249) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: الدمام، وكذا في الديوان/ 401 وفي اللسان الزمام: وهو تصحيف.
(2/335)
________________________________________
صعفر: اصعَنْفَرت الحُمُرُ: إذا تَفَرَّقَتْ وابذَعَرَّت وهَرَبَت، قال:
فلم يُصِبْ واصْعَنْفَرَتْ جَوافِلا «250»
عرصف: العِرصافُ: العَقِبُ المُستطيل، وأكثر ما يقال ذلك لعَقِبِ المتْنَيْن والجنْبَيْن. وعَرَصَفْتُ الشيءَ أي: جَذَبْتُه فَشَقَقْتُه مُستطيلاً. والعَراصيف: أربعةُ أوتادٍ يجمعن بين أحناء رءوس القَتَب، في رأس كلّ حِنْوٍ من ذلك وَدّانِ مَشْدودان بجُلُود الإِبِل، يَعدِلُونَ الحِنْوَ بالعُرْصرف. وعَراصيفُ القَتَب: عصافيره. والعُصفور والعُرْصوف واحد.
صمعر: الصَّمْعَريّ: اللَّئيمُ. والصَّمْعَريّ: كلُّ مَن لم يعمَلْ فيه رُقْيةً ولا سِحْر أيضاً. والصَمْعَرِيَّةَ من الحيّات: الخبيثة، قال «251» :
أحَيَّةُ وادٍ ثُغْرةٌ صَمْعَريَّةٌ ... أحَبُّ إليكم أم ثلاثٌ لواقِحُ
أي: عقرب.
عصمر: العُصْمُورُ والعَصَاميرُ: دُلِيُّ المَنْجَنُون.
عرصم: العِرْصَمُّ: الرجل الشديد البضعة.
__________
(250) وفي اللسان: وروي: واسحنفرت. والرجز (لرؤبة) الديوان ص 127.
(251) كذا في الأصول المخطوطة، وفي اللسان: أحية وادي بغرة ...
(2/336)
________________________________________
عنصر: العُنْصُرُ: أصْلُ الحَسَب. إنما جاء عن الفُصَحاء مضمُومُ العَين منصُوب الصاد، ولا يجيء في كلامهم من الرباعي المُنبسِط على بناء فُعْلَل إلاّ ما يكون ثانيه نوناً أو همزةً نحو الجُنْدَب والجُؤْذَر. وجاءَ السودد كذلك كراهِيَة أن يقولوا سودُدٌ فتلتقي الضمّات مع الواو.
عنفص: العِنْفِص: المرأة القليلةُ الجسم، ويقال: هي أيضاً الداعِرة الخبيثة، قال:
ليستْ بسَوْداءَ ولا عِنْفِصٍ ... تُسارِقُ الطَّرْفَ إلى الداعِرِ «252»
وقال آخر:
صُلْبُ العَنافِصِ كلَّ أمرٍ أصلَحَتْ ... ومُعَمَّر في أهله مَعْمُورُ «253»
صعنب: الصَّعْنَبَةٌ: أن تُصَعْنِبَ الثريدة، تضُمُّ جوانبها وتُكَوِّمُ صَومعتها.
صنبع: والصَّنْبَعَةُ: انقباض البخيل عند المسألة. يقال: رأيتُه يُصَنْبِعُ لؤماً. وصنيبعات «254» : اسم موضع.
__________
(252) لم نهتد إلى الشاهد في كتب اللغة، وهو مما تفرد به العين.
(253) لم نتبين هذا البيت لانفراد العين بروايته.
(254) في ط: صنبعات.
(2/337)
________________________________________
عنصل: العُنْصُل: نباتٌ شِبْهُ البَصَل، وَوَرَقُه كورق الكُرّاث «255» ونوره أصفر يتخد منه صبيان الأعراب أكاليلَ، قال:
والضرب في جَأواءَ ملمومةٍ ... كأنَّما هاماتُها العُنْصُلُ «256»
عصلب: العَصْلَبيُّ: الشديد الباقي القوّة، «257» ، قال:
قد ضَمَّها اللَّيلُ بعَصْلَبيِّ
وعَصْلَبتُه: شِدَّة عَصَبه.
صلمع، صلفع: الصَلْمَعَةُ والصَلْفَعَةُ: الإفلاس «258» . ورجلٌ مُصَلْمِعٌ مُصَلْفِعٌ مُفْقِعٌ مُدْقِعٌ. صُلْمِعَ رأسُه وصُلْفِعَ: إذا استؤصِلَ شَعرُه. بلغة أهل العراق.
صعتر: الصَّعْتَر: ضَرْبٌ من البقول. والصَعْتَريُّ: الشاطِرُ
دعمص: الدُعْمُوص: دُوَيبةٌ تكونُ في الماء، قال:
ودُعْمُوصُ ماءٍ نَشَّ عنها غَديرُها
الدعْموص: الرجلُ الدَخّال في الأُمُور، الزَوّارُ للملوك، قال أمَيّة بن أبي الصَّلت:
دُعْمُوصُ أبواب الملوك ... وجانب للخرق فاتح
__________
(255) وزاد في التهذيب مما نقل عن الليث بقوله: أو أعرض منه.
(256) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في المصادر التي أفدنا عنها.
(257) في التهذيب عن الليث: الباقي على المشي والعمل، وكذلك في اللسان. وما أثبتناه فمما ورد في الأصول المخطوطة الثلاثة.
(258) وجاء في التهذيب مما نقل عن الليث: الإفلاس وذهاب المال.
(2/338)
________________________________________
رثعن: ارثَعَنَّ المطَرُ: إذا ثَبَتَ وجاد، قال «259» :
كأنَّه بعد رِياحٍ تَدْهَمُهْ ... ومُرْثَعِنّات الدُّجُونِ تَثمِهْ
والمُرْثَعِنُّ من الرجال: الضعيف، قال:
لستُ بالنِكْسِ ولا بالمُرْثَعِنْ
والمُرْثَعِنُّ: السيدُ الغالب: قال «260» :
حيثُ ارثَعَنَّ الوَدْقُ في الصَّحاصِحِ
بعثر: يقال بَعْثَرَه بَعْثَرَةً: إذا قَلَبَ الترابَ عنه.
عبثر: العَبَوْثَران: نباتٌ مثل القَيْصُوم في الغُبْرة، ذَفِرُ الريح، الواحدة عَبَوْثَرانة، فإذا يَبِسَتْ ثَمرَتُها عادت صفراءَ كَدِرة. وفيه أربع لغات بالياء والواو وضمّ الثّاء وفتحها.
عثلب: عَثْلَبَ زنداً: أي أخذه من شجرٍ لا يدري أيوري أم لا. وعَثْلَب: اسم ماء، قال الشمّاخ:
وصدَّتْ صُدوداً عن شَريعةِ عَثْلَبٍ ... ولا بنيَ عياذٍ في الصدور حَزائِزُ «261»
. عَثْلَبْتُ الحوضَ: إذا كسَرْتُه، قال العجّاج:
والنُؤيُ أَمْسَى جدره معثلبا «266»
__________
(259) (رؤبة) ديوانه/ 149.
(260) لم نهتد إلى القائل.
(261) كذا في الأصول المخطوطة والديوان ص 181، وفي التهذيب: حوامز
(266) لم يرد الرجز في ديوان العجاج.
(2/339)
________________________________________
دلعث: الدَّلْعَثُ: الجَمَلُ الضَّخْم، قال «262» :
دلاث دلعثي، كأن عظامه ... وعت في محال الزَّوْرِ بعدَ كُسُورِ
عمثل: العَمَيْثَلُ والعَمَيْثَلَةُ: الضَّخْمُ الثقيل. والعَمَيْثَلُ: إذا كان فيه إبطاءٌ من عِظَمه ونحو ذلك. وامرأةٌ عَمَيْثَلة ويُجمَعُ عَماثِلَ، قال «263» :
ليس بمُلْتاثٍ ولا عَمَيْثَلِ
ثعلب: الثَعْلَبُ: الذَكَر، والأنثى: ثُعالة. وثَعْلُبُ الرمح: ما دخل في عامِلِ صَدره في جُبَّةِ السِّنانِ. وثَعْلَبَ «264» الرجُلُ: جَبُنَ وراغ، كقول الشاعر:
فإنْ رآني شاعِرٌ تَثَعْلَبَا
والثَّعْلَبيَّةُ: اسم مكان. والثَّعْلبيَّةُ «265» : عَدْوٌ أشَدُّ من الخَبَبِ من عَدْوِ الفَرَس. وقال بعضُهم: الثَّعْلَبُ خَشَبَةٌ صُلْبة تُبْرَى ثم تدخُلُ في قَصَبَة القَناة، ثم يُرَكَّبُ فيها السِنانُ، وتُسَمَّى بالكلب، قال لبيد:
يُغرِقُ الثَعْلَبَ في شِرَّتِه ... صائِبُ الجذْمَةِ في غَيْر فَشَلْ
قولُه: في شِرَّتِه أي في أوَّلِ رَكْضه وسُرعته. والثَعْلَبُ: الحجر الذي يسيلُ منه المطر.
__________
(262) البيت في اللسان والتاج (دلعث) ، وجاءت (دلعثي) في التاج بياء مشددة ليستقيم الوزن. من غير عزو فيهما أيضا.
(263) لم نهتد إلى الراجز.
(264) وفي التهذيب: وثعلب الرجل وتثعلب....
(265) كذا في ص وط، وفي س: الثعلبة.
(2/340)
________________________________________
نعثل: النَعْثَلُ: الشَّيْخُ الأحمقُ، ويُقال: فيه نَعْثَلةٌ أي حُمْقٌ. وقال بعضُ الناس في عُثْمانَ: اقتُلُوا النَّعْثَلَ، يقال: شَبَّهَهُ بالضَبع كما يقال في العربيّة: يا ثَوْرُ، يا حِمارُ. والنَّعْثَلُ: الذيخ، وهو الذكر من الضِبْعان.
بلعم: البُلْعُومُ: البَياضُ الذي في جَحْفَلَة الحِمار في طَرَف الفَمِ، قال:
بيص البلاعيمِ أَمثال الخَواتيمِ
قال زائدةُ: البُلْعُومُ باطِنُ العُنُقِ كُلُّه، وليس كما قال.
عنبل: امرأةٌ عُنْبُلةٌ، وعَنْبَلَتُها: طولُ بَظْرِها. والعُنْبُلةُ: الخَشَبَةُ يُدَقُّ بها الشَيء في المِهْراس «267» . والعُنابِل: الوَتَرُ الغليظ، قال:
والقَوْسُ فيها وَتَرٌ عُنابِلُ «268»
والعُنابُ مثلُ العُنْبُلة أي البَظر.
عنبر: العَنْبَرُ: ضرب من الطيب.
__________
(267) في اللسان: يدق عليها بالمهراس، وكذلك في القاموس.
(268) الرجز في اللسان (لعاصم بن ثابت) .
(2/341)
________________________________________
يعفر: اليَعفُورُ: الخِشْف، سُمِّيَ بذلك لكَثرة لُزُوقِه بالأرض، قال طَرَفة:
آخرَ الليل بيعْفُورٍ خَدِرْ «269»
أي بشخص ظَبيٍ خَجِل مُسْتَحْيٍ.
يربع: يَرْبُوع: دُوَيْبةٌ فوقَ الجُرَذ، الذكر والأنثى فيه سواء. ويَرْبُوعٌ: قبيلة من تَميم.
برعم: البَرْعَمَةُ والبَراعم: أكمامُ ثَمَر الشَجَر.
لعظم: اللَّعْظَمةُ «270» : الانتِهاسُ على اللَّحْمِ مِلءَ الفَمِ. تقول: لَعْظَمتُ اللَّحم، وهو انتِهاسٌ على عجلة.
لعمظ: اللَّعْمَظَةُ: الحِرْصُ والشَهْوة في الطعام.
عظلم: العِظْلِمُ: عُصارةُ شَجَر لونه أخضَرُ إلى الكُدْرة.
رعبل: رَعْبَلْتُ اللَّحمَ رَعْبَلَةً: أي قَطَّعْتُه قِطَعاً صِغاراً كما يُرَعْبَلُ الثَّوْبُ فيُمَزَّقُ مِزَقاً، الواحدةُ رُعْبُولةٌ من الرَّعابِلِ، وهي الخِرَقُ المُتَمَزِّقَة. والشِّواءُ المُرَعْبَلُ: يُقَطَّعُ حتى تصلَ النارُ إليه فتنضجه، قال «271» :
__________
(269) وصدر البيت كما في اللسان: جازت البيد إلى أرحلنا.
(270) هذه المادة والتي تليها واحدة في الصحاح واللسان فكأنهما على القلب.
(271) التهذيب 3/ 364 واللسان (رعبل) وقد نسب فيهما إلى (ابن أبي الحقيق.)
(2/342)
________________________________________
من سَرَّه ضَرْبٌ يُرَعْبِلُ بعضُه ... بعضاً كَمَعْمَعَةِ الأباءِ المُحْرَقِ
الأباءُ: القَصَبُ. والأبُّ: الحشيش. أي يجُزُّ بعضُه بعضاً في السرعة، والمَعْمَعَةُ: السرعة. وامرأةُ رَعْبَل: في الخلقان، قال «272» :
كَصَوْت خَرقاءَ تُلاحي، رَعْبَلِ
أي تُشاتِمُ أخرى.
برعل، فرعل: البُرْعُلُ والفُرْعُلُ: وَلَدُ الضَّبع، الواحدةُ فُرْعُلة، قال «273» :
سَواءٌ على المَرءِ الغريبِ أجارُهُ ... أبو حَنَشٍ [أم] كانَ لحمَ الفَراعِلِ
عمرط: العَمَرَّط: الجَسُور الشديد. وبالدال أيضاً.
عفنط: العفنط: اللئيم الرذل السيىء الخلق.
عفنظ: العفنظ «274» : الذي يُسَمَّى عَناقَ الأرض.
عدمل: العدملي «275» : القديم.
__________
(272) في اللسان الرجز (لأبي النجم.)
(273) زاد في التهذيب: من الضبع. ولم نهتد إلى قائل البيت الشاهد وفي الأصول المخطوطة: (أو) مكان (أم) .
(274) في اللسان: العفنط عناق الأرض بالطاء المهملة والمادتان ومادة واحدة.
(275) في اللسان العدامل والعدملي والعدامل والعداملي واحد، وكذلك في التهذيب.
(2/343)
________________________________________
برذع: البَرْذَعَةُ «276» : الحِلْسُ الذي يُلْقَى تحت الرَّحْل وهو القِرطاط.
عذفر: العُذافِرةُ: الناقةُ الشديدةُ وهي الأَمُونُ. والعُذافِرُ: كوكبُ الذَنَب.
عذلم: العُذْلُمِيُّ «277» من الرجال: الحريصُ الذي يأكُلُ ما قَدِرَ عليه.
__________
(276) وهي بالدال المهملة أيضا.
(277) لم أهتد إليه ولم أجده في المعجمات المتيسرة لدي.
(2/344)
________________________________________
باب الخماسي من العين
قال الليث، قال الخليل: الخُماسيُّ من الكلمة على خمسة أحرف، ولا بدَّ أن يكونَ من تلك الخمسة واحد أو اثنان من الحروف الذَّلْق: ر، ل، ن، ف، ب، م، فإذا جاءت كلمة [رباعية أو خماسية] لا يكون فيها واحد من هذه الستة، فاعْلَمْ أنَّها ليست بعربية. قال: فإنْ قُلتَ مثلُ ماذا؟ قال: إن سُئِلْتَ عن [الحضاثج] ، فقل: ليست بعربية، لأنّه ليس فيها شيء من تلك الأحرف الستة. وكذلك لو قيل لكَ ما الخَضَعْثَج؟ فقل: ليست بعربية لأنّه ليس فيه من تلك الأحرف الستة شيءٌ. فمن الخُماسيِّ:
عفنقس وعقنفس: العَفَنْقَسُ والعَقَنْفَسُ: لغتان مثل جذب وجبذ، وهو السيىء الخُلُقِ المُتَطاوِلُ على الناس. يقال للعَقَنْفَس: ما الذي عَقْفَسَه وعَفْقَسَه؟ أي ما الذي أساء خلقه بعد ما كانَ حَسَنَ الخُلُق، قال العجّاج:
إذا أرادَ خُلُقاً عفنقسا «278»
عضرفوط: العضرفوط: دويبة تُسَمَّى العِسْوَدَّة «279» بيضاءُ ناعمةٌ تشبه بها أصابع
__________
(278) الرجز في الديوان ص 134 وفي التهذيب وبعده:
أقره الناس وأن تفجسا
(279) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: العسود.
(2/345)
________________________________________
الجواري، تكون في الرَمْل، وتُجمَعُ عَضافيط وعَضْرَفُوطات. ويقال: هي العَضْفُوط والعَضَافيطُ جماعة في القَولَين جميعاً. قال زائدة: العَسْوَدة، بالهاء، عظاءةٌ كبيرةٌ سَوداء تكون في الشَّجَر والجَبَل، وجمعه عِسْوَدٌ. وقال بعضهم: العَضْرَفوط: ذكر العَظاء، وهي من دَوابِّ الجِنِّ، قال:
وكلَّ المَطايا قد ركِبْنا فلم نَجِدْ ... أَلَذُّ وأَحْلَى من وَخيد الثَّعالِبِ
ومن فارةٍ مُزْمومةٍ شَمَّريَّةٍ ... وخَودٍ [ترى فيها] «280» امامَ الركائب
ومن عَضْرَفُوطٍ حَطَّ بي في ثَنيّةٍ ... يُبادِرُ سِرْباً من عَظاءٍ قَوارب
قَوارِب: طَوالِبُ الماء.
هبنقع: الهَبَنْقَعُ والهَبَنْقَعَةُ: المَزْهُوُّ الأحمق، والجميعُ: هَبَنْقَعُون وهَبَنْقَعَات، والفعل اهْبَنْقَعَ اهْبِنْقاعاً، إذا جَلَسَ جِلْسَةَ المَزْهُوِّ الأحمق، يُقال: هو يمشي الهَبَيَّخَى ويجلِسُ الهَبَنْقَعَة. الهَبَيَّخَى «281» : مِشيةٌ فيها نَفْجٌ وتحريك البدَن، قال جميل:
يَظَلْنَ بأعلَى ذي سَديرٍ عَواطباً ... بمُستَأنِسٍ من عيرجن هبنقع «282»
__________
(280) في س: تراميها، وفي ص وط: ترد فيها: ولم نجد الأبيات في غير الأصول من فطان.
(281) كذا هو الصحيح، وفي الأصول المخطوطة: الهبيخ.
(282) ديوانه/ 124 وفيه: لمستأنس.
(2/346)
________________________________________
قذعمل: القُذَعْمِلةُ والقُذَعْمِلُ: (الضَّخْمُ من الإبل) «283» . والقُذَعملة: الشديد من الأمر. قال زائدةُ: القُذَعْمِلُ الشَيءُ الصغيرُ شِبْهُ الحَبَّة، تقول: لا تُعطِ فلاناً قُذَعْمِلَةً.
قبعثر: القَبَعْثَرَى: الفَصيلُ المهزول، ويُجمعُ على قَبَعْثَرات وقَباعِث. وسألتُ أبا الدقيش عن تصغيره فقال: قُبَعْثرة «284» . ويقال: بل هو الفَصيلُ الرِخْوُ المضطرِب. وقال بعضُهم: ليس ذا بشيءٍ، ووافقه مُزاحم قال: ولكنّ القَبَعْثَرَى دابَّةٌ من دَوابِّ البحر لا تُرَى إلا مُنْقَبعةً في الثَّرَى أو على ساحل البحر.
عبنقاة: العَبَنْقَاة «285» : أي الداهية من العِقبان، ويجمَع عَبَنْقَيات وعَباقيّ. ومنهم من يقلبها فيقول: عَقَنْباة، قال الطرمّاح:
عُقابُ عَبَنْقاةٌ كأنَّ وَظيفَها ... وخُرْطُومَها الأَعْلَى بنارٍ مُلَوَّحُ
قوله: عَبَنْقاة أي حديدة الأظفار، مُلَوَّح لسوادها. ويقال: اعْبَنْقَى يَعْبَنْقي اعبنقاءً. وعَبَنْقاة بوزن فَعَنْلاة.
عنقفير: العَنْقَفير: الداهية، وعَقْفَرَتها: دهاؤها. وغُولٌ عَنْقُفيرٌ.
__________
(283) سقط ما بين القوسين من س.
(284) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب وزاد قوله: على الترخيم. في اللسان: قبيعث.
(285) في اللسان: عقاب عقنباة وعبنقاة وقعنباة وبعنقاة.
(2/347)
________________________________________
قرعبل: القَرْعْبْلانةُ: دُوَيْبَّةٌ عريضةٌ مُحْبَنْطِئةٌ. وما زادَ على قَرَعْبَل فهو فضلٌ ليس من حروفها الأصلية. ولم يأتِ شيءٌ من كلام العرب يَزيدُ على خمسة أحرف إلا أن تلحقها زيادات ليست من أصلها أو يُوَصَلَ حكايةً يُحكى بها، كقول الشاعر «286» :
فَتَفْتَحُه طَوْراً وطَوراً تُجيفُه ... فَتَسمعُ في الحالَيْنِ منه جَلَنَبَلَقْ
يَحكي صوتَ بابٍ في فَتْحِهِ وإصفاقه. وهما حكايتان جَلَنْ على حِدة، وبَلَق على حِدة. وقول الشاعر في حكاية جَرْي الدَوابِّ:
جَرَتْ الخَيْلُ فقالت ... حَبَطِقْطِقْ حَبَطِقْطِقْ
وإنّما هو إردافٌ كما أردَفُوا العَصَبْصَب، وإنّما هو من العَصيب.
جَنَعْدَل: الجَنَعْدَل «287» : التارُّ الغليظ الرقَبَة.
دلعوس: الدِّلْعَوْس، المرأةُ الجريئة على أمرها العَصيَّةُ لأهلها. والدِّلْعُوْسُ: الناقةُ الجريئة أيضاً.
سقرقع: السُقُرْقَع «288» : شراب لأهل الحجاز من الشعير والحُبوب قد لَهِجُوا به. وهذه الكلمة
__________
(286) التهذيب 3/ 368، واللسان (جلنبلق) . غير منسوب أيضا.
(287) من التهذيب 3/ 369 عن العين. في الأصول المخطوطة: جعندل.
(288) كذا في اللسان، وفي التهذيب: السفرفع (بالفاء) ، وفي الأصول المخطوطة بالشين.
(2/348)
________________________________________
حبشية وليست من كلام العرب، وبيان ذلك أنه ليس من كلام العرب كلمة صدرها مَضمُوم وعَجُزُها مفتوح إلاّ ما جاء من البناء المُرَخَّم نحو الذُرَحْرَحة والخُبَعْثَنة. وأصل هذا أنّهم يَعْمِدون إلى الشعير فَيُنَبِّتُونه، فإذا كَبَتَ أو هَمَّ بالنبات خَمَدوا إليه فجفَّفُوه ثم اتَّخَذوه هَيُوجاً لشَرابهم أي عَكراً، ثم يعمِدُون إلى خُبْز الشعير أو غير ذلك فيخبِزُونه خُبزاً غِلاظاً، ثم إذا أخرَجُوه حارّاً كسروه في الماء، ثم ألقَوا فيه من ذلك الطَّحين قَبْضةً فيُغليه ذلك أيّاماً، ثم يُضْرَبُ بالعَسَل فهو شَرابٌ قطامي صلب.
اقعنسس: اقعنسس العِزُّ: إذا ثَبَتَ ولَزِمَ، قال:
تَقَاعُسَ العِزُّ بنا فاقْعَنْسَسَا «289»
سقعطر: السَّقَعْطَريُّ من الرجال: لا يكون أطوَلَ منه. ويقال: تُنْعَتُ الإبلُ بهذا النَّعْت.
سبعطر: السَّبَعْطَريُّ: الضَّخْمُ الشديدُ البَطش
خبعثن: الخُبْعَثِنُ: من كلّ شيءٍ التّارُّ البَدَن، الرّيّانُ المَفَاصِلِ، وتقول: اخبَعَّثَ في مشيهِ، وهو مَشْيٌ كَمَشيِ الأسد، قال يصف الفيل:
خُبَعْثِنٌ مشيته عثمثم «290»
__________
(289) (العجاج) ديوانه/ 138.
(290) اللسان (عثم) غير منسوب أيضا.
(2/349)
________________________________________
ويقالُ: أسَدٌ خُبَعْثِنةٌ. ويقالُ: فلان خُبَعثِنةٌ. ويقال: للفيل خُبَعْثِنٌ وبَقَرةٌ خُبَعْثِنةٌ، قال أعرابيّ في صفة الفيل:
خُبَعْثِنٌ في مَشْيِهِ تَثْقيلُ ... أمثالُه بأرضِنا قليلُ «291»
وإن قلتَ: خُبَعْث على الترخيم جازَ لك. وإنْ قيل للذَكَر بالهاء كانَ صواباً كقولك أسَدٌ خُبَعْثِنَةٌ.
علطميس: العَلْطَمِيسُ من النوق: الشَديدةُ الضَّخْمَةُ ذاتُ أقطار وسَنام مُشرفٍ.
سلنطع: السَّلَنْطَعُ: الرّجُل المُتَعَتِّهُ في كلامه كأنه مجنُون.
عيطموس: العَيْطَمُوسُ من النّوق: الشديدةُ الضَّخْمَةُ.
عندليب: العَنْدَليبُ: طُوَيْرٌ يُصَوِّتُ ألواناً.
عفرناة: أَسَدٌ عِفِرْناة: شديد قوي. ولبوءة عِفِرْناة.
جَلَنْفَع: الجَلَنْفَعُ: الغليظ من الإِبِل.
تلعثم «292» : التَلَعْثُمُ: التَنَظُّرُ. لَعْثَم عنه أي نَكَلَ عنه. وتَلَعْثَمْتُ عن هذا الأمر أي نَكَلْتُ عنه.
__________
(291) لم نهتد إليه.
(292) من حق هذه الكلمة أن يترجم لها في أبواب الرباعي لأنها رباعية، ولكنه عبث النسخ.
(2/350)
________________________________________
ج 3
حرف الحاء
قال الخليل بن أحمد- رضي الله عنه «1» -: الهاء والحاء لا تأتلفان في كلمةٍ واحدةٍ أصليّة الحروف، لقُرب مَخْرجَيْهما في الحَلْق، ولكنَّهما يجتمعان من كلمتين، لكُلِّ واحدةٍ منهما معنىً على حِدَة، كقول لبيد:
يَتَمارَى في الذي قلتُ له ... ولقد يَسَمعُ قَولي حَيَّهَلْ
وقال آخر:
هَيْهاؤهُ وحَيْهَلُهْ
حَي كلمة على حدة ومعناها هَلُمَّ، وهل حِثِّيثَى، فجَعَلَهما كلمةً واحدة.
وفي الحديث «2» : إذا ذُكِرَ الصالحونَ فَحَيَّهَلا بعُمَرَ
أي فَأْتِ بذكر عُمَرَ. قال اللَّيْث: قُلتُ للخليل: ما مِثْلُ هذا في الكلام: أن يُجْمَعَ بين كلمتين فتَصير منهما كلمة واحدة؟ قال: قول العرب عَبْد شَمْس وعَبْد قَيْس فيقولون: تَعَبْشَمَ الرجل وتعبقس وعبشمي وعبقسي.
__________
(1) جملة الدعاء لم ترد في ص وط. والبيت الشاهد في ديوان لبيد ص 183
(2) وفي اللسان: وفي حديث ابن مسعود. وقد روي الحديث في التهذيب: فحيهل ...
(3/5)
________________________________________
باب الثنائي
باب الحاء والقاف وما قبلهما مهمل ح ق، ق ح مستعملان
حق: الحقُّ نقيض الباطل. حقَّ الشيْء يَحِقُّ حَقّاً أي وَجَبَ وُجُوباً. وتقول: يُحِقُّ عليكَ أنّ تفعَلَ كذا، وأنتَ حقيقٌ على أن تفعَلَه. وحَقيقٌ فَعيلٌ في موضع مفعول. وقول اللهِ عزَّ وجَلّ «1» - حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ
«2» معناه مَحقوق كما تقول: واجب. وكلُّ مفعُول رُدَّ إلى فعيل فمذكره ومؤنثه بغير الهاء، وتقول للمرأة: أنتِ حقيقةٌ لذلك، وأنتِ محقوقة أن تفعلي ذلك، قال الأعشى:
لَمحقُوقَةٌ أنْ تَسْتَجيبي لصَوْته ... وأنْ تَعلمي أنَّ المُعانَ مُوَفَّقُ «3»
والحَقَّةُ من الحَقِّ كأنَّها أوجَبُ وأَخَصُّ. تقول: هذه حَقَّتي أي حَقّي. قال:
وحَقَّهٌ ليست بقول التُرَّهة.
والحقيقة: ما يصيرُ إليه حقُّ الأمر ووجوبه. وبلغْتُ حقيقةَ هذا: أي يقين شأنه.
وفي الحديث: لا يبلُغُ أحدُكُم حقيقةَ الإِيمان حتى لا يعيبَ على مُسلِمٍ «4» بعَيْبٍ هو فيه.
وحقيقةُ الرجل: ما لَزِمَهُ الدفاعُ عنه من أهل بيته، والجميع حقائق.
__________
(1) في ص وط: وقوله من غير إشارة إلى أن القول آية.
(2) سورة الأعراف 105
(3) البيت في الديوان واللسان وقبله:
وإن امرء أسرى إليك ودونه ... من الأرض موماة ويهماء سملق
(4) في التهذيب واللسان والنهاية: مسلما
(3/6)
________________________________________
وتقول: أَحَقَّ الرجُلُ إذا قال حَقّاً وادَّعَى حَقّاً فوَجَبَ له وحَقَّقَ، كقولك: صدَّق وقالَ هذا هو الحقُّ. وتقول: ما كان يَحُقُّك أن تَفْعَل كذا أي ما حَقَّ لك. والحاقَّةُ: النازلة التي حقَّتْ فلا كاذبةَ لها. وتقولُ للرجل إذا خاصَمَ في صِغار الأشياء: إنّه لنَزِقُ الحِقاقِ.
وفي الحديث: مَتَى ما يَغْلُوا يحتَقُّوا
أي يَدَّعي كلُّ واحدٍ أنَّ الحقَّ في يَدَيْه، ويغلوا أي يُسرفوا في دينهم ويختصموا ويتجادلوا. والحِقُّ: دونَ الجَذَع من الإِبِل بسنةٍ، وذلك حين يَسْتَحِقُّ للرُكُوب، والأُنثَى حِقَّةٌ: إذا استَحَقَّتِ الفَحْلَ، وجمعه حِقاق وحَقائِق، قال عَديّ:
لا حقة هُنَّ ولا يَنوبُ «1»
وقال الأعشى «2»
أيُّ قومٍ قَوْمي إذا عزت الخمر ... وقامتْ زِقاقُهُمْ والحِقاقُ
والرواية:
قامت حِقاقُهُم والزِّقاق
فمن رواه:
قامت زقاقُهم والحقاق
يقول: استوت في الثمن فلم يفضلُ زِقٌ حِقّاً، ولا حِقٌّ زِقّاً. ومثله:
قامت زقاقُهم بالحِقاق
فالباءُ والواوُ بمنزلة واحدة، كقولهم: قد قامَ القَفيزُ ودِرْهَم، وقام القَفيزُ بدرهم. وأنتَ بخَيرٍ يا هذا، وأنت وخَيْرٌ يا هذا، وقال «3» :
ولا ضعافِ مُخِّهِنَّ زاهقِ ... لَسْنَ بأنيابٍ ولا حَقائقِ
__________
(1) لم نجده في ديوان عدي بن زيد.
(2) البيت في التهذيب واللسان (لعدي) . وقد ضمه محقق ديوان عدي إلى شعر (عدي) مما لم يذكر في الديوان. وفي الأصول المخطوطة منسوب إلى (الأعشى) ولم نجده في ديوان الأعشى ولعله من سهو الناسخ.
(3) الرجز في اللسان (لعمارة بن طارق) وروايته: ومسد أمر من أيانق......
(3/7)
________________________________________
وقال «1» :
أفانينَ مكتُوبٍ لها دونَ حِقِّها ... إذا حَمْلُها راشَ الحِجاجَيْن بالثُّكْلِ
جَعَلَ الحِقَّ وقتاً. وجمع الحُقَّةِ من الخَشَب حُقَق، قال رؤبة:
سوى مساحيهن تقطيط الحقق «2»
والحَقْحَقَةُ: سَيْرُ أوّلِ اللُيل، وقد نُهِيَ عنه، ويقال: هو إتعابُ ساعة.
وفي الحديث: إيّاكُم والحَقْحَقةَ في الأعمال، فإنَّ أحَبَّ الأعمال إلى الله ما داومَ عليه العبد وإنْ قلَّ.
ونباتُ الحَقيق «3» : ضرب من التَّمْر وهو الشِّيصُ.
قح: والقُحُّ الجافي من الناس والأشياء، يقالُ للبَطِّيخة التي لم تَنْضَج: إنَّها لقُحٌّ «4» . والفعلُ: قَحَّ يقُحُّ قُحوحةً، قال:
لا أبتغي سَيْبَ اللئيم القُحِّ ... يكادُ من نحنحة وأح
يحكي سعال الشَّرِقِ الأَبَحِّ «5»
والقُحُّ: الشَّيخُ الفاني. والقُحُّ: الخالصُ من كُلِّ شَيْءٍ. والقُحْقُحُ: فوقَ القَبِّ شيئاً. والقَبُّ: العظمُ الناتىء من الظَّهْر بين الأَلْيَتْين.
__________
(1) الشاعر (ذو الرمة) . والبيت في الديوان 1/ 153.
(2) الرجز في ديوان رؤبة.
(3) جاء في التهذيب: قلت: صحف الليث هذه الكلمة وأخطأ في التفسير أيضا، والصواب: لون الحبيق ضرب من التمر ردىء.
(4) قال الأزهري في التهذيب: قلت: أخطأ الليث في تفسير القح، وفي قوله للبَطِّيخة التي لم تَنْضَج إنهالقح، وهذا تصحيف. وصوابه: الفج بالفاء والجيم
(5) الرجز في التهذيب فيما نقله عن الليث، ثم تكرر في اللسان، وكله من غير عزو.
(3/8)
________________________________________
باب الحاء مع الكاف ح ك، ك ح «1» مستعملان
حك: الحَكيكُ: الكَعْبُ المحكُوكُ. والحَكيكُ: الحافِرُ النَّحيتُ. والحَكَكَةُ: حَجَرٌ رِخْوٌ أبيض أرْخَى من الرِّخام وأصلَبُ من الجَصِّ. والحاكَّةُ: السِنِّ، تقول: ما فيه حاكَّة. ويقال: إنَّه لَيَتَحكَّكُ بكَ: أي يَتَعَرَّض لشَرِّكَ. وحَكَّ في صدري واحتَكَّ: وهو ما يَقَعُ في خَلَدك من وسَاوِس الشيطان.
وفي الحديث: إياكم والحكاكات فإنَّها المآتم.
وحَكَكْتُ رأسي أحُكُّه حَكّاً. واحتَكَّ رأسُه احتكاكاً. وقوله «2» :
أنا جُذَيْلُها المُحَكَّك
أي عِمادُها ومَلْجَأُها.
كح: الأكح: الذي لا سن له. والكُحْكُحُ: المُسِنُّ من الشّاء والبقر.
باب الحاء مع الجيم ح ج، ج ح مستعملان
حج: قد تُكسَر الحَجّةُ والحَجُّ فيقال: حِجُّ وحِجَّةٌ. ويقال للرجل الكثير الحَجٍّ حَجّاج من غير إمالةٍ. وكلُّ نعت على فَعّال فإنّه مفتوح الألف، فإذا صيَّرتَه اسماً يَتَحَوَّل عن حال النَّعْت فتدخله الإمالة كما دَخَلَتْ في الحَجّاج والَعجّاج. وحَجٍّ علينا فُلانٌ أي قَدِمَ. والحَجُّ: كثرة القَصْد إلى من يُعَظَّم، قال:
كانت تحُجُّ بنُو سَعْدٍ عِمامتَه ... إذا أَهَلُّوا على أنصابِهم رَجَبا «3»
__________
(1) لم ترد هذه المادة في الأصول المخطوطة بعد مادة (حكك. وأثبتناها من مختصر العين [ورقة 55] .
(2) في التهذيب: وقول (الحباب أنا جذيلها ...
أنا جذيلها ...
(3) لم نهتد إلى البيت ولا إلى قائله.
(3/9)
________________________________________
حَجُّوا عِمامتَه: أي عظَّمُوُه. والحِجَّةُ: شَحْمةُ الأُذُن، قال لبيد:
يَرُضْنَ صِعابَ الدُرِّ في كل حجة ... وإن لم تكن أعناقهن عواطلا «1»
ويقال: الحجة هيهنا الموسم. والحَجْحَجَةُ: النُّكُوصُ، تقول: حَمَلوا ثم حَجْحَجوا أي نَكَصُوا، قال «2» :
حتّى رَأَى رايتَهم فَحَجْحَجا
والمَحَجَّةُ: قارعة الطريق الواضح. والحُجَّةُ: وَجْهُ الظَّفَر عند الخُصومة. والفِعل حاجَجْتُه فَحَجَجْتُه. واحتَجَجْتُ عليه بكذا. وجمع الحُجَّة: حُجَجٌ. والحِجاج المصدر. والحَجاجُ: العظمُ المستدير حولَ العَين، ويقال: بل هو الأَعْلى الذي تحت الحاجب، وقال: «3»
إذا حَجاجا مُقلتَيْها هَجَّجا
والحَجيجُ: ما قد عُولِجَ من الشَجَّة، وهو اختلاط الدَّمِ بالدماغ فيصب عليه السَّمْنُ المَغْلِيُّ حتى يظهَرَ الدمُ فيُؤخَذُ بقُطنةٍ، يقال: حَجَجْتُه أحُجُّه حَجّاً. الجَحْجاحُ: السيِّدُ السَّمْحُ الكريمُ، ويجمع: جَحاجِحة، ويجوز بغير الهاء، قال أمية «4» :
__________
(1) رواية الديوان ص 243:
....... ... ولو لم تكن أعناقهن عواطلا.
وهو كذلك في ص وط في حين أن الرواية في س واللسان: يرضن صعاب الدو......
(2) صاحب الرجز هو (العجاج) . انظر الديوان ص 389. والرواية فيه:
حتى رأى رائيهم فحجحجا
(3) (الحجاج) أيضا. انظر الديوان واللسان.
(4) لا ندري (أأمية بن أبي الصلت) أم أمية آخر؟ ولم نجد البيت في ديوان أمية بن أبي الصلت.
(3/10)
________________________________________
ماذا ببدر فالعقنقل ... من مرازبة جَحاجحْ
وأَجَحَّتِ الكلبةُ: أي حَمَلَتْ فهي مُجحٌّ.
باب الحاء مع الشين ح ش، ش ح مستعملان
حش: حَشَشْتُ النارَ بالحَطَب أحُشُّها حَشّاً: أي ضَمَمْتُ ما تَفَرَقَ من الحَطَب إلى النار. والنابِلُ إذا راشَ السَهْمَ فأَلزَقَ القُذَذَ به من نَواحيه يقال: حَشَّ سَهْمَه بالقُذَذِ، قال:
أو كمريخ على شريانة ... حشه الرامي بظهران حشر «1»
والبَعيرُ والفَرَسُ إذا كان مُجْفَرَ الجنْبَيْن يقال: حُشَّ ظهْرُه بجَنْبَيْنِ واسِعَيْن، قال أبو داود في الفرس:
منَ الحاركِ مَحْشُوشٌ ... بجَنْبٍ جُرْشُعٍ رَحْبِ «2»
والحُشاشةُ: روحُ القلب. والحُشاشةُ: رَمَقُ بَقيَّة من حياة النفس، قال يصف القردان «3» :
__________
(1) البيت في التهذيب 3/ 392 فيما رواه عن الليث من غير عزو.
(2) البيت في اللسان (حشش) .
(3) البيت (للفرزدق) كما في التهذيب واللسان (حشش) والرواية فيه:
إذا سمعت وطء الركاب تنفست......
أما في ترجمة (نغش) فقد قال: وأنشد (الليث) لبعضهم. في صفة القراد:
إذا سمعت وطء الركاب تنغشت
(3/11)
________________________________________
إذا سمعت وطء الركاب تَنَغَشَّتْ ... حُشاشَتُها في غيرِ لحْمٍ ولا دَمِ
والحشيشُ الكَلَأُ، والطّاقَةُ منه حشيشةٌ، والفعل الاحتِشاش. والمَحَشَّةُ: الدُّبُر.
وفي الحديث: مَحاشُّ النساء حرامٌ
ويُرْوَى: مَحاسنٌّ بالسين أيضاً. والحَشُّ والحُشُّ: جماعة النَّخْل، والجميعُ الِحُشّان. ويقالُ لليَدِ الشّلاّءِ: قد حَشَّتْ ويَبِسَتْ. وإذا جاوزَتِ المرأةُ وقتَ الوِلادِ «1» وهي حاملٌ ويَبْقَى الولَدُ في بطنها يقال: قد حَشَّ ولدُها في بَطنها أي يَبِسَ. وأحَشَّتِ المرأةُ فهي مُحِشٌّ. والحَشُّ: المخرَجُ.
شح: يقالُ: زَنْد شَحاحٌ: أي لا يُوري. والشَّحْشَحُ: المواظِب على الشيء الماضي فيه. والشَّحْشَحُ: الرجل الغَيورُ وهو الشَّحشاح، قال «2» :
فيقدمُها شَحْشَحٌ عالمٌ
ويقالُ: شَحْشَحَ البعير في الهَدْر وهو الذي ليس بالخالِص من الهَدْر، قال:
فردَّدَ الهَدْرَ وما إنْ شحشحا «3»
__________
(1) كذا في ص وط، وفي س: الولادة
(2) البيت (لحميد بن ثور) كما في ديوانه ص 48 والرواية فيه:
تقدمها شحشح جائز ... لماء قعير يريد القرى
(3) الرجز في التهذيب 3/ 396 من غير عزو. ونسب في اللسان (شحح) إلى (سلمة بن عبد الله العدوي.)
(3/12)
________________________________________
ويقالُ للخطيب الماهِر في خُطْبته الماضي فيها: شَحْشَح. والشُّحُّ: البُخل وهو الحِرْصُ. وهما يَتَشاحّان على الأمر: لا يُريدُ كلُّ واحدٍ منهما أن يفوته. والنَّعْتُ شَحيح وشَحاح والعَدَدُ أشِحَّة. وقد شَحَّ يَشِحٌّ شُحّاً.
باب الحاء مع الضاد ح ض، ض ح مستعملان
حض: حضَّ: الحِضِّيضَى والحِثِّيَثى من الحَضِّ والحَثِّ. وقد حَضَّ يحُضُّ حضّاً. والحُضضُ: دَواء يُتَّخَذُ من أبوال الإبِلِ. والحَضيض: قَرارُ الأرض عند سفح الجبل.
ضح: الضِّحُّ والضَّيْحُ: ضوء الشَّمس إذا استَمْكَنَ من الأرض. والضَّحْضاحُ: الماءُ إلى الكَعْبَيْن، أو إلى أنصاف السُّوقِ. والضَحْضَحةُ والتَّضَحْضُحُ «1» : جَرْيُ السَّراب وتَلَعْلُعُهُ:
باب الحاء مع الصاد ح ص، ص ح مستعملان
حص: الحَصْحَصَةُ: الحركةُ في الشيْء حتى يَسْتَقِرَّ فيه ويَستَمكنَ منه. وتحاص
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: والتضحيح.
(3/13)
________________________________________
القَومُ تَحاصّاً: يَعني الاقتِسامَ من الحِصَّة. والحَصْحَصَةُ: بَيان الحق بعد كتمانه. حَصْحَصَ الْحَقُّ، ولا يقال: حُصْحِصَ الحقُّ. والحُصاصُ: سُرعة العَدْو فيِ شِدَّة. ويقال: الحُصاص: الضُّراط. والحُصُّ: الوَرْسُ، وإن جُمِعَ فحُصُوص، يُصْبِغُ به، وهو الزَّعْفَران أيضاً. والحَصُّ: إذهابُكَ الشَّعْر كما تَحُصُّ البَيْضة رأس صاحبها، قال «1» :
قد حَصَّتِ البَيْضَةُ رأسي فما ... أطعَمُ ونَوماً غيرَ تَهْجاعِ
وقال: «2»
بميزان قِسْطٍ لا يَحُصُّ شعيرةً ... له شاهدٌ من نفسه غيرُ فاضِلِ «3»
لا يَحُصُّ: أي لا يَنْقُصُ. ويقالُ: رجلٌ أحَصُّ وامرأةٌ حَصّاء. وقال في السنة الجَرداء الجَدْبة:
عُلُّوا على شارفٍ صَعْبٍ مراكبُها ... حَصّاءَ ليس بها هُلْبٌ ولا وَبرُ «4»
عُلُّوا: حُمِلُوا على ذلك
صح: الصِحَّةُ: ذَهابُ السَّقَم والبَراءة من كل عَيْب ورَيْب. صَحَّ يَصِحُّ صِحَّةً.
(والصَّومُ مَصَحَّةٌ «5» )
ومَصِحَّة، ونَصْب الصادِ أعلى من الكسر. يعني يصح عليه.
__________
(1) في التهذيب 3/ 400: وقال (أبو قيس بن الأسلت.)
(2) في اللسان: وفي شعر (أبي طالب) : البيت....
(3) والمعنى: ذهب الشعر كله.
(4) البيت في اللسان غير منسوب، والرواية فيه:
علوا على سائف صعب مراكبنها
(5) ما بين القوسين من الحديث الشريف كما في التهذيب 3/ 404
(3/14)
________________________________________
والصَّحْصَانُ والصَحْصَحُ: ما استوى وجَرِدَ من الأرض، ويجمع صَحاصِح، قال:
وصَحْصَحانٍ قُذُفٍ كالتُّرْسِ «1»
باب الحاء مع السين ح س، س ح مستعملان
حس: الحَسُّ: القَتْل الذَريعُ. والحَسُّ: إضرارُ البَرْد الأشياءَ، تقول: أصابتْهم حاسَّةٌ من البَرْد، وباتَ فلان بِحَسَّةِ سَوءٍ «2» : أي بحالٍ سيِّئةٍ وشدَّةٍ. والحَسُّ: نَفْضُك التُرابَ عن الدابَّة بالمِحَسَّة وهي الفِرْجَون. ويقالُ: ما سَمِعْتُ له حِسّاً ولا جرِسْاً، فالحِسُّ من الحركة، والجْرسُ من الصَّوْت. والحِسُّ: داءٌ يأخُذُ النُّفَساءَ في رَحِمها. وأَحْسَسْتُ من فُلانٍ أمراً: أي رأيتُ. وعلى الرؤيةِ يُفسَّر (قوله عَزَّ وجل) : فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ
«3» أي رأَى. ويقال: مَحَسَّةُ المرأة: دُبُرُها. ويقالُ: ضُرِبَ فلان فما قالَ حَسٍّ ولا بَسٍّ، ومنهم من لا ينوِّن ويجُرُّ فيقول: حَسِّ، ومنهم من يكسر الحاء «4» . والعرب تقول عند لَذْعِة نارٍ أو وَجَع: حَسٍّ حس «5» . والحس: مس
__________
(1) التهذيب 3/ 405 واللسان (صحح) ورواية فيهما:
وصحصحان قذف مخرج
(2) جاء في التهذيب: قلت: والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة بات بحيبة سوء، وبكينة سوء، وببيئة سوء. ولم أسمع بحسة سوء لغير الليث والله أعلم.
(3) سورة آل عمران 52
(4) وزاد في اللسان: والباء.
(5) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب 3/ 407 في اللسان: حس بس.
(3/15)
________________________________________
الحُمَّى أوّلَ ما تبدو «1» . والحِسُّ: الحَسيسُ تسمَعُه يمُرُّ بك ولا تَراه، قال:
تَرَى الطَّيْرَ العِتاقَ يَظَلْنَ مِنْهُ «2» ... جُنُوحاً إنْ سَمِعْنَ له حسيساً
وتَحَسَّسْتُ خَبَراً: أي سأَلْتُ وطَلَبْتُ.
سح: السَّحْسَحَةُ: عَرْصَة المَحَلَّة وهي السّاحةُ. وسَحَّتِ الشّاهُ تَسِحُّ سَحّاً وسُحُوحاً أي حَنَّتْ. وشاةٌ سمينة ساحٌّ، ولا يقال: ساحَّةٌ. قال الخليل: هذا مما يُحْتَجُّ به، إنّه قولُ العرب فلا نَبْتَدُع شيئاً فيه. وسَحَّ المَطَرُ والدَّمْعُ يَسِحُّ سَحّاً وهو شدَّةُ انصبِابِه. وفَرَسٌ مِسَحٌّ: أي سريع، قال «3» :
مسح إذا ما السابحات على الوَنَى ... أثَرْنَ الغُبارَ بالكَديدِ المُرَكَّلِ
باب الحاء مع الزاي ح ز، ز ح مستعملان
حز: الحُزُّ: قَطْعٌ في اللَّحْم غيرُ بائن. والفَرْضُ في العظم والعُود غير طائل حز أيضا. يقال: حززته حَزْاً، واحتزَزْتُه احتِزازاً، قال الشاعر: «4»
وعبدُ يَغُوتٍ تَحجِل الطَّيْرُ حولَه ... قد احتَزَّ عرشيه الحسام المذكر
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: تبدأ.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: يطلن.
(3) للشاعر (امرىء القيس) . انظر معلقته، وانظر اللسان (كدد) .
(4) (لذي الرمة) انظر الديوان 2/ 648، والرواية فيه: وقد حز....
(3/16)
________________________________________
فجعل الاحتزاز هيهنا قطع العنق. والحزازة: هبرية في الرَأس «1» ، وتجمَع على حَزازٍ. والحزازةُ أيضاً: وَجَعٌ في القَلْب من غَيْظٍ ونحوه. والحَزّاز يُقال في القَلْب أيضاً، قال الشمّاخ:
فلما شراها فاضت العين عبرة ... وفي الصدر حزاز من اللَّومِ حامِزُ «2»
وقال «3» :
وقد يَنْبُتُ المَرْعَى على دِمَن الثَّرَى ... وتَبْقَى حَزازاتُ النُفوس كما هِيا
وتقول: أعطيتُه حُزّةً من لَحْمٍ «4» . والحَزّاز من الرجال: الشَّديد على «5» السَّوْق والقِتال، قال:
فهي تفادى من حزاز ذي حَزِقْ «6»
وفي الحديث: أخَذَ بحُزَّته
يقال: أخَذَ بعُنقه، وهو من السَّراويل حُزَّة وحُجْزَة، والعُنُق عندي تشبيه به. وحَزّاز «7» القلوب: ما حَزَّ وحكَّ في قلبه. والحَزيزُ: مَوضِعٌ من الأرض كَثُرتْ حِجارتُه وغَلُظَتْ كأنَّها سكاكينُ، ويجمعُ على حُزّاِن وثلاثة أحِزَّة «8» . وإذا أصاب المرفقُ طَرَفَ كِرْكِرةِ البَعيرِ فقَطَعَه قيل به حاز.
__________
(1) وزاد في التهذيب: كأنها نخالة.
(2) ديوانه/ 190 وروايته فيه:
............... ........... ... وفي الصدر حزاز من الوجد حامز
(3) اللسان (حزز) ، وقد نسب فيه إلى (زفر بن الحرث الكلابي) .
(4) وفي اللسان: وأعطيته حذية من لحم وحزة من لحم.
(5) كذا في ص وس، وفي ط: من.
(6) الرجز في التهذيب 3/ 414 غير منسوب.
(7) كذا في س في ص وط: حواز. وفي اللسان مثل ما أثبتناه.
(8) في المحكم: والجمع أحزة وحزان بضم الحاء أو كسرها مع تشديد الزاي.
(3/17)
________________________________________
زح: الزح: جذب الشَّيءِ في العَجَلة. زَحَّه يزُحُّه زَحّاً. والزَّحْزَحة: التَنْحِيةُ عن الشيء [يقال] زَحْزَحْتُه فتَزَحْزَحَ.
باب الحاء مع الطاء ح ط، ط ح مستعملان
حط: الحَطُّ: وَضْعُ الأحمال عن الدَّوابِّ. والحَطُّ: الحَدْرُ من العُلوِّ. وحَطَّتِ النَجيبةُ وانحَطَّتْ في سيرها من السرعة، قال النابغة يمدح النُّعمانَ:
فما وخدت بمثلك ذات غرب ... حطوط في الزمام ولا لَجُونُ «1»
وقال: «2»
مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقِبلٍ مُدْبرٍ مَعاً ... كجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّه السَّيْلُ من عَلِ
وحَطَّ عنه ذُنُوبَه، قال:
واحْطُطْ إلهي بفَضْلٍ منك أوزاري «3»
والحَطاطةُ: بَثُرٌة تخرُج في الوجه صغيرة تُقَبِّح «4» اللَّوْنَ ولا تُقَرِّح، قال: «5»
ووجهٍ قد جَلَوتِ أُقَيْم صافٍ ... كقَرْن الشمس ليس بذي حطاط
__________
(1) البيت في الديوان ص 265.
(2) الشاعر هو (امرؤ القيس) ، والبيت في مطولته.
(3) لم نهتد إلى البيت ولا إلى قائله.
(4) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب واللسان: تقيح.
(5) (هو المتنخل الهذلي) كما في اللسان، والرواية فيه:
ووجه قد رأيت أميم صاف
وفي ديوان الهذليين 2/ 23:
ووجه قد طرقت أميم صاف
(3/18)
________________________________________
وبَلَغَنا أنَّ بني إسرائيلَ حيثُ قيل لهم: وَقُولُوا حِطَّةٌ «1» * إنّما قيل لهم ذلك حتّى يَسْتَحِطُّوا بها أوزارهم فتُحَطَّ عنهم. ويقالُ للجارية الصغيرة: يا حَطاطةُ. وجاريةٌ مَحْطُوطُة المَتْنَيْن أي ممدُودةٌ حَسَنة، قال النابغة:
محطُوطةُ المَتْنَينِ غيرُ مُفاضةٍ «2»
طح: الطَحَّ: أنْ يَضَعَ الرجلُ عَقِبَه على شيءٍ ثمَّ يَسْحَجُه بها. والمِطَحّةُ من الشّاةِ مُؤَخَّرُ ظِلْفها وتحتَ الظِلّفْ في مَوْضِع المِطَحَّة عُظَيم كالفَلْكة. والطَّحْطَحَةُ: تفريق الشيء هَلاكاً، وقال في خالد بن عبد الله القَسْريّ:
فيُمْسي نابذاً سُلْطان قَسْرٍ ... كضَوء الشمس طَحْطَحَه الغُرُوبُ «3»
باب الحاء مع الدال حد، د ح مستعملان
حد: فَصلُ ما بينَ كُلِّ شيئين حَدٌّ بينهما. ومُنْتَهَى كُلِّ شيءٍ حدُّه. وحَدَّ السيفُ واحتَدَّ. وهو جَلْدٌ حَديدٌ. وأحدَدْتُه. واستَحَدَّ الرجلُ واحتَدَّ حِدَّةً [فهو] «4» حديد. وحُدُودُ الله: هي الأشياء التي بيَّنَها وأَمَر أنْ لا يُتَعَدَّى فيها. والحَدُّ: حَدُّ القاذِف ونحوِه مما يُقامُ عليه من الجَزاء بما أتاه. والحديد معروف، وصاحبه
__________
(1) سورة البقرة 58، سورة الأعراف 161
(2) وعجز البيت:
زيا الروادف بضة المتجرد ... وهي من داليته المشهورة.
(3) اللسان (طحح) غير منسوب أيضا.
(4) الزيادة من اللسان (حدد) .
(3/19)
________________________________________
الحَدّاد. ورجل محدُود: مُحارِف في جدّه. وحَدُّ كلِّ شيءٍ: طَرَف شَباتِه كحَدِّ السِّنان والسَّيف ونحوِه. والحُدُّ: الرجلُ المَحدُودُ عن الخير. والحَدُّ: بأْسُ الرجل ونَفاذه في نجدته، قال العجاج:
أُمْ كيفَ حَدَّ مُضَرَ القَطيمُ «1»
وأحَدَّتِ المرأةُ على زَوجها فهي مُحِدٌّ «2» وحَدَّتْ بغير الألف أيضاً، وهو التَسليبُ بعد مَوته. وحادَدْتُه: عاصيته، مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ
، أي يُعاصيه. وما عن هذا الأمرِ حَدَدٌ: أي مَعْدِل «3» ولا مُحْتَدٌّ، مثله، قال الكُميت:
حَدَداً أن يكونَ سَيْبُكَ فينا ... رَزِماً أو مُجَبَّناً ممصوراً «4»
وحَدّان: حيٌّ من اليَمَن. والحَدُّ: الصَرْف عن الشيء من الخَير والشَرّ. وتقول للرامِي: اللهُم احدُدْه، أي لا تُوفِقّهْ للإصابة. وحَدَدْته عن كذا: مَنَعتُه والاستِحْداءُ: حَلْقُ الشيء بالحديد، وحَدُّ الشَّراب: صَلابتُه، قال الأعشى «5» :
وكأسٍ كعَيْنِ الديكِ باكَرْتُ حَدَّها ... بفِتْيانِ صِدق والنواقيس تضرب
__________
(1) الديوان ص 63 عن التهذيب. ورواية اللسان:
أم كيف حد مطر الفطيم.
(2) كذا في التهذيب وكتب اللغة الأخرى، وفي الأصول المخطوطة: محدة.
(3) في التهذيب: معزل.
(4) كذا في اللسان (حدد) ، وروايته في التهذيب:
............... ........... ... وتحا أو محينا محصورا
والرواية في الأصول المخطوطة: فمصورا.
(5) ديوانه/ 203.
(3/20)
________________________________________
دح: الدّحُّ: شِبْهُ الدَسِّ، وهو أن تضع شيئاً على الأرض ثمَّ تَدُقُّه وتَدُسُّه حتّى يَلْزَقَ، قال أبو النجم:
بيتاً خفّياً في الثَّرَى مَدحُوحا
والدَحُّ أن ترميَ بالشيءِ قُدُماً «1» . والدَحْداحُ والدَحْداحة من الرجال والنساء: المستديرُ المُلَمْلَم، قال:
أَغَرَّكِ أنَّني رجلٌ قصيرٌ ... دُحَيْدِحةٌ وأَنَّكِ عَلْطَميسُ «2»
باب الحاء مع التاء ح ت، ت ح مستعملان
حت: الحَتُّ: فركك شيئاً عن ثَوب ونحوه، قال الشاعر:
تحتُّ بقَرْنَيْها بَريرَ أراكة ... وتعطو بظلفيها إذا الغُصن طالها «3»
وحُتاتُ كُلِّ شَيءٍ: ما تَحاتَّ منه. والحَتُّ لا يبلُغُ النَحْتَ.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احْتُتْهُم يا سَعْدُ فِداكَ أبي وأُمِّي
يعني اردُدْهُم. والفَرَسُ الكريم العَتيقُ: الحَتُّ.
تح: وتَحْتَ: نقيضُ فَوْق. والتُحُوتُ: الذين كانوا تحتَ أقدام الناس لا يُشْعَرُ بهم.
وفي حديثٍ: لا تَقومُ الساعةُ حتى يظهَرَ التُحُوتُ «4»
__________
(1) الرجز في التهذيب فيما رواه الأزهري عن الليث، وهو منسوب (لأبي النجم) ، وزاد في اللسان: في وصف قترة الصائد.
(2) البيت في التهذيب واللسان من غير عزو.
(3) البيت في التهذيب 3/ 423 وهو مما أنشده (الليث) .
(4) التهذيب 3/ 424، وتتمته فيه:
ويهلك الوعول.
(3/21)
________________________________________
باب الحاء مع الظاء ح ظ مستعمل فقط ظ ح
حظ: والحظ: النَّصيبُ من الفَضْل والخير، والجميع: الحُظُوظ. وفلان حَظيظ، ولم نَسْمَعْ فيه فِعلاً. وناس من أهل حِمْص يقولون: حَنْظ، فإذا جَمَعوا رَجَعوا إلى الحُظُوظ، وتلك النُونُ عندهم غُنَّةٌ ليست بأصلية «1» . وإنّما يَجري على ألْسنتهم في المُشَدَّد نحو الرُزّ يقولون: رُنْز، ونحو أُتْرُجَّة يقولون أتْرُنْجة، ونحو اجّار يقولون انّجار فإذا جَمَعوا تركوا الغُنَّة ورجعوا إلى الصِحَّة فقالوا: أجاجير وحُظوظ.
باب الحاء مع الذال ح ذ مستعمل، فقط
حذ: الحَذُّ: القَطْعُ المُسْتَأْصلُ. والحَذَذُ: مصدر الأَحَذّ من غير فِعل. والأحَذُّ يُسَمَّى به الشيْءُ الذي لا يتعَلّقُ به شَيْءٌ. والقلبُ يُسَمَّى أحَذّ. والدُّنْيا وَلَّتْ حَذّاءَ مُدْبرة: لا يتعلّق بها شيء. والأحذ من عَروض الكامل: ما حُذِفَ من آخِره وَتِدٌ تامُّ وهو مُتَفاعِلُنْ حُذفَ منه عِلُنْ فصار مُتَفا فجُعل فَعِلُن مثل قوله:
وحُرِمتَ «2» منّا صاحباً ومُؤازِراً ... وأَخاً على السَّرّاء والضُرِّ
وقصيدةٌ حَذّاءُ: أي سائرةٌ لا عيبَ فيها. ويقالُ للحمار القصير الذَّنَب: أَحَذّ. ويقال للقَطاة: حَذّاء لقِصَر ذَنَبها مع خِفّتها، قال الشاعر: «3»
__________
(1) قوله: ليست بأصلية قد جاءت في التهذيب: ولكنهم يجعلونها أصلية.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: جرمت بالجيم الموحدة التحتية.
(3) (للنابغة الذبياني) يصف القطا، كما في التهذيب، وانظر الديوان (ط. دمشق) ص 176 والرواية فيه:
حذاء مدبرة سكاء مقبلة
(3/22)
________________________________________
حَذّاءُ مُقبلةً سَكّاءُ مُدبرةً ... للماء في النَّحْر منها نَوْطةٌ عَجَبُ
باب الحاء مع الثاء ح ث، ث ح مستعملان
حث: حثيثٌ فلاناً فهو حثيث مَحْثُوث، وقد احتَثَّ. وامرأة حَثيثةٌ في موضع حاثَّةٍ، وامرأ حثيث في موضع مَحثوثة. والحثِّيِثَى من الحَثّ، قال: اقبَلُوا دِلِّيلَى رَبّكُمُ وحِثّيثاه إيّاكم «1» يعني ما يدُلُّكم ويحثُّكُم. والحَثْحَثَةُ: اضطرابُ البَرْق في السِّحاب وانتخال «2» ، المَطَر والثَلْج. والحَثُوثُ والحُثْحُوث: السَّريعُ. قال زائدة: الحَثْحَثَةُ طَلَب الشيء وحَرَكُته، يقالُ: حَثْحَثَ الأمر ليتحرَّك. وحَثْحِثِ القَومَ: أي سَلْهُم عن الأمور.
ثح: الثَّحْثَحَةُ: صوتٌ فيه بُحَّةٌ عند اللَّهاةِ. قال:
أَبَحُّ مُثَحْثَحٌ صَحِلُ «3» الشَّحيحِ «4»
باب الحاء مع الراء ح ر، ر ح مستعملان
حر: حَرَّ النهار يَحِرُّ حَرّاً. والحَرُورُ: حَرُّ الشمس. وحَرَّتْ كَبِدُه حَرَّةً،
__________
(1) كذا في التهذيب، وفي الأصول المخطوطة: اقبلوا دليلاه ربكم
(2) كذا في اللسان وعنه صحح ما في التهذيب وكذا في ط وص في س: انتحال.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: صهل.
(4) كذا في الأصول المخطوطة، وفي اللسان: الثحيج
(3/23)
________________________________________
ومصدره: الحَرَرُ، وهو يُبْسُ الكَبِد. والكَبِدُ تَحَرُّ من العَطَش أو الحزن. وو الحريرة: دَقيقٌ يُطبَخُ بلَبَن. والحَرُّةُ: أرض ذاتُ حِجارة سُودٍ نَخِرة كأنَّما أُحرِقَتْ بالنار، وجمعه حِرار وإحَرِّين وحَرّات، قال:
لا خَمْسَ إلا جَندَلُ الإِحَرِّينْ ... والخَمْسُ قد جَشَّمَكَ الأَمَرِّينْ»
والحرّان: العطشان، وامرأةٌ حَرَّى. والحُرَّ: ولد الحيّة اللطيف في شعر الطِرِمّاح:
كانطِواءِ الحُرّ بينَ السِّلام «2»
والحُرُّ: نَقيضُ العَبد، حُرٌّ بين الحُرُوريَّة والحُرّية والحرار «3» . والحرارة: سحابة حُرَّة من كثرة المطر. والمُحَرَّرُ في بني إسرائيل: النذيرة. كانوا يجعلون الولد نذيرةً لخدمة الكنيسة ما عاشَ لا يَسَعُه تركه في دينهم. والحر: فعل حَسَن في قول طَرَفة:
لا يكنْ حبُّكَ داءً قاتلاً ... ليس هذا منك ماويَّ بحُرّ «4»
والحُرِّيَةُ من الناس: خِيارُهم. والحُرُّ من كل شيءٍ اعتَقُه. وحُرَّة الوَجْه: ما بداً من الوَجْنة. والحُرُّ: فَرْخَ الحَمام، قال حُمَيد [بن ثور] :
وما هاجَ هذا الشَّوقَ إلاّ حَمامَةٌ ... دَعَتْ ساقَ حُرٍّ في حَمامٍ تَرَنَّما «5»
وحُرَّة النِفْرَى: موضِع مَجال القُرْط. والحُرُّ والحُرَّة: الرَمْلُ والرَمْلةُ الطَيِّبة، قال:
__________
(1) في أرجوزة نسبت في اللسان إلى (زيد بن عتاهية التميمي) يخاطب ابنته بعد أن رجع إلى الكوفة من صفين.
(2) ديوانه/ 426 وصدر البيت فيه:
منطو في مستوي رجبة
(3) زاد في اللسان: الحرورية.
(4) البيت في ديوان طرفة ص 64.
(5) الرواية في الديوان ص 24: ترحة وترنما في مكان في حمام ترنما.
(3/24)
________________________________________
واقَبلَ كالشِّعْرَى وُضُوحاً ونُزْهةً ... يُواعِسُ من حُرِّ الصَّريمة معظما
يصف الثَور. وقول العجاج:
في خشاوى حُرَّةِ التَحريرِ
أي حُرَّة الحِرار «1» ، أي هي حُرّة. وتحرير الكتاب: إقامةُ حُروفه وإصلاحُ السَّقَط. وحَرْوراء «2» : مَوضعٌ، كان أوّل مجتمع الحُرُوريّة بها وتحكيمهم منها. وطائرٌ يُسمَّى ساق حر. والحُرّ في قول طَرَفة وَلَد الظَبْي حيثُ يقول «3» :
بين أكنافِ خُفافٍ فاللِّوَى ... مُخرِفٌ يَحْنُو لرَخْص الظِّلْف حُرّ
وحَرّان: مَوْضع. وسَحابة حُرَّةٌ تَصفِها بكثرة المطر. ويقال للَّيْلة التي تُزَفُّ فيها العَروس إلى زَوْجها فلا يقدِرُ على افتِضاضها ليلةٌ حُرَّةٌ، فإذا افتَضَّها فهي ليلةٌ شَيْباء، قال «4» :
شُمْسٌ مَوانِعُ كلَّ ليلةِ حُرَّةٍ
رح: الرَّحَحُ: انبساط الحافِر وعِرَضُ القَدَم، وكلُّ شيءٍ كذلك فهو أرَحُّ، قال الأعشى:
فلو أنَّ عِزَّ الناسِ في رأسِ صَخرةٍ ... ململمة تعيي الأرح المخدما «5»
يعني الوَعِل يصفه بانبساط أظلافه. ويستَعمل أيضاً في الخُفَّيْن وتَرَحْرَحَتِ الفَرَسُ إذا فَحَّجَتْ قَوائِمَها لَتُبوَل. رَحْرَحان: موضع.
__________
(1) في التهذيب واللسان: يعني حرة الذفرى.
(2) كذا في المصادر والأصول التاريخية، وفي الأصول المخطوطة: حرور
(3) هو (طرفة بن العبد) كما ديوانه/ 49.
(4) (النابغة الذبياني) ديوانه/ 103 وعجز البيت فيه:
يخلفن ظن الفاحش المغيار
(5) كذا في اللسان والتهذيب في الأصول المخطوطة: المخذما
(3/25)
________________________________________
باب الحاء مع اللام ح ل، ل ح مستعملان
حل: المَحَلُّ: نَقيضُ المُرْتَحَل، قالَ الأعشى:
إنَّ مَحلاًّ وإنَّ مُرْتَحَلا ... وإنّ في السَّفْر ما مَضَى مَهَلاً «1»
قُلتُ للخليل: أَلَيسَ تزعمُ أنَّ العَرَبَ العاربةَ لا تقول: إنّ رجلاً في الدار، لا تَبدأ بالنكرة ولكنّها تقول: إن في الدارِ رجلاً، قال: ليس هذا على قياس ما تقول، هذا من حكاية سَمِعَها رجلٌ من رجل: إن محلاًّ وإن مُرْتَحَلاً. ويصف بعد ذلك حيث يقول:
هل تذكُر العَهْدَ في تنمُّصَ إذ ... تضربُ لي قاعداً بها مَثَلاً
والمَحَلُّ الآخرة، والمُرْتَحَلُ: الدنيا، وقال بعضهم: أرادَ أنّ فيه محلاًّ وأن فيه مُرْتَحَلاً فأضمَرَ الصِفة. والمَحَلُّ مصدرٌ كالحُلُول. والحِلُّ والحلال والحلول والحلل: جماعة الحالّ النازل، قال رؤبة:
وقد أَرَى بالجَوِّ حَيّاً حِلَلاً ... حِلّاً «2» حِلالاً يَرْتَعون القُنْبُلا
والمحلّةُ: مَنْزِل القَوم. وأرضٌ مِحلال: إذا أَكَثْرَ القَومُ الحُلول بها. والحِلَةُ: قَومٌ نُزولٌ، قال الأعشى:
لقد كان في شَيْبان لو كنت عالماً ... قِبابٌ وحتى حلة وقبائل
__________
(1) انظر الصبح المنير ص 155
(2) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: حي، وكذلك في اللسان.
(3/26)
________________________________________
وتقول: حَلَلْتُ العُقْدةَ أحُلُّها حلاً إذا فَتَحْتَها فانحَلَّت. ومن قَرَأَ: يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي
«1» [ف] معناه ينزِلُ. ومن قَرَأَ: يحلُلْ يُفْسَّر: يحبُ من حَلَّ عليه الحقُّ يحُلّ محلاً. وكانت العَرَبُ في الجاهلية الجهلاء إذا نَظَرت إلى الهِلال قالت: لا مرحباً بمُحِلِّ الدَّيْن مُقَرِّبِ الأَجَل. والمُحِلُّ: الذي يَحِلُّ لنا قَتلُه «2» ، والمُحرِمُ الذي يَحرمُ علينا قتلُه، وقال: «3»
وكم بالقنان من مُحِلٍّ ومُحرِمِ
ويقال: المُحِلُّ الذي ليس له عهدٌ ولا حُرمة، والمُحرِمُ: الذي له حُرْمة. والتَحليل والتَحِلَّةُ من اليمين. حللت اليمين تحليلا وتحلة، وضربته ضربا تحليلا يعني شبه التعزير غيرَ مُبالَغٍ فيه، اشتُقَّ من تحليل اليمين ثمَّ أُجرِي في سائر الكلام حتّى يقال في وصف الإبِلِ إذا بَرَكَت:
نَجائِبٌ وقْعُها في الأرض تحليل «4»
أي: هَيِّنٌ. والحَليلُ والحَليلةُ: الزَّوْجُ والمرأةُ لأنَّهما يحلاَن في موضع واحد، والجميع حلائل. وحَلْحَلْتُ بالإبِلِ إذا قلت: حلْ بالتخفيف، وهو زَجْرٌ، قال:
قد جَعَلَتْ نابُ دُكَيْنٍ تَرْحَلُ «5» ... أخرى وإنْ صاحُوا بها وحَلْحَلوا
__________
(1) سورة طه 81
(2) في اللسان: قتاله.
(3) هو (زهير بن أبي سلمى) من مطولته المعروفة ديوانه/ 11 وصدر البيت:
جعلن القنان عن يمين وحزنه.
(4) قائل البيت (كعب بن زهير) ديوانه/ 13 وصدره:
تخدي على يسرات وهي لاحقة
والرواية فيه:
ذوابل وقعهن الأرض تحليل
(5) اللسان (حلل) غير منسوب أيضا. والرواية في: (تزحل) بالزاي.
(3/27)
________________________________________
وحَلْحَلْتُ القَوْمَ: أزَلْتُهم عن موضعهم. ويقالُ: الحُلَّةُ إزارٌ ورِداءُ بُردٌ أو غيرُه. ولا يقال لها حُلّة حتّى تكون ثَوْبَيْن. وفي الحديث تصديقُه وهو ثَوبٌ يمانيٌّ. ويقولون للماء والشيء اليسيرُ مُحَلَّل، كقوله: «1»
نَميرُ الماءِ غيرَ مَحَلَّلِ
أي غير يسير. ويحتمل هذا المعنى أن تقول: غَذاها غِذاءً ليس بمحلل، أي ليس بيسير ولكن بمبالغةٍ. ويقال: غير محلل أي غير مَنزُول عليه فيكْدُرُ ويَفسُدُ. قال الضرير: غير محلل أي ليس بقَدْر تَحِلَّةِ اليمين ولكن فوق ذلك رِياءً. وحَلَّتِ العُقوبة عليه تَحِلُّ: وَجَبَت. والحِلُّ: الحلال نفسه، لا هن حِلٌّ. وشاة مُحِلّ: قد أحَلَّتْ إذا نَزَلَ اللَّبَنُ في ضرَعْها من غير نِتاج ولا وِلاد. وغَنَمٌ مَحالٌّ. والإِحليلُ: مَخْرَجُ البَوْلِ من الذَّكَر ومَخَرجُ اللَّبَنِ من الضَّرْع. والحِلُّ: الرجل الحلال الذي خرج من إصراحه، والفعل أحَلّ إحلالاً. والحِلُّ: ما جاوَرَ الحَرَم. والحُلاَنُ «2» : الجَدْي ويُجمَع حَلالين، ويقال هذا للذّي يُشَقُّ عنه بطْن أُمَّه، قال عمرو بن أحمر:
تُهْدَى إليه ذراع الجفر تَكرِمةًُ ... إمّا ذبيحاً وإما كان حُلاّنا
ويُرْوَى: ذراع البَكْر والجَدْي. والحُلاحِلُ: السيّد الشجاع. والمَحَلُّ: مبلَغ المُسافر حيث يريد. والمَحِلّ: الموضِع الذي يَحِلّ نحرهُ يومَ النَّحر بعد رَمْي جِمار العَقَبة.
__________
(1) هو (امرؤ القيس) في معلقته، والشاهد شيء من عجز بيت هو قوله يصف جارية:
كبكر المُقاناةِ البياض بصفرةٍ ... غذاها نمير الماء غير محلل
انظر اللسان (حلل) .
(2) في التهذيب 3/ 439: حلام وحلان: ولد المعزى، وقد أيده بقول (ابن أحمر) المثبت في هذه المادة.
(3/28)
________________________________________
وفي الحديث: أحِلَّ بمن أحَلَّ بك «1» .
يقول: من تَرَكَ الإحِرام وأحلَّ بك فقاتَلَكَ فاحللْ أنتَ به فقاتِلْهُ.
لح: الإلحاحُ: الإلحاف في المسألة، ألَحَّ يُلِحُّ فهو مُلِحُّ. وأَلَحَّ المَطَرُ بالمكان: أي دام به. والإلحاحُ: الإقبالُ على الشيء لا يفتر عنه. وتقول: هو ابنُ عَمٍّ لّحٍ في النكرة، وابنُ عمّي لَحّاً في المعرفة، وكذلك المؤنَّث والأثنان والجماعة بمنزلة الواحد.
باب الحاء والنون ح ن، ن ح مستعملان
حن: الحِنُّ: حَيٌّ من الجِنِّ، [يقال: منهم الكلابُ السّود] «2» البهم [يقال:] كلب حِنِّيٌّ. والحَنانُ: الرحمةُ، والفعل: التَحُنُّن. والله الحَنّانُ المنّان الرَّحيم بعباده. وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا
«3» . أي رحمةً من عندنا. وحَنانَيْكَ يا فلانُ افعَلْ كذا ولا تفعَلْ كذا تُذَكِّرُه الرحمةَ والبِرِّ. ويقال: كانت أمُّ مَرْيَمَ تُسَمَّى حَنّة. والاستِحنان: الاستِطراب. وعُودٌ حَنّان: مُطرِّبٌ يَحِنُّ. وحَنينُ الناقة: صوتها إذا اشتاقَتْ، ونِزاعُها إلى ولدها من غير صَوتٍ، قال رؤبة:
حَنَّتْ قَلُوصي أمسِ بالأُرْدُنّ ... حنيِّ فما ظُلِّمتِ أنْ تَحِنِّي «4»
والحُنّة: خِرْقةٌ تلبسها المرأةُ فتُغَطّي بها رأسَها.
نح: النّحْنَحُة: أسهَلُ من السُّعال. وهو علة البخيل، قال:
__________
(1) الحديث في اللسان كما في النهاية:
من حل بك فأحلل به.
(2) ما بين المعقوفتين من التهذيب 3/ 445 عن العين.
(3) سورة مريم 13)
(4) والرجز في التهذيب 3/ 446
(3/29)
________________________________________
والتَغْلِبيُّ إذا تَنَحْنَحَ للقِرَى ... حَكَّ استَه وتَمَثَّلَ الأَمثالا
وقال:
يكادُ من نَحْنَحةٍ وأح ... يحكي سعال الشرق الأَبَحِّ «1»
باب الحاء والفاء ح ف، ف ح مستعملان
حف: حَفّ الشَّعْرُ يَحِفُّ حُفُوفاً: إذا يَبِسَ. واحْتَفَّتْ المرأةُ: أمَرَتْ من تَحُفُّ شَعر وَجْهها بخَيْطَيْن. والحُفُوفُ: اليُبُوسةُ من غير دَسَم، قال رؤبة:
قالتْ سُلَيمَى أنْ رَأَتْ حُفُوفي مَعَ اضطِرابِ اللَّحْمِ والشُّفُوفِ «2»
وحَفَّتِ المرأةُ وَجْهَها تَحُفُّه حَفّاً وحُفُوفاً. وسَويقٌ حافٌّ: غير مَلْتُوتٍ. والحَفيفُ: صوتُ الشيء تُحسُّه كالرَمْية أو طَيَران طائر أو غيره، حف يحف حفيفا. وحِفّان الإِبِل: صِغارُها. والحِفّان: الخَدَمُ. والمِحَفَّةُ: رَحْلٌ يحِفُّ بثَوْب تركبُه المرأةُ. وحِفافا كلِّ شيءٍ: جانِباه. وحَفُّ الحائكِ: خَشَبَتُه العريضة [يُنَسِّقُ] «3» بها اللُّحمة بينَ السَدَى. وحَفَّ القَومُ بسيِّدهم: أي أطافوا به وعَكَفُوا، ومنه قَولُه: حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ «4» . والحَفُّ: نَتْفُ الشَّعْر بخيط ونحوه.
__________
(1) استشهد بهذا الرجز في مادة قحح.
(2) في ديوان رؤبة ص 101:
قالت سليمى إذ رأت حفوفي.....
(3) من التهذيب 4/ 4 عن العين. في الأصول: ينسج
(4) الآية: وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. سورة الزمر 75
(3/30)
________________________________________
فح: فَحيح الحَيَّة شبيهٌ بالنَّفْخ في نَضْنَضة، أي بضَرْب أسنانِها. [وقيل] : فَحيح الأفْعَى دَلْكُ بعض جِلْدها ببعض، وهي خَشْناءُ الجلْد. والفَحْفاحُ: الأَبَحِّ من الرجال.
باب الحاء مع الباء ح ب، ب ح مستعملان
حب: أحبَبْته نَقيضُ أبغضته. والحِبُّ والحِبّةُ بمنزلة الحبيب والحبيبة. والحُبُّ: الجَرَّةُ الضَّخمةُ ويُجمَعُ على: حِبَبة وحِباب، وقالوا: الحِبَّةُ إذا كانت حُبوبٌ مختلفةٌ من كل شيء [شيءٌ] .
وفي الحديث: كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَميل السَّيْل.
ويقال لِحَبِّ الرَّياحينِ حِبّة، وللواحدة حَبّة. وحَبّة القلب: ثَمَرَتُه، قال الأعشى:
فرَمَيْت غَفلةَ عَينه عن شاته ... فأصَبْتُ حَبّةَ قلبها وطِحالَها «1»
ويقالُ: حبّ إلينا فلان يَحَبُّ حبّاً، قال:
وحَبَّ إلينا أنْ نكونَ المقدَّما «2»
وحَبابُك أن يَكون ذاك «3» ، معناه: غاية مَحبَّتك. والحِبّ: القُرْط من حَبّةٍ واحدة، قال: «4»
تبيتُ الحَيّةُ النَّضْناضُ منه ... مَكانَ الحِبِّ يَستمع السِّرِارا
__________
(1) البيت من قصيدة يمدح بها (الأعشى) قيس بن معديكرب (انظر الديوان ص 27) .
(2) الشاهد في التهذيب 4/ 8 واللسان وصدره:
دعانا فسمانا الشعار مقدما
(3) كذا في اللسان، وفي الأصول المخطوطة: وحبابك أن تكون ذاك
(4) هو (الراعي النميري) كما في اللسان (حبب) .
(3/31)
________________________________________
وحبَابُ الماء: فقاقيعُه الطافيةِ كالقَوارير، ويقال: بل مُعظَم الماء، قال طرفة:
يَشُقُّ حباب الماء حيزومها بها ... كما قسم الترب المفايل باليَدِ
فهذا يدُلُّ على أنه معْظَم الماء، وقال الشاعر:
كأنَّ صَلاَ جَهِيزةَ حينَ تَمشِي «1» ... حَبابُ الماء يَتَّبِعُ الحبَابا
ويُرْوَي: حين قامت. لم يُشبِّه صَلاها ومَآكِمَها بالفَقاقيع وإنَّما شَبَّههَا بالحَباب الذي كأنه درج في حَدَبَة «2» . وحَبَبُ الأسنان: تَنَضُّدُها، قال طرفة:
وإذا تضحك تُبدي حَبَباً ... كأَقاحي الرَّمْلِ عَذْباً ذا أُشُرْ
وحَبّان وحِبّان: اسمٌ من الحُبّ. والحَبْحابُ: الصغير: ونار الحُباحِب: ذُبابٌ يطيرُ باللَّيل له شُعاعٌ كالسراج. ويقال: بل نارُ الحُباحِب ما اقتَدَحْتَ من شَرار «3» النار في الهَواء من تصادُم الحِجارة. وحَبْحَبَتُها: اتِقّادُها. وقيل في تفسير الحُبِّ والكَرامة: إنّ الحُبَّ الخَشَباتُ الأربَعُ التي توضَعُ عليها الجَرَّة ذاتُ العُرْوَتَيْن، والكَرامة: الغِطاء الذي يُوضَع فوقَ الجرَّة من خَشَبٍ كانَ أو من خَزَفٍ. قال الليث: سمعت هاتَيْن بخراسان. حَبَّذا: حرفان حَبَّ وذا، فإذا وَصَلْتَ رَفَعْتَ بهما، تقول: حَبَّذا زَيْدٌ.
بح: عَوْدٌ أَبَحُّ: إذا كان في صوته غِلَظٌ. والبَحَحُ مصدرُ الأَبَحِّ. والبَحُّ إذا كان من داءٍ فهو البُحاحُ.
__________
(1) في اللسان وأنشد (الليث
كأن صلا جهيزة حين قامت
(2) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة: حدته
(3) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب، وفي اللسان شرر.
(3/32)
________________________________________
والتبحْبُحُ: التَمكُّن في الحُلُول والمُقام، والمرأةُ إذا ضَرَبَها الطَّلْقُ، قال أعرابيّ: تركتُها تُبَحْبحُ على أيدي القَوابل. وقال في البَحَح أي مصدر الأبَحّ:
ولقد بَحِحْتُ من النداء ... لجَمْعِكم هلْ من مُبارز
والبُحْبُوحةُ: وسطُ مَحلّة القَوم، قال جرير:
ينفونَ تغلب عن بُحْبُوحة الدار «1»
باب الحاء مع الميم ح م، م ح مستعملان
حم: حُمَّ الأَمرُ: قُضِيَ. وقدَّرُوا احتَمَمْتُ الأمرَ اهتَمَمْتُ، قال: كأنّه من اهتمام بحَميم وقَريب. والحِمامُ: قَضاءُ المَوْت. والحميم: الماء الحارُّ وتقول: أَحَمَّني الأمرُ. والحامَّةُ: خاصَّةُ الرجل من أهله وولده وذوي قَرابته. والحَمّام: أُخِذَ من الحَميم، تُذكِّرُه العَرَب. والحميم: الماء الحارُّ. وأَحَمَّتِ الأرض: أي صارت ذاتَ حُمَّى كثيرة. وحُمَّ الرجُلُ فهو محموم، وأَحَمَّه الله. والحَمَّةُ: عَيْنٌ فيها ماءٌ حارٌّ يُسْتَشْفَى فيه بالغُسْل. والحَمُّ: ما اصطَهْرتَ إهالتَه من الأَلْيَةِ والشَّحْم، الواحدة: حَمّة، قال:
كأنَّما أصواتُها في المَعْزاء ... صوتُ نَشيش الحَمِّ عند القلاّء «2»
__________
(1) وصدر البيت كما في التهذيب واللسان والديوان:
قومي تميم، هم القوم الذين هم
(2) هذا من اللسان (حمم) وفي الأصول:
كأنما أصواتها في المعزا ... صوتُ نَشيش الحَمِّ عند المقلى
(3/33)
________________________________________
والحُمَم: المَنايا، واحدتُها حُمَّة. والحُمَم أيضاً: الفَحْم البارد، الواحدة حُمَمة. والمَحَمَّةُ: أرضٌ ذاتُ حُمَّى. وجاريةٌ حُمَّةٌ: أي سَوداء كأنها حُمَمة. والأَحَمُّ من كلِّ شيء: الأسَود، والجميع الحُمُّ. والحَمّة: الاسم. والحَمّةُ: ما رَسَبَ في أسفَل النِحْي من سَواد ما احتَرَقَ من السَّمْن، قال:
لا تَحسَبَنْ أنَّ يَدي في غُمَّهْ ... في قعر نحي أستثير حُمَّهْ
وقوله تعالى: وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ
«1» هو الدُخان. والحُمام: حُمَّى الإبِلِ والدَوابِّ وتقول: حُمَّ هذا لذاك أي قُضِيَ وقُدِّرَ وقُصِدَ، قال الأعشى:
هو اليَوْمَ حَمٌّ لميعادِها «2»
أي قصد لميعادها، يقول: واعدتها أن لا أحط عنها حتى القى سلامة ذا فائش. وأحمني فاحتممت، قال زُهَير:
[وكنت إذا ما جئت يوماً] لحاجة ... مضت وأَحَمَّتْ حاجةُ الغَدِ ما تخلو «3»
أي حانت ولَزِمَتْ. والحَميمُ: الذي يَوَدُّكَ وتَوَدُّه. والحَمام: طائر، والعَرَبُ تقول: حَمامةٌ ذَكَر وحَمامةٌ أُنْثَى، والجميع حَمام. والحَميم: العرق. والحَمّاءُ «4» الدُبُر لأنه مُحَمَّم بالشَّعْر، وهو من قولك: حُمَّ الفَرْخُ إذا نَبَتَ ريشهُ. واليَحْمُومُ: من أسماء الفَرَس، على يَفعُول، يَحْتَمِلُ أن يكون بناؤه من الأَحَمّ الأسود ومن الحميم العَرَق. والحِمْحِمُ: نَبات، قال عنترة: تَسَفُّ حَبَّ الحمحم «5»
__________
(1) سورة الواقعة 43
(2) البيت في الديوان ص 73 واللسان وصدره:
تؤم سلامة ذا فائش.
(3) ديوانه/ 97.
(4) كذا في اللسان، وفي الأصول المخطوطة: الحمى.
(5) في التهذيب واللسان (حمحم) : وقد يقال له بالخاء المعجمة واستشهد بعجز بيت (عنترة
وسط الديار تسف حب الخمخم
(3/34)
________________________________________
ويُروَى بالخاء. واستحَمَّ الفَرَس: إذا عَرِقَ. والرجُلُ يُطَلِّق المرأة فَيُحمِّمُها: أي يُمَتِّعُها تَحميماً، قال:
أنتَ الذي وهبت زيدا بعد ما ... هَمَمْتَ بالعَجُوز أن تُحَممَّا
والحَمْحَمةُ: صَوْتُ الفَرَس دونَ الصوت العالي.
مح: المَحُّ: الثَوبُ البالي. والمَحّاحُ: الذي يَرَى الناسَ بلا فِعلٍ من الرجال. والمُحُّ: صُفرة البَيْض، قال «1» :
كانَتْ قُرَيشٌ بَيْضةً فتَفَلَّقَتْ ... فالمُحُّ خالِصُة لعَبْدِ مَنافِ
وأَمَحَّ الثَوْبُ يُمِحُّ: إذا خَلِقُ، ولو استعمل في أَثَر الدارِ إذا عَفَّتْ كان جائزاً، قال: «2»
ألا يا قَتْلَ قد خَلُقَ الجَديدُ ... وحُبُّكِ ما يُمِحُّ وما يَبيدُ
باب الثلاثي الصحيح
باب الحاء والقاف والشين معهما ش ق ح يستعمل فقط
شقح: الشَقْحُ، العَرَبُ تقول: قُبْحاً له وشُقْحاً. وإنَّه لقَبيحٌ شَقيح. ولا يَكاد يُعْزَلُ الشَّقح من القُبْحُ. والشَّقيحُ «3» : تَلوينُ البُسْر إذا اصفَرَّ أو احمَرَّ، قيل: قد
__________
(1) البيت في اللسان (لعبد الله بن الزبعرى) .
(2) لم نهتد إلى القائل.
(3) لا بد أن يكون الصواب: التشقيح لأن الفعل: أشقح وشقح والثاني مضعف، وما أثبتناه فمن الأصول المخطوطة.
(3/35)
________________________________________
شقح.
وفي الحديث: «1» لا بأس ببَيْع تَمْر النخل إذا شَقَّحَتْ
، ويقال: أشقَحَتْ أيضاً.
باب الحاء والقاف والسين معهما ق س ح، س ح ق مستعملان فقط
قسح: القَسْحُ: صَلابةُ الانعاظ، إنّه لقُسّاح مَقْسُوحٌ. قال زائدة: القَسْحُ الفَتْل الشَّديد في الحَبْل. قَسَحْتُه قَسْحاً.
سحق: السَّحْق: دونَ الدَّقّ، وفي العَدْوِ دونَ الحُضْر وفوق السَّحْج، قال العجاج:
سَحْقاً من الجِدِّ وسَحْجاً باطِلاً «2»
ويقال للثَّوْب البالي: سَحَقَه البلَى ودَعَكَه اللُّبْس، قال:
وليسَ عليك إلا طيلسان ... نصيبي وإلا سَحْقُ نِيمِ «3»
وقال: «4»
سَحْقُ البِلَى جدَّتَه فانسحقا
وهو يَسْحَقُه سَحْقاً: ويقال: سَحَقَه وسَحَجَه إذا طَرَدَه طردا شديدا،
__________
(1) جاء في اللسان (شقح) :
وفي حديث البيع: نَهَى عن بيع الثَّمرَ حتى يشقح.
(2) في اللسان وملحق (ديوان رؤبة) (أبيات مفردات) ، ص 182
(3) من الشواهد التي تفرد بها كتاب العين والنيم: الغرو.
(4) (رؤبة) ديوانه ص 108 والرواية فيه: فأسحقا.
(3/36)
________________________________________
قال:
كانَتْ لنا جارةٌ فأزعَجَها ... قاذورةٌ تَسحَقُ النَّوَى قُدُما
والسَحْقُ: البُعد. ولغة أهل الحجاز: بعدٌ له وسُحْقٌ، يجعلونه اسماً، والنَّصْبُ على الدُعاء عليه، أي أبعَدَه اللهُ وأسحَقَه. وأتانٌ سحوق، وحمار سحوق، وهي طِوال المَسانّ ويجمَع [على] سُحُق، قال:
يُمنّيني النسيبُ قُبَيلَ شَهرٍ ... وقد أعيتْنيَ السُحُقُ الطِوالُ «1»
والعَيْنُ تسحق الدَّمعَ سحقاً، ودَمْعٌ مُنْسحِق، ودُمُوع مَساحيقُ كما تقولُ: مُنْكسِر ومَكاسير، قال الراعي:
ظلى طَرفَ عَيْنَيه مَساحيقُ ذُرَّفُ «2»
والاسِحاقُ: ارتِفاعُ الضَّرْع ولُزُوقُه بالبطنِ، قال لبيد:
حتى إذا يَئِسَتْ وأسْحَقَ «3» حالقٌ ... لم يُبلِه إرضاعُها وفِطامُها
ويُرْوَى: لم َيْبُله أي لم يجربه. ومَكانٌ سَحيقٌ: أي بعيد. والسَّوْحَق: الطويل.
باب الحاء والقاف والزاي معهما ق ح ز، ح ز ق، ق ز ح مستعملات فقط
قحز: القَحْزُ: الوثبان والقلق، قال «4» :
__________
(1) الشاهد مما تفرد به كتاب العين.
(2) كذا في الأصول المخطوطة وأورده صاحب التهذيب عن الليث كذلك ولم نهتد إلى الشاهد في أي من المظان.
(3) كذا في التهذيب 4/ 25 والديوان ص 311 في الأصول المخطوطة: وأخلق.
(4) (رؤبة) ديوانه/ 64.
(3/37)
________________________________________
إذا تَنَزَّى قاحزِاتُ القَحْز
يعني به شَدائد الدَّهْرِ، ويقال: قاحِزاتُ القَحْزِ نازياتُ النَّزْو.
حزق: الحَزْقُ: شِدَّة جَذْبِ الرباط والوتَرَ. والرجُلُ المُتَحزِّق: المتشدِّدُ على ما في يَدَيْه ضَنْكاً، وكذلك الحُزُقَّةُ والحُزُقُّ، قال امرؤ القيس:
وأعجبَنَي مَشْيُ الحُزُقَّةِ خالدٍ ... كَمْشيِ أتانٍ حُلِّئَتْ عن مَناهِلِ
ويقال الحَزَق أيضاً وقال في الحزق:
فهي تفادى «1» من حزاز ذي حَزَقْ
والحَزيقةُ: الجماعةُ من حُمْر الوَحْش، قال ذو الرمة: «2»
كأنَّه كلَّما ارفَضَّتْ حَزيقتُها ... بالقاعِ من نَهْشِه أكفالَها كَلِبُ
قزح: القُزَح: ابزار القِدْر. وقِدْرٌ مُقَزَّحة. وقَوْسُ قُزَح: طريقة مُتَقوِّسة تبدوُ في السَّماِء «3» أيامَ الربيع. قال أبو الدُقَيْش: القُزَح الطرائف التي فيها، الواحدة: قُزْحة. وقُزَح: اسم شيطان. والتَقزيح في رأْس شجرةٍ أو نَبْتٍ: إذا انشعب شُعباً مِثْلَ بُرْثُن الكلب. ونُهي عن الصلاة خَلْفَ شجرة مقزَّحةَ، وقول الأعشى:
في مُحيلِ القدَّ من صحب قزح «4»
__________
(1) اللسان (حزق) غير منسوب أيضا، وفيه: تعادى.
(2) ديوانه 1/ 59 وفيه: (بالصلب) في مكان (بالقاع) وفي الأصول المخطوطة: حزيقته.
(3) وزاد في التهذيب عن الليث: غب المطر.
(4) وصدر البيت كما في التهذيب واللسان والديوان:
جالسا في نفر قد يئسوا
(3/38)
________________________________________
يعني لقباً له وليس باسم.
باب الحاء والقاف والطاء معهما ق ح ط يستعمل فقط
قحط: القَحْطُ: احتِباسُ المَطَر. قُحِطَ القَوم وأقحَطُوا. وقُحِطَت الأرضُ فهي مَقْحوطة. أو قَحَطَ المَطَر: احتَبَس، قال الأعشى:
وهُمُ يُطْعِمُونَ إنْ قَحَطَ القطر ... وهَبَّتْ بشَمْألٍ وضريب «1»
ورجل قَحْطِيٌّ: أكْولٌ لا يُبقي على شَيءٍ من الطعام من كلام أهل العراق دون أهل البادية، أي كأنَّه نَجَا من القَحْط. قَحْطان: ابن هُودٍ، ويقال: ابن أرفَخشذ بنِ سامِ بن نوُحٍ.
باب الحاء والقاف والدال معهما ق ح د، ح ق د، ق د ح، ح د ق، د ح ق، مستعملات
قحد: القَحَدة: «2» ما بينَ المأْنَتَيْن من شَحْم السَّنام. ناقةٌ مِقحاد: ضَخْمةُ القَحَدة، قال:
المُطْعِمُ القَوْمِ الخِفافِ الأَزوادْ ... من كُلِّ كَوماءَ شَطُوطٍ مقحاد «3»
__________
(1) ديوانه/ 333، وفيه (إذ) في مكان (إن) .
(2) كذا في كتب اللغة عامة، وفي الأصول المخطوطة: القحد
(3) مما نقله الأزهري في التهذيب عن الليث، وذكره صاحب اللسان (قحد) .
(3/39)
________________________________________
حقد: الحِقْدُ: الاسمُ، والحَقْدُ: الفِعلُ، حَقَدَ يَحقِدُ حَقْداً، وهو إمساكُ العَداوة في القلب والتَرَبُّصُ بفُرصتها.
قدح: القداح: متخذ الأقداح، وصنَعْتُه القِداحة. والقدّاح: أرْادٌ رَخْصةٌ من الفِسْفِسة، والواحدة قَدّاحة. وأراد بالأَرآد جمعَ رُؤد وهو نَعْمةُ الشَّباب وغَضارتُه وأوَّليَّتُه ورَوْنَقُه. والمِقْدَح: الحديدة التي يُقْدَحُ بها. والقدّاح: الحَجَر الذي تُورَى منه النار، قال رؤبة:
والمَرْوَ ذا القَدّاحِ مَضبُوَح الفِلَقْ «1»
والقَدْحُ: فِعلُ القادِحِ بالزَّنْد وبالقدّاح ليُوري. والقَدْح: أُكّالٌ يَقَع في الشَّجَر وفي الأسنان. والقادِحةُ: الدُودة التي تأكُلُ الشَجَرَة والسِنَّ، قال اَلطِرِمّاح:
بَريٌء من العَيْبِ والقادِحهْ «2»
وقال جميل:
رَمَى اللهُ في عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بالقَذَى ... وفي الغُرِّ من أنيابِها بالقَوادِحِ «3»
القِدْحة: اسم مشتق من الاقتداح بالزَّنْد.
وفي الحديث: لو شاءَ اللهُ لجَعَلَ للنّاس قِدْحة ظُلْمةٍ كما جَعَلَ لهم قِدْحَة نورٍ «4» .
والإنسانُ يقتَدِحُ الأمرَ إذا نَظَرَ فيه ودَبَّر، قال عمرو بن العاص:
يا قاتَلَ اللهُ وَرْداناً وقِدحتَه ... أبدى لعمرُكَ ما في النفس» وردان
__________
(1) والرجز في ديوان رؤبة ص 106
(2) ديوانه/ 83 إلا أن الرواية فيه
قليل المثالب والقادحه
(3) ديوانه/ 53.
(4) الحديث في التهذيب 4/ 31.
(5) كذا في اللسان، وفي ص وط: الناس وفي س: الأمر.
(3/40)
________________________________________
والقَديحُ: ما يَبْقَى في أسفل القِدْر فيُعْرَف بجَهْد، قال النابغة:
يَظَلُّ «1» الإِماءُ يَبْتَدِرْنَ قَديحَها ... كما ابتدَرَتْ كلبٌ مياهَ قراقِر
والمِقْدَحة: المِغرفة. والقِدْح: السَّهْمُ قبل أن يُراش ويُنصَل، وجمعُه قِداح.
حدق: حَدَقَةُ العَيْن في الظاهر هي سواد العَيْن، وفي الباطن خَرَزَتُها، وتَجْمَع [على] حَدَق وحِداق أيضاً، قال أبو ذؤيب:
فالعين بعدهم كأن حداقها سملت ... بشوك فهي عور تدْمَعُ
والحديقةُ: أرضٌ ذاتُ شَجَر مُثْمِر، والجميع: الحَدائق. والحديقة من الرياض: ما أَحدَقَ بها حاجِزٌ أو أرضٌ مُرتفعة، قال عنترة:
فَتَرْكنَ كلَّ حَديقةٍ كالدِرْهَم «2»
يعني في بَياضه واستدارته. والتَحديقُ: شدَّة النَظَر. وكُلُّ شيء استدار شيء فقد أَحدَقَ به.
دحق: الدَّحْقُ: أن تقصُرَ يَدُ الرجُل وتناولُه عن الشَّيء، تقول: أدحَقَه الله: أي باعَدَه عن كلِّ خيَر. ورجل دَحيق مُدْحَق: مُنَحًّى عن الناس والخير، قال يصف العَيْرَ المغلُوب:
والدحيقَ العاملا «3»
__________
(1) ديوانه/ 173.
(2) وصدر البيت:
جادت عليها كل بكر حرة.
(3) كذا في الأصول المخطوطة، ولم نجد البيت على صورته في المظان التي رجعت إليها.
(3/41)
________________________________________
يَعني الذي قد أُخرجَ عن الحمير. وتقول: [دَحَقَتِ الرَّحِمُ: إذا] «1» رَمَتْ بالماء ولم تقبَلْه، قال النابغة:
لم يُحرمَوا حُسنَ الغذاء وأُمُّهُمْ ... دَحَقَتْ عليك بناتقٍ مِذكارِ
يَعني بامرأةٍ بناتق مِذكارٍ. وقولُه: دَحَقَتْ عليك: فَضَلَتْ عليك بأولادٍ، أي على الذي يُفاخره «2» .
باب الحاء والقاف والذال معهما ح ذ ق مستعمل فقط
حذق: الحِذْقُ والحَذاقةُ: مَهارةٌ في كُلِّ شيءٍ. والحِذَقْ مصدر حَذَقَ وحَذِقَ معاً في عمله فهو حاذق. وحذَقَ القرآنَ حِذقاً وحَذاقاً، والاسم الحَذاقة. وحَذْقُك الشيءَ: مَدُّكَه، تقطَعُه بمِنْجَل ونحوه حتَّى لا يبقى منه شيء. وانْحَذَقَ الشيْءُ: انقَطَعَ، قال:
يكادُ منه نِياطُ القَلْب يَنْحَذِقُ «3»
باب الحاء والقاف والراء معهما ر ق ح، ح ق ر، ق ح ر، ق ر ح، حرق مستعملات
رقح: الرَّقاحيُّ: التاجرُ. وإنَّه ليُرقِّحُ معيشته: أي يصلحها.
__________
(1) سقط من الأصول المخطوطة وأثبتناه من التهذيب 4/ 34 عن العين.
(2) كذا في ص وس، وفي ط: أفاخره
(3) التهذيب 4/ 35، واللسان (حذق) غير منسوب فيهما وغير تام أيضا.
(3/42)
________________________________________
حقر: الحَقْرُ في كلّ المعاني: الذِلَّةُ. حَقَرَ يَحْقِرُ حقرا وحقرية. وتَحقيرُ الكلمةِ: تَصغيرُها.
قحر: القَحْر: المُسِنُّ وفيه بقيَّةٌ وجَلَد.
قرح: القَرُحْ: في عَضِّ السِلاح ونحوه مما يَجْرَحُ من الجَسَد. إنه لَقِرحٌ قَريح، وبه قَرْحَةٌ داميةٌ. وقَرِحَ قَلْبُه من الحزن. والقَرْح: جَرَبٌ يأخُذُ الفُصِلانَ لا تكادُ تنجو منه، يقالُ: فَصيل مَقرُوح. والناقةُ تَقْرَح قُروحاً: إذا لم يظُنُّوها حاملاً ولم تُبَشِّره بذَنَبها فيَستَبينُ الحَمْل في بَطْنها. واقَتَرحْتُ الجَمَلَ: رَكِبْتُه قبل أنْ يُرْكَبَ. واقترَحْتُ الشَيء: ابتَدَعْتُه. ويقال للصُبح أقَرْح لأنَّه بياض في سَواد، قال ذو الرمة:
وَسُوجٌ إذا اللَّيْلُ الخُداريُّ شَقَّهُ ... عن الرَكْب مَعرُوفُ السَّماوةِ أقرَحُ «1»
يَعني الصُبْحَ. والقرحَةُ: الغُرَّةُ في وسط الجَبْهةِ، والنَّعْتُ أَقرَح وقَرْحاء. ورَوْضةٌ قَرْحاءُ: في وَسَطها نَوْرٌ أبيض، قال ذو الرمة:
حواء قرحاء أشراطية وكفت ... فيها الذهاب وحفَّتْها البَراعيمُ «2»
وقَرَحَ الفَرَس قُروحاً، وقَرَحَ نابُه فهو قارحٌ، والأُنْثَى قارحٌ أيضاً. والقارحُ: السُِّن التي بها صارَ قارحاً. ويقالُ للرجل والمرأة: قُرحان إذا لم يُصْبهما الجُدَريُّ ونحوه، والجميع قُرْحانُون. والقُرحان: ضرْبٌ من الكَمْأة
__________
(1) ديوانه 2/ 1219.
(2) ديوانه 1/ 399.
(3/43)
________________________________________
بيض صغار ذات رءوس، كرءوس الفُطْر، الواحدة بالهاء. وجمع القارح من الفَرَس قُرَّح وقُرْح وقَوارِح، قال: «1»
نحنُ سَبَقْنا الحَلَباتِ الأربَعا ... الرُبعُ والقرح في شوط معا
والقَراح: الماءُ الذي لا يخالِطُه ثُفْل من سَويق وغيره. والقَراح من الأرض: كلُّ قِطعةٍ على حِيالها من مَنابِت [النَّخْلِ] «2» وغير ذلك. والقِرْواح: الأرض المستوية، قال عبيد:
فَمَنْ بعَقْوتِه كَمنْ بنَجْوَتِه «3» ... والمُستَكِنُّ كَمَنْ يَمْشي بِقرْواحِ
حرق: حَريقُ النّابِ: صَريفُه إذا حَرَق أَحَدَهُما بالآخَر. والرجل يَحرِقُ نابَه، قال زهير:
أبى الضَيْم والنُعْمان يَحرقُ نابَه ... عليه وأفضَى والسُيُوفُ مَعاقِلُهُ
أفْضَى: أي صار في فَضاء ولم يَتَحَرَّزْ بشيءٍ. وأَحْرَقَني فُلانٌ: إذا بَرَّحَ بي وآذاني: قال: «4»
أَحْرقَني الناسُ بتكليفهم ... ما لَقِيَ الناسُ من الناسِ
وأحرَقَت النّارُ الشيءَ فاحتَرَق. وحَرَقُ الثَوبِ: ما يُصيبه من دق القصار. والحرقات: سُفُنٌ فيها مرامي نيران يُْرَمي بها العَدُوُّ في البَحْر بالبَصْرة، وهي أيضاً بلغتهم: [مواضع] القلاّئين والفَحّامين «5» .
__________
(1) لم نهتد إلى الراجز،
(2) من التهذيب 4/ 42 عن العين من الأصول المخطوطة: الأرض.
(3) اللسان (قرح) : والرواية فيه:
فمن بنجوته كمن بعقوته ...
أما ديوانه (دار المعارف) 25 وتحقيق (نصار) ص 41 فروايته:
أوصرت ذا بومة في رأس رابية ... أو في قرار من الأرضين قرواح
(4) لم نتبين القائل في المصادر بين أيدينا.
(5) سقطت كلمة مواضع من الأصول وأثبتناها من التهذيب مما نقله من كلام الليث.
(3/44)
________________________________________
والحَرُّوق والحُرّاق: ما يُورَى به النار. والمُحارَقةُ: المُباضَعة على الجَنْب. والحُرقة: حَيٌّ من اليَمَن. والحُرَيْقاء: من الأسماء. والحارقةُ: عَصَبةٌ بين وابلةِ الفَخِذ التي تَدُور في صَدَفة الوَرِك والكتَفِ، فإذا انَفْصَلتْ لم تَلْتَئِم أبداً. ويقالُ: إنّما هي عَصَبة بين خُرْبة الوَرِك ورأس الفَخِذ يقالُ عند انفصالها: حُرِقَ الرجُلُ فهو مَحروُق. والحُرْقة: ما يُوجَدُ من رَمَدِ عَيْنٍ أو وَجَع قلبٍ أو طَعْم شيءٍ مُحْرق. والحارقةُ من السبع: اسم له. والحرقة: احترِاقٌ يقَعُ في أصُول الشَّعْر فيَنْحَصُّ. والحُرقتان تَيْم وسَعْدٌ وهما رَهْط الأعشى، قال الأعشى:
عَجِبْتُ لآلِ الحُرقَتْين كأنَّما ... رَأَوْني نَفّياً من إيادٍ وتُرخُمِ «1»
رحق: الرَّحيقُ: من أسماء الخَمْر، قال حسان:
يسقون من وَرَدَ البَريصَ عليهِمُ ... كأساً تُصَفّقُ بالرَّحيقِ السَّلْسَلِ «2»
باب الحاء والقاف واللام معهما ح ق ل، ق ل ح، ق ح ل، ل ق ح، ل ح ق، ح ل ق مستعملات
حقل: الحَقْلُ: الزَّرْعُ إذا تَشَعَّبَ ورَقَهُ قبلَ أنْ يَغلُظَ. وأَحْقَلَتِ الأرضُ إحقالاً. والحَقيلةُ: ماءُ الرُّطْب في الأمعاء، ورُبَّما صَيَّرَه الشاعر حَقْلاً، قال: «3»
إذا الفُرُوضُ اضطمت الحقائلا
__________
(1) البيت في اللسان والديوان ص 123.
(2) ورواية البيت في اللسان (برص) والديوان (صادر) 180:
............... .......... ... بردى يصفق بالرحيق السلسل
(3) القائل (رؤبة) والرجز في الديوان ص 124 وفي التهذيب 4/ 48، وفي الأصول المخطوطة: (الفروض) بإلغاء، وهو تصحيف.
(3/45)
________________________________________
والحِقْلَةُ «1» حُسافة التَّمْر، وهو ما بَقي من نُفاياته. وحَقيل: اسم جَبَلٍِ بالبادية. والحَوْقَل: الشَّيْخ إذا فَتَرَ عن الجِماع، قال:
أصْبَحْتُ قد حَوْقَلْتُ أو دَنَوتُ ... وفي حَواقيلِ الرجالِ الموت «2»
والحَوْقَلةُ: الغُرْمُولُ اللَّيِّن، وهي الدَّوْقَلَة أيضاً. والمُحاقَلُة: بَيْعُ الزرع قبل بدو صلاحه. قال غيره: هو أن يدفع الأرض بالثُلُث والرُبُع أو أقَّلَّ أو أكثر.
قحل: القاحِلُ: اليابِسُ من الجُلود ونحوه. وشَيْخٌ قاحل. قَحَلَ يَقْحَلُ قُحُولاً، قال (رُجُلٌ من أصحاب الجمل) :
ردوا علينا شيخنا ثم بَجَلْ ... عُثْمانَ رُدّوه بأطراف الأَسَلْ
(فأجابه رجل من أصحاب عليٍّ) :
كيفَ نَرُدُّ نَعْثَلاً وقد قَحَلْ «3»
أي ماتَ وذَهَبَ.
قلح: القلح: صُفرةُ الأسنان. رجُلٌ أقْلَحُ وامرأةٌ قَلْحاءُ قَلِحةٌ. ويُسَمَّى الجُعَلُ أقلَحَ لأنَّه لا يُرَى أبداً إلا مُتَلَطِّخاً بعذرة «4» .
__________
(1) وفي اللسان والقاموس: الحقيلة حشافة التمر وما بقي من نفاياته.
(2) (رؤبة) ديوانه (أبيات مفردات) ص 170. والرواية فيه:
وو بعض حيقال الرجال الموت
(3) الرجز في اللسان مع خلاف يسير.
(4) من (س) . في (ص وط) : بقذرة.
(3/46)
________________________________________
لقح: اللِّقاحُ: اسم ماءِ الفَحْل. واللقَّاحُ: مصدر لقِحَتِ الناقةُ تَلْقَحُ لَقاحاً، وذلك إذا استبانَ لَقاحُها يَعني حَمْلَها، فهي لاقح، قال أبو النجم:
وقد أَجَنَّتْ عَلَقاً مَلْقُوحاً ... ضَمَّنَه الأَرحامَ والكُشُوحا
يَعني لَقِحَتْه من الفَحْل أي أخَذَتْه. وأولادُ المَلاقيحِ والمَضامينِ نُهِيَ عن بَيْعها، كانوا يَتَبايعون ما في بطون الأمهات وأصلاب الآباء، فالمَلاقيحُ هُنَّ الأُمَّهات والمَضامينُ هُمُ الآباء، الواحدُ مَلْقُوحٌ ومَضْمُون. واللِّقْحَةُ: الناقةُ الحَلْوب، فإذا جُعِلَ نَعْتاً قيلّ: ناقةٌ لَقُوح، ولا يقال: ناقةٌ لِقْحةٌ. و [يقال] هذه لِقْحةٌ بني فلان. واللِّقاحُ: جمع اللِّقْحة. واللُّقُحُ: جَماعةُ اللِّقُوح. وإذا نُتِجَتِ الإبِلِ فبعضُها وَضَعَ وبعضها لم يَضَع فهي عِشارٌ، فإذا وَضَعْنَ كُلُّهُنَّ فَهُنَّ لِقاح، فإذا أُرسِلَ فيهِنَّ الفَحْلُ بعد ذلك فهُنَّ الشَّوْلُ. واللَّقاحُ: ما تُلْقَحُ به النَّخلة من النَّخلة الفُحّالة. ألقَحُوا نَخْلَهم الِقاحاً ولقَّحوها تَلقيحاً في المبالغة. واستَلْقَحَتِ النخلةُ أَنَى لها أن تُلْقَح. وحيٌّ لَقاحٌ «1» : لم يُملَكوا قطٌّ. والَّواقِح من الرياح: التي تحمل النَّدَى ثمَّ تمُجُّه في السَّحاب وفي كُلِّ شيء، فإذا اجتَمَعَ في السَّحاب صارَ مَطَراً. والمَلْقَح كاللِّقاح وهما مصدَران، قال:
يشهَدُ مِنّا مَلْقَحاً ومَنْتَحا «2»
وحَرْبٌ لاقِح تشبيهاً لها بالأُنْثَى الحامل، قال: «3»
إذا شمَّرَتْ بالناسِ شَهباءُ لاقِحٌ ... عَوانٌ شديدٌ هَمْزُها وأظَلَّتِ
أي دَنَتْ، وهَمْزُها: عَضُّها ومَكرُوهُها.
__________
(1) زاد في اللسان: لم يدينوا للملوك.
(2) الرجز في اللسان (لقح)
(3) هو (الأعشى) . ديوانه 259 وفيه:
(وقد) في مكان (إذا) و (شمطاء) في مكان (شهباء ... و (فأضلت) بالضاد، في مكان (وأظلت) بالظاء.
(3/47)
________________________________________
لحق: اللَّحَقُ: كُلُّ شيءٍ لَحِقَ شيئاً أو أَلْحقْتُه به، من النَبات ومن حَمْل النَخل، وذلك أن يُرطِب ويتمر «1» ثم يخرُجُ في بَعضِه «2» شيءٌ أخضَرُ قَلَّ ما يَرْطُبُ حتى يُدركَه الشتاء، ويكون نحو ذلك في الكَرْمُ يُسَمَّى لَحَقاً. واللَّحَقُ من الناس: قَومٌ يلحقون بقَومْ بعدَ مُضيِهِّم، قال:
ولَحَقٍ يَلْحَق من أَعرابها «3»
واللَّحَقُ: الدَّعِيُّ المُوَصَّل بغير أبيه. وناقةٌ مِلْحاقٌ: لا تكاد الإِبِلُ تَفْوتُها «4» في السَّيْر، قال رؤبة:
فهي ضَروحُ الرَّكْضِ مِلحاقُ اللَّحَقْ «5»
ولاحِقٌ: اسمُ فَرَس «6» . وقوله: إن عذابك بالكُفّار مُلْحِقٌ بالكسر. ويقال: إنه من القرآن لم يجدوا عليها إلا شاهداً واحداً فوُضِعَتْ في القُنُوت. وهذه لغة موافقة لقوله تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ «7»
حلق: الحَلْقُ: مَساغُ الطَّعام والشَراب. ومَخرَجُ النَفَس من الحُلْقُوم. ومَوضع المَذْبَح مِن الحَلْق أيضاً، ويُجْمَع على حُلْوق. وحَلَقَ فُلانٌ فُلاناً: ضَرَبَه فأصابَ حلَقْهَ. والحَلْقُ: نَباتٌ لوَرَقِه حُمُوضةٌ يُخلَط بالوَسْمَةِ للخِضاب، الواحدة بالهاء. والحَلْقَةُ من القوم وتُجمَع على حَلَق. ومنهم مَن يثقِّل فيقول حَلَقة لا
__________
(1) كذا في ص، وفي ط وس والتهذيب: تثمر. وفي اللسان: تتمر بالتضعيف.
(2) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب، وفي اللسان: بطنه.
(3) الرجز في اللسان وبعده:
تحت لِواء المَوْتِ أو عقابها.
(4) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: تفوقها.
(5) الديوان ص 107
(6) زاد في اللسان: لمعاوية بن أبي سفيان.
(7) سورة الإسراء 1 واللسان.
(3/48)
________________________________________
يبالي. والحلق: الخاتم من فِضَّةِ بلا فَصّ، قال المخبل في رجل أعطاه النعمان خاتَمَه:
وناوَلَ منا الحِلْقَ أبَيضَ ماجداً «1» ... رَديفَ مُلُوكٍ ما تُغِبُّ نوافله
أي لا يبطىء ولا يجيء غِبّاً. والحالِقُ: الجَبَلُ المُنيفُ المُشرف، قال:»
فخَرَّ من وجأته ميتا ... كأنما دهده من حالِقِ
والحالِقُ من الكَرْم والشَّرْي ونحوهِما ما التَوىَ منه وتَعَلَّقَ بالقُضبان، لم يَعرفوه. والمَحالق: من تعريش الكرم. وحلق الضرع ُيَحلُقُ حُلُوقاً فهو حالق: [يريد: ارتفاعه إلى البَطْنِ وانضمامَه] . وفي قول آخر: كَثْرة لَبَنه. وتَحَلَّقَ القَمَرُ: صارت حوله دوارة «3» . والمحلق: موضع حَلْق الرأس بِمنىً، قال:
كَلاّ وربِّ البيتِ والمُحَلَّق «4» .
وحَلَّقَ الطائر تحليقاً: إذا ارتَفَعَ. والحالق: المشْئُوم يَحلِقُ أهله ويقشُرهم. وفي شَتْم المرأة: حَلْقَى عَقْرَى، يريد مشئومة مؤذية. والمُحَلِّق: اسم رجل ذكره الأعشى:
وباتَ على النارِ النَّدَى والمحلق «5»
__________
(1) رواية الصدر في التهذيب واللسان
وأعطي منا الحلق أبيض ماجد
(2) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(3) كذا في الأصول المخطوطة، والذي في التهذيب عن العين 4/ 64 واللسان (دور) : دارة.
(4) التهذيب 4/ 59، واللسان (حلق) غير منسوب أيضا.
(5) وصدر البيت كما في الديوان واللسان:
تشب لمقرورين يصطليانها
(3/49)
________________________________________
باب الحاء والقاف والنون معهما ح ق ن، ن ق ح، ق ن ح، ح ن ق مستعملات
حقن: الحَقين: اللَّبَنُ المَحقُونُ في مِحْقَنٍ. وفي مَثَل: أَبَى الحَقينُ العِذْرة. وأصلُه أنّ أعرابياً أَتَى حَيّاً فسألهم اللَّبَن، فقيل له: ما عندَنا لَبَنٌ، فالتفت إلى سِقاء فيه لبن فقال: يأبَى الحَقينُ العِذْرة، أي يأبَى الحقين أنْ أقبَلَ عُذْرَكم. وحَقَنْتُه: جَمَعْتُه في سِقاء ونحوِه. وحَقَنْتُ دَمَه: إذا انْقَذْتُه من قَتْلٍ أحلَّ به. واحتَقَنَ الدَمُ في جَوْفه: إذا اجتَمَعَ من طعنةٍ جائفة. والحُقنةُ: اسمُ دواءٍ يُحْقَنُ به المريضُ المُحتَقِن. وبَعيرٌ مِحقانٌ يحقُنِ البَوْل، فإذا بالَ أكثَرَ. والحاقِنتان: نُقْرَتا التَرْقُوَتَيْن، والجميع: الحَواقِن
. نقح: النَّقْح: تَشذيبكَ عن العَصَا أُبَنَها. وكلُّ شيءٍ نَحَّيْتَه عن شَيء فقد نَقَحْتَه من أذىً. والمُنَقِّحُ للكلام: الذي يُفَتِّشُه ويُحسِنُ النَظَر فيه، [وقد] نقحت الكلام.
قنح: القَنْح: اتَّخاذُك قُنّاحة تشُدُّ بها عِضادةَ الباب ونحوه، تُسَمِّيه الفُرْس قانه. قال غير الخليل: لا أعرفُ القَنْح إلا في الشُرْب، وهو شُربٌ في أَفاويقَ، ويُرْوَى في الحديث.
وأَشْرَبُ فأَتَقَنَّحُ «1»
وأَتَقَمَّحُ، يُرْوَيان جميعاً.
__________
(1) في (ط) : وانقخ، وهو تصحيف. وجاء في التهذيب 4/ 66 بعد ذكر الحديث: قال ابن جبلة: قال شمر: سمعت أبا عبيد يسأل أبا عبد الله الطوال النحوي عن معنى قوله فأتقنح، فقال أبو عبد الله: أظنها تريد أشرب قليلا. قال شمر: فقلت: ليس التفسير هكذا، ولكن التقنح أن يشرب فوق الري، وهو حرف روي عن أبي زيد، فأعجب ذلك أبا عبيد، قلت: وهو كما قال شمر: وهوالتقنح والترنح.
(3/50)
________________________________________
حنق: الحَنَق: شِدُّةُ الاغتِياظ، حَنِقَ حَنَقاً فهو حَنِق. والاِحناق: لُزُوقُ البَطْنِ بالصُلْب، قال: «1»
فأحنَقَ صُلْبُها وسَنامُها
باب الحاء والقاف والفاء معهما ح ق ف، ق ح ف، ف ق ح مستعملات
حقف: الحِقْفُ: الرَّمْل ويُجْمَع [على] أحقاف وحُقُوف. واحقَوْقَفَ. واحقَوْقَفَ الرَّمْلُ، واحقَوْقَفَ ظَهْرُ البَعير: أي طالَ واعوَجَّ، قال العجاج:
سَماوةَ الهلال حتّى احقَوْقَفا «2»
والأحقافُ في القرآن يقال: جَبَل مُحيطٌ بالدنيا من زبرجدة خَضراء يَلْتَهِبُ يومَ القيامة فيُحشَرُ الناسُ من كُلِّ أفق.
قحف: القِحْفُ: العَظْم فوقَ الدِماغ من الجُمْجُمة، والجميع: القِحْفة والأَقحاف. والقَحْفُ: قَطْعُه وكَسْرُه فهو مَقْحُوف أي مَقْطُوع القِحْف، قال:
يَدَعْنَ هامَ الجُمْجُمِ المَقْحُوفِ ... صُمِّ الصَدَى كالحَنْظَل المَنْقُوفِ «3»
__________
(1) هو الشاعر (لبيد) ، وتمام البيت:
بطليح أسفار تركن بقية ... منها فأحنق صلبها وسنامها.
(2) والرجز في الديوان ص 496 واللسان (حقف) وقبله:
طي الليالي زلفا فزلفا.
(3) التهذيب 4/ 69 في روايته عن العين، واللسان (قحف) .
(3/51)
________________________________________
والقَحْفُ: شدَّةُ الشُرب، وقيل لامرىء القيس: قتل أبوك، وهو على الشَّراب، فقال: اليومَ قِحاف وغداً نِقاف، ومثلْه اليَومَ خَمْرٌ وغداً أمْرٌ. وقُحِف الإنِاءُ: شُرِبَ ما فيه. ومَطَرٌ قاحِف مثل قاعِف: إذا جاءَ مُفاجَأةً فأَقحَفَ كُلَّ شيءٍ. ويقال: سَيْلٌ قُحاف وجُحَاف وقُعاف [بمعنى واحد] «1» .
فقح: فَقَح الجُرْوُ: أي أَبصَرَ وفَتَح عَيْنَيه. والفُقّاح: من العِطْر، وقد يُجعَل في الدواء فيقال: فُقّاح الاذِخْرِ، الواحدة بالهاء وهو من الحَشيش. والفَقْحةُ: الراحة بلغة اليَمَن. والفَقْحة: معروفة وهي الدُبُر بجُمعِها. والتفقح: التفتح بالكلام.
باب الحاء والقاف والباء معهما ج ب ق، ح ق ب، ق ب ح، ق ح ب مستعملات
حبق: الحَبَق: دَواء من أدوية الصَيْدلانيِّ. والحَبْق: ضُراط المِعَز، حبقت تَحبِقُ حَبْقاً.
حقب: الحَقَبُ: حَبْل يُشَدُّ به الرَّحْل إلى بطْن البعير كي لا يَجْتَذبَه التَصدير: وحَقِبَ البعيرُ حَقَباً فهو حَقِب أي تَعَسَّرَ عليه البَوْل. والأحقَب: حِمارُ الوَحْش لبَياض حَقْوَيه، ويقال: بل سُمِّيَ لدِقَّة حَقْوَيه، والأُنثى حَقْباء، قال رؤبة:
كأنَّها حَقْباءُ بلقاء الزلق «2»
__________
(1) من التهذيب 4/ 70 للتوضيح.
(2) اللسان (حقب) ، والديوان ص 104
(3/52)
________________________________________
الزَّلَقُ: العَجُزُ وقارةٌ حَقْباءُ: دقيقةٌ مُستطيلةٌ، قال: «1»
تَرَى القارةَ الحَقْباءَ منها كأنَّها ... كُمَيْتٌ يُبارِي رَعْلةَ الخَيل فارِدُ.
ويقال: لا يقالُ ذلك حتّى يَلْتَويَ السَراب بحَقْوَيْها. والحِقابُ: شيءٌ تَتَّخذُه المرأةُ تُعلِّق به مَعاليق الحُلِيِّ تَشُدُّه على وَسَطها، ويجمع [على] حُقُب. واحتَقَبَ واستَحْقَبَ: أي شَدَّ الحقيبة من خلفه، وكذلك ما حمل من شيء من خلفه، قال النابغة:
حَلَق الماذيِّ خَلْفَهُمُ ... شُمُّ العَرانينِ ضَرّابُونَ للهامِ «2»
وقال: «3»
فاليومَ فاشرَبْ غيرَ مُستَحقِبٍ ... إثماً من اللهِ ولا واغِلِ
والمُحقِبُ كالمُردِف. والحِقْبة: زمان من الدهر لا وقتَ له. والحُقُبْ: ثَمانونَ سنةً والجميعُ: أحقاب
قحب: القُحابُ: سُعال الشَّيخ والَكلْب. قَحَبَ يَقْحُبُ قُحاباً وقَحْباً. وأخَذَه سُعالٌ قاحِب. والقَحْبَةُ: «4» المرأة بلغة اليمن.
قبح: القُبْح والقَباحة: نَقيضُ الحُسْن، عامٌّ في كلِّ شيء. وقَبَحه الله: نَحّاه عن كلّ خير وقوله تعالى: هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
«5» أي المُنَحَّيْن عن كل خير.
__________
(1) هو (امرؤ القيس) . انظر الديوان ص 458 واللسان (حقب) . وجاء في اللسان: أن البيت منحول وفي الديوان واللسان والتهذيب:
ترى القنة الحقباء.
(2) الرواية في التهذيب واللسان:
مستحقبي حلق الماذي يقدمهم.
وفي الديوان/ 221:
مستحقبو حلق الماذي فوقهم
(3) هو (امرؤ القيس) ، والبيت في الديوان واللسان (حقب، وغل) وروايته في اللسان: فاليوم أسقي....
(4) في التهذيب 4/ 74 عن العين: وأهل اليمن يسمون المرأة المسنة: قحبة.
(5) سورة القصص 42
(3/53)
________________________________________
قال زائدة: المقْبُوحُ الممقُوت. والقَبيح: طَرَفُ عَظْم المِرْفَق ويُجْمَع: قبائح، قال: «1»
حَيثُ تحُكّ الإبرةُ القَبيحا «2»
باب الحاء والقاف والميم معهما ق ح م، ق م ح، ح م ق، م ح ق مستعملات
قحم: قَحَمَ الرجُلُ يَقْحَم قُحوماً في الشِعْر، ويقال في الكلام العام: اقتَحَمَ وهو رَمْيُه بنفسَه في نَهْر أو وَهْدةٍ أو في أمْرٍ من غير رَوِيّة «3» . ويقال: قَحَمَ قُحُوماً: إذا كَبِرَ. قال زائدة: قَحَمَ وأقحَمَ تجاوَزَ، واقتَحَم هو. والقَحْم: الشّيْخ الخَرِف، والقَحْمةُ: الشَّيْخةُ، قال الراجز:
إنّي وإنْ قالوا كبير قَحْمُ ... عندي حُداءٌ «4» زَجَلٌ ونَهْمُ
والقُحْمةُ: الأمْرُ العظيم. لا يَركَبُها كل أحَد، والجمعُ: قُحَم. وقُحَم الطريق: ما صَعُبَ، قال:
يَرَكَبْنَ من فَلْجٍ طريقاً ذا قُحَمْ «5»
وبعيرٌ مِقحام: يقتَحِم الشَّوْلَ من غير إِرسالٍ فيها. والمُقْحَمُ: البعير الذي
__________
(1) هو (أبو النجم) الراجز. اللسان (قبح) .
(2) في التهذيب:
حيث تلاقي الإبرةُ القَبيحا.
(3) في التهذيب 4/ 77 نقلا عن الليث: من غير دربة.
(4) كذا في ط، وفي س: حمار
(5) لم نهتد إلى الرجز ومصدره وقائله.
(3/54)
________________________________________
يُربع ويُثنى في سنة واحدة فَتقتَحِمُ سِنُّ. وبعير مُقْحَم: يُقْحَم في مَفازة من غير مُسيمٍ ولا سائقٍ، قال ذو الرمة:
أو مُقحَمٌ أَضعَفَ الإِبطانَ حادِجُه ... بالأَمسِ فاستَأْخَرَ العِدْلانِ والقَتَبُ «1»
شبَّهَ به جَناحَي الظليم. وأعرابيُّ مُقْحَم: أي نَشَأ في المَفازة لم يخرُجْ منها. والتقحيم: رَمْي الفَرَس فارسَه على وجهه.
وفي الحديث: إنّ للخُصومة قُحَماً «2»
أي إنّها تُتَقَحَّمُ على المَهالِك وقُحْمُة الأَعراب: سَنَةٌ جَدْبةَ تَتقحَّم عليهم، أو تَقَحُّمُ الأعراب بلاد الريف.
قمح: القَمْحُ: البُرُّ. وأَقْمَحَ البُرُّ: جَرَى الدقيقُ في السُّنْبُل. والاقتِماحُ: ما تَقتَمِحُه من راحتكَ في فيكَ. والاسم: القُمْحة كاللُّقْمة والأكلة. والقميحة: اسم الحوارش. والقمحان: وَرْسٌ، ويقال: زَعْفَران. وقال زائدة: هو الزَّبَدُ وقال النابغة:
إذا فُضَّتْ خَواتُمه علاه ... يَبيسُ القُمَّحانِ من المُدام «3»
والقامِح والمُقامِحُ من الإبِلِ: الذي اشتدَّ عَطَشُه فَفَتَر فُتُوراً شديداً. وبَعير مُقْمَحٌ، وقَمَحَ يَقْمَحُ قُمُوحاً وأقمَحَه العَطَش والذليل مُقمَح: لا يكادُ يرفَعُ بصَره. وقول الله- عز وجل- فَهُمْ مُقْمَحُونَ
«4» أي خاشعون لا يَرفَعُونَ أبصارهم، وقال الشاعر:
ونحن على جوانِبِهِ عُكُوفٌ «5» ... نَغُضُّ الطرف كالإبل القماح
__________
(1) البيت في الديوان 1/ 120
(2) في التهذيب 4/ 77- 78
وفي حديث عليٍّ (رضي الله عنه أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة وقال: إن للخصومةقحما.
(3) البيت في اللسان (قحم) والديوان ص 160
(4) سورة يس 8
(5) في التهذيب: 4/ 81 واللسان (قمح) ، وفيهما: (قعود) في مكان (عكوف) ، والبيت فيهما غير منسوب أيضا.
(3/55)
________________________________________
وفي المثل: الظَمَأُ القامِحُ خَيْرُ من الرِيِّ الفاضِح يُضرَبُ هذا لِما كان أوّله مَنْفَعَة وآخرهُ نَدامة. ويقال: القامِحُ الذي يَردُ الحَوضَ فلا يشرَب. ويقال: رَوِيتُ حتّى انقَمَحْتُ: أي حتى تَرَكْتُ الشَرابَ. وابِلٌِ قِماحُ.
محق: مَحَقَهُ اللهُ فانمَحَقَ وامتَحَقَ: أي ذَهَبَ خيرُه وبَرَكَتُه ونَقَصَ، قال الشاعر:
يَزدادُ حتّى إذا ما تَمَّ أعقَبَه ... كَرُّ الجَديدَيْن نَقْصاً ثمَّ يَنْمَحِقُ «1»
والمُحِاقُ: آخِرُ الشَّهْر إذا انمَحَقَ الهِلالُ فلم يُرَ، قال:
بلالُ يا ابنَ الأَنجُمِ الأَطلاقِ ... لَسْنَ بنَحْساتٍ ولا مِحاقِ «2»
ويُرْوَي: ولا أَمحاقِ.
حمق: استَحْمَقَ الرجلُ: فَعَلَ فِعْلَ الحَمْقَى. وامرأةٌ مُحْمِقٌ: تَلِدُ الحَمْقَى. وفَرَسٌ مُحْمِقٌ: لا يَسْبِقُ نَتاجُها. وحَمَقَ حَماقة وحُمْقاً: صارَ أحمَقَ. والحُماقُ: الجُدَريّ «3» . يقال منه رَجُلٌ مَحمُوقٌ. وانحَمَقَ في معنى استَحْمَقَ، قال:
والشَّيْخُ يَوماً إذا ما خِيفَ يَنْحَمِقُ «4»
__________
(1) التهذيب 4/ 82، واللسان (محق) غير منسوب فيهما أيضا.
(2) (رؤبة) ديوانه/ 116. والرواية فيه: أمحاق
(3) في التهذيب: والحميقاء الجدري الذي يصيب الصبيان. وفي اللسان: الحماق والحميقاء: الجدري.
(4) ورواية الشطر في اللسان:
والشيخ يضرب أحيانا فينحمق.
(3/56)
________________________________________
باب الحاء والكاف والشين مهما ح ش ك، ك ش ح، ش ح ك مستعملات
حشك: الحَشَكُ: تَرْكُكَ النّاقَةَ لا تَحلُبُها حتّى يجتَمع لَبَنُها، وهي مَحْشُوكةٌ. والحَشَك: اسم للدِرّةِ المُجتَمعة، قال:
غَدَتْ وهي مَحشُوكةٌ حافِلٌ ... فراحَ الذِئارُ عليها صَحيحا «1»
كشح: الكشح: من لدن السرة إلى المَتْن ما بَيْنَ الخاصِرة إلى الضِلَع الخَلْف، وهو مَوضِع مَوقِع السَّيْف إلى المُتَقَلِّد. وطَوَى فلانٌ كَشْحَه على أمر: إذا استَمَرَّ عليه وكذلك الذاهب القاطع. والكاشِح: العَدوٌ، قال:
فذَرْني ولكنْ ما تَرَى رَأْيَ كاشحٍ ... يَرَى بيننا من جهلِه دقَّ مَنْشِمِ
ويقال: طَوَى كَشْحَه عَنّي: إذا قَطَعَكَ وعاداكَ. وكاشَحَني فلانٌ بالعَداوة.
شحك: الشَّحْكُ: من الشِّحاك، تقول: شَحَكْتُ الجَدْيَ: وهو عُودٌ يُعَرَّض في فَمِهِ يَمْنَعُه من الرِّضاع.
__________
(1) البيت في التهذيب واللسان (حشك) .
(3/57)
________________________________________
باب الحاء والكاف والضاد معهما ض ح ك مستعمل فقط
ضحك: ضحِكَ يَضَحَكُ ضَحِكاً وضِحْكاً، ولو قال: ضَحَكاً لكان قياساً لأنّ مصدر فَعِلَ فَعَل. والضُحْكَةُ: ما يُضحَكُ منه. والضُّحَكَةُ: الكثير الضَحِك يُعابُ به. والضِّحّاك في النَعْت أحسَنُ من الضُّحَكَةِ. والضَّاحكة: كلُّ سِنٍ من مُقَدَّم الأضراس ما يبدُو عند الضَّحِك. والضَّحّاكُ بن عدنان: الذي يقال مَلَكَ الأرض، ويقال له: المُذْهَب، كانَتْ أمّه جنّيَّةً فلحق بالجنِّ وتلبّد بالفِراء «1» . تقولُ العَجمُ إنّه عَمِل بالسِحْر وأظهَرَ الفساد أُخِذَ فشُدَّ في جَبَل دَنْباوَند. وقوله فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها
«2» يَعني طَمِثَتْ. والضَّحْك: الثَلجْ، ويقال: جَوْف الطَّلْع، وهي من لغة بني الحارث، يقالُ: ضحِكتِ النَّخلة إذا انشَقَّ كافورُها. وقال آخرون: هو الشُهُدُ، ويقالُ: الزُبْد، ويقال: العَسَلُ. وهو بهذَيْن أشبْهُ في قوله: «3»
فجاءَ بمزج لم يَرَ الناسُ مِثلَه ... هو الضَّحْكُ إلا أنّه عملُ النَّخْلِ
والضَحُوك من الطُرُق: ما وَضحَ فاستَبانَ، قال:
على ضَحوكِ النَّقْبِ مجرهد «4»
__________
(1) عبارة (وتلبد بالفراء) من (س) أما (ص وط) فالعبارة فيهما غير واضحة ولا مفهومة. أما في التهذيب 4/ 89 عن العين فالعبارة: (ويتبدى للقراء) . وفي اللسان: وسد القرا. وقد علق الناشر في الحاشية: كذا بالأصل بدون نقط، وأضاف: ولعله محرف عن: وبيداء القرى.
(2) سورة هود 71
(3) هو (أبو ذؤيب الهذلي) كما في التهذيب وديوان الهذليين 1/ 42
(4) (رؤبة) ديوانه/ 49 والرواية فيه:
على ضحوك النقب مصمعد
(3/58)
________________________________________
باب الحاء والكاف والسين معهما ح س ك، ك س ح يستعملان فقط
حسك: الحَسَكُ: نَباتٌ له ثَمَرةٌ خَشِنةٌ تَتَعَلّق بأصواف الغنم، الواحدة حَسَكة. والحَسَكُ: من أَدَوات الحَرْب رُبَّما يُتَّخَذُ من حديدٍ فيُلْقَى حَولَ العَسكر، ورُبَّما اتُّخِذَ من خَشَب فنُصِبَ حولَ العسكر. وحسك الصَّدْر: حِقْدُ العَداوة، تقول: إنه والحسك الصدر عليَّ. والحِسكيكُ «1» : القُنْفُذُ الضَّخْم.
كسح: الكُساحةُ: تُراٌب مجموع. وكَسَحَ بالمِكْسَحة كَسْحاً أي كَنْساً. والمُكاسحُة: المُشّارّةُ الشديدة. والكَسَح: شَلَلٌ «2» في إحدى الرِجْلَيْن إذا مَشى جَرَّها جَرّاً. ورجلٌ كَسْحان. وكَسِحَ يَكسَحَ كَسَحاً فهو أكسَحُ، قال: «3» .
كلّ ما يقطَعُ من داء الكَسَح
قال زائدة: أعرِفُ الكَسَحَ العَجْز، يقال: فلان كَسِحٌ: أيْ عاجز ضعيف. والأكَسَحُ: الأَعَرجُ.
باب الحاء والكاف والدال معهما ك د ح مستعمل فقط
كدح: الكَدْح: عَمَل الإنسان من الخَيْر والشَرِّ. ويكدَحُ لنفسه: أي يسعى.
__________
(1) كذا في (ص، ط) . في (س) : الحسيك، وفي التهذيب واللسان: الحسكك.
(2) في التهذيب من كلام الليث: ثقل.
(3) (الأعشى) ديوانه/ 245 والرواية فيه:
كل ما يحسم من داء الكشح
بالشين المعجمة. وصدر البيت
ولقد أمنح من عاديته.
(3/59)
________________________________________
وقوله تعالى: إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً
«1» أيْ ناصب، وكدحا أي نَصْباً. قال زائدة: إِلى رَبِّكَ في معنى نحو ربّك. والكَدْح: دونَ الكَدْم بالأسنان. والكَدْحُ بالحَجَر والحافِر.
باب الحاء والكاف والتاء معهما ك ت ح، ح ت ك يستعملان فقط
كتح: الكَتْح: دون الكَدْح من الحَصَى والشَّيء يُصيبُ الجلد فيُؤثّر فيه، قال: «2»
يَلْتَحْنَ وجهاً بالحَصَى ملتوحا ... ومرة بحافر مكتوحا
أي تضربه الريح بالحصى، قال:
فأَهْوِنْ بذِئبٍ يَكْتَحُ الريحُ باستِهِ «3»
أيْ تَضْربُه الريحُ بالحَصَى. ومن يروي: تكثَح، أي: تكشِفُ.
حتك: الحَتْك والحَتَكان: شِبْه الرَتَكان في المَشْي إلاّ أنَّ الرَّتك للإبِلِ خاصّة، والحَتْك من المشي للإنسان وغيره. والحوتك: القصير «4»
__________
(1) سورة الانشقاق 6
(2) هو (أبو النجم) الراجز. انظر التهذيب.
(3) الشطر في التهذيب واللسان (كتح) .
(4) وأضاف في التهذيب واللسان: القرب الخطو.
(3/60)
________________________________________
باب الحاء والكاف والثاء معهما ك ث ح يستعمل فقط «1»
كثح: الكَثْح: كشفُ الريحِ الشيءَ عن الشيء. ويَكثَحُ بالتُرابِ وبالحصَىَ: يضرِبُ به.
باب الحاء والكاف والراء معهما ح ر ك، ح ك ر، ر ك ح مستعملات
حرك: حَرَكَ الشيء يحرُكُ حَرْكاً وحركةً وكذلك يَتَحَرُّك. تقول: حَرَكْتُ بالسيف مَحْرَكَه حَرْكاً أي ضَرَبْتُه. والمَحْرَكُ: مُنَتَهى العُنُق وعند مَفصِل الرأس. والحاركُ: أعلى الكاهل، قال: «2»
مُغْبَطُ الحارِكِ مَحبُوكُ «3» الكَفَلْ
والحَراكيكُ: الحَراقِف، واحدها: حَرْكَكَة.
حكر: الحَكْرُ: الظُلم في النقص «4» وسُوء المعاشرة. وفلان يحكِرُ فلاناً: أدخَلَ عليه مَشَقّة ومَضَرَّةً في مُعاشَرته ومُعايَشته. وفلان يَحْكِرُ فلاناً حَكْراً. والنَعْت حكر، قال الشاعر:
__________
(1) في التهذيب: كثح، كحث مستعملان.
(2) هو الشاعر (لبيد) . وصدر البيت:
ساهم الوجه شديد أسره.
الديوان ص 187.
(3) كذا في الديوان واللسان (حرك) والتهذيب، وفي الأصول المخطوطة: محروك.
(4) في التهذيب عن الليث: الظلم والتنقص....
(3/61)
________________________________________
ناعَمَتْها أُمُّ صِدْقٍ بَرَّةٌ ... وأبٌ يُكرِمُها غيرَ حَكِرُ «1»
والحَكْر: ما احتَكرْتَ من طَعام ونحوه ممّا يُؤكَل، ومعناه: الجمع، والفعل: احتَكَر وصاحبه مُحتَكِرٌ ينتظر باحتباسه، الغلاء.
ركح: الرُكْح: رُكن مُنيفٌ من الجَبَل صَعْبٌ، قال:
كأنَّ فاهُ واللِّجامُ شاحي ... شَرْخا «2» غَبيطٍ سَلِسٍ مِركاح
أي كأنَّه رُكْح جَبَل. والرُكْح: ناحيةُ البَيت من وَرائه، وُرَّبما كانَ فَضاءً لا بِناءَ فيه.
باب الحاء والكاف واللام معهما ك ح ل، ل ح ك، ح ل ك، ك ل ح مستعملات
كحل: الكُحْل: ما يُكْتَحَلُ [به] والمِكحال: المِيلُ تُكحَلُ به العَيْنُ من المُكْحُلَة، والكَحَلُ: مصدره. والأكْحَل الذي يَعلُو مَنابِتَ أشفاره سَوادٌ خِلقةً. والأكحَلُ: عِرْق الحياة في اليَد وفي كُلِّ عُضو منه شعبة على حدة. والكحل: شِدَّة المَحْل. والكُحَيل: ضَرْبٌ من القَطِران.
لحك: اللَّحْك: شِدَّة لأَم الشّيء بالشيء، تقول: قد لوحِكَت فَقارُ هذه الناقة، أي دَخَلَ بعضُها في بعض. والمُلاحَكة في البُنيْان ونحوه، قال الأعشى: «3»
__________
(1) رواية التهذيب واللسان: نعمتها (بالتضعيف) .
(2) (العجاج) ديوانه/ 441. وبينهما قوله: يفرع بين الشد والإكماح في التهذيب 4/ 98 واللسان (ركح) : (شرجا غبيط) بالجيم.
(3) ديوانه/ 47.
(3/62)
________________________________________
ودأبا تلاحك مثل الفئوس ... لاحم فيه السليل «1» الفِقارا
حلك: الحَلَكُ: شدَّة السَّواد، حالِكٌ حلكوك، وحَلَكَ يَحلُكُ [حلوكا] «2» . والحَلَك: شِدَّة السَواد كلَون الغُراب، يقال: إنّه لأشدُّ سواداً من حَلَك الغُراب.
كلح: الكُلُوح: بُدُوّ الأسنان عند العُبُوس. وكَلَح كُلُوحاً. وأَكْلَحَه كذا. قال لبيد:
تُكلِحُ الأَرْوَقَ منهم والأَيَلّ «3»
حكل: تقُول: في لِسانِه حُكْلةٌ أي عُجْمة.
باب الحاء والكاف والنون معهما ن ك ح، ح ن ك، مستعملان فقط
نكح: نَكَحَ يَنكِحُ نَكْحاً: وهو البَضْع. ويُجرَى نَكَحَ أيضاً مجرى التزويج. وامرأةٌ ناكِحٌ: أي ذاتُ زوج، ويجوز في الشعر ناكحة بالهاء، قال: «4»
__________
(1) في (ص، ط، س) : الشليل، بالشين.
(2) في الأصول المخطوطة: حلكا.
(3) ديوانه/ 195. وصدر البيت:
رقميات عليها ناهض
(4) هو (الطرماح) ديوانه/ 89.
(3/63)
________________________________________
ومثلك ناحت عليه النساء ... من بين بِكْرٍ إلى ناكِحَهْ
وقال:
أحاطَتْ بخطّابِ الأيامَى وطُلِّقَتْ ... غَداتئِذٍ منهُنَّ من كان ناكحا «1»
وكانَ الرجلُ يأتي الحَيَّ خاطباً فيقوم في ناديهم فيقول: خِطبٌ، أيْ جئتُ خاطباً، فيقال «2» له: نِكحٌ، أي أنْكَحْناك.
حنك: رجلٌ مُحَنَّك: لا يُستقلّ منه شيء مما عضَّه الدهر. والمُحتَنِك: الذي تَمَّ عقًلُه وسنُّه، يُقال: حَنَّكَتْه السِّنُّ حَنْكاً وحَنَكاً. وحنَّكَتْه تحنيكاً: إذا نَبَتَتْ أسنانُه التي تُسَمَّى أسنان العقل، قال العجاج:
محنتك ضخم شئون الراسِ
ويقال: هم أهلُ الحُنْك، ومنهم من يكسر الحاء، ومنهم من يثقّل فيقول: أهل الحُنُك والحُنْكة يَعني أهلَ الشَرَف «3» والتَجارِب. والتَّحنيك: إن تغرِزَ عوداً في الحَنَك الأعلى من الدابَّة أو في طَرَف قَرْنٍ حتى يُدميه لِحَدَث يحدث فيه. واستَحنَكَ الرجلُ: اشتَدَّ أكْلُهُ بعد قِلَّة. وحَنَّكْتُ الصبيَّ بالتّمْر: دَلَكتُه في حَنَكه. والحَنَكانِ: الأعلى والأسفل، فإذا فَصلَوهما لم يَكادوا يقولون للأعلى حَنَك، قال حميد: «4»
__________
(1) التهذيب 4/ 103، واللسان (لكح) ، وفي اللسان: غداة غد.
(2) من (س) وهو الصواب. في (ص، ط) : فيقول:.......
(3) في التهذيب: السن.
(4) التهذيب 4/ 104 عن العين. أما (ص ط، س) فالرجز فيها فالحنك الأسفل منه أفعم والحنك الأعلى طوال مطهم
(3/64)
________________________________________
[فالحَنَكُ الأعلى طُوالٌ سَرطُم] ... والحنك الأسفل منه أفقمُ]
وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم- كانَ يُحنِّك أولادَ الأنصار.
واحتَنَكتُ الرجلَ: أخذتُ مالَه ومنه قوله تعالى: لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا «1» .
باب الحاء والكاف والفاء معهما ك ف ح يستعمل فقط
كفح: المُكافَحة: مُصادَفُة الوجْهِ بالوجْه عن مُفاجأة، قال عدي: «2»
أعاذل من تكتب له النّارُ يَلْقَها ... كِفاحاً َومَنْ يُكتَبْ له الخُلْدُ يَسْعَدِ
وكافَحها: قَبَّلَها عن غَفْلةٍ وِجاهاً. والمُكافحةُ في الحَرْب: المُضاربة تِلقاءَ الوُجُوه.
باب الحاء والكاف والباء معهما ك ح ب، ك ب ح، ح ب ك مستعملات
كحب: الكَحْبُ: [البَرْوَقُ] «3» بلغة اليَمَن، والحبة منه كحبة..
__________
(1) سورة الإسراء 62
(2) هو عدي بن زيد. والبيت في الديوان ص 103 وفيه: (الفوز) في مكان (الخلد) .
(3) التاج (كحب) : الكحب والكحم: الحصرم بالكسر، واحدته: كحبة بهاء، يمانية، وهو البروق. في الأصول المخطوطة: (فورق) وكذلك في مختصر العين (ورقة 61) . وفي التهذيب 4/ 110. (النورة) . وفي اللسان (كحب) : (العورة) .
(3/65)
________________________________________
كبح: الكَبْحُ: كَبْحُكَ الدابَّة باللِّجام، وهو قَرْعُك إيّاها.
حبك: حَبَكتْهُ بالسيف حَبْكاً: وهو ضَربٌ في اللَّحْم دون العَظْم، ويقال: هو مَحْبُوكُ العَجْز والمَتْن إذا كان فيه استِواء مع إرتفاع، قال الأعشى: «1»
على كُلِّ مَحبُوكِ السَّراة كأنَّه ... عُقابٌ هَوَتْ من مَرْقَبٍ وتعلت
أي: ارتفعت. وهوت انخَفْضَتْ.. والحِباكُ: رباطُ الحَضيرة بقَصَبات تُعَرَّضُ ثمَّ تُشَدُّ كما تُحبَكُ عُروشُ الكَرْم بالحِبال. واحَتَبكْتُ إزاري: شَدَدْتُه. والحَبيكة: كلُّ طريقة في الشَّعْر وكُلُّ طريقةٍ في الرَّمْل تَحْبِكهُ الرِياحُ إذا جَرَتْ عليه، ويُرَى نحوَ ذلك في البيضِ من الحديد، قال الشاعر:
والضاربُونَ حَبيكَ البيضِ إذ لَحِقُوا ... لا يَنكُصُونَ إذا ما استُلْحِموا «2» وَحَمُوا
أي اشتَدَّ قتالُهم. والحُبُك: جماعة الحبيك، ويقال: كذلك خِلْقةُ وجْهِ السَّماء. ويقال: ما طَعِمْنا عنده حبكة ولا لَبَكة، ويقال: عَبَكة، فالعَبَكةُ والحَبَكةُ معاً: الحَبَّة من السَّويق، واللَّبَكة: اللُّقمة من الثَريد ونحوِه.
باب الحاء والكاف والميم معهما ح ك م، م ح ك، ح م ك، ك م ح مستعملات
حكم: الحِكمةُ: مَرْجِعُها إلى العَدْل والعِلْم والحِلْم. ويقال: أحْكَمَتْه التَجارِبُ إذا كانَ حكيماً. وأَحْكَمَ فلانٌ عنّي «3» كذا، أي: مَنَعَه، قال:
__________
(1) ديوانه (تحقيق محمد محمد حسين) ص 261.
(2) كذلك في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: استحملوا.
(3) من (س) في (ص ط) : وأحكم عني فلانا شيء كذا.
(3/66)
________________________________________
أَلَمّا يَحْكُمُ الشُعَراءُ عَنّي «1»
واسَتحْكَمَ الأمرُ: وَثُقَ. واحتَكَمَ في ماله: إذا جازَ فيه حُكْمُه. والأسم: الأُحكُومة والحُكوُمة، قال الأعشى:
ولَمَثْلُ الذي جَمَعْتَ لرَيْب ... الدَّهْر يَأبَى حُكومةَ المُقتالِ
أي لا تَنْفُذُ حكومةُ من يحتكِم عليك من الأعداء. والمُقتالُ: المُفتَعِلُ من القَوْلِ حاجةً منه إلى القافية. والتَحكيم: قول الحَروريّة: لا حُكمَ إلاّ للهِ «2» . وحَكَّمنا فُلاناً أمرَنا: أي: يحكُمُ بيننا. وحاكَمناه إلى الله: دَعَوناه إلى حُكم الله. ويقال: نُهِيَ أنْ يُسَمَّى رَجُلٌ حَكَماً. وَحكَمة اللّجام: ما أحاطَ بحَنَكَيْه سُمِّيَ به لأنّها تمنعه من الجَرْي. وكلُّ شيء مَنَعْتَه من الفَساد فقد [حَكَمْتَهُ] وحَكَّمته وأحكَمْتَه، قال: «3»
أبني حَنيفةَ أَحكِمُوا سُفَهاءكُم ... إنّي أخافُ عليكُمُ أن أغْضَبا
وفَرَسٌ محكُومةُ: في رأسها حَكَمَةٌ. قال زائدة: مُحْكَمةُ وأنكَرَ مَحكُومة، قال:
مَحكوُمةٌ حَكمَات القِدِّ والأَبَقَا «4»
وهو القِتْبُ «5» . وسَمَّى الأعشى القصيدة المُحْكَمة حَكيمة في قوله:
وغريبةٍ تأتي المُلُوكَ حكيمةٍ «6» .
__________
(1) لم نهتد إلى البيت وإلى قائله.
(2) وزاد في التهذيب من كلام الليث: ولا حكم إلا الله.
(3) هو (جرير) . (3) هو (جرير) . ديوانه 1/ 466.
(4) الشطر في التهذيب (حكم) ويروى أيضا: قد أحكمته حكمات القد والأبقا
(5) انفرد كتاب العين بذكر هذه الدلالة.
(6) ديوانه/ 27 وعجز البيت فيه:
قد قلتها ليقال من ذا قالها.
(3/67)
________________________________________
محك: المَحْكُ: التَّمادي في اللَّجاجة عند المُساوَمة والغَضَب ونَحْوه. وتماحَكَ البَيِّعان.
حمك: الحَمَكُ: من نَعْت الأدِلاّء، [تقول] : حَمِكَ يَحْمَكُ.
كمح: الكَمْحُ: رَدُّ الفَرَس باللِّجام.
باب الحاء والجيم والشين معهما ش ح ج، ج ح ش مستعملان فقط
شحج: الشَّحيجُ: صَوْتُ البغل وبعض أصوات الحِمار. شَحَجَ يَشْحَجُ شَحيجاً. وشَحَجَ الغُرابُ شَحَجاناً: وهو تَرجيعُ الصَوْت فإذا مَدَّ [قيل] : نَعَب «1» . ويقال للبِغال: بَناتُ شاحِج وشَحّاج. ويقال للحِمار الوحشي «2» ، قال لبيد:
فهو شَحّاجُ مُدِلٌّ سَنِقٌ ... لاحِقُ البَطْن إذا يَعدُو زَمَلْ «3»
جحش: الجَحْشُ: وَلَدُ الحمار، والعَدَدُ: جِحَشة، والجميعُ جِحاشُ. والجَحْشة [يتخذها الرّاعي] كالحلقة من الصّوف يلقيها في يده ليغزلها «4» . والجِحاش: الدِفاع [تُجاحِشُ] «5» : تُدافِعُ عن نفسك. والجَحْشُ: دون الخَدْش. جُحِشَ فهوَ مَجحُوش.
__________
(1) في اللسان: فإذا مد رأسه نعب.
(2) من التهذيب 4/ 119 عن العين. في (ص، ط) : الشّيء، وفي (س) : وانحضج إذا ضرب مشحج وشحاج
(3) البيت في التهذيب 4/ 117 والديوان ص 189.
(4) من التهذيب 4/ 118 عن العين. والعبارة في الأصول مضطربة وفيها تقديم وتأخير.
(5) من اللسان (جحش لتقويم العبارة.
(3/68)
________________________________________
باب الحاء والميم والضاد معهما ح ض ج يستعمل فقط
حضج: الحَضْجُ «1» : الماءُ القليلُ. والحِضْج أيضاً قال: «2»
فأسأَرَتْ في الحوض حِضْجاً حاضجا
وانحَضَجَ الرجلُ «3» : إذا ضَرَبَ بنفسه الأرض غضبا و [يقال ذلك] إذا اتَّسَعَ بطنه، فإذا فَعلْتَ به قُلتَ: حَضَجْتُه أيْ ادخَلْتُ عليه ما يكادُ ينشَقُّ وانحَضَجَ من قِبلَه.
باب الحاء والجيم والسين معهما س ح ج، س ج ح يستعملان فقط
سحج: سَحَجْتُ الشَّعْرَ سَحْجاً: وهو تَسريح ليِّنٌ على فَرْوة الرأس. وسَحَجَ الشيءَ يَسحَجُه: أي يَقشِرُ منه شيئاً قليلاً كما يُصيبُ الحافِرَ من قِبَل الحَفا. والسَّحْجُ أيضاً: «4» جَرْيُ الدَوابِّ دون الشديد. وحِمارٌ مِسْحَج، قال النابغة:
رباعية أضر بها رَباعٌ ... بذاتِ الجِزْع مِسْحاجٌ شَنونُ «5»
والمُسَحَّج: من التَسحيج وهو الكدم.
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب نقلا عن الليث: الحضيج.
(2) في التهذيب 4/ 119 واللسان (حضج) : وأخبرني أبو مهدي قال سمعت هميان بن قحافة ينشده: الرجز......
(3) من التهذيب 4/ 119 عن العين، في (ص، ط) الشّيء، وفي (س) : وانحضج إذا ضرب....
(4) ديوانه/ 216. والرواية فيه:
رباع قد أضر بها رباع
(5) ديوانه/ 216. والرواية فيه:
رباع قد أضر بها رباع
(3/69)
________________________________________
سجح: الإسجاحُ: حُسنُ العَفْو كقولهم: مَلَكْتَ فأَسجحْ. ويقال: مَشَى مَشياً سجيحاً وسُجُحاً، قال الشاعر: «1»
ذَرُوا التَّخاجيَ وامشوا مشية سجحا ... إن الرجالَ ذوو عَصْبٍ وتذكيرِ
ويقال: سَجَحَت [الحمامة] «2» وسَجَعَتْ. ورُبَّما قالوا: مُزْجح في مُسْجح كالأسْد والأزْد. والسَجَحُ: لِينُ الخَدِّ، والنَّعتُ: أسجَحُ وسَجْحاء، قال ذو الرمة:
وخد كمرآة الغريبة أسجح «3»
باب الحاء والجيم والزاي معهما ح ج ز، ج ز ح يستعملان فقط
حجز: الحَجْزُ: أن تَحجِزَ بين مُقاتِلَيْن. والحِجاز والحاجز اسم، وقوله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً
«4» أيْ حِجازاً فذلك الحِجاز أمْر الله بين ماءٍ مِلْحٍ وعَذْبٍ لا يختلطان. وسُمِّيَ الحِجاز لأنّه يفصِلُ بينَ الغَوْر والشام وبيْنَ البادِية. والحِجازُ: حَبْلٌ يُلقَى للبعير من قِبَل رِجلَيْه، ثُمَّ يُناخُ عليه، يُشَدُّ به رُسْغا رِجلَيْه إلى حِقْوَيْه وعَجُزه. حَجَزْته فهو مَحجُوز، قال ذو الرمة:
__________
(1) الشاعر حسان بن ثابت والبيت في الديوان (ط تونس) ص 125. وفي اللسان:
دعوا التخاجؤ....
(2) سقطت في الأصول المخطوطة ووردت في التهذيب من كلام الليث.
(3) ديوانه 2/ 1217. وصدر البيت:
لها أذُنٌ حَشرٌ وذِفْرَى أسيلة
(4) سورة النمل 61
(3/70)
________________________________________
حتى إذا كانَ محجُوزاً بنافِذةٍ ... وقائظا وكِلا رَوْقَيْهِ مُخْتَضَبُ «1»
وتقول: كان بينهم رِمِّيّاً ثم حَجَزْتَ بينهم حِجِّيَزى. أيْ رَمْيٌ، ثم صاروا إلى المُحاجزة. والحُجْزَةُ: حَيثُ يُثْنَى طَرَف الأزِار في لَوْث الازِار، قال النابغة:
رِقاقُ النِعالِ طِّيبٌ حجزاتهم ... يُحَيُّونَ بالرَيْحانِ يومَ السباسِبِ
والرجلُ يحتَجزُ بإزارِه على وسَطه. وحُجْزُ الرجل: أصلُه ومَنْبِتُه. وحُجْزُ الرجل أيضاً: فَصْل ما بين فَخذِه والفَخِذِ الأخرى من عشيرته، قال: «2»
فامدَحْ كريمَ المُنْتَمَى «3» والحُجْزِ
جزح: جَزَحَ لَنا من ماله [جَزْحا «4» أو جَزْحةً: أيْ قَطَعَ قِطعةً. وجَزَحَ الشَجَرَ: حَتَّ ورقه.
باب الحاء والجيم والطاء معهما ج ط ح يستعمل فقط
جطح: جطح: يقال للعَنْز عند الحليب: جِطِحُ، أي: قَرِّي فتَقَرَّ. قال زائدة: جَطَح السَّخْلةَ إذا زُجِرَتْ ولا يقال للعنز.
__________
(1) ديوانه 1/ 109 والرواية فيه:
حتى إذا كن محجوزا بنافذة ... وزاهقا.....
رواية التهذيب 4/ 123 واللسان (حجز) :
فهن من بين محجوز بنافذة ... وقائظ وكلا روقيه مختضب.
(2) هو (رؤبة) ديوانه/ 65.
(3) في الأصول المخطوطة: المنتهى.
(4) في الأصول المخطوطة، جزاحا
(3/71)
________________________________________
باب الحاء والجيم والدال معهما ج ح د، ج د ح، ج د ح مستعملات
جحد: الجُحُود: ضدُّ الاقرار كالانكار والمعرفة. والجَحدُ: من الضيِّق والشُحِّ. ورجُلٌ جَحْدٌ: قليلُ الخير، قال:
لا جحدا ابتغينه ولا جَدا ... يَعدنَ من هازَلْنَه غداً غدا «1»
حدج: الحَدَج: حَمْلُ البِطِّيخ والحنَظْلَ ما دام صِغاراً خُضْراً. ويقال ذلك لحَسَك القُطْب ما دامَ رَطْباً، الواحدة بالهاء. والحُدْجُ لغةٌ فيه. والتَحديج: شِدَّة النَظَر بعد رَوْعةٍ وفَزْعةٍ، حَدَّجْتُ بَبصَرى، قال العجاج: «2»
إذا آثبجرّا «3» من سَواد حَدَّجا
وحَدَجْتُ ببَصَري: رَمَيتُ به. والحِدْج: مَرْكَبٌ غيرُ رَحْلٍ ولا هَوْدَج لنِساء العرب، حَدَجْتُ الناقةَ أحدِجُها حَدْجاً، والجميع: أحداج وحَدائج وحُدُوج، قال:
أَصاحِ تَرَى حَدائِجَ باكراتٍ ... عليها العَبْقَريَّةُ والنُّجُودُ «4»
وأحدَجْتُها: إذا شَدَدْتُ الحِدْجَ عليها.
__________
(1) لم نهتد إلى الرجز في المشهور من المظان.
(2) في اللسان: يصف الحمار والأتن.
(3) كذا في الأصول المخطوطة والديوان ص 379. وفي اللسان: اسبجرا.
(4) لم نهتد إلى البيت وقائله ولم نجده في المظان المعتمدة.
(3/72)
________________________________________
جدح: الجَدْحُ: خوض السَّويق واللَّبَن ونحوه بالمجدح ليختلِطَ. والمِجدَح: خَشَبةٌ في رأسها خَشَبَتان مُعتَرضَتانِ. والمِجداح: تردُّد رَيِّق الماء في السَّحاب «1» ، يقال: أرسَلَتِ السَماُء مَجاديحَ الغَيْثِ.
باب الحاء والجيم والظاء معهما ج ح ظ مستعمل فقط
جحظ: الجِحاظان: حَدَقَتا العَيْن إذا كانتا خارجتَيْن. وعَيْنٌ جاحظةُ جَحَظَتْ جُحُوظاً.
باب الحاء والجيم والذال معهما ذ ح ج مستعمل فقط
ذحج: ذَحَجَتِ المرأةُ بَوَلَدِها، إذا رَمَتْ به عندَ الوِلادة. ومَذْحِجٌ: اسم رجل.
باب الحاء والجيم والراء معهما ح ج ر، ج ح ر، ح ر ج، ر ج ح مستعملات
حجر: الأحجار: جمع الحَجَر. والحِجارة: جمع الحَجَر أيضاً على غير قياس،
__________
(1) وفي التهذيب: وما قاله الليث في تفسير المجاديح أنها تردُّد رَيِّق الماء في السحاب فباطل، والعرب لا تعرفه.
(3/73)
________________________________________
ولكن يَجْوزُ الاستحسان في العربية [كما أنه يجوز في الفقه، وترك القياس له] «1» كما قال: «2» .
لا ناقصي حسب ولا ... أيد إذا مُدَّتْ قِصارَهْ
ومثله المِهارة والبِكارة والواحدةُ مُهْرٌ وبَكْرٌ. والحِجْرُ: حطيم مكّة، وهو المَدارُ بالبيت كأنّه حُجْرَةٌ. مما يلي الَمْثَعب. وحِجْر: موضعٌ كان لثَمود ينزِلونَه. [وقصبة اليمامة] : حَجْرٌ، قال الأعشى:
وإن امرأ قد زُرْتُه قبل هذه ... بحَجْرٍ لخَيرٌ منكَ نفساً ووالِدا «3»
والحِجْر والحُجْر لغتان: وهو الحرام، وكان الرجل يَلقَى غيره في الأشهر الحُرُم فيقول: حِجْراً مَحجُوراً أيْ حَرامٌ مُحرَّم عليك في هذا الشْهر فلا يبدؤهُ بشَرٍّ، فيقول المشركون يومَ القيامة للملائكة: حِجْراً محجُوراً، ويظُنّون أن ذلكَ ينفعُهم كفِعلِهم في الدنيا، قال:
حتى دَعَونا بأَرحامٍ لهم سَلَفَتْ ... وقالَ قائلُهم إنّي بحاجُورِ «4»
وهو فاعُول من المنع، يَعني بمَعاذٍ. يقول: إني مُتَمسِّكٌ بما يعيذني منك ويَحجُبُك «5» عنّي، وعلى قياسه العاثُور وهو المَتْلَفُ. والمُحَجَّر: المُحَرَّم. والمَحْجِرُ: حيثُ يَقَعُ عليه النِقابُ من الوَجْه، قال النابغة:
وتَخالُها في البَيتِ إذْ فاجَأتَها ... وكأنَّ مَحْجِرَها سِراجُ الموقِدِ «6»
وما بَدَا من النِقاب فهو مَحْجِر. وأحجار الخَيْل «7» : ما اتخذ منها
__________
(1) من التهذيب 4/ 130 عن العين. والعبارة في الأصول مضطربة.
(2) هو الأعشى كما في التهذيب واللسان وديوانه ص 157
(3) ديوانه ص 65 والرواية فيه: بجو لخير منك......
(4) البيت في التهذيب واللسان (حجر) .
(5) في التهذيب: ويحجرك.
(6) عجز البيت في اللسان (حجر) والديوان ص 38. والرواية فيه:
قد كان محجوبا سراج الموقد
(7) في (ط) : النخل، وهو نصحيف.
(3/74)
________________________________________
للنَسل «1» لا يكادُ يُفرَد. ويقال: بل يقال هذا حِجْرٌ من أحجار خَيْلي، يَعني الفَرَسَ الواحد، وهذا اسم خاصٌّ للإِناث دونَ الذُكور، جَعَلَها كالمُحَرَّمِ بَيعُها ورُكوبُها. والحَجْر: أن تحجُرَ على إنسانٍ مالَه فتَمنَعَه أن يُفسدَه. والحَجْر: قد يكون مصدراً للحُجرة التي يَحتَجرُها الرجل، وحِجارُها: حائطُها المحيطُ بها. والحاجرِ من مَسيل الماء ومَنابِت العُشْب: ما استَدارَ به سَنَدٌ أو نهْرٌ مُرتفع، وجمعُه حُجْران، وقول العجاج:
وجارةُ البيتِ لها حُجْريٌّ «2»
أي حُرْمة. والحَجْرة: ناحيةُ كلِّ موضع قريباً منه. وفي المَثَل: يأكُلُ خُضْرةً ويَرْبِضُ حَجْرة «3» أيْ يأكُلُ من الرَوضة ويَربِض ناحيةً. وحَجْرتا العَسَكر: جانِباه من المَيْمَنةِ والميْسَرة، قال:
إذا اجتَمَعُوا فضضنا حجرتيهم ... ونجمعهم إذا كانوا بَدادِ «4»
وقال النابغة:
أُسائِلُ عن سُعْدَى وقد مَرَّ بعدَنا ... على حَجَرات الدارِ سَبْعٌ كَوامِلٌ
وحِجْر المرأة وحَجْرها، لغتان،: للحِضْنَين.
جحر: جَمْعُ الُجْحر: جِحَرة. أجْحَرته فانْجَحَر: أي أدخَلْتُه في جُحْر، ويجوز في الشعر: جَحَرتُه في معنَى أجْحَرتُه بغير الألف. واجتَحَر لنفسه جُحْراً. وجَحَرَ عنّا الربيع: تأخر، وقول امرىء القيس:
__________
(1) في (س) : للفسيل، وليس بالصواب.
(2) الرجز في التهذيب واللسان والديوان ص 316.
(3) في الأمثال ص 380 وفي التهذيب: فلان يرعى وسطا ويربض حجرة.
(4) البيت في التهذيب 4/ 135 واللسان. (حجر) .
(3/75)
________________________________________
جَواحِرُها في صَرَّةٍ لم تَزَيَّلِ «1»
أي أواخرُها. وقالوا: الجَحْرة السنةُ الشديدة، وإنّما سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها جَحَرَتِ الناسَ، قال زهير:
ونالَ كرامَ الناس في الجَحْرةِ الأَكْلُ «2»
حرج: الحَرَجُ: المَأُثم. والحارِجُ: الآثِم، قال:
يا ليتَني قد زُرْتُ غيرَ حارِجِ «3»
ورجُلٌ حَرِج وحَرَج كما تقول: دَنِف ودَنَف: في معنى الضَيِّق الصَدْر، قال الراجز:
لا حَرِجُ الصَدّرِ، ولا عنيفُ «4»
ويقرأ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً «5» وحَرِجاً. وقد حَرِجَ صدرهُ: أيْ ضاق ولا ينشَرحُ لخَير ورجلٌ مُتَحَرِّج: كافٌّ عن الإثم وتقول: أَحرَجَني إلى كذا: أيْ ألجَأني فخرِجْتُ إليه أي انضَمَمْتُ إليه، قال الشاعر: «6»
تَزدادُ للعَيْن إبهاجاً إذا سَفَرتْ ... وتَحْرَجُ العَيْن فيها حين تَنْتَقِبُ
والحَرَجَةُ من الشَجَر: الملتَفّ قَدْر رَمْية حَجَر، وجَمْعُها حِراج، قال:
ظلَّ وظلَّتْ كالحِراج قُبُلا ... وظلَّ راعيها بأخرى مبتلى «7»
__________
(1) وصدر البيت كما في الديوان، ص 22:
فألحقنا بالهاديات ودونه.
(2) وصدر البيت كما في الديوان ص 110:
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت
(3) لم نهتد إلى الرجز ولا إلى قائله.
(4) الرجز في التهذيب واللسان.
(5) سورة الأنعام 125
(6) البيت (لذي الرمة) انظر الديوان 1/ 31.
(7) لم نهتد إلى هذا الرجز.
(3/76)
________________________________________
والحرِجْ: قِلادة كَلْبٍ ويجمَع [على] أحرِجة ثم أحراج، قال الأعشى:
بنَواشِطٍ غُضُفٍ يُقلِّدُها ... الأَحراجُ فَوْقَ مُتُونها لُمَعُ «1»
والحِرْج: وَدَعة، وكِلابٌ محرّجةٌ: أي مُقَلّدة، قال الراجز: «2»
والَشُّد يُدني لاحقاً والهِبْلَعا ... وصاحبَ الحِرْج ويُدني ميلعا «3»
والحرجوج: الناقة الوقادة القَلْب، قال:
قَطَعْتُ بحُرْجُوجٍ إذا اللَّيلُ أظْلَما «4»
والحَرَج من الإبِل: التي لا تُركَب ولا يَضربُها الفَحل مُعَدَّة للسِمَن، كقوله: «5»
حَرَجٌ في مِرْفَقَيْها كالفَتَلْ «6»
ويقال: قد حَرَج الغبارُ غيرُ الساطعِ المنضَمِّ إلى حائطٍ أو سَنَد، قال:
وغارة يَحرَجُ القَتامُ لها ... يَهلِكُِ فيها المُناجِدُ البَطَلُ «7»
جرح: جَرحْتُه أجرَحُه جَرْحاً، واسمُه الجُرْح. والجِراحة: الواحدة من ضربة أو طعنةٍ. وجَوارح الإنسان: عواملُ جَسَده من يَدَيْه ورِجْلَيه، الواحدة: جارحة.
__________
(1) لم نجد البيت في الديوان (تحقيق محمد محمد حسين) .
(2) هو (رؤبة بن العجاج) ، الديوان ص 90
(3) ورواية الرجز في الديوان: (يذري) في مكان (يدني) في الرجز. و (هبلعا) بدون (أل) .
(4) لم نهتد إلى قائل البيت ولا إلى تمامه.
(5) هو الشاعر (لبيد) .
(6) وصدر البيت كما في الديوان ص 175:
قد تجاوزت وتحتي جسرة
(7) البيت في اللسان من غير عزو.
(3/77)
________________________________________
واجَتَرَح عَمَلاً: أي اكتسَبَ، قال:
وكلٌّ فتىً بما عملت يَداهُ ... وما اجتَرَحَتْ عوامِلُهُ رَهينُ «1»
والجَوارحُ: ذواتُ الصَيْد من السِباع والطَّيْر، الواحدة جارحة، قال الله تعالى: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ «2» .
رجح: رَجَحْتُ بيَدي شيئاً: وَزنته ونَظَرت ما ثِقْلُه. وأرجَحْتُ الميزان: أَثقَلْتُه حتى مال. ورجح الشيء رُجحاناً ورُجُوحاً. وأرجَحْتُ الرجلَ: أعطيته راجحاً. وحِلْمٌ راجح: يَرْجُحُ بصاحبه. وقَوْمٌ مراجيح في الحلم، الواحد مِرْجاحٌ ومِرْجَح، قال الأعشى:
من شَبابٍ تَراهُمُ غيرَ مِيلٍ ... وكُهُولاً مَراجحاً أحلاما «3»
وأراجيحُ البَعير: اهتِزازُه في رَتَكانه إذا مَشَى، قال:
على رَبِذٍ سَهْل الأراجيح مِرْجَم «4»
والفِعلُ من الأرجُوحة: الارتِجاح. والتَّرجُّح: التَذَبْذُب بينَ شَيْئَين.
باب الحاء والجيم واللام معهما ح ج ل، ل ح ج، ج ل ح، ح ل ج مستعملات
حجل: الحجل: القبج، الواحدة حَجَلةٌ. وحَجَلة العَروس تجمع على حجال
__________
(1) لم نهتد إلى قائل البيت.
(2) سورة المائدة 4
(3) كذا في التهذيب واللسان والديوان ص 249، وفي الأصول المخطوطة: أحكاما
(4) الرواية في التهذيب واللسان.
على ربذ سهو الأراجيح مرجم
(3/78)
________________________________________
وحَجَل، قال:
يا رُبَّ بيْضاءَ ألوفٍ للحَجَل
والحَجْل، مجزوم، مَشْيُ المُقيَّد. وحِجلاً القَيد: حَلْقَتاه. قال عديّ بن زيد:
أعاذلُ قد لاقَيْتُ ما يَزَعُ الفَتَى ... وطابقت في الحجلين مشي المُقيَّدِ «1»
وفلانٌ يَحْجِل: إذا رَفَعَ رجلاً وَيَثِبُ في مَشْيه على رِجْل، يقال: حَجَلَ. ونَزَوان الغُراب: حَجْله. والحِجْل: الخَلْخال، ويقال: الحَجْل أيضاً، قال النابغة:
على أنَّ حِجْلَيْها وإن قُلتُ أُوسِعا ... صَمُوتانِ من ملءٍ وقِلّةِ مَنطِق «2»
والتَحْجيل: بَياضٌ في قَوائِم الفَرَس، فَرَسٌ مُحَجَّل، وفَرَسٌ بادٍ حُجُولُه، قال: «3»
تَعالَوا فإِنَّ العِلْمَ عندَ ذَوي النُهَى ... من الناس كالبَلقْاء بادٍ حُجُولُها
والحَوْجَلةُ: من صِغار القَوارير ما وسعَ رأسُها، قال العجاج:
كأنَّ عَيْنَيهِ من الغئور ... قلتان أو حوجلتا قارور «4»
وحَجَل الإبلِ: أولادُها وحَشوها. وحَجَلتْ عينُه: غارَتْ، قال: «5»
__________
(1) ديوانه/ 103.
(2) ديوانه/ 184.
(3) هو (الأعشى) كما في اللسان (حجل) والتهذيب 4/ 145. والديوان ص 175.
(4) ديوانه ص 226، 227، والرواية فيه:
كأن عينيه من الغئور ... بعد الإني وعرق الغرور
قلتان في لحدي صفا منقور ... أذاك أم حوجلتا قارور
(5) في اللسان هو (ثعلبة بن عمرو) .
(3/79)
________________________________________
فتُصبحُ حاجلةً عينُه ... بحِنْو استه وصلاه عيوب
جحل: الجَحْل: ضرب من اليعسوب، والجمع جحِلان. غير الخليل: ضَبٌّ جَحُول إذا كان ضَخْماً كبيراً.
لحج: اللحَج: كَسر العين مثل اللَّخَص إلا أنّه من تحت ومن فوق. واللحجَ: الغَمَص نفسه. واللَّحْج، مجزُوم، المَيْلُولة «1» التَحجَوا إلى كذا. وأَلحَجَهُمْ فيه كذا: أَمالَهُم فيه، قال:
ويَلْتَحجُوا بَكْراً لدَى كلِّ مِذنَبِ «2»
قال العجاج:
أو تَلْحَجَ الألسُنُ فينا مَلْحَجا «3»
أي تقولُ فينا فتَميل إلى القَبْيحِ عن الحَسَن.
جلح: الجَلَحُ: ذَهابُ شَعْر مُقَدَّم الرأس، والنعتُ أجْلَحُ. والتَجليحُ: التَعميم في الأمر. وناقَةٌ مِجلاح: وهي المُجَلِّحة على السنة الشديدة في بقاءِ لَبَنٍها، والجميعُ: المَجاليح، قال:
شَدَّ الفَناءُ بمصباح مَجالحَه ... شَيْحانةٌ خُلِقَتْ خلق المصاعيب «4»
__________
(1) في اللسان: الميل.
(2) لم نهتد إليه.
(3) ديوانه/ 365. وقد نسب في اللسان إلى (رؤبة) .
(4) لم نجد هذا الشاهد في المظان المتيسرة لدينا.
(3/80)
________________________________________
والجالحةُ والجَوالحُ: ما تَطايَرَ من رءوس النَبات كالقُطْن من الريح ونحوه من نَسْج العنكبوت. وكالثلج إذا تَهافَتَ. والجَلْحاء: البَقَرةُ الذاهبُ قَرناها بأَخَرةٍ «1» . جُلاح: اسمُ أبي أُحَيْحَة، وكان سيِّدَ بني النَجّار وهو جَدّ عبد المطَّلب، كانت أمُّه سَلمَى بنتَ عَمْرو بنِ أُحَيْحَة. والمُجَلَّح: الكثير الأكل، ومنه قول ابن مقبل:
إذا اغبَرَّ العِضاهُ المُجَلَّحُ «2»
وهو الذي أُكِلَ فلم يُتْرَكْ منه شيءٌ.
حلج: والحَلْجُ: حَلْجُ القُطن بالمِحْلاج. والحَلْج في السَّيْر كقولك: بَيْننا وبينَهم حَلْجة صالحةٌ وحَلْجةٌ بعيدة «3» ، قال أبو النجم:
منه بعجز كصَفاةِ الحَيْجَل «4»
وفي الأصل: الحَيْلَج.
باب الحاء والجيم والنون معهما ح ج ن، ن ج ح، ج ح ن، ج ن ح مستعملات
حَجَنَ: المِحْجَنة والمِحْجَن «5» : عصا في طرفها عقافة. واحتجن الرجل: إذا
__________
(1) وجاء في التهذيب فيما نقله الأزهري عن الليث: والجلحاء من البقر التي تذهب قرناها أخرا.
(2) البيت في اللسان (جلح) وتمامه:
ألم تعلمي أن لا يذم فجاءتي ... دخيلي إذا اغبر العظاةالمجلح
(3) قال الأزهري: والذي سمعته من العرب: الخلج في السير بالخاء، ولا أنكر الحاء بهذا المعنى.
(4) لم نهتد إلى هذا الشاهد. في (س) : كصفاة الحيلج.
(5) كذا في اللسان، وفي الأصول المخطوطة: الحجن.
(3/81)
________________________________________
اختصَّ بشيءٍ «1» لنفسه دونَ أصحابه. والاحتجان أيضاً بالمِحْجَن. حَجَنته عنه: أي صَدَدْتُه، قال:
ولا بُدَّ للمشَعُوف من تَبَع الهَوَى ... إذا لم يَزَعْه من هَوَى النفس حاجنُ «2»
وغَزوةٌ حَجون: وهي التي تظهر غيرها ثمَّ تخالف إلى غير ذلك الموضع، [ويُقْصَدُ إليها] . يقال: غَزاهم غَزوةً حَجوناً، ويقال: هي البعيدة، قال الأعشى:
فتلك إذا الحَجونُ ثَنَى عليها ... عِطافَ الهَمِّ واختَلَطَ المَريدُ «3»
والحَجون: مَوضع بمكّة قال: «4»
فما أنتَ من أهل الحَجون ولا الصَفا
والحُجْنة: مَوضع أصابَه اعوِجاجٌ. والحَجَنُ: اعوجاجُ الشيء الأحجن. والصقر وما يشبهه من الطَّير أحْجَن المِنقار. ومن الأُنُوف أحجَن وهو ما أقبَلْتْ رَوثَتُه نحوَ الفَم فاستَأْخَرَتْ ناشزتاه قُبْحاً. وتكون الحُجْنةُ من الشَّعر: الذي جُعُودتُه في أطرافه.
نجح: النُجْح والنَجاح: من الظَّفَر [بالحوائج] . نَجَحَتْ حاجتُك وأنجَحْتُها لك. وسِرْتُ سَيراً نُجحاً وناجحاً ونجيحاً: أي وشيكاً، قال:
يَشُلُّهُنَّ قَرَباً نجيحا «5»
__________
(1) كذا في التهذيب واللسان وقد سقط من الأصول المخطوطة.
(2) البيت في اللسان (حجن) .
(3) ديوانه/ 325، والرواية فيه:
فتلك إذا الحجوز أبى عليه ...
(4) (الأعشى) ديوانه/ 123 وعجزه:
ولا لك حق الشرب في ماء زمزم.
(5) في (ط) : تشلهن بالتاء. والرجز في المحكم 3/ 63، وفي اللسان (نجح) ، والرواية فيهما: يغبقهن. غير منسوب أيضا.
(3/82)
________________________________________
يصف قرباً على طريق المصدر. ورأيٌ نَجيحٌ: صَوابٌ. وتناجحت أحلامه: إذ تَتابَعَت عليه رؤيا صِدقٍ. ونَجَحَ أمره: سَهُل ويَسَر.
جحن: جَيْحُونُ وجَيْحانُ: اسم نهر بالشام «1» . والجحن: السيىء الغِذاء، قال الشّماخ يذكُر ناقةً:
وقد عَرِقَتْ مَغاِبنُها وجادَتْ ... بدرَّتِها قِرَى جَحِنٍ قَتينِ «2»
أي قليلُ الطُّعْم.
جنح: جَنَحَ الطائرُ جُنُوحاً: أي كَسَرَ من جَناحَيْه ثم أقبل كالواقع اللاجىء إلى موضع. والرجُلُ يَجْنَحُ: إذا أقبَلَ على الشَيءِ يعَملُه بَيدَيْه وقد حَنَى إليه صدرهَ، قال: «3»
جُنُوحَ الهالكي على يديه ... مكبا يَجْتَلي نُقَبَ النِصال
وقال في جُنوح الطائر:
تَرَى الطَّيْرَ العتاق يَطَلْنَ منه ... جنوحا.... «4» ......
__________
(1) الذي بالشام هو جيحان، كما في معجم البلدان 2/ 196، أماجيحون فيجيء من موضع يقال له: ريوساران وهو جبل يتصل بناحية السند والهند وكابل. ولعل ترجمة (جيحون) سقطت من الأصول فاختلط الأمر واضطربت العبارة
(2) جاء في اللسان: قال (ابن سيده)
أراد قرادا جعله حجنا لسوء غذائه
، يعني أنها عرقت. فصار عرقها قرى للقراد. وهذا البيت ذكره (ابن بري) بمفرده في ترجمة (حجن) بالحاء قبل الجيم، قال: والحجن المرأة القليلة الطعم وأورد البيت. غير أن رواية العين (حجن) بالجيم قبل الحاء هي المعتمدة، فغد جاءت في مصادر معتبرة قديمة. جاء في المجهرة 2/ 59: والجحن: السيىء الغذاء. قال (الشماخ) :.. وأورد البيت. وتهذيب الألفاظ لابن السكيت ص 328، والمقاييس لابن فارس 1/ 430 والصحاح (جحن) والتهذيب 4/ 154، والمحكم 3/ 61.
(3) هو (لبيد) كما في التهذيب واللسان والديوان ص 78
(4) وتكملة العجز كما في التهذيب واللسان:.... إن سمعن له حسيسا
(3/83)
________________________________________
والسَفينةُ تجنَحُ جُنوحاً: إذا انتَهَتْ إلى الماءِ القليل فَلزِقَتْ بالأرض فلم تَمْض. واجتَنَحَ الرجُلُ على رِجْله في مَقْعَده: إذا انكَبَّ على يديه كالمتكىء على يَدٍ واحدة. وجَنَحَ الظَلامُ جُنُوحاً: إذا أقبَلَ الليل، والاسم: الجنح والجُنْح، لغتان، يقال: كأنُّه جنح اللَّيْل يُشَبَّهُ به العَسْكَرُ الجَرّار. وجَناحا الطائر: يداه. ويَدا الإنسان: جناحاه. وجَناحا العَسْكَر: جانِباه. وجَناحا الوادي: أنْ يكونَ له مَجْرى عن يَمينه وعن شمَالِه. وجَنَحَت الناقةُ: إذا كانَتْ باركةً فمالَتْ عن أحَدِ شِقَّيْها. وجَنَحَتِ الإبِل في السَّيْر: أسرَعَتْ، قال: «1»
والعيِسُ المَراسيلُ جُنَّحُ
وناقةٌ مُجَنَّحُة الجَنْبَيْن: أي واسعتها. وجَنَحْتُه عن وجهه جنحاً فاجتَنَحَ: أي أمَلْتُه فمالَ. واجْنَحْتُه فجَنَحَ: أمَلْتُه فمال، قال:
فإن تَنْأ لَيْلَى بعدَ قُرْبٍ ويَنْفَتِلْ ... بها مُجْنَحُ الأَيّام أو مُستقيمُها «2»
وجَوانِح الصدر: الأضلاع المتصلة رءوسها في وَسَط الزَّوْر، الواحدةُ جانحة.
حنج: يقال: حَنَجْتُه فاحتَنَجَ: أي أمَلْتُه فمالَ، وأحْنَجْتُه، لغة، قال العجاج:
فَتُحْمِلِ الأرواحَ حاجاً مُحْنَجاً ... إليَّ أعرِفْ وَجْهَها المُلَجْلَجا «3»
يَعني حاجةً ليسَتْ بواضحةٍ على وجهها ولكنَّها مُمالةُ المَعْنَى. والحَنْج: إمالة الشَيءِ عن وجهه. والمِحْنجة: شَيءٌ من الأدَوات.
__________
(1) هو (ذو الرمة) . ديوان 2/ 1215 وتمام البيت فيه:
إذا مات فوق الرحل أحييت نفسه ... بذكراك............... ......
(2) لم نهتد إلى نسبة البيت، وإن كان يتفق في الوزن والقافية مع قصيدة للمجنون في ديوانه.
(3) في الديوان ص 360: إلى أعرف وحيها الملجلجا.
(3/84)
________________________________________
باب الحاء والجيم والفاء معهما ح ج ف، ج ح ف، ف ح ج مستعملات
حجف: الحَجَفُ: [ضَرْبٌ من التِّرَسةِ] «1» مُقوِّرَةٌ من جُلُود الإبِل، الواحدة حَجَفة. والحُجاف: داءٌ يَعَتَري [الإنسان] من كَثرة الآكل أو من شَيءٍ لا يلائِمُه فيأخُذُ البطنَ استطلاقاً. وقيل: رجلٌ مَحْجُوف، قال: «2» .
والمُشتَكي من مَغْلة المحَجُوفِ
جحف: الجَحْفُ: شِبْهُ الجَرْف إلاّ أنّ الجَرْف للشيء الكثير والجحف للماء والكرة ونحوهما، تقول: اجتَحَفْنا ماءَ البئر إلاّ جُحفةً واحدة بالكَفِّ أو بالإناء. وتَجاحَفْنا الكُرَةَ بيننا بالصَوالِجة. وتَجاحَفْنا بالقِتال: تناول بعضُنا [بعضاً] بالعِصِيِّ والسُيُوف، قال العجاج:
وكانَ ما اهتَضَّ الجِحافُ بَهْرَجا «3»
اهتَضَّ: أي كَسَرَ، بَهْرَجاً: أي باطلاً، والجِحاف: مُزاحَمةُ الحرب. وسنة مُجْحفةٌ: تُجحفُ بالقَوم وَتْجَتحِفُ أموالَهم. ويقال: مَن آثَرَ الدُنْيا أجْحَفَتْ بآخِرتِه. والجُحْفةُ: «4» ميقات للإحرام.
فحج: الفَحَجُ: تَباعُدُ ما بينَ الساقَيْن في الإنسان والدابة، والنعْتُ: أفحَجُ وفَحْجاءُ، ويُقال «5» : لا فَجَحٌ فيها ولا صكك.
__________
(1) من التهذيب، وفي الأصول المخطوطة: ترس.
(2) هو (رؤبة) كما في اللسان وملحقات الديوان ص 178.
(3) ديوانه/ 383.
(4) في التهذيب: ميقات أهل الشام.
(5) من (س) . وسقطت من العبارة في (ص، ط) .
(3/85)
________________________________________
باب الحاء والجيم والباء معهما ح ج ب، ب ج ح، ج ب ح مستعملات
حجب: الحَجْب: كُلٌّ شيءٍ مَنَعَ شَيئاً من شيءٍ فقد حَجَبَه حَجْباً. والحِجابةُ: ولايَة الحاجب. والحِجابُ، اسمٌ،: ما حَجَبْتَ به شيئاً عن شيءٍ، ويجمع [على] : حُجُب. وجمع حاجب: حَجَبة. وحِجاب الجَوْف: جِلْدةٌ تَحْجُبُ بينَ الفُؤاد وسائر البطن. والحاجب: عظم العَيْن من فَوق يَستُرُه بشَعْره ولحمه. وحاجبُ الفيل: اسمُ شاعرٍ. ويُسَمَّى رءوس عظم الوَرِكَيْن وما يَلي الحَرْقَفَتَيْن حَجَبَتينِ وثلاث حَجَبات، وجمعهُ حَجَب، قال «1» :
ولم يُوَقَّعْ برُكُوبٍ حَجَبُهْ
حبج: أحْبَجَتْ لنا نارٌ وعَلَمٌ: أي بَدا بَغْتَةً، قال: «2»
عَلَوْتُ أقصاهُ إذا ما أحْبَجا
بجح: فلانٌ يَتَبَجَّحُ بفُلانٍ ويَتَمَجَّحُ به: أي يهذي به اعجاباً، وكذلك إذا [تَمَزَّحَ] «3» به. وَبَجَّحنَي فَبَجِحْتُ: أي فرَّحَني ففَرِحْتُ. وبَجِحْتُ وبَجَحْتُ لغتان، قال: «4»
ولكنّا بقرباك نبجح «5»
__________
(1) التهذيب 4/ 162 واللسان (حجب) غير منسوب أيضا.
(2) هو (العجاج) ديوانه/ 368 وفيه (أخشاه) في مكان أقصاه.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: تمدح.
(4) هو (الراعي) كما في التهذيب.
(5) وتمام البيت:
وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا ... إليك ولكنّا بقُرباكَ نَبْجَحُ.
(3/86)
________________________________________
جبح: جَبَحُوا بِكَعابهم: رَمَوا بها ليُنْظَرَ أيُّها يخرُجُ فائِزاً. والأُجْبُحُ «1» : مواضع النَّحْل في الجبل، الواحد جِبحْ، ويقال: هو الجَبَلُ، قال الطرماح: «2»
جَنَى النَحْل أضْحَى واتِناً بين أجبح
باب الحاء والجيم والميم معهما ح ج م، ج ح م، ج م ح، ح م ج، م ح ج مستعملات
حجم: الحِجامة: حِرْفُة الحاجِم وهو الحجّام، والحجم فعله. والمحجمة: قارورة. والمَحْجَم: مَوضعة من العُنُق. والحُجُومُ: اسمٌ للقُبل. والإِحجام: النُّكُوص عن الشّيء هَيبةً. والحِجام: شيءٌ يُجعل في خَطْم البَعير كي لا يعَضَّ، بَعيرٌ مَحْجُوم. والحَجْمُ: كفُّكُ إنساناً عن أمْرٍ يُريده. والحَجْم: وجدانُك شيئاً تحت ثَوْبٍ، تقول: مَسِسْتُ الحُبْلَى فوَجَدت حَجْمَ الصبَّيِّ في بَطْنها. وأحْجَمَ الثَدْيُ أي: نَهَدَ، قال: «3»
قد أحْجَمَ الثَدْيُ على نَحْرها ... في مُشرِقٍ ذي بَهجة نائر
جحم: الجَحيمُ: النّارُ الشديدة التَأَجُّج والالتِهاب، جَحَمَت تجحم جحوما.
__________
(1) في (ط) : والأجج: الجبل.
(2) ديوانه/ 102. وصدر البيت فيه:
وإن كنت عندي أنت أحلى من الجنى
(3) هو (الأعشى) كما في الديوان/ 139 والرواية فيه:
قد نهد الصدر على نهدها ... في مشرق ذي صبح نائر
(3/87)
________________________________________
وجاحِم الحرب: شدَّة القَتْل في معركتها، قال:
حتّى إذا ذات منها جاحِماً بَرَدا «1»
والحَجْمةُ: العَيْن بلغة حِمْيَر. قال: «2»
أيا جَحْمَتي بكي على أم واهب
وجَحْمَتا الأسَد: عَيناه بكلِّ لغة «3» . والأجحم: الشديدُ حُمرةِ العَيْن مع سَعَتها. والمرأةُ جَحْماءُ ونساءٌ جُحْمٌ وجَحْماواتٌ.
جمح: جَمَحَتِ السفينةُ جُمُوحاً: تَرَكَتْ قَصدَها فلم يَضبطْها المَلاّحُون. وجَمَح الفَرَسُ بصاحبه جِماحاً: إذا ذَهَبَ جَرْياً غالباً. وكلٌّ شيءٍ مَضَى لوجهِه على أمرٍ فقد جَمَحَ، قال:
إذا عَزَمْتُ على أمرٍ جَمَحتُ به ... لا كالذي صدَّ عنه ثُمَّ لم يَثُبِ «4»
وفَرَسٌ جَموحٌ: جامح، الذكَر والأُنثى في النَعتَيْن سواء. والجماح «5» و [الجميع] : الجَماميحُ: شِبْهُ سُنْبُلٍ في رءوس الحلي والصليان. وجمحموا بكِعابهم مثل جَبَحوا. والجُمّاح «6» : شيء يلعب به الصبيان، يأخذون ثلاث ريشات فيربطونها ويجعَلُون في وَسَطها تَمْرَةً أو عجيناً أو قِطعةَ طين فيرمونه فذلك
__________
(1) التهذيب 4/ 169، واللسان، والتاج (جحم) غير منسوب وغير تام أيضا.
(2) وفي اللسان (شنتر) : قال حميري يرثي امرأة أكلها الذئب. رواية البيت في التهذيب مع تمامه:
فيا جحمتا بكي على أم مالك ... أكيلة قليب ببعض المذانب
(3) وردد الأزهري ذلك في التهذيب 4/ 170 ناقلا عبارة (العين) . وفي اللسان (جحم) : لغة حمير، وقال ابن سيده: لغة أهل اليمن خاصة.
(4) اللسان (جمح) غير منسوب أيضا، وفيه، (لم ينب) بالنون في مكان (لم يثب) .
(5) في التهذيب من كلام الليث: الجماحة.
(6) في التهذيب 4/ 168: أبو عبيد عن الأموي: الجماح: ثمرة تجعل على رأس خشبة يلعب بها الصبيان. و (4/ 169) عن ثعلب عن ابن الأعرابي: الجماح: سهم يلعب به الصبيان.
(3/88)
________________________________________
الجُمّاح، قال: «1» عَبْداً كأنّ رأسَه جُمّاحْ وقال الحطيئة:
أخو المَرْء يُؤتَي دونَه ثُمَّ يُتَّقَى ... بزُبِّ اللِّحَى جُردِ الخُصَى كالجَمامِحِ
والجُمّاحةُ والجماميح: رءوس الحَليِّ والصِليِّان ونحو ذلك مِمّا يخرُجُ على أطرافه شِبْه سُنْبُل غيرَ أنّه كأذناب الثَعالب. والجِماح: موضع، قال الأعشى:
فكم بينَ رُحْبَى وبين الجماح ... أرضاً إذا قيسَ أميالُها «2»
حمج: وتَحميج العَيْنَيْن: إذا غارتَا، قال:
لقد تَقُودُ الخَيْلَ لم تُحَمِّجِ
أي لم تَغُرْ أعينُها. والتَحميج: النَظَرُ بخَوفٍ. ويقال: تَحميجُها هُزالُها. والتَحميجُ: تغُيُّر الوَجْه من [الغضب] «3» .
وفي الحديث: ما لي أراكَ مُحَمِّجاً.
محج: المَحْجُ: مَسْحُ شيءٍ عن شيءٍ. والرِيحُ تَمْحَجُ الأرضَ: أي تَذْهَبُ بالتُراب حتّى يتناولَ من أَدَمة الأرض تُرابَها «4» ، قال العجاج:
__________
(1) واللسان (جمح) : وروت العرب عن راجز من الجن زعموا وفيه: (هيق) في مكان (عبد) . للحكم 3/ 69
(2) رواية البيت في الديوان ص 165:
وكم دون أهلك من مهمه ... وأرض إذا قيس أميالها
(3) من عبارة العين في التهذيب 4/ 167 وهو الصواب.
(4) سقطت في الأصول المخطوطة، وهي في كلام الليث في التهذيب.
(3/89)
________________________________________
ومَحْجُ أرواحٍ يُبارينَ الصبَّا
ويُرْوَى: وسَحْجُ أرواحٍ «1»
مجح: التمَجُّح: «2» الاعجابُ بالشيء.
باب الحاء والصاد والشين معهما ش ح ص مستعمل فقط
شحص: الشَّحْصاء: الشاة التي لا لَبَنَ لها.
باب الحاء والشين والطاء معهما ش ح ط مستعمل فقط
شحط: الشَّحْطُ: البُعْدُ في الحالات كُلّها يُخَفَّف ويُثَقَّل. شَحَطَتْ دارُه تَشْحَطُ شُحُوطاً وشَحطاً. والشَحْطة: داءٌ يأخذ في صُدُور الإبِل لا تكادُ تنجُو منه. ويقال لأثَرِ سَحْج يُصيب جَنباً أو فَخِذاً ونحوه: أصابته شَحطةٌ. والشَّوْحَطُ: ضربٌ من النَّبْع. والمِشْحَطُ: عُوَيْدٌ يوضَع عند القضيب من قُضبان الكَرْم يقيه من الأرض.
__________
(1) وورد في اللسان (بيت العجاج) وكذا في ملحقات الديوان ص 73 وليس من إشارة إلى هذه الرواية.
(2) في التهذيب: قال غير واحدالتمجح والتبجح البذخ والفخر.
(3/90)
________________________________________
والتَشحُّطُ: الاضطِرابُ في الدم. والوَلَدُ يَتَشَحَّطُ في السَّلَى: أي يضطرِبُ فيه، قال النابغة:
ويَقْذِفْنَ بالأولادِ في كُلِّ مَنْزِلٍ ... تَشَحَّطُ في أَسلائِها كالوصَائِل «1»
يَعني بالوصائل البُرودُ الحُمْر.
باب الحاء والشين والدال معهما ح ش د، ش ح د يستعملان فقط
حشد: يقال: حَشَدوا أي خَفُّوا في التَعاوُن، وكذلك إذا دُعُوا فأَسْرَعُوا الإجابة، يستعمل في الجميع، قَلَّما يُقال: حَشَدَ، إلاّ أنَّهم يقولون للإبِل: لها حالِبٌ حاشدٌ أيْ لا يفتُرُ عن حَلْبها والقيام بذلك.
شحد «2» : الشَّوْحَدُ: الطَويل من النُّوق، قال الطرماح:
بفَتْلاءَ أمرار الذراعين شَوْدَحِ «3»
وهذا مقلوبٌ من شَوْحَد.
باب الحاء والشين والذال معهما ش ح ذ يستعمل فقط
شحذ: الشَّحْذُ: التَّحديد، شَحَذْت السِكِّينَ أشحَذهُ شَحْذاً فهو شحيذ ومشحوذ،
__________
(1) ديوانه/ 70.
(2) جاء في التهذيب من هذه المادة أشياء أخرى نسبها المصنف إلى الليث ولم يذكر الشوحد.
(3) ديوانه/ 116 (دمشق) والرواية فيه: بفتلاء ممران. وهذا الشاهد مما ذكره صاحب التهذيب في شدح التي أهملت في العين. وصدر البيت:
قطعت إلى معروفها منكراتها.
(3/91)
________________________________________
قال رؤبة:
يَشحَذُ لَحيَيْهِ بنابٍ أعْصَلِ «1»
والشَحَذانُ: الجائع
باب الحاء والشين والراء معهما ح ش ر، ش ح ر، ش ر ح، ر ش ح، ح ر ش مستعملات
حشر: الحَشْر: حَشْرُ يَومِ القِيامة [وقوله تعالى] : ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
«2» ، قيل: هو الموتُ. والمَحْشَرُ: المجمعُ الذي يُحشَرُ إليه القوم. ويقال: حَشَرتْهُم السَّنةُ: وذلك أنَّها تضُمُّهم من النَّواحي [إلى الأمصار] ، قال: «3»
وما نَجا من حَشْرها المَحْشُوش ... وَحْشٌ ولا طمْشٌ من الطُمُوش
قال غير الخليل: الحش والمحشوش واحد. والحَشَرة: ما كان من صِغار دَوابِّ الأرض مثل اليّرابيع والقَنافِذ والضبِّاب ونحوها. وهو اسمٌ جامعٌ لا يُفردَ منه الواحد إلاّ أن يقولوا هذا من الحشرة. قال الضرير: الجَرادُ والأرانِبُ والكَمْاة من الحَشَرة قد يكون دَوابَّ وغير ذلك. والحَشْوَر: كُلُّ مُلَزَّز الخَلْق. شديدةُ. والحَشْر من الآذانِ ومن قُذّذ السِهام ما لطُفَ كأنَّما بُرِيَ بَرْياً، قال: «4»
لها أذُنٌ حشر وذفرى أسيلة ... وخذ كمرآة الغريبة أسجح
__________
(1) ليس الرجز في ديوان رؤبة وهو في التهذيب 4/ 176 وفي اللسان (شحذ) غير منسوب.
(2) سورة الأنعام 38.
(3) هو (رؤبة بن العجاج) . والرجز في ديوانه ص 78.
(4) القائل (ذو الرمة) . والبيت في الديوان ص 2/ 1217.
(3/92)
________________________________________
وحَشَرْتُ السِنانَ فهو مَحْشُور: أي رَقَّقُته «1» وأَلْطَفْتُه.
شحر: الشِحْرُ: ساحِلُ اليَمَن في أقصاها، قال العجاج:
رَحَلْتُ من أقصَى بلاد الرُحَّلِ ... من قُلَل الشِحْرِ فجَنْبَيْ مَوْكِلِ «2»
ويقال: الشِحْر مَوضع بعُمان.
شرح: الشَّرْحُ: السَعَةُ، قال الله- عز وجل-: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ
«3» أي وسَّعَه فاتَّسَعَ لقَول الخير. والشَرْحُ: البَيان، اشرَحْ: أيْ بيِّنْ. والشَّرْحُ والتَشريحُ: قِطْعُ اللَّحم على العظام قَطْعاً، والقِطعة منه شَرْحةٌ.
رشح: رَشَحَ فلانٌ رَشْحاً: أي عَرِقَ. والرَشْحُ: اسمٌ للعَرَق. والمِرْشِحَةُ: بِطانةٌ تحت لِبْدِ السَّرْج لنَشْفِها العَرَق. والأُمُّ تُرشِّحُ وَلَدَها تَرشيحاً باللَّبَن القليل: أيْ تجعلُه في فَمِه شيئاً بعدَ شيءٍ حتى يقْوَى للمص. والترشيح أيضا: لحس الأُمِّ ما على طِفلها من النُدُوَّة، قال:
أُدْمُ «4» الظِباء تُرَشِّحُ الأطفالا
والراشِحُ والرَواشِحُ: جبال تَنْدَى فرُّبَما اجتَمَعَ في أصُولها ماء قليل وإنْ كَثُرَ سُمِّيَ واشِلاً. وإِنْ رأيتَه كالعَرَق يَجري خلالَ الحِجارة سُمِّيَ راشحا.
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة وفي نسخة من أصول التهذيب في سائرها: دققته.
(2) الرجز في الديوان (ط مصر) ص 46 والرواية فيه: بجنبي:
(3) سورة الزمر 39.
(4) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب 4/ 181 من العين واللسان (رشح) : أم الظبا ...
(3/93)
________________________________________
حرش: الحرش والتحريش: إغراؤك إنسانا بغيره. والأحرش من الدنانير ما فيه خشونة لجِدَّته، قال:
دنانيرُ حُرْشٌ كُلُّها ضَربُ واحِدٍ «1»
والضَبُّ أحرَشُ: خَشِنُ الجِلدِ كأنَّه مُحَزَّز. واحترشْتُ الضَبَّ وهو أن تحرشه في جحره فتُهيجَه فإذا خَرَجَ قريباً منك هَدَمْتَ عليه بقيَّةَ الجُحْر. ورُبَّما حارَشَ الضَبُّ الأفعَى: إذا أرادت أن تدخُل عليه قاتَلَها. والحَريشُ: دابَّةٌ لها مَخالِبُ كمخَالبِ الأسد ولها قرن واحد في وسط هامَتها، قال:
بها الحريشٌ وضِغْزٌ مائِلٌ ضَبِرٌ ... يَأوي إلى رَشَفٍ منها وتقليصِ «2»
والحَرْش: ضَرْبٌ من البَضْع وهي مُسْتَلْقِيةٌ.
باب الحاء والشين والنون معهما ح ش ن، ش ح ن، ش ن ح، ن ش ح، ح ن ش مستعملات
حشن: حَشِنَ السِقاءُ حَشَناً وأَحْشَنتُه أنا: إذا أكثَرْتُ استعماله بحَقْن اللَّبَن ولم يُغْسَل ففَسَدَتْ ريحه.
__________
(1) لم نهتد إلى نسبة الشطر.
(2) رواية البيت في التهذيب:
بها الحريشٌ وضِغْزٌ مائِلٌ ضئز ... يأوي إلى رشح منها وتقليص
واللسان (ضغز) :
ما يني ضئزا.... ... يأوي إلى رشف ...
(3/94)
________________________________________
شحن: شَحَنْتُ السَّفينةَ: مَلأَتها فهي مَشْحُونة. والشَحْناءُ: العَداوة، عَدُوٌّ مُشاحِن: يشحَنُ لك بالعَداوة «1» .
شنح: الشَناحيٌّ: نَعْتٌ للجَمَل في تَمام خَلْقه: قال «2» :
أعَدُّوا كلَّ يَعْمَلَةٍ ذَمُولٍ ... وأعْيَسَ بازلٍ قَطمٍ شَناحي
نشح: نَشَحَ الشاربُ: أي شَرِبَ حتّى امتَلأ، ويقالُ للَّذي يشرَبُ قليلاً قليلاً، قال: «3»
وقد نَشَحْنَ فلا رِيٌّ ولا هِيمُ
وسقاءٌ نَشّاح، أي: نَضّاح.
حنش: الحَنَشُ: من الحَرابيِّ وسَوامِّ أبرص ونحوه، تشبه رءوسه رءوس الحَيّات، وجمعُه أحناش، قال الشماخ:
تَرَى قِطَعاً من الأحناش فيه ... جَماجِمُهُن كالخَشَل النَزيعِ «4»
يَصفِها في الوَكْر.
__________
(1) في الأصول المخطوطة بعد كلمة (بالعداوة) : عبارة: والشيحان: الطويل لم نثبتها هنا، لأنها من معتل الحاء وسنثبتها في موضعها.
(2) كذا في التهذيب واللسان في الأصول المخطوطة: شناح. ولم نهتد إلى نسبة الشاهد.
(3) هو (ذو الرمة) . وصدر البيت:
فانصاعت الحقب لم تقصع صرائرها
انظر اللسان والديوان 1/ 453.
(4) البيت في التهذيب (حنش) واللسان (حنش وخشل) .
(3/95)
________________________________________
قال زائدة: الخشْل ما يُكْسَر من الحُلِيِّ، ونَزيعٌ ومَنْزُوع واحد.
باب الحاء والشين والفاء معهما ح ش ف، ش ح ف، ح ف ش، مستعملات
حشف: الحَشَفُ: ما لم يُنْوِ «1» من التَمْر، فإذا يَبِسَ صَلُبَ وفَسَدَ، لا طَعْمَ له ولا حَلاوة «2» . وقد أحشَفَ ضَرْعُ الناقة: إذا يَبِسَ وتَقَبَّضَ. والحَشيفُ: الثَوْبُ الخَلَق. والحَشَفةُ: ما فَوقَ الخِتان. والحَشَفُ: الضَرْعُ اليابسُ، قال طرفة:
فطَوراً به خَلْفَ الزَميل وتارةً ... على حَشَف كالشَّنِّ ذاوٍ مُجَدَّدِ «3»
فحش: الفُحْشُ: مَعرُوف، والفَحْشاءُ: اسمٌ للفاحِشة. وأفحَشَ في القَوْل والعَمَل وكلِّ أمر: لم يُوافقِ الحَقَّ فهو فاحِشةٌ. وقوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ*
«4» ، يَعني خُروجَها من بَيْتها بغير إِذْنِ زوجها المُطَلِّقها.
حفش: الحِفْش: ما كانَ من الآنِية مِمّا يكون أوعية في البَيت للطِيب ونَحوهِ، وقَواريرُ الطيب أحفاش. والسَّيْل يحفِش الماءَ حَفْشاً من كُلِّ جانب إلى مُستَنْقِعٍ واحدٍ فتلك المسايلُ التي [تَنَصبُّ «5» ] إلى المسيل الأعظَمِ من الحوافِش، الواحدة حافِشة، قال:
__________
(1) في (ط) : ينق وهو تصحيف.
(2) زاد في التهذيب واللسان: ولا لحاء. وهو كلام (الليث) .
(3) البيت من مطولة (طرفة) ديوانه/ 13.
(4) سورة النساء 19
(5) كذا في التهذيب من كلام (الليث) ، وفي الأصول المخطوطة: التي تنسب إلى المسايل
(3/96)
________________________________________
عَشيَّةَ رُحْنا وراحُوا إلينا ... كما مَلأَ الحافِشات المَسيلا «1»
وقال مرار بن منقذ:
يَرجِعُ الشَدُّ على الشَدِّ كما ... حفش الوابل غيث مُسْبَكِرّ «2»
وحَفَش: أي طَرَدَ فأسرَعَ، يصف الفَرَس. والحِفْشُ: البيتُ الصَغير أيضاً. والحَفْش: الجَريُ. وهُم يحفِشُون عليك ويجلُبون: أي يجتمعُون. والفَرَسُ يحفِشُ الجَرْيَ: أي يُعقِبُ جَرْياً بعدَ جَرْي فلا يزدادُ إلا جَودة.
باب الحاء والشين والباء معهما ح ش ب، ش ح ب، ح ب ش، ش ب ح، مستعملات
حشب: الحَوْشَبُ: عظمٌ في باطِن الحافِر بينَ العَصَب والوَظيف. والحَوْشَبُ: العظيم البطن، قال الأعلم الهذلي:
وتجُرُّ مُجرِيةٌ لها ... لَحمي إلى أجرٍ حَواشِبْ «3»
وقال العَجّاج في الوَظيف:
في رُسُغٍ لا يَتَشَكَّى الحَوْشَبا «4»
الحَوْشَب: من أسماء الرجال.
__________
(1) البيت في اللسان (حفش) غير منسوب أيضا.
(2) لم نهتد إلى البيت في المظان التي بين أيدينا.
(3) كذا في التهذيب وديوان الهذليين 2/ 80، وفي الأصول المخطوطة:
وتجر أجريه لها ... تحمي إلى أجر حواشب
(4) كذا في التهذيب، وفي الأصول المخطوطة: حوشبا وليس الرجز في ديوان العجاج (ط بيروت) .
(3/97)
________________________________________
شحب: شَحَبَ يَشحَبُ شُحوباً: أي تَغَيَّر من سَفَرٍ أو هُزال أو عَمَل، قال:
فإنّ كِرامَ الناس بادٍ شُحُوبُها «1»
حبش: الحَبَشُ: جنْس من السُودان، وهم الحبشان والحبش، و [في] لغة يقولون: الحَبَشِة على بناء سَفَرة، وهذا خطأ في القياس لأنّك لا تقول حابش كما تقول: فاسق وفَسَقة، ولكنّه سارَ في اللَّغات وهو في اضطِرار الشعر جائز. والأُحُبوش كالحَبَش، قال: «2»
كأنَّ صِيران المَهَا الأخلاطِ ... بالرَّمْل أُحبُوشٌ من الأنباطِ
وأما الأحابيش فكانوا أحياءَ من القارَة انضَمُّوا إلى بني ليث في الحَرْب التي وقَعَت بينهم وبينَ قُرَيش قبلَ الإسلام فيها يقول إبليس لقريش: إني جارٌ لكم من بني كبْت فواقِعوا محمداً، أتاهم في صورة سُراقة بن مالك بن جَعْثم، وذلك حيث يقول الشاعر:
لَيْثٌ ودِيِلٌ وكعبٌ والتي ظَأَرَتْ ... جُمْعَ الأحابيشِ لمّا احمَرَّتِ الحَدَقُ
سُمُّوا بذلك لتَجَمُّعِهم فلمّا صارَ لهم ذلك الاسمُ صارَ التَحبيش في الكلام كالتجميع، قال رؤبة «3» :
أولاك حَبَّشتُ لهم تجبيشي ... فَرضي وما جَمَّعْت من خُروشي
والحُبْشّيُة: ضَرْبٌ من النَّمْل سُودٌ عِظامٌ، لمّا جَعَلوا ذلك اسماً غيَّروا اللفظ
__________
(1) سقطت (فإن) من (ط) . ولم نهتد إلى القائل ولا إلى تمام البيت.
(2) هو (العجاج) كما في التهذيب واللسان والديوان ص 247.
(3) القائل هو (رؤبة) كما في التهذيب واللسان، أما في الأصول المخطوطة فهو (العجاج) . والرجز في ديوان رؤبة ص 78 وروايته:
أولاك حفشت لهم تحفيشي
(3/98)
________________________________________
ليكونَ فَرقاً بين النسبةِ والاسمِ. النِسبةُ: حبَشيَّة، والاسم: حبُشْيّة. وعلى هذا أيضاً الحُبْشيّة: ناقةٌ شديدة السَواد.
شبح: الشَبَحُ: ما بَدا لكَ شَخصُه من الخلق، يقال: شَبَحَ لنا أي مَثَلَ، وجمعهُ: أشباح، قال:
رمقت بعيني كل شبح وحائِلِ «1»
وقال:
كأنَّما الرَحْلُ منها فوقَ ذي جُدَدٍ ... ذبِّ الريادِ إلى الأشباح نَظّارِ «2»
أي كثير الرِياد وهو الاقبال والادِبار في الرَعْيِ. ويقال في التصريف أسماءُ الأشباح وهو ما [أدرَكَتْهُ] «3» الرُؤيةُ والحِسُّ، وأسماء الأعمال: ما لا تدركه الرؤيةُ ولا الحِس. والشَبْحُ: مَدُّك الشَيءَ بينَ أوتاد ليَجِفَّ. والمضُروبُ يُشّبُح إذا مُدَّ للجَلْد. ورجُلٌ مَشبُوح الذِراعَيْن: أي طويلُهما، قال أبو ذؤيب:
فذلك مَشبُوحُ الذراعَيْن خَلْجَمٌ ... خَشُوفٌ إذا ما الحَرْبُ طالَ مِرارُها «4»
باب الحاء والشين والميم معهما ح ش م، ش ح م، ح م ش، م ح ش مستعملات
حشم: الحَشَمُ: خَدَمُ الرجل ومَن دونَ أهلِه من وَلَدِه وعِياله. والحِشمةُ: الانقباض عن أخيك في المَطْعَم وطَلَب الحاجة، تقول: احتَشَمْتُ، وما الذي
__________
(1) في التهذيب 4/ 191 واللسان (شج) .
(2) (النابغة) ديوانه/ 236. وفيه: (الزياد) بالزاي وهو تصحيف. واللسان (ذبب) .
(3) مما نقل في التهذيب 4/ 192 عن العين في الأصول: أدركت.
(4) البيت في شرح أشعار الهذليين 1/ 82) .
(3/99)
________________________________________
حَشَمَكَ وأحشَمَكَ أيضاً. والحُشُومُ: الإِقبال بعدَ الهُزال، حَشَمَ يحشِمُ، ورجلٌ حاشِم، وقد حَشَمتِ الدَّوابُّ في أوَّل الربيع وذلك إذا أصابت شيئاً فحَسُنَتْ بطُونُها وعَظُمَت.
شحم: رجلٌ شاحِمٌ لاحم: إذا أطعَمَ الناسَ الشَّحْمَ واللحم. وقد شَحَمَهُم يَشْحَمُهُم شَحْماً. وشَحْمةُ الرُمّانة: هَنَةٌ في جَوْفها تَفْصِلُ بين حَبّها، وإذا غَلُظَت قلتَ رُمّانة شَحِمةٌ. وعَنِبٌ شَحِمٌ: قليلُ الماء صُلْبُ اللِّحاء. وشَحْمةُ الأُذن: لَحْمةُ مُتَعَلَّق القُرْطِ من أسفَلَ.
حمش: الحَمْشُ: الدَّقيقُ القوائِمِ. وساقٌ حَمْشةٌ، جزم، وتجمَع [على] : حُمْش وحِماش، قال الطرماح يصف الدِيَكةَ:
حِماشُ الشَّوَى يَصْدَحْنَ من كُلِّ مَصْدَح «1» .
أيْ: من كل وجه. والاستِحماش في الوَتَر أحسَنُ، يقال: أوتارٌ حَمْشةٌ، ووَتَرٌ حَمْشٌ: مُسَتْحِمش، قال: «2»
كأنَّما ضُرِبَت قُدّامَ أعيُنِها ... قُطْنٌ بِمُسْتَحِمشِ الأوتارِ مَحْلُوجُ
واستَحْمَشَ الرجُلُ: اشتَدَّ غضَبُه.
محش: المَحْشُ: تناولٌ من لَهَبٍْ يُحرِق الجلدَ ويُبدي العظمَ، يقال محشته النار محشا.
__________
(1) وصدر البيت في الديوان ص 99:
إذا صاح لم يخذل وجاوب صوته
،
(2) البيت (لذي الرمة) . انظر الديوان 2/ 995. والرواية فيه: عهنا بمستحصد.
(3/100)
________________________________________
باب الحاء والضاد والدال معهما د ح ض مستعمل فقط
دحض: الدَّحْضُ: الزَلَقُ، يقال: مَزْلَقَةٌ مِدحاضٌ. والدَّحْضُ: الماءُ الذي تكون منه المزْلَقَةُ. ودَحَضَتِ الشَمس عن بطن السَماءِ، أي: زالت. ودَحَضَت حُجَّتُه: أي: بَطَلَتْ. ودُحَيْضة: موضع، قال: «1»
َأَتْنَسْيَن أيّاماً لنا بدُحَيْضةٍ ... وأيّامَنا بينَ البَديِّ فَثَهْمَدِ
البدي: بئر لحمى ضرية لبني جعفر بن كلاب. ودَحَضَتْ رِجْلُ البعير: زَلَقَت.
باب الحاء والضاء والظاء معهما ح ض ظ مستعمل فقط
حضظ: الحُضَظ لغة في الحُضَض: [دواءٌ يتخذ من أبوال الإبل] «2» .
باب الحاء والضاد والراء معهما ح ض ر، ر ح ض، ح ر ض، ض ر ح، ر ض ح مستعملات
حضر: الحَضَرُ: خلافُ البَدْو، والحاضِرة خلاف البادية لأن أهل الحاضرة
__________
(1) هو (الأعشى) ، ديوانه/ 189، وانظر اللسان (دحض) .
(2) من مختصر العين (ورقة 65) ، وجاء في التهذيب من كلام الليث: الحُضَظ لغة في الحُضَض وهو دواء يتخذ من أبوال الإبل.
(3/101)
________________________________________
حَضَروا الأمصارَ والديار. والباديةُ يُشبِهُ أنْ يكونَ اشتِقاق اسمه من: بدا يبدو أى بَرَزَ وظَهَرَ، ولكنّه اسم لزم ذلك الموضع خاصَّةً دونَ ما سِواه، [والحَضْرَةُ: قرب الشَّيء] «1» . تقول: كنت بحَضرةِ الدار، قال:
فشَلَّتْ يَداهُ يومَ يحمِلُ رأسَه «2» ... إلى نَهشَل «3» والقَومُ حَضرةَ نَهْشَلِ
وضَرَبُته بحَضْرَة فلانٍ، وبمَحْضَره أحسَنُ في هذا. والحاضِرُ: هُمُ الحَيُّ إذا حَضَروا الدارَ التي بها مُجتَمَعهُم فصارَ الحاضر اسماً جامعاً كالحاجِّ والسامِرِ ونحوِهما، قال:
في حاضِرٍ لَجِبٍ باللَّيْلِ سامرُه ... فيه الصواهل والرايات والعَكَرُ «4»
والحُضْر والحِضار: من عَدْوِ الدابَّة، والفعل: الإحضار. وفَرَسٌ مِحضير بمعنى مِحضار غيرَ أنّه لا يقالُ إلا بالياء وهو من نَوادر كلام العرب، قال امرؤ القيس:
استلحم الوحش على أحشائها ... أهوَجُ مِحضيرٌ إذا النقْعُ دَخَنْ «5»
والحضيرُ: ما اجتَمَعَ من [جائية] «6» المِدَّةِ «7» في الجُرْح، وما اجتَمَعَ من السُّخد في السَّلا ونحوه. والمُحاضرةُ: أنْ يُحاضِرَك إنسان بحَقّكَ فيذهَب به مُغالَبةً ومُكابَرةٌ. والحِضار: اسم جامع للإبِلِ البِيض كالهِجان، الواحدةُ والجميع في الحضار سَواءٌ. وتقول: حَضارِ. أي: احضَرْ مثلُ نَزالِ بمعنَى انزل. وتقول: حضرت
__________
(1) من التهذيب 4/ 200 عن العين.
(2) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب وفي اللسان: راية.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي (ط) : فشل.
(4) البيت في التهذيب واللسان فيما نقله صاحب التهذيب عن (الليث) .
(5) ليس البيت في الديوان ولكنه غير منسوب في اللسان والتاج (دخن) .
(6) من المحكم 3/ 87 والجائية: الغليظة، وفي التهذيب 4/ 200: جايئة. وفي الأصول المخطوطة: جانبه.
(7) في اللسان المادة.
(3/102)
________________________________________
الصَّلاةُ، لغة أهل المدينة، بمعنى حَضَرت، وكلهم يقولون: تَحضُر. وحَضارِ: اسم كوكب معروف، مجرورٌ أبداً. وحَضْرَمَوْت: اسمان جُعِلا اسماً واحداً ثم سُمِّيَت به تلك الَبْلَدة، ونظيرهُ: أحمرجون «1» .
رحض: ثَوبٌ رَحيضٌ ومَرْحُوضٌ: أي: مَغسُول. والرحْضُ: الغَسْل.
وقالتْ عائشة في عُثمانَ: استَتابوه حتى إذا تَرَكوه كالثَوْبِ الرَّحيض أحالوا عليه فقَتَلُوه «2» .
والمِرْحَضةُ: شيءٌ يُتَوَضَّأ فيه مثل كنيف وكذلك المِرحاضُ وهو المُغَتسَل. والرُحَضاء: عَرَق الحُمَّى، رُحِض الرجُلُ أخَذَتْهُ الرُحَضاءُ.
حرض: التَحريضٌ: التَحضيضُ. والحُرضُ، (مثقل) ، الأشْنان، والمِحْرَضةُ: وِعاؤه. وقوله تعالى: حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً «3» أي مُحْرَضاً يُذيبك الهَمُّ، وهو المُشرِف حتى يكاد يَهلِك. رجلٌ حَرَضٌ ورجالٌ أحراض. والحَرَضُ: الذي لا خير فيه لؤماً ودقّةً من كلّ شيءٍ. [والفِعل منه «4» : حَرُضَ يحرُضُ حُروضاً. وناقةٌ حَرَضٌ وإبِلٌ أحراض: وهو الضاوي الرديءُ.
ضرح: الضَرْحُ: حَفرُكَ الضَريحَ للميِّت وهو قَبْرٌ بلا لَحْدٍ، ضَرَّحْتُ له. والضَرْحُ: الرَمْيُ بالشيْءِ. واضطَرُحوا فلاناً: إذا رَمَوا به، والعامَّةُ تقول: اطَّرَحُوه، يظُنُّونَ أنَّه من الطَرْح وإنّما هو من الضَرْح، قال:
ضرحاً بصليات النُسور نحتبي «5»
__________
(1) لم نجده في المظان التي بين أيدينا.
(2) التهذيب 4/ 203.
(3) سورة يوسف 85
(4) من اللسان (حرض) ، لتوضيح العبارة.
(5) كذا في الأصول المخطوطة، ولم نهتد إلى هذا الرجز ولم نتبينه.
(3/103)
________________________________________
ويقال: الضَرْحُ الرُمْح. والضرُّاح بيت في السَّماء. والمَضْرَحيُّ من الصِقُوُر: ما طالَ جناحاه، قال طرفة:
كأنَّ جَناحَي مَضْرحَيٍّ تَكَنَّفا «1»
ويقال للرجل السيد السَريِّ: مَضْرَحيّ. ويقال المَضْرَحّي. ويقال المَضْرَحِيُّ: الأبيضُ من كلّ شَيءٍ.
رضح: الرَضْحُ: رَضْحُك النَّوَي بالمِرْضاح أي: بالحَجَر، والخاء لغة قليلة.
باب الحاء والضاد واللام معهما ض ح ل، ح ض ل يستعملان فقط
ضحل: الضَّحْل: الماءُ القريبُ القَعْر. والضَّحْضاحُ: أعَمُّ منه قلَّ أو كثر. وأتان الضحل: الصَّخْرة بعضُها غامِرٌ وبعضُها ظاهر. والمَضْحَل: مكان يقِلُّ فيه الماء من الضَّحْل، وبه يُشَبَّه السَّراب، قال: «2»
حسِبتُ يَوماً غيرَ قَرٍّ شاملاً ... يَنسُجُ غُدراناً على مَضاحِلاً
حضل: حَضِلَتِ النخْلةُ: أي فَسَدَ أصولُ سعفها، و [حظلت] «3» أيضاً. وصَلاحُها: إشعالُ نارٍ فيها حتّى يحترقَ ما فَسَدَ من ليفها وسَعَفها ثم تجود بعد ذلك.
__________
(1) وعجز البيت كما في التهذيب واللسان والديوان:
حفافية شكا في العسيب بمسرد
(2) هو (رؤبة بن العجاج) . انظر الديوان ص 121 ونسب غلطا إلى (العجاج) في اللسان.
(3) كذا في التهذيب 4/ 209 واللسان (حضل) ، وفي الأصول المخطوطة: حضلت.
(3/104)
________________________________________
باب الحاء والضاد والنون معهما ح ض ن، ن ض ح، ن ح ض، ض ح ن مستعملات
حضن: الحِضْن: ما دونَ الإبْط إلى الكَشْح، ومنه احتضانك الشَيءَ وهو احتمالُكَهُ وحَمْلكَهُ في حضنِك كما تَحْتَضِنُ المرأة ولدها فتحمله في أحد شِقَّيْها. والمُحْتَضَنُ: الحِضْن، قال: «1»
هَضيمُ الحَشَا شَخْتَةُ المُحتَضَنْ «2»
والحَضانةُ: مصدر الحاضِنة والحاضِن وهما اللذان يُربِّيان الصَبيِّ. وناحِيَتا المَفازةِ: حِضناها، قال:
أجَزْتُ حِضْنَيه هِبَلاًّ وعثا «3»
وعَنْزٌ حَضون: أَيْ أحَد طُبْيَيْها أطوَلُ. والحَمامةُ تَحتضِنُ بَيْضَها حُضُوناً للتفريخ فهي حاضِنٌ. وسُقْعٌ حَواضِنُ: أي جَواثِمُ، قال النابغة:
رَمادٌ مَحَتْة الريحُ من كُلِّ وِجْهةٍ ... وسُفْعٌ على ما بَيْنَهُنَّ حَواضِنُ «4»
أي أثافيُّ [جَواثم] على الرَماد. وحَضَنْتْ الرجل عن الشيء: اختَزَلتُه ومَنَعْتُه، قال ابن مسعُود: لا تُحضَنُ زَيْنَبُ امرأةُ عبدِ الله «5» أي لا تُحجَب عنه ولا يُقْطَعُ أمرٌ دونها. وفُلانٌ احتَجَنَ بأمرٍ دُوني وأحضَنني: أي أخَرجَني منه في ناحيةٍ. وقالت الأنصار لأبي بَكْر: تُريدونَ أن تَحضُنونا «6» من هذا الأمر.
__________
(1) هو (الأعشى) كما في التهذيب واللسان والديوان ص 17.
(2) وصدر البيت:
عريضة بوص إذا أدبرت.
(3) ورواية الرجز في المحكم 3/ 91، واللسان:
أجزت حضنيها هبلا وغما
. وروايته في التهذيب 4/ 209
أَجَزْتُ حِضْنَيْهِ هِبَلاً وَغْبا.
(4) لم نجد البيت في ديوان الشاعر في مختلف طبعاته المتيسرة. وهو في التهذيب 4/ 210، واللسان (حصنن) منسوب إلى (النابغة) أيضا.
(5) الفائق 1/ 291. وفي التهذيب 4/ 210: ولاتحضن زينب امرأته عن ذلك.
(6) كذا في التهذيب 4/ 210، وفي (س) أيضا. وفي ط: تحضونها، وفي (ص) : تحضوننا.
(3/105)
________________________________________
والمِحْضَنة: المعمُولةُ من الطيِن للحمامة كالقصعة الرَّوْحاء. والمَحاضِن: المَواضِع التي تحضُنُ فيها الحمامة على بَيْضها، واحدُها مَحضَن. والأعنُز الحَضَينات: ضَربٌ منها شَديَدة الحُمْرة، وأسوَدُ منها شَديدُ السَواد. والحَضَن: جَبَل، قال الأعشى:
كخلْقاء من هَضبَات الحَضَنْ «1»
نضح: النضح: كالنضح رُبَّما اختَلَفا ورُبَّما اتَّفَقا. ويقال: النَّضخ ما بَقِيَ له أَثَرَ، يقال: على ثَوبه نَضْخُ دَمٍ. والعَيْن تَنْضَح بالماء نَضْحاً: أي تفور [وتنضخ] أيضاً. والرجُلُ يعتَرفُ بأمرٍ فيَنْتَضِحُ منه: إذا أظهَرَ البَراءةَ وبَرَّاً نفسَه منه جُهْدَه. والنَضيحُ من الحِياض: ما قرُبُ من البِئر حتّى يكونَ الافِراغ فيه من الدَلْوِ ويكونَ عظيماً، قال: «2»
فغَدَونا علَيهِمُ بُكرةَ الورد ... كما تورِدُ النَضيحَ الهِياما
والناضِحُ: جَمَلٌ يُسْتَقَى عليه الماء للقِرَى في الحَوض، أو سِقيْ أرضٍ وجَمعُه النَواضِح. والفَرَس يَنْضَحُ: أي يعْرَقُ، قال: «3»
كأنَّ عِطْفَيْه من التَنْضاحِ ... بالماء ثوباً مُنْهِلٍ مَيّاحِ
أي مُستَقٍ بيَده. والجَرَّة تنضَحُ بالماء: يخرُج الماء من الخَزَف لرِقَّتِها. والجَبَل يَنْضَحُ: إذا تَحَلَّبَ الماءُ من بين صُخُوره. ويقال في القتال: نضحوهم
__________
(1) البيت في الديوان (الصبح المنير) ص 16 وروايته:
وطال السنام على جبلة ... كخلقاء من هضبات الضحن
وفي حاشية صفحة الديوان: وروى غيره الحضن (بفتحتين) والحضن (بضم ففتح) . وقال (أبو عبيدة) : من هضبات الضحن. وفي الديوان (ط مصر) ص 19 ولكن الرواية فيه: من هضبات الدجن.
(2) هو (الأعشى) . انظر التهذيب واللسان والديوان ص 249، وفيه: بكر الورد
(3) هو (العجاج) . والرجز في الديوان ص 442.
(3/106)
________________________________________
بالنُّشّاب ورَضِّحوهم بالحِجارة. واستَنْضَحَ الرجلُ: أي رَشَّ شيئاً من الماء على فَرْجه بعد الوضوء. وإذا ابتَدَأَ الدقيق في حَبِّ السُنْبُل وهو رَطْبٌ قيلَ: قد أنْضَحَ ونَضَحَ «1» ، لغتان. والنَّضُوحُ: الطِيبُ.
نحض: النَحْضُ: اللَّحْم نفسُه، والقطعةُ الضَخْمةُ تُسَمَّى نَحْضَة. ورجُلٌ نَحيضٌ، وامرأةٌ نَحيضةٌ: كثيرة اللَّحْم. وقد نَحُضَ نَحاضةً، فإذا قُلتَ: نُحِضَتْ فقد ذَهَبَ لحمُها فهي مَنحُوضةٌ ونَحيضٌ. ونحضتُ السِنان رَقَّقْتُه، قال حميد:
كَمَوقِف الأشقَرِ إنْ تَقَدَّما ... باشَرَ مَنحُوضَ السِنانِ لَهْذَما
والموتُ من وَرائه ان أحجَما «2»
ضحن: الضَّحَنُ: اسم بَلَد.
باب الحاء والضاد والفاء معهما ف ض ح، ح ف ض يستعملان فقط
فضح: والاسم: الفضيحة: ويجمَع الفضائح. والفَضْح فِعلٌ مُجاوز من الفاضِح إلى المفضُوح، قال في الفضائح:
قَومٌ إذا ما رَهِبوا الفضائحا ... على النساء لبسوا الصفائحا «3»
__________
(1) في (ط) : أنضح (وأنطح) وهو تصحيف.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي هذه المصادر كلها ورد اسم الراجز حميد، ونرجح أن يكون حميد الأرقط لا حميد بن ثور الهلالي، لأن الأول راجز معروف والثاني شاعر لم يشتهر بالرجز.
(3) الرجز في التهذيب 4/ 215 نقلا عن العين، ثم في اللسان (فضح) .
(3/107)
________________________________________
وقال الأعشى:
لأَمُكُّ َبالهِجاء أحَقُّ مِنّا ... لِما أَوْلتْكَ من شَوط الفِضاح «1»
الشَوط: المُجازاة. يقال للمُفتَضِح: يا فَضُوح. وأفضَحَ البُسْرُ: إذا بَدَتْ فيه الحُمرة. والفُضْحةُ: غبرة في طُحْلة «2» يُخالِطُها لونٌ قَبيحٌ يكونُ في ألوان الإبِل والحمام، والنَعْتُ أفضَحُ. قد فَضِحَ فَضَحاً.
حفض: الحَفَض: القَعود نفسُه بما عليه، ويقال: بل الحَفَضُ كلُّ جُوالَقٍ فيه مَتاع القَوم ويُحْتَجُّ بقوله: «3»
على الأحفاضِ نَمنَعُ من يَلينا
ويقال: الأحفاضُ في هذا البَيت صِغارُ الإبِل أوَّلَ ما تُرْكَبُ، وكانوا يُكِنُّونها في البيت من البَرْد، قال:
بملقى بُيُوتٍ عُطِّلَتْ بحِفاضِها ... وإنَّ سَوادَ اللَّيل شُدَّ على مُهْر «4»
ويقال: الأحفاض عند الأخبية. ومَثَلٌ من الأمثال: يَومٌ بيوم الحفض المجور «5» .
__________
(1) ورواية البيت في الديوان ص 345.
لأَمُكُّ َبالهِجاء أحَقُّ مِنّا ... لما أبلتك من شوط الفضاح
في (س) : لأنك وهو تصحيف.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: ظلمة.
(3) هو (عمرو بن كلثوم) ، وصدر البيت:
ونحن إذا عماد البيت خرت
انظر اللسان والمعلقات ص 125
(4) لم نهتد إلى الشاهد.
(5) كذا في التهذيب واللسان (حفض) ، وفي (ط) : المجود. والمثل في مجمع الأمثال 2/ 310 وفيه: وأصل المثل كما ذكره أبو حاتم في كتاب الإبل أن رجلا كان له عم قد كبر وشاخ، وكان ابن أخيه لا يزال يدخل بيت ابن عمه ويطرح متاعه بعضه على بعض، فلما كبر أدركه بنو أخ أو بنو أخوات له، فكانوا يفعلون به ما كان يفعله بعمه. فقال: يوم بيوم الحفض المجور. أي هذا بما فعلت أنا بعمي فذهبت مثلا.
(3/108)
________________________________________
باب الحاء والضاد والباء معهما ح ض ب، ض ب ح، ح ب ض، ب ح ض، مستعملات
حضب: الحَضَب والحصب واحد، وقرىء: حَضَبُ جَهَنَّم، قال الأعشى:
فلا تَكُ في حَرْبِنا مِحْضَباً ... لتجعَلَ قَومَك شَتَّى شُعوبا «1»
أيْ موقِداً.
ضبح: ضَبَحْتُ العُودَ بالنار: إذا أحرقت من أعاليه شيئاً، وكذلك حِجارة القَدّاحة إذا طَلَعَتْ كأنَّها محترقة: مَضبُوحة، قال طرفة:
واصفَرَ مَضبْوُحٍ نَظَرتُ حوارهَ ... إلى النارِ واستَوْدَعتُه كفَّ مُجْمِدِ «2»
أي بَخيلُ يُريدُ المَضْبُوحَ بالنار. يقال: كلُّ شيءٍ مَسَّتْه النارُ فقد ضَبَحَتْه. والضبُّاح: صَوْتُ الثَعلَب. والهامُ يَضْبَحُ، قال الشاعر:
من ضابح الهامِ وبُومٍ نُوَّمٍ «3»
الأُرجوزة للعَجّاج، وقال ذو الرمة:
سَباريت يخلُو سَمْعُ مُجتاز رَكْبها «4» ... من الصَوتٍ إلاّ من ضباح الثعالب
__________
(1) البيت في اللسان (شعب) ، وفي ملحقات الديوان (ط أوروبا) ص 236 (عن التهذيب) .
(2) لم نجد البيت في ديوان طرفة. وهو في اللسان (ضج) غير منسوب.
(3) الرجز في التهذيب واللسان وروايته فيهما:
من ضابح الهامِ وبُومٍ بوام
(كذا) . ولا يستقيم الرجز. ولم نجد الرجز في ديوان العجاج (ط. دمشق) ولكن محقق التهذيب أشار إلى ملحقات الديوان (ط. مصر) فذكر أنه في الصفحة 87 وروايته: توأم بدل بوام
(4) في الديوان ص 58: مجتاز خرقها. وفي ص و (س) : يحلو. وهو تصحيف.
(3/109)
________________________________________
والخَيْلُ تَضْبَحُ في عَدوِها ضَبْحاً: تسمَعُ من أفواهِها صوتاً ليس بصهيل ولا حَمْحَمة.
حبض: حَبَضَ القلبُ يَحبِضُ حَبْضاً: أي ضَرَباناً شديداً. والعِرقَ يَحبِض ثم يسكُن، وهو أشَدُّ من النَبْض. والوَتَر يَحبِض إذا مَدَدَتَه ثم أرسَلْتَه. وحَبِضَ السُهْمُ: إذا لم يَقَعْ بالرَّميَّة وقصّرَ دونَها فوَقَعَ وَقْعاً [غَيْرَ شديدٍ «1» ] ، قال الراجز:
والنَبْلُ يَهوي خَطَأً وَحَبْضا
ويقال: أصابَ القومَ داهِيةٌ من حَبْض الدَّهْرِ: أي من ضَرَباته. ويقال: حَبْضُ الدهر وحَبَضُه أي حركاته. والحَبْض والنَبْض: الحركة، يقال: ما يَحبِض ولا ينبِض.
باب الحاء والضاد والميم معهما ح م ض، م ح ض، م ض ح مستعملات
حمض: الحَمْضُ: كلُّ نَباتٍ يبقى على القَيْظ فلا يَهيجُ في الربيع، وفيه مُلُوحة، تشربُ الإبِلُ الماءَ على أكلِه، وإذا لم تجدْه دَقَّتْ «2» وضَعُفَت. حَمَضَتْ تَحْمُضُ حُمُوضاً: إذا رَعَتْها، وهي حَوامِضُ، وأحْمَضناها، قال: «3»
قريبة ندوته من محمضه
__________
(1) من التهذيب 4/ 221 في الأصول: وقعا شديدا يؤيده أن النساخ ذكروا أن في نسخة الزوزني: إذا وقع بالدمية وَقْعاً غَيْرَ شديدٍ. قال الأزهري في التهذيب: فأما ما قاله (الليث إن الحابض الذي يقع بالرمية وقعا غير شديدفليس بصواب.
إن الحابض الذي يقع بالرمية وقعا غير شديدفليس بصواب.
(2) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب واللسان: رقت.
(3) هو (هميان بن قحافة) كما في اللسان.
(3/110)
________________________________________
وقد يُسَمَّى كلُّ ما فيه مُلُوحة حُمْضاً. ويقال للشيء الحامض: حَمَضَ حُموضةً، إلاّ أنَّهم يقولون للَّبَن خاصةً حَمَضُ حَمْضاً، وهو شديد الحَمْض. واللَّحمُ حَمْضُ الرِجال، وإذا حَوِّلت رجلاً عن أمرٍ فقد أحمَضْتَه، قال الطرماح:
لا يَني يُحمِضُ العَدُوُّ وذُو الخُلَّةِ ... يُشْفَى صداه بالإحماضِ «1»
والحَمْضة: الشَّهْوةُ للشَيء: وحَمضةُ اسم حَيِّ بلعاء بن قيس الليَّثيّ. والحُمّاض: بَقْلةٌ من ذُكُور البَقل لها زَهْرةٌ حَمراء، قال: «2»
كثَمَر الحُمّاضِ من هَفَت العَلَقْ
ويقال للذَّي يكونُ في جَوف الأُتْرُجِّ: حُمّاضة ويجمع الحُمّاض: قال «3» :
كأنَّما في فيه حُمّاضٌ نَزا
محض: المَحْضُ: اللَّبَنُ الخالصُ بلا رَغوة. وكلُّ شيءٍ خَلَصَ حتّى لا يشُوبُه شَيءٌ فهو مَحْضٌ. ورجلٌ مَمْحُوض الضَريبةِ: أي مخلص. وفضة مَحْضَة: لا شَوبَ فيها، فإذا قلت هذه الفضةُ محضاً جَعَلْتَ المحض [نصباً] اعتِماداً على المصدر أي قصداً له. ورجل عَرَبيُّ مَحْضٌ، وامرأةٌ مَحْضةٌ ومَحْضٌ.
مضح: مَضَحَ الرجلُ عِرْضَ فُلانٍ: «4» إذا شأنَه وعابَه، قال «5» .
لا تَمْضَحنْ عِرْضي فإنّي ماضِحُ ... عِرضَكَ إنْ شاتمتني وقادح
__________
(1) البيت في الديوان (ط. مصر) ص 87 واللسان (حمض) .
(2) هو (رؤبة بن العجاج) . انظر التهذيب والديوان ص 108 ورواية الرجز في اللسان:
كتامر الحُمّاضِ من هَفَت العَلَقْ.
(3) لم نهتد إلى الراجز.
(4) وزاد في التهذيب من كلام الليث: وأمضحه.
(5) في التهذيب 4/ 226 غير منسوب أيضا.
(3/111)
________________________________________
باب الحاء والصاد والدال معهما ح ص د، ص د ح يستعملان فقط
حصد: الحَصْد: جَزُّ البُرِّ ونحوه. وقَتْلُ الناس أيضاً حَصْدٌ. وقول الله تعالى: جَعَلْناهُمْ حَصِيداً
«1» أي كالحَصيد المَحصُود. والحَصيدةُ: المَزْرَعة إذا حُصِدَت كُلُّها. والجميع الحَصائد، قال الأعشى:
قالوا البقيَّةَ والهِنْديٌّ يحصُدُهُمْ ... ولا بقيَّة إلاّ الثَأرُ «2» فانكَشَفُوا
نَصَبَ البقيّةَ بفِعْل مُضمَر أي ألقَوا. وقوله تعالى: وَحَبَّ الْحَصِيدِ
«3» أي وحَبّ البُرِّ المَحصُود. وأحصَدَ البُرُّ: إذا أَنَى حَصاده أي: حانَ وقتُ جَزازه. والحِصَاد: اسمُ البُرِّ المحصود وبعد ما يُحصَد، قال ذو الرمة:
عليهن رفضا من حصاد القُلاقِلِ «4»
وقوله تعالى: يَوْمَ حَصادِهِ
وحِصاده، يُريدُ: الوَقْتَ للجزاز. والأحصَدُ: المِحْصَد: [وهو المُحْكِم فتله] «5» وصنعته من حَبل ودِرع ونحوه. ويقال للخَلْقِ الشَديد أَحصَدُ فهو مُحصَد ومُستَحصِد، وَتَرٌ أحصَدُ، قال: «6» .
من نزع أحصد مُسْتَأرِبِ
أي مُحكَم الأَرْب ومثله مُؤَرَّب الخَلْق أي مُحكَمُة، ومُستَأْرِب مُستَفْعِل، والدِرعُ الحصداء: المحكمة.
__________
(1) سورة يونس الآية 24.
(2) كذا في الأصول والتهذيب واللسان، وفي الديوان ص 311: إلا النار.
(3) سورة ق من الآية 9.
(4) وصدر البيت:
إلى مُقْعَداتٍ تَطْرَحُ الرّيح بالضحى
. انظر التهذيب واللسان والديوان ص 498.
(5) من التهذيب 4/ 228 عن العين أما الأصول فالعبارة فيها منقوصة قاصرة.
(6) في التهذيب 4/ 228. واللسان (حصد) : (قال الجعدي) .
(3/112)
________________________________________
صدح: الصَّدْح: من شدَّة صَوت الديك والغُراب ونحوهما، قال أبو النجم يصف الحمار:
مُحَشْرِجاً ومرةً صَدُوحا
والصادحةُ: المُغَنِيَّةُ. وصَيْدَح: اسمُ ناقَةِ ذي الرُمَّة، لا ينصَرِفُ، ولو كانَ اسماً عاملا لانصرف، قال:
فقلت لصَيْدَحَ انتَجِعي بِلالا «1»
باب الحاء والصاد والراء معهما ح ص ر، ص ح ر، ص ر ح، ح ر ص، مستعملات فقط
حصر: حَصِرَ حَصَراً: أي عَيَّ فلم يَقْدِر على الكلام. وحصر صدر المرء: أي ضاق عن أمرٍ حَصَراً. والحُصْرُ: اعتِقالُ البَطْن حُصِرَ، وبه حُصْرٌ، وهو مَحْصُور. والحِصار: مَوضع يُحْصَر فيه المَرءُ، حَصَروه حَصْراً، وحاصَرُوه، قال رؤبة:
مِدْحةَ مَحْصُورٍ تَشَكَّى الحَصْرا ... دَجْرانَ لم يشرب هناك الخمرا «2»
دَجران: أيْ سَكران: والإحصارُ: أن يَحصُرَ الحاجَّ عن بُلوغ المنَاسِك مَرَضٌ أو عَدُوٌّ. والحَصُور: مَن لا إربةَ له في النِساء. والحَصُور كالهَيُوب المُحجِم عن الشيء، قال الأخطل:
__________
(1) وصدر البيت:
سمعت الناس ينتجعون غيثا
انظر الديوان ص 442
(2) الرجز في ملحق الديوان ص 174 وروايته وتمامه:
مِدْحةَ مَحْصُورٍ تَشَكَّى الحَصْرا ... رأيته كما رأيت نسرا
كُرِّز يلقي قادمات زعرا ... دجران لم يشرب هناك الخمرا
(3/113)
________________________________________
لا بالحصور ولا فيها بسَوّار «1»
والحَصيرُ: سَفيفةٌ من بَردّي ونحوه. وحَصيرُ الأرض: وجْهُها، وجمعُه حُصُر. والعدد: أحصِرة. والحَصيرُ: فِرِنْد السيَف. والحَصيرُ: الجنب، قال تعالى: وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً «2» أي يُحْصَرون فيها.
صحر: أصحَرَ القَومُ: أي بَرزُوا إلى الصَّحْراء، وهو فَضاءٌ من الأرض واسِعٌ لا يُواريهم شيءٌ، والجمع الصَّحَارَى ولا يُجمَع على الصُّحْر لأنّه ليسَ بنَعْتٍ. والصَّحَرُ مصدر الأصحَر وهو لَونُ غُبْرةٍ في حُمرة خَفيفة «3» إلى بياض قليل، والجميع الصُّحْر. والصُّحْرةُ: اسم اللَّوْن، يقال حِمارٌ أصحَر، قال ذو الرمة:
صُحْرُ السَرابيلِ في أحشائها فبب «4»
وأصحارّ النَباتُ: أي أخَذَتْ فيه صُفرةٌ غيرُ خالصةٍ ثمَّ يَهيجُ فيَصفَرُّ. وَيقول: أبرز له ما في نفسه صَحاراً: أي جاهَرَه به جِهاراً. والصَحيرُ: النَهيقُ الشديد، صَحَر يَصحَرُ صحيرا، أي: نَهَق.
صرح: الصَرْح: بَيْت منُفَرِد يُبنَى ضَخْماً طويلاً في السماء، ويُجمَع الصُرُوح، قال: «5»
__________
(1) وصدر البيت:
وشاربٍ مُرْبحٍ بالكأس نادمَني
انظر الديوان ص 116.
(2) سورة الإسراء الآية 8
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: خفيفة.
(4) وصدر البيت:
تنصبت حوله يوما تراقبه
الديوان 1/ 56 والرواية فيه: صحر سماحج.....
(5) هو (أبو ذؤيب الهذلي) كما في التهذيب واللسان، ورواية البيت فيهما، وفي ديوان الهذليين 1/ 136:
على طرق كنحور الركاب ... تحسب آرامهن الصروحا
(3/114)
________________________________________
بهن نعام بنته الرجال ... تَحسِبُ أعلامَهُنَّ الصُرُوحا
يُريدُ بالنَعام: [خَشَبات] قائماتٍ على أرجاء الآباد. والصَريحُ: اللَّبَن المَحْضُ الخالصُ. ومن كل شيء. ومن البَول: إذا لم يكنْ عليه رَغوة، قال أبو النجم:
يَسُوف من أبوالِها الصَريحا ... حَسْوَ المريضِ الخَرْدَلَ المجْدُوحا «1»
والصَريح من الخَيل والرجال: المَحْض الحَسَب، وجمعه: صُرَحاء، وجمع الخيل: الصَرائح. وصَريح النُصْح: مَحْضُه، قال الشاعر:
أمرتُ أبا ثَورٍ بنُصْحٍ كأنَّما ... يرى بصريح النصح وكع العَقارِبِ «2»
وقول عبيد: «3»
فَتْخاءَ لاحَ لها بالصَرْحةِ الذيبُ
فالصَرْحةُ: موضع، ويقال: مَتْنٌ «4» من الأرض مُسْتَوٍ.
وكُرِّمَ ماءً صريحا
قال زائدة: بالصخرة الذيبُ. وقال في السحاب: «5» أي: خالصاً، كُرِّمَ «6» : كَثُرَ بلغة هُذيل وصَرَّح ما في نفسه تصريحا أي أبداه «7» . وخَمرٌ وكأسٌ صراحية وصراح:
__________
(1) البيت الأول وحده في التهذيب.
(2) لم نهتد إلى نسبة هذا البيت.
(3) هو (عبيد بن حصين الراعي) ، وصدر البيت:
كأنها حين فاض الماء واختلفت
انظر التهذيب 2/ 39 واللسان (صرح)
(4) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: هي.
(5) هو (أبو ذؤيب الهذلي) ، انظر ديوان الهذليين 1/ 131، وتمام البيت وروايته:
وهي خرجه واستجيل الرباب ... منه وغرم ماءصريحا
(6) في الأصول المخطوطة: كزم.
(7) كذا في ط، وفي ص: أنبأه.
(3/115)
________________________________________
أي لم تُشَبْ بمزاج، وصَرَّحَتِ الخمر تصريحاً: ذهب عنها الزَبَد، قال الأعشى:
كُمَيتاً تَكَشَّفُ عن حُمرةٍ ... إذا صَرَّحَتْ بعد إزبادِها
ويقال: جاء بالكُفر صُراحاً: أي جَهِاراً.
حرص: حَرَص يَحرِص حِرْصاً فهو حَريص عليك: أي على نفعك، وقَومٌ حُرَصاءُ وحِراصٌ. والحَرْصة: مستَقَرُّ وَسَط كُلِّ شَيءٍ كالعَرْصة للدار «1» . والحارصةُ: شَجَّةٌ تشُقُّ الجِلْدَ قليلاً كما يحرِصُ القَصّارُ الثوبَ عند الدق، ويقال منه قول الله- عز وجل-: وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ «2» . والمطَرُ يحرِصُ الأرضَ: يخرِقها.
باب الحاء والصاد واللام معهما ح ص ل، ص ل ح، ل ح ص، ص ح ل مستعملات
حصل: حَصَلَ يحصُل حُصُولاً: أي بَقِيَ وثَبَتَ وذَهَبَ ما سِواهُ من حِسابٍ أو عَمَلٍ ونحوه فهو حاصل. والتحصيلُ: تَمييز ما يحصل. والاسم: الحصيلة، قال لبيد:
وكل امرىء يَوماً سيَعلَم سَعْيَه ... إذا حُصِّلَتْ عند الإِله الحصائل «3»
ويُرَوى: إذا كُشِّفَت عند الإِله. وحَوْصَلةُ الطائر: معرُوف. والحَوْصلةُ: طَيْرٌ أعظَمُ من طير الماء طويل العنق، بَحْريَّةٌ جُلُودُها بيضٌ تُلْبَسُ،
__________
(1) وعلق الأزهري في التهذيب 4/ 240 وقال: لم أسمع حرصة بمعنى العرصة لغير الليث.
(2) سورة يوسف من الآية 103.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الديوان ص 257:
إذا كُشِّفَت عند الإِله المحاصل
(3/116)
________________________________________
ويُجمَع حَواصِل. والحَوْصَلُ: الشاةُ التي عَظُمَ ما فَوقَ سُرَّتِها من بَطْنها. ويقال: احوَنْصَلَ الطَيْرُ: إذا ثَنَى عُنَقَه وأخرَجَ [حوصلته] «1» .
صحل: الصحلّ: صَوْتٌ فيه بُحَّة، صَحِل صوتُه فهو أصحَلُ الصَوْت «2»
صلح: الصَلاحُ: نقيض الطلاح «3» . ورجل صالح في نفسه ومُصلِحٌ في أعماله وأمُوره. والصُّلْحُ: تصالُحُ القوم بينهم. وأصلَحْتُ إلى الدابَّة: أحْسَنْتُ إليها. والصِّلْحُ: نهر بمَيْسان.
لحص: اللَّحْصُ والتَلحيصُ: استقصاء خَبَر الشيء وبيانه، لَحَصَ لي فلان خَبَرك وأمْرَكَ أي بَيَّنَه شَيئاً شَيئاً. وقال «4» في بعض الوصف: أَمْرُ مَناقِع النّزّ ومواقع الرّزّ، حبُّها لا يُجَزُّ، وقصبها يهتزّ، وكتَبْتَ كتابي هذا وقد حَصَّلتُه ولحَّصتْهُ وفَصَّلُته ووَصَّلْتُه وترّصته «6» وفَصَّصْته مُحَصَّلاً مُلَحَّصاً مُفَصَّلاً مُوَصَّلاً مُتَرَّصاً مُفصّصا، وبعض يقول ملخصا بالخاء.
__________
(1) من مختصر العين (ورقة 67) ، وفي التهذيب 4/ 241 عن العين: وأخرج حوصلته. في الأصول المخطوطة: (صلبه) وفيه بتر وتصحيف.
(2) وصحل مثل فرح.
(3) في التهذيب من كلام (الليث) : نقيض الفساد.
(4) عبارة التهذيب عن (الليث) : وكتب بعض الفصحاء إلى بعض إخوانه كتابا في بعض الوصف فقال:
(6) وجاء النص في الأصول كثير التصحيف. (مناقح) بالقاف، في (ط) : منافع بالفاء (والنز) في (ط) : النبز، و (الرز) : الوز. و (ترصته) : في (س) : قرطسته. و (مترصا) من (س) : مقرطسا
(3/117)
________________________________________
باب الحاء والصاد والنون معهما ح ص ن، ص ح ن، ن ص ح، ن ح ص مستعملات
حصن: الحِصْنُ: كل مَوضِع حَصين لا يُوصل إلى ما في جَوفه، يقال: حَصُنَ الموضع حصانةً وحَصَّنْتُه وأحصنَتْهُ. وحِصنٌ حَصين: أي لا يُوصل إلى ما في جَوْفه. والحِصان: الفَرس الفَحْل، وقد تَحصَّن أي تكلف ذلك، ويجمع [على] حُصُن. وامرأةٌ مُحْصَنٌة: أَحصَنَها زَوْجُها. ومُحْصِنةٌ: أحْصَنَتْ زَوْجَها. ويقال: فَرْجَها. وامرأةٌ حاصِنٌ: بَيِّنة الحُصْن والحَصانة أي العَفافة عن الريبة. وامرأة حَصانُ الفَرْج، قال: «1»
وبِيني حَصانَ الفرجَ غيرَ ذَميمةٍ ... ومَوْمُوقةٌ فينا كذاك ووامِقَهْ
وجماعة الحاصن حواصن وحاصنات، قال:
وابناء الحَواصِنِ من نِزارٍ «2»
وقال العجاج:
وحاصِنٍ من حاصناتٍ مُلْسِ «3»
وأحسن ما يجمع عليه الحَصان حَصاناتِ. والمحصن: المكتل «4» . والحصينة: اسم للدِرْع المُحكَمِة النَسْج، قال:
__________
(1) البيت (للأعشى) ، انظر الديوان وفيه: غير ذميمة، وفي (ط) : دميمة.
(2) لم نهتد إلى هذا الشطر وإلى قائله.
(3) وتكملة الرجز كما في التهذيب واللسان والديوان ص 481:
من الأذى ومن قراب الوقس
(4) في اللسان: المكتلة.
(3/118)
________________________________________
وكل دِلاصٍ كالأضاةِ حَصينةٍ «1»
صحن: الصَحْنُ: شبه العُسِّ الضَخْم إلا أنَّ فيه عِرَضاً وقُرْبَ قَعْرٍ. والسائلُ يَتَصَحَّنُ الناس: أي يسأل في قَصْعةٍ ونحوها. والصِّحْناة «2» بوزن فعلاة إذا ذهب عنها الهاء دخلها التنوين، ويجمع على الصِحْنَى بحذف الهاء.
نصح: فلانٌ ناصح الجيب: أي ناصح القَلْب مثل طاهرُ الثياب أي الصدر. ونَصَحْتُه ونَصَحْتُ له نُصحاً ونَصيحةً، قال:
النُصْحُ مجّانٌ فمن شاء قبِل ... ومنْ أبَى لا شكَّ يَخْسَرْ ويَضِلّ «3»
والناصِحُ: الخيّاط، وقميصٌ مَنْصُوحٌ: أي مَخيطٌ. نَصَحتُه أنصَحُه نَصْحاً [منَ النِّصاحة] . والنِّصاحة: السُلُوكُ التي يُخاطُ بها وتصغيرها نصيحة، قال: «4»
وسَلَبْناهُ بُرْدَه المَنْصُوحا
والتنصح: كثرة النصيحة،
قال أكتم بن صيفي: إيّاكمْ وكثْرة التَنَصُّح فإنه يُورِثُ التُهَمَة.
والتَوْبةُ النّصوحُ: أن لا يعُودَ إلى ما تاب عنه. والنِّصاحات: الجُلود، قال الأعشى:
فتَرَى القَومَ نَشاوىَ كلَّهُمْ ... مثلَ ما مُدَّت نِصاحاتُ الرُبَحْ «5»
__________
(1) (الأعشى) ديوانه/ 205 وعجز البيت فيه:
ترى فضلها عن ربها يتذبذب
(2) الصحناة: الصير وهي السمكات المملوحة.
(3) لم نهتد إليه.
(4) لم نهتد إلى القائل.
(5) البيت في الديوان ص 243 وفي التهذيب 4/ 249 واللسان (نصح)
(3/119)
________________________________________
نحص: النَّحُوصُ: الأتانُ الوَحْشَّيُة الحائِل. ونُحْص الجَبَل: أصله.
حنص: الحِنْصَأوة من الرجال: الضئيل الضَعيف، قال:
حتّى تَرَى الحِنْصَأوةَ الفَروقا ... مُتَّكِئاً [يَقْتَمِحُ] «1» السَّويقا
باب الحاء والصاد والفاء معهما ص ح ف، ح ص ف، ف ص ح، ص ف ح، ف ح ص، ح ف ص، كلهن
صحف: الصُّحُفُ: جمع الصَحيفة، يُخَفَّف ويُثّقَّل، مثل سفينة وسُفْنُ، نادِرتان، وقياسُه صَحائف وسَفائن. وصَحيفة الوجه: بشرة جلده، قال:
إذا بَدا من وَجْهِكَ الصَحيفُ «2»
وسُمِّيَ المُصْحَفُ مُصْحَفاً لأنَّه أُصْحِفَ، أي جُعِلَ جامعاً للصُحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْن. والصَّحْفةُ شبه القَصْعة المُسْلَنْطِحة العَريضة وجمعه صِحاف. والصَّحَفِيُّ: المُصَحِّف، وهو الذي يَروي الخَطَأ عن قِراءة الصُّحُف بأشباه الحُروف.
حصف: الحصف: بثر صِغارٌ يَقيحُ ولا يعظُم «3» ، ورُبَّما خَرَجَ في مَراقِّ البطن أيام
__________
(1) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: يقتحم.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: الصحيفة.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: يقيح ولا يقيح ولا يعظم.
(3/120)
________________________________________
الحَرِّ. حَصِفَ جَلْدُه حَصَفاً. والحَصافَةُ: ثخانة العَقل. رجلٌ حَصيفٌ حَصِفٌ، قال
حَديثُكَ في الشِتاءِ حَديثُ صَيْفٍ ... وشَتْويُّ الحديثِ إذا تَصيفُ
فتَخلِطُ فيه من هذا بهذا ... فما أدري أَأَحمَقُ أم حَصيفُ «1»
ويقال: أحصَفَ نَسجَه: أحكمه. وأحصَفَ الفَرَسُ: عَدا عَدْواً شديداً، [ويقال: استَحْصَف القوم واستحصدوا إذا اجتمعوا] . قال الأعشى:
تَأوي طوائفُها إلى مَحْصُوفةٍ ... مَكرُوهةٍ يَخشىَ الكُماةُ نِزالُها «2»
فصح: الفُصِحْ: فِطْر النَصارَى، قال الأعشى:
بهم تَقرَّبَ يومَ الفِصْح ضاحيةً «3»
وتَفصيحُ اللَّبَن: ذَهابُ اللِّبأ عنه وكَثرةُ مَحْضة وذَهابُ رَغْوته، فَصَّحَ اللَّبَنَ تَفصيحاً. ورجلٌ فصيحٌ فَصُحَ فَصاحة، وأفصَحَ الرجلُ القَوْلَ. فلما كَثُرَ وعُرِفَ أضمَروا القَولَ واكتَفَوا بالفِعل كقَولهم: أحسَنَ وأسْرَعَ وأبْطَأَ. ويقال في الشِّعْر في وصف العُجْم: أفصَح وإن كان بغَير العربّية كقول أبي النجم:
أعجَمَ في آذانِها فصيحا «4»
يَعني صوتَ الحمارِ. والفصيحُ في كلام العامة: المعرب.
__________
(1) البيتان في تاج العروس (حصف) غير منسوبين أيضا.
(2) قال الأزهري في التهذيب: أرادبالمحصوفة كتيبة مجموعةو البيت في التهذيب 4/ 252 وفي الديوان ص 33. والرواية فيه: إلى مخضرة.
(3) ديوانه ص 111 وعجز البيت فيه:
يرجو الإله بما سدى وما صنعا
(4) الرجز في التهذيب 4/ 253 واللسان (فصح)
(3/121)
________________________________________
صفح: الصَّفْحُ: الجَنْبُ: من كلِّ شيءٍ. وصَفْحا السَيْف: وَجْههاهُ. وصَفْحةُ الرجلِ: عُرْضُ صَدره «1» وسَيْفٌ مُصَفَّحٌ [ومُصْفَح] وصَدرٌ مُصْفَحٌ: أي عَريض، قال:
وصَدري مُصْفَحٌ للمَوتِ نَهْدٌ ... إذا ضاقَت عن المَوتِ الصُدُورُ «2»
وقال الأعشى:
أَلَسْنا نحنُ أكرَمَ إن نُسْبنا ... وأضْرَبَ بالمُهَنَّدة الصِّفاحِ «3»
وقال لبيد: «4»
كأنَّ مُصَفَّحاتٍ في ذراه ... وأنواحا عليهن المَآلي
شَبَّهَ السَحَاب وظُلْمَتَه وبَرقَه بسُيُوفٍ مُصَفَّحة، والمَآلي جمع المِئلاة وهي خِرْقةٌ سَوداء بيَد النَوّاحة. وكل حَجَرٍ عَريضٍ أو خَشَبةٍ أو لَوحٍ أو حَديدة أو سَيْفٍ له طُولٌ وعَرْضٌ فهو صَفيحة، وجمعُه صَفائحُ. والصُفّاحُ من الحِجارة خاصةً: ما عَرُضَ وطالَ، الواحدة صفاحة، قال: «5»
ويوقدن بالصُفّاحِ نارَ الحُباحِبِ
وَصَفْحتُ عنه: أي عَفَوتُ عنه. وصَفَحْتُ وَرَقَ المُصْحَف صَفْحاً. وصَفَحْتُ القَومَ: عَرَضْتُهم واحداً واحداً «6» وتَصَفَّحْتُهم: نَظَرتُ في خِلالهم هل أرَى فُلاناً، أو ما حالُهم. وقوله تعالى: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً
«7»
__________
(1) في التهذيب من كلام الليث: وجهه.
(2) البيت في التهذيب 4/ 255، وفي اللسان (صفح) .
(3) البيت في الديوان ص 347 واللسان (صفح) .
(4) أضاف الأزهري في التهذيب قوله: يصف السحاب.
(5) هو (النابغة الذبياني) كما في التهذيب، وصدر البيت كما في الديوان:
تقد السَّلُوقيَّ المضاعفَ نَسجهُ
(6) (واحدا) الثانية ساقطة من (ط)
(7) سورة الزخرف الآية 5.
(3/122)
________________________________________
هو الاِعراض. والصُفّاح من الإبِلِ: التي عَرُضَت أسنامُها «1» ، ويُجمَع صُفّاحات وصَفافيح. والمُصافَحةُ معروفة.
فحص: الفَحْصُ: شِدَّة الطَلَب خِلالَ كُلِّ شيءٍ [تقول] : فحَصْتُ عنه وعن أمره لأَعلَمَ كنْهَ حاله. ومَفْحَصُ القَطا: موضِعٌ تُفرِّخ فيه. والدَجاجَةُ تفحَصُ برَجلَيْها وجَناحَيْها في التُراب: تَتَّخِذُ أُفحُوصةً تَبيضُ أو تربضُ «2» فيها.
وفي الحديث: «3» فَحَصُوا عن أوساط الرءوس
أي عَمِلوها مثلَ أَفاحيص القَطا. والمَطَرُ يَفحَص [الحصَىَ] «4» : يقلِبُه ويُنَحِّي بعضَه عن بعض.
حفص: أمُّ حَفْصة: تُكْنَى به الدَجاجةُ. ووَلَدُ الأَسَد يُسَمَّى [حفصاً] «5» .
باب الحاء والصاد والباء معهما ح ص ب، ص ح ب، ص ب ح، مستعملات
حصب: الحَصْبُ: رَمْيُكَ بالحَصْباء أي صِغار الحَصَى أو كِبارها.
وفي فِتنةِ عُثمان: تَحاصَبُوا حتّى ما أُبصِرَ أديمُ السَماء.
والحَصْبَةُ معروفة تخرُجُ بالجَنْب، حُصِبَ فهو مَحصُوب. والحَصَبُ: الحَطَب للتَنُّور أو في وقود [أما] «6»
__________
(1) في رواية التهذيب 4/ 258 عن العين: التي عظمت أسمتها.
(2) في رواية التهذيب 4/ 259 عن العين أو تجثم
(3) في التهذيب 4/ 259: ومنه اشتق قول أبي بكر.....
(4) كذا في التهذيب واللسان، وفي ص وط وس: القطا.
(5) من مختصر العين (ورقة 97) ، والتهذيب 4/ 259 عن العين. في الأصول المخطوطة: حفصة
(6) زيادة من التهذيب 4/ 260 عن العين، لتقويم العبارة.
(3/123)
________________________________________
ما دام غيرَ مُسَتْعمل للسُجُور فلا يُسَمَّى حصباً. والحاصِب: الريحُ تَحمِلُ التُرابَ وكذلك ما تَناثَر من دِقاق البَرَد والثّلج، قال الأعشى:
لنا حاصِبٌ مثلُ رِجْلِ الدَّبَى ... وجأواءُ تُبرِق عنها الهُيُوبا «1»
يصف جَيشاً جَعَلَه بمنزلةِ الريح الحاصب يُثير الأرض. والمُحَصَّب: موضع الجِمار. والتَحصيبُ: النَّومَ بالشِعْب الذي مَخرَجُه إلى الأبْطَح ساعةً من اللَّيل ثم يُخرَجُ إلى «2» مَكّة.
صحب: الصّاحِبُ: يجمعُ بالصَّحْب، والصُّحبان والصُحْبة والصِحاب. والأَصحابُ: جماعة الصَّحْبِ. والصِّحابة مصدرُ قولِك صاحَبَكَ اللهُ وأَحْسَنَ صِحابتَكَ. ويُقالُ عندَ الوَداع: مُصاحَباً مُعافىً. ويقال: صَحِبَكَ اللهُ [أي: حفظك] ، ولا يُقال: مصحوب. والصّاحبُ يكونُ في حالٍ نعتاً، ولكنَّه عَمَّ في الكلام فجرى مَجرى الاسمِ، كقولك: صاحبُ مال، أي: ذو مالٍ، وصاحبُ زيدٍ، أي: أخو زيدٍ ألا تَرى أنّ الألفَ والّلام لا تدخلانِ، على قياس الضّارب زيداً، لأنّه لم يُشْتَقّ من قولك: صَحِبَ زَيْداً، فإذا أَرَدْتَ ذلك المعنى قُلتَ: هو الصاحب زيداً. وأَصْحَبَ الرجُلُ: إذا كان ذا صاحبٍ. وتقول: إنَّك لَمِصْحابٌ لنا بما تُحِبُّ، قال: «3»
فقد أراك لنا بالوُدِّ مِصْحابا
وكلُّ شَيءٍ لاءَمَ شَيئاً فقد استَصْحَبَه، قال:
إنَّ لك الفضل على صاحبي «4» ... والمسك قد يستصحب الرامكا
__________
(1) في اللسان (حصب) وفي ملحقات الديوان 236
(2) في (ط) : من..
(3) هو (الأعشى) ، وصدر البيت:
إن تصرمي الحبل يا سعدى وتعتزمي
انظر ملحقات الديوان ص 235
(4) في اللسان: على صحبتي.
(3/124)
________________________________________
ويقال: جِلدٌ مُصْحِب: إذا كان عليه شَعْرُه وصُوفه.
صبح: [تقول] : صَبَحنَي فلانٌ: إذا أتاك صبَاحاً. وناوَلكَ الصَبُّوح صباحاً، قال طرفة بن العبد:
متى تَأْتِني أصبحك كأسا روية ... وإن كنتَ عنها ذا غِنىً فاغْنَ وازْدَدِ «1»
وتقول في الحرب: صَبَحناهم. أي غادَيناهم بالخَيْل ونادَوا: يا صَباحاه، إذا استَغاثُوا. ويومُ الصبَّاح: يومُ الغارة، قال الأعشى:
ويمنَعُه يَومَ الصَّباح مَصُونةٌ ... سِراعاً إلى الداعي تَثُوبُ وتُركَبُ «2»
(يَعني أنَّ الخَيْل تَمنَع هذا المصطَبح يَوْمَ الصبَّاح، المصونة: الخيْل، تثوب: ترجع) «3» . وكان ينبغي أن يقول: تُركَبُ وتَثُوب، فاضطُرَّ إلى ما قاله. وهذا مثل قوله تعالى: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ «4» إنَّما معناه: انشَقَّ القَمَرُ واقَتَرَبتِ الساعةُ. وكما قال ابن أحمر:
فاستَعرِفا ثم قُولا في مَقامِكُما ... هذا بَعيرٌ لنا قد قامَ فانعَقَرا «5»
مَعناهُ: قد انعَقَرَ فقامَ. والصَّبْحُ: سَقْيُكَ من أتاكَ صبَوحاً من لَبَنٍ وغيره. والصَّبُوح: ما يُشرَب بالغَداة فما دونَ القائلة، وفِعلك الاصطِباح. والصبَّوَح: الخمرَ، قال الأعشى:
ولقد غَدوتُ على الصَّبُوحِ معي ... شَرْبٌ كِرامٌ من بَني رُهْمِ «6»
__________
(1) البيت في اللسان (صبح) ، وفي معلقة الشاعر المشهورة.
(2) الرواية في الديوان ص 203:
يوم الصباح بالياء.. ... وسراع إلى الداعي تَثُوبُ وتُركَبُ
(3) سقط ما بين القوسين من ط وس.
(4) سورة القمر الآية 1
(5) لم نقف على البيت في المصادر المتيسرة لدينا.
(6) البيت في التهذيب 4/ 264 واللسان (صبح)
(3/125)
________________________________________
واستصبح القوم بالغدوات. والمُصْبَحُ: الموضع الذي يُصبَحُ فيه، قال:
بعيدةُ المُصْبَح من مُمساها «1»
والمِصباحُ: السِراج بالمِسرَجة، والمِصباحُ: نفْسُ السراج وهو قُرْطُه الذي تَراهُ في القِنديل وغيره، والقِراطة «2» لغة. والمِصباح من الإبِل: ما يَبْرُك في مُعَرَّسه فلا ينهضُ وإنْ أُثيرَ حتى يُصبحَ، قال:
أَعْيَس في مَبْرَكهِ مِصباحا «3»
والمَصابيحُ من النُجُوم: أعلامُ الكَواِكب، الواحدُ مِصباح، وقَوْلُ الله- عزَّ وجَلَّ-: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ «4» أي بعدَ طُلُوع الفجر وقبلَ طُلُوع الشمس. وصَبَحْتُ القومَ ماءَ كذا، وصبحتهم أيضا: أتيتهم مع الصَباح، قال:
وصَبَّحْتُهم ماءً بفيفاء قفرة ... وقد حلق النَّجْمُ اليَمانيُّ فاستَوَى «5»
والصُّبْح والصباح: هما أوَّل النَهار. والصَّبَحُ: شِدَّةُ حُمْرةٍ في الشَّعْر، وهو أصْبَحُ. والأَصْبَحيَّةُ والأَصْبَحيُّ: غِلاظ السياط وجيادها، وتقول: أصبَحَ الصبح صَباحاً وصَباحَةً. وصَبُحَ الرجلُ صَباحةً وصُبْحةً، قال ذو الرمة:
وتَجلو بفَرْعٍ من أَراكٍ كأنَّه ... من العَنْبَر الهِنْديِّ والمِسْكُ أصْبَحُ «6»
أراد به أذَكى ريحاً. ونَزَل رجلٌ بقَومٍ فَعَشَّوه فجَعَل يقولُ: إذا كانَ غدٌ وأصَبْتُ من الصَّبُوح مَضَيْتُ في حاجَة كذا (أراد أن يُوجبَ) «7» الصبوح عليهم
__________
(1) البيت في التهذيب 4/ 267 واللسان (صبح) .
(2) في التهذيب: القراط
(3) لم نهتد إلى الراجز.
(4) سورة الحجر من الآية 83.
(5) البيت في التهذيب 4/ 265 واللسان (صبح) من غير عزو.
(6) ورواية البيت في الديوان ص 83:
............... ............ ... من العَنْبَر الهِنْديِّ والمِسْكُ يصبح
(7) ما بين القوسين من (س) . في (ص) و (ط) : فإذا أوجب.
(3/126)
________________________________________
ففَطٍنُوا له فقالوا: أَعَنْ صبَوحٍ تُرَقِّقُ. أي: تُحسِن كلامَكَ فذَهَبَتْ مَثَلاً.
باب الحاء والصاد والميم معهما ح م ص، م ح ص، ص ح م، ص م ح، ح ص م، م ص ح كلهن مستعملات
حمص: الحَمَصيصُ: بَقْلةٌ دونَ الحُمّاض في الحُمُوضة، طَيِّبة الطَّعْم من أحرار البَقْل تنبت في رمل عالج. والحَمْصُ: تَرَجُّح الغُلام على أُرجُوحةٍ من غير أن يُرجَّح، يقال: حَمَصَ. وانحَمَصَ الوَرَمُ: أي سَكَن. وحَمَّصَه الدواء «1» . وحمصتُ القَذاةَ بيَدي: إذا رَفْقتَ بإخراجها من العَيْن مَسْحاً مَسْحاً. حِمْص: كُورةٌ بالشام أهلها يَمانُون. والحِمِصَّ: جمع الحِمِصَّة، وهو حبَّة القِدْر، قال:
ولا تَعْدُوَنَّ سبيلَ الصَّوابِ ... فأرزَنُ من كذِبٍ حمَّصَهْ «2»
محص: المَحْصُ: خُلُوصُ الشَيء، مَحَصْتُه مَحْصاً: خَلَّصْتُه من كلِّ عَيْب، قال:
يَعتادُ كلَّ طِمِرَّةٍ ... مَمْحُوصةٍ ومُقَلَّص «3»
والمحْص: العَدْوُ، يقال: خَرَجَ يَمْحَص كأنَّه ظَبْيٌ. والتَمحيصُ: التَطهيرُ من الذنوب.
__________
(1) جاء في التهذيب: وقال غيره (أي غير (الليث) حمزة وحمصه إذا أخرج ما فيه.
(2) لم نهتد إلى القائل.
(3) لم نهتد إلى القائل.
(3/127)
________________________________________
صحم: الصُحْمةُ: لَون من الغُبرة إلى سَوادٍ قليل. واصحامَّتِ البقلةُ فهي مُصحامَّةٌ: إذا أخَذَتْ ريَّها واشتدَّتْ خُضرتُها. والصَحْماءُ: اسمُ بَقْلةٍ ليسَتْ بشديدة الخُضرة. وبَلْدةٌ صَحْماءُ: ذاتُ اغبِرار، قال الطرماح:
وصَحْماءَ مَغْبَرِّ الحَزابي كأنَّها «1»
مصح: مَصَحَ الشَيءُ «2» يمصَحُ مُصُوحاً: إذا رسَخَ، من الثَرَى وغيره. والدارُ تمصَحُ: أي تَدْرُسُ فتذهَبُ، قال الطرماح:
قِفا نَسْأَلِ الدِّمَن الماصِحَهْ «3»
وقال:
عَبْلُ الشَّوَى ماصِحةٌ أشاعُرهْ «4»
أيْ رسَخَتْ أصُولُ الأشاعِر حتى أُمِنَتْ الانتِتافَ والانحِصاصَ.
صمح: صَمَحَه الصَيْفُ: أي: كادَ يُذيب دِماغَه من شِدَّة الحَرِّ «5» . قال أبو زبيد الطائي: «6»
__________
(1) وفي التهذيب 4/ 273 واللسان (صحم) : قول (الطرماح) يصف فلاة:
وصحماء أشباه الحزابي ما يرى ... بها سارب غير القطا المتراطن
والبيت في الديوان/ 487 وقد نسب في الأصول المخطوطة خطأ إلى (ذي الرمة) .
(2) في التهذيب 4/ 275 وهو كلام الليث: مصح الندى يمصَحُ مُصُوحاً إذا رسَخَ في الثرى.
(3) وعجز البيت كما في التهذيب والديوان ص 67:
وهل هي إن سئلت بائحه
(4) لم نهتد إلى القائل.
(5) جاء في (س) بعد كلمة (الحر) : (هذا في نسخة الزوزني، وفي نسخة الحاتمي: لا يقال: صمحه الصيف، لأنه خطأ) حذفنا هذه العبارة من الأصل لأنها ليست منه.
(6) في الأصول المخطوطة: أبو زيد، والبيت في اللسان (صمح) .
(3/128)
________________________________________
من سُمُومٍ كأنَّها لَفْحُ نارٍ ... صَمَحتْها ظَهيرةٌ غَرّاء
وقال ذو الرمة:
إذا صَمَحتْنا الشَمسُ كان مَقيلُنا ... سَماوَةَ بَيْتٍ لم يُرَوَّقْ له سِتْرُ «1»
وفي حديث مَقتَل حجر بن عَدِيّ عن أبي عُبَيد في ذِكْر سُمَيَّةَ أُمِّ زِيادٍ: إنَّها لَوطْباءُ «2» شدَيدة الصِماح تُحبُّ النِكاح
أيْ شديدة الحرِّ. ورجلٌ صَمَحْمَحٌ وصَمَحْمَحيٌّ: أي مُجْتَمِعٌ ذو ألواحٍ، وفي السِنِّ: ما بين الثَلاثينَ إلى الأربَعينَ.
حصم: حَصَمَ الفرس وخَبَجَ الحمار: إذا ضَرَط. والحَصُومُ: الضَرُوط.
باب الحاء والسين والطاء معهما س ط ح، س ح ط يستعملان فقط
سطح: السَطْحُ: البَسْطُ، يقالُ في الحَرْب سَطَحُوهم أي أَضْجَعُوهم على الأرض. والسَطيحُ: المَسْطُوح، وهو القَتيل، قال:
حتّى تَراه وَسْطَنا سطيحا «3»
وسَطيح: اسمُ رجلٍ من بني ذِئبٍ في الجاهليّة الجَهْلاء، كان يَتَكَهَّنُ، سُمِّيَ سطيحا لأنه لم يكن بين مفاصِلِه قَصَب يَعمِدُه، كانّ لا يقدِرُ على قُعُوٍد ولا
__________
(1) البيت في الديوان 1/ 591.
(2) الوطباء: العظيمة الثدي. في ص: رطباء وهو تصحيف.
(3) رواية الرجز في التهذيب 4/ 276: حتى تراه وسطها سطيحا وفي اللسان (سطح) : حتى يراه وجهها سطحيا،
(3/129)
________________________________________
قيام، وكان مسطحاً على ألأرض وفيه يقول الأعشى:
ما نَظَرتْ ذاتُ أشفارٍ كنَظْرتها ... يَوماً كما صَدَقَ الذِئبيُّ إذ سجعا «1»
والسَطْح: ظَهْر البَيْت إذا كان مُستَوياً، والفِعلُ التَسَطيح «2» . والمِسْطَح: شِبْهُ مِطهَرةٍ ليسَتْ بمُرَبَّعة. والمِسْطَحةُ: الكُوزُ ذو الجَنْب الواحد يُتَّخَذُ للأسفار، قال «3» :
فلم يُلْهِنا استِنْجاءُ وَطْبٍ ومسطح
. الاستنجاء: التشمم هاهنا. والمِسْطَح: عُودٌ من عِيدان الخِباء والفُسْطاط ونحوه، قال مالك بن عوف النضري: «4»
تعرض ضيطار وخزاعة دونَنا ... وما خَيْرُ ضَيْطارٍ يُقَلَّبُ مِسْطَحاً
سحط: سَحَطْتُ الشاةَ سَحْطاً، وهو ذَبْحٌ وحِيٌّ.
باب الحاء والسين والدال معهما ح س د، س د ح، ح د س، د ح س مستعملات
حسد: الحَسَدُ: معروف، والفعل: حَسَدَ يَحْسُد حَسَداً، ويقال: فلانٌ يُحْسَدُ على كذا فهو محسود.
__________
(1) البيت في الديوان ص 103 وروايته:
............... ......... ... حقا كما صَدَقَ الذِئبيُّ إذ سجعا
(2) في التهذيب من كلام الليث: والسطح ظهر البيت.....، وفعلكه التسطيح.
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول
(4) في اللسان وقال مالك بن عوف النضري. وهذا من حواشي ابن بري. وفي التهذيب: عوف بن مالك النضري كذلك. في الأصول المخطوطة. النصراني.
(3/130)
________________________________________
سدح: السَّدْحُ: ذبحُكَ الحيوانَ وبَسْطُكَهُ على وجه الأرض، ويكونُ إضجاعك الشّيءَ على الأرضِ سَدْحاً، نحو القِرْبة المملوءة المسدوحة إلى جَنْبك. قال أبو النجم: «1»
يأخذ فيه الحيّةَ النَّبوحا ... ثمَّ يَبيتُ عنده مَذْبوحا
مُشَدَّخَ، الهامةِ أو مَسْدوحا
حدس: الحَدْسُ: التَّوهّمُ في معاني الكلام والأمور. تقول: بَلَغني عنه أمرٌ فأنا أَحْدِسُ فيه، أي: أقول فيه بالظَّنّ. والحَدْسُ: سُرْعةٌ في السَّيْر، ومُضِيُّ على طريقةٍ مُسْتمرّة. قال «2» :
كأَنَّها من بَعْدِ سيرٍ حَدْسِ
وحُدَسُ: حيٌّ من اليَمَن بالشّام. والعربُ تختلف في زَجْرِ البَغْل، فيقول: عَدَس، وبعض يقول: حَدَس، والحاءُ أصوبُ. ويقال: إنّ حَدَساً قومٌ كانوا بَغّالينَ على عهد سُلَيْمانَ بن داودَ عليهما السّلام، وكانوا يَعْنُفُون على البغال، فإذا ذُكِروا نفرتِ البغالُ خوفاً مما كانت تَلْقَى منهم.
دحس: الدَّحْسُ: التَّدْسيسُ للأمْرِ تَسْتبطِنُه وتَطْلُبُهُ أَخْفَى ما تَقْدِر عليه، ولذلك سميت دودة تحت التراب دحّاسة. وهي صَفْراء صُلْبة داهية، لها رأس مشعب
__________
(1) التهذيب 4/ 281. اللسان (سدح) ، غير منسوب.
(2) التهذيب 4/ 282. اللسان (حدس) غير منسوب.
(3/131)
________________________________________
يَشُدُّه الصّبيان في الفخاخِ لصَيْد العصافير، لا تؤذي. قال: [في الدّحس بمعنى] «1» الاستيطان: «2»
ويَعْتِلونَ مَنْ مَأَى في الدَّحْسِ
من مأى: أي: من نمَّ. والمَأْيُ النّميمة. مَأَتُّ بين القوم: نَمَمْتُ.
باب الحاء والسين والتاء معهما س ح ت يستعمل فقط
سحت: السُّحْتُ: كلُّ حرامٍ قبيح الذِّكْر يلزَمُ منه العارُ- نحو ثمن الكلب والخمرِ والخنزيرِ. وأَسْحَتَ الرّجلُ: وقع فيه. والسُّحْتُ: جَهْدُ العذاب. وسحتناهم- وأسحتنا بهم لغة- أي: بلغنا مجهودهم في المشقّة عليهم. [قال] الله عز وجل: فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ «3» . قال الفرزدق: «4»
وعَضّ زَمانٌ يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مُسْحَتٌ أو مُجَلَّفُ
أي: مُقَشَّر، ورجل مَسْحوتُ الجوف، أي: لا يَشْبَع. قال: «5»
يُدْفَعُ عنه جَوْفُهُ المَسْحُوتُ
أي: سَحَتَ جَوْفَهُ، فَنَحَّى جوانبَهُ عن أذَى يونس عليه السلام.
__________
(1) من التهذيب 4/ 284 في روايته عن العين.
(2) (العجاج) . ديوانه ص 482. في النسخ: (يقبلون) مكان (يعتلون) .
(3) طه 61.
(4) نزهة الألباء. ص 20 (أبو الفضل) . وليس في ديوانه (صادر) .
(5) (رؤبة) ديوانه ص 27.
(3/132)
________________________________________
باب الحاء والسين والراء معهما ح س ر، س ح ر، س ر ح، ر س ح مستعملات
حسر: الحَسْر: كَشْطُكَ الشَيْءَ عن الشيءِ. (يقال) : «1» حَسَرَ عن ذراعَيْه، وحَسَرَ البيضةَ عن رأسه، (وحَسَرَت الريحُ السَحابَ حَسْراً) «2» . وانحسَرَ الشيءُ إذا طاوَعَ. ويجيء في الشعر حَسَرَ لازماً مثل انحَسَرَ. والحَسْر والحُسُور: الإِعياء، (تقول) «3» : حَسَرَتِ الدابّة وحَسَرَها بُعْدُ السير فهي حسير ومحسورة «4» وهُنَّ حَسْرَى، قال الأعشى:
فالخَيْلُ شُعْثٌ ما تزال جيِادُها ... حَسْرَى تُغادرُ بالطريق سِخالَها «5»
وحَسِرَتِ العَيْن أيْ: كَلَّتْ، وحَسَرَها بُعْدُ الشيء الذي حَدَّقَتْ نحوه «6» ، قال: «7»
يَحْسُرُ طرف عينه فضاؤه
__________
(1) ما بين القوسين من التهذيب 4/ 286 مما نسبه الأزهري إلى الليث.
(2) ما بين القوسين من التهذيب 4/ 286 مما نسبه الأزهري إلى الليث.
(3) ما بين القوسين من التهذيب أيضا.
(4) هذا ما نرى وهو الصحيح، وفي الأصول المخطوطة: فهو حسير محسور.
(5) ورواية البيت في كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير ص 26:
بالخيل شعثا ما تزال جيادها ... رجعا تغادر بالطريق سخالها
(6) جاء في المحكم 3/ 130: وحسرت العين: كلت، وحسرها بعد ما حدقت إليه، أو خفاؤه. ونقل ابن منظور هذا في اللسان (حسر) .
(7) القائل (رؤبة) والرجز في التهذيب واللسان والديوان ص 3.
(3/133)
________________________________________
وحَسِرَ حَسْرةً وحسراً أي نَدِمَ على أمْرِ فاته، قال مرار بن منقذ: «1»
ما أنا اليومَ على شَيْءٍ خَلا ... يا ابنَهَ القَيْنِ تَوَلَّى بِحسِرْ
أي بنادم. ويقال: حَسِرَ البحرُ عن القرار «2» وعن السَّاحل اذا نضب عنه الماء ولا يُقال: انحسَرَ. وانحَسَرَ الطيْرُ: خَرَجَ من الريش العتيق إلى الحديث، وحَسَّرَها إبّان التحسير: ثَقَّله لأنّه فُعِلَ في مُهلةٍ وشَيء بعد شيء. والجارية تَنْحسِر «3» إذا صار لحمُها في مَواضعه. ورجل حاسر: خلاف الدارع، قال الأعشى:
وفَيْلَقٍ شهباءَ مَلمومةٍ ... تقذِفُ بالدارع والحاسر «4»
وامرأةٌ حاسِرٌ: حَسَرَتْ عنها درعَها. والحَسار: ضرب من النبات يُسلِحّ «5» الإبلِ. ورجل مُحَسَّر أيْ مُحَقَّر مؤذىً. ويقال: يخرج في آخر الزمان رجلٌ أصحابُه مُحَسَّرون أي مُقْصَونَ عن أبواب السُلطان ومجالس الملوك يأتونه من كل أوب كأنهم قزع الخريف يورثهم
__________
(1) هو (المرار بن منقذ العدوي) من شعراء الدولة الأموية. انظر الشعر والشعراء ص 586، وشرح المفضليات لابن الأنباري. والبيت في التهذيب واللسان.
(2) كذا في الأصول المخطوطة، وفي اللسان: العراق. نقول: وهو الصحيح. ولم ترد كلمة العراق في التهذيب.
(3) في التهذيب: والجارية تتحسر.
(4) ورواية البيت في الصبح المنير ص 108:
يجمع خضراء لها سورة ... تعصف بالدارع والحاسر
(5) في (س) : يسلح بلا تشديد.
(3/134)
________________________________________
الله مشارق الأرض ومغاربها.
سحر: السِّحْر: كلُّ ما كان من الشيطان فيه مَعُونة «1» . والسِّحْر: الُأْخَذُة التي تأخُذُ العين. والسِّحْر: البَيان في الفطنة. والسَحْرُ: فعل السِحْرِ. والسَّحّارة: شيءٌ يلعَبُ به الصبيان إذا مُدَّ خَرَجَ على لونٍ، وإذا مُدَّ من جانبٍ آخَرَ خرج على لون آخر مخالف (للأوّل) «2» ، وما أَشْبَهَها فهو سَحّارة. والسَّحْر: الغَذْوُ، كقول امرىء القيس:
ونُسْحَرُ بالطعامِ وبالشَرابِ «3»
وقال لبيدُ بنُ ربيعةَ العامريّ:
فإن تسألينا: فيم نحن فإنّنا ... عصافير من هذا الأنام المُسَحَّرِ «4»
وقول الله- عزَّ وجلَّ-: إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ*
«5» ، أيْ من المخلوقين. وفي تمييز العربية: هو المخلوق الذي يُطعَم ويُسقَى. والسَّحَرُ: آخِرُ الليل وتقول: لقيته سَحَراً وسَحَرَ، بلا تنوين، تجعله اسماً مقصوداً إليه، ولقِيتُه بالسَّحَر الأعلى، ولقيتُه سُحْرةَ وسُحْرةً بالتنوين، ولقيتُه بأعلى سَحَريْن، ويقال: بأعلى السَّحَرَيْن، وقول العجاج:
__________
(1) وعبارة التهذيب فيما نسب إلى الليث: عمل يقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه.
(2) زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(3) وصدر البيت كما في الديوان ص 47 (ط. السندوبي) :
أرانا موضعين لأمر غيب
(4) البيت في التهذيب واللسان والديوان ص 56.
(5) سورة الشعراء الآية 153.
(3/135)
________________________________________
غدا بأعلى سحر و [أجرسا] «1»
هو خَطَأ، كان ينبغي أن يقول: بأعلَى سَحَرَيْنِ لأنَّه أوّلُ تنفُّس الصبح ثمّ الصبح، كما قال الراجز:
مَرَّتْ بأعلى سَحَرَيْنِ تَدْأَلُ «2»
أي تُسرع، وتقول: سَحَريَّ هذه الليلة، ويقال: سَحَريَّةَ هذه الليلة، قال:
في ليلةٍ لا نَحْسَ في ... سَحَريِّها وعِشائِها «3»
وتقول: أسْحَرْنا كما تقول: أصْبَحْنا. وتَسَحَّرْنا: أكَلْنا سَحوراً على فَعولُ وُضِعَ اسماً لِما يُؤكَل في ذلك الوقت. والإسحارَّة: بَقْلة يَسْمَنُ عليها المالُ. والسَّحْر والسُّحْر: الرئة في البطن بما اشتَمَلتْ، وما تَعَلَّق بالحُلقوم، وإذا نَزَتْ بالرجل البِطْنة يقال: انتفخ سَحْرُه إذا عَدا طَوْرَه وجاوَزَ قَدْرَه، وأكثرُ ما يقال للجبان إذا جَبُنَ عن أمرٍ «4» . والسَّحْرُ: أعلى الصَدر،
ومنه حديث عائشة: تُوّفيَ رسول الله صلى الله عليه و [على] آله وسلم- بينَ سَحْري ونحري [ «5» .
__________
(1) الرجز في التهذيب 4/ 293 واللسان والأصول المخطوطة والرواية في كل ذلك: وأحرسا بالحاء المهملة. والصواب ما جاء في الديوان ص 131 (ط. دمشق) وأجرس أي سمع صوته.
(2) الرجز في التهذيب 4/ 293 واللسان ولم نهتد إلى الراجز.
(3) البيت في التهذيب 4/ 293 واللسان، وجاء في س: في ليلةٍ لا نَحْسَ في سحريها أي صبحها وعشائها. ويبدو أن (عشائها) سقطت في النسخ.
(4) وعقب الأزهري على هذا فقال: هذا خطأإنما يقال: انتفخ سحرة للجبان الذي ملأ الخوف جوفه فانتفخ السحر وهو الرئة حتى رفع القلب إلى الحلقوم ومنه قول الله جل وعز: وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا.
(5) روي الحديث في اللسان: مات رسول الله......
(3/136)
________________________________________
حرس: الحَرْس: وقت من الدهر دون الحُقْبِ، قال: «1»
َأْتَقَنه الكاتبُ واختارَهُ ... من سائر الأمثال في حَرْسِهِ
والحَرَسُ هم الحُرّاس والأحراس، (والفعل) «2» حَرَسَ يَحرُسُ، ويحترس أي: يحتَرِزُ: فعل لازم. والأحرَسُ هو الأصَمُّ من البُنيان.
وفي الحديث: أنّ الحريسةَ السرقة «3» .
وحريسةُ الجَبَل: ما يُسرَق من الراعي في الجبال وأدرَكَها الليل قبل أن يُؤويها المَأْوَى.
سرح: سَرَّحنا الإبِل، وسَرَحَتِ الإبِلُ سَرْحاً. والمَسْرَح: مَرْعَى السَّرْح، والسَّرْح من المال: ما يغُدَى به ويُراح، والجميع: سروح، والسارح اسم للراعي، ويكون اسماً للقوم الذين هم السَّرْح نحو الحاضر والسامر وهم الجميع، قال: «4»
سَواءٌ فلا جَدْبٌ فيُعرَفُ جَدْبُها ... ولا سارحٌ فيها على الرَعْي يَشبَعُ
والسَّرْحُ: شَجَرٌ له حَمْلٌ وهي [الآءُ] «5» ، والواحدة سرحة. والسرح: انفجار البول بعد احتباسه.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2) الزيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(3) يريد أن الكلمة وردت في الحديث وهو: أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة: احترسوا ناقة لرجل فانتحروها التهذيب 4/ 296 واللسان.
(4) لم نهتد إلى القائل.
(5) من اللسان (سرح) . أما في التهذيب فقد ذكر: وهي الألاءة. وفي الأصول المخطوطة: الأواو.
(3/137)
________________________________________
ورجل مُنْسَرِح الثياب أيْ: قليلها خفيف فيها، قال رؤبة:
مُنسَرِحاً إلاّ ذغاليبَ الخِرَقْ «1»
والسَّريحةُ: كل قطعة من خِرْقة مُتَمزِّقة، أو دم سائل مستطيل يابس وما يُشبِهُها، والجميع السَّرائح، قال: «2»
بلَبَّتِهِ سرائحُ كالعَصيمِ
يريد به ضَرْباً من القطران. والسَّريحُ: سَيْرٌ تُشَدُّ به الخَدَمة فوق الرُّسْغ، قال حميد: «3»
.............. ودَعْدَعَتْ ... بأَقْتادِها إلا سَريحاً مُخدَّما
وقولهم: لا يكون هذا في سريح، أيْ في عجلة. وإذا ضاق شَيْء فَفرَّجْتَ عنه، قلتَ: سَرَّحْتُ عنه تَسريحاً فانسرَحَ وهو كتسريحِكَ الشَّعرَ إذا خلَّصت بعضَه عن بعضٍ، قال العجاج:
وسَرَّحَتْ عنه إذا تَحَوَّبا ... رواجِبَ الجَوْفِ الصَّحيلَ الصُّلَّبا «4»
والتَسريح: إرسالُك رسولاً في حاجةٍ سَراحاً. وناقةٌ سُرُحٌ: مُنسَرِحة في سيرها، أي سريعة.
__________
(1) والرجز في الديوان ص 105.
(2) البيت في التهذيب 4/ 299 واللسان (سرح وعصم) منسوب إلى (البيد) ، وصدره: ولم نجده في ديوانه (ط. الكويت) .
(3) هو (حميد بن ثور الهلالي) ، ورواية البيت في ديوانه ص 10:
وخاضت بأيديها النطاف ودَعْدَعَتْ ... بأَقْتادِها إلا سَريحاً مخدما
في الأصول: (ذعذعت) بذال معجمة، و (أفيادها) وهو تصحيف.
(4) لم نجد الرجز في ديوان العجاج ولكننا وجدناه في اللسان وروايته:
............... ... ... رواجب الجوف الصهيل الصلبا
(3/138)
________________________________________
والسِّرْحان: الذئب ويجمع على السَّراح، النون زائدة «1» . والمُنسَرح: ضَرب من الشِعر على [مستفعلن مفعولات مستفعلن] [مرّتين] «2» .
رسح: يقال منه امرأةٌ رَسْحاء [أيْ] لا عَجيزَة لها. قد رَسَحَتْ رَسْحاً. وقد يوصف به الذئب
. باب الحاء والسين واللام معهما ح س ل، س ل ح، س ح ل، ح ل س، ل ح س، ل س ح كلهن مستعملات
حسل: الضَبُّ يُكْنَى أبا حِسْل، والحِسْلُ: ولدُه، ويقال: إنه قاضي الدوابّ والطَّيْر، ويقال: وُصِفَ له آدَمُ وصورتُه- عليه السلام-، فقال الضَّبُّ: وَصَفتُم طَيْراً ينزل الطير من السماء والحوت [في] الماء، فمن كان ذا جَناحٍ فَلْيَطِرْ، ومن كان ذا حافر فليحفر. وجمعة حِسَلةٌ «3» .
سحل: السَّحيل: ثَوْبٌ لا يُبْرَمُ غَزْلُة أي لا يفتل طاقَيْنِ طاقَْين، تقول: سَحَلُوه أي:
__________
(1) وفي التهذيب: الليث: السرحان: الذئب ويجمع على السَّراح. قال الأزهري: ويجمع سراحين وسراحي بغير نون كما قال: ثعالب وثعالي فأما السراح في جمع السرحان فهو مسموع من العرب وليس بقياس.
(2) في الأصول: مستفعلن ست مرات وليس الأمر كذلك. والصواب ما أثبتناه.
(3) وزاد الأزهري في التهذيب: قلت: ويجمع حسول.
(3/139)
________________________________________
لم يَفْتِلوا سَداه «1» ، والجمع السُّحُل، قال «2» :
على كلِّ حالٍ من سَحيلٍ ومُبْرَمِ
والمِسْحَلُ: الحِمارُ الوحشيُّ، والسَّحيل: أشدُّ نهيق الحمار. والسَّحْل: نَحْتُكَ الخَشَبَةَ بالمِسْحَل، أيْ: المِبْرَد، ويقال له ومِبْرَد الخَشَب، إذا شَتَمه. والمِسْحَل: من أسماء الرِّجال الخُطَباء، واللِّسان، قال الأعشى:
وما كنتُ شاحرداً ولكن حَسْبتُني ... إذا مِسْحَلٌ سَدَّى ليَ القَوْلَ أَنطِقُ «3»
ومِسْحَل يقال، اسمُ جِنّيّ الأعشى في هذا البيت، ويُريد بالمِسْحَل المِقْوَل. والريحُ تَسْحَل الأرض سَحْلاً تَكْشِطُ أَدَمَتَها. والسُّحالةُ: ما تحات من الحديد إذا بُرِدَ، ومن الموازين إذا [تَحاتّتْ] «4» ، ومن الذُّرَة والأَرُزِّ إذا دُقَّ شِبْهُ النُّخالة. والسَّحْل: الضرْب بالسياط مما يَكْشِطُ من الجِلد. والمِسَحلان: حَلْقَتان إحداهما مُدْخَلة في الأخرى على طَرَفَي شَكيم الدابّة، وتُجمَع مَساحِل، قال: «5»
__________
(1) وزاد الأزهري: وقال غيره (غير الليث) : السحيل: الغزل الذي لم يبرم، فأما الثوب فإنه لا يسمى سحيلا ولكن يقال للثوب سحل.
(2) القائل هو (زهير بن أبي سلمى) والبيت في مطولته (الديوان ص 14) ، وتمامه:
يمينا لنعم السيدان وجدتما ... على كلِّ حالٍ من سحيل ومبرم
(3) البيت في الصبح المنير ص 148 والديوان (ط مصر) ص 221. وروايته في الأصول المخطوطة: وما كنت شاجردا.... بالجيم.
(4) وعبارة التهذيب: والسُّحالةُ ما تَحاتَّ من الحديد وبرد من الموازين. في س: تحتت، وفي (ط) و (ص) : نحتت ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) القائل (رؤبة) والرجز في ملحقات الديوان ص 180 وروايته
لولا شكيم المسحلين اندقا
وكذلك في التهذيب واللسان.
(3/140)
________________________________________
لولا شَباةُ المِسْحَلَيْنِ اندَقَّاً
وقال: «1»
صُدودَ المَذاكي أفلتتها المساحل
والساحل: شاطىء البحر. والإسْحِل: من شَجَر السِّواك. ومُسْحُلان: اسمُ وادٍ، قال النابغة:
سأربِطُ كلبي أنْ يَريبك نَبْحُهُ ... وإنْ كنتُ أرْعَى مُسْحُلانَ وحامِرا «2»
وشابٌّ مُسْحُلان «3» : طويل حَسَن القامة.
سلح: السَّلْح: السُّلاح، ويقال: هذه الحشيشة تُسَلِّح الإِبِل تسليحاً. والسِّلاح من عِداد الحرب ما كان من حديد، حتى السَّيف وحدَه يُدعَى سِلاحاً، قال:
طَليحَ سِفارٍ كالسِلّاح المُفَرَّد
يعني السيف وحدَه. والسُّلْحة: رُبُّ خاثر يُصَبُّ في النِحْي.
__________
(1) القائل هو (الأعشى) (الصبح المنير ص 187) ، والديوان ص 271. وتمام البيت:
صددت عن الأعداء يوم عباعب ... صدود المذاكي أقرعتها المساحل
(2) والبيت في الديوان (ط أوروبا) ص 82 وروايته:
سأكعم كلبي أنْ يَريبك نَبْحُهُ............... ...........
(3) القائل هو (الأعشى) ، والبيت في الديوان (ط مصر) ص 189، وتمامه:
ثلاثا وشهرا ثم صارت رذية ... طَليحَ سِفارٍ كالسِلّاح المُفَرَّد
وكذلك ورد في التهذيب 4/ 310 واللسان (سلح) من غير عزو.
(3/141)
________________________________________
والمَسْلَحة: قومٌ في عُدَّةٍ قد وُكِّلوا بإزاء ثَغْر، والجميع المَسالِح، والمَسْلَحيٌّ: الواحد المُوَكَّل به. والاِسليح: شجرة تغرُز عليه الإبل. وسَيْلَحِين وسَيْلَحُون ونُصيبِين ونَصيُبون، كذا تُسميه العرب بلغتين.
حلس: الحِلْس: ما وَلِيَ البعير تحت الرحل «1» ، ويقال: فلان من أحلاس الخيل، أي في الفُروسيّة أي كالحِلْس اللازم لظَهْر الفَرَس. والحِلْس للبيت: ما يُبْسَطُ تحت حُرِّ المتاع من مِسْحٍ وغيره. وحَلَسْتُ البعيرَ حَلْساً: غشَّيتُه بحِلْسٍ.
وفي الحديث في الفِتْنة كُنْ حِلْسَ بيتِكَ حتى تأتيك يدٌ خاطية أو مَنِيّةٌ قاضية «2» .
وحَلسَتِ السماءُ: أمطرتْ مطراً رقيقاً دائماً. وعُشّبٌ مُسْتَحِلس: ترى له طرائق بعضها فوق بعض لتراكُمه وسواده. واستَحْلَسَ الليلُ بالظلام، أي: تراكَمَ. واستَحْلَسَ السَّنام إذا رَكِبَتْه رَوادِفُ الشَّحم ورَواكبُه. والحَلِس (بكسر اللام) : [الشجاع الذي يُلازمُ قِرْنَهُ] «3» والحِلْس: أن ياخذ المُصَدِّق مكان الإبل دراهمَ «4» .
__________
(1) وزاد الأزهري في التهذيب فيما نسبه إلى الليث:..... تحت الرحل والقنب، وكذلك حلس الدابة بمنزلة المرشحة تكون تحت اللبد.
(2) وجاءت رواية الحديث في التهذيب واللسان كالآتي:
كن حلسا من أحلاس بيتك في الفتنة......
(3) من التهذيب 4/ 312، لأن الرابع من القداح إنما يسمى حلسا بحاء مكسورة ولام ساكنة.
(4) لم يرد هذا المعنى في غير كتاب العين.
(3/142)
________________________________________
والحِلْسُ: الرّابعُ من القِداح. والمُسْتَحلِس: الذي يلزم المكان.
لحس: اللَّحْسُ: أكل الدَّوابّ «1» الصوف، وأكل الجَراد الخضر والشجر ونحوه. واللاحوس: المشئوم يَلْحَس قومه. واللَّحُوس: الذي يَتَتَبَّع الحلاوة كالذُّباب. والمِلْحَس: الشُّجاع الذي يأكل كل شيء يرتفع إليه.
باب الحاء والسين والنون معهما ح س ن، س ح ن، ن ح س، س ن ح، ن س ح مستعملات
حسن: حَسُنَ الشَيْءُ فهو حَسَن. والمَحْسَن: الموضع الحسن في البدن، وجمعه مَحاسن. وامرأةٌ حَسناء، ورجُل حُسّان، وقد يجيء فُعّال نعتاً، رجلٌ كُرّام، قال الله- جل وعز-: مَكْراً كُبَّاراً «2» . والحسان: الحسن جدا، ولا يقال: رجل أحسنَ. وجارية حُسّانة. والمَحاسِن من الأعمال ضد المساوىء، قال الله- عز وجل-: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ
«3» أي الجنة وهي «4» ضد السوءى.
__________
(1) في التهذيب واللسان: أكل الدود.... نقول: والدابة تشمل الحيوان كافة مما يدب على الأرض، والدود على ذلك مما يدب أيضا.
(2) سورة نوح، الآية 22.
(3) سورة يونس، الآية 26.
(4) في ص وط: هو.
(3/143)
________________________________________
وحَسَن: اسم رَمْلةٍ لبني سعْد «1» . وفي أشعارهم يوم الحَسَن، وكتاب التَّحاسين، وهو الغليظ ونحوه من المصادر، يُجْعَل اسماً ثم يجمع كقولك: تقاضيب الشَّعُر وتكاليف الأشياء.
سحن: السُّحْنة: لينُ البشرة، والناعم له سُحْنة. والمُساحنة: المُلاقاة. والسَّحْن: دَلْكُكَ خشبةً بِمَسْحَنٍ حتى تلين من غير أن يأخذ من الخشبة شيئاً.
نحس: النَّحْس: خلاف السَّعْد، وجمعه النُحوُس، من النجوم وغيرها. يومٌ نَحِسٌ وأيّام نَحِسات، من جعله نعتاً ثَقّله، ومن أضاف اليوم إلى النَحْس خَفَّفَ النَحْس. والنُّحاس: ضربٌ من الصُّفْر شديد الحُمْرة، قال النابغة:
كأنَّ شِواظَهُنَّ بجانِبَيْه ... نُحاسُ الصُّفْر تضربه القُيُون «2»
والنُحاس: الدُّخان الذي لا لهب فيه، قال: «3»
يُضيءُ كضوء سراج السليط ... لم يجعل الله فيه نُحاسا
والنِّحاس: مبلغ طبع وأصله، قال: «4»
__________
(1) في التهذيب: والحسن نقا في ديار بني تميم معروف. نقول: ولم يذكر ياقوت في معجمه
(2) البيت في ديوان النابغة (تحقيق شكري فيصل) ص 262.
(3) قائل البيت هو (الجعدي) كما في اللسان (نحس) .
(4) نسب الرجز خطأ في اللسان إلى (لبيد) والصواب أنه من قول (رؤبة) كما في ملحق مجموع أشعار العرب ص 175، والرواية فيه:
......... ... عني ولما يبلغوا أشطاسي
(3/144)
________________________________________
يا أيها السائل عن نِحاسي ... عَنّي ولمّا تَبلُغَنْ أشطاسي
سنح: سَنَحَ لي طائر وظبيٌ سُنُوحاً، فهو سانح إذا أتاك عن يَميِنكَ، يُتَيَمَّنُ به، قال الشاعر: «1»
أبالسنح الأَيامِنِ أمْ بنَحْسِ ... تمُرُّ به البَوارحُ حينَ تجري
وسَنَحَ لي رَأْيٌ أو قريضٌ أيْ: عَرَض. وكان في الجاهلية امرأةٌ تَقومُ في سوق عكاظ فتُنْشد الأقوالَ وتضرِب الأمثالَ وتُخْجِل الرجالَ، فانْتَدَبَ لها رجلٌ، فقالتْ ما قالتْ، فأجابها فقال:
أسيكتاك جامِحٌ ورامِحٌ ... كالظَّبْيَتَيْنِ سانِحٌ وبارِحٌ «2»
فَخَجِلَتْ وهَرَبَتْ.
نسح: النَّسْحُ والنُّساح: ما تحاتَّ عن التَّمْر من قِشْره، وفُتات أقْماعه ونحوه مما يبقى في أسفل الوعاء. والمِنْساح: شَيْءٌ يُدْفَعُ به التراب ويذرى به.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل، والبيت في اللسان، والتاج (سنح) ، غير منسوب أيضا
(2) الرجز في التهذيب 4/ 321. واللسان (رسخ) ، غير منسوب أيضا. في (ط) : إسكتاك وفي التهذيب 4/ 321 عن العين: وأسكتاك (بفتح الهمزة) وليس بالصواب.
(3/145)
________________________________________
باب الحاء والسين والفاء معهما ح س ف، ح ف س، س ح ف، س ف ح، ف س ح، ف ح س، كلهن «1» مستعملات
حسف: حُسافة التَّمْر: قُشوره ورديئة، (تقول) «2» : حَسَفْتُ التَّمْرَ أحسِفُه حسَفاً: نَقَّيْتُه «3» .
حفس: رجل حِيْفْسٌ، وامرأة حِيَفْساء، والحِيَفْساء إلى القِصَر ولؤم الخِلْقة.
سحف: السَّحْف: كَشْطُكَ الشَّعَر عن الجلد حتى لا يبقى منه شيء تقول: «4» سَحَفتُه سَحْفاً. والسَّحائف، الواحدة سَحيفة: طرائق الشَّحْم التي بين طرائق الطَفاطِف ونحوها ممّا يُرَى من شَحْمة عريضة مُلْزَقة «5» بالجِلْد. وناقة سَحوف: كثيرةُ السَّحائف، وجَمَلٌ سَحوف كذلك، قال: «6»
بجَلْهَة عِلْيانٍ سَحوِف المعقب «7»
__________
(1) رتبنا المواد على النحو الذي أثبتناه وخالفنا ما جاء في الأصول المخطوطة جريا على نظام التقليب المتبع في العين والذي احتذاه الأزهري في التهذيب وابن سيده في المحكم. وقد رتبت المواد في الأصول المخطوطة الثلاث على النحو الآتي: سحف، حسف، سفح، فسح، فحس، حفس.
(2) كذا ورد في س وفي التهذيب فيما نسب إلى الليث، وليس شيء من ذلك في ص وط.
(3) كذا في الأصول المخطوطة، ولكن في التهذيب جاء: نفيته (بالفاء) وهو تصحيف.
(4) كذا في س وفي التهذيب وقد خلا من ذلك كل من ص وط.
(5) كذا في ص وط أما في س والتهذيب ففيهما: ملتزقة.
(6) لم نهتد إلى القائل.
(7) كذا في ص أما في ط وس فقد جاء: جلهة عليان.....
(3/146)
________________________________________
والقطعة منه سَحيفة وتكون سَحْفة. والسُّحاف: السِّلُّ. والسَّحُوف من الغنم: الرقيقة صُوف البطن. والسَّيْحَف: النَّصْل العريض، والجميع: السَّياحف.
سفح: سَفْح الجَبَل: عُرضهُ المُضْطَجع، وجمعه سُفُوح. وسَفَحَتِ العَيْنُ دَمْعَها تَسْفَحُ سَفْحاً. وسَفَحَ الدَّمْعُ يَسفَحُ سَفْحاً وسُفُوحاً وسَفَحاناً، قال الطرماح:
سِوى سَفَحانِ الدمْعِ من كُلِّ [مَسْفَحِ] «1»
وسَفْحُ الدَّمِ كالصَّبِّ. ورجلٌ سَفّاح: سَفّاكٌ للدِماء. والمُسافَحة: الإقامة مع امرأة على فجور من غير تزويج صحيح، ويقال لابن البغي: ابن المُسافحة.
وقال جْبِريل: يا مُحمَّد ما بينك وبين آدَمِ نِكاح لا سِفاحَ فيه.
والسَّفيحان: جُوالِقانِ يُجْعَلانِ كالخُرْج «2» ، قال:
تَنُجو إذا ما اضطَرَبَ السَّفيحانْ ... نَجاءَ هِقْل جافلٍ بفَيْحانْ «3»
__________
(1) من الديوان (ط أوروبا) ص 72 واللسان (سنح) ، أما الأصول فالبيت فيهن:
سِوى سَفَحانِ الدمْعِ من كل مدمع
نقول: والذي نراه أن الخلاف وهم وخطأ في رواية العين ولعل ذلك من أحد النساخ فثبت في هذه الأصول المتأخرة. وليس من قصائد الديوان على هذا الوزن ما كان رويه عينا مكسورة.
(2) جاء في التهذيب مما نسب إلى الليث:..... يجعلان كالخرجين.
(3) كذا في التهذيب واللسان أما الرواية في الأصول المخطوطة فهي:
............... .......... ... نجاء هقل حافل بفيحان
وقد جاء في حاشية محقق التهذيب 4/ 326: أنه للجعيل كما في كتاب مشارف الأقاويز في محاسن الأراجيز ص 299، والرواية فيه السبيجان بدلا من السفيحان.
(3/147)
________________________________________
والَّسفيح: من أسماء القِداح.
فسح: الفُساحة: السَّعَة في الأرض، بَلَدٌ فَسيح»
وأمر فَسيح، فيه فَسحة أي: سَعَة. والرَّجل يَفسَحُ لأخيه في المجلس: يُوسِّعُ عليه. والقَوم يَتَفَسَّحُون إذا مَكَّنُوا. وانفَسَحَ طرْفه إذا لم يَردُدْه شيءٌ عن بُعْد النَّظَر. والفُساح: من نَعْت الذَّكَر الصُّلْب «2» .
فحس: الفَحْس: أَخذُك الشَيْءَ بلسانِك وفَمِك من الماء ونحوه، فَحَسَه فَحْساً.
باب الحاء والسين والباء معهما ح س ب، ح ب س، س ح ب، س ب ح، «3» مستعملات
حسب: الحَسَبُ: الشَرَف الثابت في الآباء. رجل كريم الحَسَب حسيبٌ، وقَوْمٌ حُسَباءُ،
وفي الحديث: الحَسَبُ المالُ، والكَرَمُ التقوى «4» .
__________
(1) وقد ورد في التهذيب، بعد بلد فسيح مما نسب إلى الليث: ومفازة فسيحة
(2) لم نجد هذا المعنى وهذا النعت للذكر في سائر المعجمات.
(3) لم يكن ترتيب المواد على هذا النحو في الأصول المخطوطة، وهذا الترتيب المثبت يوافق نظام التقليب.
(4) وفي التهذيب في هذا الموضع زيادة فيما جاء في الكلام المنسوب إلى الليث وهي:
وروي عن النبيّ صلى الله عليه أنه قال: تنكح المرأة لمالها وحسبها وميسمها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك.
(3/148)
________________________________________
وتقول: الأَجْر على حَسَب ذلك أي على قَدْره،
قال خالد بن جعفر للحارث بن ظالم: أما تَشكُرُ لي إذْ جَعَلْتُك سيِّد قَومِكَ؟ قال: حَسَبُ ذلك أشكُرُكَ.
وأمّا حَسْب (مجزوماً) فمعناه كما تقول: حَسْبُك هذا، أيْ: كَفاكَ، وأَحْسَبَني ما أعطاني أي: كفاني. والحِسابُ: عَدُّكَ الأشياء. والحِسابةُ مصدر قولِكَ: حَسَبْتُ حِسابةً، وأنا أحْسُبُه حِساباً. وحِسْبة أيضاً «1» ، قال النابغة:
وأَسْرَعَتْ حِسْبةً في ذلك العَدَدِ «2»
وقوله- عز وجل-: يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ* «3» اختُلِفَ فيه، يقال: بغير تقدير على أجْرٍ بالنقصان، ويقال: بغير مُحاسَبةٍ، ما إنْ يخاف أحدا يحاسبه «4» ، ويقال: بغير أن حَسِبَ المُعطَى أنّه يعطيه: أعطاه من حيثُ لم يَحتَسِبْ. واحتَسَبْتُ أيضاً من الحِساب والحسبة مصدر احتِسابك الأجْرَ عند الله. ورجلٌ حاسِبٌ وقَوْمٌ حُسّاب. والحُسْبان من الظنّ، حَسِبَ يحسَبُ، لغتان، حُسْباناً، وقوله- عز وجل-: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ
«5» ، أي قُدِّرَ لهما حِسابٌ معلوم في مواقيتِهما لا يَعدُوانِه ولا يُجاوزانِه. وقوله تعالى: وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ
«6» أي نارا تحرقها.
__________
(1) كذا في ص وط أما في س فقد جاء: والحسبة....
(2) عجز بيت في التهذيب واللسان (حسب) وفي الديوان (ط دمشق) ص 16 وصدره:
فكملت مائة فيها حمامتها
(3) سورة آل عمران الآية 37.
(4) في التهذيب 4/ 333: ما يخاف أحدا أن يحاسبه عليه.
(5) سورة الرحمن الآية 5.
(6) سورة الكهف الآية 40.
(3/149)
________________________________________
والحُسْبان: سهِام قِصارُ يُرمى بها عن القِسِيِّ الفارسية، الواحدة بالهاء. والأَحْسَبُ: الذي ابيضَّتْ جلدتُه من داءٍ ففَسَدَتْ شَعَرتُه فصار أحمَرَ وأبيَضَ، من الناس والإبل وهو الأبرَصُ، قال: «1»
عليه عَقيقتُه أَحْسَبا
عابَه بذلك، أَيْ لم يُعَقِّ له في صِغَره حتى كَبِرَ فشابَتْ عقيقته، يعني شَعَره الذي وُلِدَ معه «2» . والحَسْبُ والتَحسيب: دَفْن الميِّت في الحجارة، قال:
غَداةَ ثَوَى في الرَّمْل غيرَ مُحَسَّبِ «3»
أيْ غيرَ مُكَفَّن.
حبس: الحَبْس والمَحْبِس: موضعان للمحبوس، فالمَحْبِس يكون سِجْناً ويكون فعلاً كالحَبْس. والحَبيس: الفَرَس: يُجْعَل في سبيل الله. والحِباس: شيء يُحْبَس به نحو الحِباس في [المَزْرَفة] «4» يحبس به فضول الماء.
__________
(1) هو (امرؤ القيس) كما في الديوان (ط. المعارف) ص 128، واللسان (حسب) . وصدر البيت:
أيا هند لا تنحكي بوهة
(2) جاء بعد هذا نص ليس من العين، فيما نرى، وهو: قال القاسم: الأحسب: الشعر الذي نعلوه حمرة. أدخله النساخ في الأصل.. نحسب أنه من كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، فقد جاء في التهذيب 4/ 334: وقال أبو عبيد: الأحسب: الذي في شعره حمرة وبياض.
(3) كذا في التهذيب واللسان، ورواية ابن سيده: في الترب بدلا من قوله في الرمل. وهو غير منسوب إلى قائل.
(4) كذا في التهذيب واللسان في الأصول المخطوطة: الدرقة. ولا معنى للدرقة. وجاء في مادة حبس في اللسان. أن الحباسة هي المزرفة بالفاء أي ما يحبس به الماء. ولم نجد في مادة زرف لفظ المزرفة بل وجدنا فيها: الزرافة: منزفة الماء.
(3/150)
________________________________________
والحباسة في كلام العجم: (المكلا) «1» ، وهي التي تُسَمَّى المَزْرَفة، وهي الحباسات في الأرض قد أحاطت بالدَّبْرة يُحْبَس فيها الماء حتى يمتلىء ثم يُساق إلى غيرها. واحتَبَسْتُ الشَيْءَ أي خَصصتُه لنفسي خاصَّةُ. واحتَبَست الفِراشَ بالمِحْبَس أي بالمِقْرَمة «2» .
سحب: السَّحْبُ: جَرُّكَ الشَّيْءَ، كسَحْب المرأةِ َذْيَلها، وكسَحْبِ الريحِ التُرابَ. وسُمِّيَ السَّحابُ لانسحابه في الهواء. والسَّحْبُ: شدَّة الأكْل والشُّرْب، رجلٌ أُسْحُوب «3» : أَكُولٌ شَروبٌ. ورجل مُتَسَحِّب: حريص على أكل ما يوضَع بين يَدَيْه.
سبح: قوله- عز وجل- إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا
«4» ، أي: فَراغاً للنَّوم عن أبي الدُّقَيْش، ويكون السَّبْحُ فراغاً باللَّيْل أيضاً. سُبْحانَ اللهِ: تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي أن يُوصَف به، ونَصبُه في موضع فِعْلٍ على معنى: تَسبيحاً لله، تُريدُ: سَبَّحْتُ تَسبيحاً للهِ [أي: نزَّهتُه تنزيهاً] «5» . ويقال: نُصِبَ سُبحانَ الله على الصرف، وليس بذاك، والأول أجود.
__________
(1) هكذا رسمت في الأصول، ولم نهتد إلى ضبطها.
(2) المقرمة: ما يبسط على وجه الفراش للنوم. انظر التهذيب (حبس) 4/ 343
(3) عقب الأزهري في التهذيب 4/ 336 فقال: قلت الذي عرفناه وحصلناه رجل أسحوت بالتاء إذا كان أكولا شروبا، ولعل الأسحوب بهذا المعنى جائز.
(4) سورة المزمل الآية 7
(5) من التهذيب 4/ 338 عن العين. في الأصول: تنزهه
(3/151)
________________________________________
والسُّبُّوح: القُدُّوس، هو اللهُ، وليس في الكلام فُعُّول غير هذين. والسُّبْحةُ: خَرَزات يُسَبَّح بعددها.
وفي الحديث أن جبريل؟ قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم-: إن لله دون العرش سبعين حِجاباً لو دَنَونا من أحدها لأَحْرَقَتْنا سُبُحاتُ وَجْهِ رَبِّنا
يعني بالسُّبْحة جَلالَه وعَظَمَتَه ونورهَ. والتَّسبيح يكونُ في معنى الصلاة وبه يُفسَّر قوله- عَزَّ وجل- فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ «1» ، الآية تأمُرُ بالصَّلاة في أوقاتِها، قال الأعشى:
وسَبِّحْ على حينِ العَشِيّات والضُّحَى ... ولا تَعْبُدِ الشَّيطانَ واللهَ فاعبُدا «2»
يعني الصلاة. وقوله تعالى: فَلَوْلا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
«3» يعني المُصَلِّين. والسَّبْح مصدرٌ كالسِّباحة، سَبحَ السابحُ في الماء. والسابح من الخَيْل: الحَسَنُ مَدِّ اليَدَيْن في الجَرْي. والنُجُوم تَسْبَح في الفَلَك: تجري في دَوَرانه. والسُّبْحة من الصلاة: التَطَوُّع.
__________
(1) سورة الروم الآية 17.
(2) ديوانه ص 137، وقد لفق من بيتين له، هما:
وذا، النصب المنصوب لا تنسكنه ... ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا
وصل على حينِ العَشِيّات والضُّحَى ... ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا
(3) سورة الصافات الآية 143.
(3/152)
________________________________________
باب الحاء والسين والميم معهما ح س م، ح م س، س ح م، س م ح، م س ح «1» مستعملات
حسم: الحَسْم: أن تَحسِمَ عِرْقاً فتَكويه لئلاّ يَسيل دمه. والحسم: المنع، والمحسوم: الذي حُسِمَ رَضاعُه وغِذاؤه. وحَسَمْتُ الأمْرَ أي: قَطعتُه حتى لم يُظفَر منه بشيء، ومنه سمِّي السَّيفُ حُساماً لأنّه يحسِمُ العدوَّ عَمَا يُريد، أي يمنَعُه. والحُسُوم: الشُّؤْم، تقول: هذه ليالي الحُسُوم تحسِم الخَير عن أهلها، كما حُسِمَ عن قَوم عادٍ في قوله تعالى: ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً
«2» أي شُؤْماً عليهم ونَحْساً «3» . حُسُم: موضع، قال: «4»
وأدْنَى مَنازلِها ذو حُسُمْ
وحاسم: موضع. وحَيْسُمان: اسم رجل «5» .
__________
(1) هذا هو الترتيب في المواد الذي اقتضاه نظام التقليب، وهو غير ما ذكر في الأصول المخطوطة. وفي أن المستعملات هي مواد أما السادسة (محس) فقد عدها الخليل من المهمل في حين ذكرها الأزهري في التهذيب وأدرج فيها قدرا موجزا من الفوائد.
(2) سورة الحاقة الآية 7.
(3) بعده بلا فصل: قال القاسم: حسوما: متتابعة. رفعناها من الأصل لأنها تعليق أدخله النساخ فيه. والقاسم هو أبو عبيد القاسم بن سلام، كما سبق أن بينا ذلك في هامشنا (ص 149)
(4) القائل هو (الأعشى) ، والبيت في ديوانه (الصبح المنير) ، وتمام البيت فيه:
فكيف طلابكها إذ نأت ... وأدنى مزارا لها ذو حسم
وكذلك في ديوانه (شرح الدكتور محمد حسين) ص 35، وفي الديروانين: (وأدنى مزارا) بالنصب، وهو لحن. ورواية البيت في معجم ما استعجم (2/ 446) :
وأدنى ديار بها ذو حسم
(5) وزاد الأزهري في التهذيب مما نسب إلى الليث:.... اسم رجل من خزاعة. وفي القاموس: ابن إياس الخزاعي، صحابي.
(3/153)
________________________________________
حمس: رجُلٌ أحْمَس أي شجاع. وعامٌ أحْمَس، وسنة حَمْساء أي شديدة، ونَجْدَة حَمْساء يُريد بها الشجاعة، قال «1» :
بنجدةٍ حَمْساءَ تُعدي الذَّمْرا
ويقال: أصابَتْهم سِنُونَ أحامِسُ لم يُرِد به مَحْضَ النَّعْت، ولو أرادَه لقال: سِنونَ حُمْسٌ، وأريد بتذكيره الأعوام. والتَنَّور: هو الوَطيس والحَميس. والحُمْسُ: قُرَيش. وأحماس العَرَب: أُمُّهاتُهم من قُرَيش، وكانوا مُتَشدِّدين في دينهم، وكانوا شُجَعاء العرب لا يُطاقُون، وفي قَيْسٍ حُمْسٌ أيضا، قال:
والحُمْسُ: قد تُعلَمُ يوم مأزق «2»
والحمس: الجَرْس، قال:
كأن صَوْتَ وَهْسِها تحتَ الدُجَى ... وقد مضى ليل عليها وبَغَى «3»
حَمْسُ رجالٍ سَمِعُوا صَوْتَ وَحَا «4»
والوَحَى مثل الوَغَى.
سحم: السُّحْمةُ: سَوادٌ كَلَوْنِ الغُرابِ الأَسْحَم، أي: الأَسْوَد.
__________
(1) الرجز في اللسان غير منسوب (حسم) .
(2) لم نهتد إلى الرجز ولا إلى الراجز.
(3) كذا في ص وط أما في س فقد جاء: سجا
(4) الأول والثالث من هذا الرجز في التهذيب واللسان (حمس) .
(3/154)
________________________________________
والأَسْحَم: اللَّيل في شعر الأعشَى:
بأسحَمَ داجٍ عَوْضُ لا نتفرَّقُ «1»
وفي قول النابغة: السحاب الأسود:
وأسْحَم دانٍ مُزْنُه مُتَصَوِّبُ «2»
سمح: رجلٌ سَمْحٌ، ورجالٌ سُمَحاءُ، وقد سَمُحَ سَماحةً وجادَ بمالِه «3» ، ورجلٌ مِسْماحٌ مَساميح، قال: «4»
غَلَبَ المَساميح الوليد سَماحةً ... وكَفَى قُرَيش المُعضِلاتِ وسادَها
وسَمَحَ لي بذلكَ يَسمَحُ سَماحةً وهو الموافقة فيما طَلَبَ. والتَسميح: السُّرْعة «5» ، والمُسامَحةُ في الطِّعان والضرِّاب والعَدْوِ إذا كانت على مُساهلة، قال: «6»
وسامَحْتُ طَعْناً بالوَشِيج ِالمُقَوَّمِ
ورُمْحٌ «7» مُسَمَّح: تُقِّفَ حتى لان. وكذلك بعير [مسمح] «8» . ورجل
__________
(1) عجز بيت (للأعشى) وصدره:
رضيعَيْ لِبانٍ ثديَ أم تحالفا
، والبيت في ديوانه (الصبح المنير) والتهذيب 4/ 345 واللسان (سحم) .
(2) البيت في الديوان (ط. دمشق) ص 73 وفي اللسان (سحم) ، وصدره:
عفا آية ريح الجنوب مع الصبا
(3) في التهذيب 4/ 345 عن العين.
(4) البيت (لجرير) كما في المحكم 3/ 159 واللسان والتاج (سمح)
(5) وزاد الأزهري في التهذيب مما نسب إلى الليث الرجز الآتي: سمح واجتاز فلاة قيا. وكذلك في اللسان.
(6) الشطر في التهذيب 4/ 346، واللسان (سمح) غير منسوب وغير تام أيضا.
(7) كذا في التهذيب مما نسب إلى الليث، وهو الصواب وذلك لأن في ص وط: ورجل مسمح. وهذا لا يستقيم مع المعنى. وقد جاء في س: ورمح ورجل مسمح، وهو غير وجيه أيضا. والذي أشار إليه محقق التهذيب 4/ 346: أن في بعض النسخ المخطوطة رجل بدل رمح.
(8) آثرنا إضافتها لأنها متطلبة.
(3/155)
________________________________________
مِسْماح أيْ: جَوادٌ عند السَّنة.
مسح: يقال للمريض: مَسَحَ اللهُ ما بكَ، ومَصَحَ أجوَدُ. ورجل ممسوح الوَجْهِ ومَسيحٌ إذا لم يبقَ على أحَد شِقَّي وَجْهه عَيْنٌ ولا حاجبٌ إلا استَوَى. والمَسيحُ الدَّجّال على هذه الصفة. والمَسيحُ عيسِى بن مَرْيَمَ عليه السلام- أُعرِبَ اسمُه في القرآن، وهو في التَوراة مَشيحا «1» ، قال:
إذا المَسيحُ يقتُل المَسيحا
يَعْني عيَسى يقتُل الدَّجّال بنَيْزَكه. والأمْسَحُ من المَفاوِز كالأَمْلَس، والجميع الأماسِحُ. والمِساحةُ: ذَرْعُ الأرض، يقال: مَسَحَ يمسَحُ مَسْحاً ومِساحةً. والمَسْحُ: ضَرْب العنق تمسَحُه بالسَّيْف مَسْحاً ومنه قوله- عز وجل-: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ «2» . والتِّمْسَحُ والتِّمْساح: خَلْقٌ في الماء شَبيهٌ بالسُّلَحْفاة، إلا أنه ضَخْمٌ طويلٌ قَويٌ. والماسِحة: الماشطة. والمُماسحَة: المُلايَنة في المُعاشَرة من غير صفاء القَلْب. وعلى فلانٍ مَسْحةٌ من جَمال، وكانَتْ مَيَّةُ تتمَّنَى لقاء «3» ذي الرُّمَّة فلمّا رَأَتْه استَقْبَحته فقالت: أن تسمع بالمعيدي خير من أن تَراه، فَسِمع ذو الرُمَّة فهَجاها فقال:
على وجْهِ مَيٍّ مَسْحَةٌ من مَلاحةٍ ... وتحت الثَياب الشَّيْن لو كانَ بادياً «4»
__________
(1) كذا في س أما في ص فإنه: مسيحا (بالسين) .
(2) سورة ص الآية 33.
(3) كذا في س أما في ص وط: لقي.
(4) البيت في ديوان ذي الرمة ص 675.
(3/156)
________________________________________
والمَسيحة، قِطعة من الفِضَّة. والمَسيحة والمسايحُ: ما تُرِكَ من الشَّعَر فلم يُعالَج بشَيْءٍ وفُلانٌ يُتَمسَّحُ به لفَضْله وعبادته.
باب الحاء والزاي والدال معهما د ح ز يستعمل فقط
دحز: الدَّحْز: الجِماع.
باب الحاء والزاي والراء معهما ح ز ر، ح ر ز، ز ح ر، ر ز ح «1» مستعملات
حزر: الحَزْر: حَزْرُكَ الشَّيءَ بالحَدس تَحْزِرُه حَزْراً. والحاِزُر والحَزْر: اللَّبَن الحامِض. والحَزْرَةُ: خِيار المال «2» ، قال:
الحزرات حزرات النَّفْسِ «3»
حرز: مكان حَريز: قد حَرُزَ حَرازةً، والحَرَزُ: الخَطَر، وهو الجَوْزُ المَحْكُوك يُلْعَبُ به «4» ، وجمعُه أحراز. وأخطار. والحِرْز: ما أحْرَزْتَ في موضع من
__________
(1) رتبت المواد بحسب ما يقتضي نظام التقليب، وفي الأصول المخطوطة ما يختلف عما أثبتنا.
(2) كذا في التهذيب 4/ 358 عن العين وغيره من المعجمات، في الأصول المخطوطة: الموت: وهو من خطإ الناسخ.
(3) الرجز في التهذيب 4/ 358 واللسان (جذر) غير منسوب
(4) في التهذيب 4/ 360 عن الليث، يلعب بها الصبي.
(3/157)
________________________________________
شَيْء، تقول: هو في حِرْزي. واحتَرَزْتُ من فُلانٍ.
زحر: زَحَرَ يَزْحَر زَحيراً وهو إخراج النَّفَس بأَنين عند شِدَّةٍ ونحوها، والتَزَحُّر مثله. وزَحَرَتِ المرأةُ بوَلَدها، وتَزَحَّرَت عنه إذا وَلَدَتْ، قال: «1»
إني زعيم لك أَن تَزَحَّري ... عن وارِمِ الجَبْهة ضَخْمِ المَنخَرِ
وفُلانٌ يَتَزَحَّرُ بماله شُحّاً.
رزح: رَزَحَ البعيرُ رُزُوحاً أي: أعْيا، وبَعير مِرْزاح ورازِح وهو المُعْيي القائم، وإبِل رَزْحَى ومَرازيح. والمِرْزيح: الصَّوْت.
باب الحاء والزاي واللام معهما ح ز ل، ح ل ز، ز ل ح، ز ح ل، ل ح ز «2» مستعملات
حزل: الإحزِئْلال: الارتِفاع، احزَأَلَّ يَحْزَئِلُّ في السَّيْر وفي الأرض صعداً كما يَحْزَئِلُّ السحاب إذا ارتَفَعَ نحو بَطْن السَّماء. واحزَأَلَّتِ الإبِل: اجتَمَعَتْ ثُمَّ ارتَفَعَتْ على مَتْنٍ من الأرض في ذهابها، قال: «3»
__________
(1) في التهذيب 4/ 357 واللسان (زحر) ، غير منسوب أيضا.
(2) هذا هو ترتيب التقليب وهو غير ما هو موجود في العين.
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى الشطر في غير الأصول.
(3/158)
________________________________________
بَنُو جُنْدَعٍ فاحزَوْزَأَتْ واحزَأَلَّتِ
والاحتِزال: الاحتِزام بالثَّوْب. واحزَوْزَأَتِ الدَّجاجة على بَيْضها: «1» تجافَتْ، وهذا من المضاعف.
حلز: القَلْبُ يَتَحلَّزُ عند الحُزْن كالاعتِصار فيه والتَوَجُّع. وقَلْبٌ حالِز، وإنسانُ حالِز: ذو «2» حَلْزٍ، ويقال: كَبِدٌ [حِلِّزَة وحَلِزَة، أي: قريحة] «3» . ورجلٌ حِلِّزٌ (أيْ بخيل) «4» . وامرأةٌ حِلِّزَةٌ بخيلةٌ.
زلح: (الزَّلْحُ من قولك) : «5» قَصْعةٌ زَلَحْلَحة: لا قَعْر لها.
زحل: زحل الشيء: زال عن مَقامه. والناقة تَزْحَلُ زَحْلاً إذا تأخَرَّت في سَيْرها، قال: «6»
فإنْ لا تُغَيِّرْها قريش بملكها ... يكن عن قُرَيشٍ مُسْتَمازٌ ومَزْحَلُ
وقال: «7»
قد جعلت ناب دكين تزحل
__________
(1) كذا في ص وط أما في س: بيضتها.
(2) جاء في التهذيب: وهو ذوه وهو خطأ صوابه ما أثبتنا مما جاء في الأصول المخطوطة.
(3) من اللسان (حلز) . في الأصول: حلز. وقرحة
(4) زيادة من التهذيب 4/ 362 مما نسبه إلى الليث.
(5) زيادة من التهذيب 4/ 361 مما نسبه إلى الليث.
(6) القائل هو (الأخطل) والبيت في ديوانه ص 11.
(7) الرجز في التهذيب 4/ 363 واللسان (زحل
(3/159)
________________________________________
والمزَحَل: المَوْضِع الذي يُزْحَل إليه. والزَّحُول من الإبل: التي إذا غَشِيَت الحَوْضَ ضَرَبَ الذائد وجْهَها فوَلته عَجُزَها (ولم تَزَلْ تَزْحَلُ حتى تَرِدَ الحوضَ) «1» ، وربَّما ثَبَتَت مقبلةً، قال لبيد في زحل الشيء إذا زال عن مقامه «2» :
لو يقومُ الفيلُ أو فَيَّالُه ... زَلَّ عن مِثْل مَقامي وزَحَلْ
لحز: رجُلٌ لَحِزٌ أي شَحيحُ النفس، وأنشد:
تَرَى اللَّحِزَ الشَّحيحَ إذا أُمِرَّتْ ... عليه لِما له فيها مُهينا) «3»
والتَلَحُّزُ: تَحَلُّبُ فيكَ من أكل رمّانٍة ونحوها «4» . شهوةً.
باب الحاء والزاي والنون معهما ح ز ن، ز ح ن، ن ز ح، ن ح ز مستعملات
حزن: الحُزْن والحَزَن، لغتان [إذا ثقّلوا فتحوا، وإذا ضحّوا خفّفوا، يقال: أصابه حَزَنٌ شديدٌ، وحُزْنٌ شديد] «5» ، ويقال: حَزَنَني الأمرُ [يَحْزُنُني فأنا محزون] وأحزنني [فأنا مُحْزَنٌ، وهو مُحْزِنٌ] ، لغتان أيضاً، ولا يقال: حازن. وروي عن أبي عمرو «6» : إذا جاء الحَزَنُ منصوباً فَتَحوه، وإذا جاء مكسوراً
__________
(1) زيادة من التهذيب 4/ 363 مما نسب إلى الليث.
(2) البيت في التهذيب 4/ 363 واللسان (زحل) ، وديوانه (ط الكويت) ص 194.
(3) ما بين القوسين زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(4) في التهذيب مما نسب إلى الليث: أو إجاصة.
(5) ما بين الأقواس من التهذيب 4/ 364 عن العين أثبتناه، لأن عبارة الأصول قاصرة ومضطربة.
(6) هو أبو عمرو بن العلاء.
(3/160)
________________________________________
مرفوعاً ضَمَّوه، قال الله عز وجل-: وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ «1» وقال- عزَّ اسمه-: وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً «2» . وقوله- عز وجل-: نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
«3» . ضَمُّوا الحاءَ هنا لكَسْرة النون، كأنّه مجرور في استعمال الفعل. وإذا أفردُوا الصَّوْتَ والأمْرَ قالوا: أمْرٌ مُحزن وصَوْتٌ محُزن ولا يقال: حازن. والحَزْنُ من الأرض والدَّوابِّ: ما فيه خُشونة، والأنثى حَزْنة، وقد حَزُنَ حُزونةً. وحُزانةُ الرجل: من يَتَحَزَّن بأمره. ويُسَمِّي سَفَنْجقانية العرب على العجم في أوَّل قُدومهم الذي استَحَقُّوا به ما استَحَقُّوا من الدور والضياع «4» حُزانة «5» .
زحن: زَحَنَ الرجلُ يزْحَنُ زَحْناً، وتَزَحَّنَ تَزَحُّناً أي: أبطَأَ عن أمره وعَمَله. وإذا أرادَ رَحيلاً فعَرَضَ له شُغْل فبَطَّأَ به قلت: له زَحْنةٌ بعد. والرجل الزيحنة «6» : المتباطىء عند الحاجة تُطلَب إليه، قال:
__________
(1) سورة يوسف الآية 84.
(2) سورة التوبة الآية 92.
(3) سورة يوسف الآية 86.
(4) كذا في س أما في ص وط: الضياعة.
(5) عقب الأزهري على ما نقله الليث عن الخليل فقال في التهذيب (4/ 366) فقال: السفنجقانية: شرط كان للعرب على العجم بخراسان إذا افتتحوا بلدا صلحا أن يكونوا إذا مر بهم الجيوش أفذاذا أو جماعات أن؟ ينزلوهم ويقروهم ثم يزودوهم إلى ناحية أخرى في (س) : سفنجانية.
(6) في (س) : الزحنية، ولعله تحريف، فقد جاء رسم الكلمة في التهذيب 4/ 366 وفي مختصر العين (ورقة 70) ، وفي المحكم 3/ 167، وفي اللسان (زحن) مطابقا لما في (ص) و (ط) .. وجاء في القاموس المحيط ما يزيل اللبس، فقد قال: والزيحنة كسيفنة: المتباطىء، وتابعه التاج (زمن) . أكبر الظن أن ما جاء في (س) وما ورد في آخر المادة في النسخ، الثلاث المخطوطة من عبارة: (الحاء ساكنة) ... من فعل النساخ.
(3/161)
________________________________________
إذا ما التَوَى الزِّيحَنَّةُ المُتآزِفُ «1»
نزح: نَزَحَتِ الدارُ تَنْزَح نُزُوحاً أي بَعُدَت. ووَصْل نازح أي بعيد، قال: «2»
أم نازحُ الوصْل مِخلافٌ لشِيمته
ونَزَحْتُ البِئْرَ، ونَزَحْتُ ماءَها، وبئر نَزوحٌ ونَزَحٌ أي قليلة الماء، [ونَزَحَتِ البِئْرٌ، أي: قلّ ماؤها] «3» والصَّواب عندي: نُزِحَتِ البئرُ أي: اسْتُقِيَ ما فيها.
نحز: النَحْز كالنَّخْس. والنَّحْز شَبْهُ الدَّقّ. والراكبُ يَنْحَزُ بصدره واسِطَ الرَّحْل، قال ذو الرمة:
إذا نَحَزَ الإدْلاجُ ثُغرةَ نَحْره ... به أَنَّ مُستْرخي العِمامِة ناعِسُ «4»
قال: والنُّحازُ داءٌ «5» يأخُذُ الإبل والدَّوابَّ في رِئاتها «6» ، وناقةٌ ناحِز: بها نُحاز، قال القطامي:
تَرَى منه صدور الخيل زورا ... كأن بها نحازا أو دكاعا «7»
__________
(1) الشطر في التهذيب غير منسوب.
(2) لم نهتد إلى القائل ولا إلى الشطر.
(3) سقط ما بين القوسين من الأصول المخطوطة الثلاث وأثبتناه مما نقل في التهذيب 4/ 376 عن العين، لتقويم العبارة.
(4) البيت في الديوان ص 317.
(5) في التهذيب 4/ 367: سعال.
(6) كذا في التهذيب مما نسب إلى الليث، وفي الأصول المخطوطة: رئتها.
(7) كذا في ص وط والديوان ص 33. أما في س: فبالراء وهو تصحيف.
(3/162)
________________________________________
والنّاحزِ أيضاً: أن يُصيبَ المِرفقُ كِرْكِرةَ البعير، فيقال: به ناحز «1» ، وإذا أصابَ حَرْفَ الكِرْكَرة المِرفقُ فحزَّة قيلَ: بها حازٌّ، مُضاعَف، فإذا كان من اضطغاط عند الأبِطْ قيل بها ضاغِط. والمِنْحاز ما يُدَقُّ به. ونَحيزة الرجل: طبيعتُه، وتجمع: نَحائز. ونَحيزةُ الأرض كالطِّبَّة ممدودةٌ في بَطن الأرض تقود الفَراسِخَ وأقلّ (من ذلك) «2» ، ويجيء في الشعر نَحائز يُعْنَى بها طِبَبٌ من الخِرَق والأَدَم إذا قُطِعَتْ شرُكُاً طِوالاً.
باب الحاء والزاي والفاء معهما ز ح ف، ح ف ز يستعملان فقط
زحف: الزَّحْف جماعة يزحَفُون إلى عدوِّهم بمَرَّة، فهُم الزَّحْف والجميع زُحُوف. والصَّبيُّ يَتَزَحَّفُ على الأرض قبل أن يمشي. وزَحَفَ البعير يزحَفُ زَحْفاً فهو زاحف إذا جَرَّ فِرْسَنَه من الاعِياء، ويجمع زَواحف، قال: «3» .
على زَواحِفَ تُْزَجى مُخُّهارِيرُ
وأَزْحَفَها طولُ السَّفَر والازدحاف كالتزاحف.
__________
(1) كذا في التهذيب أما في الأصول المخطوطة ففيها: أن يصيب المرفق كركرته. وقد عقب الأزهري على عبارة العين المشار إليها فقال: قلت: لم نسمع الناحز في باب الضاغط لغير الليث، وأراه أراد الحاز فغيره. نقول: وتعقيب الأزهري غير صحيح فقد بين الخليل ذلك بعد الناحز فذكر الحاز الذي أشار إليه الأزهري.
(2) من التهذيب مما نسب إلى الليث وهو ما ذكره الخليل في العين.
(3) القائل هو (الفرزدق) ، والشطر في التهذيب واللسان، وفي الديوان 1/ 213 (ط صادر) والرواية فيه:
على عمائِمنا تُلْقَى وأَرْحلنا ... على زواحف نزجيها محاسير
(3/163)
________________________________________
حفز: الحَفْزُ: [حثّك] الشَّيْءَ حثيثاً من حَلفه، سَوْقاً أو غير سَوْق «1» ، قال: «2»
وقد سِيقَتْ من الرِّجْلَيْن نفسي ... ومن جَنْبي يُحَفَّزُها وَتينُ
أي يحثها الوتين، وهو نِياط القلب، بالخروج. والرجُلُ يَحْتَفِزُ في جلوسه: يُريد القيام أو البَطْش بالشَّيْء. واللَّيْلُ يَحْفِزُ النَّهار: يسوقُه، قال رؤبة:
حَفْزُ الليالي أمَدَ التَّدليف «3»
والحَوْفَزان من الأسماء.
باب الحاء والزاي والباء معهما ح ز ب يستعمل فقط
حزب: حَزَبَ الأمرُ يَحْزُبُ حَزْباً إذا نابَكَ، قال: «4»
فنِعْمَ أخاً فيما ينوبُ ويحزُبُ
وتَحَزَّبَ القَومُ: تَجَمَّعوا. وحَزَّبْتُ أحزاباً: جَمَّعْتُهم. والحِزْبُ: أصحابُ الرجل على رَأْيه وأَمِره، قال العجاج «5» :
لقد وجَدْنا مُصْعَباً ُمَستَصعَبا ... حتى رمى الأحزاب والمحزبا) «6»
__________
(1) من التهذيب 4/ 372 عن العين، في الأصول المخطوطة: الحفز: سوقك الشيء حثيتا من خلفه أو غير سوق وهي عبارة قاصرة مضطربة.
(2) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(3) مجموع أشعار العرب ص 101.
(4) لم نهتد إلى القائل ولا إلى الشطر.
(5) سقط ما بين القوسين من (س) وفي (ص) و (ط) : (رؤبة بن العجاج) وه وهم.
(6) الرجز في ديوان العجاج ص 94، والرواية فيه:
لقد وجدتم مصعبا مستصعبا ... حين رَمَى الأحزابَ والمُحزِّبا
(3/164)
________________________________________
والمؤمنون حزبُ الله، والكافرون حزبُ الشَّيْطان. وكلُّ طائفةٍ تكون أهواؤهم واحدة فهم حزبٌ. والحَيْزَبون: العَجوز، النون زائدة كنون الزيتون. والحزباءة، ممدودة،: أرض حَزْنةٌُ غليظة، وتُجمَع حَزابيّ، قال: «1»
تحِنُّ إلى الدَّهْنا قَلوصي وقد عَلَت ... حَزابيَّ من شَأْز «2» المُناخ جديبا
وعَيْرٌ حَزابيةٌ في استداره خَلَقه، قال النابغة:
أَقَبَّ ككَرِّ الأَنْدَريِّ مُعَقْربٌ ... حَزابية قد كدَّمَتْه المساحل «3»
وركب حزابية، قال: «4»
إن حِري حَزَنْبَلٌ حَزابِيَهْ ... إذا قَعَدْتُ فوقَه نَبابِيَهْ
كالقَدَح المكبوب فَوْقَ الرابيهْ
ويقال: أرادَت: حَزابي أي: رَفَع بي عن الأرض.
باب الحاء والزاي والميم معهما ح ز م، ز ح م، م ز ح، ز م ح، ح م ز، م ح ز كلهن مستعملات
حزم: المِحْزَم: حِزامة البقل، وهو الذي تُشَدُّ به الحُزْمة، حَزَمَه يحزِمُه حزما.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(2) كذا في ص وط أما في س فهو: شأو.
(3) البيت في الديوان (ط. دمشق) ص 114 والرواية فيه:
أقب كعقد الأندري معقرب............... .............
(4) الرجز في التهذيب 4/ 374 واللسان حزب وهو لا مرأة تصف ركبها
(3/165)
________________________________________
والحِزامُ للدابَّة والصبَّيّ في مَهْده. والمِحْزَم: الذي يَقَع عليه الحِزام من الصَّدْر. والحَزيم: موضِع الحزِام من الصَّدْر والظَّهْرِ كله ما استدارَ به، يقال: شَدَّ حَزيمَه وشَمَّرَ، قال: «1»
شَيْخٌ إذا حمل مكروهة ... شد الحَيازيمَ لها والحَزيمْ
والحَيْزُوم: وَسَط الصَّدْر حيث يلتقي فيه رءوس الجَوانح فوقَ الرُّهابة بحِيال الكاهل، قال ذو الرمة:
تَكادُ تَنْقَضُّ مِنْهُنَّ الحَيازيمُ «2»
والحَيْزوم: اسم فَرَس جِبْريل «3» ع-. والحَزْم أيضاً: َضْبُطَك أمرَكَ وأخْذُكَ فيه بالثقة، حَزُمَ الرجُلُ حَزامةً فهو حازم ذو حَزْمة «4» . والحَزْم: ما احتَزَمَ السَّيْل من نَجَوات الأرضِ والظُهور، وجمعُه حُزُوم.
زحم: زَحَمَ القَوْمُ بَعضُهم بعضاً من شِدَّة الزِّحام إذا ازدَحموا. والأمواجُ تَزْدَحِم، قال: «5»
تَزَاحُمَ المَوْجِ إذا الموج التطم
__________
(1) البيت غير منسوب في التهذيب واللسان.
(2) من قصيدة الشاعر:
أعن ترسمت من خرقاء منزلة
الديوان ص 569 وصدر البيت:
تعتادني زفرات من تذكرها
(3) كذلك في الجمهرة 2/ 149، والمحكم 3/ 172، واللسان، والقاموس والتاج، حزم) .
(4) كذا في الأصول المخطوطة أما في التهذيب فهو: حزم.
(5) الرجز في التهذيب واللسان من غير عزو.
(3/166)
________________________________________
جعل مصدر ازدَحَمَ تَزاحُماً. والفيل والثَّوْر يُكَنَّيانِ أبا مُزاحِم. ومُزاحم أو أبو مُزاحِم: أوّل خاقانٍ ولَيَ التُّرْكَ وقاتَلَ العرب، فقُتِل زَمَنَ أَسَد بن عبد الله القسري.
مزح: المِزاح مصدر كالمُمازَحة، والمُزاحُ الاسم، قال: «1»
ولا تَمْزَح فإن المَزْحَ جَهْلٌ ... وبَعضُ الشرِّ يبدَؤُه المُزاح
مَزَحَ يَمْزَحُ مَزْحاً ومُزاحاً ومُزاحةً.
زمح: الزَّوْمَح [والزُّمَّحُ] : الأسود القبيح من الرجال، ويقال: الزُّمَّح الضيِّق الخُلُق «2» ، قال بعض قريش: «3»
لازُمَّحيّينَ إذا جئْتَهم ... وفي هِياج الحَربِ كالأَشْبُلِ
[والزُّمّاح: طائرٌ عظيم] «4» .
حمز: حمز اللوم فُؤاده وقلبَه أيْ: أوجَعَه، قال الشماخ بن ضرار:
فلما شراها فاضت العين عبرة ... وفي الصدر حزاز من اللوم حامز «5»
__________
(1) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(2) جاء في التهذيب 4/ 378: الزمح القصير السمج الخلقة السيىء الأدم المشئوم. ما بين القوسين زيادة من مختصر العين (ورقة 71) .
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(4) من مختصر العين- الورقة 71.
(5) البيت في الديوان (ط. دار المعارف) ص 190 والرواية فيه:
............... ........... ... وفي الصدر حزار من الوجد حامِزُ
(3/167)
________________________________________
الحامِز: الشديدُ من كلِّ شيء. ورجل حامِزُ الفؤاد: شديدُه.
وقال ابن عباس: أفضل الأشياء أحمزها
أي: أَشَدُّها وأَمتَنُها «1»
محز: المَحْزُ: النِكاح، تقول: مَحَزَها، قال جرير:
مَحَزَ الفرزدق أُمَّه من شاعرِ «2»
باب الحاء والطاء والراء معهما ط ح ر، ط ر ح يستعملان فقط
طحر: الطَّحْر: قَذْف العَيْن قذاها «3» ، وطَحَرتِ العَيْنُ الغَمَصَ أي رَمَت به، قال: «4»
وناظرتَيْنِ تطحَران قَذَاهما
وقال في عَيْن الماء: «5»
تَرَى الشريريغ يطفو فوق طاحرة ... مسحنطرا ناظرا نحو الشناغيب
(يصف عَيْنَ ماء تفُور بالماء، والشُّرَيْرِيغ: الضِّفْدَع الصغير،
__________
(1) جاء في اللسان (حمز) :
وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أفضل؟ قال: أحمزها عليك
يعني أمتنها وأقواها وأشدها، وقيل: أمضها وأشقها. (أشدها) في الأصل: زيادة من (س) .
(2) البيت في ديوان جرير ص 307 وصدره:
كان الفرزدق شاعرا فخصيته
وقد ورى نساخ الأصول المخطوطة عن الفرزدق فأثبتوا وزنه الصرفي الفعلل.
(3) والرواية في التهذيب: بقذاها.
(4) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى البيت.
(5) لم نهتد إلى القائل، والبيت في التهذيب واللسان (طحر) .
(3/168)
________________________________________
والطاحرةُ: العَيْن التي ترمي ما يُطْرْح فيها لشِدَّة حَمْوَة مائها من مَنبَعها وقُوَّة فَوَرانه، والشَّناغيب والشَّغانيب: الأغصان الرَّطْبة، واحدها شُغْنُوب وشُنْغوب، والمُسْحَنْطِر: المشرف المنتصب) «1» . وقوس مطحرة: ترمي بسهمها صُعُداً لا تقصِدُ إلى الرَّمِيَّة. والقَناة إذا التَوَتْ في الثِّقاف فوَثَبَتْ فهي مِطْحَرة، وأما قول النابغة: مِطْحَرةُ زَبون «2» فإنّه نعت للحرب. والطَّحِير: شِبْه الزَّحير.
طرح: طَرَحْتُ الشَّيْءَ فأَنا أطْرَحُه طَرْحاً، والطِّرْح: الشَّيْءُ المطروحُ لا حاجة لأحَدٍ فيه. والطَّروح: البعيد نحو البَلْدة وما أشبهها.
باب الحاء والطاء واللام معهما ط ل ح، ط ح ل، ل ط ح، ح ل ط مستعملات
طلح: شَجَرُ أمِّ َغْيلان، شَوْكُه أَحْجَنُ، من أعظم العِظاه شَوْكاً، وأصلبِه عُوداً واجوده «3» صَمْغاً، الواحدة طَلْحة. والطَّلْح في القرآن المَوْز.
__________
(1) ما بين القوسين كله من التهذيب مما نسب إلى الليث، ولم يرد منه في الأصول المخطوطة إلا قوله: يعني: أغصان الشجرة تدلت، الواحد شنغوب.
(2) لم نجد هذه العبارة في قصيدة (النابغة) النونية من الوافر (الديوان ط دمشق ص 256) بل هناك عبارة حرب زبون في قوله: وحالت بيننا حرب زبون.
(3) كذا في (ص) و (ط) وفي التهذيب 4/ 383 عن العين. في (س) : أصلبها، أجودها.
(3/169)
________________________________________
والطَّلاح نقيض الصَّلاح، والفعل طلح يطلح طَلاحاً. وذو طَلَح: مَوضِع: قال: «1»
ورأيْتُ المرءَ عَمْراً بِطَلَحْ
قال بعضهم: رأيته يَنْعُمُ بنعمة، وهو غلط، إنما عمرو هذا بموضعٍ يقال له: ذو طَلَح، وكان مَلِكاً. والطَّلاحة: الإِعياء وبَعيرٌ طَليحٌ، وناقةٌ طَليح، وطِلْح أيضاً، قال: «2»
فقد لَوَى أنْفَه بمِشْفَرها ... طِلْحُ قَراشيمَ شاحِبٌ جَسَدُهْ
والقُرْشُوم: شَجَرَةٌ تزعمُ العرب أنّها تُنْبِتُ القِرْدان، والقُرْشُوم: القُراد الضَّخْم.
طحل: الطُّحْلة: لوْنٌ بين الغُبْرة والبَياض في سَوادٍ قليل كسَواد الرَّماد. وشَرابٌ طاحِل: ليس بصافي اللَّوْن، والفعل طَحِلَ يطْحَل طَحَلاً. وذِئبٌ أطحَلُ، ورَماد أطحَلُ. والطِّحال معروف. ورجل مطحول إذا ديء «3» طِحالُه.
لطح: اللَّطْح كاللَّطْخ إذا جَفَّ ويُحَكُّ لم يبْقَ له أثَرٌ. واللَّطْحُ كالضرب باليد.
__________
(1) القائل هو (الأعشى) ديوانه 237- والرواية فيه: كم رأينا من أناس هلكوا
وكم رأينا من أناس هلكوا ... ورأينا المرء عمدا بطلح
(2) القائل هو (الطرماح) ، والبيت في التهذيب واللسان والديوان (ط. القاهرة) ص 118.
(3) في الأصول المخطوطة: دئي، والصواب ما أثبتناه.
(3/170)
________________________________________
حلط: حَلَطَ فلان إذا نَزَل بحال مَهْلكة. والاحتِلاط: الاجتِهادُ في مَحْكٍ ولَجاجة. وأحْلَطَ الرجل بالمكان إذا أقامَ به، قال ابن أحمر:
وأحْلَطَ هذا: لا أريمُ مَكانيا «1»
باب الحاء والطاء والنون معهما ط ح ن، ح ن ط، ن ح ط، ن ط ح، ط ن ح، مستعملات
طحن: الطِّحْن: الطَّحين المطحون، والطَّحْن الفِعل، والطِّحانة: فعل الطَّحّان. والطّاحُونة: الطَّحّانة التي تدور بالماء. وكل سن من الأضراس طاحنة. والطُّحَنَةُ: دُوَيْبَّةِ كالجُعَل، ويُجْمَع [على] طُحَن. والطّحون: الكتيبة [من الخيل] تَطْحَن كُلَّ شيءٍ بحَوافرها.
حنط: الحِنْطة: البُرُّ. والحِناطةُ: حِرفة الحَنّاط، وهو بَيّاع البُرِّ. والحَنُوط: يُخلَط (من الطِّيب) «2» للميِّت خاصَّةً،
وفي الحديث: أنّ ثَمُوداً لمّا أيقَنُوا بالعذاب تَكَفَّنُوا بالأَنْطاع وتَحَنَّطوا بالصبر «3» .
__________
(1) البيت في التهذيب و 4/ 387 واللسان (حلط) ورواية اللسان: لا أعود ورائيا وصدره:
(2) زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث. وفي (س) : يحنط به الميت خاصة.
(3) التهذيب 4/ 390.
(3/171)
________________________________________
نحط: النَّحْطةُ: داءٌ يُصيب (الخيل) «1» والإبل في صدورها، فلا تكاد تسلم منه. والنَّحْطُ شِبْه الزَّفير، والقَصَّار يَنْحِط إذا ضَرَب بثوبِه على الحَجَر، ليكون أروَحَ له، قال الراجز: «2»
ما لك لا تنْحِطُ يا فلاّح ... إنَّ النَّحيطَ للسُّقاةِ راحُ
أي راحة. والنَّحّاط: الرَّجل المتكبِّر، وقال النابغة:
وتَنْحِطْ حَصانٌ آخِرَ اللَّيْل نَحْطةً ... تَقَضَّبُ منها أو تكادُ ضُلوعُها «3»
نطح: النَّطْح للكِباش ونحوها، وتناطحت الأمواج والسُّيُول والرجال في الحروب. والنَّطيح: ما يأتيكَ من أمامِك من الظِّباء والطَّيْر وما يُزْجَر. والنَّطيحة: ما تناطَحا فماتا، كان أهل الجاهلية يأكلونَها فنُهِيَ عنها.
باب الحاء والطاء والفاء معهما ف ط ح، ط ح ف، ط ف ح، مستعملات
فطح: الفَطَح: عِرَضٌ في وَسَط الرأس، وفي الأَرْنَبة حتى تلتزق بالوجه كالثور
__________
(1) زيادة من التهذيب 4/ 389 مما نسب إلى الليث.
(2) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز في غير الأصول
(3) البيت في التهذيب 4/ 390 واللسان (نحط) والديوان (ط. دمشق) ص 124.
(3/172)
________________________________________
الأفطَح، قال أبو النجم:
قبصاء لم تفطح ولم تُكَتَّلِ «1»
طحف: الطَّحْف: حَبٌّ يكون باليَمَن يُطْبَخ «2» .
طفح: طَفَحَ النَّهْر إذا امتَلَأَ. والشارب طافح «3» أي ممتلىء سُكْراً. والرِّيحُ تَطفَح القُطْنةَ إذا سَطَعَت بها، قال أبو النجم:
مُمَزَّقاً في الرِّيح أو مطفوحا «4»
وما طَفَح فوقَ شَيءٍ فهو طُفاحة كطُفاح القِدْر.
باب الحاء والطاء والباء معهما ح ط ب، ح ب ط، ب ط ح مستعملات
حطب: الحَطَب معروف، حَطَبَ يَحطِب حَطْباً وحطبا، المخفف مصدر، والمثَّقَل اسم. وحطَبْتُ القوم إذا احتَطَبتَ لهم، قال: «5»
__________
(1) الرجز في التهذيب واللسان (فطح) .
(2) عقب الأزهري فقال في التهذيب 4/ 392 فقال: قلت هو الطهف بالهاء ولعل الحاء تبدل من الهاء.
(3) وعبارة التهذيب عن الليث: ويقال للذي يشرب الخمر حتى يمتلىء سكرا: طافح.
(4) الرجز في اللسان (طفح) .
(5) القائل (ذو الرمة) والبيت في الديوان ص 665، وعجزه:
أصول ألاء في ثرى عمد جعد.
(3/173)
________________________________________
وهل أحطِبَنَّ القوم وهي عَرِيَّةٌ
(ويقال) «1» للمُخلِّط في كلامه وأمره: حاطبُ لَيْلٍ، مَثَلاً له لأنّه لا يَتَفَقّد كلامَه كحاطب اللَّيل لا يُبصر ما يجمع في حَبْله من رديء وجيّد. وحَطَب فلان بفُلان إذا سَعَى به. والحَطَب في القرآن «2» النَّميمة، ويقال: هو الشَّوك كانت تَحمله فتلقيه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-. ويقال للشديد الهزال حَطِبٌ «3» .
حبط: الحَبَط: وَجَع يأخُذُ البعيرَ في بَطْنه «4» من كَلأَ يَسْتَوْبِلُه، (يقال) «5» : حَبِطَتِ الإبِل تحبَط حَبَطاً. وحَبِطَ عَمَلُه: فَسَدَ، وأحبَطَه صاحبُه، واللهُ مُحْبِطٌ عمل من أشرك. و [الحبطات] «6» : حيٌّ من تميم.
بطح: بَطَحْتُه فانبَطَحَ. والبَطْحاء: مَسيل فيه دُقاق الحَصَى، فإنْ عَرُضَ واتَّسَعَ سُمِّيَ أبطَح. والبَطيحة: ماء مستنقِع بينَ واسِطٍ والبصرة، لا يُرَى طَرَفاه من سَعَته، وهو مَغيض دجلةَ والفُرات، وكذلك مَغايض ما بين البصرة والأهواز، والطَّفُ: ساحل البَطيحة.
__________
(1) زيادة من التهذيب.
(2) في قوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وهي أم جميل امرأة أبي لهب وكانت تمشي بالنميمة. (التهذيب 4/ 394) .
(3) وفي اللسان: وأحطب أيضا.
(4) هذه عبارة التهذيب أما في الأصول المخطوطة فهو: وجع يأخذ في بطن البعير.
(5) زيادة من التهذيب
(6) كذا في التهذيب 4/ 397، أما في الأصول المخطوطة ففيها: الحبط.
(3/174)
________________________________________
وتَبَطَّحَ السَّيْل أي: سالَ سَيْلاً عريضاً، قال ذو الرمة:
ولا زالَ من نَوْء السِّماكِ عليكُما ... ونَوْءِ الثُرَيّا، وابِلٌ مُتَبَطِّحُ»
وقال الراجز:
إذا تَبَطَّحْنَ على المحامِلِ ... تَبَطُّحَ البَطِّ بشَطِّ الساحِلِ «2»
والبَطْحاءُ والأبْطَحُ ومنِىً من الأبْطح «3» . ويقال: بين قَرْية كذا وقَرْية كذا بطحة «4» بعيدة.
باب الحاء والطاء والميم معهما ح ط م، ط م ح، ط ح م، م ح ط، ح م ط، م ط ح كلهن مستعملات
حطم: الحَطْمُ: كَسْرُك الشَّيْءَ اليابس كالعظام ونحوها، حَطَمْتُه فانحَطَمَ، والحُطامُ: ما تَحَطَّمَ منِه، وقِشْر البَيْض حُطام، قال الطرماح:
كأنَّ حُطامَ قَيْضِ الصَّيْف فيه ... فَراشُ صَميم أقحاف الشئون «5»
والحَطْمَةُ: السَّنة الشديدة. وحَطْمةُ الأسَد في المال: عَيْثه وفَرْسُه. [والحُطَمَةُ: النّار] «6» . وقيل: الحُطَمَةُ: بابٌ من جهنّم. والحطيم: حجر مكة.
__________
(1) البيت في التهذيب واللسان والديوان ص 77.
(2) الرجز في التهذيب واللسان والرواية فيهما:
............... ........... ... تبطح البط بجنب الساحل
(3) كذا في س أما في ص وط فقد جاء: بطحاء وأبطح.
(4) كذا في ص وط أما في س فقد جاء: بطيحة.
(5) البيت في التهذيب واللسان (حطم) والديوان (ط. مصر) ص 178
(6) ما بين القوسين من مختصر العين، من الورقة 71، زيد هنا لتقويم العبارة.
(3/175)
________________________________________
طحم: طَحْمة السَّيْل: دَفّاعُه ومُعْظَمُه. وطَحْمةُ الفِتْنة: جَوْلة الناس عندها، قال: «1»
تَرمي بنا خِنْدُفُ يوم الايسادْ ... طَحْمةَ إبليسٍ ومَرداةَ الراد «2»
محط: مَحَّطْتَ الوَتَرَ: أمرَرْتَ الأصابعَ عليه لتُصلِحَه، وكذلك تُمَحِّطُ العَقَبَ فَتُخَلَّصُه، والبازي يُمُحِّطُ ريشه: يُذهبه «3» ، وتقول: امتَحَطَ البازي «4» .
طمح: طَمَّحَ الفَرَسُ رأسه أي رفعه، وكذلك طَمَّحَ يَدَيْه «5» . وطَمَحاتُ الدَّهْر: شَدائدُه، [وربّما خُفِّف] «6» قال: «7»
باتت همومي في الصدر تحضؤها ... طمحات دهر ما كنت أدرؤها
وطَمَّحْتُ الشْيَء وغيرَه في الهواء أي رَمَيْتُ به تطميحاً. وطَمَح ببَصَره إذا رَمَى به إلى الشيْء. وفَرَس طامِحُ البَصَر والطَّرْف، قال: «8»
__________
(1) لم نهتد إلى القائل ولم نهتد إلى مصدر البيت ولم نجده فيما بين أيدينا من مظان.
(2) لم نهتد إلى القائل ولم نهتد إلى مصدر البيت ولم نجده فيما بين أيدينا من مظان.
(3) كذا في الأصول المخطوطة، أما في التهذيب فقد جاء: يدهنه. نقول: وقد جاء في اللسان كما في الأصول المخطوطة.
(4) ورد في الأصول المخطوطة مما أخل به الناسخ كلمةمحط وهي حديدة يسقل بها الجلد حتى تلين. ووجه الإخلال أن هذه المادة هي في حطط ولا صلة لها ب محط.
(5) أصل هذه العبارة في التهذيب طمح الفرس رأسه ويديه أي رفعه، وقد آثرنا إعادة ترتيب العبارة على الوجه الذي أثبتناه.
(6) من التهذيب 4/ 404 عن العين.
(7) البيت في التهذيب 4/ 404 وفي اللسان (حثنا) أيضا، غير منسوب. في الأصول: تحطاها، وهو تصحيف.
(8) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(3/176)
________________________________________
طمحت رءوسكم لتبلُغَ عِزَّنا ... إن الذليل بأن يُضامَ جديرُ
حمط: الحمطيط و [جمعه] الحَماطيط، والحَماط: نبْت. والحَماطة: حُرْقة يجدُها الرجلُ في حَلْقه، تقول. أجدُ في حَلْقي حَماطةً.
باب الحاء والدال والثاء معهما ح د ث يستعمل فقط
حدث: يقال: صارَ فلان أُحدوثة أي كَثَّروا فيه الأحاديث. وشابُّ حَدَثٌ، وشابَّة حَدَثة: [فتيّة] في السِّنِّ. والحَدَث من أحداث الدهر شِبْه النازلة، والأُحدوثة: الحديث نفسه. والحديث: الجديد من الأشياء. ورجل حِدْث: كثير الحديث. والحَدَث: الإِبْداء.
باب الحاء والدال والراء معهما د ح ر، ح د ر، ر د ح، ح ر د، د ر ح مستعملات
دحر: دَحَرْتُه أدحَرُه دَحْراً أي بعَّدتُه ونَحَّيْتُه. ومَلُوماً مَدْحُوراً
«1» أي: مطرودا.
__________
(1) من سورة الأعراف، الآية 18، والآية هي: قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً.
(3/177)
________________________________________
حدر: الحَدْر: ما تحدِرُه من علو إلى سفل، والمطاوعة منه الأنْحدار، وحَدَرْتُ السَّفينة في الماء حُدوراً. والحَدور اسم مُنحَدَر الماء في انحطاط صبَبَه، وكذلك الحَدور في سَفْح جَبَل. وحَدَرْتُ القرِاءةَ حَدْراً، وحَدَرَتْ عيَنْي الدَّمْعَ، وانحدَرَ الدمعُ. وناقةٌ حادرةُ العينين أي ممتلئتهما «1» نقيا قد ارتوتا وحَسُنَتا «2» . وكل رَيّان حَسَن الخَلْق حادر، وقد حَدُرَ حدارة، قال: «3»
وعسير «4» أدماء حادرة العين ... خَنُوفٍ عَيْرانةٍ شِمْالال
وقال: «5»
أُحِبُّ صَبيَّ «6» السَّوْء من أجل أُمِّه ... وأُبْغِضُه من بُغْضِها وهو حادِرُ
وامرأةٌ حَدْراءُ، ورجل أحْدَرُ. والحَدْرة (جزم) «7» : قَرْحةٌ تخرج بباطن جَفْن العَيْن (وقد) «8» حَدَرتْ عينه حَدْراً. ويقال: الحَدْر في نعت العَيْن في حسنها خاصة مثل الحادرة، قال: «9»
وأنكرْتَ من حَدْراءَ ما كنت تعرف
__________
(1) كذا في س في ص وط: ممتلئتها.
(2) كذا في التهذيب مما نسب إلى الليث. في الأصول المخطوطة: قد ارتوت وحسنت.
(3) هو (الأعشى الكبير) ، والبيت في ديوانه (الصبح المنير) ص 6.
(4) كذا في الديوان ص 5. والتهذيب واللسان أما في الأصول المخطوطة ففيها: وعيسين، وهو تصحيف.
(5) لم نهتد إلى القائل، والبيت في التهذيب واللسان.
(6) كذا في الأصول المخطوطة، وأما في التهذيب واللسان ففيهما: الصبي.
(7) كذا في الأصول المخطوطة، ويراد به إسكان الدال في الحدرة، وقد صحف في التهذيب واللسان فصار جرم ولا معنى له.
(8) زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(9) القائل هو (الفرزدق) ، والبيت في التهذيب واللسان والديوان 2/ 551، وصدره:
عزفت بأعشاش وما كنت تعزف
(3/178)
________________________________________
وحيدرة: اسم علي بن أبي طالب عليه السلام- في التوراة، وارتجَزَ فقال:
أنا الذي سَمَّتْني أُمّي حَيْدَرَه «1»
وحَدَرَ جِلْده يحدُرُ حُدوراً أي تَوَرَّمَ، قال: «2»
لو دَبَّ ذرٌّ فوقَ ضاحي جلدها ... لأبانَ من آثارِهنَّ حُدورُ
ومنه يقال: حَدَرْتُ جلدَه بضرْبٍ، وأحْدَرتُ لغة.
ردح: الرَّدْح: بَسْطُكَ الشَّيء فَتُسَوٍّي ظهرهَ بالأرض، قال أبو النجم:
بَيْتَ حُتُوفٍ مُكْفأً مردوحا «3» ... شَخْتا خَفيّاً في الثَّرَى مدحُوحا «4»
يصف القُتْرة. ويجيء في الشعر مُردَح مثل مَبْسُوط ومُبْسَط. وناقةٌ رَداحٌ: ضَخْمة العَجيزة والمآكِم «5» ، تقول: رَدُحَت رَداحةً فهي رَدُوحٌ ورَداحٌ. وكَبْشٌ رَداح: ضَخْم الأَلْية، قال: «6»
ومَشَى الكُمأةُ إلى الكماة ... وقُرِّبَ الكبَشْ الرَّداحْ
وكتيبة رَداح: مُلَمْلَمة كثيرة الفُرسان «7» .
__________
(1) الرجز في التهذيب واللسان وهو أول ثلاثة أشطار.
(2) (عمر بن أبي ربيعة) ديوان ص 146 (صادر) .
(3) في صحاح الجوهري: مكفحا مردوحا.
(4) كذا في س وهو الصواب أما في ص وط فهو: شحتا بالحاء المهملة.
(5) جاء في التهذيب واللسان مما نسب إلى الليث: وامرأةرداح أي ضخمة العجيزة والمآكم.
(6) البيت في اللسان (ردح) غير منسوب.
(7) في التهذيب واللسان: وكتيبة رداح أي ضخمة ململمة....
(3/179)
________________________________________
حرد: الحَرَدُ مصدر الأحْرَد الذي إذا مَشَى رَفَعَ قوائمه رفعاً شديداً ويَضَعُها مكانَها من شِدَّة قَطافته في الدَّوابِّ وغيرها. وحَرِدَ الرجلُ فهو أحرَد إذا ثَقُلَتْ «1» عليه دِرعُه فلم يستطع الانبِساط في المشْي، قال:»
إذا ما مَشَى في دِرْعِه غيرَ أحرَدِ
والحَرْدُ والحَرَد لغتان، يقال: حَرِدَ فهو حَرِد إذا اغتاظ فَتَحرَّشَ بالذي غاظه وهَمَّ به فهو حاردٌ، قال: «3»
أسود شرى لاقت أسود خفية ... تساقين سما، كَلُّهُنَّ حَوارِدُ
وقطاً حُرْدٌ أيْ سِراع، قال: «4»
بادَرْتُ حردا من قطاها النامي
وقول الله جل ذكره: وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ
«5» ، أيْ على جِدٍّ من أمرهم. وحَرِدَ السَّيْرُ إذا لم يستَوِ قَطْعُه. والحُرْديّة: حِياصة الحَظيرة التي تُشَدُّ على حائطٍ من قَصَب عَرْضاً (تقول) «6» : حَرَّدناه تحريداً، ويجمع على حرادي.
__________
(1) في التهذيب: ثقل.
(2) الشطر في التهذيب واللسان غير منسوب أيضا.
(3) لم نهتد إلى القائل، والبيت من شواهد التهذيب واللسان. غير أن في اللسان رواية لبيت منسوب إلى (الأشهب بن ميلة) وهو:
أسود شرى لاقت أسود خفية ... تساقوا على حرد غماء الأساود
(4) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول.
(5) سورة القلم، الآية 25.
(6) زيادة من التهذيب.
(3/180)
________________________________________
وحَيٌّ حَريدٌ: (الذي) «1» ينزل مَنزِلاً من جَماعَة القبيلة لا يخالطهم في ارتِحاله وحُلُولِه. والحِرْد: قِطعة من سِنَام «2» . والمُحاردةُ: انقِطاعُ اللَّبَن من المَواشي والإبِل، وناقة مُحاردِ: شديدةُ الحِراد. والحَرْدُ: القَصْد، قال: «3»
أَقَبلَ سَيْلٌ جاء من أمْر الله ... يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المُغِلَّةْ
باب الحاء والدال واللام معهما ح د ل، د ح ل، ل ح د، د ل ح، مستعملات
حدل: الأحْدَلُ: ذو الخُصْيَة الواحدة من كُلِّ شيء، ويقال لمِائِل الشِّقَّينْ أيضا. والحودل: المُذَكَّر من القِرْدان. وبَنو حُدال: حَيُّ نُسبوا إلى محَلَّة [كانوا ينزلونها] «4» . والتَّحادُل: الانحناء على القوس.
__________
(1) زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(2) وعلق الأزهري في التهذيب (4/ 415) فقال: قلت: لم أسمع بهذا لغير الليث، وهو خطأ، إنما الحرد المعى.
(3) البيت في التهذيب واللسان غير منسوب.
(4) تكملة من اللسان (حدل) ، للبيان.
(3/181)
________________________________________
دحل: الدَّحْل: مَدْخلٌ تحتَ الجُرْف أو في عُرْض جَنْب «1» البئر في أسفلِها، أو نحوه من المناهِل والموارد، ورُبَّ بيت من بُيُوت الأَعراب يُجْعَل له دَحْل تدخُلُ المرأةُ فيه إذا دَخَلَ عليهم داخِلٌ، وجمعُه دُحْلان وأدحال، قال: «2»
دَحْلُ أبي المِرقال خيرُ الأدْحالْ
والداحُول وجمعه دَواحيل: خشبات على رءوسها خِرَقٌ كأنهَّا طَرّاداتٌ قِصارٌ، تُرْكَز في الأرض لصيد الحمر «3» . والدحل: [ال] عظيم البطن، ويقال: الخَدّاع.
لحد: اللَّحْد: ما حُفِرَ في عُرْضِ القَبْر، وقَبْرٌ مُلْحَد، ويقال: مَلْحُود، ولَحَدوا لَحْداً، قال ذو الرمة:
أَناسِيُّ ملحود لها في الحواجب «4»
شبَّه إنسانَ العَيْن تحت الحاجِب باللَّحْد، حين غارت عُيون الإبِل من تَعَب السَّيْر. والرجل يلْتَحِد إلى الشَيء: يلجأُ إليه ويميَل، يقال: أَلْحَد إليه ولَحَدَ إليه بلسانه أيْ: مال، ويُقرأ: لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ ويلحدون «5» .
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة، في التهذيب واللسان: خشب. وهو تصحيف لأنه لا يتناسب مع قوله في أسفلها.
(2) لم نهتد إلى الرجز ولا إلى قائله.
(3) جاء في التهذيب واللسان: لصيد الحمر والظباء.
(4) وصدر البيت في الديوان ص 63 وهو:
إذا استوجست آذانها استأنست لها
(5) إشارة إلى الآية 103 من سورة النحل: لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.
(3/182)
________________________________________
وأَلْحَد في الحَرَم، (ولا يقال: لَحَدَ) «1» إذا تَرَكَ القَصد ومال إلى الظلم، ومنه قولُه تعالى: مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ
«2» يعني في الحَرَم، قال حميد الأرقط: «3»
لما رَأَى المُلْحِدُ حينَ أَلْحَما ... صواعِقَ الحجّاج يَمْطُرنَ دَما «4»
دلح: دَلَح البعيرُ فهو دالِحٌ إذا تثاقَلَ في مَشْيِه من ثِقَلِ الحِمْل. والسَّحابةُ تَدْلَح في سَيْرها من كَثْرة مائِها، كأنَّما «5» تَنْخَزِلُ انخِزالاً، قال: «6»
بينما نحن مُرتِعون بَفَلْجٍ ... قالتْ الدُلَّحُ الرِّواءُ أنيه «7» .
__________
(1) سقطت العبارة المحصورة بين القوسين من التهذيب واللسان مما نسب إلى الليث وبذلك اختل المعنى.
(2) سورة الحج، الآية 25
(3) الرجز في التهذيب واللسان وروايته في الأصول المخطوطة:
لما رَأَى المُلْحِدُ حينَ ألجما.
(4) وجاء في الأصول المخطوطة بعد هذا البيت ما يجب ألا يضم إلى كتاب العين لأنه كلام الليث وهو: قال الليث: حدثني شيخ من بني شيبة في مسجد مكة قال: إني لأذكر حين نصب المنجنيق على أبي قبيس، وابن الزبير متحصن في البيت، فجعل يرميه بالحجارة والنيران، فاشتعلت النار في أستار الكعبة (حتى أسرعت فيها) ، فجاءت سحابة من نحو الجدة مرتفعة كأنها ملاءة يسمع منها الرعد ويرى فيها البرق حتى استوت فوق البيت فمطرت فما جاوز (مطرها البيت ومواضع الطواف) حتى أطفأت النار، وسال المرزاب في الحجر، ثم عدلت إلى أبي قبيس فرمت بالصاعقة فأحرقت المنجنيق وما فيها. قال الليث: فحدثت بهذا الحديث بالبصرة قوما، وفيهم رجل من أهل واسط، وهو ابن سليمان الطيار شعوذي الحجاج، فقال الرجل: سمعت أبي يحدث بهذا الحديث، وقال: لما أحرقت المنجنيق أمسك الحجاج عن (القتال) ، وكتب إلى عبد الملك بالقصة على ما كانت بعينها، فكتب إليه عبد الملك: أما بعد فإن بني إسرائيل إذا قربوا قربانا فتقبل الله منهم بعث نارا من السماء فأكلته، وإن الله قد رضي عملك، وتقبل قربانك فجد في أمرك والسلام. نقول: ما ورد بين قوسين من كلام الليث المتقدم في هذه الحاشية (4) أخذناه من التهذيب لأن عبارته أصلح من عبارة الأصول المخطوطة.
(5) كذا في الأصول المخطوطة، أما في التهذيب مما نسب إلى الليث فإنه: كأنها.
(6) لم نهتد إلى القائل، ولم نجد البيت في أي من المصادر التي رجعنا إليها.
(7) لعلها: إن إية وخففت بحذف همزة (إيه) ونقل حركتها إلى نون (أن بدلالة قوله: أي: صبي وافعلي.
(3/183)
________________________________________
تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
الكتاب: كتاب العين
المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ)
المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي
الناشر: دار ومكتبة الهلال
عدد الأجزاء: 8
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
حاول منه العرضُ طولاً سَلْهَبا ... أكْتَدَ دُعْميَّ الحوامي جسزبا
ودُعْمِيُّ كلِّ شيءٍ أشدُّه وأكْثَرُهُ. والدَّعْمُ: تقويةُ الشيءِ الواهنِ، نحو: الحائط المائل فتدعَمه بدِعامةٍ من خلفه، وبه يشبّه الرّجل السيّد يقال: دِعامةُ العشيرة، أي: به يتقوَّوْن. ودعائم الأمور: ما كان قوامها.
معد: الْمَعِدَةُ: [ما] «15» يستوعبُ الطعام من الإنسان، والمِعْدَةُ لغةٌ. قال: «16»
معداً وقلْ لجارتَيْك تمعدا ... إنّي أرى المعد عليها أجودا
قال هذا ساقٍ يسقي إبِلَهُ فاستعان بجاريته إذ لا أعوان له يقول: امعدْ ونادِ جاريتك. والمَعْدُ: أن تأخذَ الشيء من الرّجل ويأخذَهُ منك. والمَعْدُ: نزعُ الماء من البئر. ومُعِدَ الرّجل فهو [مَمْعُودٌ «17» ] ، أي: دويت معدته فلم يستمرىء ما يأكل واشتكاها. ويجوز جمعه على المِعَدِ. مَعَدّ: اسم أبي نزار. والتّمعدُدُ: الصبر على عيشهم في سفر وحضر. تَمَعْدَدَ فلانٌ. وكذلك إذا عاد إليهم بعد التحوّل عنهم إلى غيرهم.
__________
(15) زيادة اقتضاها السياق.
(16) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في المراجع.
(17) ص، ط: معمود. س: معود.
(2/61)
________________________________________
والمَعَدُّ مشددة الدّال: اللحم الذي تحت الكتف، أو أسفل منه قليلاً، من أطيب لحم الجنب «18» . ويقال: المَعَدّان من الفرس ما بين كتفيه إلى مؤخر متنيه. قال ابن أحمر «19» :
وإمّا زالَ سرجٌ عن معدٍّ ... وأَجْدِرْ بالحوادثِ أن تكونا
وقال «20» :
وكأنّما تحتَ المعدِّ ضئيلةٌ ... ينفي رُقادَكَ لَدْغُها وسِمامُها
ومَثَلٌ تضربه العرب: قد يأكلُ المعدّيّ أكل السوء، وهو في الإشتقاق يخرج على مَفْعَل، وعلى تقدير فَعَلٍّ على مثال عَلَدٍّ ونحوه، ولم يشتقّ منه فِعْلٌ. مَعْدان: اسم رجل، ولو اشتق منه من سعة المعدة فقيل: معدان واسع المعدة لكان صواباً. والمُعَيْديْ: رجل من كنانة صغير الجثة عظيم الهيبة قال له النّعمان: أن تسمع بالمعَيْديْ خير من أن تراه فذهب مثلا. والمعد: الجَذْبُ. مَعَدْته مَعْداً. ويقال: امْعَدْ دَلْوَكَ، أي: انزَعْها وأَخْرِجْها من البئر. قال الراجز «21» :
يا سعدُ يا ابن عَمَل يا سَعْدُ ... هل يُروِيَنْ ذَوْدَكَ نَزْعٌ معد
__________
(18) س: الجيب، وهو تصحيف.
(19) البيت في التهذيب 2/ 261 والرواية فيه: فإما زل.
(20) البيت في التهذيب 2/ 261، والرواية فيه: سمها وسمامها. وفي اللسان (معد) والرواية فيه: سمها وسماعها.
(21) القائل: (أحمد بن جندل السعدي) كما في المحكم 2/ 30 واللسان (معد) . غير أن الرواية في اللسان: يا ابن عمر. والثاني في التهذيب 2/ 259 بدون عزو.
(2/62)
________________________________________
والمَعْدُ: الغضّ من الثّمار. والتَّمَعْدُدُ: التّردُّد في الّلصوصيّة.
دمع: دَمِعَتِ العينُ تدمَعُ دَمَعاً ودَمْعاً ودُمُوعاً. من قال: دمعت قال: دمعا، ومن قال: دَمَعَتْ قال: دَمْعاً. وعين دامعة، والدّمْع: ماؤها. والدَّمْعَة القطرة. والمَدْمَعُ: مجتمع الدّمع في نواحيها. يقال: فاضت مدامعي ومدامع عيني. والماقيان من المدامع، وكذلك المؤخّران. وامرأة دَمِعَةٌ: سريعة الدمعة والبكاء، وإذا قلت: ما أكثر دَمْعَتَها خفّفت، لأنّ ذلك تأنيث الدمع. قال «22» :
قد بليت مهجتي وقد قرح المد ... مع ...
ويقال للماء الصّافي: كأنّه دمعة. والدَّمّاع من الثّرى ما تراه يتحلّب عنه النّدى، أو يكاد. قال «23» :
من كلِّ دمَّاعِ الثَّرَى مُطَلَّلِ ... يُثِرْنَ صيفيّ الظّباءِ الغُفَّلِ
ودُمّاعُ الكَرْمِ ما يسيل منه أيّام الربيع. والدَّمّاعُ: ما تحرّك من رأس الصبيّ إذا ولد ما لم «24» يشتدّ، وهي اللّمّاعة والغاذية أيضاً. وشجّة دامعة: تسيل دما.
__________
(22) هكذا في النسخ ولم نقف عليه في المراجع التي بين أيدينا.
(23) لم نهتد إلى القائل. والأول في المحكم 2/ 32 وفي اللسان (دمع) بلا عزو أيضا.
(24) نفس المصدر السابق.
(2/63)
________________________________________
باب العين والتاء والذال معهما ذ ع ت يستعمل فقط
ذعت: ذَعَتُّ فلاناً أَذْعَتُهُ ذَعْتاً إذا أخذتَ برأسه ووَجْهِهِ فمعكتَهُ في التراب مَعْكاً كأنّك تَغُطُّه في الماء، ولا يكون الذّعتُ إلا كذلك. ويقال: الذّعتُ: الخَنْقُ. ذَعَتّه: خَنَقْته، حتى قَتَلْته.
(2/64)
________________________________________
باب العين والتاء والراء معهما ع ت ر- ت ر ع- ر ت ع مستعملات
عتر: عَتَرَ الرّمْحُ يَعْتِرُ عَتْراً وعَتَراناً، أي: اضطرب وتراءد في اهتزاز. قال «1» :
من كلِّ خَطّيٍّ إذا هُزَّ عَتَرْ
والعَتِيرة: شاة تذبح ويصب دمها [على رأ] «2» س الصَّنَم. والعاتِرُ: الذي يَعْتِرُ شاةً، يفعلونه في الجاهليّة، وهي المعتورة. قال «3» :
فَخَرَّ صريعاً مِثْلَ عاتِرةِ النُّسْكِ
أراد الشاةَ المعتورةَ. وربما أدخلوا الفاعل على المفعول إذا جعلوه صاحب واحد ذلك الوصف. كقولهم: أَمْرٌ عارفٌ، أي: معروفٌ، ولكن أرادوا أمراً ذا معرفةٍ، كما تقول: رجل كاس، أي: ذو كسوة، ونحوه وقوله: فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ «4» *، أي: مرضيّة. وجمعه عتائر وعتيرات. قال «5» :
عتائر مظلوم الهدي المذبح
__________
(1) الرجز في المحكم 2/ 32. بلا عزو.
(2) تتمة من اللسان (عتر) وهي في الأصل (ص) : بياض. في ط: ومهلهل. وفي س: مهلهد.
(3) لم نهتد إلى القائل. والشطر في التهذيب 2/ 263 وفي المحكم 2/ 32.
(4) سورة القارعة 7.
(5) لم نهتد إلى القائل ولا القول.
(2/65)
________________________________________
وأمّا العِتْر فاختلف فيه. قالوا: العِتْر مثل الذِّبْح، ويقال: هو الصّنم الذي كان تُعْتَرُ له العتائر في رجب. قال زهير «6» :
كناصبِ العِتْرِ دمَّى رأسَهُ النُّسُكُ
يصف صقراً وقطاة، ويُروَى: كَمَنْصِبِ العِتْر، يقول: كمنصب ذلك الصَّنَم أو الحجر الذي يُدَمَّى بدم العتيرة. ومن روى: كناصب العتر يقول: إنّ العاتر إذا عتر عتيرته دمّى نفسه ونصبه إلى جنب الصّنم فوق شرف من الأرض ليعلم أنه ذبح لذلك. وعِترةُ الرجل: أصله. وعِتْرَةُ الرَّجلِ أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمّه دِنْياً. وعِتْرةُ الثّغرِ إذا رقّت غروب الأسنان ونقيت وجَرَى عليها الماء فتلك العِتْرة. ويقال: إنّ ثغرَها لذو أُشْرَةٍ وعِتْرَةٍ. وعِتْرَةُ المسحاةِ: خشبتها التي تسمى يد المسحاة. عتوارة: اسم رجل من بني كنانة. والعِتْرَةُ أيضاً: بقلة إذا طالت قطع أصلها، فيخرج منه لبنٌ. قال «7» :
فما كنت أخشَى أن أقيم خلافهم ... لستة أبيات كما ينبت العِتْرُ
لأنه إذا قطع أصله نبتتت من حواليْه شُعَبٌ ستّ أو ثلاث، ولأن أصل العتر أقلّ من فرعه، وقال: لا تكون العترة أبداً كثيرة إنّما هنّ شجرات بمكان، وشجرات بمكان لا تملأ الوادي، ولها جراء شبهُ جراءِ العُلْقَة. والعُلْقَة شجرة يدبغ بها الأُهُب. والعِتْرَةُ [نبتة «8» ] طيبة يأكلها الناس ويأكلون جراءها.
__________
(6) ديوانه ص 178. وصدر البيت فيه:
فزل عنها ووافى رأس مرقبة
(7) البريق (عياض بن خويلد) . ديوان الهذليين 3/ 59.
(8) زيادة اقتضاها السياق.
(2/66)
________________________________________
ترع: التَّرَعُ: امتلاء الإِناء. تَرِعَ يَتْرَعُ تَرَعاً، وأترعته. قال جرير «9» :
فهنا كم ببابه رادحات ... من ذرى الكوم مترعات ركود
وقال «10» :
فافترش الأرض بسيلٍ أترعا
أي: ملأ الأرض ملءً شديداً. وقال بعضهم: لا أقول تَرِعَ الإناء في موضع الإمتلاء، ولكن أترع. ويقولون: تَرِعَ الرجلُ، أي: اقتحم الأمور مرحاً ونشاطاً، يَتْرَعُ تَرَعاً. قال «11» :
الباغيَ الحرب يسعى نحوها تَرِعاً ... حتى إذا ذاق منها جاحماً بردا
ترعاً، أي: ممتلئاً نشيطاً، جاحماً، أي: لهباً ووقوداً. وإنّه لمتَتَرِّعٌ إلى كذا، أي: متسّرع.
وقول رسول الله ص: إنّ مِنْبَري على تُرْعَةٍ من تُرَعِ الجنّة «12» .
يقال: هي الدّرجة، ويقال: هي البابُ، كأنّه قال: إنّ مِنْبَري على باب من أبواب الجنّة. والتُّرعَةُ، والجماعةُ التُّرَعُ: أفواه الجداول تفجر من الأنهار فيها وتُسْكَرُ إذا ساقوا الماء.
رتع: الرَّتْعُ: الأكل والشّرب في الربيع رغدا.
__________
(9) ليس في ديوانه، ولم نقف عليه فيما بين أيدينا من مراجع.
(10) (رؤبة) ديوانه. أرجوزة 33 ب 180 ص 92.
(11) لم نهتد إلى القائل، والبيت في التهذيب 2/ 267، وفي اللسان (ترع) .
(12) الحديث في التهذيب 2/ 266 والرواية فيه: إن منبري هذا..
(2/67)
________________________________________
رَتَعَتِ الإبلُ رَتْعاً، وأَرْتَعْتُها: ألقيتها في الخصب. قال العجّاج «13» :
يرتاد من أربا لهنَّ الرُّتَّعا
فأمّا إذا قلت: ارْتَعَتِ الإبل ترتعي فإنّما هو تفتعل من الرّعي نالت خصباً أو لم تنل، والرَّتْعُ لا يكون إلا في الخصب، وقال الفرزدق «14» :
اِرْعَيْ فزارةُ، لا هناكِ المَرْتَعُ
وقال الحجاج للغضبان: سمنت قال: أسمنني القَيْدُ والرَتَعَةَ، كما يقال: العز والمنعة والنجاة والأمنة. وقال «15» :
أبا جعفر لما تولَّيت أرتعوا ... وقالوا لدُنْياهُمْ أفيقي فدرّت
وقوم مُرتعون وراتعون. ورَتَعَ فلان في المال إذا تقلّب فيه أكلاً وشرباً. وإِبِلٌ رِتاع.
__________
(13) ليس في ديوانه.
(14) ديوانه 1/ 408 وصدر البيت:
ومَضَتْ لَمْسَلَمَةَ الرِّكابُ مُوَدَّعاً.
والرواية فيه فارعي.
(15) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول.
(2/68)
________________________________________
باب العين والتّاء والّلام معهما ع ت ل- ت ل ع يستعملان فقط
عتل: العَتَلَةُ: حديدةٌ كحد فأس عريضة ليست بمتعقّفة الرأس كالفأس، ولكنها مستقيمة مع الخشبة، في أصلها خشبة يحفر بها الأرض والحيطان. ورجل عُتُلٌّ أي: أكولٌ مَنُوع. والعَتْلُ: أن تأخذ بتلبيب رجل فَتَعْتِلَهُ، أي: تجرّه إليك، وتذهب به إلى حبس أو عذاب. وتقول: لا أَنْعتِلُ «1» معك، أي: لا أَنْقاد معك. وأخذ فلان بزمام النّاقة فَعَتَلَها، وذلك إذا قَبَض على أصْلِ الزِّمام عند الرأس فقادها قوداً عنيفاً. وقال بعضهم: العتلة عصاً من حديد ضخمةٌ طويلةٌ لها رأسٌ مُفَلْطَح مثل قَبيعةِ السيف مع البناة يهدمون بها الحيطان. والعَتَلَةُ: الهراوة الغليظة من الخشب، والجميع عَتَلٌ. قال الراجز «16» :
__________
(1) هذا من س. في الأصل بياض، وفي ط: (لأن المعتل) وهو تحريف.
(16) لم نهتد إليه.
(2/69)
________________________________________
وأينما كنت من البلاد ... فاجتنبنّ عرمَ الذّوّاد
وضّرْبَهم بالعَتَلِ الشِّداد
يعني عرامهم وشِرّتهم.
تلع: التَّلَعُ: ارتفاع الضّحى. وتَلَعَ النّهار ارتفع. قال «17» :
وكأنّهم في الآل إذ تَلَع الضّحى
وتَلَع فلان إذا أخرج رأسه من كل شيء كأن فيه وهو شبهُ طَلَعَ، غير أنّ طَلَعَ أعمُّ. وتَلَعَ الشاةُ يعني الثورَ، أي: أخرج رأسَه من الكناس. وأَتْلَعَ رأسَهُ، فنظر إتلاعاً، لأنّ فعلَه يجاوز، كما تقول: أطْلَعَ رأسه إطلاعاً. قال ذو الرّمة «18» :
كما أَتْلَعَتْ من تحتِ أَرْطَى صريمةٍ ... ألى نبأةِ الصوتِ الظِّباءُ الكوانِسُ
والأتلع من كلّ شيء: الطويلُ العُنُقِ. والأنثَى: تلعاء. والتّلِعُ والتَّرِعُ هو الأتلع، لأن الفَعِلَ يدخُلُ على الأَفْعَل. قال «19» :
وعَلَّقوا في تِلَعِ الرأسِ خَدِبْ
يعني بعيراً طويل العنق. وسيد تَلِعٌ، ورجلٌ تَلِعٌ، أي كثيرُ التلفّت حوله. ولزم فلانٌ مكانه فما يتتلّع، أي ما يرفع رأسه للنّهوض ولا يريد البراح. قال أبو ذؤيب «20» :
__________
(17) لم نهتد إلى القائل، والبيت في التاج، وعجزه فيه:
سفن تعوم قد ألبست إجلالا
(18) ديوانه. ق 36 ب 23 ص 1127 ج 2.
(19) الرجز في المحكم 2/ 37، واللسان (تلع) .
(20) ديوان الهذليين 1/ 6.
(2/70)
________________________________________
فوردن والعيوق مقعد رابىء ... الضُّرَباءِ فوقَ النَّظْمِ لا يتتلَّعُ
ويقال: إنّه لَيتتالَعُ في مشيِهِ إذا مدَّ عُنُقه ورفَع رأسَه. ومُتالع: اسم جبل بالحمى. ومُتالع اسم موضع بالبادية. قال لبيد «21» :
دَرَسَ المَنَا بمُتالعٍ فَأَبانِ ... فتقادَمَتْ بالحُبْسِ فالسُّوبانِ
والتّلعةُ: أرضٌ مرتفعة غليظة، وربما كانت مع غِلَظِها عريضة يتردّد فيها السّيلُ ثم يدفع منها إلى تلعةٍ أسفلَ منها. قال النابغة «22» :
فالتِّلاعُ الدَّوافِعُ
ويقال: التَّلعَةُ مقدار قفيزٍ من الأرض، والذي يكون طويلاً ولا يكون عريضاً. والقرارة أصغرُ من «23» التّلعة، والدّمعة أصغر من ذلك. ورجلٌ تليع، وجيدٌ تليع، أي: طويل. قال:
جيدٍ تليعٍ تزينه الأطواق
__________
(21) ديوانه. ق 16 ب 1 ص 138. المنا: منزل. والرواية فيه: وتقادمت.
(22) ديوانه. ق 3 ب 1 ص 42. وتمام البيت:
عفا حسم من فرتنا فالفوارع ... فجنبا أراك فالتلاع الدوافع
(23) (الأعشى
 ديوانه. ق 32 ب 6 ص 209. وتمامه فيه:
ديوانه. ق 32 ب 6 ص 209. وتمامه فيه:يوم تبدي لنا قتيلة عن جيدٍ ... تليعٍ تَزينُهُ الأَطْواقُ
(2/71)
________________________________________
باب العين والتاء والنون معهما ع ن ت- ن ع ت- ن ت ع مستعملات ع ت ن- ت ن ع- ت ع ن مهملات
عنت: العَنَتُ: إدخالُ المشقّةِ على إنسانٍ. عَنِتَ فلان، أي: لَقِيَ مشقّة. وتَعَنَّتُّه تَعَنُّتاً، أي: سألتُه عن شيءٍ أردتُ به اللَّبْسَ عليه والمشقّة. والعظم المجبورُ يصيبه شيءٌ فيُعْنِتُه إعناتاً، قال «1» :
فأَرْغَمَ الله الأنوفَ الرُّغَّما ... مَجدوعَها والعَنِتَ المُخَشَّما
المُخَشَّمُ: الذي قد كُسِرَتْ خياشيمُه مرّة بعد مرّة. والعَنَتُ: الإثْمُ أيضاً. والعُنْتُوتُ: ما طال من الآكام كلّها.
نعت: النَّعْتُ: وصفُكَ الشيءَ بما فيه. ويُقالُ: النَّعْتُ وصف الشيءِ بما فيه إلى الحسن مذهبُه، إلا أن يتكلّفَ متكلّفٌ، فيقول: هذا نعت سوء. فأمّا العرب العاربة فإنما تقول لشيءٍ إذا كان على استكمال النّعت: هو نعتٌ كما ترى، يريد التّتمة. قال:
أمّا القطاةُ فإنّي سوف أّنْعَتُها ... نَعْتاً يُوافِقُ نَعْتي بعضَ ما فيها
__________
(1) (رؤبة) ديوانه- أرجوزة 89 ب 14، 15 ص 184.
(2/72)
________________________________________
سكاء مخطومة في ريشها طَرَقٌ ... حُمْرٌ قوادمُها سُود خوافيها «2»
البيتان لامرىء القيس «3» . ويقال: صلماء «4» أصحّ من سكّاء، لأن السّكك قِصَرٌ في الأذن. فلو قال: صلماء لأصاب. و [النعت] «5» : كل شيء كان بالغاً. تقول: هو نعت، أي: جيّد بالغ. والنعت: الفرس «6» الذي هو غاية في العتق والروع إنه لنعت ونعيت. وفرس نعتة، بيّنة النّعاتة وما كان نعتاً، ولقد نعت، أي: تكلف فعله. يقال: نعت نعاتة. واستنعته، أي استوصفته. والنعوت: جماعة النّعت، كقولك: نعت كذا ونعت كذا. وأهل النحو يقولون: النعت خلف من الاسم يقوم مقامه. نَعَتُّه أَنْعَتُه نعتاً، فهو منعوت.
نتع: نَتَعَ العَرَقُ نتوعاً، وهو مثل نَبَعَ، إلاّ أن نَتَعَ في العرق أحسن.
__________
(2) البيتان في اللسان (طرق) بدون عزو والرواية فيه: سود قوادمها صهب خوافيها ومعهما بيتان آخران في التاج (طرق) نسبا في كتاب الطير لأبي حاتم إلى الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي أو ابن عباس على الشك. وعن ابن الكلبي: هما للعباس بن يزيد بن الأسود. والرواية فيه:
سود قوادمها كدر خوافيها.
(3) ليسا في ديوانه.
(4) ط وس: سلماء بالسين وهو تصحيف.
(5) زيادة اقتضاها السياق.
(6) في النسخ الثلاث: والفرس النعت وما أثبتناه فمما اقتضاه السياق.
(2/73)
________________________________________
باب العين والتاء والفاء معهما ع ف ت يستعمل فقط
عفت: العفت في الكلام كاللّكْنَةَ. عَفَتَ الكلامَ يَعْفِتُهُ عَفْتاً. وهو أن يكسرَهُ، وهي عربيّةٌ كعربيّةِ الأعجميّ أو الحبشيّ أو السّنديّ ونحوه إذا تكلّف العربيّة. وقال ابن القِرِّيَّةِ: لا يَعرِفُ العربيةَ هؤلاء الجراجمة الطمطمانيّون الذين يلفتونها لفتاً ويعفتونها عفتاً.
(2/74)
________________________________________
باب العين والتاء والباء معهما ع ت ب- ت ع ب- ت ب ع- ب ت ع مستعملات
عتب: العَتَبَةُ: أُسْكُفَّةُ البابِ. وجعلها ابراهيم ع كناية عن امرأة إسماعيل إذ أمره بإبدال عَتَبَتِه. وعتباتُ الدَّرَجة وما يشبهها من عتبات الجبال وأشراف الأرض وكلّ مَرْقاةٍ من الدرج عَتَبَة، والجميع العَتَب. وتقول: عتّب لنا عتبة، أي: اتَّخذ عَتَبات: أي: مَرْقَيات. والعتَب ما دخل في أمرٍ يُفْسِدُهُ ويُغَيِّرُهُ عن الخلوص. قال خلف بن خليفة «1» :
فما في حُسْنِ طاعتنا ... ولا في سمعِنا عَتَبُ
وحُمِلَ فلانٌ على عَتَبَةٍ كريهة، وعلى «2» عَتَبٍ كريهٍ من البلاء والشّرّ. والعتَب: التواءٌ عند الضريبة. قال امرؤ القيس «3» :
مُجَرَّبَ الوَقْعِ غَيْرَ ذي عتب
__________
(1) البيت في المحكم 2/ 40، وفي اللسان (عتب) غير منسوب.
(2) في النسخ: وكل. وما أثبتناه فمن حكاية الأزهري عن الليث.
(3) ليس في ديوانه. والبيت في المحكم 2/ 40، وفي اللسان (عتب) بدون عزو، وصدر البيت فيهما:
أعددت للحرب صارما ذكرا
(2/75)
________________________________________
يصف السيف، وقال المتلمّس «4» :
يُعْلَى على العَتَبِ الكريه ويُوبَسُ
أي: يكره ويرد عليه. والفحل المعقول، أو الظالع إذا مشى على ثلاث قوائم كأنّه يَقْفِزُ يقال: يَعْتِبُ عَتَباناً، وكذلك الأقطع إذا مشى على خشبة، وهذا تشبيه كأنّه ينزو من عتبة إلى عَتَبة. والعَتْبُ: الموجدة. عَتَبْتُ على فلان عَتْباً ومَعْتِبَةً، أي: وجدت [عليه] . قال «5» :
عتبتُ على جُمْلٍ ولستُ بشامتٍ ... بجُمْلٍ وإن كانتْ بها النَّعلُ زَلَّتِ
وأعتبني، أي ترك ما كنت أجِد [عليه] «6» ورجع إلى [مرضاتي] «7» والاسم: العُتْبَى. تقول: لك العُتبى. والتّعاتب إذا وصفا موجِدَتها، وكذلك المعاتبة إذا لامك واستزادك، قال «8» :
إذا ذهب العِتابُ فليس حبٌّ ... ويَبْقَى الحبُّ ما بقيَ العِتابُ
وأعطاني فلان العُتْبَى، أي أعتبني. قال «9» :
لك العُتْبَى وحبّايا خليلي
واستعتب، أي: طلب أن يعتب.
__________
(4) الشطر في التهذيب 2/ 278، وفي اللسان (عتب) بدون عزو.
(5) لم نهتد إليه.
(6) زيادة اقتضاها السياق.
(7) في الأصل، أي: ص: مسراتي. في ط: في س: سيرتي.
(8) البيت في اللسان (عتب) بدون عزو أيضا. والرواية فيه: ود ... الود.
(9) لم نهتد إليه.
(2/76)
________________________________________
وما وجدت في قوله وفعله عتباناً، إذا ذكر أنّه قد أعتبك، ولم يُرَ لذلك بيان. قال أبو الأسود في الإستعتاب «10» :
فعاتبته ثم راجعته ... عتاباً رفيقاً وقولاً أصيلا
فألفيته غيرَ مستعتب ... ولا ذاكِرِ الله إلاّ قليلا
نصب ذكر الله على توهّم التنوين، أي: ذاكرٍ الله. وعُتَيْبَة وعتّابة من أسماء النّساء، وعُتْبَة وعتّاب ومُعَتِّب من أسماء الرجال «11» وعَتِيب اسم قبيلة.
تعب: التَّعَبُ: شدّة العناء. والإِعجال في السّير والسَّوق والعمل. تَعِبَ يَتْعَبُ تَعَباً. فهو تَعِبٌ. وأتْعَبْتُه إتعاباً [فهو] «12» مُتْعَبٌ، ولا يقال: متعوبٌ. وإذا أعْتِبَ العظم المجبور، وهو أوّل بُرْئِه قيل أُتْعِبَ ما أُعْتِبَ. قال ذو الرمة «13» :
إذا ما رآها رأية هيض قلبه ... بها كانهياضِ فيِ المُتْعَبِ المتتمّم
يعني أنّه تتمّم جبره بعد الكسر.
__________
(10) ديوان ص 203 ورواية البيت الأول فيه:
فذكرته ثم عاتبته ... عتابا رقيقا وقولا جميلا
(11) أصل العبارة المحصورة بين الزاويتين هنا، في النسخ: عتيبة من أسماء الناس وعتابة وعتيبة ومعتب وعيب اسم قبيلة وهي هنا مضطربة كما ترى، وقد عدلت كما هي بين الزاويتين من حكايات اللغويين عن الليث أو عن الخليل في العين.
(12) زيادة اقتضاها السياق.
(13) ديوانه. ق 38 ب 15 ص 1173 ج 2. والرواية فيه:
إذا نال منها نظرة هيض قلبه ...
(2/77)
________________________________________
تبع: التّابع: التالي «14» ، ومنه التتبّعُ والمتابعة، والإتّباع، يتبَعه: يتلوه. تَبِعَه يَتْبَعُهُ تَبَعاً. والتَّتَبُّعُ: فعلك شيئاً بعد شيء. تقول: تتبّعتُ علمه، أي: اتّبعت آثاره. والتّابعة: جِنِّيَّة تكون مع الإنسان تتبعه حيثما ذهب. وفلانٌ يتابع الإِماء، أي: يُزانيهنَ. والمتابعة أن تُتْبِعَهُ هواك وقلبك. تقول: هؤلاء تبع وأتباع، أي: مُتَّبِعُوك ومتابعوك على هواك. والقوائم يقال لها تَبَعٌ. قال أبو دؤاد «15» :
وقوائم تَبَعٌ لها ... من خلفها زَمَعٌ مُعَلَّقْ
يصف الظبية. وقال «16» :
يَسْحَبُ اللَّيْل نجوماً طُلَّعا ... وتواليها بطيئات التَّبَع
والتّبيع: العِجْلُ المُدْرك من ولد البقر الذّكر، لأنه يتبع أمّه بعدوٍ. والعدد: أَتْبِعَة، والجميع: أتابيع. وبَقَرٌ مُتْبِعٌ، أي: خلفها تبيع. وتَبِعْتُ شيئاً، واتّبعْتُ سواء.
__________
(14) في ص: التا. وفي ط: الد. أما في س فقد سقطت هذه الكلمة منها.
(15) البيت في التهذيب 2/ 282. وفي المحكم 2/ 43 إلا أن الرواية فيه:
من خلفها زمع زوائد
وجاءت الروايتان كلتاهما في اللسان (تبع) على عادته في جمع الروايات.
(16) لم نهتد إليه.
(2/78)
________________________________________
وأَتْبَعَ فلانٌ فلاناً إذا تَبِعَه يُريد شرّا. قال الله عزّ ذِكْرُهُ: فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ «17» والتّتابُعُ ما بين الأشياء إذا فعل هذا على إثر هذا لا مهلة بينهما كتتابع الأمطارِ والأمورِ واحدا خلف آخر، كما تقول: تابع بين الصلاة والقراءة، وكما تقول: رميته بسهمين تِباعاً وولاءً ونحوه. قال «18» :
متابعة تذبّ عن الجواري ... تتابع بينها عاماً فعاما
والتَّبيع: النَّصير «19» . والتَّبِعَةُ هي التَّباعَةُ، وهو اسم الشيء الذي لك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها. والتُّبَّعُ والتُّبُّعُ: الظلّ، لأنه مُتَّبعٌ حيثما زال. قال الفرزدق «20» :
نرد المياه قديمة وحديثة ... وِرْدَ القَطاةِ إذا اسْمِأَلَّ التُّبَّعُ
والتُّبَّعُ ضربٌ من اليعاسيب، أحسنها وأعظمها، وجمعها: تبابيع. تُبَّع: اسم ملكٍ من ملوك اليمن، وكان مؤمناً، ويقال: تُبّت اشتقّ لهم هذا الاسم من تُبَّع ولكن فيه عُجْمة، ويقال: هم من اليمن وهم من وضائع تبّع بتلك البلاد. والتّبيع الذي له عليك مال يتابعك به، أي: يطالبك.
__________
(17) سورة الأعراف 175.
(18) لم نهتد إليه.
(19) بعده كلمة هكذا رسمت في النسخ: (المثام) ولم يقع لنا مفادها.
(20) ليس في ديوانه والبيت في المحكم 2/ 43 منسوب إلى (الجهينية) . وفي اللسان (تبع) منسوب إلى (سعدى الجهنية) ترثي أخاها أسعد. والرواية فيهما:
يرد المِياهَ حَضيرةً ونَفيضةً ... وِرْدَ القطاة إذا اسمأل التبع
(2/79)
________________________________________
وأتبعت فلاناً على فلان، أي: أحلته عليه، ونحو ذلك.
بتع: البِتْعُ والبِتَعُ معاً: نبيذ يتّخذ من العسل كأنّه الخَمْرُ صلابةً. وأما البَتِعُ فالشديدُ المفاصلِ والمواصل من الجسد. قال سلامة بن جندل «21» :
يرقى الدسيع إلى هاد له بَتِعٍ ... في جُؤْجُؤٍ كَمَداكِ الطِّيبِ مخضوبِ
أي: شديد موصول. وقال رؤبة: «22»
وقَصَباً فَعْماً وعُنْقاً أَبْتَعا
أي: صلبا، ويروى: أرسعا.
__________
(21) ديوانه. ق 1 ب 11 ص 106 والرواية فيه: تم الدسيع.
(22) ديوانه: (أبيات مفردات) . رقمه 57 ص 178. والرواية فيه: ورسغا أبتعا.
(2/80)
________________________________________
باب العين والتاء والميم معهما ع ت م- ع م ت- م ت ع مستعملات ت م ع- ت ع م- م ع ت مهملات
عتم: عتّم الرّجلُ تعتميا إذا كفّ عن الشيء بعد ما مضى فيه. قال حُمَيْد «23» :
عَصاهُ منقارٌ شديدٌ يلطمُ ... مجامعَ الهامِ ولا يُعَتّمُ
يصف الفيل. عصا الفيل منقاره، لأنّه يضرب به كلّ شيء. وقوله: لا يعتّم، أي: لا يكفّ ولا يهمل. وحملت على فلان فما عتّمت، أي: ضربته فما تنهنهت وما نكلت ولا أبطأت. وعَتَمْتُ فأنا عاتِمٌ، أي: كففت. قال «24» :
ولستُ بوقّافٍ إذا الخيلُ أَحْجَمَتْ ... ولستُ عن القرن الكميّ بعاتمِ
والعاتم: البطيء. قال «25»
ظعائنُ أمّا نيلهن فعاتم
__________
(23) ليس في ديوان حميد بن ثور الهلالي، فلعله (لحميد الأرقط) .
(24) لم نهتد إليه.
(25) لم نهتد إليه.
(2/81)
________________________________________
وفي الحديث «26» : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ناول سلمان كذا وكذا وديّة فَغَرَسَها فما عَتَّمتْ منها وَديَّة،
أي، ما أبطأتْ حتى عَلِقَتْ. والعَتَمَةُ: الثُلُثُ الأوّلُ من الليل بعد غيبوبة الشَّفَق. أَعْتَمَ القوم إذا صاروا في ذلك الوقت، وعتّموا تعتيماً ساروا في ذلك الوقت، وأوردوا أو أصدروا في تلك السّاعة. قال «27»
يَبْني العُلَى ويبتني المكارما ... أقراهُ «28» للضَّيفِ يثوبُ عاتِما
والعُتْمُ: الزّيتونُ يُشْبِهُ البرّي لا يَحْمِلُ شيئاً.
عمت: العَمْتُ: أن تَعْمِتَ الصّوفَ فتلُفّ بعضَه على بعضٍ مستطيلاً أو مستديراً، كما يفعلُه الذي يغزلُ الصّوفَ فيُلقيه في يده أو نحو ذلك، والاسمُ: العَميتُ، وثلاثة أَعْمِتَةٍ، وجمعه: عُمُتٌ. قال «29» :
يظَلُّ في الشّاء يرعاها ويَحْلُبُها ... ويَعْمِتُ الدّهرَ إلاّ ريْثَ يَهْتَبِدُ
ورجل عمّات وامرأة عمّاتة إذا كانت جيدة العَمْت. وعمَّتَ الصّوفَ تعميتاً. وعَمْتُ الصّوفِ أن تعمِتَه عمائت. والعميتة: [ما] «30» ينفش [من] «31» الصوف، ثم يمدّ، ثم يُجْعل حبالا، يلقى بعضه على بعض، ثم يغزل «32» .
__________
(26) ورد الحديث في التهذيب 2/ 228.
(27) الرجز في اللسان غير منسوب أيضا.
(28) ط: اقرأه س: قراءة.
(29) البيت في التهذيب 2/ 290، وفي اللسان (عمت) بدون عزو.
(30) في النسخ: أن.
(31) زيادة اقتضاها السياق.
(32) سقطت من س.
(2/82)
________________________________________
قال:
حتى تطير ساطعاً سختيتا ... وقطعاً من وَبَر عميتا
وقيل: العَمْتُ: أن تضربَ ولا تُبالي من أصابَ ضربُك.
متع: متع النَّهارُ متوعاً. وذلك قبل الزّوال. ومتع الضّحى. إذا بلغ غايته عند «33» الضحى الأكبر. قال «34» :
وأدركْنا بها حَكَمَ بنَ عمرٍو ... وقد مَتَعَ النَّهارُ بنا فزالا
والمتاعُ: ما يَستمتع به الإنسانُ في حوائجه من أمتعة البيت ونحوه من كلّ شيء. والدنيا متاعُ الغرور، وكلّ شيء تمتعت به فهو متاع، تقول: إنّما العيشُ متاعُ أيّام ثم يزول [أي بقاء أيام] «35» ومتّعك اللهُ به وأَمْتَعَكَ واحدٌ، أي: أبقاك لتستمتع به فيما تحب من السرور والمنافع. وكلّ من متّعته شيئاً فهو له متاعٌ ينتفع به. ومُتعةُ المرأةِ المطلّقةِ إذا طلّقها زوجُها. متّعها مُتعةً يعطيها شيئاً، وليس ذلك بواجب، ولكنّه سُنّة. قال الأعشى «36» يصف صيّاداً:
حتّى إذا ذرَّ قرنُ الشمسِ صبَّحها ... من آل نبهانَ يبغي أهلَه مُتَعا
أي: يبغيهم صيداً يتمتعون به، ومنهم من يكسر في هذا خاصّة، فيقول: المِتعة. والمُتعةُ في الحجّ: أن تضمَّ عُمْرَةً إلى الحجّ فذلك التّمتع. ويلزمُ لذلك «37» دمٌ لا يجزيه غيره.
__________
(33) في س: عن.
(34) لم نقف على القائل. في ص: يبغي لأهله. وهو وهم من الناسخ.
(35) زيادة من التهذيب من رواية له عن الليث.
(36) في الديوان ص 105 والرواية فيه:
ذؤال بنهان يبغي صحبه المتعا
(37) في س وط: ذلك.
(2/83)
________________________________________
باب العين والظاء والراء معهما يستعمل ر ع ظ فقط
رعظ: الرُّعْظُ من السّهم: الموضعُ الذي يدخُل فيه سِنْخ النَّصْل. وفوقه الذي عليه لفائف العَقَبِ. ورُعِظَ السّهمُ فهو مرعوظ إذا انكسر رُعْظُه. قال «1» :
ناضلني وسهمُهُ مرعوظُ
ويقال: أُرْعِظَ فهو مُرْعَظٌ. يعني: مرعوظ. ويقال: إنّ فلاناً لَيكسِرُ عليك أَرْعاظَ النّبلِ غضباً. أبو خيرة: المرعوظ الموصوف بالضعف.
__________
(1) لم نقف على الراجز. في ط: فاضلني بالفاء.
(2/84)
________________________________________
باب العين والظاء واللاّم معهما ع ظ ل، ل ع ظ، ظ ل ع مستعملات
عظل: عَظَل يَعْظُلُ الجراد والكلاب وكلّ ما [يلازم] «2» في السّفاد. والاسم العِظال. قال «3» :
يا أمّ عمرٍو أبشري بالبشرى ... موت ذريع وجراد عَظْلَى
أي: يَسْفِد «4» بعضُها بعضاً. وعاظلها فعظلها، أي: غلبها. قال جرير «5» :
كلابٌ تعاظل سود الفقاح...............
لعظ: جاريةٌ مُلَعَّظة: طويلة سمينة.
__________
(2) من التهذيب في روايته عن الليث وفي الأصول: يلزم.
(3) لم نقف على الراجز.
(4) من س. في ص وط: أسفد.
(5) ليس في ديوانه والبيت في التهذيب واللسان والتاج غير منسوب، وتمامه:
لم تحم شيئا ولم تصطد
(2/85)
________________________________________
ظلع: الظَّلْع: الغَمْزُ، كأنّ برجله داءً فهو يظلع. قال كثير «6» :
وكنتُ كذاتِ الظَّلْعِ لمّا تحاملتْ ... على ظّلْعِها يومَ العثارِ استقلتِ
يصف عشقه، أخبر أنّه كان مثل الظالع من شدة العشق فلمّا تحامل على الهّجْر استقلّ حين حمل نفسَهُ على الشِّدّة، وهو كإنسان أو دابّة يصيبها حمر، فهي أقلّ ما تركب تغمز صدرها، ثم يستمرّ يقول: لمّا رأى الناس، وعَلِمَ أنّه لا سبيلَ له إليها حَمَلَ نفسَهُ على الصّبر فأطاعته. ودابّةٌ ظالعٌ، وبِرْذَوْنٌ ظالعٌ، الذّكرُ والأنثى فيه سواء.
__________
(6) البيت من قصيدته التائية. انظر الأمالي 2/ 108.
(2/86)
________________________________________
باب العين والظاء والنون معهما ع ن ظ، ظ ع ن، ن ع ظ مستعملات
عنظ: العُنْظُوانُ نباتٌ إذا استكثر منه البعيرُ وَجِعَ بطنُه. عَظِيَ البعير عظىً فهو عظٍ «1» . النون زائدة، وأصل الكلام: العين والظاء والواو، ولكنّ الواو إذا بنيت منه فَعِلَ «2» قلت: عَظِيَ مثل رَضِيَ، فالياء هو الواو وكسرته الضاد المكسورة، والدليل عليه الرِّضوان. قال «3» :
حرَّقها وارسُ عُنْظُوانِ ... فاليومُ منها يومُ أَرْوَنانِ
وارس ثمرُهُ. والمُورِسُ [الذي] «4» خرج وارسه. وقال «5» :
ماذا تقول نبتها تَلَمَّسُ ... وقد دعاها العُنظوان المُخْلِسُ
والعُنْظُوانَةُ: الجرادةُ الأنثى، والجمعُ «6» العنظوانات.
__________
(1) في (ط وس) : عظى. وفي (ص) : معظي والصواب ما أثبتناه.
(2) من (ص) . في (س وط) : الفعل.
(3) من (س) وقد سقطت من (ص وط) . والرجز في اللسان (عنظ) وهو غير منسوب أيضا.
(4) في الأصول: (أي) .
(5) الرجز من (ط وس) . أما (ص) فقد سقط الرجز منها.
(6) من (ص) . في (س وط) : والجميع.
(2/87)
________________________________________
ظعن: ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْناً وظُعوناً وظَعَناً وهو الشخوص. والظَّعينةُ: المرأةُ، سُمّيت به لأنّها تَظْعَنُ إذا ظَعَنَ زوجُها، وتقيم إذا أقام. ويقال: لا بل الظّعينةُ الجملُ الذي يعتمل ويركب، وسمّيت ظعينةً لأنّها راكبتُه، كما سُمّيتْ المزادةُ راوية وإنما الرواية البعيرُ. قال «7» :
تَبَيَّنْ خليلي هل ترى من ظعائن ... لميّة أمثالِ النّخيلِ المَخَارِفِ
والنّساء لا يُشَبَّهْنَ بالنخيل، وإنما تُشَبَّهُ بها الإِبل التي عليها الأحمال فهذا يبيّن لك أن الظَّعينةَ قد تكون البعير الذي يعتمل. والظُّعُنُ: رجالٌ ونساءٌ جماعة.
نعظ: نَعَظَ ذكرُ الرّجلِ يَنْعَظُ نَعْظاً ونُعُوظاً. وأَنْعَظَهُ [يُنْعِظُهُ] «8» . وهو أن ينتشر ما عند الرّجل، ومن المرأة الاهتياج إذا علاها الشبق. يقال: أنعظت المرأة.
__________
(7) البيت (للفرزدق) . ديوانه 2/ 13 (صادر) .
(8) في (ص) و (ط) : منعظه. وفي (س) : منعظة. وما أثبتناه أصوب.
(2/88)
________________________________________
باب العين والظاء والفاء معهما يستعمل من وجوهها ف ظ ع فقط
فظع: فَظُعَ الأمر يَفْظُعُ فَظاعةً. وأَفْظَعَ إفْظاعاً. وأمرٌ فظيع، أي: عظيم. وأفظعني هذا الأمرُ وفَظِعْتُ به: واستفظعته رأيتُه فظيعاً. وأفْظَعْتُه أيضاً.
(2/89)
________________________________________
باب العين والظاء والباء معهما ع ظ ب يستعمل فقط
عظب: عَظَبَ الطائرُ يَعْظِبُ عَظْباً وهو سرعةُ تحريكِ الزِّمِكَّى.
(2/90)
________________________________________
باب العين والظاء والميم معهما ع ظ م، م ظ ع، مستعملان
عظم: العِظام: جمع العَظْم، وهو قَصَب المفاصل. والعِظم: مصدر الشيء العظيم. عَظُم الشيء عِظَماً فهو عظيم. والعَظَامَةُ: مصدرُ الأمرِ العظيمِ. عَظُمَ الأمرُ عَظامَةً. وعَظَّمَهُ يُعَظِّمُهُ تعظيماً، أي: كبّره. وسمعت خبراً فأَعْظَمتُه، أي: عَظُمَ في عيني. ورأيت شيئاً فاستعظمته. واستعظمْتُ الشيء: أخذت أُعَظِّمُهُ. واستعظمتُه: أنكرته. وعُظْمُ الشيءِ: أعظمُهُ وأكبرُهُ ومُعْظَمُ «1» الشيءِ أكْثَرُهُ. مثل مُعْظَم الماء وهو تبلّده. والعُظْم: جلّ الشيء وأكثره. والعَظَمَةُ من [التَعَظُّمِ] «2» والزّهو والنّخوة. وعَظُمَ الرّجُلُ عّظامةً فهو عظيمٌ في الرأي والمجد. والعظيمةُ: المُلِمَّةُ النّازلةُ الفظيعة. قال «3» :
__________
(1) من (س) . في (ص) و (ط) معظمه.
(2) هذا من التهذيب في روايته عن الليث في الأصول: التعظيم.
(3) عجز البيت كما في المحكم 2/ 52 واللسان (عظم) :
وإلا فإني لا إخالك ناجيا
والبيت غير منسوب.
(2/91)
________________________________________
فإن تنجُ منها تَنْجُ من ذي عظيمة................
وتقول: لا يتعاظمني ذلك، أي: لا يَعْظُمُ في عيني.
مظع: مَظَعَ الرّجُلُ الوتَرَ يَمْظَعُ مَظْعاً، وهو أن يمسحَ الوتَرَ بخُرَيْقةٍ أو قطعةِ شعر حتى يقوّمَ متنَه. ويمْظَعُ «4» الخشبةَ يملّسُها حتى ييبّسَها، وكلّ شيء نحوه. والمَظْعُ الذّبولُ. مَظَعَه مشقه «5» حتى يبسه.
__________
(4) في الأصول. مظع وما أثبتناه أنسب.
(5) من (س) . في (ص) و (ط) مشقة.
(2/92)
________________________________________
باب العين والذال والرّاء معهما ع ذ ر، ذ ع ر، ذ ر ع مستعملات
عذر: عَذَرْتُه عَذْراً ومَعْذِرَةً. والعُذْرُ اسمٌ، عذرته بما صنع عَذْراً ومَعْذِرة وعَذَرْتُه من فلانٍ، أي: لُمْتُ فلاناً ولم أَلُمْهُ. قال «1» :
يا قوم من يعذر من عجرد ... القاتل النفس على الدانق
وعذيرُ الرّجل ما يروم ويحاول مما يعذر عليه إذا فعله. قال العجاج «2» :
جاريَ لا تَسْتَنكري عَذيري
ثم فسّره فقال:
سَعْيي وإشفاقي على بعيري
وعَذِيري من فلان، أي من يَعْذِرُني منه. قال «3» :
عَذيرَكَ من سعيدٍ كلّ يوم ... يُفجّعنا بفُرْقته سعيد
__________
(1) لم نقف على القائل.
(2) ديوانه ص 221 (دمشق) .
(3) لم نقف على القائل ولا على القول في غير الأصول.
(2/93)
________________________________________
أي: أعذر من سعيد. واعتذر فلانٌ اعتذاراً وعِذرةً. قال «4» :
ها إن تا عِذْرةٌ.
واعتذر من ذنبه فَعَذَرْته. وأعْذَرَ فلان، أي: أبلى عذراً فلا يلام. واعتذر إذا بالغ فيه. وعذر الرجل تعذيرا إذا لم يبالغ في الأمر وهو يريك أنّه يبالغ فيه. وأهلُ العربية يقولون: المُعْذِرُونَ الّذين لهم عُذْر بالتخفيف، وبالتثقيل «5» الذين لا عُذْرَ لهم فتكلّفوا عُذْراً. وتعذّر الأمرُ إذا لم يستقمْ. قال «6» :
............. تعذّرت ... عليّ وآلتْ حَلْفَةً لم تَحَلَّلِ
وأَعْذَرَ إذا كثُرَتْ ذنوبُه وعيوبُه «7» . والعِذارُ عَذار اللّجام، عَذَرْتُ الفرسَ، أي: ألجمتُه أَعذِره. وعذَّرته تعذيراً، يقال: عَذِّرْ فرسَك يا هذا. وعذَّرْتُ اللّجامَ جعلتُ له عِذاراً. وما كان على الخدّين من كيّ أو كّدْحٍ طولاً فهو عِذارٌ.
__________
(4) من بيت (للنابغة) في ديوانه ص 26 وتمام البيت:
ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت ... فإن صاحبَها قد تاهَ في البلد
(5) المعذرون. قال تعالى من سورة التوبة: وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ.
(6) من معلقة (امرىء القيس) . ديوانه ص 12 وتمام البيت:
ويوما على ظهر الكثيب تعذّرت ... عليّ وآلتْ حَلْفَةً لم تحلل
(7) قبل هذه العبارة وبعد بيت (امرىء القيس) . غير الخليل يروي
عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. ويروى يعذروا
والظاهر أنه تعليق أدخله النساخ في الأصل.
(2/94)
________________________________________
والإِعذار: طعام الختان. والعِذارُ طعامٌ تدعو إليه إخوانك لشيء تستفيده، أو لحدَثٍ كالخِتانِ ونحوه سوى العُرس. أعذرتُ الغلام ختنته. قال «8» :
تلوية الخاتن زب المعذر
والمعذور مثله «9» . وحمارٌ عَذَوَّرٌ. أي: واسعُ الجوف. قال يصف الملك أنه واسع عريض «10» :
وحاز لنا اللهُ النبوّة والهدى ... فأعطى به عزا وملكا عذورا
والعُذْرة عُذْرة الجارية العذراء وهي التي لم يَمْسَسْها رجل. والعُذْرَة داء يأخذ في الحلق. قال «11» :
غَمْزَ الطبيب نغانِغَ المَعْذور
والعُذْرةُ نجمٌ إذا طلع اشتدّ الحرّ. قال الساجع: إذا طلعتِ العُذْرةُ لم تبق بعمان سرّة وكانت عكّة نكرة. والعُذْرةُ: الخُصْلَةُ من عرف الفرس أو ناصيته، والجميع العُذَر. قال ينعت فرساً «12» :
سَبِط العُذْرةِ ميّاح الحضر
ويروى: مياع.
__________
(8) الرجز في التهذيب 2/ 310. غير منسوب. وفي اللسان (عذر) غير منسوب أيضا. ورواية اللسان: ... المعذور.
(9) من (س) . في (ص) و (ط) : قال والمعذور..
(10) لم نقف على القائل، ولا على القول في غير الأصول.
(11) (جرير) ديوانه 2/ 858 وصدر البيت:
غمز ابن مرة يا فرزدق كينها
(12) لم نقف على الراجز، ولا على الرجز في غير الأصول.
(2/95)
________________________________________
والعذراء: شيء من حديد يعذّب به الإنسان لاستخراج مالٍ أو لإقرارِ بشيء. والعَذِرةُ: البَدَا، أعذر الرّجلُ إذا بدا «13» وأحدث من الغائط. وأصل العَذِرَةُ فِناءُ الدار ثم كنّوا عنها باسم الفِناء، كما كُنِّيَ بالغائط، وإنّما أصل الغائط المطمئنّ من الأرض. قال «14» :
لعمري لقد جرَّبتكم فوجّدْتكم ... قباحَ الوجوهِ سيِّئي العَذِرات
يريد الأفنية، أنّها ليست بنظيفة. والعاذرُ والعَذِرَةُ هما البَدَا أيضاً، وهو حَدَثه. قال بشار يهجو الطرماح:
فقلت له لا دهل ملقمل بعد ما ... ملا ينفق التّبان منه بعاذر
يقول: خاف المهجُوُّ من الجمل فكلَّمَهُ الهاجي بكلام الأنباط. قوله: لا دهل، أي لا تَخَفْ بالنبطية، والقمل: الجمل. ومُعَذَّرُ الجمل ما تحت العِذار من الأذنين. ومَعْذِرُهُ ومَعْذَرَهُ، كما تقول: مَرْسِنُهُ ومَرْسَنَهُ «15» .
ذعر: ذُعِرَ الرّجُلُ فهو مذعور منذعر، أي: أخيف. والذُّعْرُ: الفَزَع، وهو الاسم. وانْذَعَرَ القومُ تفرقوا.
ذرع: الذِّراعُ من طَرَف المِرْفَق إلى طرف الإِصْبَع الوُسْطَى.
__________
(13) في الأصول: 8 بدا، والصواب ما أثبتناه.
(14) (الحطيئة) ديوانه ص/ 332 (البابي الحلبي) .
(15) (مرسنة) الثانية من (س) فقد سقطت من (ص) و (ط) .
(2/96)
________________________________________
ذَرَعْتُ الثوب أذْرَعُ ذَرْعاً بالذِّراع والذِّراعُ السّاعد كلّه، وهو الاسم. والرّجُلُ ذارِعٌ. والثَّوبُ مذروعٌ. وذرعتُ الحائط ونحوه. قال «16» :
فلمّا ذَرَعْنا الأرضَ تسعين غلوة............... ....
والمُذَرَّع: الممسوح بالأذْرع. ومنهم من يؤنّث الذِّراع، ومنهم من يذكّر، ويصغّرونه على ذُرَيْع فقط «17» . والرّجلُ يُذَرِّعُ في ساحته تذريعاً إذا اتّسع، وكذلك يتذرّع أي: يتوسع كيف شاء. وموتٌ ذريعٌ، أي: فاشٍ، إذا لم يتدافنوا، ولم أسمع له فِعْلاً. وذَرَعَهُ القَيْء، أي: غلبه. ومِذارِعُ الدّابّة قوائمها، ومَذارِعُ الأرض نواحيها. وثوب موشى المذراع. والذَّرَع ولدُ البقرة، بقرةٌ «18» مُذْرِعٌ، وهنّ مُذْرِعاتٌ ومذاريع، أي: ذوات ذِرْعان. قال الأعشى «19» :
كأنها بعد ما أفضى النِّجادُ بها ... بالشّيِّطَيْنِ مَهاةٌ تبتغي ذَرَعا
والذِّراعُ سِمَةُ بني ثعلبة من اليمن، وأناس من بني مالك بن سعد من أهل الرّمال. وذِراعُ العامل: صدر القناة. وأَذْرِعاتٌ: مكان تنسب إليه الخمور.
__________
(16) لم نقف على القائل ولا على القول.
(17) من (س) . في (ص) و (ط) : قط.
(18) من (س) . في (ص) و (ط) : بقر.
(19) ديوانه ص 105، في (س) النجباء وفي (ص) و (ط) : النجأ.
(2/97)
________________________________________
والذَّريعةُ جملٌ يُخْتَلُ به الصّيدُ، يمشي الصّيادُ إلى جنبه فإذا أمكنه الصيدُ رمى وذلك [الجملُ] «20» يسيّب أوّلاً مع الوحش حتى يأتلفا. والذريعةُ حلقةٌ يتعلّم عليها الرّمي. والذّريعةُ الوسيلةُ. والذِّراعُ من النّجوم، وتقول العرب: إذا طلع الذّراع أمرأَتِ الشّمسُ الكُراع. واشتدّ منها الشُّعاع. ويقال للثور مُذَرَّعٌ إذا كان في أكارعه لُمَعٌ سودٌ. قال ذو الرمة «21» :
بها كل خوّارٍ إلى كلِّ صَعْلةٍ ... ضهول ورفض المذرعات القراهب
والمِذراع الذِّراع يُذْرَعُ به الأرض والثياب. ومَذارِعُ القرى: ما بَعُدَ من الأمصار.
__________
(20) زيادة من المحكم يقتضيها السياق.
(21) ديوانه 1/ 188.
(2/98)
________________________________________
باب العين والذال واللاّم معهما ع ذ ل، ل ذ ع يستعملان فقط
عذل: عَذَلَ يَعْذِلُ عَذْلاً وعَذَلاً، وهو اللّوم، والعُذّال الرّجال، والعُذّلُ النساء. قال «1» :
يا صاحبيَّ أقلاّ اللّومَ والعَذَلا ... ولا تقولا لشيء فات ما فعلا
والعاذِلُ: اسم العِرْق الذي يخرج منه دم الاستحاضة.
لذع: لَذَعَ يَلْذَعُ لَذْعاً كلَذْعِ النار أي: كحُرْقَتِها، ولَذَعْتُه بلساني، والقرحة تلتَذِعُ إذا قيّحتْ، ويلْذَعُها القيحُ. قال «2» :
وفي الجَمْر لَذْعٌ كجمرِ الغَضَى
والطائر يلذَعُ الجناحَ إذا رَفْرَفَ به ثمّ حرّك جناحَيْهِ ومشَى مشيا قليلا.
__________
(1) لم تهتد إلى القائل.
(2) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول.
(2/99)
________________________________________
باب العين والذّال والنّون معهما يستعمل ذ ع ن فقط
ذعن: يقال: أَذْعَنَ إِذْعاناً، وذَعِنَ يذْعَن أيضاً، أي: انقاد وسَلِسَ. ناقةٌ مِذعانٌ سَلِسَةُ الرأسِ منقادةٌ لقائدها. وفي القرآن: مُذْعِنِينَ أي: طائعين. قال «1»
............... .... ... وقرّبت مذعاناً لموعاً زمامُها
__________
(1) (ذو الرمة) ديوانه 2/ 1327 وصدر البيت:
فعاجا علندى ناجيا ذا براية
ورواية الديوان: وعرجت مكان قربت.
(2/100)
________________________________________
باب العين والذّال والفاء معهما ذ ع ف يستعمل فقط
ذعف: الذُّعافُ سمٌّ ساعة. وطعام مَذْعوفٌ جعل فيه الذُّعاف. قال رزاح:
وكنّا نمنعُ الأقوامَ طرّا ... ونسقيهم ذُعافاً لا كميتا
(2/101)
________________________________________
باب العين والذّال والباء معهما ع ذ ب، ب ذ ع يستعملان فقط
عذب: عَذُبَ الماءُ عُذوبةً فهو عَذْبٌ طيب، وأَعْذبتُه إعذاباً، واستعذبته، أي: أسقيته وشربته عَذْباً. وعَذَبَ الحمار يَعْذِبُ عَذْباً وعُذوباً فهو عاذِبٌ عَذوبٌ لا يأكل من شدة العطش. ويقال للفرس وغيره: عَذوبٌ إذا بات لا يأكل ولا يشرب، لأنه ممتنع من ذلك. ويَعْذِبُ الرّجل فهو عاذِبٌ عن الأكل، لا صائم ولا مُفْطِرٌ. قال عَبِيد «1» :
وتَبَدَّلوا اليَعْبوبَ بعدَ إلَههم ... صنماً فَقَرّوا يا جَديلَ وأَعْذِبوا
وقال حُمَيْد «2» :
إلى شجرٍ ألمَى الظّلال كأنّه ... رواهبُ أَحْرَمْنَ الشراب عذوب
__________
(1) (عبيد بن الأبرص) ديوانه ص 3.
(2) (حميد بن ثور الهلالي.) ديوانه ص 57. في الأصول: إلى شجر الماء.
(2/102)
________________________________________
وتقول: أعذبتُه إعذاباً، وعذّبتُه تعذيباً، كقولك: فطّمته عن هذا الأمر، وكلّ من مَنَعْتَهُ شيئاً فقد أعْذَبْتَهُ. قال «3» :
يَسُبُّ قومَك سبّاً غير تعذيب
أي: غير تفطيم. والعذوب والعاذب الذي ليس بينَه وبين السّماء سِتْر. قال النابغة الجعديّ «4» :
فبات عَذوباً للسّماءِ كأنّه ... سهيلٌ إذا ما أفردَتْهُ الكواكبُ
والمعذّب قد يجيء اسماً ونعتاً للعاشق. وعَذَبَةُ السَّوط: طَرَفُه. قال «5» :
مثلُ السّراحِينِ في أعناقِها العَذَبُ
يعني أطراف السُّيور التي قد قلّدت بها الكلاب. والعَذَبَةُ في قضيب البعير أَسَلَتُه. أي: المستدقّ من مقدّمه، ويجمع على عَذَب. وعذَبة شِراك النعل: المرسلة من الشّراك. والعُذَيْبُ: ماء لبني تميم.
بذع: البَذَعُ: شبه الفَزَع. والمبذوع كالمفزوع. قال الأعرابيّ: بُذِعُوا فأبْذَعَرُّوا. أي: فَزِعوا فتفرّقوا.
__________
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(4) البيت في المحكم 2/ 61 وفي اللسان (عذب) .
(5) (ذو الرمة) ديوانه 1/ 98. وصدر البيت:
غضف مهرتة الأشداق ضارية
(2/103)
________________________________________
باب العين والذّال والميم معهما ع ذ م، م ذ ع يستعملان فقط
عذم: عَذَمَ يَعْذِم عَذْماً، والاسم العذيمة وهو الأخذ باللسان، واللوم. قال الرّاجز «1» :
يظَلُّ مَنْ جاراه في عذائم ... من عنفوان جَرْيِهِ العُفاهمِ
أي: في ملامات. وفرسٌ عَذُومٌ، وعَذِمٌ، أي: عضوض. والعُذّامُ: شَجَرٌ من الحَمْضِ يَنْتَمِىءُ، وانتماؤه انشداخه إذا مَسسْتَه. له ورق كورق القاقُلّ، الواحدة عُذّامة.
مذع «2» : مَذَعَ لي فلانُ مَذْعَةً من الخَبَر إذا أخبرك عن الشيء ببعضِ خَبَره ثم قَطَعَهُ، وأخذ في غيره، ولم يتمّمه. والمُذّاعُ: الكذّابُ يكذِبُ لا وفاءَ له. ولا يحفظ أحدا بالغيب.
__________
(1) الرجز في التهذيب 2/ 323 وفي المحكم 2/ 62 غير معزو. وفي اللسان (عذم) و (عفهم) ونسب إلى (غيلان) . في (س) : من جراه.
(2) قال الأزهري 2/ 324 عند ترجمته ل (مذع) : أهمله الليث، وهو كما ترى.
(2/104)
________________________________________
باب العين والثاء والرّاء معهما ع ث ر، ث ع ر، ر ع ث، ر ث ع مستعملات
عثر: عَثَرَ الرّجل يَعْثُرِ [ويَعْثُرُ] عثوراً، وعثر الفرس عِثاراً إذا أصاب قوائمه شيء، فيُصرع أو يَتَتَعْتَعُ. دابّة عثور: كثيرة العثار. وعثرَ الرّجل يعثرُ عثراً إذا اطلّع على شيء لم يطلّع عليه غيره. وأعثرت فلاناً على فلانٍ أي: أطلعته عليه، وأعثرته على كذا. وقوله عزّ وجل «1» : فَإِنْ عُثِرَ «2» أي: اطُّلِعَ. والعِثْيَرُ: الغبار السّاطع. والعَثْيَرُ الأثَرُ الخفيُّ، وما رأيت له أثرا ولا عثيرا. والعثير: ما قلبت من ترابٍ أو مَدَرٍ أو طينٍ بأطراف أصابع رجلَيْكَ إذا مشيت لا يرى من القدم غيره. قال «3» :
............... ...... ... عَيْثَرْتَ طَيْرَكَ لو تَعيفُ
يقول: وقعت عليها لو كنت تعرف، أي: جزتَ بما أنت لاقٍ «4» لكنّك لا تعرف.
__________
(1) من (س) . في (ص) و (ط) : (وقوله) فقط.
(2) المائدة 107: فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً.
(3) من بيت (للمغيرة بن حبناء التميمي) ، وتمام البيت، كما في المحكم 2/ 65 واللسان (عثر) :
لعمر أبيك يا صخر بن ليلى ... لقد عثيرت طيرك لو تعيف
(4) في (س) : جزات بما تلاقي. في (ص) و (ط) : جزت بما انتلاق ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2/105)
________________________________________
والعاثور: المتالِف. قال «5» :
وبلدةٍ كثيرةِ العاثُورِ
ثعر: الثَّعْرُ والثُّعْرُ، لغتان، لَثىً «6» يخرج من غصن شجرة السَّمُر، يقال: هو سمٌّ. والثُّعْرور «7» : الغليظ القصير من الرّجال. والثعارير: ضربٌ من النّبات يشبه الأذْخِرَ يكون بأرض الحجاز.
رعث: الرَّعْثةُ: تلتلة تتّخذ من جُفِّ الطَّلْعِ يُشْرَبُ بها. والرِّعاثُ: ضربٌ من الخَرَزِ والحليّ. قال «8» :
إذا علقت خافَ الجنان رِعاثها
وقال «9» :
رقراقة كالرشأ المُرَعَّثِ
أي في عنقها قلائد كالرِعاث. وكلّ مِعْلاقٍ كالقُرط والشّنْف ونحوه في آذان أو قلادة فهو رِعاثٌ، وربّما علّقت في الهودج رُعُثٌ كثيرة، وهي ذباذب يُزَيَّنُ بها الهودجُ. ورَعْثَةُ الدّيك عُثْنونُهُ. أنشد أبو ليلى «10» :
ماذا يُؤَرّقُني والنّومُ يَطْرُقُني ... من صوتِ ذي رَعَثاتٍ ساكنِ الدّارِ
__________
(5) (العجاج) ديوانه ص 225، والرواية فيه: بل بلدة مرهوبة العاثور.
(6) في (س) : لما.
(7) في (ص) و (ط) والثعارير والثعرور. وفي (س) والثعارير.
(8) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول.
(9) (رؤبة) ديوانه ص 27 والرواية فيه:
دارا لذاك الرشأ المرعث
ورواية اللسان كرواية الأصول.
(10) (الأخطل) كما جاء في اللسان. وليس في ديوانه.
(2/106)
________________________________________
وَرَعِثَتِ العَنْز تَرْعَثُ رَعَثاً إذا ابيضّت أطرافُ رَعْثَتِها. أي: زَنَمَتها.
رثع: رجل رَثِعٌ، وقوم رَثِعون، وقد رَثِعَ رَثَعاً، وهو الطّمع والحرص.
(2/107)
________________________________________
باب العين والثاء واللام معهما ع ل ث، ث ع ل مستعملان فقط
علث: العَلْثُ: الخَلْطُ. يقال: عَلَثَ يَعْلِثُ عَلْثاً، واعتلث. ويقال للزّنْد إذا لم يُورِ واعتاص: عُلاثة، ويقال: إنّما هو علث والعُلاثُ اسمه. قال «1» :
وإنّي غير معتلث الزناد
أي: غير صلد الزّند. أي: أنا صافي النّسب. واعْتَلَث زنداً أخذه من شجرٍ لا يدري أيوري أم لا. واعتلث سهماً أتّخذه بغير حذاقة. عُلاثَةُ: اسم رجل، ويقال: بل هو الشيء الذي يَجْمع من هنا وهناك.
ثعل: الثُّعْلُ: زيادة السّنّ أو دخول سنّ تحت سنّ في اختلاف من المّنْبِت. ثَعِلَ ثَعَلاً فهو أَثْعَلُ والأنثى ثَعْلاء، وربما كان الثُّعْل في أطباء الناقة، والبقرة، وهي زيادة في طُبْيِها فهي ثَعْلاء. والأَثْعَلُ: السيّد الذي له فضول.
__________
(1) الشطر في التهذيب 2/ 328 وفي اللسان (علث) غير معزو.
(2/108)
________________________________________
والثُّعلول: الرّجلُ الغضبانُ. قال «2» :
وليس بثُعْلولٍ إذا سِيل واجتُدي ... ولا بَرٍماً يوماً إذا الضّيفُ أوهما
والأنثى من الثعالب ثُعالة، ويقال للذّكر أيضاً ثعالة. قال رافع «3» : الثعل دُوَيْبة صغيرة تكون في السّقاء إذا خبث ريحُه. ويقال للرّجل إذا سبّ: هذا الثّعل والكعل، أي: لئيم ليس بشيء، والكعل: كسرة تمر يابس لا يكاد أحدٌ يكسره ولا يأكله وأصله تشبيه بتلك الدّوَيْبَة فاعلم.
عثل «4» : يقال: رجل عِثْوَلٌ، أي: طويل اللحية، ولِحْيةٌ عثولة «5» : [ضخمة «6» ] .
__________
(2) البيت في التهذيب 2/ 329، واللسان (ثعل) غير معزو أيضا.
(3) هذا القول إلى آخره مثبت في (ص) و (ط) بعد ترجمة (علث) . أما في (س) فالقول في موضعه.
(4) هذا من (س) فقط وليس في (ص) ولا (ط) . وقال الأزهري في التهذيب عند ترجمته (عثل) : أهمله الليث.
(5) (س) : عثولية والصواب ما أثبتناه.
(6) زيادة من المحكم 2/ 66 اقتضاها السياق.
(2/109)
________________________________________
باب العين والثاء والنون معهما ع ث ن، ع ن ث يستعملان فقط
عثن: العُثانُ: الدُّخانُ. عَثَنَ النار يَعْثُنُ عَثْناً، وعَثّنَ يُعَثّنُ تعثيناً، أي: دخّن تدخيناً. وعَثِنَ البيتُ يَعْثَنُ عَثَناً إذا عبق به ريح الدُّخْنة، وعَثَّنْتُ البيتَ والثّوبَ بريح الدُّخْنة والطِّيب تعثيناً، أي: دخّنتُه. وعُثْنونُ اللّحية طولُها وما تحتها من الشّعر. والعُثْنونُ: شُعَيْراتٌ عند مَذْبَحِ البعير. وجمعُه: عَثانين. وعُثْنونُ السَّحابِ: [ما تدلّى من هَيْدَبِها] «1» . و [عثنون] «2» الرّيحِ: هَيْدَبُها في أوائلها إذا أقبلت تجُرُّ الغبارَ جرّاً، ويقال: هو أوّلُ هبوبها. ويقال: العِثْنُ: يبيسُ الكلأ.
عنث: العُنْثُ أصلُ تأسيس العُنْثُوة وهي يبيسُ الحلِيّ خاصّة إذا اسودّ وبلي. ويقال: عُنْثَة، وشبه الشاعر شَعَرات اللّمّة به فقال «3» :
عليه من لِمّتِهِ عِناثٌ
ويروى عَناثي مثل عناصي في جماعة عنثوة.
__________
(1) زيادة من التهذيب 2/ 330 من روايته عن الليث.
(2) زيادة لتقويم العبارة.
(3) الرجز في التهذيب 2/ 331 والمحكم 2/ 69 واللسان (عنث) غير معزو أيضا.
(2/110)
________________________________________
باب العين والثّاء والباء معهما ع ب ث، ث ع ب، ب ث ع، ب ع ث مستعملات
عبث: عَبِثَ يَعْبَثُ عَبَثاً فهو عابث بما لا يعنيه، وليس من باله، أي: لاعب. وعَبَثْتُ الأقِطَ أَعْبِثُهُ عَبْثاً فأنا عابث، أي: جفّفته في الشمس. والاسم: العبيث. والعبيثة والعبيث: الخلط «1» .
ثعب: ثَعَبْتُ الماء أَثْعَبُهُ ثَعْباً، أي فجّرته فانثعب، ومنه اشتقّ المَثْعَبُ وهو المِرْزاب. وانثعب الدم من الأنف. والثُّعبانُ: الحيّة الطويل الضّخم، ويقال: أُثْعُبان. قال «2» :
على نهجٍ كثُعْبانِ العرين
والأُثْعُبانُ الوجهُ الضَّخْم الفَخْمُ في حُسْنٍ وبياضٍ. قال الرّاجز «3» :
إنّي رأيتُ أُثْعُباناً جَعْدا ... قد خرجتْ بعدي وقالتْ نكدا
__________
(1) بعده بلا فصل: وهو بالفارسية ترف ترين، وهو المصل أيضا في بعض اللغات. اقتطعناها، لأنها، فيما يبدو، زيادة من النساخ.
(2) لم نقف على الراجز ولا على الرجز في غير الأصول.
(3) البيت في المحكم 2/ 70 وفي اللسان (ثعب) غير معزو أيضا.
(2/111)
________________________________________
والثُّعَبَةُ: ضربٌ من الوزغ لا تلقى أبداً إلا فاتحةً فاها شبه سامّ أبرص، غير أنها خضراء الرأس والحلق جاحظة العينين، والجميع: الثُّعَب. والثَّعْبُ: الذي يجتمع في مسيل المطر من الغُثاء. وربما قالوا: هذا ماء ثَعْبٌ، أي: جارٍ، للواحد، ويجمع على ثُعْبان.
بثع: البَثَعُ: ظهور الدّم في الشّفتين خاصّة. شفة باثِعةٌ كاثِعةٌ، أي: يتبثع فيها الدم، [و] «4» كادت تنفطر من شدّة الحُمرة، فإذا كان بِالغَيْن «5» فهو في الشّفتين وغيرهما من الجسد كلّه، وهو التَّبثّغ.
بعث: البَعْثُ: الإِرسالُ، كبعث الله من في القبور. وَبَعَثْتُ البعيرَ أرسلتُه وحللت عِقالُه، أو كان باركاً فَهِجْتُهُ. قال «6» :
أُنيخها ما بدا لي ثم أَبْعَثُها ... كأنها كاسر في الجو فتخاء
وبعثته من نومه فانبعث، أي: نبّهته. ويومُ البَعْثِ: يومُ القيامة. وضرب البَعْثُ على الجند إذا بعثوا، وكل قوم بُعِثوا في أمرٍ أو في وَجْه فهم بَعْثٌ. وقيل لآدم: ابعَثْ بَعْثَ النار فصار البَعْثُ بَعْثاً للقوم جماعة. هؤلاء بَعْثٌ مثل هؤلاء سفر وركب.
__________
(4) زيادة اقتضاها تقويم العبارة.
(5) في النسخ الثلاث: (والياء) ويبدو أنها زيادة.
(6) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(2/112)
________________________________________
باب العين والثاء والميم معهما ع ث م، ث ع م مستعملان فقط
عثم: عَثَمْتُ عظمَهُ أَعْثِمُهُ عَثْماً إذا أسأت جَبْرَهُ وبقيَ فيه وَرَمٌ أو عِوَج، [وعَثِمَ عَثَماً «1» ] فهو عَثِمٌ، وبه عَثَمٌ كهيئة المشمش. قال «2» :
وقد يقطع السيف اليماني وجفنه ... شباريق أعشار عثمن على كَسْرِ
والعَيْثام: شجرة بيضاء طويلة جداً، الواحدة عَيْثامة «3» . والعَيْثُومُ الضّخم من كلّ شيء الشّديد. ويقال للفيلة الأنثى عَيْثوم، ويقال للذّكر أيضاً عيثوم، ويُجمع عياثيم. قال «4» :
وقد أَسِيرُ أمامَ الحيِّ تحمِلُني ... والفَضْلَتَيْنِ كِنازُ اللحم عيثوم
__________
(1) زيادة من المحكم 2/ 71.
(2) البيت في المحكم 2/ 72، واللسان عثم غير معزو أيضا.
(3) بعد (عيثامة) : تسميه الفرس سبيذ دال أسقطناه لأنه زيادة مقحمة إقحاما.
(4) البيت في التهذيب 2/ 336، واللسان (عثم) غير منسوب أيضا.
(2/113)
________________________________________
أي: قوّية ضخمة شديدة. والعَثَمْثَمُ: الطويل من الإبل في غِلَظٍ، ويُجمع على عَثَمْثَمات، ويوصف به الأسد والبغل لشدّة وَطْئهما.
ثعم: الثَّعْمُ: النّزع والجرّ. ثَعَمْتُه: نزعته. وتَثَعَّمَتْ فلاناً أرضُ بني فلانٍ إذا أعجبتْهُ وجَرَّتْه إليها ونَزَعَتْهُ.
(2/114)
________________________________________
باب العين والرّاء واللام معهما ر ع ل مستعمل فقط
رعل: الرّعْلُ: شدّةُ الطَّعْن «1» . رَعَلَهُ بالرّمح، وأَرْعَلَ الطَّعْنَ. قال الأعراب: الرَّعْلُ الطّعنُ ليس بصحيح إنّما هو الإرعال، وهو السُّرعةُ في الطّعن. وضرب أرعَلُ، وطعنٌ أَرْعَلُ أي: سريع. قال «2» :
يَحمي إذا اخْترط السيوفَ نساءنا ... ضربٌ تطيرُ له السّواعدُ أَرْعَلُ
ورَعْلَةُ الخيل: القِطْعَةُ «3» التي تكون في أوائلها غير كثير. والرِّعالُ: جماعة. قال «4» :
كأنّ رِعالَ الخيلِ لمّا تبدّدت ... بوادي جرادِ الهبوةِ المُتَصَوّب
والرَّعيلُ: القطيعُ أيضاً منها. والرَّعْلَةُ النّعامة، سُمّيت بها لأنّها لا تكاد تُرى إلا سابقةً للظليم. والرَّعْلَةُ: أوّل كلّ جماعة ليست بكثيرة.
__________
(1) في (س) : الوطي، وهو تحريف.
(2) لم نقف على القائل.
(3) من المحكم 2/ 73. في (ص) و (ط) : القطيع، وفي (س) : القطع.
(4) لم نقف على القائل.
(2/115)
________________________________________
وأراعيل في كلام رؤبة: أوائل الرّياح، حيث يقول «5» :
تُزْجي أراعيلَ الجَهامِ الخُورِ
وقال «6» :
جاءت أراعيل وجئت هَدَجا ... في مدرعٍ لي من كساءٍ أَنْهَجا
والرَّعْلَةُ: القُلْفَةُ وهي الجِلْدةُ من أُذُنِ الشّاةِ تُشْتَقُّ فَتُتْرَكُ مُعلّقةً في مُؤَخَّر الأذُن.
__________
(5) ليس في ديوان رؤبة. والرجز في المحكم 2/ 73 واللسان (رعل) منسوب إلى (ذي الرمة) .
(6) لم نهتد إليه.
(2/116)
________________________________________
باب العين والراء والنون معهما ع ر ن، ر ع ن، ن ع ر مستعملات
عرن: عَرِنَتِ الدّابّةُ عَرَناً فهي عَرونٌ، وبها عَرَنٌ وعُرْنَةٌ وعِران، على لفظ العِضاض والخِراط، وهي داءٌ يأخُذُ في رِجل الدّابّة فوق الرُّسْغِ من آخره مثل سَحَجٍ في الجلد يُذْهِب الشَّعر. والعِرانُ: خَشَبة في أنفِ البعير. قال «1» :
وإن يَظْهَرْ حديثُك يُؤتَ عَدْواً ... برأسك في زناق أو عِرانِ
والعَرَنُ «2» قروح تأخذ في أعناق الإبل وأعجازها. والعرنين: الأنف. قال ذو الرمة «3» :
تثني النقاب على عرنين أرنبة ... شماء مارنها بالمسْكِ مَرْثوم
عُرَيْنة: اسم حيّ من اليمن، وعَرين: حيّ من تميم. قال جرير «4» :
بَرِئْتُ إلى عُرَيْنَة من عرين
__________
(1) اللسان (زنق) غير منسوب أيضا.
(2) من (ص) في (ط) و (س) : العرون.
(3) ديوانه 1/ 395.
(4) ديوانه ص 475. وصدر البيت:
عرين من عرينة ليس منا
(2/117)
________________________________________
والعَرِينُ: مأوى الأسد. قال «5» :
أَحَمَّ سَراةِ أعلَى اللّونِ منه ... كَلَوْنِ سَراةِ ثُعْبانِ العَرين
قال: هذا زمامٌ وإنّما حمّمتْهُ الشّمس ولوّحتْ لَوْنَه، والثُعْبانُ على هذه الصفة.
رعن: رَعُنَ الرّجلُ يَرْعَنُ رَعَناً فهو أَرْعَنُ، أي: أهوج، والمرأة رعناء، إذا عُرِفَ الموق والهوج في منطقها. والرَّعنُ من الجبال ليس بطويل، ويجمع على رُعُون ورِعان، قال «6» :
يعدل عنه رعُنِ كلِّ ضدٍّ ... عن جانِبَيْ أجْرَد مُجْرَهِدِّ
أي عريان مستقيم، وقال «7» :
يَرْمينَ بالأبصارِ أنْ رعنٌ بدا
ويقال هو الطّويل. وجيشٌ أرعنُ: كثير. قال «8» :
أَرْعَنَ جرّارٍ إذا جرَّ الأَثَرْ
ورُعِنَ الرّجل إذا غثي عليه كثير. قال «9» :
كأنّه من أوار الشمس مرعون
أي: مغشي عليه من حرّ الشّمس.
__________
(5) (الطرماح) ديوانه 530 والرواية فيه أحم سواد.
(6) (رؤبة) ديوانه 49 والرواية فيه: يعدل عند.. وعن حافتي أبلق ...
(7) لم نقع على الراجز.
(8) (العجاج) - ديوانه ص 16.
(9) التهذيب 2/ 341، واللسان (رعن) ، وصدره:
باكره قانص يسعى بأكلبه
(2/118)
________________________________________
رُعَيْنٌ: جبلٌ باليَمَن، وفيه حِصْن يقال لملكه: ذو رُعَيْنٍ يُنْسَبُ إليه. وكان المسلمون يقولون للنّبيّ صلى الله عليه وآله: أَرْعِنا سمعك، أي: اجعل إلينا سمعك. فاستغنمت اليهود ذلك، فقالوا ينحون نحو المسلمين: يا محمد راعِنا، وهو عندهم شتم، ثمّ قالوا فيما بينهم: إنّا نشتم «10» محمّداً في وجهه، فأنزل الله: لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا «11» ، فقال سعد لليهود: لو قالها رجل منكم لأضرِبَنَّ عُنُقَه.
نعر: نَعَرَ الرّجلُ يَنْعَرُ نعيراً، وهو صوتٌ في الخيشوم. والنُّعرة: الخيشوم. نعر النّاعر، أي: صاح الصائح. قال «12» :
وبَجَّ كلَّ عاندٍ نَعورِ
بَجَّ أي: صبّ فأكْثَرَ، يعني: خروج الدّماء من عِرْقٍ عانِدٍ لا يَرْقأُ دَمُه. نَعَرَ عِذرقُه نُعُوراً وهو خروج الدّم. والناعور: ضَرْبٌ من الدِّلاء. والنُّعَرَةُ: ذبابُ الحمير، أزرق يقع في أنوف الخيل والحمير. قال امرؤ القيس «13» :
فظلّ يُرَنِّحُ في غَيْطَلٍ ... كما يستدير الحِمارُ النَّعِرْ
قال «14» :
وأحذريات يعييها النعر
__________
(10) من (س) . (ص) و (ط) : بالشتم.
(11) البقرة 105.
(12) (العجاج) ديوانه ص 240.
(13) ديوانه ص 162.
(14) لم يقع لنا القائل، ولم نجد القول في غير الأصول.
(2/119)
________________________________________
والنُّعَرَةُ: ما أَجَنَّتْ حُمُرُ الوحش في أرحامها قبل أن يَتمَّ خَلْقُه. قال رؤبة «15» :
والشَّدَنيّاتُ يساقِطْنَ النُّعَرْ ... حُوصَ العُيونِ مُجْهِضاتٍ ما اسْتَطَرْ
يصفُ رِكاباً ترمي بأّجِنَّتِها من شدّة السّير. ورجلٌ نعور: شديد الصوت. ورجل نعر: غضبان. وو امرأة غَيْرَى نَعْرَى، يعني بالنَّعرى: الغضبى «16» . وأمّا نغِرة بالغين فمُحمارّة الوجه مُتغيِّرة متربّدة اللّون. ويقال للمرأة الفحّاشة: نعارة.
__________
(15) ليس في ديوان رؤبة. هو العجاج، ديوانه ص 22.
(16) في النسخ الثلاث: غضبانة.
(2/120)
________________________________________
باب العين والرّاء والفاء معهما ع ر ف، ع ف ر، ر ع ف، ر ف ع، ف ر ع مستعملات
عَرَفَ: عَرَفت الشىءَ مَعْرِفَةً وعِرْفاناً. وأَمْرٌ عارفٌ، معروفٌ، عَرِيفٌ. والعُرْفُ: المعروف. قال النّابغة «17» :
أبَى اللهُ إلا عَدْلَهُ وقَضاءَهُ ... فلا النُّكْرُ مَعْروفٌ ولا العُرْفٌ ضائع
والعَريفُ: القيّم بأمرِ قومٍ عرّفَ عليهم، سُمّي به لأنّه عُرِفَ بذلك الاسم. ويوم عَرَفَة: موقفُ النّاس بعَرَفات، وعَرَفات جبل، والتَّعريفُ: وقوفهم بها وتعظيمهم يوم عَرَفَة. والتعريف: أن تصيب شيئاً فتعرفه إذا ناديت من يعرف هذا. والاعْترافُ: الإقرار بالذّنب، والذلُ، والمهانة، والرضَى به. والنفسُ عَرُوفٌ إذا حُمِلَتْ على أمرٍ بسأتْ به، أي: اطمأنَّت. قال «18» :
فآبوا بالنِّساءِ مُرَدَّفاتٍ ... عوارفَ بعْدَ كَنٍّ وائتجاح
__________
(17) ديوانه ص 53، والرواية فيه: ووفاءه.
(18) في التهذيب 2/ 344، واللسان (عرف) بدون عزو أيضا.
(2/121)
________________________________________
الائتجاح من الوجاح وهو السّتر، أي: معترفات بالذّلّ والهون «19» . والعَرْفُ: ريحٌ طيّبٌ، تقول: ما أطيب عَرْفَهُ، قال الله عز وجل: عَرَّفَها لَهُمْ
«20» ، أي: طيّبها، وقال «21» :
ألا رُبَّ يومٍ قد لَهَوْتُ وليلةٍ ... بواضحة الخدّين طيّبة العَرْف
ويقال: طار القَطا عُرْفاً فعُرْفا، أي: أولاً فأولاً، وجماعة بعد جماعة. والعُرْف: عُرْفُ الفَرَس، ويجمع على أَعْرَاف. ومَعْرَفَةُ الفرس: أصل عرفه. والعرف: نبات ليس بحمض ولا عضاة، وهو من الثمام. قال شجاع: لا أعرفه ولكن أعرف العرف وهو قرحة الأكلة، يقال: أصابته عُرْفة.
عفر: عَفَرْته في التراب أعفره عفرا، وهو متعفّر الوجه في التّراب. والعفر: التّراب. وعفّرتُه تعفيراً، واعتفرته اعتفاراً إذا ضربت به الأرض فَمَغَثْتُه فانعفر، قال «22» :
تَهْلِكُ المِدْراةُ في أكنافِه ... وإذا ما أرسلَتْه يَنْعَفِرْ
أي: يسقط على الأرض.
__________
(19) ورد في النسخ الثلاث نص بعد كلمة (الهون) يبدو أنه أقحم إقحاما، لأنه فضلة وزيادة لا يقتضيها السياق، ولا يحتاج إليه الشاهد فضلا عما فيه من إرتباك، والنص هو: يقول كان فرسان هذه النساء قد ائتجحوا افتخروا وكروا ثم غلبوا بعد ذلك وأخذت سبيهم.
(20) سورة (محمد) 6.
(21) لم نقع على القائل، ولا على القول في غير الأصول.
(22) البيت في التهذيب 2/ 351 غير معزو أيضا. وفي اللسان (عفر) معزو إلى المرار.
(2/122)
________________________________________
يَعْفُر: اسم رجل. والعُفرة في اللون: أن يضرب إلى غيره في حمرة، كلون الظّبي الأعْفَر، وكذلك الرّمل الأعفر. قال الفرزدق «22» :
يقول لي الأنباط إذْ أنا ساقط ... به لا بظبيٍ بالصَّريمة أعفرا
واليعفور: الخشف، لكثرة لزوقه بالأرض. ورجل عِفْرٌ وعِفْرِيَةٌ. وعِفارِيَةٌ وعِفْريتٌ: بيّن العَفارة، يوصف بالشيطنة. وشيطان عِفْرِيةٌ وعِفْريتٌ وهم العَفارِيَة والعَفارِيتُ، وهو الظّريف الكيّس، ويقال للخبيث: عِفِّرِّي، أي: عِفِرّ وهم العفريون وأسد عفرنى ولبوءة عَفَرناةٌ وهي الشّديدة قال الأعشى «23» :
بذاتِ لَوْثٍ «24» عَفَرْناةٍ إذا عَثَرَتْ
وعِفْرِيةُ الرأس: الشّعر الذي عليه. وعِفْرِيةُ الديك مثله. وأمّا ليثُ عِفِّرين فدُوَيْبَّة مأواها التّراب السّهل في أصول الحيطان. تُدَوِّرُ دُوّارة ثم تندسّ في جوفها، فإذا هِيج رمَى بالتّراب صُعُدا. ويُسمَّى الرّجل الكامل من أبناء خمسين: ليثَ عِفِرِّين. قال: وابنُ العَشْر لعّابٌ بالقُلِينَ، وابنُ العِشرينَ باغي نِسِين، أي: طالب نساء، وابنُ الثلاثين أسْعَى السّاعينَ، وابنُ الأربعين أبطشُ الباطشينَ، وابنُ الخمسين ليث عِفِرّين. وابنُ الستين مؤنس الجَليسينَ، وابنُ السّبعينَ أحكمُ الحاكمين، وابنُ الثّمانينَ أسرعُ الحاسبينَ، وابنُ
__________
(22) ديوانه 1/ 201 ولكن الرواية فيه:
أقول له لما أتاني نعية ... به لا بظبي بالصريمة أعفرا
(23) ديوانه ص 103.
(24) في (س) و (ط) : ليث، وفي (ص) بياض، والصواب ما أثبتناه. وعجز البيت:
فالتَّعْسُ أَدْنَى لها من أن أقول: لعا
(2/123)
________________________________________
التّسعين واحد الأرذلينَ، وابنُ المائة لاجا ولاسا، أي: لا رجل ولا امرأة. والعَفارَة: شجرة من المَرْخ يُتَّخذُ منها الزّند، ويُجمع: عَفاراً. ومَعافر: العرفط يَخْرجُ منه شبه صَمْغٍ حُلوٍ يُضيّع بالماء فيشرب. ومَعافر: قبيلةٌ من اليَمَن. ولقيته عن عُفْرٍ، أي بعد حين. وأنشد «25» :
أعِكْرِم أنت الأصل والفرعُ والذي ... أتاك ابن عمّ زائراً لك عن عُفْرَ
قال أبو عبد الله: يقال: إنّ المُعَفَّر المفطوم شيئاً بعد شيءٍ يُحْبَس عنه اللبن للوقت الذي كان يرضَعُ شيئاً، ثمّ يعاد بالرَّضاع، ثمّ يُزادُ تأخيراً عن الوقت، فلا تزالُ أمُّه به حتّى يصبر عن الرَّضاع، فَتَفْطمه فِطاماً باتًّا.
رعف: رَعَفَ يَرْعُفُ رُعافاً فهو راعف. قال «26» : تضمَّخْنَ بالجاديّ حتّى كأنّما الأنوفُ إذا استعرضتَهُنَّ رواعفُ والرَّاعفُ: أَنْف الجبل «27» ، ويجمع رواعف. والرّاعِفُ: طرف الأرْنَبَة. والرّاعِف: المتقدم. وراعوفةُ البئر وأُرْعوفَتُها، لغتان،: حجر ناتىء [على رأسها «28» ] لا يستطاع قلعه، ويقال: هو حجرٌ على رأس البئر يقوم عليه المستقي.
__________
(25) لم يقع لنا المنشد ولا القائل، كما لم يقع لنا البيت في غير الأصول.
(26) لم نهتد إلى القائل.
(27) من التهذيب في روايته عن الليث 2/ 348. في النسخ الثلاث: الجمل، وهو تصحيف.
(28) زيادة من المحكم 2/ 86 لتقويم العبارة.
(2/124)
________________________________________
رفع: رفَعْته رَفْعاً فارتفع. وبَرْقٌ رافع، أي: ساطع، قال «29» :
أصاح ألم يُحْزِنْكَ ريح مريضة ... وبرق تلالا بالعقيقين رافع
والمرفوعُ من حُضْر الفَرَس والبِرْذَون دون الحُضْر وفوقَ الموضوع. يقال: ارفع من دابتك، هكذا كلام العرب. ورَفُع الرّجلُ يَرْفُعُ رَفاعةً فهو رفيعٌ [إذا شَرُف] «30» وامرأة رفيعة. والحمارُ يرفِّعُ في عَدْوِهِ ترفيعاً: [أي: عدا] «31» عَدْواً بعضُهُ أرفعُ من بعض. كذلك لو أخذت شيئاً فرفعت الأوّل فالأوّل قلت: رفَّعتُه ترفيعاً. والرَّفْعُ: نقيضُ الخَفْضِ. قال «32» :
فاخْضَعْ ولا تُنْكِرْ لربّك قُدْرةً ... فالله يخفض من يشاء ويرفع
والرّفعة نقيض الذّلّة. والرُّفاعةُ والعظامة و [الزنجبة] «33» : شيء تعظّم به المرأة عجيزتها.
فرع: فَرَعْتُ رأس الجبل، وفَرَعْتُ فلاناً: علوتُه. قال لبيد «34» :
لم أَبِتْ إلاّ عليه أو على ... مَرْقَب يَفْرَعُ أطرافَ الجَبَلْ
__________
(29) لم نهتد إلى القائل.
(30) من التهذيب 2/ 358 في روايته عن الليث.
(31) من التهذيب 2/ 358 في روايته عن الليث.
(32) لم نهتد إلى القائل.
(33) من اللسان (زنجب) . في النسخ الثلاث (الزنجتة) .
(34) ديوانه ص 190 والرواية فيه: لم أقل.
(2/125)
________________________________________
والفَرْعُ: أوّل نِتاجِ الغنم أو الإبل. وأَفْرَعَ القومُ إذا نُتِجوا في أوّل النِّتاج. ويقال: الفَرَعُ: أوّل نتاج الإبل يُسلخ جلده فَيُلْبَسُ فصيلاً آخر ثم تَعْطِفُ عليه [ناقة] «35» سوى أُمّه فتحلبُ عليه. قال أوس بن حَجَر «36» :
وشُبِّهَ الهيدب العبام من الأقوام ... سَقْباً مُجَلَّلاً فَرَعا
والفَرْعُ: أعلى كلّ شيء، وجَمْعُه: فُروعٌ. والفروع: الصّعود من الأرض. ووادٍ مُفْرِعٍ: أفْرَع أهلَه، أيْ: كفاهم فلا يحتاجون إلى نُجْعة. والفَرَعُ: المال المُعَدُّ. ويقال: فَرِعَ يَفْرَعُ فَرَعاً، ورجلٌ أَفْرَعُ: كثير الشّعر. والفارِع والفارِعة والأفرَعُ والفَرْعاء يوصف به كثرة الشّعر وطوله على الرأس. ورجلٌ مُفْرَعُ الكَتِفِ: أي: عريض. قال مرار «37» :
جَعْدةٌ فرعاءُ في جُمْجُمةٍ ... ضخْمةٍ نمرق عنها كالضّفر
وأفرع فلان إذا طال طولاً. وأَفْرَعْتُ «38» بفلانٍ فما أحمدته، أي: نزلت. وأفرع فلان في فرع قومه، قال النابغة «39» :
ورعابيب كأمثالِ الدُّمَى ... مُفْرِعات في ذِرَى عز الكرم
__________
(35) من المحكم 2/ 89.
(36) ديوانه 54 والرواية فيه: ملبسا فرعا.
(37) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(38) من (س) . (ص) و (ط) : أفرعته.
(39) ليس في ديوان النابغة، ولم نقع على البيت فيما تحت أيدينا.
(2/126)
________________________________________
وقول الشاعر «40» :
وفروعٍ سابغٍ أطرافها ... عللتها ريح مسك ذي فَنَع
يعني بالفروع: الشعور. وافْتَرَعْتُ المرأةَ: افْتَضَضْتُها. وفَرَّعْتُ أرض كذا: أي جوّلت فيها، وعلمت علمها وخبرها. وفَرْعَةُ الطّريق وفارِعَتُهُ: حواشيه. وتَفَرّعْتُ بني فلان: أي: تزوّجتُ سيّدةَ نسائهم. قال «41» :
وتفرّعنا من ابني وائلٍ ... هامةَ العزّ وخُرطومَ الكرم
فوارع: موضعٌ. والإفراعُ: التصويب. والمُفْرِعُ: الطويل من كلّ شيء. والفارعُ: ما ارتفع من الأرض من تلّ أو علم. أو نحو ذلك. فارِعٌ: اسمُ حصنٍ كان في المدينة. والفرعة: القملة الصغيرة.
__________
(40) (سويد بن أبي كاهل) اللسان- (فنع) .
(41) لم يقع لنا القائل.
(2/127)
________________________________________
باب العين والراء والباء معهما ع ر ب، ع ب ر، ر ع ب، ب ع ر، ر ب ع، ب ر ع مستعملات
عرب: العرب العاربة: الصريح منهم. والأعاريب: جماعة الأعراب. ورجل عربيّ. وما بها عَريب، أي: ما بها عربيّ. وأعرب الرجل: أفصح القول والكلام، وهو عربانيّ اللسان، أي: فصيح. وأعرب الفرس إذا خلصت عربيّته وفاتته القرافة. والإبل العِراب: هي العربية والعرب المستعربة الذين دخلوا فيهم فاستعربوا وتعرّبوا. والمرأة العَروُبُ: الضحّاكة الطّيّبةُ النّفس، وهنّ العرب. والعَروبةُ: يوم الجُمُعَة. قال «1» :
يا حسنه عبد العزيز إذا بدا ... يومَ العروبة واستقر المنير
كَنَّى عن عبد العزيز قبل أن يظهره، ثم أظهره. والعَرَبُ: النّشاطُ والأرَنُ. وعرب الرجل يعرب عربا فهو عَرِبٌ، وكذلك الفرس عرب، أي: نشيط.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2/128)
________________________________________
وعرب الرجل يعرب عربا فهو عَرِبٌ، أي: مُتْخَم. وعربت مَعِدَتُه وهو أن يدوي جوفه من العلف. والعِرْبُ: يبيس البهمى. الواحدة: عِرْبَةٌ. والتّعريب: أن تُعَرَّبَ الدّابّة فَتُكْوَى على أشاعراها في مواضع، ثم يُبْزَغُ بمبزَغٍ ليشتدّ أشعره. والعِرابَةُ والتَّعريب والإعْرابُ: أسامٍ من قولك: أعربت، وهو ما قبح من الكلام، وكرِه الإعرابُ للمُحْرِم. وعرّبت عن فلان، أي تكلّمت عنه بحجة.
عبر: عَبَّرَ يُعبِّر الرؤيا تَعبيراً. وعَبَرَها يَعْبُرُها عَبْراً وعِبارة. إذا فسّرها. وعَبَرْت النهر عُبوراً. وعِبْرُ النّهر شطّه. وناقةٌ عُبْرُ أسفارٍ. أي: لا تزال يُسافَرُ عليها. قال [الطّرمّاح] «2» :
قد تبطنت بهلواعة ... عبر أسفارٍ كَتُومِ البُغامْ
والمَعْبَرُ: شط النهر الذي هيىء للعبور. والمَعْبَرُ: مركب يعبر بك، أي: يقطع بلداً إلى بلَدٍ. والمِعْبَرَة: سفينة يُعْبَرُ عليها النّهرُ. وعَبَّرتُ عنه تعبيراً إذا عيّ من حُجّته فتكلّمتُ بها عنه. والشّعرى العَبورُ: نجم خلف الجوزاء. وعَبَّرتُ الدّنانير تعبيراً: وَزَنْتها ديناراً ديناراً. ورجلٌ عابِرُ سبيلٍ، أي مارُّ طريق. والعِبْرَةُ: الإعتبار لما مضى. والعَبيرُ: ضربٌ من الطيب.
__________
(2) ديوانه 407 (دمشق) ، واللسان (هلع) والرواية في اللسان: غبر بالغين المعجمة. ونسب البيت في النسخ الثلاث إلى (لبيد،) وليس في ديوانه.
(2/129)
________________________________________
وعَبْرَة الدّمع: جريُه، ونفسه أيضاً. عَبِرَ فلان يَعْبَرُ عَبَراً من الحزن، وهو عَبْرانُ عَبِرٌ، وامرأة عَبْرَى عَبِرَةٌ. واستعبر، أي: جرت عَبْرَتُهُ. والعُبْرِيُّ: ضربٌ من السِّدْر. ويقال: العُبْرِيُّ: الطويل من السِّدْر الذي له سوق. والضّال: ما صغر منه. قال العجّاج «3» :
لاثٌ بها الأشاءُ والعُبْرِيّ
وقال «4» :
..... ... ضروبَ السِّدرِ عُبْرِيّاً وضالا
والعُبْرُ: قبيلة، قال «5» :
وقابلتِ العُبْر نصف النهار ... ثمّ تولّت مع الصّادر
وقوم عَبيٌر، أي: كثيرٌ. والعِبْرانِيّة لغة اليهود.
رعب: الرُّعْبُ: الخوف. رَعَبْتُ فلاناً رُعْباً ورُعُباً فهو مرعوب مُرْتَعِبٌ، أي: فَزِع. والحمام الرّعبيّ والرّاعبيّ: يُرَعِّبُ في صوته ترعيباً، وهو شدّة الصوت. ويقال: إنّه لشديد الرَّعب. قال:
ولا أجيب الرعب إن دعيت
__________
(3) ديوانه 324 (بيروت) .
(4) (ذو الرمة) ديوانه 3/ 1530، وصدر البيت:
قطعت إذا تجوفت العواطي
(5) لم نهتد إلى القائل.
(2/130)
________________________________________
ورعّبْتُ السّنامَ ترعيباً. إذا قطّعته تِرْعيبةً تِرْعيبةً. والرّعبة: القِطعة من السّنامِ ونحوه. قال «6» :
ثمّ ظلِلنا في شواءٍ رُعْبَبُه
وقال «7» :
كأنَّهنّ إذا جرّدنَ تِرْعيب
وجارية رُعبوبة. أي: شطبة تارة، ويقال: رُعبوب والجمع: الرّعابيب. قال الأخطل «8» :
قضيت لبانةَ الحاجاتِ إلاّ ... من البيضِ الرَّعابيبِ المِلاحِ
والتَّرْعابةُ: الفَروقةُ. قال «9» :
أرى كلَّ ياموف وكلّ حَزَنْبَلٍ ... وشِهْدارة تِرْعابة قد تضلّعا
الشهدارة: القصير، وهو الذي يُسْخَر منه أيضاً. وسيلٌ راعِبٌ، إذا امتلأ (منه) «10» الوادي
بعر: البَعَرُ للإِبل ولكلّ ذي ظلف إلاّ للبقر الأهليّ فإنه يَخْثِي. والوحشيّ يَبْعَرُ. ويقال: بَعَرُ الأرانب وخراها. والمِبعار: الشاة أو النّاقة تُباعِرُ إلى حالبها، وهو البُعار على فُعال [بضم الفاء] ، لأنّه عيب. وقال: بل المِبعار: الكثيرة البَعَر.
__________
(6) التهذيب 2/ 368: وأنشد الليث وكذلك اللسان (رعب) .
(7) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(8) ليس في ديوانه.
(9) لم نهتد إليه في غير الأصول، ودوناه كما جاء في الأصول.
(10) سقطت من..
(2/131)
________________________________________
والمَبْعَر حيث يكون البَعَرُ من الإِبل والشاء، وهي: المَبَاعِر. والبعيرُ البازل. والعرب تقول: هذا بَعيرٌ ما لم يَعْرِفوا، فإذا عَرَفوا قالوا للذّكر: جمل، وللأُنْثَى: ناقة، كما يقولون: إنسان فإذا عرفوا قالوا للذكر: رجل، وللأُنْثى امرأة.
ربع: رَبَعَ يَرْبَعُ رَبْعاً. ورَبَعْتُ القومَ فأنار رابِعُهم. والرِّبْعُ من الوِرْدِ: أن تُحْبَسَ الإبلُ عن الماءِ أربعةَ أيّامٍ ثم تردَ اليومَ الخامسَ «11» . قال «12» :
وبلدةٍ تُمسِي قَطاها نُسَّسا ... روابِعاً وبعدَ رِبْعٍ خُمَّسا
ورَبَعْت الحجر بيديّ رَبْعاً إذا رفعته عن الأرض بيدك. ورَبَعْتُ الوتَرَ إذا جعلته أربعَ طاقاتٍ. قال «13»
كقوس الماسخيّ يرنّ فيها ... من الشّرعيّ مربوع متين
وقال لبيد «14» :
رابط الجأش على فرجهم ... أعطف الجون بمربوع متل
وقال «15» :
أنزعها تبوّعا ومتّا ... بالمَسَدِ المربوعِ حتى ارفتّا
__________
(11) في النسخ الثلاث: يوم الخامس.
(12) (العجاج) ديوانه 127.
(13) لم نهتد إلى قائله، ولم يقع لنا البيت في غير الأصولين.
(14) ديوانه ص 186.
(15) لم نهتد إلى الراجز.
(2/132)
________________________________________
يعني الزّمام [أي] : أنه على أربعِ قُوَى. ومربوع مثل رمحٍ ليس بطويل ولا قصير. وتقول: ارْبَعْ على ظلعك، وارْبَعْ على نفسك، أي انتظر. قال «16» :
لو أنهم قبل بينهم رَبَعوا
والرَّبْعُ: المنزلْ والوطنُ. سمّي رَبْعاً، لأنّهم يَرْبَعون فيه، أي: يطمئنّون، ويقال: هو الموضع الذي يرتبعون فيه في الرّبيع. والرُّبَعُ: الفصيل الذي نُتِجَ في الرّبيع. ورجلٌ رَبْعَة ومَرْبوع الخلق، أي: ليس بطويل ولا قصير. والمِرباعُ كانت العرب إذا غزت أخذ رئيسُهم رُبْعَ الغنيمةِ، وقَسَمَ بينهم ما بقي. قال «17» :
لك المِرباعُ منها والصّفايا ... وحُكْمُكَ والنَّشيطةُ والفُضولُ
وأوّل الأسنان الثّنايا ثم الرَّباعيات، الواحدة: رَباعيَة. وأَرْبَعَ الفرس: ألقى رَباعِيَتَهُ من السّنة الأخرى. والجميع: الربع والأثني: رَباعيَة. والإِبل تعدو أربعة، وهو عَدْوٌ فوق المشي فيه مَيَلان. وأرْبَعَتِ الناقةُ فهي مُرْبعٌ إذا استغلق رَحِمُها فلم تقبل الماء. والأربِعاء والأربِعاوان والأربِعاوات مكسورة الباء حُمِلَتْ على أسعِداء. ومن فتح الباء حمله على قصباء وشبهه «18» والرّبيعة: البيضة من السّلاح. قال «19» :
ربيعته تلوح لدى الهياج
__________
(16) (الأحوص) ديوانه ص 121 وصدره:
ما ضر جيراننا إذ انتجعوا
(17) التهذيب 2/ 369، والمحكم 2/ 98 والصحاح (ربع) وهو منسوب إلى عبد الله بن عنمة الضبي.
(18) في (س) وشبهاء.
(19) لم يقع لنا القائل ولا القول في غير الأصول.
(2/133)
________________________________________
ورُبِعَتِ الأرضُ فهي مربوعة من الرّبيع. وارْتَبَعَ القوْم: أصابوا ربيعاً، ولا يقال: رُبِعَ. وحمّى ربع تأتي في اليوم الرابع. والمِرْبَعَةُ: خَشَبَةٌ تشال بها الأحمال، فتوضع على الإبل. قال «20» :
أين الشَّظاظانِ وأين المِرْبَعة
قال شجاع: الرَّبَعَةُ أقصى غايةِ العادي. يقال: مالك ترتبع إليّ، أي: تعدو أقصى عَدْوك. رَبَعَ القوم في السّير. أي: رفعوا. قال «21»
واعْرَوْرَتِ العُلُطَ العُرْضيَّ تركضه ... أم الفوارس بالدئداء والرَّبَعَة
وقال «22» :
ما ضرَّ جيراننا إذ ارتبعوا ... لو أنّهم قبلَ بَيْنِهِمْ رَبعوا
هذا من قولهم: إرْبَعْ على نفسك. ويقال: الرّبعة: عَدْوٌ فوق المشي فيه مَيَلان. والرَّبْعَةُ: الجُونةُ. قال خلف بن خليفة «23» :
محاجم نضدن في ربعة
__________
(20) لسان العرب (ربع) بدون عزو.
(21) البيت في التهذيب 2/ 372 واللسان (ربع) وقد نسب فيه إلى (أبي دواد الرؤاسي) .
(22) (الأحوص) ديوانه 121.
(23) لم نقع عليه في غير الأصول.
(2/134)
________________________________________
برع: بَرَعَ يَبْرُعُ بَرْعاً، وهو يتبرّع من قبل نفسه بالعطاء، إذا لم يطلب عوضاً. قالت الخنساء «24» :
جَلْدٌ جميلٌ أريبٌ بارعٌ وَرِعٌ ... مأوى الأرامِلِ والأيتامِ والجار
__________
(24) ليس في ديوانها ولا في الظان التي رجعنا إليها.
(2/135)
________________________________________
باب العين والرّاء والميم معهما ع ر م، ع م ر، ر ع م، م ع ر، ر م ع، م ر ع مستعملات
عرم: عَرَمَ الإنسانُ يَعْرُمُ عَرامةً فهو عارِمٌ. وعَرُم يَعْرُم. قال صقر بن حكيم «1» :
إنّي امرؤٌ يَذُبُّ عن مَحارمي ... بسطةُ كفٍّ ولسانٍ عارمِ
وعُرامُ الجيشِ: حدُّهم وشِرَّتُهم وكَثْرتُهم. قال سَلامَة بنُ جَنْدَل «2» :
وإنّا كالحصى عَدَداً وإنّا ... بنو الحربِ التي فيها عُرامُ
وقال «3» :
وليلةِ هَوْلٍ قد سَرَيْتُ وفِتْيةٍ ... هَدَيْتُ وجمعٍ ذي عُرامٍ مُلادِسِ
والعَرِمُ: الجُرَذُ الذّكَرُ. والعُرْمَةُ: بياضٌ بمرَمّة الشاة، عنقها بيضاء وسائرها أسود. والعَرَمَةُ الكُدْسُ المدوسُ الذي لم يُذَرَّ بعد كهيئة الأزج.
__________
(1) التهذيب 2/ 390، واللسان- عرم، غير منسوب.
(2) ديوانه- ص 251، والمحكم 2/ 104.
(3) التهذيب 2/ 390 واللسان (عرم) غير منسوب أيضا.
(2/136)
________________________________________
قال شجاع: لا أقول: نعجة عَرْماء، ولكن ماعزة عرماء ببطنها بياض. والعَرَمْرَمُ: الجيشُ الكثير. وجبلٌ عَرَمْرَمٌ، أي: ضخم. قال «4» :
أداراً بأجْمادِ النَّعام عَهِدْتُها ... بها نَعَماً حَوْماً وعِزّاً عَرَمْرَمَا
والعَرَمْرَمْ الشّديدْ العجمةِ الذي لا يُفصح.
عمر: العَمْرُ: ضربُ من النَّخْلِ وهو السَّحُوقُ الطويلُ. والعَمْرُ: ما بدا من اللِّثة، ومنه اشتقّ اسم عمرو. والعُمْرُ عُمْرُ الحياة. وقول العرب: لعَمْرُكَ، تحلف بعمره، وتقول: عَمْرَكَ الله أن تفعل كذا. هذا إن تحلفه بالله، أو تسأله طول عُمره. عَمَرَ النّاس وعّمَّرهُمُ الله تعميراً. وتقول: إنّك عَمْري لظريف. وعَمَرَ النّاس الأرض يَعْمُرُونَها عِمارةً، وهي عامرة معمورة ومنها العُمْران. واستعمر الله النّاسَ ليَعْمُروها. والله أعمر الدّنيا عمْراناً فجعلها تعمر ثمُ يُخَرِّبُها. والعِمارة: القبيلة العظيمة. والعُمورُ: [حي من عبد القيس] «5» . قال «6» :
فلولا كان أسعد عبد قيسٍ «7» ... أعاديها لعادتني العمور
والحاجُّ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً. والعَمْرَةُ: خَرَزَةٌ حمراء كثيرة الماء طويلة تكون في القرط.
__________
(4) المحكم 2/ 105، واللسان (عرم) غير منسوب أيضا.
(5) من المحكم 2/ 109، واللسان (عمر) في النسخ الثلاث: (اسم أبي حي من قيس) .
(6) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(7) من (س) . في (ص) و (ط) : (ابن بكر) .
(2/137)
________________________________________
والإفلاس يُكنى أبا عَمْرَة «8» .
رعم: رَعَمَتِ الشّاةُ تَرْعَمُ فهي رَعومٌ، وهو داءٌ يأخذُ في أنفها فيسيل منه شيء، فيقال لذلك الشيء: رُعام رَعُوم: اسم امرأة تشبيهاً بالشّاة الرّعوم. قال الأخطل «9» :
صَرَمَتْ أمامةُ حَبْلَنا وَرَعُومُ ... وبدا المُجَمْجَمُ منهما، المَكْتومُ
رُعْم: اسم امرأة. قال «10» :
ودع عنك رُعْماً قد أتى الدّهر دونها ... وليس على دهر لشيء معول
معر: مَعِرَ الظُّفْرُ مَعَراً. إذا أصابه شيءٌ فَنَصَلَ. قال «11» :
بوقاح مجمر غير مَعِرْ
وقال «12» :
تتّقي الأرضَ بمرثومٍ مَعِرْ
وتَمَعَّرَ لَوْنُهُ إذا تغيّر، وعَرَتْه صفرةٌ من غضبٍ. ورجل أَمْعَرُ، وبه مُعْرَة، وهو لون يضرب إلى الحمرة والصفرة، وهو أقبح الألوان.
__________
(8) من (س) . في (ص) و (ط) : أباعمرو. في التهذيب 2/ 388، والمحكم 2/ 109. واللسان (عمر) : أبوعمرة.
(9) ديوانه 1/ 380 والرواية فيه: حبلها.
(10) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(11) لم يقع لنا الراجز. ولا الرجز في غير الأصول.
(12) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز في غير الأصول.
(2/138)
________________________________________
ومَعِرَ رأس الرّجل إذا ذهب شعره، وأَمْعَر أيضاً بالألف. قال «13» :
والرأس منك مبيّن الإِمْعارِ
ويقال: رجلٌ أَمْعَرُ، أي: قليل الشعر، مثل أَزْعَر. وأَمْعَرَت الأرضُ إذا لم يكن فيها نبات، وأرض مَعِرَة مثل زَعِرَة: قليلة النبات غليظة. ومَعِرَتِ الأرضُ وأمْعَرَتْ لغتان. قال الكميت «14» :
أصبحت ذا تلعة خضراء إذْ مَعِرَتْ ... تلك التلاع من المعروف والرّحب
وأَمْعَرْنا في هذا البلد، أي: وقعنا في أرض مَعِرَة.
رمع: رَمَعَ يَرْمَعُ رَمْعاً ورَمَعاناً وهو التحرّك «15» . وتقول: مرّ بي يرمع رمعاً ورمعاناً مثل: رسم يرسم رسماً «16» ورسماناً. والرَّمّاعةُ: الاست، لترمُّعِها، أي: تحرّكها. والرَّمّاعةُ التي تتحرك من رأس الصبيّ المولود [من يافوخه من رقّته] «17» . واليَرْمَعُ: الحصى البيض التي تتلألأ في الشمس، الواحدة بالهاء. قال رؤبة «18» :
حتى إذا أحمى النهار اليرمعا
__________
(13) لم يقع لنا القائل ولا القول كاملا.
(14) ليس في مجموعة أشعاره، ولا فيما بين أيدينا من مصادر.
(15) (ص) غير واضحة، (ط) التحرف.
(16) سقطت من (ص) و (ط) .
(17) من التهذيب 2/ 393 من روايته عن الليث.
(18) ما في ديوان رؤبة هو:
بالبيد إيقاد الحزور اليَرْمَعا
(2/139)
________________________________________
مرع: مرُعَ يَمْرَعُ مُرْعاً والمَرْعُ الاسم، وهو الكلأ. ويقال: أرض مَرِعَةٌ مُمْرِعة. مثل خَصِبَة مُخْصِبة. وأَمْرَعَ القومُ: أصابوا مَرْعاً. قال «19» :
فلما هبطناه وأَمْرَعَ سربنا ... أسال علينا البطن بالعدد الدثر
وأَمْرَعَ المكانُ والوادي، أي: أكلآ.
__________
(19) لم نهتد إلى القائل.
(2/140)
________________________________________
باب العين واللاّم والنّون معهما ع ل ن، ل ع ن، ن ع ل مستعملات
علن: عَلَنَ الأمرُ يَعْلُنُ عُلُوناً وعَلانِيَةً، أي: شاع وظهر. وأعلنته إعلاناً. قال «1» :
قد كنت وَعَّزْت إلى علاء ... في السر والإعْلانِ والنَّجاءِ
ويقال للرّجُل: استسرّ ثم استعلَنَ. لا يقال: أعلن إلاّ للأمر والكلام، وأمّا استعلن فقد يجوز في كلّ ذلك. واعْتلَنَ الأمر، أي: اشتهر. ويقولون: استعلِنْ يا رجل، أي: أَظْهِرْ. والعِلان: المُعالَنة، يُعْلِنُ كلُّ واحدٍ لصاحبه ما في نفسه. قال «2» :
وإعلاني لمن يبغي عِلاني
لعن: اللّعن: التّعذيب، والمُلَعّنُ: المعذّب، واللَّعِينُ المشتوم المسبوب «3» . لَعَنْتُه: سَبَبْتُه. ولَعَنَهُ اللهُ: باعده.
__________
(1) اللسان (وعز) ، غير معزو أيضا.
(2) التهذيب 2/ 396 عن الليث، واللسان (علن) ، وصدر البيت فيهما:
وكفي عن أذى الجيران نفسي
(3) في النسخ الثلاث: المسبب.
(2/141)
________________________________________
واللَّعِينُ: ما يُتّخذ في المزارع كهيئة رجل. واللَّعْنَةُ في القرآن: العذابُ. وقولهم: أبيت اللَّعْنَ، أي: لا تأتي أمراً تُلْحَى عليه وتُلْعَنُ. واللّعنة: الدّعاء عليه. واللُّعَنَةُ: الكثيرُ اللّعن، واللُّعْنَةُ: الذي يلعنه النّاس. والْتَعَنَ الرّجُل، أي: أنصف في الدّعاء على نفسِه وخَصْمِه، فيقول: على الكاذب منّي ومنك اللَّعْنة. وتلاعَنوا: لَعَنَ بعضهم بعضا، واشتقاق مُلاعَنة الرّجل امرأته منه في الحكم. والحاكم يُلاعِنُ بينهما ثم يُفَرِّق. قال جميل «4» :
إذا ما ابنُ ملعونٍ تَحدَّر رشْحُه ... عليكِ فموتي بعد ذلك أوذري
والتلاعُنُ كالتَّشاتُم في اللفظ، وكلّ فعل على [تفاعل] «5» فإن الفعل يكون منها، غير أن التّلاعُنَ ربّما استعمل في فعل أحدهما، والتَّلاعُنُ يقع فعل كلّ واحدٍ منهما بنفسه ويجوز أن يقع كلُّ واحدٍ بصاحبه فهو على معنيين.
نعل: النَّعْل: ما جُعِلَتْ وقاية من الأرض. نَعِل يَنْعَل نعلاً، وانتعل بكذا: [إذا لبس النّعل] «6» . والتنعيل: أن يُنَعّل حافر البِرْذَوْن بطبقٍ من حديد يقيه الحجارة، [وكذلك خُفّ البعير بالجلد] «7» لئلا يحفى.
__________
(4) ديوانه ص 101.
(5) في النسخ: (مفاعل) .
(6) زيادة من التهذيب 2/ 398 من روايته عن الليث.
(7) زيادة من التهذيب 2/ 398 من روايته عن الليث.
(2/142)
________________________________________
ويقال: لا يقال إلاّ أَنْعلت. ويوصف حمار الوحش فيقال: ناعِلٌ، لصلابته. قال «8» :
يركب قيناه وقيعا ناعلا
يقول: صلبُ من توقيع الحجارةِ حتّى كأنّه مُنْتَعِلٌ من وَقاحته. ورجلٌ ناعل: ذو خفّ ونَعْل، وكذلك مُنْعِل. وكذلك يقال: أنْعَلتُ الفرس. ونَعْلُ السيف: الحديدة التي في أسفل جفنه. قال «9» :
إلى ملك لا ينصف السّاق نعله
والنَّعلُ من الأرض: شبه أكمة صلب يبرق حصاه، لا ينبت شيئاً، ويجمع النّعال، ونعلها غِلَظُها. قال «10» :
كأنّهمْ حَرْشَفٌ مَبْثُوثٌ ... بالجوِّ إذ تَبْرُقُ النِّعالُ
يعني: نعال الحرة.
__________
(8) ديوانه/ 125.
(9) (ذو الرمة) ديوانه 2/ 1266 وعجز البيت:
أَجَلْ لا، وإنْ كانت طوالا محامله
والرواية فيه: (ترى سيفه) مكان (إلى ملك) .
(10) (امرؤ القيس) ديوانه 193.
(2/143)
________________________________________
باب العين واللاّم والفاء معهما ع ل ف، ع ف ل، ف ع ل، ل ف ع، ف ل ع مستعملات
علف: عَلَفْتُ الدّابةَ أَعْلِفُها عَلْفاً، أي: أطعمتها العَلَف. والمِعْلَفُ: موضع العَلَف. والدّابة تعتلف، أي: تأكل، وتستعلِفُ، أي: تطلب العَلَفَ بالحمحمة. والشّاة المُعَلَّفة هي التي تسمّن. علّفتها تعليفاً [إذا أكثرت تعهّدها بإلقاء العَلَفِ لها] «1» . (وعلوفة الدّوابّ كأنّه جَمْعٌ وهو شبيهٌ بالمصدر وبالجمع أُخرى) «2» . والعُلَّفُ: ثمرُ الطّلح، مشددة اللاّم، الواحدة بالهاء. والعِلافِيّ، منسوب، وهو أعظم الرِّحال آخرة وواسطاً «3» . وجمعه: عِلافيّات. قال ذو الرّمة «4» :
أحمُّ عِلافيٌّ وأبيضُ صارمٌ ... وأَعْيَسُ مَهْرِيٌّ وأروع ماجد
__________
(1) ما بين المعقوفتين من التهذيب من روايته عن الليث وما يقابله في النسخ مضطرب.
(2) جعلت بين قوسين لأنها مضطربة.
(3) من التهذيب في روايته عن الليث 2/ 400. في النسخ الثلاث: واسطة.
(4) ديوانه 2/ 1109، والرواية فيه (وأشعث ماجِدُ) .
(2/144)
________________________________________
وقال «5» :
شعب العِلافيّاتِ بين فروجهم ... والمحصناتُ عوازبُ الأطهار
قوله بين فروجهم، أي قد ركبوها ونساؤهم عوازب منهن إذا طهرن لا يغشونهنَّ، لأنّهم أبداً على الأسفار. وشيخ عُلْفوفٌ: كثيرُ الشَّعَرِ واللّحمِ، ويقال: هو الكبير السّنّ.
عفل: عَفِلَتِ المرأةُ عَفَلاً فهي عَفْلاءُ. وعَفِلَتِ النّاقةُ. والعَفَلُ والعَفَلَةُ الاسم، وهو شيء يخرج في حياء النّاقة شِبهُ أَدَرة.
فعل: فَعَلَ يَفْعَلُ فَعْلاً وفِعْلاً، فالفَعْلُ: المصدر، والفِعْل: الاسم، والفَعالُ اسمٌ للفِعل الحسَن، مثل الجود والكرم ونحوه. ويقرأ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ «6» بالنصب. والفَعَلَةُ: العَمَلَةُ، وهم قوم يستعملون الطّينَ والحَفْر وما يشبه ذلك من العمل.
لفع: لفع الشّيبُ الرأس يلفع لفعاً، أي: شمل المشيب الرأس. قال سويد «7» :
كيف يرجون سقاطي بعد ما ... لفع الرأس مشيب وصلع
__________
(5) لم نهتد إلى القائل.
(6) الأنبياء 73.
(7) لم نهتد إلى القائل.
(2/145)
________________________________________
وتلفّع الرّجلُ، إذا شمله الشيبُ، كأنّه غطّى على سوادِ رأسِه ولحيته. قال رؤبة بن العجاج «8» :
إنّا إذا أمر العدى تَتَرَّعا ... وأجمعت بالشر أن تلفعا
أي: تلبّس بالشّر، يقول: يشمل شرُّهم النّاسَ. وقال «9» :
وقد تلفع بالقور العساقيل
يعني: تلفع السّرابُ على القَارَةِ. وإذا اخضرَّ الرَعيُ واليبيسُ، وانتفعَ المالُ بما يأكل. قيل: قد تَلَفَّعَ المالُ. ولُفِّعَتْ «10» فهي مُلَفَّعَة. واللِّفاعُ: خمارٌ للمرأة يَسْتُرُ رأسَها وصَدْرَها، والمرأة تَتَلَفَّعُ به. وتقول: لَفِّعَتِ المزادةُ فهي مُلَفَّعَة، أي: ثنيتها فجعلت أَطِبَّتَها في وَسَطها، فذلك تَلْفِيعُها.
فلع: فَلَعَ رأسَه بحجرٍ يَفْلَعُ فَلْعاً فهو مَفْلوعٌ، أي مشقوق، فانْفَلَعَ، أي: انشقّ. قال طفيل «11» :
نَشُقُّ العِهادَ الحُوَّ لم تُرْعَ قبلنا ... كما شُقَّ بالمُوسَى السَّنامُ المفلع
وتفلعت البطيخة، وتفلعت العَقِبُ ونحوه. ويُقال في الشتم: لَعَنَ الله فِلْعَتَها. ويقال للمرأة: يا فَلْعَاءُ، ويا فَلْحاء، أي: يا منشقة.
__________
(8) ديوانه 91. في النسخ الثلاث: (العجاج) .
(9) (كعب بن زهير) ديوانه 16 وصدره:
كأنّ أَوْبَ ذراعيها وقد عرقت
(10) في النسخ الثلاث (وألفعت) ولم نجد (ألفع) .
(11) (طفيل الغنوي) كما في اللسان (فلع) .
(2/146)
________________________________________
باب العين واللاّم والباء معهما ع ل ب، ع ب ل، ل ع ب، ب ع ل، ب ل ع مستعملات
علب: عَلِبَ النّباتُ يَعْلَبُ عَلَباً فهو عَلِبٌ. وهو الجاسي. واللحم يَعْلَبُ ويستَعْلَبُ إذا لم يكن رخصاً. واسْتَعْلَبْتُ البقل، أي: وجدْتُه عَلِباً. والعلبة الشيخ الكبير المهزول. والعُلْبُ: الضبُّّ الضّخْمُ المُسِنُّ. والعِلْباءُ: عَصَبُ العُنُق، وهما عِلباوان، وهُنَّ عَلاَبيُّ. ورمْح مُعَلَّبٌ، أي: مجلُوزٌ بعَصَبِ العِلْباء. والعُلْبَةُ من خشب كالقَدَح يُحْلَبُ فيها. ويقال: عَلَّبْتُ السّيفَ بالعَلابيّ تَعْليباً، وهو سيف مُعَلَّبٌ ومَعْلوبٌ. قال «1» :
وسيفُ الحارثِ المعْلوبُ أَرْدَى ... حُصَيْناً في الجبابرةِ الرَّدِينا
وبعير أَعْلَبُ، وقد عَلِبَ عَلَباً، وهو داء يأخذ في جانِبَيْ عنقه تُرِمُ منه الرَّقَبَةُ وتنحني، تقول: قد حز علباويه، وعلبابيه وبالواو أجود. والعِلابُ سمة في طول العُنُق، ربّما كان شبراً، ورُبّما كان أقصر.
__________
(1) (الكميت) - شعره 2/ 129.
(2/147)
________________________________________
وعَلَبْتُ الشيءَ أَعْلُبُهُ عَلْباً وعُلُوباً إذا أثّرت فيه. قال ابن الرَّقاع «2» :
يتبعْنَ ناجية كأنّ بِدَفِّها ... من غَرْضِ نِسْعتها عُلُوبَ مواسم
عبل: العَبْلُ: الضَّخم، عَبُلَ يَعْبُلُ عَبالةً. قال «3» :
خبطناهم بكلّ أزجّ لام ... كمرضاخ النّوى عَبْلٍ وقاحِ
وحَبْلٌ أَعْبَلُ، وصخرة عَبْلاء، أي: بيضاء. وقد عَبِلَ عَبَلاً فهو أعبل. قال أبو كبير الهذليّ «4» :
أخرجت منها سلقة مهزولة ... عجفاء يَبْرُقُ نابُها كالأَعْبَلِ
أي: كحجرٍ أبيضَ صلب من حجارة المرو. والعَبَلُ: ثمر الأرطى، الواحدة بالهاء.
لعب: لَعِبَ يَلْعَبُ لَعِباً ولَعْباً، فهو لاعبٌ لُعَبَةٌ، ومنه التَّلعُّب. ورجل تِلِعّابة- مشددة العين- أي: ذو تلعُّبٍ. ورجل لُعَبَة، أي: كثير اللَّعِبِ، ولُعْبَة، أي: يُلْعَبُ به كلُعْبَة الشّطْرَنْجِ ونحوها. قال الرّاجز «5» :
العَبْ بها أو اعْطِني ألعب بها ... إنك لا تُحْسِنُ تَلعاباً بها
والمَلْعَبُ حيث يُلْعَبُ. والمِلْعَبَةُ: ثوبٌ لا كُمَّ له، يلعب فيها الصبي.
__________
(2) التهذيب 2/ 407، واللسان (علب) .
(3) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(4) ليس في قصيدة أبي كبير اللامية، والذي فيها هو قوله:
صديان أخذي الطرف في ملمومة ... لون السحاب بها كلون الأعبل
(5) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز في غير الأصول.
(2/148)
________________________________________
واللّعّاب من يكونُ حرفتُه اللَّعِب.. ولُعابُ الصّبيّ: ما سال من فيه، لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْباً، ولعابُ الشّمس: السّراب. قال «6» :
في صحن يهماء يهتَفُّ السّهامُ بها ... في قَرْقَرٍ بلُعاب الشّمسِ مَضْروجِ
قال شجاع: المضروج من نعت القَرْقَر، يقول: هذا القرقر قد اكتسَى السّراب، وأعانه ذائب من شُعاع الشّمس، فقوّى السّراب. ولعاب الشّمس أيضاً: شعاعُها. قال «7» :
حتى إذا ذاب لعابُ الشّمسِ ... واعترف الرّاعي ليومٍ نجسِ
ومُلاعِبُ ظِلِّهِ: طائر بالبادية. ومُلاعِبا ظِلّيهِما، والثلاثة: ملاعباتُ ظِلالِهِنَّ. وتقول: رأيت ثلاثة مُلاعِباتِ أظلالٍ لَهُنَّ، ولا تَقُلْ أظلالَهنّ، لأنّه يصيرُ معْرِفَةً. قال شجاع: مُلاعِبُ ظلِّهِ عندنا: الخطّاف.
بعل: البَعْلُ: الزّوجُ. يقال: بَعَلَ يَبْعَلُ بَعْلاً وبُعَولة فهو بَعْل مستبعل، وامرأة مستبعل، إذا كانت تحظَى عند زوجها، والرّجل يتعرّس لامرأته يطلب الحُظْوَة عندها: والمرأة تتبعّل لزوجها إذا كانت مطيعةً له. والبَعْلُ: أرضٌ مرتفعة لا يُصيبُها مطر إلاّ مرّةً في السّنة. قال سلامة بن جندل «8» :
إذا ما عَلَوْنا ظهرَ بَعْلٍ عَريضَةٍ ... تَخالُ علينا قَيْضَ بَيْضٍ مفلق
__________
(6) (ذو الرمة) ديوانه 2/ 992.
(7) لم نهتد إلى الراجز.
(8) المحكم 2/ 112 واللسان (بعل) . وديوانه 164 إلا أن الرواية فيه: (نشز) وهو وهم من المحقق.
(2/149)
________________________________________
ويقال: البَعْلُ من الأرضِ التي لا يَبْلُغُها الماءُ إنْ سيق إليها لارتفاعها. ورجل بَعِلٌ، وقد بَعِل يَبْعَلُ بَعَلاً إذا كان يصير عند الحرب كالمبهوت من الفرق والدّهش. قال أعشى هَمْدان:
فجاهَدَ في فُرسانِهِ ورجالِهِ ... وناهَضَ لم يَبْعَلْ ولم يتهيّب
وامرأة بَعْلَةٌ: لا تُحسنُ لبسَ الثّياب. والبَعْلُ من النَّخل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها. قال عبد الله بن رَواحة «9» :
هنالك لا أبالي سقيَ نَخْل ... ولا بَعْلٍ وإنْ عَظُمَ الإِتاءُ
الإِتاء: الثّمرة. والبَعْلُ: الذّكر من النّخل، والنّاس يسمّونه: الفّحْل. قال النّابغة «10» :
من الواردات الماء بالقاعِ تستقي ... بأذنابِها قبلَ استقاءِ الحناجِر
أراد بأذنابها: العروق. والبَعْلُ: صَنَمٌ كان لقومِ إلياس. قال الله عز وجل: أَتَدْعُونَ بَعْلًا والتّباعُلُ والمُباعَلَةُ والبِعالُ: مُلاعَبة الرّجلِ أهلَه، تقول: باعَلَها مُباعَلة،
وفي الحديث: أيّام شرب وبعالٍ «11» .
__________
(9) المحكم 2/ 123، واللسان (بعل) . والرواية فيهما: لا أبالي نخل بعل ... ولا سقي..
(10) ديوانه ص 145، والرواية فيه: من الشارعات الماء ... بأعجازها مكان بأذنابها.
(11) تمام الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أيام التشريق، فقال:
إنها أيام أكل وشرب وبعال.
التهذيب 2/ 414.
(2/150)
________________________________________
بلع: بَلِعَ الماءَ يَبْلَعُ بَلْعاً، أي شرب. وابتلعَ الطّعامَ، أي: لم يَمضغْهُ. والبُلَعَةُ من قامة البكرة سَمُّها وثَقْبُها، ويُجمعُ على بُلَع. والبالوعةُ والبَلُّوعةُ: بئر يُضَيَّقُ رأسُها لماءِ المطر. والمَبلع: موضعُ الابتلاع من الحَلْق. قال «12» :
تأمّلوا خَيْشومَه والمَبْلَعا
والبُلَعَةُ والزُّرَدَةُ: الإنسان الأكول. ورجل متبلّع إذا كان أكولاً. وسَعْدُ بَلْعٌ: نجم يجعلونه معرفة. ورجلٌ بَلْعٌ، أي: كأنّه يبتلِعُ الكلامَ. قال رؤبة «13» :
بَلْعٌ إذا استنطقتني صموت
__________
(12) لم نهتد إلى الراجز. غير أن لرؤبة ما يقاربه، وهو قوله:
ما ملئوا أشداقه والمبلعا.
(13) ديوانه 26.
(2/151)
________________________________________
باب العين واللاّم والميم معهما ع ل م، ع م ل، م ع ل، ل م ع مستعملات
علم: عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْماً، نقيض جَهِلَ. ورجل علاّمة، وعلاّم، وعليم، فإن أنكروا العليم فإنّ الله يحكي عن يوسف إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ «1» ، وأدخلت الهاء في علامة للتّوكيد. وما عَلِمْتُ بخبرك، أي: ما شعرت به. وأعلمته بكذا، أي: أَشْعَرْتُه وعلّمته تعليماً. والله العالِمُ العَليمُ العلاّمُ. والأَعْلَمُ: الذي انشقّتْ شَفَتُه العُليا. وقوم عُلْمٌ وقد عَلِمَ عَلَماً. قال عنترة «2» :
تمكو فَريصَتُه كشِدْقِ الأعلَمِ
والعَلَمُ: الجبل الطّويل، والجميع: الأعلام. قال «3» :
قال ابنُ صانعةِ الزّروب لقومه ... لا أستطيعُ رواسيَ الأَعْلامِ
__________
(1) يوسف 55.
(2) ديوانه 24. وصدر البيت:
وخليل غانية تركت مجدلا
(3) لم نهتد إلى القائل. ولم نجد القول في غير الأصول.
(2/152)
________________________________________
ومنه قوله [تعالى] : فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ
«4» *، شبه السّفن البحرية بالجبال. والعَلَمُ: الرّاية، إليها مجمعُ الجُند. والعَلَمُ: عَلَمُ الثّوبِ ورَقْمُه. والعَلَمُ: ما يُنْصَبُ في الطّريق، ليكون علامةً يُهْتَدَى بها، شِبْه الميل والعَلامَة والمَعْلَم. والعَلَم: ما جعلته عَلَماً للشيء. ويُقرأ: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ «5» ، يعني: خروج عيسَى ع، ومن قرأ لعلم يقول: يعلم بخروجه اقتراب السّاعة. والعالَم: الطّمش، أي الأنام، يعني: الخلق كلّه، والجمع: عالَمون. والمَعْلَمُ: موضعُ العلامة. والعَيْلَمُ: البحر، والماء الذي عليه الأرض، قال «6» :
في حوض جيّاش بعيدٍ عَيْلَمُهْ
ويقال: العيلم: البئر الكثيرة الماء، قال «7» :
يا جَمَّةَ العَيْلَم لَنْ نُراعي ... أورد من كلّ خليفٍ راعي
الخليف: الطّريق. والعُلامُ: الباشِقُ. عُلَيْمٌ: اسمُ رجل.
عمل: عَمِلَ عَمَلاً فهو عاملٌ. واعتمل: عمل لنفسه. قال «8» :
إنّ الكريمَ وأبيك يَعْتَمِلْ ... إنْ لم يجد يوما على من يتكل
__________
(4) الشورى 32 والرحمن 24.
(5) الزخرف 61.
(6) (رؤبة) ديوانه 159 والرواية فيه: خسيف.
(7) لم نهتد إلى الراجز.
(8) بعض الأعراب، كما في الكتاب 1/ 443.
(2/153)
________________________________________
والعمالة: أجر ما عمل لك. والمعاملة: مصدر عاملْته مُعامَلةً. والعَمَلَةُ: الذين يعملون بأيديهم ضروباً من العَمَل حَفْراً وطيناً ونحوه. وعاملُ الرُّمْحِ: دون الثّعلب قليلاً ممّا يلي السِّنان وهو صّدْرُه. قال «9» :
أطعَنُ النَّجلاء يَعْوي كَلْمُها ... عامل الثّعلب فيها مُرْجَحِنْ
وتقول: أعطِهِ أَجْرَ عملته وعمله. ويقال: كان كذا في عملة فلانٍ علينا، أي: في عمارته. ورجُلٌ عِمِّيلٌ: قويّ على العمل. والعَمولُ: القويُّ على العمل، الصابر عليه، وجمعه: عُمُلٌ. وأَعْمَلْتُ إليك المطيَّ: أَتْعبتُها. وفلان يُعْمِلُ رأيه ورُمْحَه وكلامه ونحوه [عَمِلَ به] «10» . والبنّاء يستعمل اللّبِنَ إذا بنَى. واليَعْمَلَةُ من الإبل: اسم مشتقّ من العمل، ويجمع: يَعْمَلات، ولا يقال إلاّ للأنثى، وقد يُجمع باليعامل، قال «11» :
واليَعْمَلاتُ على الوَنَى ... يَقْطَعْنَ بيداً بعدَ بيدِ
معل: مَعَلْت الخُصْيَةَ إذا استخرجتها من أرومتها وصَفَنِها.
__________
(9) لم نهتد إلى القائل.
(10) من المحكم لتوضيح المعنى. 2/ 127.
(11) لم نهتد إلى القائل فيما بين أيدينا من مصادر.
(2/154)
________________________________________
لمع: لَمَعَ بثوبه يلمع لمعا، للإنذار، أي: للتحذير. وأَلْمَعَتِ النّاقةُ بذَنَبِها فهي ملمعة، و [هي] «12» مُلْمِعٌ أيضاً: قد لَحِقَتْ. قال لبيد بن ربيعة «13» :
أو مُلْمِعٌ وَسَقَتْ لأحْقَبَ لاحَهُ ... طَرْدُ الفُحول وزَرُّها وكِدامُها
ويقال: أَلْمَعَتْ إذا حملتْ، ويقال: ألْمَعَتْ إذا تحرَّك ولدُها في بطنها. وتلمَّع ضرعُها إذا تلوّن ألواناً عند الإنزال. قال أبو ليلى: يقال: لَمَعَ ضَرْعُها إذا ظهر. واللُّمَعُ: التّلميع في الحجر، أو الثّوب ونحوه من ألوانٍ شتَّى، تقول: إنّه لحجرٌ مُلَمّعٌ، الواحدة: لُمْعة. قال لبيد «14» :
مَهْلاً أبيت اللّعنَ لا تأكُلْ معَهْ ... إنّ استَهُ من بَرَصٍ مُلَمَّعه
يقول: هو منقّط بسواد وبياض. ويقال: لَمْعَة سوادٍ أو بياضٍ أو حُمرة. يَلْمَع: اسم البَرْق الخُلَّب. واليلمَعُ: السّراب. واليلمعُ: الملاّذُ الكذّاب، ويقال: ألْمَعِيٌّ، لغة فيه، وهو مأخوذ من السّراب قال أبو ليلى: اليَلْمَعيّ من القوم: الدّاعي الذي يَتَظَنَّى الأمور ولا يكاد يخطىء ظنّه، قال أوس بن حجر «15» :
__________
(12) زيادة من التهذيب 2/ 423.
(13) ديوانه 304، والرواية فيه: (ضربها) مكان (زرها) .
(14) ديوانه 343.
(15) ديوانه ص 53. والرواية فيه: الألمعي.
(2/155)
________________________________________
اليَلْمَعيّ الذي يَظُنُّ بكَ الظّنَّ كأنْ قد رأى وقد سَمِعا واللِّماعُ جمعُ اللُّمْعَة من الكلأ. والْتمعْتُ الشيء ذهبتُ به، وأمّا قول الشاعر «16» :
أَبَرْنا منْ فَصيلتِهِمْ لِماعاً
أي: السّيّد اللاّمع، وإن شئت فمعناه. التمعناهم، أي: استأصلناهم.
__________
(16) (القطامي) ديوانه 36 والرواية فيه: فصيلته وصدر البيت:
زمان الجاهلية كل حي.
(2/156)
________________________________________
باب العين والنّون والفاء معهما ع ن ف، ع ف ن، ن ع ف، ن ف ع، ف ن ع مستعملات
عنف: العُنْف: ضدّ الرفق. عَنَفَ يَعْنُفُ عَنْفاً فهو عنيفٌ. وعنّفته تعنيفاً، ووجدت له عليك عُنْفاً ومشقّة. وعُنْفُوانُ الشّباب: أوّل بهجته، وكذلك النّبات. قال «1» :
تلومُ امْرأً في عُنْفُوانِ شبابهِ ... وتتركُ أشياعَ الضّلالةِ حُيَّرا
وقال «2» :
وقد دعاها العُنْفُوان المخلس
واعتَنَفْتُ الشيءَ كرهتُه.
عفن: عَفِنَ الشيءُ يَعْفَنُ عَفَناً فهو عَفِنٌ، وهو الشيء الذي فيه نُدُوَّةٌ يُحبس في موضع فيفسد فإذا مَسَسْتَه تفتّت. وعَفِنَ الخُبْزُ أيضاً إذا فسد وعشش.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2) لم نهتد إلى الراجز.
(2/157)
________________________________________
نعف: النَّعْفُ من الأرض: المكانُ المرتفع في اعتراض، ويقال: ناحية من الجبل، وناحية من رأسه. والرّجل ينتعِفُ إذا ارتقى نَعْفاً. قال العجّاج «3» :
والنَّعْفُ بين الأُسْحُمانِ الأطولِ
وقال رؤبة «4» :
بادرْنَ ريح مطر وبَرْقا ... وظلمة الليل نِعافاً بُلْقا
والنَّعْفُ: ذُؤابة النَعل. والنَّعَفَةُ: أَدَمَة تضطربُ خلْف مؤخّر الرّحْل.
نفع: النّفع: ضدّ الضَّرّ. نفعه نَفْعاً، وانتفعت بكذا. والنَّفْعة في جانبَي المزادة، يشقّ الأديمُ فيجعل في كلّ جانبٍ نَفْعة. نُفَيْعٌ: اسم رجل.
فنع: الفَنَعُ: نشرُ المسكِ ونَفْحَتُهُ، ونشرُ الثّناءِ الحسَن. يقال: له «5» فَنَعٌ في الجود، قال «6» :
وفروعٍ سابِغٍ أطرافُها ... عللتها ريح مسك ذي فَنَع
أي: ذي نَشْر. ومال ذو فَنَعٍ، وذو فَنَأٍ «7» ، أي: ذو كَثْرةٍ. والفنع أكثر وأعرف.
__________
(3) ديوانه 140، وفيه (عند) مكان (بين) .
(4) ليس في ديوانه.
(5) سقطت (له) من (ط) و (س) .
(6) (سويد بن أبي كاهل) . كما في التهذيب 3/ 4.
(7) في النسخ الثلاث: فناع، وهو تصحيف.
(2/158)
________________________________________
باب العين والنّون والباء معهما ع ن ب، ع ب ن، ن ع ب، ن ب ع، مستعملات
عنب: رجل عانب: ذو عِنَب كثير، كما يقال: لابن وتامر، أي كثير اللّبن والتّمر، الواحدة: عِنَبَةٌ ويجمع أَعْناباً. والعُنّاب: ثَمَرٌ، والعُنَابُ الجبلُ الصغير الأسودُ. وظبيٌ عَنَبانٌ: نشيط، ولم أسمع للعَنَبانِ فِعلاً. قال «1» :
يشتدّ شدّ العَنَبانِ البارحِ
والعِنَبَةُ: قُرْحة تُعْرفُ بهذا الاسم. والعُنابُ: المطر، ويجمع أَعْنِبة.
عبن: العَبَنُّ [والعَبَنَّى] «2» : الجملُ الشّديدُ الجسيمُ. وناقةٌ عَبَنَّة وعَبَنّاة، ويُجمع: عَبَنَّيات. ورَجُلٌ عَبَنُّ الخلق: أي ضَخْمُه وجَسيمُه. قال حميد بن ثور «3» :
وفيها عَبَنُّ الخَلْقِ مختلف الشَّبا ... يقول المُماري طالَ ما كان مقرما
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2) من التهذيب 3/ 7 من روايته عن الليث.
(3) ديوانه 32 والرواية فيه: (أمين) مكان (وفيها) .
(2/159)
________________________________________
نعب: نَعَبَ الغُرابُ يَنْعَبُ نعيباً ونعَباناً، وهو صوته. وفرسٌ مِنْعَبٌ: جوادٌ. وناقة نعّابة، أي: سريعة.
نبع: نَبَعَ الماءُ نَبْعاً ونُبُوعاً: خرج من العين، ولذلك سمّيت العين يَنْبوعاً. والنّبع: شجرٌ يُتَّخذُ منها القِسيّ. يُنابِعَى: اسم مكان ويجمع: يَنابِعات. قال «4» :
سقَى الرحمنُ حَزْنَ يَنابِعاتٍ ... من الجوزاء أنواء غزارا
__________
(4) لم نهتد إلى القائل.
(2/160)
________________________________________
باب العين والنون والميم معهما ع ن م، ن ع م، م ع ن، م ن ع مستعملات
عنم: العَنَمُ: شجر من شجر السّواك، ليّن الأغصان لطيفها، كأنها بنان جارية. الواحدة: عَنَمة. ويقال: العَنَمُ: شوك الطّلح. والعَنَمةُ: ضَرْبٌ من الوزغ مثل العَظاية إلاّ أنّها أحسن منها وأشدّ بياضاً. قال رؤبة «1» :
يبدين أطرافاً لطافاً عَنَمُهْ
نعم: نَعِمَ يَنْعَمُ نَعْمةً فهو نَعِمٌ ناعمٌ بيّنُ المَنْعَم. قال «2» :
هذا أوانِي وأوانِكنَّهْ ... ليس النّعيم دائماً لكنَّهْ
والنَّعماءُ اسم النَّعمةِ. والنَّعيمُ: الخفضُ والدَّعة. والنِّعْمةُ: اليد الصّالحة، وأنعم الله عليه.
__________
(1) ديوانه 150.
(2) لم نهتد إلى الراجز.
(2/161)
________________________________________
وجارية ناعمةٌ مُنَعَّمةٌ، وأَنْعَمَ الله بك عيناً، ونَعِمَ بك عيناً، أي: أقرّ بك عَيْنَ من تحبّ. وتقول: نُعْمَةُ عينٍ، ونعماء عين، ونُعام عَين. والنّعمة: المسرّة. ونعم الرّجلُ فلانٌ، وإنه لنعما وإنه لنعيم. نَعَمْ: كقولك: بَلَى، إلاّ أنّ نَعَمْ في جواب الواجب. والنُّعَامَى: اسم ريح الجنوب. قال «3» :
مَرَتْهُ الجَنُوبُ فلمْ يعترفْ ... خِلافَ النُّعامَى من الشَّام ريحا
والنَّعامُ الذَّكَرُ وهو الظّليم. والنّعامة: الخشبةُ المُعْتَرِضة على الرّجامين تتعلق عليها البكرة، وهما نعامتان. وزعموا أنّ ابن النَّعامة من الطُّرُقِ كأنّه مركبُ النَّعامة. قال «4» :
ويكون مركبُكِ القَعودُ ورَحْلَهُ ... وابنُ النَّعامَةِ عندَ ذلك مركبي
ويقال: ليس ابنُ النَّعامةِ هاهنا الطريق، ولكنّه صدرُ القَدَم. وهو الطّريقُ أيضاً. ويقال: قد خَفَّتْ نَعامَتُهم، أي: استمرّ بِهِمُ السّيرُ. والنَّعَمُ: الإِبلُ إذا كثرت. وزَعَم المفسّرون أنّ النَّعَمَ الشّاءُ والإبلُ، في قول الله عز وجلّ: وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً «5» . والنَّعائِمُ: من منازِل القَمَر.. والأَنْعَمانِ: واديانِ. وتقول: دَقَقْتُهً دقّاً نِعِمّاً، أي زدته على الدّقّ. وأحْسَنَ وأَنْعَمَ، أي زاد على الإحسان.
__________
(3) (أبو ذؤيب) ديوان الهذليين 132. وفيه (النعامى) مكان (الجنوب) .
(4) (عنترة) ديوانه 33.
(5) الأنعام 142.
(2/162)
________________________________________
يَنْعَمُ: حيّ من اليمن. نَعْمانُ: أرض بالحجاز أو بالعراق. وفلان من عَيْشِهِ في نُعْمٍ. نُعَيْمٌ ونُعمانُ: اسمان.
معن: أمْعَنَ الفرسُ ونحوه إمعاناً، إذا تباعد يعدو. ومَعَنَ يَمْعَنُ مَعْناً أيضا. والماعون يفسر بالزكاة والصّدقة. ويقال: هو أسقاط البيت، نحو الفَأْس، والقِدْر، والدلو.. مَعْنٌ: اسم رجل.
منع: مَنَعْتُه أَمْنَعُه مَنْعاً فامْتَنَعَ، أي: حُلتُ بينه وبين إرادته. ورجل منيع: لا يُخْلَصُ إليه، وهو في عزٍّ ومَنَعَةٍ، ومنعة- يخفّف ويثقّل، وامرأة منيعة: متمنّعة لا تُؤاتى على فاحشة، قد مَنُعَتْ مَناعةً، وكذلك الحصن ونحوه. ومَنُعَ مَناعةً «6» إذا لم يُرَمْ. [ومَناعِ بمعنى امنَعْ] «7» قال «8» :
مَناعِها من إبلٍ مَناعِها
__________
(6) من التهذيب 3/ 19 عن العين.
(7) من المحكم 2/ 146 لتقويم العبارة.
(8) لم يقع لنا الراجز، وهو من شواهد الكتاب 1/ 123.
(2/163)
________________________________________
باب العين والفاء والميم معهما ف ع م يستعمل فقط
فعم: يقال: فَعُمَ فَعامَةً وفُعُومةً، فهو فَعْمٌ، أي: ملآن. قال كعب بن زهير «1» :
فَعْمٌ مُقَلَّدُها عَبْلٌ مُقَيَّدُها ... في خَلْقِها عن بناتِ الفَحْلِ تفضيل
وامرأة فعمة السّاق، فَعُمَتْ فَعَامَةً وفُعُومةً، أي: مستوية الكعب، غليظة السّاق. قال «2» :
فعم [مخلخلها] «3» وعث مؤزرها ... عذب مقبلها طعم السَّدا فوها
وأَفْعَمْتُ البيتَ بريحِ العُود. وافْعَوْعَمَ النّهر والبحر، أي: امتلأ. قال «4» :
مُفْعَوعِمٌ صَخِبُ الآذيّ مُنبعِقُ ... كأن فيه أكف القوم تَصطّفِقُ
يعني النّهر. وأفعمته فهو مُفْعَمٌ. وأفعمَ المِسْكُ البيتَ. وقوله في البيت الأول: طعم السَّدا: السَّدا: البلح.
__________
(1) ديوانه ص 10 والرواية فيه:
ضخم مقلدها نعم مقيدها
(2) المحكم 2/ 147 واللسان (فعم) .
(3) من المحكم 2/ 147 واللسان (فعم) . في النسخ الثلاث: (مقلدها) ولعله سهو.
(4) نسب في اللسان إلى (كعب) وليس في ديوان كعب بن زهير.
(2/164)
________________________________________
باب العين والباء والميم معهما ع ب م يستعمل فقط
عبم: العبام: الرّجل الغليظ الخَلْقُ. في حمق عَبُمَ يَعْبُمُ عَبامَةً [فهو عَبامٌ] «1» . قال «2» :
فأنكرتُ إنكار الكريم ولم أكن ... كفَدْمٍ عَبامٍ سيل نسيا فجمجما
__________
(1) من التهذيب 2/ 21 عن العين.
(2) لم نهتد إلى القائل، ولم نقف على القول في غير الأصول.
(2/165)
________________________________________
باب الثلاثي المعتل
(2/167)
________________________________________
باب العين والهاء و (واي) معهما ع وهـ، هـ وع، هـ ي ع مستعملات
عوه: التّعويه والتّعريس: نومة خفيفة عند وجه الصّبح. عوّهت تَعْويهاً. قال رؤبة «1» :
شأزٍ بمن عَوَّهَ جَدْبِ المنطق ... تبدو لنا أعلامُهُ بعدَ الغَرَقْ
وتقولُ: عَوَّهْتُ بالجَحْشِ تعويهاً إذا دَعَوتَه لِيَلْحَقَ بك. تقول: عَوْهِ عَوْهِ. وعاهِ عاهِ: زجرٌ للإبل [لتحتبس] «2» وربّما قالوا: عَيْهِ عَيْهِ، وقد يقولون: عَهْ عَهْ، وعَهْعَهْتُ بها. وأَعاهَ الزَّرْعُ، وأعاهَ القومُ إذا أصابَ زرْعَهُم خاصّةً عاهةٌ وآفةٌ من اليَرَقان ونحوه فأفْسَدَهُ. قال: «3»
قذف المجنّبِ بالعاهاتِ والسَّقَمِ
وقال بعضُهم: عِيةَ الزَّرْعُ فهو مَعُوهٌ.
__________
(1) ديوانه 104.
(2) من التهذيب 3/ 22 في نقله عن العين.
(3) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى تمام القول.
(2/169)
________________________________________
هوع: هاعَ يَهُوعُ هَوْعاً وهُواعاً إذا جاءه القيء ومن غير تكلّف. قال «4» :
ما هاعَ عمرٌو حين أدْخَلَ حَلْقَهُ ... يا صاحِ ريش حمامة بل قاء
وإذا تكلّف ذلك قيل: تهوَّع، فما خرجَ من حلقِهِ فهو هُواعة. تقول: لأَهوِعَنَّهُ أَكْلَهُ، أي: لأَستخرجنّ من حَلْقِهِ ما أَكَلَ.
هيع: الهاعُ: سوء الحرص. هاعَ يَهاعُ هيعة وهاعاً. وقال بعضهم: هاع يَهِيعُ هُيُوعاً وهَيْعَةً وهَيَعاناً. وقال أبو قيس بن الأسْلَتِ «5» :
الكَيْسُ والقُوّةُ خيرٌ من الإشفاق ... والفَهّةِ والهاع
ورجلٌ هاعٌ، وامرأة هاعة إذا كان جباناً ضعيفاً. والهَيْعَةُ: الحَيْرَة. رجل مُتَهيّعٌ هائع، أي: حائر. وطريق مَهْيَعٌ، مَفْعَلٌ من التّهيُّعِ، وهو الانْبساطُ، ومن قال: فَعْيَل فقد أخْطأ، لأنه ليس في كلام العرب فعيل إلا وصدرُه مكسورٌ نحو: حِذْيَم وعِثْيَر. وبلَدٌ مَهْيَعٌ أيضاً، أي، واسع، قال أبو ذُؤَيب:
فاحْتَثَّهُنَّ من السَّواءِ وماؤه ... بَثْرٌ وعانَدَهُ طريقٌ مهْيَعُ
ويُجْمَعُ مهايع بلا همز.
__________
(4) لم نهتد إلى القائل.
(5) المحكم 2/ 151، واللسان (هيع) .
(2/170)
________________________________________
والسّراب يَتَهَيَّعُ على وجهِ الأرضِ، أي: ينبسِطُ. تهيّع السّرابُ وانْهاع انهياعاً. والهَيْعَةُ: أرضٌ واسعةٌ مبسوطة. والهَيعةُ سَيَلانُ الشيءِ والمصبوبِ على وجهِ الأرضِ، هاعَ يَهِيعُ هيعاً. وماءً هائع. والرّصاص يَهيعُ في المِذْوَبِ.
وفي الحديث: كلّما سمع هيعةً طار إليها «6»
، أي: صوتاً يُفْزَع منه ويُخافُ، وأصله من الجزع.
__________
(6) اللسان (هيع) وتمام الحديث:
خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلّما سمع هيعةً طار إليها.
في (ط) : طاب وهو تصحيف.
(2/171)
________________________________________
باب العين والخاء و (واي) معهما خ وع يستعمل فقط
خوع: الخَوْعُ: جبلٌ أبيض بين الجبال، قال رؤبة «7» :
كما يَلُوحُ الخوع بين الأجبال
__________
(7) نسب البيت في الصحاح واللسان (خدع) إلى (رؤبة) أيضا، وحكى اللسان عن ابن بري أنه (للعجاج) .
(2/172)
________________________________________
باب العين والقاف و (واي) معهما ع وق، وع ق، ع ق و، ق ع و، وق ع، ع ق ي، ع ي ق مستعملات
عوق: عاقه فاعتاقَهُ وعوَّقَهُ في الكثرة والمبالغة يَعوقُهُ عَوْقاً. قال أبو ذؤيب «8» :
ألا هلْ إلى أُمِّ الخويلدِ مُرْسَلٌ ... بلى خالدٌ إن لم تَعُقْهُ العَوائِقُ
والواحدة: عائقة. وقال أميّة بن أبي الصلت:
تَعرِفُ ذاك النّفوس حتّى إذا هَمَّتْ بخيرٍ عاقت عوائقها
ورجل عُوقَةٌ: ذو تعويق وتربيث للنّاس عن الخير، ويجوز عَقاني في معنى عاقني على القلب قال «9» :
لَعاقَك عن دُعاءِ الذّئبِ عاقي
والعوق الذي لا خير فيه وعنده. قال رؤبة «10» :
__________
(8) ديوان الهذليين 151، والرواية فيه:
ألا هل أتى أم الحويرث ...
(9) اللسان (عوق) غير منسوب أيضا، وصدره:
فلو أني رميتك من قريب
(10) ديوانه 173.
(2/173)
________________________________________
فَداكَ منهم كلُّ عَوْقٍ أصلدِ
والعَوَقَةُ: حيّ من اليمن. قال «11» :
إنّي امرؤ حنظليّ في أرومتها ... لا من عَتِيك ولا أخواليَ العَوَقَه
ويعوق: اسم صنم كان يعبد زمن نوح عليه السلام. وعُوقٌ والدُعُوجٍ. وعوق: موضع بالحجاز. قال «12» :
فعوق فرماح فاللوى ... من أهلِهِ قَفْرُ
ويقال: كان يعوق رجلاً من صالحي أهلِ زمانِهِ قبلَ نوحٍ. فلما مات جزع عليه قومُه فأتاهم الشيطان في صورة إنسان فقال: أمثله لكم في مِحْرابِكم حتى تروه كلّما صلّيتم. ففعلوا ذلك. وشيّعه من بعده من صالحيهم، ثم تمادى بهم الأمْرُ إلى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناماً يعبدونها من دون الله. وأمّا عيّق فمن أصواتِ الزّجر. عيّق يُعَيّق في صوته.
وعق: رجلٌ وعقة لعقة، أي: سيىء الخُلُق. ورجلٌ وَعِقٌ: فيه حِرْصٌ، ووُقوعٌ في الأمر بجهلٍ. تقول: إنه لَوَعِقٌ لَعِقٌ. قال رؤبة «13» :
مخافة الله وأَنْ يُوَعَّقا
أي: أن يقال: إنّك لَوَعِقٌ، وبه وعقة شديدة.
__________
(11) اللسان (عوق) وغير منسوب، ونسبه (التاج- عرق) إلى (المغيرة بن حيفاء) . ولعله (ابن حبناء) .
(12) اللسان (عوق) غير منسوب أيضا.
(13) ليس في ديوانه.
(2/174)
________________________________________
والوَعيقُ: صوت يخرُجُ من حياء الدّابّة إذا مَشَتْ. وَعَقَتْ تَعِقُ، وهو بمنزلة الخَقِيقِ من قُنْب الذّكر. يقال: عُواق ووُعاق، وهو العَويقُ والوَعيقُ. قال «14» :
إذا ما الرّكبُ حلَّ بدارِ قومٍ ... سمعتَ لها إذا هَدَرَتْ عواقا
عقو: العَقْوَةُ: ما حولُ الدّارِ والمَحَلَّة. تقول: ما بعَقْوَةِ هذه الدّار أحدٌ مثل فلان، وتقولُ للأسَد ما يطور بعقوته أحد. والرّجلُ يحفر البئر فإذا لم ينبط من قعرها اعتقى يَمْنَةً ويَسْرةً، وكذلك إذا اشتقّ الإنسان في الكلام فيعتقي منه. والعاقي كذلك، وقلّما يقولون: عقا يعقو. قال «15» :
ولقد دربت بالاعتقاء ... والاعتقام فنلت نجحا
يقول: إذا لم يأته الأمر سهلاً عقم فيه وعقا حتّى ينجح.
قعو: القَعْو: شبه البَكْرة، وهو الدّموك يستقي عليها الطيّانون. قال «16» :
له صريفٌ صريفَ القَعْوِ بالمَسَدِ
ويقال: القَعْو: خشبتان تكونان كنّا في البكرة تضمّانه يكون فيهما المِحْوَر.
__________
(14) اللسان والتاج (عوق) غير منسوب فيهما أيضا.
(15) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(16) (النابغة الذبياني) ديوانه ص 6، وصدر البيت:
مقذومة بدخيس النحض بازلها
(2/175)
________________________________________
والقَعا: رَدَّةٌ في رأسِ أَنْفِ البَعير، وهو أن تُشْرِفَ الأَرْنَبَة، ثم تقعي نحو القصبة. قِعيَ الرّجل قَعاً، وأَقْعَتْ أرنبتُه، وأَقْعَى أنفُه. ورجل أَقْعى وامرأةٌ قَعْواء وقد يقعي الرّجل في جلوسه كأنّه مُتَساندٌ إلى ظهْرِه. والذّئب يُقعي، والكلب يقعي. إقعاء مثله سواء، لأنّ الكلبَ يُقْعي على اسْتِه. والقَعْو: إرسالُ الفحل نفسَهُ على النّاقةِ في ضِرابِها. قَعا عليها يَقْعُو قُعُوّاً إذا أناخها ثم علاها.
وقع: الوَقْعُ: وَقْعَةُ الضَّرب بالشّيء. ووَقْعُ المطرِ، ووَقْعُ حوافِرِ الدّابَّةِ، يعني: ما يُسْمَعُ من وَقعِه. ويقال للطّير إذا كان على أرضٍ أو شجرٍ: هنّ وقوعٌ ووُقَّعٌ. قال الرّاعي:
كأنّ على أثباجها حين شوّلَتْ ... بأَذْنابِها قبّا من الطّيْر وُقَّعا
والواحد: واقعٌ. والنَّسْرُ الواقع سُمّي به كأنه كاسرٌ جناحيه من خلفه، وهو من نجوم العلامات التي يُهْتَدَى بها، قريب من بنات نَعش، بحيالِ النَّسْرِ الطّائر. والمِيقعةُ: المكانُ الذي يقَعُ عليه الطّائر. ويقال: وقعت الدّوابُّ والإبل، أي: ربضَتْ تشبيهاً بوقوع الطّير. قال «17» :
وَقَعْنَ وقوعَ الطّير فيها وما بها ... سوى جرّة يرجعنها متعلل
وقد وقَّعَ الدّهرُ بالنّاس، والواقِعةُ: النازلةُ الشَّديدةُ من صُروفِ الدّهْر، وفلانٌ وُقَعَةٌ في الناس، ووقّاعٌ فيهم [أي يغتابهم] «18» . ووَقَعَ الشيءُ يَقَعُ وقوعا، أي: هويا.
__________
(17) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(18) زيادة لتوضيح المراد.
(2/176)
________________________________________
وواقعنا العدوّ، والاسم: الوقيعة. والوِقاعُ: المواقعة في الحرب. ووَقَعَ فلان في فلان، وقد أظهر الوقيعة فيه [إذا عابه] «19» . والوَقيعُ من مناقع الماء في متون الصخور. ووقائع العرب: أيّامُها التي كانت فيها حروبُهُمْ. والتَّوقيعُ في الكتاب: إلحاقُ شيءٍ فيه. وتوقّعتُ الأمرَ، أي: انتظرتُه. والتوقيع: رَمْيٌ قريبٌ لا تُباعِدُهُ كأنّك تُريدُ أن تُوقِعَهُ على شيء، وكذلك توقيع الإزكان، تقول: وَقِّعْ أي: ألقِ ظنّك على كذا. والتّوقيعُ: سَحْجٌ بأطرافِ عِظام الدّابّة من الرّكوب وربّما تحاصّ عنه الشَّعَرُ. قال الكميت «20» :
إذا هما ارتدفا نَصّا قعودهما ... إلى التي غبها التَّوْقيعُ والخَزَلُ
يقالُ: دابّة مُوَقَّعة. والتّوقيع: أثَرُ الرّحل على ظهر البعير. يقال: بعيرٌ موقّع، قال «21» :
ولم يُوَقَّعْ برُكوبٍ حَجَبُهْ
وإذا أصابَ الأرضَ مطرٌ مُتَفَرِّقٌ فذلك توقيع في نباتها. والتّوقيعُ: إقبال الصَّيْقَل على السيف يحدّده بميقعته، وربما وُقِّعَ بحَجَرٍ. وحافِرٌ وَقيعٌ: مقطّط السّنابك. والوقيعُ من السُّيوف وغيرها: ما شُحِذ بالجحر، قال يصف حافر الحمار «22» :
يركب قيناه وقيعا ناعلا
__________
(19) زيادة من نقول الأزهري عن العين 3/ 35 من التهذيب.
(20) ليس في مجموع شعر الكميت.
(21) التهذيب 3/ 35، اللسان (وقع) .
(22) (رؤبة) ديوانه 135.
(2/177)
________________________________________
وقال الشّماخ يصف إبلاً حدادَ الأسْنانِ «23» :
يغادين العِضاه بمقنعات ... نواجذهن كالحدأ الوقيع
وقد وَقِعَ الرّجل يَوْقَعُ وَقعاً. إذا اشتكى قدميه من المشي على الحجارة. قال «24» :
كلَّ الحِذاءِ يَحْتَذي الحافي الوَقِعْ
ووقَّعَتْهُ الحجارةُ توقيعاً، كما توقّع الحديدةُ تُشْحَذُ وتُسَنُّ. واستوقَع السَّيفُ: إذا أنَى له الشَّحْذُ. والميقَعَةُ: خَشَبَةُ القصّارين يُدَقُّ عليها الثياب بعد غسلها «25» . والتوقيع: أثر الدم والسحج. والتّوقيعُ بالظن شبه الحزر والتّوهُّم. والمَوْقِعُ: موضِعٌ لكلّ واقع، وجمعُه: مَواقِعُ. قال «26» :
أنا شُرَيْقٌ وأبو البلادِ ... في أبلٍ مصنوعة تلادِ
تربّعتْ مَواقِعَ العِهادِ
عقي: عقّيتم صبيّكم، أي: سقيتموه عَسَلاً، أو دواءً ليَسْقُطَ عنه عِقْيُهُ، وهو ما يخرج من بطن الصبيّ حين يولد، أسودُ لزجٌ كالغِراء. يقال: عقَى يَعْقي عَقْياً. والعِقْيانُ ذَهَبٌ ينبُتُ نَباتاً وليس مما يُذابُ من الحجارة. قال «27» :
كلّ قوم صيغه من آنك ... وبنو العبّاسِ عقيان الذّهب
__________
(23) اللسان (وقع) والرواية فيه: يباكرن.
(24) (جساس بن قطيب) ، اللسان (وقع) .
(25) في النسخ الثلاث: غسله.
(26) لم نقف على الرجز في غير الأصول.
(27) لم نقف عليه في غير الأصول.
(2/178)
________________________________________
ويقال: عَقَّى بسهمه تعقيةً إذا رمى به بعد ما يستبعد العدوّ
. عيق: العيّوق: كوكبٌ بحيال الثّريّا إذا طلع عُلِمَ أنّ الثّريّا قد طلعت. قال «28» :
تراعى الثّريّا وعيّوقها ... ونجم الذّراعين والمرزم
وعَيُّوقٌ: فَيْعول، يحتمل أن يكون من (عيق) ومن (عوق) ، لأنّ الواو والياء فيه سواء.
__________
(28) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(2/179)
________________________________________
باب العين والكاف و (واي) معهما ع ك و، وع ك، ك وع، وك ع مستعملات
عكو: عَكَوْتُ ذَنَب الدّابّةِ عَكْواً إذا عطفت الذَّنَب عند العُكوة، وعَقَدْتُهُ. والعُكْوَة: أصْلُ الذَّنَبِ، حيث عَرِيَ من الشَّعَر، ويقال: هو ما فضل عن الوَرِكَيْنْ من أصلِ الذَّنَبِ قدر قبضة. بِرْذَوْنٌ مَعْكُوٌّ، أي: معقودُ الذَّنَب. وجمعُ العُكْوَةِ: عُكىً. قال «1» :
هَلَكْتَ إن شَرِبْتَ في إكْبابِها ... حتّى تُوَلّيكَ عُكَى أذنابِها
وشاة عكواء إذا ابيضّ ذَنَبُها وسائِرُها أسود، ولو استعمل فعل [لهذا] «2» لقيل: عَكِيَ يَعكَى «3» فهو أَعْكَى، ولم أسمعْ له ذلك.
وعك «4» : الوَعْكُ: مَغْثُ المَرْض. وعكته الحُمّى، أي دكّته «5» وهي تَعِكُهُ. قال «6» :
__________
(1) اللسان (عكا) .
(2) زيادة اقتضاها السياق.
(3) من التهذيب في روايته عن الليث 3/ 39. في (ص) عكي عكى. وفي (ط) و (س) : عكا عكا.
(4) هذا من (س) فقد سقط كله من (ص) و (ط) .
(5) من التهذيب في حكايته عن الليث 3/ 43 في (س) دلكته. وهي محرفة عن دكته.
(6) لم نهتد إلى القائل.
(2/180)
________________________________________
كأنّ به تَوْسيمَ حُمّى تصيبه ... طروقاً وأعباط من الورد واعك
ورجلٌ موعوك: محموم. وأوعكَتِ الكلابُ الصَّيدَ، أي: مرّغته. قال رؤبة في الكلاب والثّور «7» :
عوابس في وَعْكَةٍ تحت الوَعِكْ
أي: تحت واعكتها، أي: صوتها. والوَعْكَةُ: معركة الأبطال إذا أخذ بعضُهم بعضاً، وأَوْعَكَتِ الإبل إذا ازدحمت فركب بعضُها بعضاً عند الحوض، وهي الوَعْكَةُ. قال «8» :
نحن جلبنا الخيل من مرادها ... من جانب السّقيا إلى نضادها
فصبّحت كلباً على أحدادها ... وَعْكَة وردٍ ليس من أورادها
أي: لم يكن لها بورد، وكان وردها غير ذلك.
كوع: «9» : الكوع والكاع، زعم أبو الدّقَيْش أنهما طرفا الزندين في الذّراع ممّا يلي الرُّسغ. والكوع منهما طرف الزند الذي يلي الإبهام وهو أخفاهما، والكاعُ طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الكرسوع.
__________
(7) ما في ديوان رؤبة هو قوله: ولم تزل في وعكة اليوم الوعك.
(8) لم نقع على الراجز. ولا على الرجز. وأثبتناه كما جاء في (س) .
(9) وهذا أيضا سقط من (ص) و (ط) وما أثبتناه فمن (س) .
(2/181)
________________________________________
ورجلٌ أكوعُ وامرأة كوْعاء، أي: عظيم الكاع. قال «10» : دواحسٌ في رُسْغِ عَيْرٍ أكوعا ويقال: الكوعُ يَبسٌ في الرُّسغَيْن، وإقبال إحدى اليدين على الأخرى. بعيرٌ أكوع، وناقة كَوْعاء. كاعَ يكُوعُ كَوْعاً، وتصغير الكاع: كُوَيْع، وأكْوَعُ اسم رجل.
وكع: الوَكْع: ضربة العقرب بإِبرتها. قال «11» :
كأنّما يرى بصريح النصح وكع العقارب
والأوكع: المائل. والوَكَعُ: ميلانُ صدرِ القدم نحو الخِنْصِر، ورُبّما كان في إبهام اليد والرّجل، والنّعت: أوكع، ووَكْعاء، وأكثره في الإماء اللّواتي يكددْنَ بالعمل. ويقال: الأوكع والوكعاء: للأحمق [والحمقاء] «12» . وفرسٌ وَكِيعٌ. وَكُعَ يَوْكُعُ وَكَاعَةً، أي: صَلُبَ واشتدّ إهابُه. قال سليمان بن يزيد «13» :
عَبْلٌ وكيع ضليع مقرب أرن ... للمقربات أمام الخيل مفترق
وسقاء وَكِيعٌ: صُلْبٌ غليظٌ، وفَرْوٌ وكيعٌ: متينٌ. ومَزادةٌ وَكِيعةٌ: قُوِّرَتْ فأُلْقي ما ضَعُفَ من الأديم وبقي الجيّد فَخَرِزَ، والجميع: وكائع. واستوكع السّقاءُ متن واشتدت مخارزه بعد ما جعل فيه الماء «14» .
__________
(10) التهذيب 3/ 42 واللسان (كوع) غير منسوب أيضا.
(11) (القطامي) ديوانه ص 47 إلا أن الرواية فيه:
سرى في جليد الليل حتى كأنما ... تخزم بالأطراف شوك العقارب
(12) من التهذيب 3/ 42 فقد سقطت من النسخ الثلاث.
(13) التاج (وكع) - (سليمان بن يزيد العَدَويّ) .
(14) ما بين القوسين من (س) وقد سقط كله من (ص) و (ط) .
(2/182)
________________________________________
باب العين والجيم و (واي) معهما ع ج و، ع وج، ج وع، وج ع، ع ي ج مستعملات
عجو: العجوة: تمرٌ بالمدينة، يقال: [إنّه] غرسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمّ تعجو وَلَدَها، أي: تؤخّر رضاعه عن مَواقيته، ويُورِثُ ذلك وَهَناً في جسمِه.. ومنه: المعاجاة، وهو ألا يكون للأمّ لبنٌ يُرْوِي صبيّها فتعاجيه بشيء تعلّله به ساعة. قال الأعشى «1» :
مشغقا قلبها عليه فما تعجوه ... إلاّ عُفافةٌ وفُواقُ
وكذلك إن ربّى الولدَ غيرُ أمّه. والاسم: العُجْوةُ، والفِعل: العَجْو، واسم الولد: عَجيٌّ، والأنثى عَجيّة والجميع: العُجايا. قال يصف أولاد الجراد «2» :
إذا ارتحلت عن منزلٍ خلّفتْ به ... عُجايا يحاثى بالتراب دفينها
__________
(1) ديوانه 221، وصدر البيت فيه:
ما تعادى عنه النهار ولا تعجوه............... .......
(2) التهذيب 3/ 45.
(2/183)
________________________________________
ويروى: صغيرها. وإذا منع اللبن عن الرضيع، واغتذى بالطعام قيل: قد عُوجيَ. قال الإصبع «3» :
إذا شئتَ أبصرتَ من عَقْبِهِمْ ... يتامَى يُعاجَوْنَ كالأَذْؤُبِ
والعُجاية: عَصَبٌ مركّبٌ فيه فُصوص من عظام كأمثال فُصوص الخاتم عند رُسْغ الدّابّة، إذا جاع أحدهم دقّه بين فهرَيْن فأكله، ويُجمع: عُجايات وعُجىً. قال «4» :
شمّ العُجاياتِ يَتركْنَ الحصى زِيَماً
يصف أخفافها بالصّلابة، وعُجاياتها بالشّمم، وأشدّ ما يكون للدّابّة إذا كان أشمّ العُجاية.
عوج: عَوْجُ كلّ شيء: تعطّفه، من قضيب وغير ذلك. وتقول: عُجْتُه أَعُوجُهُ عَوْجاً فانعاج، قال «5» :
وانعاجَ عُودي كالشَّظيفِ الأَخْشنِ
والعِوَجُ الاسم اللازم منه الذي تراه العيون من خشب ونحوه، والمصدر من عَوِجَ يَعْوَجُ: العَوَجُ فهو أَعْوَجُ، والأنثى: عَوْجاء، وجمعه: عُوجٌ. قال أبو عبد الله: يقال من العِوَج: عَوِج يَعْوَجُ عَوَجاً، ومن العَوْج: اعوجّ اعوجاجاً [فهو مُعْوَجٌّ] وعوّجَ الشيءَ فهو مُعَوَّجٌ.
__________
(3) التهذيب 3/ 45 غير منسوب، ونسبه اللسان إلى (النابغة الجعدي) وقال: وأنشد الليث (للنابغة الجعدي) وذكر البيت.
(4) (كعب بن زهير) ديوانه 14 وعجز البيت:
لم يقهن رءوس الأكم تنعيل
(5) (رؤبة) ديوانه 161.
(2/184)
________________________________________
والخيولُ الأعوجيّةُ منسوبة إلى فرس كان في الجاهلية سابقاً، ويقال: كان لغنيّ. قال طفيل «6» :
بناتُ الوَجيهِ والغُرابِ ولاحقٍ ... وأَعْوجَ تَنْمي نِسْبةَ المتنسِّبِ
ويقال: أعوجيّ من بنات أعوج. والعوج: القوائم من الخيل التي في أرجلها تحنيب. والعائج الواقف. والعاج: أنياب الفِيَلَة، لا يُسمّى غير النّاب عاجاً. وناقة عاج إذا كانت مذعان السّير، ليّنة الانعطاف. قال ذو الرّمة:
تقدُّ بيَ المَوْماةَ عاجٌ كأنّها
وإذا عجعجت بالناقةِ قلت: عاجِ عاجِ خفض بغير تنوين. وإن شئت جزمت على توهُّم الوقْف. وعجعجتُها: أنختها. وعُوج بنُ عُوقٍ، يقال: إنّه صاحبُ الصَّخرةِ، الذي قتله موسى عليه السّلام، ويقال: إنّه إذا قام كان السّحابُ له مئزراً، وكان من فراعنةِ مِصْر.
جوع: «7» الجوع: اسم جامعٌ للمخمصة. والفعل: جاع يجوع جوعاً. والنعت: جائع، وجَوْعان، والمجاعة: عامٌ فيه جوعٌ [ويقال: أجعته وجوّعته فجاع يجوع جوعاً] «8» فالمتعدي: الإجاعة والتجويع. قال «9» :
يُدْعَى الجُنَيْدَ وهو فينا الزُّمَّلِقْ ... مُجَوَّعُ البطنِ كلابيُّ الخلق
__________
(6) اللسان (وجه) .
(7) سقطت هذه المادة وترجمتها من (ص) و (ط) .
(8) زيادة مكملة من التهذيب في روايته عن العين.
(9) التهذيب 3/ 50. وفيه: كان الجنيد..
(2/185)
________________________________________
وجع: [الوَجَعُ: اسم جامع لكل مرض مؤلم. يقال:] «10» رجل وجِعٌ وقومٌ وجاعَى، ونسوة وَجَاعَى، وقوم وَجِعَونَ. وقد وَجِعَ فلانٌ رأسه أو بطنه، وفلانٌ يَوْجَعُ رأسه. وفيه ثلاث لغات: يَوْجَعُ، ويَيْجَعُ، وياجَعُ، ومنهم من يكسر الياء فيقول: يِيجَعُ وكذلك تقول: أنا إيجَعُ، وأنت تِيجَعُ «11» . والوجعاء: اسم الدّبر. ولغة قبيحة، منهم من يقول: وجع يجع. وتوجّعت لفلان إذا رثيتَ له من مكروه نزل به. ويقال: أوجعت فلاناً ضرباً، وضربته ضرباً وجيعاً، ويُوجِعُني رأسي.
عيج: العَيْجُ: شبهُ الاكتراث للشيء والإقبال عليه. تقول: عِجْتُ به يعيج عَيْجاً، ولو قيل: عيجوجة لكان صواباً، وما عِجْتُ بقوله: لم أَكْتَرِثْ. قال «12» :
فما رأيت لها شيئا أعيج به
__________
(10) ما بين المعقوفتين من التهذيب في روايته عن الليث.
(11) ما بين القوسين من (س) فقد سقط من (ص) و (ط) أيضا.
(12) التهذيب 3/ 52، واللسان (عيج) ، غير منسوب فيهما أيضا. وعجز البيت فيهما:
إلا الثمام وإلا موقد النار
(2/186)
________________________________________
باب العين والشين و (واي) معهما ع ش و، ع ش ي، ع ي ش، ش ع و، ش وع، ش ي ع، وش ع مستعملات
عشو، عشي: العشو: إتيانك ناراً ترجو عندها خيراً وهدىً. عَشَوْتُها أَعْشُوها عَشْواً وعُشُوّا. قال الحطيئة «1» :
متى تأتِهِ تعشو إلى ضَوْءِ نارِه ... تَجِدْ خَيْرَ نارٍ عندها خيرُ مُوقِدِ
والعاشيةُ: كلُّ شيءٍ يعشو إلى ضوء نارٍ بالليل كالفَراشِ وغيره، وكذلك الإبل العواشي، قال «2» :
وعاشيةٍ حوشٍ بطانٍ ذَعَرْتُها ... بضربِ قتيلٍ وَسْطَها يَتَسَيَّفُ
وأوطأته عَشْوَة وعِشْوَةُ وعُشْوَةً- ثلاث لغات، وذلك في معنى أن تحملَه على أن يركب أمراً على غير بيانٍ. تقول: ركب فلانٌ عشوة من الأمر، وأوطأني فلان عَشْوةً، أي: حملني على أمرٍ غير رشيدٍ، ولقيته في عَشْوةِ العَتَمَة وعَشْوةِ السَّحَر. وأصله من عشواء اللّيل، والعشواء بمنزلة الظّلماء، وعَشْواء الليل ظلمته «3» .
__________
(1) ديوانه ص 249.
(2) البيت في اللسان (عشو) غير منسوب أيضا.
(3) هذه الفقرة مضطربة في النسخ الثلاث، فقومناها من نقول الأزهري عن العين.
(2/187)
________________________________________
والعِشاءُ: أوّلُ ظلام اللّيلِ، وعشّيتُ الإبل فتعشّت إذا رعيتُها اللّيلِ كلَّه. وقولهم: عش ولا تغتر، أي: عش إبلك هاهنا، ولا تطلب أفضل منه فلعلّك تغترّ. ويقال: العواشي: الإبل والغنم تُرعَى باللّيل. العشيّ، آخر النّهار، فإذا قلت: عَشِيّة فهي ليومٍ واحد، تقول: لقيتُه عشيّةَ يوم كذا، وعشيّةً من العَشِيّاتِ، وإذا صغّروا العشيّ قالوا: عُشَيشِيان، وذلك عند الشَّفَى وهو آخر ساعة من النّهار عند مُغَيْرِبان الشّمس. ويجوز في تصغير عَشيّة: عُشَيَّة، وعُشَيشِيَة. والعَشاءُ ممدود مهموز: الأكلُ في وقت العشيّ. والعِشاءُ عند العامّة بعد غروب الشّمس من لدُنْ ذلك إلى أن يولّي صدر اللّيل، وبعض يقول: إلى طلوع الفجر، ويحتجّ بما ألغز الشّاعرُ فيه:
غدونا غدوة سحرا بليل ... عشاء بعد ما انتصف النهار.
والعَشَى- مقصوراً- مصدر الأعشَى، والمرأة عَشْواءُ، ورجال عُشْوٌ، [والأعشى] هو الذي لا يبصر باللّيل وهو بالنّهار بصير، وقد يكون الذي ساء بَصَرُه من غير عمىً، وهو عَرَض حادثٌ ربّما ذهب. وتقول: هما يَعْشَيانِ، وهم يَعْشَوْن، والنّساء يَعْشَيْنَ، والقياس الواو، وتعاشَى تعاشياً مثله، لأنّ كلّ واوٍ من الفعل إذا طالت الكلمة فإنّها تقلب ياءً. وناقةٌ عَشْواءُ لا تُبصِرُ ما أمامَها فَتَخْبِطُ كلَّ شيءٍ بيدها، أو تقعُ في بئرٍ أو وهْدةٍ، لأنّها لا تَتَعاهدُ موضعَ أخْفافِها. قال زهير:
رأيتُ المنايا خبطَ عشواءَ من تُصِبْ ... تمته ومن تخطىء يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ
وتقول: إنّهم لفي عَشْواء من أمرهم، أو في عمياء.
(2/188)
________________________________________
وتعاشَى الرّجلُ في الأمر، أي: تجاهل. قال «4» :
تَعُدُ التّعاشِيَ في دينها ... هدىً لا تقبّل قُربانها
عيش: العيشُ: الحياةُ. والمعيشة: الّتي يعيش بها الإنسان من المطعم والمشرب، والعِيشة: ضربٌ من العيش، مثل: الجِلْسة، والمِشْية، وكلّ شيء يعاشُ به أو فيه فهو معاش، النّهار معاش، والأرض معاش للخلق يلتمسون فيها معايشهم. والعِيش في الشعر بطرح الهاء: العيشة. قال «5» :
إذا أمّ عِيشٍ ما تَحُلُّ إزارَها ... من الكَيْس فيها سورة وهي قاعد
بنو عيش: قبيلة، وإنّهم بنو عائشة، كما قال «6» :
عبد بني عائشة الهلابعا
وقال آخر «7» :
يا أمّنا عائش لا تراعي ... كلّ بنيك بطل شجاعِ
خَفَضَ العَيْنَ بشُفعةِ الكافِ المكسورة.
__________
(4) لم نهتد إليه.
(5) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(6) التهذيب 3/ 60 واللسان (عيش) .
(7) لم يستشهد به فيما بين أيدينا من مصادر.
(2/189)
________________________________________
شعو: الشَّعْواءُ: الغارة الفاشية. وأشعى القومُ الغارة إشعاءً، أي: أشعلوها. قال «8» :
كيف نَوْمي على الفراش ولمّا ... تشملِ الشّامَ غارةٌ شَعْواءُ
شيع وشوع: الشُّوعُ: شجرُ البانِ، الواحدة: شُوعةٌ. قال الطّرمّاح «9» :
جَنَى ثَمَرٍ بالواديين وشُوعُ
فمن قال بفتح الواو وضمّ الشين: فالواو نسق، وشُوع: شجر البان، ومن قال: وشوع بضمهما، أراد: جماعةَ وَشْعٍ «10» ، وهو زهر البقول. والشَّيْعُ: مقدارٌ من العَدَد. أقمت شهراً أو شيْعَ شهرٍ، ومعه ألفُ رجلٍ، أو شَيْعُ ذاك. والشَّيْعُ من أولاد الأسد. وشاعَ الشّيءُ يَشِيعُ مَشاعاً وشَيْعُوعَةً فهو شائعٌ، إذا ظهر وأشعْتُهُ وشعْتُ به: أذعته. وفي لغة: أشعت به. ورجلٌ مِشْياعٌ مِذْياعٌ، وهو الذي لا يكْتُمُ شيئاً. والمُشايَعةُ: متابعتُك إنساناً على أمرٍ. وشَيَّعتُ النارَ في الحَطَبِ: أضرمتُه إضراماً شديداً، قال رؤبة «11» :
شدّا كما يشيّع التَّضْرِيمُ
__________
(8) لم نهتد إلى القائل، ولم نقف على القول في غير الأصول.
(9) ديوانه 295، وصدر البيت:
وما جلس أفكار أطاع لسرحها.
(10) في (س) : وشيع، وليس صوابا.
(11) اللسان (شيع) وهو غير منسوب.
(2/190)
________________________________________
والشّياعُ: صوتُ قَصَبةِ الرّاعي. قال «12» :
حَنِين النّيبِ تَطْرَبُ للشِّياعِ
وشيَّع الرّاعي في الشِّياعِ: نَفَخَ في القَصَبة. ورجل مُشَيَّعُ القَلبِ إذا كان شجاعاً، قد شُيّع قلبه تشييعاً إذا ركب كلَّ هولٍ، قال سليمان: «13»
مُشَيَّع القلبِ ما منْ شأنِهِ الفَرَقُ
وقال الرّاجز «14» :
والخزرجيُّ قلبُه مُشَيَّعُ ... ليس من الأمر الجليل يَفْزَعُ
والشِّيعةُ: قوم يتشيّعون، أي: يهوون أهواء قوم ويتابعونهم. وشيعةُ الرّجلِ: أصحابه وأتباعه. وكلّ قومٍ اجتمعوا على أمرٍ فهم شيعة وأصنافهم: شِيَع. قال الله [تعالى] : كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ
«15» . أي: بأمثالِهِمْ من الشِّيَعِ الماضية. وشَيَّعْتَ فلاناً إذا خرجت معَه لتُودِّعَه وتُبْلِغَه منزِلَهُ. والشِّياعُ: دعاءُ الإبل إذا استأخرت. قال «16» :
وألاّ تخلدَ الإبل الصّفايا ... ولا طول الإهابة والشِّياعِ
__________
(12) اللسان (شيع غير منسوب أيضا، ونسبه التاج إلى (قيس بن ذريح،) وصدره:
إذا ما تذكرين يحن قلبي
(13) لم نهتد إلى البيت، ولعل سليمان هذا هو سليمان بن يزيد العَدَويّ.
(14) لم نهتد إلى الراجز.
(15) سبأ 54.
(16) لم نقف على القائل.
(2/191)
________________________________________
وشع: الوَشِيعَةُ: خَشَبَة يُلَفُّ عليها الغَزْلُ من ألوان الوَشْي، فكلُّ لفيفةٍ وَشِيعةٌ، ومن هنالك سُمِّيتْ قَصَبَةُ الحائكِ وَشِيعَة، لأنّ الغَزْلَ يُوَشَّعُ فيه. قال ذو الرّمة «17» :
به مَلْعَبٌ من مُعْصِفاتٍ نَسَجْنَهُ ... كنَسْجِ اليَمانِي بُرْدَهُ بالوَشائِعِ
وقال «18» :
نَدْفَ القِياس القُطُنَ المُوَشَّعا
والوَشْعُ من زهر البقول: ما اجتمع على أطرافها، فهي وَشْعٌ ووُشُوع. وأَوْشَعَتِ البُقولُ خرجت زهرتها قبل أن تتفرق.
__________
(17) ديوانه 2/ 778.
(18) ديوانه 90.
(2/192)
________________________________________
باب العين والضاد و (واي) معهما ع ض و، ع وض، ض وع، ض ي ع، ض ع و، وض ع
عضو: العُضْوُ والعِضْوُ- لغتان- كلّ عظم وافر من الجسد بلحمه. والعِضة: القطعة من الشيء، عضّيت الشيء عِضةً عِضةً إذا وزّعته بكذا، قال «1» :
وليس دين الله بالمُعَضَّى
وقوله تعالى: جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ
«2» ، أي: عضةً عضةً تفرقوا فيه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
عوض: العِوَضُ معروف، يقال: عِضْتُه عِياضاً وعَوْضاً، والاسم: العِوَضُ، والمستعملُ التَّعويضُ عوّضتُه من هِبَته خيراً. واستعاضني: سألني العِوَضَ. عاوَضْتُ فلاناً بعَوَضٍ في البيع والأخذ فاعتَضْته مما أعطيته. عِياض: اسم رجل. وتقول: هذا عِياضٌ لك، أي: عِوَضٌ لك. عَوْضُ: يجري مجرى القَسَم، وبعض النّاس يقول: هو الدّهر والزّمان، يقول الرّجلُ لصاحبه: عَوْضُ لا يكون ذاك أبداً، فلو كان اسماً للزّمان
__________
(1) (رؤبة) ديوانه ص 81.
(2) الحجر 91.
(2/193)
________________________________________
إذا لجرى بالتنوين، ولكنه حرفٌ يُرادُ به قَسَم، كما أنّ أجَلْ ونَحْوَها مما لم يتمكّن في التّصريف حُمِلَ على غير الإعراب. قال الأعشى:
رضيعَيْ لِبانٍ ثديَ أم تحالفا ... بأسحمَ داجٍ عَوْضَ لا تَتَفَرَّقُ
وتقول العرب: لا أفعل ذاك عَوْضُ، أي: لا أفعله الدّهر، ونصب عوض، لأنّ الواو حفزت الضّاد، لاجتماع السّاكنين.
ضوع، ضيع: ضاعَتِ الريحُ ضوعاً: نَفَحَتْ. قال «4» :
إذا التَفَتَتْ نحوي تضوّع ريحُها
ويقال: ضاعَ يَضُوعُ، وهو التَّضوُّر، في البكاء في شِدَّةٍ ورفعِ صوتٍ. تقول: ضَرَبَهُ حتّى تَضَوَّعَ، وتضوّر. وبكاءُ الصّبيّ تضوُّعٌ أكْثَرَهُ، قال «5» :
يَعِزُّ عليها رقبتي ويسوؤها ... بكاه فتثني الجيدَ أن يتضوّعا
وأضاعَ الرّجلُ إذا صارت له ضَيْعَةٌ يشتغِلُ بها، وهو بِمَضِيعَةٍ وبمَضيع إذا كان ضائعاً وأضاع إذا ضيّع. والضُّوَعُ: طائر من طير اللّيل من جنسِ الهامِ إذا أَحَسَّ بالصّباح صَدَحَ «6» . وضَيْعةُ الرّجلِ: حِرْفَتُه، تقول: ما ضَيْعَتُك؟ أي: ما حِرْفَتُك؟ وإذا أخذ الرّجلُ في أمور لا تَعنيه تقول: فَشَتْ عليك الضَّيعة، أي: انتشرتْ
__________
(4) (امرؤ القيس) ديوانه ص 15 وعجز البيت:
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل
(5) (امرؤ القيس) ديوانه ص 241 وفيه (ريبتي) مكان (رقبتي) .
(6) من التهذيب 3/ 7 في نقله عن العين. في الأصول: صرخ ولعله تصحيف.
(2/194)
________________________________________
حتّى لا تدري بأيّ أمرٍ تأخذ. وضاعَ عيالُ فلانٍ ضَيْعَةً وضِياعاً، وتركهم بمَضْيَعَةٍ، وبمَضِيعَةٍ وأضاعَ الرّجلُ عياله وضيعهم إضاعة ونضييعا، فهو مُضِيعٌ، ومُضَيِّع
ضعو: الضَّعْوَةُ: شَجَرٌ تكون بالبادية، والضَّعة أيضاً بحذف الواو، ويجمع ضَعَوات قال «7» :
مُتَّخِذاً في ضَعَواتٍ تَوْلَجا
وقال يصف رجلاً شهوان اللّحم «8» :
تتوقُ باللّيل لشَحْمِ القَمعَه ... تثاؤبَ الذّئبِ إلى جنبِ الضّعة
وضع: الوضاعةُ: الضَّعَةُ. تقول: وَضُعَ [يَوْضُعُ] وَضاعة. والوضيعة: نحو وضائع كسرى، كان ينقل قوماً من بلادهم ويسكنهم أرضاً أخرى حتّى يصيروا بها وَضِيعَةً أبداً. والوَضيعةُ أيضاً: قوم من الجند يُجْعَلُ أسماؤهم في كورة لا يغزون منها. والوضيعةُ: ما تَضَعُه من رأسِ مالكَ. والخيّاط يُوضِّعُ القُطنَ على الثّوب توضيعاً قال «9» :
كأنَّه في ذرى عمائمهم ... موضع من مَنادِفِ العَطَبِ
وتقول: في كلامه توضيعٌ إذا كان فيه تأنيثُ كلامِ النِّساءِ.
__________
(7) (جرير) ديوانه 1/ 187.
(8) لسان العرب (قمع) غير منسوب.
(9) لم نهتد إلى القائل.
(2/195)
________________________________________
والوَضْعُ: مصدرُ قولِك: وَضَعَ يَضَعُ. والدّابّة تضع السّير وضعاً [وهو سير دون] «10» . وتقول: هي حسنة الموضوع. وأوضعها راكبها. قال الله عزّ وجلّ: وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ «11» . والمُواضَعَةُ: أن تُواضِعَ أخاك أمراً فتناظره فيه. وفلان وضعه دخوله في كذا فاتضع والتواضع: التذلل.
__________
(10) زيادة من التهذيب من روايته عن العين. لتوجيه العبارة وتوضيح المعنى.
(11) التوبة 47.
(2/196)
________________________________________
باب العين والصاد و (واي) معهما ع ص و، ع ص ي، ع وص، ع ي ص، ص ع و، ص وع، وص ع، مستعملات
عصو، عصي: العصا: جماعة الإسلام، فمن خالفهم فقد شقّ عصا المسلمين. [والعصا: العود، أنثى] عصا وعَصَوان وعِصِيّ. وعَصِيَ بالسّيف: أخذه أخذ العصا، أو ضرب به ضربه بالعصا. وعصا يعصو لغة. قال «1» :
وإنَّ المشرفيةَ قد عَلِمْتُمْ ... إذا يَعْصَى بها النَّفرُ الكرامُ
والعصا: عرقوة الدّلو، والإثنان عَصَوانِ، قال «2» :
فجاءتْ بنَسْجِ العنكَبُوتِ كأنّما ... على عصويها سابري مشبرق
وإذا انتهى المسافرُ إلى عُشْبٍ، وأزمع المُقامَ قيل: ألقى عصاه، قال «3» :
فألقَتْ عصاها واستقرّت بها النَّوَى ... كما قرّ عيناً بالإياب المسافر
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2) (ذو الرمة) ديوانه 1/ 496.
(3) التهذيب 3/ 77. المحكم 2/ 215 غير منسوب أيضا، ونسبه ابن بري، كما جاء في اللسان (عصا) إلى (عبد ربه السلمي) .
(2/197)
________________________________________
وذهب هذا البيت مَثَلاً لكلّ من وافقه شيء فأقام عليه، وكانت هذه امرأة كلّما تزَّوجتْ فارقَتْ زَوْجَها، ثم أقامتْ على زوجٍ. وكانتْ علامةُ إبائها أنَّها لا تكشِفُ عن رأسها، فلمّا رضيت بالزّوْجِ الأخير، ألقتْ عصاها، أي: خمارها. وتقول: عَصَى يَعْصي عِصياناً ومَعْصية. والعاصي: اسم الفصيل خاصّة إذا عصى أمّه في اتّباعها.
عوص، عيص: العَوَص: مصدر الأَعْوص والعَويص. اعتاص هذا الشيء إذا لم يُمكِنْ. وكلام عَويصٌ، وكلمةٌ عَوْصاءُ. قال الرّاجز «4» :
يا أيها السائل عن عَوْصائها
وتقول: أَعْوَصْتُ في المنطق، وأَعْوَصْتُ بالخَصْمِ إذا أدخلت في الأمرِ ما لا يُفْطَنُ له، قال لبيد «5» :
فلقد أُعْوِصُ بالخَصْمِ وقد ... أملأُ الجَفْنَةَ من شَحْمِ القُلَلْ
واعتاصتِ النّاقةُ: ضَربَها الفَحْلُ فلم تحمِلْ من غَير علّة. والمَعِيص، كما تقول: المَنْبِت: اسمُ رجلٍ. قال «6» :
حتّى أنالَ عُصَيَّةَ بن مَعِيصِ
والعِيصُ: مَنْبِتُ خِيار الشَّجَرِ. قال «7» :
فما شجرات عيصك في قريش ... بعشات الفروع ولا ضواحي
__________
(4) لم نهتد إلى الراجز.
(5) ديوانه 177.
(6) البيت في التهذيب 3/ 81 واللسان (عيص) غير منسوب فيهما، وصدره:
ولأثأرن ربيعة بن مكدم
(7) (جرير) ديوانه 1/ 90.
(2/198)
________________________________________
وأعياص قريش: كرامُهم يتناسبون إلى عِيص، وعيص في آبائهم عيص بن إسحاق، ويقال: عيصاً. وقيل: العِيصُ: السِّدْرُ الملتفّ.
صعو: الصَّعو: صِغارُ العصافير، والأنثى: صَعْوة، وهو أحمر الرأس والجميع: الصِّعاء. ويقال: صَعْوةٌ واحدة وصَعْوٌ كثير، ويقال: بل الصَّعْو والوَصْع واحدٌ، مثل: جَذَبَ وجَبَذَ.
صوع: الصّواع: إناء يُشْرَبُ فيه. وإذا هيّأَتِ المرأةُ موضِعاً لنَدْفِ القطن قيل: صوَّعَتْ موضِعاً، واسم الموضع: الصّاعة. والكَمِيُّ يَصُوعُ أقرانَه إذا حازهم من نواحيهم. والرّاعي يَصوعُ الإبلَ كذلك. وانصاع القوم فذهبوا سراعاً وهو من بنات الواو، وجعله رؤبة من بنات الياء حيث يقول «8» :
فظلّ يكسوها الغُبارَ الأصْيَعَا
ولو ردّ إلى الواو لقال: أَصْوَعا. وتَصَوَّعَ النّباتُ إذا صار هَيْجاً. والتّصوّعُ: تَقَبُّضُ الشَّعر. والصّاعُ: مِكيالٌ يأخذ أربعةَ أمدادٍ، وهي من بنات الواو.
وصع: الوَصْعُ والوَصَعُ: من صغار العصافير خاصّة، والجمع: وِصْعانٌ،
وفي الحديث: إن العرش على مَنْكِبِ إسرافيل، وإنّه ليتواضع لله حتّى يصيرَ مثل الوَصَعِ «9» .
والوَصِيعُ: صوت العصفور.
__________
(8) ديوانه 90.
(9) المحكم 2/ 218، واللسان (وصع) .
(2/199)
________________________________________
باب العين والسين و (واي) معهما ع س و، ع وس، ع ي س، س ع ي، س وع، س ي ع، ي س ع، وس ع، وع س
عسو: عسا الشّيخ يَعْسو عَسْوَةً، وعَسِيَ يَعْسَى عسىً إذا كَبِرَ، قال رؤبة «1» :
يهوُون عن أركانِ عزٍّ أَدْرَما ... عن صامل عاس إذا ما اصلخمما
قوله: عن صاملٍ، أي: عن عزٍّ كأنّه جبل صامل، أي: صُلْب. وعسا الليل: اشتدت ظلمته. قال «2» :
وأطعن اللّيلَ إذا اللّيل عسا
أي: أظلم. وعَسِيَ النبات يعسى عسى، إذا غلظ. قال الرّاجز يصف راعياً وإبلاً «3» :
فظل ينحاها ظماءً خمّسا ... أسعف ضرب قد عسا وقوّسا
عسَى في القرآنِ من الله واجبٌ، كما قال في الفتح وفي جمع يوسف وأبيه: عسَيْت، وعسِيت بالفتح والكسر، وأهلُ النّحوِ يقولون: هو فعل
__________
(1) ديوانه 184.
(2) العجاج ديوانه 129، والرواية فيه: غسا بالعين المعجمة. وعسا وغسا بمعنى.
(3) لم نقف على الراجز، ولا على الرجز في غير الأصول.
(2/200)
________________________________________
ناقص، ونقصانه أنك لا تقول منه فَعل يَفْعلُ، و (ليس) مثله، ألا ترى أنك تقول: لَسْتُ ولا تقول: لاس يَليس. وعسَى في الناس بمنزلة: لعلّ وهي كلمة مطمعة، ويستعملُ منه الفعل الماضي، فيقال: عَسَيْت وعَسَيْنا وعَسَوْا وعَسَيا وعسَيْنَ- لغة- وأُمِيتَ ما سواه من وجوه الفعل. لا يقال يفعل ولا فاعل ولا مفعول
. عوس: العَوْس والعَوَسانُ: الطَّوَفان باللّيل. والذّئْبُ يَعُوسُ: يَطْلُبُ شيئاً يأكلُه. والأعوس الصيقل، ويقال لكلّ وصّافٍ للشيء: هو أَعْوَسُ وصّافٌ، قال جرير «4» :
يا ابن القُيُونِ وذاكَ فِعْلُ الأَعْوَسِ
عيس: العَيَسُ: عَسْبُ الجملِ، أي: ضرابه. والعَيَسُ والعِيسَةُ: لونٌ أبيضُ مشرب صفاءً في ظُلْمة خفيّة. يقال: جملٌ أَعْيَسُ، وناقة عَيْساء. والجمعُ: عِيسٌ قال رؤبة «5» :
بالعيس تمطوها قياقٍ تَمْتَطي
والعَرَبُ خصّت بالعيس عِراب الإبلِ البيض خاصّة. وبناء عِيسَةٍ: فُعْلة على قياس كُمْتَةٍ وصُهْبَة، ولكنْ قَبُح الياءُ بعد الضّمّة فكُسِرَتِ العين على الياء. ظبيٌ أعيس. وعيسَى: [اسم نبي الله صلوات الله عليه] «6» يجمع: عِيسُونَ بضمّ السّين، والياء «7» ساقطة، وهي زائدة، وكذلك كلّ ياء زائدة في آخر
__________
(4) ديوانه ص 359 (صادر) غير أن الرواية فيه غير ذلك، فالشطر في الديوان: وذاك فعل الصيقل فالروي لام.. إلا أن يكون الشطر لغير جرير.
(5) ديوانه 84.
(6) زيادة من التهذيب 3/ 94 من روايته عن العين.
(7) يعني الألف في آخره المرسومة ياء.
(2/201)
________________________________________
الاسم تسقط عند واو الجمع، ولم تعقب فتحة. فإن قلت: ما الدليل على أن ياء عيسى زائدة؟ قلت: هو من العَيَس، وعيسى شبهُ فُعلَى، وعلى هذا القياس: مُوسَى.
سعي: السَّعْيُ: عَدْوٌ ليس بشديد. وكلُّ عملٍ من خيرٍ أو شَرٍّ فهو السَّعْيُ. يقولون: السّعيُ العملُ، أي: الكسب. والمسْعاة في الكَرَم والجود. والسّاعي: الذي يُوَلّى قَبْضَ الصَّدَقات. والجمع: سعاةٌ قال:
سَعَى عِقالاً فلم يَتْرُكْ لنا سَبَداً ... فكيف لو قد سعى عمرٌو عقالَينْ
والسِّعاية: أن تَسعَى بصاحبك إلى والٍ أو مَنْ فوقَه. والسِّعاية: ما يُسْتَسْعَى فيه العبدُ من ثَمَنِ رقَبتِه إذا أُعْتِق بعضُه، وهو أن يكلَّفَ من العَملِ ما يُؤدّي عن نفسِه ما بقي.
سوع: سُواعٌ: اسم صَنَمٍ في زمن نوح فَغَرَّقَهُ الطُّوفانُ، ودَفَنَهُ، فاستثاره إبليسُ لأهْلِ الجاهليّةِ فكانوا يعبدونه من دون الله عزّ وجلّ. والسّاعة تُصغّر سُوَيْعة، والسّاعة القيامة.
سيع: السّيعُ الماء الجاري على وجه الأرض. تقول: قد انساعَ إذا جرى. وانساعَ الجَمَدُ إذا ذابَ وسالَ. قال «9» :
من شِلّها ماءُ السراب الأسيعا
__________
(9) (رؤبة) - ديوانه 89. والرواية فيه: ترى بها ماء السراب الأسعيا.
(2/202)
________________________________________
والسياعُ تطيينُك بالجَصِّ أو الطّينِ، أو القِير، كما تُسَيّعُ به الحبّ أو الزّق أو السُّفُن تَطْليه طلْياً رفيقاً. قال يُشَبِّهُ الخَمْرَ بالوَرْسِ «10» :
كأنّها في سِياعِ الدَّنِّ قِندِيد
يجوزُ في السّين النَّصب والكسر. والمِسْيَعَةُ: خَشَبةٌ مُمَلَّسَةٌ يُطَيَّنُ بها. والفعل: سَيَّعْتُه تَسييعاً، أي: تطييناً. والسِّيَاع: شجر البان، وهو من شجرِ العِضاه، ثَمَرتُهُ كهيئةِ الفُسْتُق، ولِثاهُ مِثْلَ الكُنْدُر إذا جَمَد.
يسع: اليَسَع: اسم من اسماء الأنبياء، والألف واللام زائدتان.
وسع: الوُسْعُ: جِدةُ الرَّجلِ، وقدرة ذات يده. تقول: انفِقْ على قَدْرِ وُسْعِك، أي: طاقتك. وَوَسُعَ الفرس سَعَةً ووَساعَةً فهو وَساعٌ. وأَوْسَعَ الرّجل: إذا صارَ ذا سَعَةٍ في المال، فهو مُوسِعٌ وإنّه لذو سَعَةٍ في عيشه. وسَيْرٌ وَسِيعٌ ووَساعٌ. ورحمة الله وسعت كل شيء، وأَوْسَعَ الرّجُلُ صار ذا سعة في المال. وتقول: لا يَسَعُكَ، أي: لَسْتَ منهُ في سَعَةٍ.
وعس: الوَعْسُ: رملٌ أو غيره، وهو أعظم من الوعساء. والوَعْسُ: الرّملُ الذي تغيبُ فيه القوائم. والاسم: الوعساء وإذا ذكّروا قالوا: أوعسُ. قال العجاج يصف العَجُزَ «11» :
ومَيْسَنا نِيًّا لها مُمَيّسا ... ألبس دعصاً بين ظهري أوعسا
__________
(10) في اللسان والتاج (سيع) غير منسوب وغير تام.
(11) ديوانه 127.
(2/203)
________________________________________
والمِيعاسُ: المكان الذي فيه الوَعْسُ في قول جرير «12» :
حيّ الهِدَمْلَة من ذاتِ المواعيس
والمُواعَسَةُ: ضربٌ من سير الإبل في السّرعة يقولون: تَوَاعَسْنَ بالأعناق، إذا سارت ومدّت أعناقها في سعة الخطو، قال الشاعر «13» :
كَمِ اجْتَبْنَ من ليلٍ إليك وواعَسَتْ ... بنا البِيدَ أعناق المهاري الشعاشع
__________
(12) ديوانه 249 (صادر) وعجز البيت:
فالحنو أصبح قفرا غير مأنوس
(13) المحكم 2/ 219، اللسان (وعس) .
(2/204)
________________________________________
باب العين والزاي و (واي) معهما ع ز و، ع ز ي، ع وز، وع ز، ز وع، وز ع مستعملات
عزو، ع ز ي: العِزَةُ: عصبةٌ من النّاس فوقَ الحِلَقَة، والجماعةُ: عِزُونَ، ونقصانُها واو. وكذلك الثُّبة. قال في الحيّة «1» :
خُلِقَتْ نواجذُه عِزينَ ورأسُه ... كالقُرص فُلْطِحَ من طَحينِ شعيرِ «2»
وعَزِيَ الرّجلُ يَعْزَى عزاءً، ممدود. وإنّه لَعَزِيٌّ صبور. والعَزاءُ هو الصّبرُ نفسه عن كلّ ما فقدت ورزئت، قال «3» :
ألا مَنْ لِنَفْسٍ غاب عنها عزاؤها
والتّعزّي فعلُهُ، والتّعزِيَةُ فعلك به قال «4» :
وقد لمت نفسي وعزّيتها ... وباليأس والصبر عزّيتُها
والاعتزاءُ: الإتّصالُ في الدَّعْوَى إذا كانت حرب، فكل مَنِ ادَّعَى في شِعارِه أنا فلانُ بنُ فلانٍ: أو فلان الفلانيّ فقد اعتزَى إليه. وكلمةٌ
__________
(1) اللسان (عزا) وهو منسوب فيه إلى (ابن أحمر البجلي) .
(2) في النسخ (عجين) مكان شعير.
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول.
(4) لم نهتد إليه في غير الأصول.
(2/205)
________________________________________
شنعاءُ من لغة أهل الشِّحْر، يقولون: يَعْزى لقد كان كذا وكذا، ويَعْزيكَ ما كان ذلك، كما تقول: لعمري لقد كانَ كذا وكذا، ولعَمْرُكَ ما كانَ ذاك. وتقول: فلان حسَنُ العِزْوَةِ على المصائب. والعِزْوَةُ: انتماءُ الرّجلِ إلى قومه. تقول: إلى مَنْ عِزْوَتُكَ، فيقول: إلى تميم.
عوز: العَوَزُ أن يُعْوِزَك الشيء وأنت إليه مُحتاجٌ، فإذا لم تجدِ الشيء قلت: أعوزني «5» . وأَعْوَزَ الرّجلُ ساءتْ حالُه. والمِعْوَزُ والجمع مَعاوِز: الخِرَقُ التي يُلَفُّ فيها الصّبيّ ... قال حسان بن ثابت «6» :
وموءودةٍ مقرورةٍ في مَعاوزٍ ... بآمَتِها مَرْموسَةٍ لم تُوَسَّدِ
ورواية عبد الله: منذورة في معاوز. وكلّ شيءٍ لزِمَهُ عيبٌ فالعيب آمَتُهُ، وهي في هذا البيت: القلفة.
وعز: الوَعْزُ: التَّقدِمَةُ. أوعزت إليه، أي: تَقَدَّمْتُ إليه ألاّ يَفْعَل كذا، قال «7» :
قد كنت أَوْعَزْتُ إلى علاء ... في السر والإعلانِ والنَّجاء
النَّجاءُ من المناجاة.
__________
(5) في (ص) و (ط) : عوز وما أثبتناه فمن (س) .
(6) في (ص) : (مفروضة) وفي (ط) (مفروزة) وفي (س) : (معزوة) مكان (مقرورة) . وفي (ص) و (ط) : (بأمتها) وفي س (بامتها) مكان (بآمتها) . وفي (ط) مرمرسة، وفي (س) مرسومة والصواب ما أثبتنا من (ص) والمحكم 2/ 221 واللسان (عوز) .
(7) المحكم 2/ 222، واللسان (وعز) غير منسوب، والرواية فيهما (وعزت) .
(2/206)
________________________________________
زوع: الزَّوع: جَذْبُك النّاقة بالزّمام لِتَنْقاد. قال ذو الرّمة «8» :
ومائلٍ فوقَ ظهرِ الرّحْلِ قلتُ له: ... زُعْ بالزّمام وجَوْزُ اللّيل مَرْكومُ
وقال في مثل للنّساء «9» :
ألا لا تبالي العِيسُ من شدِّ كُورِها ... عليها ولا من زاعها بالخزائم
وزع: الوزع: كفُّ النَّفْس عن هواها. قال «10» :
إذا لم أزع نفسي عنِ الجَهلِ والصِّبا ... لِينفَعَها عِلْمي فقد ضَرَّها جَهْلي
والوَزوع: الوَلوع. أُوزِع بكذا، أي: أوِلع.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله موزَعاً بالسّواك،
والتَّوزيع: القِسْمة: أن يقسموا الشيء بينهم من الجزور ونحوه، تقول: وزّعتُها بينهم، وفيهم، أي: قسّمتها. وَزُوع: اسم امرأة. والوازعُ: الحابسُ للعسكر. قال عزّ وجلّ: فَهُمْ يُوزَعُونَ
«11» * أي: يُكَفُّ أوّلُهم على آخرهم. وقوله عزّ وجلّ: أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
«12» *، أي: أَلْهِمْني.
__________
(8) ديوانه 1/ 420 والرواية فيه: وخافق الرأس مثل السيف ...
(9) (ذو الرمة) ديوانه 3/ 1915 (ملحق الديوان) .
(10) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(11) النمل 17.
(12) النمل 19.
(2/207)
________________________________________
باب العين والطّاء و (واي) معهما ع ط و، ط وع، ع ي ط، ي ع ط مستعملات
عطو: العَطاء: اسمٌ لما يُعْطَى، وإذا سمّيت الشيء بالعطاء من الذّهب والفضّة قلت: أَعْطِيَة، وأَعْطِيَات: جمع الجمع. والعَطْوُ: التّناوُلُ باليدِ. قال امرؤ القيس «1» :
وتَعْطو برَخْصٍ غيرِ شَثْنٍ كأنه ... أساريع ظبي أو مَساويكُ إسْحِلِ
والظّبيُ العاطي: الرافع يديه إلى الشّجرة ليتناول من الورق. قال «2» :
تحكُّ بقَرنَيْها برير أراكة ... وتعطو بظلفيها إذا الغُصْنُ طالَها
يقال: ظبيٌ عاطٍ، وعَطُوٌّ، وجَدْيٌ عطوٌّ، ومنه اشتُقَّ الإعطاءُ. والمُعاطاةُ: المُناوَلَةُ. عاطى الصبيُّ أهلَه إذا عَمِلَ لهم وناولَ ما أرادوا. والتَّعاطي: تناولُ ما لا يحقّ. تعاطَى فلان: ظلمك، قال الله عزّ وجلّ: فَتَعاطى فَعَقَرَ «3» ، قالوا: قام الشّقيّ على أطرافِ أصابع رجلَيْه، ثمّ رفع يدَيْه فضربَها فعقرها،
__________
(1) ديوانه 17.
(2) لم نهتد إلى القائل.
(3) القمر 29.
(2/208)
________________________________________
ويقال: بل تَعاطيهِ جُرْأتُهُ، كما تقول: تعاطى أمراً لا ينبغي له.. والتَّعاطي أيضاً في القُبَل.
طوع: طاع يَطُوع طوعاً فهو طائع. والطَّوْعُ: نقيض الكَرْه، تقول: لَتَفْعَلَنَّهُ طوعاً أو كَرْهاً. طائعاً أو كارِهاً، وطاع له إذا انقاد له. إذا مضَى في أمرك فقد أطاعك، وإذا وافقك فقد طاوعك. قال يصف دلواً «4» :
أحلِفُ بالله لَتُخْرِجِنَّهْ ... كارِهةً أو لتطاوِعِنَّهْ
أو لَتَرينَّ بيَ المُرِنَّهْ
أي: الصّائحة. والطّاعة اسم لما يكون مصدره الإطاعة، وهو الإنقياد، والطّواعِيَةُ اسم لما يكون مصدره المطاوعة. يقال: طاوعتِ المرأة زوجَها طَواعيةً حَسَنةً، ولا يقال: للرعيّة ما أحسن طَواعِيَتَهُم للرّاعي، لأنَّ فعلَهم الإطاعة، وكذلك الطّاقة اسم الإِطاقة والجابة اسم الإِجابة، وكذلك ما أشْبَهَهُ، قال «5» :
حَلَفْتُ بالبيتِ وما حَوْلَهُ ... من عائذٍ بالبيت أَوْ طاعي
أراد: أو طائع فقلبه، مثل قِسِيّ، جعل الياء في طائع بعد العين، ويقال: بل طرح الياءَ أصلاً، ولم يُعِدْها بعد العين، إنّما هي: طاع،
__________
(4) لم نهتد إلى الراجز.
(5) المحكم 2/ 224. واللسان (طوع) .
(2/209)
________________________________________
كما تقول: رجلٌ مالٌ وقال، يراد به: مائل، وقائل، مثل قول أبي ذؤيب «6» :
وسوّد ماءُ المَرْدِ فاها فلونُهُ ... كلَوْنِ الرَّمادِ وهي أدماءُ سارُها
أي: سائرها. وقال أصحابُ التّصريف: هو مثل الحاجة، أصلها: الحائجة. ألا ترى أنّهم يردّونها إلى الحوائج، ويقولون: اشتُقّت الاستطاعة من الطّوع. ويقال: تَطاوَعْ لهذا الأمر حتّى تستطيعه. وتطوّع: تكلّف استطاعته، وقد تطوّع لك طوعاً إذا انقاد، والعرب تحذف التّاء من استطاع، فتقول: اسطاع يَسطيع بفتح الياء، ومنهم من يضمّ الياء، فيقول: يُسْطِيعُ، مثل يُهريق. والتَّطوُّعُ: ما تبرّعت به ممّا لا يلزمك فريضته. والمُطّوِّعة بكسر الواو وتثقيل الحرفين: القوم الذين يتطوّعون بالجهاد يخرجون إلى المُرابَطات. ويقال للإبل وغيرها: أطاعَ لها الكلأ إذا أصابتْ فأكلَتْ منه ما شاءت، قال الطرمّاح «7» :
فما سرحُ أبكارٍ أطاعَ لِسَرْحِهِ
والفَرَس يكون طوعَ العِنانِ، أي: سَلِس العِنانِ. وتقول: أنا طَوْعُ يدِكَ، أي: منقادٌ لكَ، وإنَّها لطوعُ الضّجيع. والطّوْعُ: مصدرُ الطائعِ. قال «8» :
طَوْعَ الشَّوامِتِ مِنْ خوف ومن صرد
__________
(6) ديوان الهذليين ص 24، والرواية فيه: كلون النوور.
(7) ديوانه، ص 295 والرواية فيه: فما جلس أبكار ... وعجز البيت:
جَنَى ثَمَرٍ بالواديين وشُوعُ
(8) النابغة ديوانه ص 8 وصدر البيت:
فارتاع من صوت كلاب فبات له
(2/210)
________________________________________
عيط: جملٌ أَعْيَطُ، وناقةٌ عَيْطاء: طويلُ الرّأسِ والعُنُقِ. وتُوصَفُ به حُمُر الوَحْشِ. قال العجّاج يصفُ الفَرَس بأنّه يعقر عليه «9» :
فهو يكب العيط منها للذقن
وكذلك القَصْرُ المنيف أَعْيَطُ لطوله، وكذلك الفأرة عَيْطاء. قال «10» :
نحنُ ثقيفٌ عِزُّنا منيعُ ... أَعْيَطُ صعْبُ المرتَقَى رفيع
واعتاطت النّاقة إذا لم تَحْمِلْ سنوات من غير عقر، وربّما كان اعتياطها من كثرة شحمها، وقد تعتاط المرأة أيضاً. وناقةٌ عائط، قد عاطت تعيط عياطاً في معنى حائل. ونُوقٌ عِيطٌ وعوائطُ. والتعيّط: تنبّع الشيء من حجرٍ أو عود يَخْرُجُ منه شِبْهُ ماءٍ فيُصَمَّغُ، أو يَسِيلُ. وذِفْرَى الجَمَل يَتَعَيَّطُ بالعَرَق الأسود. قال «11» :
تعَيَّطُ ذِفراها بجَوْنٍ كأنّه ... كُحَيْلٌ جَرَى من قُنْفُذِ اللّيتِ نابعُ
وقال في العائط بالشحم «12» :
قدّد من ذات المدكّ العائط
وعِيطِ: كلمة يُنادَى بها الأشِرُ عند السُّكر، ويُلْهَجُ بها عند الغلبة، فإذا لم يَزِدْ على واحدة مدّه وقال: عيَّط، وإن رجّع قال: عطعط.
__________
(9) ليس في ديوانه، ولم نقف عليه في غير الأصول.
(10) لم نهتد إلى الراجز.
(11) (جرير) ديوانه 290 (صادر) والرواية فيه: تغيض مكان تعيط. وفي النسخ: (الليل) مكان (الليت) .
(12) هذا من (س) ، ولم يتبين لنا معناه. أما (ص) و (ط) فالعبارة فيهما أكثر اضطرابا فقد جاءت العبارة فيهما: قال في العائط: وبالشحم قد دمها نيها وبالمد [بياض] العائط.
(2/211)
________________________________________
يعط: يَعاطِ: زجرُك الذّئبَ إذا رأيته. قلت: يَعاطِ يَعاطِ. ويقال: يَعَطْتُ به، وأَيْعَطْتُ به، وياعَطْتُه. قال «13» :
صُبَّ على شاءِ أبي رِباطِ ... ذُؤالةٌ كالأَقْدُحِ الأمْراطِ
يدنو إذا قيلَ له: يَعاطِ
وبعض يقول: يِعاط، وهو قبيحٌ، لأنَّ كسر الياء زاده قبحاً، وذلك أنّ الياء خُلِقَتْ من الكسرة، وليس في كلامِ العربِ فَعال في صدرها ياء مكسورة في غير اليِسار بمعنى الشّمال، أرادوا أن يكون حذوهما واحداً، ثم اختلفوا فمنهم من يهمز، فيقول: إسار. ومنهم من يفتح الياء فيقول: يَسار، وهو العالي من كلامهم.
__________
(13) التهذيب 3/ 107 واللسان (يعط) .
(2/212)
________________________________________
باب العين والدّال و (واي) معهما ع د و، ع ود، د ع و، وع د، ود ع، يدع
عدو: العَدْوُ: الحُضْرُ. عدا يعدو عدواً وعدوّاً، مثقلةً، وهو التعدّي في الأمر، وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه، ويقرأ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً «1» على فُعُول في زنة: قُعُود. وما رأيت أحداً ما عدا زيداً، أي: ما جاوز زيداً، فإن حذفت (ما) خفضته على معنى سوى، تقول: ما رأيت أحداً عدا زيد. وعدا طورَه، وعدا قدرَه، أي: جاوز ما ليس له. والعدوان والإعتداء والعداء، والعدوى والتعدّي: الظُّلْمُ البراح. والعَدْوَى: طلبك إلى والٍ ليُعْدِيَك على من ظلمك، أيْ: ينتقم لك منه باعتدائه عليك. والعَدْوَى: ما يقال إنّه يُعْدِي من جَرَب أو داء.
وفي الحديث: لا عَدْوَى ولا هامةِ ولا صفرَ ولا غُولَ ولا طيرَةَ «2»
أي: لا يُعْدي شيءٌ شيئاً. والعَدْوَةُ: عَدْوَةُ اللّص أو المغيرِ. عدا عليه فأخذ ماله، وعدا عليه بسيفِه فضربه، ولا يُريدُ عَدْواً على الرّجلينِ، ولكنْ من الظّلم.
__________
(1) الأنعام 108.
(2) اللسان (عدا) .
(2/213)
________________________________________
وتقول: عَدَتُ عوادٍ بيننا وخُطُوب، وكذلك عادت، ولا يُجْعَلُ مصدره في هذا المعنى: معاداة، ولكن يقال: عدى مخافةَ الإلتباس. وتقول: كُفَّ عنّي يا فلانُ عاديتَكَ، وعادية شرّك، وهو ما عَداك من قِبَلِهِ من المكروه. والعاديةُ: الخيلُ المغيرة. والعادية: شُغْلٌ من أشغال الدّهر تَعْدوك عن أمورك. أي: تشغلك. عداني عنك أمر كذا يعدوني عداءً، أي: شَغَلني. قال:
وعادك أن تلاقيها العداء
أي: شغلك. ويقولون: عادك معناه: عداك، فحذف الألف أمام الدال، ويقال: أراد: عاودك. قال «3» :
إنّي عداني أن أزورميا ... صهب تغالى فوق نيّ نيّا
والعَداءُ والعِداءُ لغتان: الطَّلْقُ الواحد، وهو أن يعادي الفرس أو الصيّاد بين صيدين ويصرع أحدهما على أثر الآخر، قال «4» :
فعادَى عِداءً بين ثَوْرٍ ونَعْجَةٍ
وقال «5» :
يَصْرَعُ الخَمْسَ عَداءً في طَلَقْ
يعني يصرع الفرس، فمن فتح العين قال: جاوز هذا إلى ذاك، ومن كسر العين قال: يعادي الصيد، من العَدْو. والعَداء: طَوارُ الشيء. تقول: لَزِمتُ عَداء النّهر، وعَداءَ الطريق والجبل، أي: طواره.
__________
(3) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(4) (امرؤ القيس) ديوانه ص 52، وعجز البيت:
وبين شبوب كالقضيمة قرهب
(5) الشطر في التهذيب 3/ 114 واللسان (عدا) غير منسوب، وفي الأصول منسوب إلى (رؤية) ، وليس له.
(2/214)
________________________________________
ويقال: الأكحل عرْقٌ عَداءَ السّاعد. وقد يقال: عِدْوة في معنى العَداء، وعِدْو في معناها بغير هاء، ويجمع [على أفعال فيقال] أعداء النهر، وأعداء الطريق. والتَّعداء: التَّفعال من كلّ ما مرَّ جائز. قال ذو الرّمة «6» :
مِنْها على عُدْوَاءِ النَّأيِ تَسْتقيمُ
والعِنْدَأْوَة: التواءٌ وعَسَرٌ [في الرِّجْلِ] «7» . قال بعضهم: هو من العَداءِ، والنون والهمزة زائدتان، ويقال: هو بناء على فِنْعالة، وليس في كلام العرب كلمة تدخل العين والهمزة في أصل بنائها إلاّ في هذه الكلمات: عِنْدأْوة وإمَّعة وعَباء، وعَفاء وعَماء، فأمّا عَظاءة فهي لغة في عَظاية، وإن جاء منه شيء فلا يجوز إلاّ بفصل لازم بين العين والهمزة. ويقال: عِنْدَأوة: فِعْلَلْوة، والأصلُ أُمِيتَ فِعْلُهُ، لا يُدرى أمن عَنْدَى يُعْنَدي أم عدا يعدو، فلذلك اختلف فيه. وعدّى تَعْدِيَةً، أي: جاوز إلى غيره. عدّيتُ عنّي الهمَّ، أي: نحّيتُه. وتقول للنّازل عليك: عدِّ عنّي إلى غيري. وعَدِّ عن هذا الأمر، أي: دعْهُ وخذ في غيره. قال النّابغة «8» :
فعدِّ عمّا تَرَى إذ لا ارتجاعَ لَهُ ... وانْمِ القُتُودَ على عَيْرانَةٍ أُجُدِ
وتعدّيتُ المفازَةَ، أي: جاوزتُها إلى غيرها. وتقول للفعل المجاوِزِ: يتعدّى إلى مفعولٍ بعد مفعول، والمجاوز مثل ضرب عمرو بكراً،
__________
(6) ديوانه 1/ 384 والرواية فيه (الدار) مكان (النأي) . وصدر البيت فيه:
هام الفؤاد لذكراها وخامره
(7) زيادة من التهذيب 3/ 118. لتوضيح المعنى.
(8) ديوانه ص 5.
(2/215)
________________________________________
والمتعدّي مثل: ظنّ عمرو بكراً خالداً. وعدّاه فاعله، وهو كلام عامّ في كل شيء. والعَدُوُّ: اسمٌ جامعٌ للواحد والجميع والتّثنية والتّأنيث والتّذكير، تقول: هو لك عدوٌّ، وهي وهما وهم وهنَّ لك عدوٌّ، فإذا جعلته نعتاً قلت: الرّجلانِ عدوّاك، والرّجالُ أعداؤك. والمرأتان عدوتاك، والنسوة عداوتك، ويجمع العدوّ على الأعداء والعِدَى والعُدَى والعُداة والأعادي. [وتجمع العَدوّة على] عَدَايا. وعدْوانُ حيّ من قيس، قال «9» :
عَذيرَ الحيِّ من عدوان ... كانوا حَيَّةَ الأرْضِ
والعَدَوان: الفَرس الكثير العَدْوِ. والعَدَوان: الذّئب الذي يعدو على النّاس كلّ ساعة، قال يصف ذئباً قد آذاه ثمّ قتله بعد ذلك «10» :
تذكرُ إذْ أنت شديدُ القَفْز ... نَهْد القصيرَى عَدَوان الجمز
والعداوء: أرضٌ يابسةُ صُلْبة، وربما جاءت في جوف البئر إذا حُفِرَت، وربّما كانت حجراً حتى يحيد عنها الحفّار بعضَ الحَيْد. قال العجّاج يصفُ الثّور وحَفْرَهُ الكِنَاسَ «11» :
وإن أصاب عُدَوَاءَ احْرَوْرَفا ... عنها وولاّها الظُّلوفَ الظُّلَّفا
والعُدوة: صلابة من شاطىء الوادي، ويقال: عِدوة، ويقرأ: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا بالكسر والضم.
__________
(9) (ذو الإصبع العدواني) - الكتاب 1/ 390. ديوانه 46.
(10) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز في غير الأصول.
(11) ديوانه ص 500.
(2/216)
________________________________________
عَدّي: فَعيلٌ من بنات الواو، والنسبة: عَدَوِيّ، ردّوا الواو كما يقولون: عَلَوِيّ في النسبة إلى عَلِيّ. والعَدَويّة من نَباتِ الصّيف بعد ذهاب الرّبيع يَخْضرُّ صغار الشّجر فترعاه الإبلُ. والعَدَويَّة: من صغارِ سِخال الغَنَم، يقال: هي بناتُ أربعينَ يوماً فإذا جُزَّتْ عنها عقيقتُها ذَهَبَ عنها هذا الاسم. ومَعْدي كرب، مَنْ جَعَلَهُ مَفْعِلاً فإنّه يكون له مخرجٌ من الواو والياء جميعاً، ولكنّهم جعلوا اسمين اسماً واحداً فصار الإعرابُ على الباء وسكّنوا ياء مَعْدِي لتحرُّكِ الدّال، ولو كانت الدّال ساكنة لنصبوا الياء، وكذلك كلُّ اسمينِ جعلا اسماً واحداً، كقول الشاعر «12» :
... عرّدت ... بأبي نَعَامَةَ أمُّ رَأْلٍ خَيْفَقُ
عود: العَوْدُ: تثنيةُ الأمرِ عَوْداً بَعْدَ بَدْءٍ، بدأ ثم عاد. والعَوْدَةُ مرّة واحدة،
كما يقول: ملك الموت لأهل الميّت: إنّ لي فيكم عَوْدة ثمّ عَوْدة حتّى لا يبقى منكم أحد.
وتقول: عاد فلانٌ علينا معروفُه إذا أحسن ثمّ زاد قال «13» :
قد أحْسَنَ سعدٌ في الذي كان بيننا ... فإنْ عادَ بالإحْسانِ فالعَوْدُ أحمدُ
وقول معاوية: لقد متّتْ برحِمٍ عَوْدة. يعني: قديمة. قد عَوَّدَتْ، أي: قَدُمَتْ، فصارت كالعَوْدِ القديم من الإبل.
__________
(12) لسان العرب (عرد) غير منسوب، وصدر البيت:
لما استباحوا عبد رب عردت
(13) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(2/217)
________________________________________
وفلان في مَعادة، أي: مُصيبة، يغشاه النّاس في مناوِح، ومثله: المَعاوِد: والمَعاوِد المآتم. والحجّ مَعادُ الحاجّ إذا ثنّوا يقولون في الدّعاء:
اللهمَّ ارزُقنا إلى البيتِ مَعاداً أو عَوْداً.
وقوله لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ «14» يعني مكّة، عِدَةً للنبيّ صلى الله عليه وآله أن يَفْتحها ويَعودَ «15» إليها. ورأيت فلانا ما يبدىء وما يُعيد، أي: ما يتكلّم بباديةٍ ولا عاديةٍ. قال عبيد بن الأبرص «16» :
أقفر من أهله عبيد ... فاليوم لا يبدي ولا يُعِيدُ
والعادةُ: الدُّرْبة في الشيء، وهو أن يتمادى في الأمر حتّى يصيرَ له سجيّة. ويقال للرَّجُل المواظب في الأمر: مُعاوِد. في كلامِ بَعْضِهِم: الْزَموا تُقى الله واستعيدوها، أي: تعوّدوها، ويقال: معنى تَعَوَّدَ: أعاد. قال الرّاجز «17» :
لا تَستطيعُ جَرَّه الغَوامِضُ ... إلاّ المُعِيداتُ بهِ النّواهِضُ
يعني: النّوق التي استعادتِ النَّهْضَ بالدّلو. ويقال للشّجاع: بطلٌ مُعاوِدٌ، أي: قد عاوَدَ الحربَ مرَّةً بعد مرّةٍ. وهو معيدٌ لهذا الشيء أي: مُطيقٌ له، قد اعتاده. والرّجال عُوّاد المريض، والنّساء عُوَّد، ولا يُقال: عُوّاد. واللهُ العَوَّادُ بالمغفرة، والعبد العَوَّاد بالذّنوب.. والعَوْدُ: الجَمَلُ المُسِنّ وفيه سَورة،
__________
(14) القصص 85.
(15) هذا من (س) .. (ص) و (ط) : حتى يعود.
(16) ديوانه 45.
(17) المحكم 2/ 232، واللسان (عود) غير منسوب فيهما أيضا.
(2/218)
________________________________________
أي بقيّة، ويجمع: عِوَدة، وعِيَدة لغة، وعوّد تعويداً بلغ ذلك الوقت، قال «18» :
لا بُدَّ من صَنْعا وإنْ طال السَّفَرْ ... وإنْ تحنّى كلّ عَوْدٍ وانْعقَرْ
والعَوْدُ: الطّريقُ القديم. قال «19» : عَوْدٌ على عَوْدٍ لأقْوامٍ أُوَل يريد: جمل على طريقٍ قديم. والعَوْدُ: يوصف به السُّودَدُ القديم. قال الطرماح «20» :
هل المجدُ إلاّ السُّودَدُ العَوْدُ والنَّدَى ... ورَأْبُ الثَّأَى والصّبرُ عندَ المُواطِن
والعُوْدُ: الخشبةُ المُطَرّاة يدخن به. والعُودُ: ذو الأوتار الذي يضرب به، والجميع من ذلك كلّه: العِيدان، وثلاثة أعواد، والعَوَّادُ: متّخذُ العِيدان. والعِيدُ: كلُّ يومِ مَجْمَعٍ، من عاد يعود إليه، ويقال: بل سُمِّيَ لأنّهم اعتادوه. والياءُ في العيد أصلها الواو قُلبت لِكَسْرَةِ العَيْن. قال العجاج يصف الثور الوحشيّ ينتابُ الكِناس «21» :
يَعْتاد أرباضاً لها آريُّ ... كما يَعودُ العيدَ نَصْرانيُّ
وإذا جمعوه قالوا: أعْياد، وإذا صغّروه قالوا: عُيَيْد، وتركوه على التّغيير. والعِيدُ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّث. والعائدة: الصّلة والمعروف، والجميع:
__________
(18) الشطر الأول في المخصص 15/ 111 واللسان (صنع) والشطر الثاني في التصريح على التوضيح 2/ 293 والرواية فيه (ودبر) .
(19) المحكم 2/ 233 غير منسوب أيضا، ونسب في اللسان (عود) إلى بشير بن النكث.
(20) ديوانه ص 516 والرواية فيه (اللها) مكان (الندى) .
(21) ديوانه 322 والرواية فيه (واعتاد) مكان (يعتاد) .
(2/219)
________________________________________
عوائد. وتقول: هذا الأمر أَعْوَد عليك من غيره. أي: أرفقُ بك من غيره. وفَحْلٌ مُعيدٌ: مُعتادٌ للضِراب. وعوّدتُه فتعوَّد. قال عنترة يَصِفُ ظليماً يَعْتادُ بيضَه كلَّ ساعة «22» :
صَعْلٍ يَعودُ بذْي العُشَيْرَةِ بيضَهُ ... كالعَبْد ذي الفَرْوِ الطويلِ الأصْلَمِ
والعِيدِيّةُ: نجائبُ منسوبة إلى عاد بن سام بن نوح عليه السّلام، وقبيلته سُمّيت به. وأمّا عاديّ بن عاديّ فيقال: ملك ألف سنة، وهزم ألف جيش وافتضّ ألفَ عذراءَ، ووجد قبيل الإسلام على سريرٍ في خرقٍ تحتَ صخرةٍ مكتوبٍ عليها على طَرَفِ السّرير قِصَّتُه «23» . قال زهير «24» :
ألم تَرَ أنّ اللهَ أَهْلَكَ تُبّعاً ... وأَهْلَكَ لُقمانَ بن عادٍ وعادِيا
وأمّا عادٌ الآخرة فيقال إنّهم بنو تميم ينزلون رمالَ عالِجٍ، وهم الذين عَصَوا الله فمسخهم نسناساً لكلّ إنسان منهم يدٌ ورجلٌ من شِقٍّ ينقز نقز الظّبْي. فأمّا المسخُ فقد انقرضوا، وأمّا الشَّبُه الذي مُسِخوا عليه فهو على حاله «25» . ويقال للشيء القديم: عاديّ يُنْسَبُ إلى عادٍ لقِدَمِهِ. قال «26» :
عادِيّة ما حُفِرَتْ بعدَ إرَمْ ... قام عليها فتيةٌ سود اللمم
__________
(22) ديوانه ص 21 وهو من معلقته.
(23) أكبر الظن أن المحصور بين أقواس التنصيص ليس من كلام الخليل. ولكنه من زيادات النساخ.
(24) ديوانه ص 288.
(25) أكبر الظن أن المحصور بين أقواس التنصيص ليس من كلام الخليل. ولكنه من زيادات النساخ.
(26) لم نهتد إلى الراجز، ولا إلى الرجز فيما بين أيدينا من مظان.
(2/220)
________________________________________
دعو: الدِّعْوَةُ: ادّعاء الولد الدّعيّ غير أبيه، ويدّعيه غير أبيه. قال «27» :
ودِعْوَة هاربٍ من لُؤْمِ أصلٍ ... إلى فحْلٍ لغير أبيه حوب
يقال: دَعيٌّ بيّنُ الدِّعْوَة. والادّعاء في الحرب: الاعتزاء. ومِنْه التّداعي، تقول: إليّ أنا فُلان.. والادعاء في الحرب أيضاً أنْ تقولَ يال فلان. والادّعاء أن تدّعي حقًّا لك ولغيرك، يقال: ادّعَى حقًّا أو باطلاً. والتّداعي: أن يدعوَ القومُ بعضُهم بعضاً.
وفي الحديث: دع داعيةَ اللّبنِ «28»
يعني إذا حلبت فدعْ في الضّرع بقيّةً من اللّبن. والدّاعيةُ: صريخ الخَيْلِ في الحروب. أجيبوا داعيةَ الخيل. والنّادبة تدعو الميت إذا نَدَبتْهُ. وتقول: دعا الله فلاناً بما يكره، أي: أنزل به ذلك. قال «29» :
دعاكَ اللهُ من قَيْسٍ بأفعَى ... إذا نام العيونُ سرتْ عليكا
وقوله عز وجل: تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى «30» ، يقال: ليس هو كالدّعاء، ولكنّ دعوتَها إيّاهم: ما تَفْعَلُ بهم من الأفاعيل، يعني نار جهنّم. ويقال: تداعَى عليهم العدوُّ من كلّ جانبٍ: [أَقْبَل] . وتداعَتِ الحيطانُ إذا انقاضَّتْ وتَفَرَّزَتْ. وداعَيْنا عليهم الحيطانَ من جوانبها، أي: هدمناها عليهم.
__________
(27) لم نهتد إلى القائل.
(28) التهذيب 3/ 121.
(29) المحكم 2/ 235، واللسان (دعا) . في الأصول: (فيش) مكان (قيس) .
(30) المعارج 17.
(2/221)
________________________________________
ودواعي الدّهر: صُروفُهُ. وفي هذا الأمر دعاؤه، أي: دعوى قسحة. وفلانٌ في مَدْعاة إذا دُعيَ إلى الطّعام. وتقول: دعا دُعاءً، وفلانٌ داعي قومٍ وداعية قومٍ: يدعو إلى بيعتهم دعوة. والجميعُ: دُعاةٌ.
وعد: [الوَعْدُ والعِدَةُ يكونان مصدراً واسماً. فأمّا العِدَةُ فتُجْمع: عِدات، والوعد لا يجمع] «31» . والموعِدُ: موضع التّواعُدِ وهو الميعادُ. والمَوْعِدُ مصدرُ وَعَدْتُهُ، وقد يكون الموعِدُ وقتاً للعدة «32»
، والموعدة: اسم للعدة. قال جرير «33» :
تُعَلِّلُنا أُمامةُ بالعِداتِ ... وما تَشْفي القُلوبَ الصّادياتِ
والميعاد لا يكون إلاّ وقتاً أو موضعاً. والوعيد من التّهدّد. أوعدته ضرباً ونحوه، ويكون وعدته أيضاً من الشّرّ. قال الله عزّ وجلّ: النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا «34» . ووعيد الفحل إذا همّ أن يصول. قال أبو النجم:
يرعد أن يوعدَ قلب الأعزل
ودع: الوَدْعُ والوَدْعَةُ الواحدة: مناقفُ صغار تخرج من البحر يزيّن به العثاكل، وهي بيضاء. في بطنها مَشْقٌ كشقِّ النواة، وهي جوف، في جوفها دُوَيْبة كالحَلَمة. قال ذو الرّمة «35» :
كأنّ آرامها والشّمسُ ماتعةٌ ... وَدْعٌ بأرجائِهِ فذ ومنظوم
__________
(31) نص من العين حفظه الأزهري في التهذيب 3/ 133، وسقط من الأصول.
(32) في الأصول: للحين، وما أثبتناه فمن التهذيب 3/ 134 عن العين.
(33) ديوانه 69.
(34) الحج 72.
(35) ديوانه 1/ 416، والرواية فيه (أدمانها) مكان آرامها) ، و (فض) مكان (فذ) .
(2/222)
________________________________________
والدَّعَةُ: الخفض في العيش والرّاحة. رجُلٌ مُتَّدع: صاحب دَعَةٍ وراحة. ونال فلان من المكارم وادعاً، أي: من غير أن تكلّف من نفسه مشقّة. يقال وَدُعَ يَوْدُعُ دَعَةً، واتَّدع تُدَعَة مثل اتَّهم تُهَمَة واتَّأد تُؤَدَة. قال «36» :
يا رُبَّ هيجا هي خيرٌ من دَعَه
والتَّوديعُ: أن تودّع ثوباً في صوان، أي في موضع لا تصل إليه ريح، ولا غبار. والمِيدَعُ: ثوب يُجْعل وقايةً لغيره، ويوصف به الثّوبُ المبتذَلُ أيضاً الذي يصان فيه، فيقال: ثوبٌ مِيدَعٌ، قال «37» :
طرحتُ أثوابيَ إلا الميدعا
والوداع: توديعُك أخاك في المسير. والوَداعُ: التَّرْك والقِلَى، وهو توديعُ الفِراق، والمصدر من كلٍّ: توديع قال «38» :
غداة غدٍ تودّع كلّ عين ... بها كُحُلٌ وكلّ يدٍ خضيبِ
وقوله تعالى: ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى
«39» أي: ما تَرَكَكَ. والمودوعُ: المودَّع. قال «40» :
إذا رأيت الغرب المودوعا
__________
(36) (لبيد) - ديوانه 340.
(37) لم نقف عليه.
(38) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(39) الضحى 3.
(40) لم نهتد إليه.
(2/223)
________________________________________
والعرب لا تقول: وَدَعتُهُ فأنا وادع. في معنى تركتُه فأنا تارك. ولكنّهم يقولون في الغابر: لم يدع، وفي الأمر: دعْه، وفي النّهي: لا تدعه، إلاّ أن يُضطّر الشّاعرُ، كما قال «40» :
وكانَ ما قدّموا لأنفُسِهِمْ ... أكْثَرَ نفعاً منَ الّذي وَدَعُوا
أي تركوا ... وقال الفرزدق «41» :
وعضّ زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحت أو مجلف
فمن قال: لم يدع، تفسيره، لم يترك، فإنّه يضمر في المسحت والمجلف ما يرفعه مثل الذي ونحوه، ومن روى: لم يُدَعْ في معنى: لم يُتْرَكُ فسبيلُه الرّفعُ بلا علّة، كقولك: لم يُضْرَبْ إلاّ زيدٌ، وكان قياسُه: لم يُودَعْ ولكنّ العربَ اجتمعتْ على حذف الواو فقالتْ: يَدَع، ولكنّكَ إذا جَهِلْتَ الفاعل تقول: لم يُودَعْ ولم يُوذَرْ وكذلك جميعُ ما كانَ مِثلَ يودع وجميع هذا الحدّ على ذلك. إلاّ أنّ العرب استخفّت في هذين الفعلين خاصّة لما دخل عليهما من العلّة التي وصفنا فقالوا: لم يُدَعْ ولم يُذَرْ في لغة، وسمعنا من فصحاء العرب من يقول: لم أُدَعْ وراءً، ولم أُذَرْ وراءً. والمُوادَعَةُ: شِبْهُ المُصالَحَة، وكذلك التَّوادُعْ. والوَديعةُ: ما تستودعه غيرَك ليحفظَه، وإذا قلت: أَوْدَعَ فلانٌ فلاناً شيئاً فمعناه: تحويل الوديعة إلى غيره:
وفي الحديث: ما تَقولُ في رجلٍ استُودِعَ وديعةً فأودَعَها غيرَه قال: عليه الضّمان.
وقول الله عزّ وجلّ: فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ «42» . يُقال: المستودَع: ما في الأرحام.
__________
(40) المحكم 2/ 238 واللسان والتاج، غير منسوب أيضا.
(41) ليس في ديوانه (صادر) . وهو في نزهة الألباء ص 20 (أبو الفضل) .
(42) الأنعام 98.
(2/224)
________________________________________
ووَدْعان: موضعٌ بالبادية. وإذا أمرت بالسكينةِ والوَداع قلت: تَوَدَّعْ، واتدع. ويقال: عليك بالمودوع من غير أن تجعلَ له فِعلاً ولا فاعلاً على جهةِ لفظِه، إنّما هو كقولك: المعسور والميسور، لا تقول: منه عسرت ولا يسرت. ووَدُعَ الرّجُلُ يَوْدُع وداعةً، وهو وادعٌ، أي: ساكن. والوَديعُ: الرَّجُلْ الساكن الهادىء ذو التَّدعة. ويقال: ذو وَداعةٍ. ووَدَاعة: من أسماء الرجال. والأودعُ: اسم من أسماء اليربوع.
يدع: الأَيْدَع: صبغ أحمر، وهو خشب البَقَّم. تقول: يَدَّعتُه [وأنا أُيَدِّعُهُ] «44» تَيْديعاً قال «45» :
فنحا لها بمُذَلَّقَيْنِ كأنّما ... بهما من النَّضْحِ المُجَدَّحِ أَيْدَعُ
__________
(44) زيادة من التهذيب 3/ 142 عن العين.
(45) (أبو ذؤيب) ديوان الهذليين 1/ 13.
(2/225)
________________________________________
باب العين والتاء و (واي) معهما ع ت و، ت وع، ت ي ع، تستعمل فقط
عتو: عتا عُتُوّاً وعِتِيّاً إذا استكبر فهو عاتٍ، والملك الجبار عاتٍ، وجبابرة عتاة. وتَعَتَّى فلانٌ، وتَعَتَّتْ فُلانة إذا لم تُطِعْ. قال العجاج «1» :
بأمره الأرض فما تعتَّتِ
أي: فما عَصَتْ «2»
توع: التَّوْعُ: كسرك لبا أو سمناً بكسرة خبز ترفعه بها. تقول: تُعْتُه فأنا أتوعُه توعاً.
تيع: التَّيْعُ: ما يسيل على الأرض من جمد إذا ذاب، ونحوه. وتاعَ الماء تيعا إذا تتيع على وجه الأرض، أي: انبسط في المكان الواسع فهو تائع
__________
(1) ديوانه 266 والرواية فيه: بإذنه الأرض وما تعتت
(2) جاء في النسخ بعد قوله: (فما عصت) ما يأتي: وتهته في الأمر إذا تعمق فيه قال: [والقائل (رؤبة) - ديوانه 165] :
بعد لَجَاجٍ لا يكادُ يَنْتَهي ... عَنِ التَّصابي وعن التعته
فحذفناه لأنه لا صلة له بهذا الباب إنما هو من باب العين والهاء والتاء معهما، وقد مر بنا في بابه ص 104 من الجزء الأول وما نظنه إلا من وهم النساخ.
(2/226)
________________________________________
مائِع. والرّجُلُ يَتَتَايَعُ في الأمر إذا بقي فيه. والبعير يَتَتايَعُ في مشيه إذا حرّك ألواحه حتى يكاد يتفكّكُ. والسكران يتتايع: يرمي بنفسه إذا لجّ وتهافت. والتَّتايُعْ: رميُك بنفسك في الشيء من غير ثبت. والتَّتَيُّعُ: القيء، وهو مُتَتَيِّعٌ. وقد تاع، إذا قاء، وأتاعه غيره، أي: قيّأه.
(2/227)
________________________________________
باب العين والظاء و (واي) معهما ع ظ ي، وع ظ، مستعملان
عظي: العَظايَةُ على خلقة سام أبرص، أو أُعَيظِم منهُ شيئاً، والذّكر يقال له اللحم غير أنه إذا لم تَرَ قوائمها ظَنَنْتَ أن رأسها رأسُ حيّةٍ. وتجمع: عَظاء، وثلاث عَظايات، والعَظاءَةُ: لغة فيها.
وعظ: العِظَةُ: الموعظة. وَعَظْتُ الرّجلَ أَعِظُهُ عِظَةً وموعظة: واتَّعَظَ: تقبّل العِظَةَ، وهو تذكيرُك إيّاه الخيرَ ونحوَه ممّا يرقُّ له قلبُهُ. ومن أمثالِهم المعروفة: لا تَعِظيني وتَعَظْعَظي، أي: اتَّعظي أنتِ ودَعي موعظتي.
(2/228)
________________________________________
باب العين والذال و (واي) معهما ع ذ ي، ع وذ، ذ ي ع مستعملات
عذي: العِذْيُ: موضع بالبادية. والعَذَاةُ: الأرضُ الطيّبةُ التربةِ الكريمةُ المنْبِتِ. قال «1» :
بأرضٍ هجان الترب وسمية الثرى ... عَذاةٍ نَأَتْ عنها المُلوحَةُ والبَحْرُ
والعِذْيُ: اسمٌ للموضِعِ الذي ينبت في الشّتاء والصّيف من غير سقيٍ. ويقال: العِذْيُ: الزّرع الذي لا يُسقَى إلاّ من المطر لبعده من المياه، الواحدة،: عَذاة. ويقال: العِذْي واحد وجمعُهُ: أَعْذاء.
عوذ: أعوذ بالله، أي: ألجأ إلى الله، عَوْذاً وعِياذا. ومعاذَ الله: معناه: أعوذُ بالله، ومنه: العَوْذَةُ، والتّعويذ. والمعاذة الّتي يُعَوَّذُ بها الإنسان من فَزَعٍ أو جُنون. وكلّ أنثى عائِذٌ إذا وضعت مدّة سبعةِ أيّامٍ، والجميع: عُوذ، من قَول لبيد «2» :
__________
(1) (ذو الرمة) - 1/ 575.
(2) ديوانه ص 299 وصدر البيت فيه:
والعين ساكنة على أطلائها
(2/229)
________________________________________
عُوذاً تَأَجَّلَ بالفَضاءِ بِهامُها
ذيع: الذَّيْعُ: إشاعةُ الأمر. أذعته فذاع. ورجل مِذياع مِشياعٌ لا يستطيع كتمانَ شيءٍ وقوم مذاييع، وأذعت به، الباء دخيل،! معناه: أذعته.
(2/230)
________________________________________
باب العين والثاء و (واي) معهما ع ث و، ع ث ي، وع ث، ع ي ث مستعملات
عثو: العَثا: لون إلى السّواد [مع كثرة شعر] «1» . والأَعْثَى: الكثير الشّعر. والأَعْثَى: الضبع الكبير، والأنثى: عَثْواء، وفي لغة: عثياء والواو أصوب. والجميعُ: العُثْوُ، ويقال: العُثْيُ، والعِثْيانُ: اسم الذَّكر من الضِّباع.
عثي: عَثِيَ يَعْثَى في الأرض عِثيّاً وعَثَياناً: أفسد.
وعث: الوَعْثُ من الرّمل: ما غابتْ فيه القوائمُ. ومنه اشتُقَّ وَعْثاء السَّفَر، يعني: المشقّة. وأَوْعَثَ القومُ: وقعوا في الوَعْثِ. قال «2» :
وَعْثاً وُعُوراً وقِفافاً كُبَّسا
عيث: عاثَ يَعيثُ عيثاً، أي: أَسْرَعَ في الفسادِ. تقول: إنّك لأَعْيَثُ في المال
__________
(1) زيادة من المحكم لتوضيح الترجمة.
(2) (العجاح) ديوانه 128.
(2/231)
________________________________________
من السّوس في الصَّيف. والذِّئْبُ يعيث في الغنم فلا يأخذ شيئاً إلاّ قتله. قال «3» :
والذّئبُ وسْطَ غنَمي يَعيثُ
والتَّعيِيثُ: طلبُ الأعمى الشَّيء، وطلبُ الرّجُلِ الشّيء في الظُّلْمة. والتَّعييثُ: إدخالُ الرّجلِ يدَهُ في الكنانةِ يَطْلُبُ سَهماً. قال أبو ذويب «4» :
فَعَيَّثَ في الكِنانَةِ يَرْجِعُ
__________
(3) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(4) ديوان الهذليين 1/ 9 والبيت هو:
فبدا له أقراب هذا رائغا ... عجلا فَعَيَّثَ في الكِنانَةِ يَرْجِعُ
(2/232)
________________________________________
باب العين والرّاء والواو معهما ع ر و، ع ر ي، ع ور، ع ي ر، ر ع و، ر ع ي، وع ر، ر وع، ر ي ع، ور ع، ي ع ر
عرو: عري: عراه أمرٌ يَعْرُوه عَرْواً إذا غشيه وأصابه، يقال: عراه البرد، وعَرَتْهُ الحُمَّى، وهي تَعْروه إذا جاءته بنافض، وأخذته الحُمَّى بعُرَوائها. وعُرِيَ الرّجلُ فهو مَعْروّ، واعتراه الهمّ. عام في كل شيء، حتى يقال: الدّلف يعتري الملاحة.
ويقال: ما مِنْ مؤمنٍ إلا وله ذَنْبٌ يعتريه
قال أعرابيّ إذا طلع السّماك فعند ذلك يعروك ما عداك من البرد الذي يغشاك. وعَرِيَ فلانٌ عِرْوَةً وعِرْيَةً شديدة وعُرْيا فهو عُريانٌ والمرأة عُريانة، ورجل عارٍ وامرأة عارية. والعُريان من الخيل: فرس مقلّص طويل القوائم. والعُريان من الرّمل ما ليس عليه شجر. وفرسٌ عُرْيٌ: ليس على ظهره شيءٌ، وأفراس أَعْراء، ولا يقال: رجلٌ عُرْيٌ، واعْرَوْرَيْتُ الفَرَسَ: ركبته عُرْياً، ولم يجىء افعوعل مجاوز غير هذا. والعَراء: الأرضُ الفضاءُ التي لا يُسْتَتَرُ فيها بشيء، ويجمع: أَعْراء، وثلاثة أَعْرِيَةٍ والعرب تُذكّره فتقول: انتهينا إلى عَراءٍ من الأرضِ واسعٍ
(2/233)
________________________________________
باردٍ، ولا يُجْعَلُ نعتاً للأرض. وأعراءُ الأرض: ما ظهر من مُتُونها. قال «1» :
وبلدٍ عاريةٍ أَعْراؤُهُ
وقال «2» :
أو مُجْنَ عنه عُرِيَتْ أَعْراؤُهُ
واعْرَوْرَى السّرابُ ظهورَ الآكامِ إذا ماج عنها فأعراها. ماج عنها: ذهب عنها، ويقال: بل إذا علا ظهورها. والعَراءُ: كلّ شيء أَعْرَيْتَهُ من سُتْرته، تقول: استُرْهُ من العَراء، ويُقال: لا يُعَرَّى فلانٌ من هذا الأمر أي: لا يُخَلَّصُ، ولا يُعَرَّى من الموت أحدٌ، أي: لا يُخَلَّص. قال «3» :
وأحْداثُ دهرٍ ما يُعَرَّى بَلاؤُها
والعَرِىّ: الريح الباردة. [يقال] : ريحٌ عَرِيَّةٌ، ومساءٌ عَرِيٌّ، وليلةٌ عريّة ذات ريح باردة قال ذو الرمة «4» :
وهل أحطِبَنَّ القوم وهي عريَّةٌ ... أصول ألاءٍ في ثَرَى عمدٍ جَعْدِ
والعُرْوةُ: عروةُ الدلو وعروة المزادة وعروة الكوز. والجمع: عُرَى. والنّخلة العريّة: التي عُزِلَتْ عن المساومة لحرمة أو لِهِبَةٍ إذا أينع ثمر النَّخل، ويجمع: عَرايا.
وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخّص في العَرايا «5» .
وعرّيت الشيء: اتخذت له عروة كالدلو ونحوه.
__________
(1) التهذيب 3/ 159 واللسان (عرا) غير منسوب أيضا.
(2) اللسان (عرا) غير منسوب أيضا. وفي (س) : أو لجن. وفي اللسان: أو مجز.
(3) لم نهتد إليه.
(4) ليس في ديوانه، ولم نقف عليه فيما بين أيدينا من مصادر.
(5) التهذيب 3/ 155.
(2/234)
________________________________________
وجارية حسنة المُعَرَّى، أي: [حسنة عند تجريدها من ثيابها] «6» والجميع: المعاري: والمعاري مبادىء رءوس العظام حيث تعرّى العظام عن اللحم. ويُقال: المعاري: اليدان والرجلان والوجه لأنّه بادٍ أبداً. قال أبو كبير الهُذَليّ يصف قوماً ضربوا على أيديهم وأرجلهم حتى سقطوا «7» :
متكوّرين على المعاري بينهم ... ضرب كتعطاط المزَاد الأنجل
والعُرْوَةُ من النّبات: ما تبقَى له خُضْرةٌ في الشتاء تتعلّقُ بها الإبلُ حتى تُدْرِكَ الرّبيعَ. وهي العُلْقَة. قال «8» :
خَلَعَ الملوكَ وآب تحتَ لوائِهِ ... شَجَرُ العُرَى وعُراعِرُ الأقوام
ويقال: العُرْوة: الشّجر الملتفّ الذي تَشْتُو فيه الإبلْ فتأكل منه، وتبرك في أَذْرائه.
عور: عير: عارتِ العَيْنُ تَعار عَوَاراً، وعَوِرَتْ أيضاً، واعْوَرَّتْ. يعني ذهاب البصر [منها] . قال «9» :
ورُبّة سائلٍ عنّي حفيٍّ ... أعارت عينه أم لم تعارا
والعُوَّارُ: ضربٌ من الخطاطيف، أسود طويل الجناحين.
__________
(6) من التهذيب 3/ 160 عن العين. أما عبارة النسخ فمضطربة.
(7) ديوان الهذليين 2/ 96.
(8) (المهلهل) التهذيب 3/ 159. المحكم 2/ 244.
(9) التهذيب 3/ 170 غير منسوب أيضا، ونسب ابن بري فيما يروي اللسان (عور) إلى (عمرو بن أحمر الباهلي) .
(2/235)
________________________________________
والعُوَّارُ: الرّجُلُ الجبانُ السّريعُ الفِرار، وجمعُه عواوير. قال «10» :
غيرُ ميلٍ ولا عواويرَ في الهيجا ... ولا عُزَّلٍ ولا أكْفالِ
والعرب تُسمّي الغُرابَ أعور، وتصيح به فتقول: عوير عوير. قال «11» :
يطير عُوَيْر أن أنوّه باسمه ... عُوَيْر............... .....
وسمّي أعور لحدّة بصره، كما يكنّى الأَعْمَى بالبصير، ويقال: بل سمّي [أعور] لأنّ حدقته سوداء. قال «12» :
وصحاحُ العيونِ يُدْعَوْنَ عُورا
ويقال: انظر إلى عينه العَوْراء، ولا يقال: العمياء، لأنّ العَوَرَ لا يكون إلاّ في إحدى العينين، يقال: اعورّت عينُه، ويخفف فيقال: عُوِرَتْ، ويقال: عُرْت عينه، وأعْوَرَ الله عَيْنَ فلان. والنعت: أَعْوَرُ وعَوْراءُ، والعَوْراء: الكلمة تَهْوِي في غيرِ عقلٍ ولا رُشْدٍ. قال «13» :
ولا تنطق العوراء في القومِ سادراً ... فإنّ لها فاعلمْ من الله واعيا
ويقال: العَوْراء: الكلمةُ القبيحةُ الّتي يمتعضُ منها الرجال ويَغضبون. قال كعب بن سعد الغنويّ «14» :
وعَوْراءَ قد قيلت فلم ألتفِتْ لها ... وما الكَلِمُ العُوْراُن لي بقتول
__________
(10) الأعشى- ديوانه ص 11.
(11) لم نهتد إليه.
(12) التهذيب 3/ 171 واللسان (عور) .
(13) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(14) لسان العرب (عور) ، المحكم 2/ 247 غير منسوب.
(2/236)
________________________________________
ودجلة العَوْراء بالعراق بمَيْسان. والعُوارُ: خَرْقٌ أو شَقٌّ يكون في الثَّوب. والعَوْرَة: سوءة الإنسان، وكلّ أمرٍ يُسْتَحْيَ منه فهو عَوْرة. قال «15» :
في أناسٍ حافظي عَوْراتِهم
وثلاثُ ساعاتٍ في الليلِ والنَّهارِ هنَّ عَوْراتٌ، أمَرَ الله الولدان والخدم ألا يدخلوا إلا بتسليم: ساعة قبلَ صلاةِ الفَجْر، وساعة عندَ نِصْفِ النَّهار، وساعة بعدَ صلاةِ العشاء الآخرة.
والعَوْرةُ في الثّغور والحروب والمساكن: خَلَلٌ يُتخوَّفُ منه القَتْل. وقوله عزّ وجلّ: إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ
«16» . أي: ليستْ بحريزة، ويقرأ عَوِرَة بمعناه. [ومن قرأ: عَوِرة. ذكّر وأنّث. ومن قرأ: عَوْرة قال في التّذكير والتّأنيث والجمع (عَوْرة) كالمصدر. كقولك: رجل صومٌ وامرأة صوم ونسوةٌ صَوْمٌ ورجالٌ صوم، وكذلك قياس العَوْرة: والعَوَرُ: تركُ الحقّ. قال العجاج «17» :
وَعَوَّرَ الرَّحمنُ مَنْ وَلَّى العَوَر
ويقال: تردُ على فلانٍ عائرة عين من المال وعائرة عينين، أي: ترد عليه إبلٌ كثيرة كأنّها من كثرتها تملأ العينين، حتى تكاد تَعُورها. وسلكت مفازة فما رأيت فيها عائِرَ عَيْنٍ، [أي: أحداً يَطْرِفُ العينَ فَيَعُوُرها] «18» . وعَوَّرَ عينَ الرَّكِيَّة [أَفْسَدها حتى نضبَ الماء] «19» .
__________
(15) لم نهتد إليه.
(16) الأحزاب 13.
(17) ديوانه ص 4.
(18) من المحكم 2/ 247 لتوضيح المعنى.
(19) كذلك.
(2/237)
________________________________________
وعُوَيْر: اسم موضعٍ بالبادية. وسَهْمٌ عائِرٌ: لا يُدرَى من أينَ أتَى «20» . والعَيْرُ: الحمار الأهليّ والوحشيّ. والجمع أعيار، والمعيوراء ممدوداً: جماعة من العَيْر، وثلاث كلمات جِئْنَ ممدوداتٍ: المعيوراء والمعلوجاء والمشيوخاء على مَفْعُولاء، ويقولون: مَشْيَخَة، أي مَفْعَلَة ولم يجمعوا مثل هذا. والعَيْر: العظم الباقي في وسط الكتف، والجميع: العِيَرة. وعَيْرُ النّعل: وسطه. قال «21» :
فصادف سَهمُه أحجارَ قُفٍّ ... كسرْنَ العَيْرَ منه والغِرارا
والعَيْرَ: جبلٌ بالمدينة. والعَيْرُ: اسم موضعٍ كان خِصباً فغيَّره الدهر فأقفره، وكانتِ العربُ تَستوحِشُهُ. قال «22» :
وواد كجوف العير قفر مَضِلّةٍ ... قطعت بسامٍ ساهمِ الوجْهِ حسّان
ولو رأيت في صخرة نتوء، حرفاً ناتئاً خلقةً كان ذلك عَيْراً له. والعِيارُ: فِعْلُ الفرسِ العائرِ، أو الكلبِ العائرِ عارَ يَعِيرُ عِياراً وهو ذهابه كأنّه مُنْفَلِتٌ من صاحبه. وقصيدة عائرة: سائرة. ويقال: ما قالت العرب بيتاً أَعْيَرَ من قول شاعر هذا البيت:
ومن يلقَ خيراً يحمَدِ الناسُ أمرَه ... ومن يغوِ لا يَعْدَمْ على الغي لائما
__________
(20) من قوله وقوله عز وجل إلى قوله من أين أتى من (س) أما (ص) و (ط) فقد سقط النص منهما.
(21) (الراعي) اللسان (عير) .
(22) (امرؤ القيس) - ديوانه ص 92، اللسان (عير) . والبيت في الأصول:
وواد كجوف العير قفر قطعته ... به الذئب يعوي كالخليع المعيل
ويبدو أنه ملفق، فليس في ديوانه من هذا البحر والروي مثل هذا البيت.
(2/238)
________________________________________
والعارُ: كلّ شيء لزم به سُبّة أو عَيْب. تقول: هو عليه عارٌ وشَنارٌ. والفعل: التّعيير، والله يُغَيِّر ولا يُعَيِّر. والعارِيَّةُ: ما استعرت من شيء، سمّيت به، لأنّها عارٌ على من طلبها، يقال: هم يتعاورون من جيرانِهم الماعُونَ والأمتعة. ويقال: العارِيَّة من المعاوَرَة والمناوَلَة. يتعاورون: يأخُذونَ ويُعطُون. قال ذو الرّمة «23» :
وسِقْطٍ كعَيْنِ الديك عاورت صحبتي ... أباها وهيّأنا لموقِعها وَكْرا
والعيار: ما عايرت به المكاييل. والعيار صحيح وافر تام. عايَرْتُه. أي: سوّيته عليه فهو المِعْيار والعيار. وعيّرتُ الدّنانيرَ تعييراً، إذا ألقيت ديناراً فتُوازِنُ به ديناراً ديناراً. والعِيار والمِعيار لا يقال إلا في الكَيْل والوَزْن. وتعاوَرَ القوم فلاناً فاعتوروه ضرباً، أي: تعاونوا فكلّما كفّ واحد ضرب الآخر، وهو عامّ في كلّ شيء. وتعاورتِ الرّياحُ رسماً حتى عفّته، أي: تواظبت عليه. قال «24» :
دِمنةٌ قفرة تعاورها الصيف ... بريحَيْن من صَباً وشمالِ
والعائر: غَمَصَةٌ تَمُضُّ العينَ كأنّما فيها قذى وهو العُوَّار. قالت الخنساء «25» :
قذًى بعينك أم بالعينِ عُوَّار
__________
(23) ديوانه 3/ 1426 والرواية فيه: عاورت صاحبي.
(24) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(25) ديوانها ص 47 وعجز البيت:
أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار
والبيت مطلع القصيدة.
(2/239)
________________________________________
وهي عائرة، أي ذات عُوَّار، ولا يقال في هذا المعنَى: عارتْ، إنّما هو كقولك: دارِعٌ ورامح، ولا يقال: دَرَعَ، ولا رَمَحَ. ويقال: العائرة: بَثْرَة في جفن العين الأسفل. ويقال: عارت عينه من حزن أو غيره، قال كثيّر:
بعينٍ مُعَنّاةٍ بعزّةَ لم يَزَلْ ... بها منذُ ما لم تلقَ عزّةَ عائرُ
رعو: رعي: ارْعَوَى فلانٌ عن الجهْلِ ارعِواءً حسناً، ورَعْوَى حسنة وهو نزوعه عن الجهل وحسن رجوعه. قال «26» :
إذا ارعَوى عاد إلى جهله ... كذي الضنى عاد إلى نكسه
ورعَى يرعَى رَعْياً. والرّعيُ: الكَلأ. والرّاعي يَرْعاها رعايةً إذا ساسَها وسَرَحَها. وكلُّ من وليَ من قومٍ أمراً فهو راعِيهم. والقوم رَعيّتُهُ. والرّاعي: السّائسُ، والمَرْعيُّ: المَسُوس. والجميع: الرِّعاء مهموز على فِعالٍ رواية عن العرب قد أجمَعَتْ عليه دونَ ما سواه. ويجوز على قياس أمثاله: راعٍ ورُعاة مثل داعٍ ودُعاة. قال «27» :
فليس فِعْلٌ مثلَ فعلي ولا المرعي ... في الأقْوامِ كالرّاعي
والإبل ترعى وترتعي.
__________
(26) لم نهتد إلى القائل.
(27) (أبو قيس الأسلت) . التهذيب 3/ 162 واللسان (رعي) والرواية فيهما: ليس قطا مثل قطي....
(2/240)
________________________________________
وراعيتُ أُراعي، معناه: نظرت إلى ما يصير [إليه] أمري. وفي معناه: يجوز: رعيت النجوم، قالت الخنساء «28» :
أرعَى النُّجومَ وما كُلِّفْتُ رِعْيَتَها ... وتارة أَتَغشَّى فَضْلَ أَطْماري
رعيت النّجومَ، أي: رَقَبْتُها، وفلان يَرْعَى فلاناً إذا تعاهد أمرَه. قال القطامي «29» :
ونحن رعية وهم رعاة ... ولولا رعيهم شنع الشَّنارُ
والرّعيان: الرّعاة. والمَرْعَى: الرّعي أي المصدر، والموضِع. واسْتَرعيتُه: ولّيتُه أمراً يَرْعاه. وإبل راعية، وتُجمَعُ رَواعي. والإرعاء: الإبقاء على أخيك. وأَرْعَى فلانٌ إلى فلانٍ، أي: استمع، وروي عن الحسن: راعنا بالتنوين وبغير التنوين ويُفَسَّرُ في باب (رعن) . ورجل تِرْعِيَّة: لم تزل صنعته وصنعة آبائه الرِّعاية. قال «30» :
يسوقها تِرْعِيَّةٌ جافٍ فضل
وأَرْعيتُ فلاناً، أي أعطيتُه رِعْيةً يرعاها.
وعر: الوعْرُ: المكانُ الصُّلْب وَعُرَ يَوْعُر ووَعَرَ يَعِرُ وَعْراً ووُعوراً والجمع: وُعُورٌ. وتوعّر المكانُ. وفلانٌ وَعْرُ المعروف: قليلُه. قال الفرزدق «31» :
وَفَتْ ثمّ أدّتْ لا قليلا ولا وعرا
__________
(28) ديوانها ص 58.
(29) ديوانه ص 142.
(30) لم نهتد إلى القائل.
(31) ديوانه ص 323، وصدر البيت فيه:
إليكم: وتلقونا بني كل حرة
(2/241)
________________________________________
أي: وَلَدَتْ فأنجبتْ، وأكثرت، يعني: أمّ تميم. واستوعر القومُ طريقَهم. وأوعروا، أي، وقعوا في الوَعْر.
روع: الرَّوْعُ: الفزع. راعني هذا الأمرُ يَرُوعني، وارتَعْت له، وروَّعَني فتروَّعْت منه. وكذلك كلُّ شيء يَروعُك منه جمالٌ أو كثرةٌ. تقول: راعني فهو رائعٌ. وفرس رائع: كريم يروعك حسنُه، وفرسٌ رائع بيّن الرَّوْعة. قال «32» :
رائعةُ تحمل شيخاً رائعاً ... مجرَّباً قد شهِدَ الوقائعا
والأرْوَعُ من الرّجال: من له جسم وجهارة وفضلٌ وسُودَد، وهو بيّنُ الرَّوَع. والقياس في اشتقاق الفعل منه: رَوِعَ يَرْوَعُ رَوَعاً. ورُوعُ القلب: ذِهْنُه وخَلَدُه. يُقال: رجع إليه رُوعُه ورُواعُهُ إذا ذهب قلبه ثم ثاب إليه.
ورع: الوَرَعُ: شدّةُ التَحَرَّجِ. ورّعْهُ: اكفُفْهُ كفّاً. ورجلٌ وَرِعٌ متورَعٌ. [إذا كان متحرجاً] «33» . والوَرَعُ: الجبان، ورُعَ يَوْرُعُ وَراعةً. ومن التّحرّج: وَرِعَ يَرِعُ رِعَةً. وسمّي الجبانُ وَرَعاً لإحجامه ونكوصه، ومنه يقال: وَدَّعْتُ الإبلَ عن الحوض، إذا رَدَدْتُها فارتدت.
وفي
__________
(32) المحكم: 2/ 250 واللسان (ووع) .
(33) زيادة من التهذيب لتوضيح المعنى.
(2/242)
________________________________________
الحديث: ورّعوا اللّص ولا تُراعوه «34» .
أي ردّوه بتعرّضٍ له، أو بثنية، ولا تنتظروا ما يكون من أمره. قال «35» :
وقال الذي يرجو العُلالَة وَرِّعُوا ... عن الماء لا يطرق وهن طوارِقُهْ
يعر: اليَعْرُ واليَعْرَةُ: الشّاة تُشَدُّ عندَ زُبْيَة الذّئب. واليُعارُ: صوت من أصوات الشّاء شديد. يَعَرَتْ تَيْعَرُ يُعاراً. قال «36» :
تيوساً بالشَّظيّ لها يُعار
واليَعور «37» : الشّاة التي تبولُ على حالِبها، وتُفْسِدُ اللَّبنَ «38» .
ريع: الرَّيْع: فضل كلّ شيء على أصله، نحو الدّقيق وهو فضلُهُ على كَيْلِ البُرّ، ورَيْعُ البَذْرِ: فضل ما يَخْرُجُ من النُّزْلِ على أصلِ البَذْر. والرَّيْع: رَيْع الدّرع، أي: فضل كُمَتِها على أطرافِ الأنامل. قال قيس بن الخطيم «39» :
مُضَاعَفَةً يَغْشَى الأناملَ رَيْعُها ... كأن قَتِيرَيْها عيونُ الجنادبِ
__________
(34) التهذيب 3/ 175 وروايته فيه ورع اللص ولا تراعه.
(35) (الراعي) المحكم 2/ 252 واللسان (ورع) .
(36) اللسان (يعر) غير منسوب أيضا وصدره فيه:
وأما أشجع الخنثى فولوا
(37) قال الجوهري: هذا الحرف هكذا جاء. وقال الأزهري: شاة يعور إذا كانت كثيرة اليعار.
(38) ترجمة الكلمات الثلاث الأخيرة من (س) فقد سقطت من (ص) و (ط) .
(39) ديوانه ص 82. والرواية فيه: فضلها.
(2/243)
________________________________________
وراع يَرِيعُ رَيْعاً، أي: رجع في كلّ شيء. والإبل إذا تفرّقت فصاح بها الرّاعي راعت إليه، أي: رجعت، قال «40» :
تَرِيعُ إلى صوتِ المُهيبِ وتتّقي
ورَيْعانُ كلِّ شيء أوّلُه وأفضلُه. ورَيْعانُ الشَّباب صدرُه. ورَيْعانُ المطر أوّلُهُ. والرِّيعُ: هو السّبيل سُلِكَ أو لم يُسْلَكْ، قال «41» :
كظهْرِ التُّرس ليس بهنّ رِيعُ
__________
(40) (طرفة) ديوانه ص وعجز البيت فيه:
بذي خصل روعات أكلف ملبد
(41) لسان العرب (ريع) منقوص وغير منسوب أيضا.
(2/244)
________________________________________
باب العين واللام و (واي) معهما ع ل و، ع ول، ع ي ل، ل ع و، وع ل، ل وع، ل ي ع، ول ع، ي ع ل مستعملات
علو: العُلُوٌّ للهِ سبحانَه وتَعَالَى عن كلِّ شيء فهو أعلى وأعظم مما يُثْنَى عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والعلو: أصل البناء. ومنه العَلاءُ والعُلُوّ، فالعَلاءُ الرِّفْعَةُ، والعُلُوُّ العظمة والتجبّر. [يقال] : علا مَلِكٌ في الأرض [أي: طغَى وتعظّم] . قال الله عزّ وجلّ: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ «1» . ورجلٌ عالي الكعب، أي: شريف. قال «2» :
لمّا عَلا كَعْبُكَ لي عَلِيتُ
[وتقول] لكلّ شيء علا: علا يَعْلو علوا، و [تقول] في الرِّفعة والشرف: عَلِيَ يَعْلى عَلاءً. والعَلْياء: رأسُ كلّ جَبَلٍ مُشْرِف. قال «3» :
تحملن بالعلياء من فوق جرثم
__________
(1) القصص 4.
(2) (رؤبة) ديوانه ص 25.
(3) (زهير) ديوانه ص 9 وهو من معلقته، وصدر البيت:
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن
(2/245)
________________________________________
والعالية: القناة المستقيمة. والجمع: العوالي. [ويُسمّى أعلى القناة: العالية. وأسفلُها: السّافِلَة] «4» . والمَعْلاةُ: كَسْبُ الشَّرَفِ من المعالي. والعالية من محلّة العرب: الحجاز وما يليها، والنّسبة إليها: عُلْويّ. وعُلْوُ كلّ شيء أعلاه تَرْفَع العَيْنَ وتخفِضُ. وذهب في السّماء عُلْواً وفي الأرض سُفْلاً. والعُلْوُ والسُّفْلُ: أعلى كلّ شيء وأسفله. و [يقال] : سِفْلُ الدّارِ وعِلْوُها، وسُفْلُها وعُلْوُها. وفلان من عِلْية الناس، أي: من أهل الشَّرَفْ. وهؤلاء عِلْيَةُ قومهم. مكسورة العين، على فِعْلَة خفيفة. والعُلِّيَّة: الغُرفة على بناء حُرّيّة، في التّصريف على: فُعُّولة. وعاليةُ الوادي: أعلاه، وسافلتُه: أسفلُه، وفي كلّ شيء كذلك، عُلْيا مضر، وسُفْلى مضر. إذا قلت: عُليا قلت: سُفْلَى، وإذا قلت: عُلْو قلت: سفل. والسماوات العُلَى. الواحدة عُلْيا. وتِعْلَى: اسم امرأة. قال «5» :
سلامُ اللهِ يا تِعْلَى ... عليكِ، الملك الأَعْلَى
والثّنايا العُلْيا، والثّنايا السُّفْلَى. والله تبارَكَ وتعالَى هو العليّ العالي المتعالي ذو العُلَى والمعالي تعالَى عمّا يقولُ الظالمون علوا كبيرا. و (على) : صفة من الصّفات، وللعرب فيه ثلاث لغات: على زيدٍ مال، وعليك مال. ويقال: علاك، أي: عليك. ويقولون: كنت على
__________
(4) من التهذيب 3/ 187 عن العين.
(5) لم نقف عليه.
(2/246)
________________________________________
السّطح، وكنت في أعلَى السّطح. ويقولون: في موضع أعلى عالٍ، وفي موضع أعلى علٍ. قال أبو النجم «6» :
أقبُّ من تحتُ عريضٌ من علِ
وقد ترفعُه العربُ في الغاية فيقولون: من علُ. قال عبد الله بن رَواحة:
شهِدْتُ فلم أكذبْ بأنّ محمّداً ... رسول الذي سوّى السماوات من علُ
ويقال: اعْلُ عن مَجْلِسِك. فإذا قام فقد علا عنه. وتعلّتِ المرأة فهي تتعلَّى إذا طَهُرت من نفاسها. وتقول: يا رجل تعالَهْ، الهاءُ صِلَة، فإذا وصلتَ طرحتَ الهاء. فتقول: تعالَ يا رجلُ، وتعاليا وتعالَوْا، وأماتوا هذا الفعل سوى النّداء. وعَلْوَى: اسم فرس كان في الجاهلية. والعلاوة: رأس الجمل وعُنُقه. والعلاوة: رأس الرّجل وعُنُقه. والعلاوة: ما يحمل على البعير والحمار فوق العِدْلينِ بعد تمام الوقر، والجميع: علاوات. وتقول: أعطيك ألفاً وديناراً علاوة. والجمع العَلاوَى على وزن فَعالَى، كالهِراوَة والهَراوَى.
وقال أبو سفيان: اعلُ هُبَل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: الله أَعْلَى وأَجَلّ.
وعَلِيّ: اسم على فعيل، إذا نُسِبَ إليه قيل: عَلَويّ. والمُعَلَّى: القِدْحُ الأوّل يخرج في الميسر. وكلّ من قهر امرأً أو عدوّاً فقد علا واعتلاه واستعلى عليه. والفَرَسُ إذا جرى في الرّهان وبلغ الغاية، قيل: استعلَى على الغاية واستولى. ويقال: عُلْوان الكتاب، وأظنه غلطاً، وإنّما هو عُنوان. والعِليانْ: الذّكر من الضّباع. والبعير الضخم أيضا.
__________
(6) اللسان (علا) .
(2/247)
________________________________________
وعِلِّيِّينَ: جماعة علِّيٍّ في السماء السابعة يُصْعَدُ إليه بأرواحِ المؤمنين. والعَلاةُ: النّاقة الصُّلبة تُشَبّهُ بالعَلاة وهي السّندان.
عول: العَوْلُ: ارتفاع الحساب في الفرائض. والعالةُ: الفريضة. تَعُول عَوْلاً. ويقالُ للفارض: اعلُ الفريضة. والعَوْلُ: الميل في الحكم، أي: الجَوْر. والعَوْل: كلّ أمرٍ عالكَ. قالت الخنساء «7» :
يُكلّفُه القومُ ما عالَهُمْ ... وإن كان أصْغَرَهُمْ مَولدا
والعَوْلة من العَويل، وهو البكاء. أعْوَلَتِ المرأة إعوالاً، وهو شدّة صياحِها عند بكاء أو مكروه نزل بها. والعَوْل أيضاً: المُعَوَّل. عَوَّلَ عليه: اقتصر عليه، ولم يختر عليه. وعوّلتُ عليه: استعنتُ به، ومعناه: صيّرتُ أمري إليه. وتقول: أبفلانٍ تعوّل عليّ وبكذا إذا نازعك في أمرٍ يتطاول عليك. قال «8» :
وليس على دهرٍ لشيءٍ مُعَوَّل
وقال «9» :
عندي ولا في القومِ من مُعوّل
والعَوْل: قُوتُ العِيال. هو يَعُولهم عولاً. والمِعْوَل: حديدة ينقر بها الجبال، قال «10» :
أنيابها كالمعاول
__________
(7) ديوانها ص 30. وما في الأصول:
ويكفي العشير ما عالها.
(8) لم نهتد إليه.
(9) لم نهتد إليه.
(10) لم نهتد إليه.
(2/248)
________________________________________
عيل: العيالُ: جماعة عيِّل. ورجل مُعيل ومُعَيَّل: كثير العيال. قال «11» :
ووادٍ كجوفِ العير قفر قطعته ... به الذئب يعوي كالخليع المعيل
والعَيلة الحاجة. عال الرّجل يعيل عَيلة إذا احتاج
وفي الحديث: ما عال مقتصد ولا يَعيل «12»
، وقال «13» :
من عال يوماً بعدها فلا انجبر ... ولا سقى الماء ولا رعى الشَّجر
عَيْلان: اسم أبي قيس بن عَيْلان بن مُضَر.
لعو: كلبة لَعْوَة، وامرأة لَعْوَة، وذئبة لَعْوَة، أي: حريصة تقاتل عمَّا تأكل. والجمع: اللعوات واللعاء. وتيعى العسلُ ونحوه: تعقّد. لعاً: كلمة تقال عند العثرة. قال الأخطل «14» :
ولا هدى اللهُ قيساً من ضَلالتها ... ولا لَعاً ذَكْوانَ إن عَثَرُوا
وعل: الوَعِلُ وجمعه الأوعال، وهي الشّاءُ الجبلية. وقد استوعلتْ في الجبال، ويقال: وَعِل ووَعْل. ولغة للعرب: وُعِل بضمّ الواو وكسر العين من
__________
(11) الصدر (لامرىء القيس) وهو في ديوانه 92 أما عجز البيت فليس في ديوانه وقد تقدم ذلك عند ترجمة (العير) .
(12) لسان العرب (عيل) .
(13) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز غير الأصول.
(14) ديوانه 1/ 205.
(2/249)
________________________________________
غير أن يكونَ ذلك مُطّرِداً، لأنه لم يجيء في كلامهم: فُعِل اسماً إلا دُئل، وهو شاذّ. والوَعْل- خفيف- بمنزلة بُدّ، كقولك: ما بدٌّ من ذلك ولا وَعْل، وِعالٌ: اسم جبل. وَعْلَة: اسم رجل.
لوع: اللَّوْعة: حُرقة يجدها الرّجل من الحُزْنِ والوَجْد. ورجل هاعٌ لاع، أي: حريص سيىء الخلق، والفعل من هذا: لاع يلوعُ لَوْعاً ولُووعاً. ويُجْمَعُ على الألواع واللاّعين. والمرأة اللاّعة، ويقال: اللاّعة- بلامين-: التي تُغازِلُك ولا تُمكِّنُك. قال أبو خيرة: هي اللاّعة بهذا المعنَى، والأوّل قول أبي الدُّقيش.
ليع: لاعني الهمُّ والحزنُ فالْتَعْتُ التياعاً: أي: أَحْزَنَني فَحَزِنْت.
ولع: الوَلَعُ: نفس الولوع. تقول: أُولِع بكذا وَلُوعاً وإيلاعاً إذا لجّ، وتقول: وَلِعَ يَوْلَعُ وَلَعاً. ورجُلٌ ولِعٌ ووَلُوعٌ ولاعةٌ. والمُوَلَّعُ: الذي أصابه لُمَعٌ من برصٍ في وجهه والله ولَّع وجهه، أي: بَرَّصَهُ. قال: «15»
كأنّها في الجلد تَوْليعُ البهق
__________
(15) (رؤبة) ديوانه 104.
(2/250)
________________________________________
والوليع: الطلع ما دام في قِيقاتِه كأنّه اللّؤلؤ في شدّة بياضه، الواحدة: وَلِيعَة. قال «16» :
تَبَسَّمُ عن نيّر كالوليع ... يُشقِّقُ عنهُ الرّقاةُ الجُفوفا
الجفوف: القشور. والرُّقاة الذين يَرْتَقون النَّخْل.
يعل: اليَعْلول واليَعاليل من السَّحاب: قِطَعٌ بيضٌ. قال «17» :
تجلو الرياح القذى عنه وأَفْرَطَةُ ... من صَوْبِ ساريةٍ بيض يعاليل
__________
(16) التهذيب 3/ 200.
(17) (كعب بن زهير) ديوانه 7.
(2/251)
________________________________________
باب العين والنون و (واي) معهما ع ن و، ع ن ي، ع ون، ع ي ن، ن ع و، ن ع ي، وع ن، ن وع، ن ي ع مستعملات
عنو: العاني: الأسير، أقرّ بالعُنُوِّ والعَناء وهما مصدران قال «1» :
ابني أمية إني عنكما عاني ... وما العنا غير أني مرعش فاني
قوله: عانٍ، أي: ماسور، أي ليس عُنُوّي إلاّ أنّي مرعش. ويقال للأسير: عنا يعنو وعَنِيَ يَعْنَى إذا نشب في الإسار. قال «2» :
ولا يُفكّ طَوالَ الدّهر عانيها
وتقول: أَعْنُوه، أي أَبْقُوهُ في الإسار. والعاني: الخاضع المُتَذَلِّل. قال الله عزّ وجلّ: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ «3» وهي تَعْنو عُنُوّاً. وجئت إليك عانياً: أي: خاضعاً كالأسير المرتهن بذنوبه. والعنوة: القهر. أخذها عنوة، أي: قهراً بالسّيف. والعاني مأخوذ من العنوة، أي: الذلة.
__________
(1) لم نهتد إليه في غير الأصول.
(2) لم نقف عليه في غير الأصول.
(3) طه 111.
(2/252)
________________________________________
والعُنوان: عُنوان الكتاب، وفيه ثلاث لغات: عَنْوَنْتُ، وعنّنْتُ وعَيَّنْتُ، وعنوان الكتاب مُشْتَقٌّ من المعنى، يقال.
عني: عناني الأمر يَعْنيني عِناية فأنا مَعنيّ به. واعتنيت بأمره. وعنت أمور واعتنّت، أي: نزلت ووقعت. قال رؤبة «4» :
إني وقد تَعْني أمور تَعْتَنِي
ومَعْنَى كلّ شيء: مِحْنَتُهُ وحالُه الذي يصير إليه أمره. والعناء: التّعنِيَةُ والمشقّة. عنَّيته تُعَنّيه. والمُعَنَّى: كان أهلُ الجاهلية إذا بلغت إبل الرّجل مائة عمدوا إلى البعير الذي أَمْأَتْ به إبلُه فأَغْلَقوا ظهرَهُ لئلا يُرْكَب ولا يُنْتَفَعُ بظهرِهِ ليَعْلَمَ أن صاحبها مميء وإغلاق ظهره أن يُنْزَع منه سناسِنُ من فِقْرتَه، ويعقر سنامه. قال الفرزدق «5» :
غلبتك بالمفقىء والمُعَنِّي ... وبيت المُحْتَبَى والخافقاتِ
والعَنِيّةُ: الهناء، وقيل: بل هي بول يُعقد بالبعر. قال أوس بن حجر «6» :
كأنّ كُحَيْلاً مُعْقَداً أو عَنِيَّةً
عون: كلّ شيء استعنت به، أو أعانك فهو عَوْنُك. والصّوم عَوْنٌ على العبادة. وتقول: هؤلاءِ عَوْنُك، الذّكر والأنثى والجميع سواء، ويجمع أَعْوان. وأَعَنْته إعانة. وتَعاوَنوا أي: أعان بعضهم بعضا.
__________
(4) ديوانه 163.
(5) ديوانه ص 110.
(6) ديوانه 67 وعجز البيت:
على رجع ذفراها من الليت، واكف
(2/253)
________________________________________
ورجل مِعْوان: حسن المعونة. والمَعُونة على مَفْعُلة في القياس عند من جعله من العَوْن. وعند أناس هي: فَعُولة من الماعون، الفاعول. والعَوَان: البقرة النَّصَف في سنّها. والحربُ العَوانُ التي كانت قبلها حرب بَكْر، وهي أوّل وقعةٍ، ثمّ تكون عَوَاناً كأنّها ترفع من حالٍ إلى حالٍ أشدَّ منها. ويقال للمرأة النَّصَف: عَوَان قال:
نواعم بين أبكار وعون
والعانةُ: القطيع من حُمُر الوَحْش، وتجمع على عانات وعُون. وعانات: موضع من ناحية الجزيرة تُنْسب إليه الخمر العانيّة. وعانة الرّجل: إسْبُهُ من الشَّعَر على فرجه، وتصغيره: عُوَيْنة.
عين: العَيْن النّاظرة لكلّ ذي بصر. وعَيْنُ الماء، وعَيْنُ الرُّكبة. والعينُ من السّحاب ما أقبل عن يمينِ القِبْلة، وذلك الصُّقْع يُسمَّى العَيْن. يقال: نشأتْ سَحابةٌ من قِبَل العَيْن فلا تكادُ تُخْلِفُ. وعَيْنُ الشّمس: صيخدها. ويقال لكلّ رُكْبَةٍ عينانِ كأنّهما نُقرتان في مُقَدّمها. والعَينْ: المال العتيد الحاضر. يقال: إنه لَعَيّن غير (دين) «7» ، أي: مالٌ حاضر. ويقال: إنّ فلاناً لكريم عَينْ الكريم. ويقال: لا أطلبْ أثراً بعد عَينْ، أي: بعد مُعايَنَة. ويُقال: العَيْن: الدّينار، قال أبو المِقْدام «8» :
حبشيّ له ثمانون عيناً ... بين عَيْنَيْهِ قد يَسوقُ إفالا
وعِنْتُ الشّيء بعينه فأنا أَعينُه عَيْناً، وهو مَعْيونٌ، ويقال: مَعِينٌ
__________
(7) في (ص) : بياض وفي (ط) و (س) : عين.
(8) التهذيب 3/ 208، واللسان (عين) .
(2/254)
________________________________________
ورجل مِعيانٌ: خبيثُ العَيْن، قال في المعيون: «9»
قد كان قومُك يَحْسَبونك سيّداً ... وإخالُ أنّك سيّدٌ مَعْيونُ
والعَيْنُ: المَيْلُ في الميزان، تقول: أَصْلِحْ عَيْنَ ميزانِك. والعَيْنُ الذي تبعثه لتجسُّسِ الخبر، ونسميه العربُ ذا العُيَيْنَتَيْنِ، وذا العِيَيْنَتَيْنِ وذا العُوَيْنَتَيْنِ كلّه بمعنى واحد. ورأيته عِياناً، أي: مُعايَنَةً. وتَعَيَّن السِّقاءُ، أي: بَلِيَ ورقَّ منه مواضع [فلم يُمْسِكِ الماء] «10» ، قال القطاميّ «11» :
ولكنّ الأديمَ إذا تفرَّى ... بِلًى وتَعَيُّناً غَلَبَ الصَّناعا
وتَعَيَّنَ الشَّعِيبُ، أي: المزادة. والعِينةُ: السَّلَف، وتعيّن فلانٌ من فلانٍ عِينة، وقد عيّنه فلانٌ تَعييناً. والعِينُ: بَقَرُ الوحش وهو اسم جامع لها كالعِيس للإبل. ويُوصَفُ بسَعَةِ العَيْنَ، فيقال: بقرة عَيْناءُ وامرأة عَيْناء، ورجلٌ أَعْيُنَ، ولا يقال: ثورٌ أَعْيُنُ. وقيلَ: يقال ذلك. ورُوِي عن أبي عمرو. وهو حسَنُ العِينة والعَيَنِ، والفعل: عَيِنَ عَيَناً. والعَيَنُ: عظم سواد العَيْن في سَعَتها. ويقال: الأَعْيَنُ: اسم للثَّورِ وليس بنعتٍ. وهؤلاءِ أعيانُ تومهم، أي أشرافُ قومهم. ويُقال لكلّ إخوةٍ لأبٍ وأمٍ، ولهم إخوةٌ لأمّهات شتَّى: هؤلاءِ أعيانُ إخوتهم. والماء المَعِين: الظّاهر الذي تراه العُيون. وثوبٌ مُعَيَّن: في وَشْيِهِ ترابيعُ صغارٌ تُشْبِهُ عيون الوحش.
__________
(9) لم نهتد إليه.
(10) زيادة من التهذيب 3/ 206 لتوضيح المعنى.
(11) ديوانه- ص 34.
(2/255)
________________________________________
وأولاد الرّجل من الحرائر: بنو أعيان، ويقال: هم أعيان.
نعو: النَّعْوُ: الشَّقُ في مشْفَر البعير الأعلَى من قول الطّرمّاح «12» :
خَريعَ النَّعْوِ مُضطّرِبَ النَّواحي ... كأخلافِ الغَريفةِ ذا غُضُونِ
نعي: نَعَى يَنْعَى نُعْياً. وجاء نَعِيُّه بوزن فَعِيل. وهو خَبَرُ المَوْت. والنّعي: نداءُ النّاعي. وانتشار ندائه. والنَّعيُّ أيضاً: الرّجل الذي يَنْعَى. قال «13» :
قامَ النَّعيُّ فأَسْمَعا ... ونَعَى الكريمَ الأَرْوَعا
والإستِنْعَاءُ: شبهُ النّفار. واسْتَنْعَى القومُ إذا كانوا مُجتمعين فتفرّقوا لشيءٍ فَزِعوا منه. واسْتَنْعَتِ النّاقةُ، أي: عَدَتْ بصاحبها نافرةً. ويقال: يا نَعاءِ العربَ، أي: يا من نَعَى العربَ. قال الكُمَيْت «14» :
نعاءِ جُذاماً غَيْرَ مَوْتٍ ولا قَتْلِ ... ولكنْ فِراقاً للدعائم والأصل
يذكر انتقال جُذامٍ بنسبهم. وفيه لغة أخرى، يا نُعيان العرب، وهو مصدر نَعَيْتُه نُعْياً ونعيانا.
__________
(12) ديوانه 534. في النسخ: ذي غضون، وكذلك في اللسان (خرع) و (نعو) مع نصب الصفات قبله.
(13) التهذيب 3/ 219. اللسان (نعى) ، في (س) : قال.
(14) ليس في مجموع شعر الكميت، ولكنه في التهذيب 3/ 218، واللسان (نعى) .
(2/256)
________________________________________
وعن: الوَعْنَةُ: جمعُها: الوِعان، بياضٌ تراهُ على الأرض تعلم به أنّه وادي النمل، لا يُنْبِتُ شيئاً. قال «15» :
كالوِعانِ رُسُومُها
وتَوعَّنتِ الغنم: أخذ فيها السِّمَنُ أيّامَ الرّبيع. وكانت تلبية الجاهليّة:
وعن إليك عانية ... عبادل اليمانية
على قلاص ناجيه
نوع: النّوع والأنواع جماعة كلّ ضربٍ وصنف من الثّياب والثّمار والأشياء حتّى الكلام. والنُّوَع: الجُوع، ويقال: هو العطش وبالعطش أشبه، لقول العرب عليه الجوع والنوع، وجائع نائع. ولو كان الجوع نوعاً لم يحسن تكريره. وقال آخر: إذا اختلف اللّفظان كرّروا والمعنى واحد.
ينع: يَنَعَتِ الثّمرةُ يُنْعاً ويَنَعاً. وأَيْنَعَ إيناعاً. والنَّعتُ: يانِعٌ ومونع.
__________
(15) في اللسان (وعن) : كالوعان رسومها وفي التاج كذلك، منقوص غير منسوب.
(2/257)
________________________________________
باب العين والفاء و (واي) معهما ع ف و، ف ع د، ع ي ف، ي ف ع مستعملات
عفو: العفو: تركُكَ إنساناً استوجَبَ عُقوبةً فعفوتَ عنه تعفُو، والله العَفُوُّ الغَفور. والعَفْوُ: أحَلُّ المالِ وأطيبُه. والعَفْوُ: المعروف. والعُفاةُ: طُلاّبُ المعروف، وهم المُعْتَفُونَ. واعْتَفَيتُ فلاناً: طَلَبتُ مَعروفَه. والعافيةُ من الدَّوابِّ والطَّيْر «1» : طُلاّب الرِزقِ، اسمٌ لهم جامع.
وجاء في الحديث: مَن غَرَسَ شجرةً فما أَكَلَتِ العافيةُ منها كُتِبَتْ له صَدَقةٌ «2» .
والعافيةُ: دِفاعُ الله عن العبد المَكارِه. والإستِعفاءُ: أن تَطْلُبَ إلى من يُكَلِّفُك أمراً أن يُعفيك منه أي يَصرِفُه عنك. والعَفاءُ: التُّرابُ. والعَفاءُ: الدُّروسُ، قال:
__________
(1) في اللسان: والعافية: طلاب الرزق من الإنس والدواب، والطير.
(2) في اللسان:
وفي الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة.
وجاء أيضا في حديث أم مبشر الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لي فقال: من غرسه أمسلم أم كافر؟ قلت: لا بل مسلم، قال: ما من مسلم يغوس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طائر أو سبع إلا كانت له صدقة.
(2/258)
________________________________________
على آثار مَن ذَهَبَ العَفاءُ «3»
تقول: عَفَتِ الدِّيار تَعفُو عُفُوّاً، والرِّيحُ تَعفُو الدارَ عَفاءً وعُفُوّاً وتَعَفَّتِ الدارُ والأثَرُ تَعَفّيَاً. والعَفْو والعِفَو والجميع عِفْوة «4» : الحُمُر الأَفْتاء والفَتيات، والأنثى عِفَوَة ولا أعلم واواً مُتحركة بعد حرف متحرك في في آخِر البناء غيرَ هذا، وأن [لُغَة] «5» قيس بها جاءت «6» وذلكم أنَّهم كَرهوا عِفاة في موضع فِعَلة وهم يريدون الجماعة فيلتبس بوُحْدان الأسماء فلو تكلَّف متكلّف أن يَبنيَ من العَفو اسماً مفرداً على فِعلة لقال عِفاة. وفيه قول آخر: يقال همزة العَفاء والعَفاءة ليست بأصلية إنما هي واوٌ أو ياء لا تُعرَف لأنّها لم تُصَرَّف ولكنّها جاءت أشياء في لغات العرب ثَبَتَت المَدَّة في مؤنثّها نحو العَماء والواحدة العَماءة ليست في الأصل مهموزة ولكنّهم إذا لم يكن بين المذكّر والمؤنّث فرقٌ في أصل البناء همَزوا بالمدّة كما تقول: رجلٌ سَقّاء وامرأة سقّاءة وسقّاية. قيل أيضاً، من ذهب إلى أن أصله ليس بمهموز «7» . والعِفاء ما كَثُر من الريش والوَبَر. ناقةٌ ذات عِفاء كثيرةُ الوَبَر طويلتُه قد كادَ ينسِل للسُقوط. وعِفاء النَّعامة: الريشُ الذي قد عَلا الزِّفَّ الصِّغار، وكذلك الدّيك ونحوه من الطَّير، الواحدة عِفاءة بمَدَّة وهمزة، قال «8» :
__________
(3) عجز بيت (زهير) وصدره:
تحمل أهلها عنها فبانوا
والبيت في شرح ديوان زهير ص 58 وفي اللسان. وفي الأصول المخطوطة: على آثار ما ذهب العفاء.
(4) في اللسان: والعفو والعفو والعفو والعفا والعفا تبصرهما: الحجش. وفي التهذيب: ولقد الحمار. والجمع أعفاء وعفاء وعفوة.
(5) ما بين المعقوفين من اللسان وهو شيء يقتضيه السياق وهو الفعل جاءت.
(6) كذا في ط وس في ص: كان.
(7) في الأصول المخطوطة: بمهموزة.
(8) لم نهتد إلى القائل،
(2/259)
________________________________________
أُجُدٌ مُؤَثَّفةٌ كأنَّ عِفاءَها ... سِقْطانِ من كَنَفَيْ ظَليمٍ جافِلِ
وعِفاءُ السّحاب: كالخَمْل «9» في وجهه لا يكاد يُخلِف «10» ، ولا يقال للواحدة عِفاءة حتى تكونَ كثيرة فيها كثافة.
فعو: الأفعى: حَيَّةٌ رَقشاءُ طويلةُ العُنُق عريضة الرَّأس، لا ينفَعُ منها رُقْيَة ولا تِرْياق، وربّما كانتْ ذاتَ قَرْنَيْن. والأُفْعُوانُ: الذَّكَرُ.
عوف: العَوْفُ: الضَّيْف، وهو الحالُ أيضاً «11» : تقول: نِعْمَ عَوْفُك أي ضَيْفُكَ. والعَوْفُ: اسم من أسماء الأسد لأنّه يَتَعَوَّف باللَّيْل فيَطلُب. ويقال: كلُّ مَن ظَفِرَ في اللَّيْل بشيءٍ «12» فالذي يَظفَر به عُوافتُه. وعُوافةُ وعَوْفٌ «13» من أسماء الرّجال. ويقال: العَوْفُ الأَيْرُ. ويقال: العَوْف نَبْتٌ
عيف: عافَ الشَّيءَ يَعَافُه عِيافةً «14» إذا كَرِهَه من طعام أو شراب. والعَيُوفُ من الإبِلِ: الذي يَشَمُّ الماءَ فيَدَعُه وهو عطشان. والعِيافة زَجْرُ الطَّيْر، وهو أَنْ تَرَى طَيْراً أو غراباً فَتَتَطَيَّرَ، تقول: ينبغي أنْ يكون كذا فإنْ لم تَرَ شيئاً قُلتَ بالحَدْس فهو عِيافة. ورجل عائف يَتَكَهَّن، قال: عَثَرَت طيرك أو تعيف.
__________
(9) كذا في (ط) و (ص) في (س) : كل ما تحمد.
(10) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة: يخفف.
(11) في اللسان: وخص بعضهم به الشر.
(12) كذا في س في ط وص: فهو الذي.
(13) كذا في الأصول المخطوطةفي اللسان: وعرف وعويف: من أسماء الرجال.
(14) في اللسان: عاف الشيء يعافه عيفا وعيافة وعيافا وعيفانا.
(2/260)
________________________________________
يفع: اليَفاعُ: التلُّ المُنيفُ. وكلُّ شيءٍ مُرتَفع يَفاع. وغُلامٌ يَفَعة «15» وقد أيْفَعَ ويَفَعَ أي شَبَّ ولم يبلُغ. والجارية يَفَعَة والأيفاع جمعه.
__________
(15) في اللسان: وغلام يافع ويفعة وأفعة ويفع: شاب.
(2/261)
________________________________________
باب العين والباء و (واي) معهما ع ب ا، ع بء، ع ي ب، وع ب، ب وع، ب ع و، ب ي ع مستعملات
عبا: العباية: ضرب من الأكسية فيه خُطوط سُود كبار والجميع العَباء، والعَباءة لغة. وما ليس فيه خُطوطٌ وجِدّة فليس بعَباءة، قال:
نَجَا دَوْبَل في البئر واللَّيل دامِسٌ ... ولولا عباءته «1» لزار المقابرا
والعَبا، مقصور،: الرجل العَبام في لغة وهو الجافي العَيُّ «2» .
عبء: العِبْء: كلّ حِمْلٍ من غُرْمٍ أو حَمالةٍ، والجميع الأَعْباء، قال:
وحَمْلُ العِبْء عن أعناق قَومي ... وفِعلي في الخُطوبِ بما عَناني «3»
__________
(1) كذا ورد، ولا يستقيم الوزن إلا بإسكان التاء، وهذا من أقبح الضرورات. ولم نهتد إلى الشاهد في المعجمات المشهورة ولا في كتب اللغة والأدب.
(2) نقل الأزهري عن الليث: العبا مقصور الرجل العبام، وهو الجافي العيي.. قال الأزهري: ولم أسمع العبا بمعنى العبام لغير الليث (تهذيب اللغة 3/ 235) وفي اللسان، العيي أيضا. وفيه: رَجُلٌ عَيٌّ بوزن فَعْلٍ، وهو أكثر من عيي.
(3) لم نجد الشاهد.
(2/262)
________________________________________
وما عَبَأَت به شيئاً: أي لم أياله ولم ارتفع «4» . وما أعبَأُ بهذا الأمر: أي ما أصنع به كأنَّك تَستقلُّه وتَستَحقِرهُ. تقول: عَبَأَ يَعْبَأُ عَبْأً وعَباءً، وعَبَأتُ الطِيبَ أعبوه عَبْأً وأُعَبِّئُهُ تَعْبِئةً إذا هَيَّأتُه في مواضعه، وكذلك الجيش «5» إذا ألبستُهم السلاحَ وهَيَّأتُهم للحرب، قال:
وداهيةٍ يُهالُ الناسُ منها ... عَبَأتُ لشدِّ شِرَّتِها عَلَيّا «6»
وتقول في ترخيم اسم مثل عبد الرَّحمن وعبد الرَّحيم وعبد الله وعُبَيْد الله عَبْوَيْهِ مثل عَمْرَوَيْةِ «7» .
عيب: العَيْبُ والعَابُ لغتان، ومنه المَعَابُ. ورجُلٌ عَيّابٌ: يَعيبُ النّاسَ، وكذلك عَيّابة «8» : وقَّاعَةٌ في الناس، قال:
قد أَصْبَحَتْ لَيْلَى قليلاً عابُها «9»
وعابَ الشّيء: إذا ظَهَرَ فيه عَيب. وعابَ الماءُ: إذا ثَقَبَ الشَّطَّ فَخَرَجَ منه، مُجاوزُه ولازمهُ واحد. وعَيْبَة المَتاعِ يجمَعُ عِياباً. والعِيابُ: المِنْدَف «10» ، لم يعرفوه. والعِيابُ: الصُّدورُ أيضاً واحدُها عَيْبة.
وفي الحديث: إنَّ بينَنا وبَينَكم عَيْبةً مكفُوفَةً «11»
يُريد صَدْراً نَقِيّاً من الغِلِّ والعداوة، مَطْوِيًّا على الوفاء. قال بِشْر بن أبي خازم:
__________
(4) كذا في الأصول المخطوطة ولكن لم نجد قوله ولم أرتفع في المعجمات.
(5) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة: الخيل. وقد اخترت ما في اللسان لصحته بقرينة الضمير في ألبستهم وهيأتهم.
(6) لم نهتد إلى قائل الشاهد.
(7) كذا في ص في ط وس: غبرويه.
(8) في اللسان: وعيبة بضم ففتح.
(9) لم نظفر بالشاهد.
(10) وفي اللسان: قال الأزهري لم أسمعه لغير الليث.
(11) وفي اللسان: قال الأزهري وقرأت بخط شمر:
وإن بيننا وبينهم عيبة مكفوفة.
(2/263)
________________________________________
وكادتْ عِيابُ الوُدِّ منَّا ومنكم ... وإنْ قيل أبناءُ العُمُومةِ تَصْفَرُ «12»
أي تخلو من المَحبَّة.
وعب: الوَعْبُ: إيعابُكَ الشَّيْءَ في الشيء. واستَوْعَبَ الجِرابُ الدقيقَ.
وفي الحديث: إنَّ النِّعْمةَ الواحدَة تَستَوعِبُ جميعَ عَمَلِ العبد يومَ القِيامة
أيْ تَأتي عليه.
بوع: البَوعُ «13» والبَاعُ لغتان، ولكنْ يُسَمَّى البَوعُ في الخِلقة، وبَسْطُ الباع في الكَرَم ونحوه فلا يقال إلاّ كريمُ الباع، قال:
لهُ في المجْدِ سابقةٌ وباعٌ 1»
والبَوعُ أيضاً مصدر باع يَبُوع بَوعاً، وهو بَسْطُ الباع في المَشْيِ والتناوُلِ، وفي الذَّرع. [والإبِل] «15» تَبُوعُ في سيرها. وقال في بَسطِ الباع:
لقد خِفتُ أن ألْقَى المنايا ولم أَنَلْ ... من المالِ ما أسْمُو به وأَبُوعُ «16»
أيْ أمُدُّ به باعي.
__________
(12) لم نجده في الديوان، وأضافه محقق الديوان (عزة حسن) في ملحق الديوان. وهو منسوب إلى (بشر) في أساس البلاغة وفي اللسان (عيب) من غير عزو، والبيت مع بيت آخر في كتاب المعاني الكبير ص 527 منسوبان إلى (الكميت) .
(13) في اللسان والبوع بفتح الباء وهي كلمة ثالثة.
(14) لم يرد في المعجمات الأخرى ولا في كتب اللغة التي أفدنا منها.
(15) الكلمة زيادة من اللسان ومكانها في ص فراغ.
(16) (الطرماح) ديوانه/ 314 والرواية فيه:
وشيبني أن لا أزال مناهضا ... بغير ثرا أثرو به وجبوع
(2/264)
________________________________________
بعو: البَعْوُ: الجُرْمُ «17» ، قال «18» :
وإِبسالي بَنِيَّ بغَير جُرْمٍ ... بَعَوناهُ ولا بِدمٍ مُراقِ
وبَعَوا من فلان أي حقروا وتجرءوا «19» .
بيع: العَرَبُ تقول: بِعتُ الشيءَ بمعنى اشتريته. ولا تَبعْ بمعنى لا تَشْتر. وبِعتُه فابْتاعَ أي اشتَرَى. والبَيّاعات: الأشياءُ التي يُتَبايَع بها للتجارة. والإبتياع: الإشتراء. والبَيْعة: الصَّفْقة على إيجابِ البَيع وعلى المُبايَعَةِ والطَّاعة، [وقد] «20» تَبايَعوا على كذا. والبَيْعُ اسم يَقَع على المَبيعِ، والجميع البُيوع. والبَيِّعان: البائع والمشتري. والبِيعةُ: كنيسة النَّصارَى وجَمعُها بِيَع، قال الله عزّ وجلّ: [لَهُدِّمَتْ «21» ] صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ.
__________
(17) في اللسان: الجناية والجرم.
(18) (هو عوف بن الأحوص الجعفري) (اللسان) .
(19) لم نجد قوله: بعوا من فلان إلى آخره في سائر المعجمات.
(20) كذا في اللسان وهي مما يقتضيها السياق.
(21) تمام الآية وهي ضرورية. انظر سورة الحج الآية 40.
(2/265)
________________________________________
باب العين والميم و (واي) معهما ع م ي، م ع و، ع وم، ع ي م، م ي ع مستعملات
عمي: العَمَى: ذَهابُ البَصرَ، عَمِيَ يَعْمَى عَمىً. وفي لغة اعمايَّ يَعمايُّ اعمِيياء، أرادوا حَذْوَ ادهَامَّ ادهيماماً فأخرجوه على لفظٍ صحيح كقولك ادهامَّ: اعمايَّ. ورَجُلٌ أعْمَى وامرأة عَمْياءُ لا يَقَعُ على عَيْنٍ واحدةٍ. وعَمِيَت عَيْناهُ. وعَينانِ عَمياوان. وعَمْياوات يَعني النساء. ورجالُ عُمْيٌ. ورَجُلٌ عَمٍ، وقَومٌ عَمُون من عَمَى القَلْب، وفي هذا المعنى [يُقال] «1» ما أعماه، ولا يُقال، من عَمَى البَصرَ، ما أعماه لأنّه نَعْتٌ ظاهرٌ تُدركُه الأبصار. ويقال: يجوز فيما خَفِيَ من النُّعوت وما ظَهَرَ خلا نَعْتٍ يكون على أَفْعَلَ مُشَدَّد الفعل مثل اصفَرَّ واحمرَّ. والعَمايَةُ: الغَوايةُ وهي اللَّجاجة. والعَمايَةُ والعَماء: السَّحابُ الكثيفُ المُطبِقُ، ويقال للَّذي حَمَلَ الماءَ وارتَفَعَ، ويقال للَّذي هَراقَ ماءَه ولما يَتَقَطَّع، تَقَطَّعَ الجَفْل «2» والجَهامُ. والقِطعةُ منها عماءة، وبَعضٌ يُنكِره ويَجعَلُ العَماءَ اسماً جامعاً. وقال الساجعُ: أشَدُّ بَرْدِ الشِّتاء شَمالٌ جِرْبِياءُ في غِبِّ السَّماء تحت ظِلِّ عَماء.
__________
(1) زيادة يقتضيها السياق، وكذا في اللسان.
(2) كذا وردت في اللسان مرة وقد جاءت الجفال مرة أخرى.
(2/266)
________________________________________
والعَمْيُ على لفظ الرَّمْيُ: رَفْعُ الأمواجِ القَذَى والزَّبَد في أعاليه، قال:
رَهَا «3» زَبَداً يَعمِي به المَوْج طاميا
والبعيرُ إذا هَدَرَ عَمَى بلغامِه على هامتِه عَمْياً. والتَّعمِيَة: أن تُعَمِّي شيئاً على إنسانٍ حتى تُلْبَه عليه لَقْماً «4» ، وجمع العَماء أعماء كأنه جعل العماء اسماً ثمّ جمعه على الأعماء، قال رؤبة «5» :
وبَلَدٍ عاميةٍ اعماؤُهُ «6»
والعُمِّيَةُ: الضَّلالة، وفي لغة عِمِّيَة. والاعتماء: الاختيار، قال:
سيل بينَ النّاسِ أيًّا يَعْتمي «7»
والمَعامي: الأرضُ المجهُولة.
معو: المَعْوُ: الرُّطَبُ الذي أَرْطَبَ بُسْرُه أجمَعُ، الواحدةُ مَعْوَة لا تَذنيبَ فيها ولا تَجزيع. والمُعاء: من أصواتِ السنانير، معا يمعو أومغا يَمْغُو لونان «8» أحدُهما من الآخر، وهُما أرفَعُ من الصئي.
__________
(3) كذا في اللسان وفي الأصول المخطوطة: زها. ولم نهتد إلى قائل البيت.
(4) كذا في الأصول المخطوطة أما في اللسان: تلبيسا. واللقم: سد فم الطريق ونحو ذلك.
(5) كذا في ديوان رؤبة واللسان في الأصول المخطوطة: العجاج.
(6) كذا روي الرجز في اللسان والديوان في الأصول المخطوطة:
وبلدة عامية أعماؤه
وتكملته:
كأن لون أرضه سماؤه
(7) كذا في الأصول المخطوطة: ولم نجده في سائر المعجمات.
(8) كذا في ص وط واللسان في س: لغتان.
(2/267)
________________________________________
معي: ومَعًى ومِعًى واحدٌ، ومِعَيانِ وأمعاءٌ وهو الجميعُ ممّا في البَطْن ممّا يتردَّدُ فيه من الحَوايا كُلِّها. والمِعَى: من مَذانب الأرض، كُلُّ مِذْنَبٍ يُناصي مِذْنَباً بالسَّنَد، والذي في السَّفْح هو الصُّلْب، قال:
تحبو إلى أصلابه أمعاؤه «9»
[وهما مَعاً وهم مَعاً «10» ، يُريدُ به جماعة. ورجل إمَّعَة على تقدير فِعَّلة: يقول لكلٍ أنا مَعَك، والفعل نَأْمَعَ «11» الرجُلُ واسْتَأْمَعَ «12» . ويقال للَّذي يتردَّدُ في غير ضَيعَةٍ إمَّعَة،
وفي الحديث: اغْدُ عالِماً أو مُتَعَلِّماً ولا تَغْدُ إمَّعَة] .
عوم: العَوْمُ: السِّباحة. والسَّفينةُ والإبِلُ والنُّجُوم تَعُومُ في سيرها، قال:
وهُنَّ بالدَّوِّ «13» يَعُمْنَ عَوْماً
وفَرَس عَوّام: يَعُومُ في جَرْيه. والعامُ: حَوْلٌ يأتي على شَتْوةٍ وصَيْفَةٍ، ألِفُها واو، ويُجمَع على الأعوام. ورَسْمٌ عامِيٌّ أو حَوْليٌّ: أتَى عليه عامٌ، قال العجّاج:
مِن أنْ شَجاكَ طَلَلٌ عامِيُّ «14»
والعامَةُ: تُتَّخَذُ من أغصان الشَّجر ونحوه، تُعْبَر عليها الأنهار كعُبُور السُّفُن، وهي تَموجُ فوْقَ الماء، وتُجمَعُ عامات. والعام والعومة
__________
(9) الرجز (لرؤبة) في ديوانه ص 4:
تحبو إلى أصلابه أمعاؤه ... والرمل في معتلج أنقاؤه
(10) أدرجت الكلمة في مادة (معع في اللسان وفي غيره من المعجمات كالتهذيب مثلا. وكذلك إمعة ولا مكان لها في معي.
(11) لم نجد الفعل في المعجمات المتيسرة.
(12) لم نجد الفعل في المعجمات المتيسرة.
(13) كذا في اللسان وسائر المظان اللغوية، في الأصول المخطوطة: الدوم.
(14) الرجز في الديوان ص 311.
(2/268)
________________________________________
والعامَةُ: هامَةُ الراكب إذا بدا لك رأسُه في الصَّحْراء وهو يَسيرُ. ويقال: لا يُسَمَّى رأسُه عامةً حتّى تَرَى عِمامةً عليه. والإعتِيامُ: اصطِفاء خِيارِ مالِ الرَّجُل، يُقال: اعتَمْتُ فلاناً، واعتَمْتُ أَفْضَلَ مالِهِ. والمَوْتُ يَعْتامُ النُّفُوس، قالَ طَرَفة:
أَرَى المَوْتَ مِعْيَامَ الكِرامِ ويَصْطَفي ... عَقيلةَ حالِ الفاحِشِ المُتَشَدِّدِ «15»
عيم: العَيْمانُ: الذي يَشْتَهي اللَّبَنَ شَهْوَةً شَديدةً، والمرأة عَيْمَى. وقد عِمْتُ إلى اللَّبَن عَيْمَةً شديدة وعَيَماً «16» شديداً. وكل مَصْدرٍ مثلهُ ممّا يكون فَعْلان وفَعْلى، فإذا أَنَّثْتَ المصدر فقُلْ على فَعْلةٍ خفيفة، وإذا طَرَحْتَ الهاءَ فَثَقِّلْ نحو الحَيَرْ والحَيرَة.
ميع: مَاعَ الماءُ يميع مَيْعاً إذا جرى على وجه الأرض جَرْياً مُنْبسطاً في هيئته، وكذلك الدَّمُ. وأَمَعْتُه إماعةً، قال «17» :
بساعِدَيْهِ جَسَدٌ مُوَرَّسُ ... منَ الدِّماءِ مائِعٌ ويُبَّسُ
والسَّرابُ يَميعُ. ومَيْعَةُ الشَّبابِ: أوَّلُه ونشاطه. والمَيْعَة والمائعة: من العِطْر. والمَيْعَة: اللبنى «18» .
__________
(15) ورواية البيت في كتاب السبع الطوال لابن الأنباري وغيره من مصادر الشعر الجاهلي، واللسان:
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي............... .............
(16) في الأصول واللسان: عيما بسكون الياء والصواب الذي يقتضيه قول الخليل، فتح الياء.
(17) في اللسان: وأنشد الليث والرجز فيه يبدأ لقوله:
كأنه ذو لبد دلهمس............... ..........
(18) اللبنى واللبن: شجر.
(2/269)
________________________________________
باب اللَّفيف من العين
اللَّفيفُ: أنْ تلفَّ الحَرْف بالحَرْف أي تُدْغم لأنَّ العَيَّ أصْلُهُ العَوْيُ فاستتْقلوا إظهارَ الواو مع الياء المتحرِّكة.. فحوَّلُوها ياء وأدغمُوها فيها.
عوي: عَوَتِ السِّباعُ تَعْوي عَوًى «1» . وللكلْب عُواءٌ، وهو صوْتٌ يمُدُّهُ وليس بنَبْح. وعَوَيْتُ الحَبْلَ عيّاً: لوَيْتُهُ. وعَوَيْتُ رأس النّاقة «2» : أي عُجْتُها فانْعَوَى. والناقةُ تَعْوي بُرَتها في سيْرها: أيْ تلويها «3» بخَطْمها، قال «4» :
تَعْوي البُرَى مُسْتوفِضاتٌ وفْضا
وعَوَى فلانٌ قَوْماً واسْتَعْوَى: دَعاهُم إلى الفِتنة. وعَوَيْتُ المُعْوَجَّ حتّى أقَمْتُه. والمُعاويَةُ: الكَلْبَةُ المُسْتحرِمةُ تَعْوي إليهنَّ ويَعْوِينَ، يُقال: تَعاوَى الكِلابُ. والعَوَّاءُ: نَجْمٌ في السَّماءِ يُؤَنَّث، (يُقال لها عَوَّاء) «5» ،
__________
(1) لم يرد هذا المصدر في كتب اللغة وفيها أن العواء هو المصدر، ليس غير. وأضيف أن بناء فعل مصدرا للثلاثي المكسور العين والماضي مفتوحها في المضارع، خاص في الأكثر بالأعراض والصفات والعيوب والحلية. ولم نجد هذا المصدر إلا في الأصول المخطوطة التي لدينا من كتاب العين.
(2) كذا في ص وس وقد سقطت من ط.
(3) كذا في س أما في ص وط: تلويه.
(4) (رؤبة) ديوانه/ 80.
(5) سقط ما بين القوسين من س.
(2/270)
________________________________________
ويقال: إذا طَلَعَتِ العَوّاءُ جَثَمَ الشِّتاءُ وطابَ الصِّلاءُ، وهي من نُجُوم السُّنْبُلة من أنْواء البَرْدِ في الرَّبيع، إذا طلعت وسَقَطَتْ جاءَتْ بالبَرد، ويُقالُ لها عواء البرد. والعواء والعَوَّة «6» ، لغتان: الدُبُرْ، قال:
فهلاّ شَدَدْتَ العَقْدَ أو بِتَّ طاوِياً ... ولم يَفْرَحِ العَوّا كما يَفْرَحُ القَتْبُ
وقال:
قِياماً يُوارُون عَوّاتِهم ... بِشَتْمي وعَوّاتُهُمْ أظْهَرُ
عا، مقصُورٌ، زَجْرُ الضئين، ورُبّما قالوا: عو وعاي، كلّ ذلك يُخفَّف، فإذا استُعملَ فِعْلُه قيل: عَاعَى يُعاعِي مُعَاعاةً»
وعَاعاةً «8» ، ويُقالُ أيضاً، عَوْعَى يُعَوْعِي «9» عَوْعَاةً وعَيْعَى يُعَيْعِي «10» عَيْعاة وعِيعاء «11» مصدرٌ لكلّ تلك اللغات، قال «12» :
وإنّ ثِيابي من ثِيابِ مُحَرَّقٍ ... ولم أَسْتَعِرْها من مُعاعٍ وناعِقِ
عيي: والعِيُّ مصدر العَيِّ، وفيه لغتان: رَجُلٌ عَيٌّ بوزن فَعْلٍ وعَيِيٌّ بوزنِ فَعيل «13» قال العجّاج:
لا طائِشٌ فاقٌ ولا عيي «14»
__________
(6) كذا في اللسان وما يقتضيه الشاهدان المذكوران، في الأصول المخطوطة: العوا ولم نهتد إلى القائل لكل من الشاهدين. وقال محقق (اللسان) عن عجز البيت الأول: قوله: ولم يفرح ... هكذا في الأصل. ولعل الصواب: لم يقرح.
(7) كذا في القياس واللسان في الأصول المخطوطة: عاعاة.
(8) هذا هو القياس وكذا في اللسان في الأصول المخطوطة: عيعا.
(9) سقط من الأصول المخطوطة.
(10) سقط من الأصول المخطوطة.
(11) سقط من الأصول المخطوطة.
(12) لم نهتد إلى القائل.
(13) كذا في ص وقد سقط في ط وس.
(14) لم نجد الرجز في الديوان.
(2/271)
________________________________________
وقال آخر «15» :
لنا صاحِبٌ لا عَيِيُّ اللسانِ ... فيَسْكُتُ عنّا ولا غافِلُ
وقد عيَّ عن حُجَّته عِيّاً، وعَيِيتُ بهذا الأَمْر وعنه، إذا لم أَهْتَدِ لوجههِ، وأعياني الأَمْرُ أنْ أضْبِطَه. والدَّاءُ العَياءُ: الذي لا دَواءَ له. ويقال: الدَّاءُ العَياء الحُمْقُ. والإعْياءُ: الكَلالُ. والمُعاياة: أن تَأتي بكَلام، لا يُهْتَدَى له. والفَحْلُ العَياءُ: الذي لا يَهتَدِي لضراب الشَّوْل. والعَيَاياءُ من الإبل: الذي لا يَضْرِبُ ولا يُلْقِحُ، وكذلك من الرِّجال.
وعي: وَعَى يَعِي وَعْياً: أيْ حَفِظ حديثاً ونحوه. وَوَعَى العَظْمُ: إذا انجَبَرَ بعدَ كَسْرٍ، قال
دلاث دلعثي «16» ، كأن عظامه ... وعت في محال الزور بعدَ كُسُورِ «17»
وقال أبو الدُّقَيْش: وَعَتِ المِدَّةُ في الجُرْحِ، ووَعَتْ جايئَتُه يَعْني مِدَّتُه. وأَوْعَيتُ شَيئاً في الوِعاء وفي الإِعاءِ، لغتان. والواعِيةُ: الصُّراخُ على المَيِّتِ ولم أسمع منه فعلا. والوَعَلأ «18» : جَلَبَةٌ وأصْواتٌ للكِلابِ إذا جَدَّتْ في الطَّلَبِ وهَرَبَتْ «19» . قال:
عَوابِساً في وعكة تحت الوعا «20»
__________
(15) لم نجد البيت ولا قائله.
(16) كذا في الأصول المخطوطة، في اللسان: دلعثى (مقصور) وهو سهو.
(17) البيت في اللسان والتاج: دلعث.
(18) كذا في س في ص وط: الوعاء.
(19) كذا في ص في ط: هرت.
(20) لم نهتد إلى الراجز.
(2/272)
________________________________________
جَعَلَه آسْماً من الواعِية. وإذا أَمَرْتَ من الوَعَى قُلْتَ: عِهْ، الهاءُ عِمادٌ للوُقُوفِ الإبتِداءُ والوُقُوفُ على حرف واحد. والوَعْوَعَةُ: من أصواتِ الكلاب وبنات آوَى وخَطيبْ وَعْوَعٌ: نَعْتٌ له حَسَنٌ، قالت الخنساء:
هو القَرْمُ واللَّسِنُ الوَعْوَعُ «21»
رَجُل وَعْواعٌ، نَعْتٌ قبيحٌ: أي مِهْذار، قال:
نِكْسٌ من القوم ووغواه وعيّ «22»
وكَقَول الآخَر:
تَسْمَعُ للمَرْءِ به وَعْواعا
وتقولُ: وَعْوَعَتِ الكلبة وَعْوَعةً، والمصدَرُ الوَعْواع، لا يُكْسَرُ على وِعْواع نحو زِلْزال كراهيةً للكَسْر في الواو. وكذلك حكاية اليَعْيَعَة من الصَّوتِ: يَع، واليَعْياع، لا يُكْسَر. وإنَّما يَع من كَلامِ الصِّبيان وفِعالِهم، إذا رَمَى أَحَدهُم الشَّيْءَ إلى الآخَر، لأنَّ الياءَ خِلْقَتُها الكَسْرة فَيَسْتَقْبِحُونَ الواو بينَ كَسْرَتَيْن. والواو خِلْقَتُها من الضَمَّة فيستقبحون التِقاءَ كَسْرةٍ وضَمَّةٍ، ولا تَجِدها في كلام العرب في أصل البناء سِوى النَّحوْ «23» .
__________
(21) في الديوان ص 55:
هو الفارس المستعد الخطيب ... في القوم واليسر الوعوع
(22) من اللسان (وعع) . وفي الأصول:
لا نكس في القوم وعواع ولا وعق
ويروى: وعي. وهو مصحف ومحرف.
(23) انتهى كلام الليث في التهذيب بقوله: في أصل البناء، ولعل عبارة سوى النحو قد اندست سهوا.
(2/273)
________________________________________
باب الرُباعيِّ من العين
قال الخليل: سَمِعْتُ كلمةً شَنعاءَ لا تَجُوزُ في التأليف الرُباعيِّ. سُئِل أعرابيٌّ عن ناقته فقال: تَرَكْتُها تَرْعَى العُهْعُخ، فَسأَلْنا الثِقاتِ من عُلَمائهم فأنكَروا أن يكونَ هذا الإسْمُ من كلام العرب. وقال الفَذُّ منهم: هي شَجَرَةٌ يُتَدَاوَى «1» بوَرَقِها. وقال أعرابيٌّ: إنَّما هو الخُعْخُعُ، وهذا موافق لقياس العربية.
__________
(1) في التهذيب 3/ 264: يتداوى بها وبورقها. وقد ساق الخبر كله عن الليث.
(2/274)
________________________________________
هجرع: الهِجْرَعُ من وصف الكلاب السَّلُوقيّةِ الخِفافِ. والهِجْرَع: الطويلُ المَمْشُوق، الأهْوَجُ الطَّول، قال العّجّاج «1» :
أَسْعَرُ ضَرْباً وطُوالاً هجْرَعا
والهِجْرَع: الأحْمَقُ من الرجال، قال: الشاعر «2» :
فلأقْضِيَنَّ على يَزيدَ أميرِها ... بقَضاءِ لا رِخْوٍ وليس بهِجْرَعِ
وأنشد عَرّام «3» :
إذا أنتَ لم تخلِطْ مع الحِلْمِ طِيرةً ... من الجَهْلِ ضامتك اللئام الهجارع
__________
(1) الرجز (لرؤبة) . انظر الديوان ص 90، وقبله:
يقدمن سواس كلاب شعشعا
(2) البيت في التهذيب (هجرع) غير منسوب، ومثل ذلك في اللسان.
(3) وهذا مما تفرد به كتاب العين من الشواهد.
(2/275)
________________________________________
هجنع: والهَجَنَّعُ: الشيخُ الأصْلَعُ وبه قُوَّة. والظَّليمُ الأقرع. والنَّعامة. هَجَنَّعَة، قال:
جَذْباً كرأس الأقرَعِ الهَجَنَّعِ
والهَجَنَّعُ من أولاد [الإبِلِ] «4» ما يُوضَعُ في حَمارّة الصَّيْف قَلَّما يَسْلَم حتى يقرَعَ رأسُه.
عنجه: العُنْجُهُ: الجافي من الرجال، وفيه عُنْجُهِيَّة أي جَفْوةً في خُشُونة «5» مَطْعَمِه وأموره، قال حَسّانُ بنُ ثابت:
ومن عاشَ منّا عاشَ في عُنْجُهِيّةٍ ... على شَظَفٍ من عَيْشِهِ المتَنَكِّدِ
وقال رُؤبة:
بالدَّفْع عَنّي دَرْءَ كلّ عنجه «6»
والعُنْجُهةُ: القُنْفُذُةُ الضَّخْمةُ.
عجهن: والعُجاهِنُ: صديقُ الرجُل المُعْرِسِ الذي يَجرِي بيْنَه وبيْنَ أَهلِه بالرسائل، فإذا بَنَى بأهله فلا عُجاهِنَ له، قال:
ارجِعْ إلى أهْلِكَ يا عُجاهِنُ ... فقد مَضَى العرس وأنت واهن «7»
__________
(4) سقط من الأصول المخطوطة وأثبتناه من التهذيب واللسان.
(5) كذا في الأصول المخطوطة واللسان في التهذيب: جشوبة.
(6) ديوانه/ 166.
(7) الرجز في اللسان (عجهن) وروايته: ارجع إلى بيتك ...
(2/276)
________________________________________
والماشِطةُ عُجاهِنةٌ إذا لم تُفارِقْها حتى يُبْنىَ بها. والمرأةُ عُجاهِنة، وهي صديقةُ العَروس. والفِعلُ تَعَجْهَنَ تَعَجْهُناً، قال:
يُنازِعْنَ العَجاهِنَةَ الرِّئينا «8»
جمعُ العُجاهِن، قال عرّام: العُجاهِنُ من الرجال: المخلوط الذي ليس بصريح النَسَب «9» . ويقال فيه عُنْجُهيَّةٌ وعُنْزُ هْوَةٌ وهما واحد.
عمهج: العُماهِج: اللَّبَنُ الخاثِرُ من ألبان الإبِل، قال:
تُغذَى بمَحْضِ اللَّبَنِ العُماهِج
عجهم: العُجهُوم: طائرٌ من طَيْر الماء منقارُهُ كجَلَمِ الخيَاط
. علهج: المُعَلْهَج: الرجل الأحمقُ المَذِر اللئيم الحَسَب المُعجب بنفسه، قال:
فكيف تُساميني وأنت معلهج ... هذارمة جعد الأناملِ حَنْكَلُ «10»
والمُعَلْهَج: الدَّعِيّ. وقال بعض الأعراب: العَلْهَج شجر ببلادنا معروف.
__________
(8) الشطر عجز بيت (للكميت) وصدره
وينصبن القدور مسمرات
انظر اللسان (عجهن) .
(9) إذا كان عرام هو ابن الأصبغ المتوفى سنة 275 هـ فلا يمكن أن يكون ممن روى عنهم الخليل، وقد فاتنا ذكر هذه الفائدة في المرات السابقة التي ذكر فيها عرام مثل الصفحة 97، وقد يكون عرام هذا غير ابن الأصبغ
(10) في حاشية التهذيب 3/ 265 ينسب إلى الأحطل والصاغاني ينفي النسبة.
(2/277)
________________________________________
عنبج: العُنْبُج: الثقيل من الناس. العُنْبُج «199» : الضَّخْم الرخْو الثقيل من كلّ شيءٍ، وأكثر ما يوصَفُ به الضِبعان، قال:
فوَلَدَتْ أعْثى ضَرُوطاً عنبجا «200»
علهص: علهَصْتَ القارورة إذا عالجتَ صمامَها لتَستخرجه «11» . وَعَلْهَصْتَ العَيْنَ إذا استخرجْتَها من الرأس علهصةً، وهو ملاجكها بإصبَعك واستخراجُكَها من مُقلتها. وعَلْهَصتُ الرجل: عالجتهُ علاجاً شديداً. وَعَلْهَصْتُ منه شيئاً: إذا نِلْتُ شيئاً. وَلحْمٌ مُعَلْهَصٌ أي لم ينضج بعد.
علهس: قال عرّام: عَلْهَسْتُ الشَّيءَ مارَستُهُ بشدَّة «12» .
همسع: الْهَمَيسَع من الرجال: القَويّ الذي لا يُصرع جَنْبُه، ويقال للطَّويل الشَّديد هَمَيْعَ. والهَميع جَدُّ عدنانَ بن أُدَد.
علهز: العِلْهزِ كان يُفْعَلُ في الجاهلية، يُعالَج الوَتر بدماءِ الحَلَمَ فيأكلونه، قال:
وإنَّ قِرى قحطانَ قِرْفٌ وَعِلْهِزٌ ... فَأَقبَح بهذا وَيحَ نَفسِك مِن فِعْلِ 1»
والعِلْهِز: القرادُ الضَّخم: والقِرفُ: نبتُ يَنْبُتُ نبْتةَ الطَّرانيث يخرجُ مع المَطر في وقت الصَّيف وفي وقت الخريف مِثلَ جِروِ القِثّاء، إلاَّ أنَّها حمراءُ مُنْتَنَةُ الريح. قال عرّام: والعِلْهِزُ يَنبتُ ببلادِ بني سليم وهو نبت
__________
(199) أدرجت هذه المادة في حشو مادة عجرم.
(200) الرجز في التهذيب واللسان (عنبج) .
(11) إلى هنا ينتهي ما جاء عن هذه الكلمة في المعجمات الأخرى. وما بقي مما تفرد به كتاب العين.
(12) لم ترد هذه الكلمة في اللسان والتهذيب.
(13) البيت من شواهد التهذيب وهو بلا غرو.
(2/278)
________________________________________
شِبْهُ الجِراءِ إلاّ أنَّها مُعَنْقَرةٌ أي لها عُنْقُرةٌ. قال: وأقول شاةٌ مُعَلْهَزَة أي ليست بسمينة «14» .
هزلع: الهِزْلاع: السِّمْعُ الأزَلُّ. وهَزْلَعَتُه: انسِلالُهُ ومُضُيُّه.
عزهل: العُزْهُل: الذَّكَرُ من الحَمام، وجمعه عَزاهِل، قال:
إذا سَعْدانةُ الشَّعَفاتِ ناحَتْ ... عَزاهِلُها، سَمِعْتَ لها عَرينا
أي بُكاءً «15» . وقالَ بعضُهم: العَزاهيلُ الجماعةُ من الإبِلِ المهمَلة، واحدُها عُزْهول، وقالَ بعضهم: لا أعرف واحدَها، قال الشَّمّاخ:
حتّى استغاثَ بأحْوَى فوقَه حُبُكٌ ... يدعُو هَديلاً به العُزْفُ العَزاهيلُ «16»
والقولُ الأول أشبه بالصَّواب. والعَزْاهِل «17» : الأرضُ لا تُنْبِتُ شيئاً، الواحدة عُزْهُلة.
زهنع: وتقول: زَهْنَعتُ المرأة وزَتَّتُّها: زيَّنْتُها بالصَّواب!؟ «18» قال:
بني «19» تَميم زَهْنِعُوا نِساءَكم ... إنَّ فتاةَ الحَيِّ بالتزتت
__________
(14) ليس هذا المعنى في أي من المعجمات سوى كتاب العين.
(15) في اللسان: قال ابن الأعرابي: العرين الصوت.
(16) لم أجد البيت في الديوان.
(17) هذا مما تفرد به كتاب العين.
(18) وردت كلمة الصواب في ص وط ولم أجدها في س ولا في المعجمات الأخرى وأظنها من تزيد الناسخ.
(19) في ص وط: أبني تميم ... ورواية البيت في اللسان:
بني تميم زهنعوا فتاتكم............... ..........
(2/279)
________________________________________
هطلع: الهَطَلَّعُ: الرجلُ الجسيم العريض المضطَرِب الطُوال «20» . ويقال: بَوْشٌ «21» هَطَلَّع أي كثير.
عيهر: العَيْهَرَةُ: الفاجرة عَهَرَتْ وتَعَيْهَرَتْ. والعَيْهَرَةُ: الشَّديدة من الإبِلِ، والتَيْهَرَةُ «22» أيضاً. ورجلٌ عَيْهَرٌ تَيْهَر أي شديد ضخم.
هرنع: الهُرْنُوع: القَمْلةُ الضَخْمة، ويقال: هي الصغيرة. قال عرّام: لا أعرفُ الهرنوع ولكنّه الهِرَنَّعة، وهو الحِنْبجُ والهُرْنُع، قال جرير:
يَهِزُ الهَرانعَ لا يَزالُ كأنَّه «23»
هزنع: الهُزْنُوع «24» ، ويقال هو بالغين المعجمة: هو أُصُول نَباتٍ شِبْهِ الطُّرْثُوث.
هرمع: الهَرْمَعَةُ: السُّرْعة. اهْرَمَّعَ في مَشْيه ومَنْطِقِهِ كالإنهِماكِ فيه اهرمّاعاً. والعَيْن تهَرَمِّعُ إذا ذَرَفَتِ الدَّمْعَ سريعاً. والنَّعْت هَرَمَّع ومُهْرَمِّع. واهْرَمَّعَ
__________
(20) في اللسان: المضطرب الطول.
(21) في اللسان: بؤس. والبوش: الجماعة.
(22) لم نجده في المعجمات ولعله من ألفاظ الإتباع.
(23) كذا في س في ص وط: يهز الهرنع ... والبيت في التهذيب 3/ 268 وروايته:
يهز الهرانع عقده عند الخصى ... يا ذل حيث يكون من يتذلل
وكذلك في اللسان. وليس في ديوان جرير. وقد نسب في التاج إلى (الفرزدق) .
(24) لم يرد في سائر المعجمات، وهو مما تفرد به كتاب العين.
(2/280)
________________________________________
إليه الرجُل أي تَباكَى. ورجُلٌ هَرَمَّعٌ: سريعُ البُكاء، والهَلَمَّعُ لغةٌ فيه عن عَرّام. والهَلْمَعَةُ والهَرْمَعَةُ: السُّرعةُ في كلّ شيءْ.
عرهم: العُراهِم: التّارُّ الناعِمُ من كلّ شيءٍ، قال: «25»
وقَصَباً عُراهِماً عُرْهوماً «26»
وقال بعضُهم: العُراهِم الطَّويلُ الضَّخْم، قال «27» :
فَعَوَّجَتْ مُطَّرِداً عُراهِما
وقال بعضُهم: العُراهِم نعْتٌ للمؤنَّث دونَ المذكَّر. وقال آخر: الذَّكرَ عُراهِم والأُنْثى عُراهِمة.
عبهر: العَبْهَر: اسْمٌ للنَّرجِس، ويقال للياسَمين. وجاريةٌ عَبْهَرَةٌ: رقيقةُ البَشَرَة ناصعةُ البَياض، قال:
قامَتْ تُرائيكَ قَواماً عَبْهَرا «28»
العَبْهَر: الناعم من كلّ شيءٍ، قال الكميت:
مِلء عينِ السَّفيه تُبْدي لك الأشنب ... منها والعبهر الممكورا «29»
__________
(25) التهذيب 3/ 269 غير منسوب أيضا.
(26) ورواية الرجز في التهذيب:
وقصبا عفاهما عرهوما
(27) لم نهتد إليه.
(28) جاء في اللسان: وأنشد (الأزهري

قامَتْ تُرائيكَ قَواماً عَبْهَرا ... منها ووجها واضحا وبشرا
لو يدرج الذر عليه أثرا
(29) لم أجد البيت في شعر (الكميت) .
(2/281)
________________________________________
ورَجُلُ عَبْهَر أيْ ضَخْم، وامْرأةٌ عَبْهَرَةٌ، ويُجْمَعُ عَباهِر وعَباهير، قال «30» :
عَبْهَرَةُ الخَلْقِ لباخية ... تزينه بالخلق الظاهر
علهب: العَلْهَب: التَّيسُ الطويل القَرْنَيْن من الوَحْشِيَّة والإِنْسِيّة ويوصف به الثَّور الوحشيُّ، وجمعه عَلاهِب، قال جرير.
إذا قَعِسَتْ ظهورُ بنات تَيْمٍ ... تَكشَّفُ عن عَلاهِبةِ الوُعُولِ
أي عن بُظُورٍ «31» كأنَّها قُرونُ الوُعُول. والعَلْهَب: الرجُلُ الطَّويلُ، والمرأةُ بالهاء.
عبهل: ومَلِكٌ مُعَبْهَل: لا يُرَدُّ أمرُه في شَيْءٍ.
هبلع: والهِبْلَع: الأَكُولُ، العظيمُ اللَّقْم، الواسِعُ الحُنْجُور، وأنشَدَ عرّام «32» :
وُضِعَ الخزيرُ فقيلَ أينَ مُجاشِعٌ ... فشَحَا «33» جَحافِلَه جراف هبلع
__________
(30) هو (الأعشى) . ديوانه/ 139 وفيه: بلاخية.
(31) كذا في الأصول المخطوطة وفي اللسان: بطون.
(32) البيت (لجرير) . نظر الديوان ص 437، وانظر هامش مادة عجهن.
(33) كذا في س واللسان. في ص وط: فشجا.
(2/282)
________________________________________
والهِبْلَعُ من أسماء الكلابِ السَّلُوقيَّة، قال العجّاج:
والشَدُّ يدني لا حقا وهِبلَعاً «34»
هلبع: الهُلابع: اللئيمُ الجَسيمُ الكُرَّزيُّ، قال:
وقُلْتُ لا آتي «35» زُرَيْقاً طائِعاً ... عبد بني عائشة الهلابعا
هملع: الهَمَلعَّ: الرجُلُ المُتَخطِرفُ الذي يُوَقِّع وَطْأه تَوقيعاً شديداً، قال:
رأيت الهَمَلَّع ذا اللعوتين ... ليس بآبٍ «36» ولا ضَهْيَدِ
ضَهْيَد كلمة مُوَلَدة لأنَّها على بناء فَعْيَل، وليس فَعْيَل من بناء كَلام العرب، قال:
جاوَزْتُ «37» أهوالاً وتَحْتيَ شَيْقَبٌ «38» ... يَعْدو برحْلي كالفنيق هَمَلَّعُ
هنبع: الهُنْبُع والخُنْبُع: من لِباس النِّساء شِبْهُ مِقْنَعةٍ خِيط مُقدَّمُها تلبَسها الجواري. ويقال: الهُنْبُع ما صَغُر، والخُنْبُع: ما اتَّسَعَ حتّى يبلُغَ اليَدَيْن «39» ويُغطِّيهما.
__________
(34) الرجز (لرؤبة) ديوانه ص 90، وفيه: والشد يذري....
(35) كذا في س والتهذيب في ص وط: زريعا.
(36) كذا في س والتهذيب أما في ص وط ففراغ.
(37) في الأصول المخطوطة: تجاوزت.
(38) اللسان (هملع) ، غير منسوب أيضا.
(39) كذا في اللسان والتهذيب. في الأصول المخطوطة: الثديين.
(2/283)
________________________________________
عفهم: العُفاهِم: النّاقةُ الجَلْدة، ويجمَعُ عَفاهيم، قال:
يَظَلُّ من جاراه في عذائم ... من عنفوان جريه العفاهم «40»
يصفُ أوَّل شَبابه وقوّته. وفي لغة عُفاهِن، بالنُّون، والنُّون يجعَلُونَها بدلاً من اللام، يقولون: اسماعِين في اسماعيل واسرافين وقد رُوِيَ في الحديثِ بالنّون. وقال:
وقَرَّبوا كلّ وأًي عُراهِمِ ... من الجَمالِ الجِلَّة العَفاهِمِ
علهم: العُلاهِمُ والعُلاهِمةُ «41» : القويّة الشّديدة من الإبل، وجمعُه عَلاهيم.
خضرع: الخُضارِعُ: البخيل المُتَسَمِّحُ وتَأْبَى شِيمتُه السَّماحة. وهو المُتَخضرِع.
خرعب: الخُرْعُوبة «42» : القطعةُ من القَرْعة والقِثّاء والشَّحْم. الخَرْعَبَةُ: الشَّابةُ الحسَنةُ القوام، وكأنَّها خُرعُوبةٌ من خَراعيب الأغصان من بَنات سَنَنها. ويقال: جَمَل خُرْعُوب أيْ طويلٌ في حُسْن خلق.
__________
(40) التهذيب 3/ 269 ونسب فيه إلى غيلان.
(41) في التهذيب 3/ 273 العلهم بكسر فسكون ففتح فتشديد الضخم العظيم من الإبل، وأنشد:
لقد غدوت طاردا وقانصا ... أقود علهما أشق شاخصا
(42) كذا في الأصول المخطوطة واللسان في التهذيب: الخذعوبة.
(2/284)
________________________________________
خثعم: خَثْعَمٌ: اسمُ جبَل، فمن نَزَلَ به فهو خَثْعَميٌّ، وهم خَثْعَميُّون. وخَثْعَم: اسم قبيلة وافق اسمُها اسم الجبَل «43»
ختعر: الخَيْتَعُور: ما بَقيَ من السَّرابِ من آخره حتى يَتَفَرَّقَ فلا يَلْبَث أن يضمَحِلَّ. وخَتْعَرَتُه: اضْمِحلالُه. ويقال: بَل الخَيْتَعُور دُوَيْبة على وجْه الماء لا تَلْبَثُ في مواضِع «44» إلاّ رَيْثَما تَطْرِف. وكلّ شيءٍ لا يدُومُ على حالٍ ويَتَلَوَّنُ فهو خَيْتَعُور. والخَيْتَعُور: الذي يَنْزِل من الهواءِ أبيضَ كالخُيوط أو كَنَسْج العَنْكبُوت. والدُّنيا خَيْتَعُور، قال 4»
:
كُلُّ أُنْثَى وإنْ بدا لك منها ... آيةُ الحُبِّ، حُبُّها خَيْتَعُورُ
والغُول: خَيْتَعُور. والذّئبُ خَيْتَعُور لأنّه لا عَهْدَ له، قال «46» :
ماذا «47» يُتمُكَ والخَيْتَعُور ... بدارِ المَذَلَّةِ والقَسْطَلِ
ويقال: هو الداهية هاهنا.
خرفع: الخُرْفُعُ: القُطْن الذي يَفسُدُ في براعيمه.
خنبع: الخُنْبُعةُ: شِبهُ القُنْبُعة تُخاطُ كالمِقْنَعة تُغَطِّي المَتْنَيْن. والخُنْبُعُ أوسَعُ وأعرَفُ عند العامّة. والخُنْبُعَةُ: مَشَقُّ ما بين الشاربين بحيال الوترة.
__________
(43) في الأصول المخطوطة: اسمه.
(44) كذا في الأصول المخطوطة في التهذيب: موضع.
(45) لم نتبين قائل البيت في كثير من المصادر.
(46) لم نهتد إلى قائل البيت.
(47) لعله: وماذا.
(2/285)
________________________________________
قعضب: القعْضَبُ: الضَّخْم الشَّديدُ الجَريء. والقَعْضَبَةُ: استِئصال الشَّيء. وقَعْضَبٌ: اسمُ رجل كان يعمَلُ الأسِنَّة في الجاهلية، وهو الذي ذكرَه طفيل الغنوي:
وعُوْج «48» كأحْناءِ السَّراءِ مطت بها ... ضراغم «49» تهديها أسِنَّةُ قَعْضَبِ
دعشق: الدُّعْشُوقةُ: دويبة شِبْهُ خُنْفُساء. وربَّما قالوا للصَّبيَّة والمرأةِ القصيرة: يا دُعْشُوقةُ، تشبيهاً بتلك الدُّوَيْبة، وليستْ بعربيّةٍ مَحْضَةٍ لتَعْريتها من حروف الذلق والشفوية.
قعشم: والقَشْعَمُ: النَّسْرُ المُسِنُّ والرَّخَم والشَّيخُ الكبيرُ فإذا شدَّدت الميم كَسَرتَ القافَ. وكذلك بناءُ الرُّباعِيِّ المُنْبسط إذا ثُقِّلَ آخرُه كُسِرَ أوَّله كقول العجّاج:
إذ زعمت ربيعةُ القِشْعَمُّ «50»
وتُكنى الحَرْبُ أم قَشْعَم. والضَّبع يُكنى به أيضاً.
عشرق: العِشْرِقُ: حَشيش وَرَقُه شبيه بوَرَق الغار إلاّ أنَّه أعظم، إذا حَرَّكَتْه الرِّيحُ سَمِعتَ له زَجَلاً شديداً، قال الأعشى:
__________
(48) كذا في الديوان ص 5 في الأصول المخطوطة: وعرج.
(49) كذا في س وقد سقطت من ص وط. وهي في الديوان: مطارد.
(50) ديوانه/ 422.
(2/286)
________________________________________
تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت ... كما استعان «51» بريح عِشْرِقٌ زَجِلُ
ويقال: هي شَجَرة كشَجَرة الباقِلَّى لها سِنْفَة «52» كسِنْفِة الباقِلَّى وهو وِعاء «53» حَبِّهِ، أي قِشره عليه، وقال «54» :
لولا الأماضيحُ وحَبُّ العِشْرِقِ ... لَمِتُّ بالنَّزْواءِ مَوتَ الخِرْنِقِ
خَصَّ الخِرْنِق لأنّه يموتُ سريعاً.
عشنق: والعَشَنَّق: الطويلُ الجسيم. وهو العَشَنَّظ أيضاً. وامرأةً عَشَنَّقةٌ: طويلة العُنُق. ونَعامَةٌ عَشَنَّقة. والجميع عَشانِق وعَشانيق وعَشَنَّقُون «55» .
قشعر: القُشْعُر: القِثّاء بلغةِ أهل الجَوْفِ من اليَمَن. الواحدة بالهاء. ويقال: القُشَعْريرة، العَيْنُ ساكنةٌ: اقشِعْرار الجِلْد من فَزَعٍ ونحوه. وكُلُّ شيءٍ تَغَيَّر فهو مُقْشَعِرٌ. واقشَعَرَّتِ السَّنَةُ من شِدَّة المَحْل. واقشَعَرَّتِ الأرضُ من المحل، والجِلْدُ من الجَرَبِ.
__________
(51) ديوانه/ 55.
(52) كذا في س في ص وط: سنقة بالقاف وهو تصحيف.
(53) كذا في ص وط في س: دواء.
(54) لم نهتد إلى القائل.
(55) إذا كان وصفا للعاقل المذكر.
(2/287)
________________________________________
واقشَعَرَّ النَّباتُ إذا لم يجدْ رِيّاً. والقُشَعريرة مثلُ الإقشعرار، قال «56» .
أصْبَحَ البيتُ بيتُ آلِ بَيانٍ «57» ... مُقْشَعِرّاً والحيُّ حَيُّ خَلوفُ
صقعر: الصُّقْعُرُ: الماءُ المُرُّ الغَليظ.
عرقص: العُرْقُصاء والعُرَيْقِصاء: نَبات يكون بالباديةِ. وبعضٌ يقول للواحدة: عُرَيْقصانة، والجميع: عُرَيْقِصان. ومن قال: عُرَيْقصاء وعُرْقُصاء فهو في الواحدة والجميع ممدودٌ على حالٍ واحدة.
قصعر: القِنْصَعْرُ: القصير العُنُق والظَّهْر المُكَتَّل من الرجال، قال:
لا تَعْدِ لي بالشَّيْظَم السِّبَطْر ... الباسِطِ الباعِ الشَّديدِ الأسْرِ
كلُّ لئيمٍ حَمِقٍ قِنْصَعْرِ «58»
وامرأةً قِنْصَعْرة. ويقال: ضَرَبْتُه حتى اقعَنْصَرَ أي تقاصَرَ إلى الأرض.
صعفق: الصَّعافِقَةُ: قومٌ يَشْهَدون السُّوق للتِّجارة ليست لهم رءوس الأموال، فإذا اشتَرَى التُّجّار شيئاً دخلوا معهم. الواحدُ صَعْفَقٌ وصَعْفَقيٌّ، ويُجمعُ على صَعافيق وصَعافِقة، قال أبو النجم:
__________
(56) هو (أبو زبيد الطائي) كما في التهذيب واللسان.
(57) كذا في التهذيب واللسان في ص وط:
أصبح البيت بنت البنان
وفي س:
أصبح النبت نبت آل بنان
(58) كذا في الأصول المخطوطة و (اللسان أما في التهذيب فبضم القاف.
(2/288)
________________________________________
بهم «59» قَدَرنا والعزيزُ مَنْ قَدَرْ ... وآبتِ الخَيلُ وقَصَّينا الوَتَر «60»
من الصَّعافيق وأدْرَكْنا المِيَر «61»
ويقال: الصَعْفُوق اللِّصُّ الخَبيث. والصَّعْفُوقُ: اللئيم من الرجال، وكان آباؤهم عَبيداً فاسْتَعْرَبوا قال العجّاج:
من آلِ صَعْفُوقٍ وأتباعٍ أُخَرْ «62»
قال أعرابيٌّ: هؤلاء الصَّعافِقة عندَك، وهم بالحجاز مسكنهم، وهم رُذالةُ الناس. ومنهم من يقول بالسين.
صلقع، سلقع: الصَّلْقَعُ والصَّلْقَعَةُ: الإعدامُ. تقول: صَلْقَعَةُ بنُ قَلْمَعةَ: أي ليسَ عنده قليلٌ ولا كثير، لأنّه مُفْلِسٌ وأبوه مِن قَبله، فلذلك قال: ابنُ قَلْمَعة. يقال: صَلْقَعَ الرّجل فهو مُصَلْقِعٌ أي عَديم مُعدم، ويجُوز بالسين. وهو نَعْتٌ يَتْبَعُ البَلْقَعَ، يقال: بَلْقَعٌ سَلْقَعٌ وبَلاقِعُ سَلاقِعُ، ولا يُفرَدُ. والسَّلْقَعُ: الأرضُ التي ليسَ فيها شَجَرٌ ولا شَيْءٌ. والسَّلْقَعُ: المكان الحَزْنُ، والحَصَى إذا حَمِيتْ عليه الشَّمْسُ. وتقول: اسلَنْقَعَ بالبَرْقِ واسْلَنْقَعَ البَرْقُ إذا استَطارَ في الغيم، وإنَّما هي خَطْفَةٌ لا لُبْثَ لها. والسِّلِنْقاعُ: الاسم من ذلك.
__________
(59) الرجز في التهذيب واللسان على النحو الآتي:
يوم قَدَرنا والعزيزُ مَنْ قَدَرْ
(60) كذا في ص وط في س والتهذيب واللسان:
وآبت الخيل وقضينا الوطر
(61) كذا في الأصول المخطوطة، في التهذيب واللسان: المئر.
(62) وبعده:
من طامعين لا يبالون الغمر
ديوانه/ 12.
(2/289)
________________________________________
عسلق: وكل سَبعً جريءٍ على الصَّيْد فهو عَسْلَق وعَسَلَّقٌ «63» ، والأنثى بالهاء. [والجميع] «64» عَسالِق. والعَسَلَّقُ: اسمٌ للظَّليم خاصَّة، قال «65» :
بحيثُ يُلاقي الآبداتِ العَسَلَّقُ
عسقل: والعُسْقُولةُ: ضَرْبٌ من الجَبْأَةِ «66» ، وهي كَمْأَة لَونُها بين البياض والحُمْرة، ويُجْمَعُ عَساقِل، قال:
ولقد جَنَيْتُك أكمُؤاً وعَساقِلاً ... ولقد نَهيتك عن بناتِ الأَوْبَرِ
[وكان في النُسْخة كلاهما، يعني العُسْلوق والعُسقولة. ورجلٌ عَسْلَق، وامرأة بالهاء] «67» ، إذا كان خفيف المَشْي سريعاً. والعَسْقَلَةُ والعُسْقُولُ: لَمْعُ السَّراب وقِطَع السَّراب، ويجمع عَساقيلَ، قال «68» :
جَرَّدَ منها جُدَداً عَساقِلا ... تَجريدَكَ المصقُول والسَّلائلا
وعَسْقَلان «69» : موضع بالشام من الثغور «70» .
__________
(63) في الأصول المخطوطة: وعسليق، ولا وجود للعسليق في أي معجم.
(64) زيادة وهي مما يقتضيه الأمر.
(65) الشطر للراعي كما في التهذيب واللسان. وروايته في الأصول المخطوطة:
بحيث يلاقي الآبدات العسلقا
(66) كذا في س والتهذيب في ص وط: الجناة.
(67) وهذه العبارة من غير شك إضافة من الناسخ وقد حصرناها بين قوسين.
(68) هو (رؤبة بن العجاج) والرجز في (ديوانه ص 125 وروايته:
جدد منها جُدَداً عَساقِلا ... تَجريدَكَ المصقولة السلائلا
وفي ص وط: المسقول والسلائلا.
(69) كذا في س وص أما في ط: عسلقان.
(70) كان الأمر مختلطا بين اللادتين (عسلق) و (عسقل) فأرجعنا إلى كل منهما ما يخصه.
(2/290)
________________________________________
عسقف: العَسْقَفَةُ «71» : نقيض البُكاء. ويُقال: بَكَى فلانٌ وعَسْقَفَ أي جَمَدتْ عينُه فلم تَبْكِ. وكذلك إذا أرادَ البكاءَ فلم يقدِرْ عليه.
فقعس: فَقْعسُ: حَيٌّ من بني أسد.
صقعب: الصَّقْعَبُ: الطويل من الرجال.
عسقب: العِسْقِبةُ: عُنَيقيدٌ يكون منفرداً بأصل العُنْقُود الضَّخْم ويُجمعُ عَساقِب وعِسْقِب «72» .
قعمس وجعمس: القُعْمُوسُ والجُعْمُوسُ، ويقال بالصاد، قَعْمَصَ فلان إذا أبْدَى بمَرَّةٍ ووضع بمرّة. ويقال: قد تحرَّكَ قُعْمُوصُه في بَطْنه. والقُعْمُوصُ: ضربٌ من الكَمْأة.
قعسر: القَعْسَريُّ «73» : الرّجل الضَّخْمُ الشَّديدُ. وهو القَعْسَرُ أيضاً، قال العجّاج:
والدَّهْرُ بالإنسان دَوّاريُّ ... أفْنَى القرون وهو قعسري «74»
__________
(71) في اللسان: العسقبة جمود العين وقت البكاء. قال الأزهري: جعله الليث العسقفة بالفاء، والباء عندي أصوب.
(72) مثل ثمر وثمرة وقصيد وقصيدة.
(73) في التهذيب: وقال الليث: القعسري الجمل الضخم. وفي اللسان: القعسري من الرجال: الباقي على الهرم.
(74) الرجز في ديوان العجاج ص 310 وروايته فيه:
أفنى القرون وهو قسعري ... والدهر بالإنسان دواري
(2/291)
________________________________________
يصف الدَّهْرَ. والقَعْسَريُّ: الخَشَبَةُ التي تُدارُ بها الرَّحَى القصيرةُ التي تَطْحَنُ باليَد، قال:
الزَمْ بقَعْسَريِّها ... وألقِ في خُرْتيِّها «75»
تُطْعِمُكَ من نَفيِّها «76»
خُرتُيُّها: فَمُها تُلْقَى فيه اللُّهْوةُ. وعَبْدٌ قَعْسَرٌ: جَيِّدُ السَّقْيِ شديدُ النَّزْع. وقَعْسَرَ فلانٌ في مَشْيِهِ: إذا مَشَى مَشْياً مُتقاعِساً.
عقرس: عِقْرِسٌ: حيٌّ من اليمن
قنعس: القِنْعاسُ: الرّجلُ السَّيَّد المنيعُ. والقِنْعاسُ: الجَمَلُ الضَّخْمُ، قال جرير:
وابنُ اللَّبُونِ إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ ... لم يَسْتَطِعْ صَوْلةَ البُزْلِ القَناعيسِ
قنزع: القَنْزَعة والقُنْزُعة: التي تَتَّخِذُها المرأةُ على رأسها. والقَنْزَعةُ: الخصْلةُ من الشَّعر التي تُترَكُ على رأس الصَّبيّ، وتُجمَعُ قَنازِعَ، قال الكميت:
عاري المغَابِن لم يعبرُ بجُؤْجُئِه ... إلا القَنازعُ من زيزائه الزغب 7»
__________
(75) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة والتهذيب خريها. وروي خريها بالباء في اللسان.
(76) كذا في اللسان وص في التهذيب وط وس: نقيها بالقاف.
(77) لم نهتد إليه في شعر الكميت.
(2/292)
________________________________________
يقول: انْتُتِفَ شَعُر صَدرِه. والزِيزاءُ: عَظمُ الزَّوْر. والقُنْزُعة: ما يُتْرَك على قَرْنَي الرَّأس للصبيِّ من الشَّعر القصير لا من الطَّويل. والقُنْزُعةُ من الحجارة: أعظَمُ من الجَوْزة. القُنْزُعةُ «78» : المرأة القصيرةُ جداً «79» .
عنقز: العَنْقَزُ: من المَرْزَنْجُوش، قال الأخطل «80» :
ألا آسلَمْ سَلِمْتَ أبا خالدٍ ... وحيَّاكَ ربُّكَ بالعَنْقَزِ
وقال بعضهم: العَنْقَزُ جُرْدانُ الحِمار. والعَنْقَزُ: السمُّ الذُّعافُ «81»
قلعط: اقلَعَطَّ الشَّعرُ واقلَعَدَّ: وهو الجَعْدُ الذي لا يطولُ ولا يكونُ إلاّ مع صَلابةٍ. وقد اقلَعَطَّ الرّجل اقلِعْطاطاً، قال:
بأَتْلَعَ مُقْلَعِطِّ الرأسِ طاطِ «82»
أي مُنحدرٌ مُنْخَفِض، وقال غيرُه: اقْلَعَطَّ واقْلَعَدَّ واجْلَعَدَّ إذا مَضَى في البلاد على وجهه. والمُقْلَعِطُّ من الشَّعر: القصير.
__________
(78) كذا في الأصول المخطوطة واللسان أما في التهذيب: المقنزعة.
(79) جاء بعده: هذا في نسخة الحاتمي، وفي نسخة أخرى: القنزعة: المرأة الصغيرة جدا. وهذه أول إشارة إلى النسخ التي أخذت منها نسخ العين المخطوطة التي بين أيدينا وفيها نسخة الحاتمي ونسخة أخرى. وما حصر بين القوسين من كلام الناسخ.
(80) في اللسان: قال (الأخطل) يهجو رجلا. وروايته في التهذيب: أسلم سلمت ...
(81) لا توجد الذعاف في التهذيب فيما نقله عن الليث. وزاد: وقيل العنقز الداهية.
(82) كذا في التهذيب واللسان في الأصول المخطوطة: طاطي.
(2/293)
________________________________________
قمعط: اقمَعَطَّ [الرجل] «83» : عَظُم أعلى بَطْنِه وخمِصَ أسفلُه. [والقُعْمُوطة والقُمْعُوطة] «84» والبِقْعُوطة: دُحْروجة الجُعَل «85» .
قعطر: اقْعَطَرَّ الرجل: إذا انقَطَعَ نَفَسُه من بُهْرِ.
عندق: العَنْدَقةُ: مَوْضِعٌ في أسفل البَطْنِ عند السُرَّة كأنَّها ثَغْرةُ النَّحْر في الخِلْقَةِ.
عنقد: والعُنْقُودُ من العِنَب، وحَمْلُ الأراكِ والبطم ونحوه.
قردع: القردوعة: الزّاويةُ في شِعْبِ جَبَل، قال:
منَ الثَياتِلِ مَأْواها القَراديعُ
والقُرْدوعةُ أيضاً: أعلَى الجَبَل.
درقع: الدَّرْقَعَةُ: فِرارُ الرجُلِ من الشَّدة «86» ، قال:
وإنْ ثارَتِ الهَيْجاءُ وِلَّى مُدَرْقِعاً
وهو المُدَرْنقِعُ أيضاً. والدَّرْقَعَةُ: سُرعةُ المَشْيِ. جاءَ يُدَرْقِعُ أي يَمشي مَشْياً شديداً. والمُدْرَنْقِعُ في العَدْوِ.
__________
(83) مما يقتضيه السياق.
(84) مما نقله الأزهري في التهذيب عن الليث.
(85) وزاد الأزهري في التهذيب والعريقطة دويبة عريضة من ضرب الجعل عن الليث.
(86) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة والتهذيب: الشديدة.
(2/294)
________________________________________
قمعد: المُقْمَعِدُّ: الذي تُكَلِّمُه بجُهْدكَ فلا يَلينُ ولا يَنْقادُ. كَلَّمْتُه فاقْمَعَدَّ اقمِعداداً أي: انقَبَضَ. ومثله اقْمَهَدَّ.
عرقد: العَرْقَدَةُ: شدَّة فَتْلِ الحَبْلِ ونحوه من الأشياء كُلِّها.
ذعلق: الذُّعْلُوقُ «87» : نَباتٌ بالباديةِ.
قذعر: المُقْذَعِرُّ: المُتَعَرِّض للقَوْم ليدخُلَ في أمرهِم وحديثهم. ويَقْذَعِرُّ نَحوهم: يَرْمي بالكلمةِ بعد الكلمة وَيَتَزَحَّفُ نحوهم «89» وإليهم.
قذعل: والمُقْذَعِلُّ: السريع من كل شيء، قال:
إذا كُفيتُ أكْتَفي وإلاّ ... وَجَدْتَني أَرْمُلُ مُقْذَعِلاّ
قال غير الخليل «90» : المُقْذُعِلُّ السريع من كل شيء، والمقذعِرّ الخبيث اللسان مُقْذَعِلاًّ. قال: ويُروى مُشمعلاًّ «91» .
ذلقع: المُذْلَنْقِعُ «92» الذي قد انْخَلَعَ أيْ وَضَعَ جِلْبَابَ الحَياءِ فلا يبالي بشيء.
__________
(87) لم يرد هذا المعنى في التهذيب بل جاء في هذه المادة فوائد كثيرة أخرى.
(89) سقطت في التهذيب مما نقله الأزهري عن الليث.
(90) هذا مما أضافه النساخ.
(91) لقد جاء هذا في مادة منفردة بعد الكلام على (ذلقع) وآثرنا أن نرده إلى مكانه وذلك من قوله: قال غير الخليل.
(92) لم نجد هذه المادة في اللسان.
(2/295)
________________________________________
قنذع: القَنْذَعُ والقُنْذُع «93» ، بالفتح والضّمّ: الدَّيُّوثُ، وأظُنُّها بالسُّريانية.
قرثع: القَرْثَعُ: المرأةُ الجَريئةُ القليلةُ الحَياء.
قعثب: القَعْثَب: الكثير. والقُعْثُبان: دُوَيْبة كالخُنْفساء تكونُ على النَّبات، والقَعْثَبان أيضاً.
عرقب: عَرْقَبْتُ الدّابّةَ: قَطَعْتُ عُرْقُوبَها. والعُرْقُوبُ: عَقِبٌ مُوَتَّرٌ خلف الكَعْبَيْنِ، ومن الإنسانِ فُوَيق العَقِب، ومن ذَوات الأرْبَع بين مَفْصِل الوَظيف ومَفْصِل الساقِ من خَلْفِ الكَعبَيْنِ. والعُرقُوبُ من الوادي: مُنْحَنى فيه التِواءٌ شديد، قال:
ومَخُوفٍ من المناهل وحش ... ذي عراقيب آجِنٍ مدفانِ «94»
والعُرْقُوبُ: طريقٌ يكون في الجَبَل مُصَعِّداً. تَعَرْقَبْتُ الجَبَلَ: أي صَعِدتُ فيه. وعَراقيبُ الأمور: عَصاويدُها وادخال اللَّبْس فيها. وعُرْقُوبُ: رجلٌ من أهل يَثْرب أكْذَبُ أهل زَمانِه موعداً، فذَهَبَتْ مَثلاً، قال كَعْبُ بنُ زُهَير:
كانَتْ مَواعيدُ عُرْقوبٍ لها مَثَلاً ... وما مواعيدها إلا الأباطيل
__________
(93) في اللسان: القندوع والقندع (بضمتين) وبالدال، والقنذع بالضم والفتح والذال المعجمة، والقنذع (بضمتين) والقنذوع بالذال أيضا.
(94) البيت غير منسوب في اللسان والتهذيب.
(2/296)
________________________________________
وقال آخرُ:
وأكْذَبُ من عُرقُوبِ يَثْربَ لهجةً ... وأبْيَن شُؤْماً في الكَواكبِ من زُحَلْ «95»
وفي مَثَلٍ للعَرَب: مَرَّ بنا يومٌ أقْصَرُ عُرقُوبِ القَطا «96»
، يريدُ ساقَها. ويقال: أقْصَرُ من إبهامِ القَطاةِ، قال:
ويَوْمٍ كإبهامِ القَطاةِ مُمَلَّحٍ ... إليَّ صباه، مُعجِبٌ لِيَ باطِلُهْ «97»
قرعب: واقْرَعَبَّ البَرْدُ اقرِعباباً، واقْرَعَبَّ الانسانُ: أي قَعَدَ مُسْتَوْفِزاً.
عقرب: العَقْرَبُ: الأنثى والذَّكر فيه سواءٌ والغالِبُ التأنيث. ويقالُ للرّجل الذي يَقرِضُ النّاسَ: إنَّه لتدِبُّ عَقارِبُه. والعَقْرَبُ: سَيْرٌ مَضْفُورٌ في طَرَفه إبْزيمٌ يُشَدُّ به تَفَرُ الدّابّةِ في السَّرْج. والدّابّة مُعَقْرَبَةُ الخَلْقِ أي مُلَزَّزٌ مُجَمَّعٌ شديدٌ، قال العجّاج:
عَرْدَ التَراقي حَشْوَراً مُعَقْرَبا ... شَذَّبَ عن عَاناتِه ما شَذَّبا
والعَقْرَبُ: حَديدةٌ تكونُ في سَيْرٍ في مُؤَخَّر السَّرج، يُعَلَّقُ فيه الشَّيْء، أو يُكَلَّبُ به الدرْع. والعَقْرَبُ: بُرْجٌ في السَّماء، وهو بُرْجُ العَقْرَب، وطُلُوعُها في حَدِّ الشِّتاء. وقال قائل: إذا طَلَعَتِ العَقْرَبُ جَمَسَ «98» المُذَنِّب «99» وفَرَّ الأشيب ومات الحندب. قولُه: جَمَسَ أي: صارَ تمرا، ويقال:
__________
(95) لم نهتد إلى قائل البيت.
(96) في ط: أقصر مثل عرقوب القطاة.
(97) لم نهتد إلى القائل.
(98) كذا في الأصول المخطوطة، وفي اللسان (حمس) وهو تصحيف.
(99) هذا هو الوجه، وفي التهذيب واللسان: المذنب (بكسر الميم وفتح النون) .
(2/297)
________________________________________
لا بَلْ يَبقَى بُسْراً على حاله فلا يرطب، يعني: لا يَصِرُّ الجُنْدُب لِشدَّة البَرْد. والعُقْرُبان: دُوَيْبة، يُقال هو دَخَّال الآذان. ويقالُ: العَقْرَبان هو العَقْرَبُ الذَّكر.
عبقر: عَبْقَرٌ: موضعٌ بالبادية كثير الجنِّ. يقال: كأنَّهم جِنٌّ عَبْقَر، قال زهير:
بِخَيْلٍ عليها جِنَّةٌ عَبْقَريَّةٌ ... جَديرونَ يَوْماً أن يَنالوا فيَسْتَعلوا «100»
والعَبْقَرَةُ: المرأةُ التارَّةٌ الجميلةُ، قال الشاعر «101» :
تَبَدَّلَ حِصْنٌ بأزواجِهِ ... عِشاراً وعَبْقَرةً عَبْقَرا
أراد: عَبْقَرَةً عَبْقَرَةً، فذهَبَتِ الهاء في القافية وصارَت ألفاً بَدَلاً للهاء. والعَبْقَريُّ: ضربُ من البُسُط، الواحدة بالهاء، وقال بعضهم: عَباقِريّ، فإن أرادَ بذلك جَمْعَ عَبْقَريٍّ، فإنَّ ذلك لا يكون لأنَّ المنسوبَ لا يُجْمَعُ على نِسبةٍ ولا سيَّما الرباعيُّ، لا يُجْمَعُ الخثعمي بالخَثاعِميِّ ولا المُهَلَّبِيِّ بالمَهالِبيِّ، ولا يجوز ذلك ألا أن يكونَ يُنسب اسمٌ على بناء الجماعة بعدَ تَمامِ الاسم نحو شَيءٍ تنسِبُه إلى حَضاجِر وسَراويل فيقال: حضاجري وسَراويليٌّ، ويُنسب كذلك إلى عَباقِر فيقال: عَباقِريٌّ. والعَبْقَرةُ: تَلألُؤ السَّراب.
برقع: البُرْقُعُ: تَلْبَسُهُ الدَّوابُّ ونِساءُ الأعراب، فيه خَرْقان للعَيْنَين، قال «102» :
وكُنْتُ إذا ما زُرْتُ ليلى تَبَرْقَعَتْ ... فقد رابَني منها الغداة سفورها
__________
(100) شرح ديوان زهير ص 103.
(101) في التهذيب: الشاعر (مكرز بن حفص) .
(102) قائل البيت هو (توبة بن الحمير) كما في التهذيب.
(2/298)
________________________________________
فرقع: الفرقعة: [أن] تنقص الأصابع. وفَرْقَعَ أصابِعَه فَتَفَرْقَعَت. وتقول: افرَنْقِعُوا عنَّا: أي تَنَحَّوْا. وافْرَنْقَعَ: إذا قَعَدَ مُنْقَبِضاً.
عفقر: العَنْقَفير: داهِيةٌ من دَواهي الزَّمان، تقولُ: غُولٌ عَنْقَفير.
عرقل: العِرْقيلُ: صُفْرةُ البَيْض، قال الشاعر:
طِفلةٌ تَحسَبُ المَجاسِدَ منها ... زَعْفَراناً يُدافُ أو عرقيلا «103»
عنقر: العُنْقُر: أصلُ القَصَب ونحوه أوَّل ما ينبت، وهو رِخْوٌ غَضٌّ، الواحدة: عُنْقُرةٌ، وذلك قبل أن يظهَرَ في الأرضِ. ويقال لأولاد الدَّهاقين: عُنْقُر، شَبَّههُم بالعُنْقُر لترارتِهم ورُطُوبَتهم، قال «104» :
كعُنْقُرات الحائط المَسْطُور
قفعل: اقْفَعَلَّتْ أنامِلُه: إذا تَشَنَّجَتْ من بردٍ أو كبرٍ. وفي لغة: اقْلَعَفَّ اقْلِعْفافاً، قال:
رأيتُ الفَتَى يَبْلَى وإنْ طالَ عُمُره ... بِلَى الشنِّ حتى تَقْفعِلَّ أناملُه «105»
__________
(103) ويروى غرقيلا بالغين المعجمة كما في التهذيب.
(104) قائل الرجز (العجاج،) الديوان ص 223 وروايته فيه:
كعنقرات الحائط المسطور
وروايته في التهذيب:
كعنقرات الحائط المسجور
(105) لم نهتد إلى قائل البيت.
(2/299)
________________________________________
والبعيرُ يَقْلَعِفُّ إذا ضَرَبَ النّاقةَ فانضمَّ إليها يصيرُ على عُرقُوبَيْهِ مُتَعَمِّداً عليها، وهو في ضِرابِها يقال: اقْلَعَفَّها. واقْلَعَفَّ الرّجل: إذا تَقَبَّضَ. وإذا مدَدْت الشيءَ ثمَّ أرسَلْتَه فانْضَمَّ قلت: قد اقْلَعَفَّ.
عفلق: العَفْلَقُ: الفَرْجُ إذا كان واسعاً رِخواً، قال:
يا ابنَ رَطومٍ ذاتِ فَرْجٍ عَفْلَقِ
والعَفْلَقُ من الرّجال: الوَخْمُ الضَّخْم.
علقم: العَلْقَم: شَجَر الحَنْظَل، القِطْعَة: عَلْقَمةٌ.
قمعل: القُمْعُلُ: القَدَحُ الضَّخْم بلغةِ هُذَيْل، قال:
كالقُمْعُل المُنْكَبِّ فوقَ الأتْلَبِ «106»
الأتْلًب: التُّراب. يَنْعَتُ حافِرَ الفَرَس.
قعبل: «107» رجلٌ مُقَعْبَلُ القَدَمَيْن: إذا كان شديدَ القَبَل، اعْوِجاجُ صَدْرِ القَدَم مُقْبلاً إلى الأخرى وتلقبُه فتقول: يا قَعْبَل. (والقِعْبِل: ضربٌ من الكَمْأة ينبُت مُستطيلاً كأنّه عود فإذا يَبسَ وصارَ له رأسٌ مثلُ الدُّخْنَةِ «108» السَّوداء سمِّيتْ فوات الضباع) «109» .
__________
(106) الرجز في التهذيب وقبله: يلتهب الأرض بوأب حوأب. وروايته في اللسان: يلتهم الأرض ...
(107) قبل هذه الكلمة جاء في الأصول المخطوطة قال موسى وأظن أن هذه العبارة قد أدرجت سهوا من الناسخ.
(108) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب في اللسان: الدجنة.
(109) النص المحصور بين القوسين قد أدرج في غير هذا الموضع في الأصول المخطوطة.
(2/300)
________________________________________
قلعم، قلحم: القِلّعْم القِلّحْم: الشَّيْخُ الهَرِم، بالحاء أصْوَب.
عملق: عِملاقٌ: أبو العَمالِقة وهُم الجَبابرةُ الذينَ كانُوا بالشّام على عَهد مُوسَى ع-
بلقع: البَلْقَعُ: القَفْر لا شَيْءَ فيه. مَنْزِل بَلْقَعٌ ودِيارٌ بَلاقِعُ. وإذا كانت اسْماً مُنْفرداً أُنِّثَ، تقُولُ: انْتَهَيْنا إلى بَلْقَعَةٍ مَلْساءَ.
عقبل: العُقْبُول: ما يَبْثُرُ من الحُمَّى بالشَّفَتَيْن في غِبِّها. الواحِدةُ عُقبُولة، قال 11»
:
من وِرْدِ حُمَّى أسْأَرَتْ عَقابلا
ويُقالُ لصاحِب الشَّرِّ: إنَّه لذو عَقابيلَ، وذو عَواقيلَ.
عنفق: العَنْفَقَةُ: بينَ الشَّفَةِ السُّفلَى وبينَ الذَّقَن. وهي الشُّعَيْرات بينَهما، سالَتْ من مُقَدَّمة الشَّفَة السُّفلَى، تقوُل للرَّجُل: بادي العَنْفَقَةِ إذا عَرِيَ جانِباه من الشَّعر.
قنفع: القُنْفُعَةُ: القُنْفُذَةُ إذا تَقَبَّضَتْ، وقد تَقَنْفَعَتْ.
__________
(110) الرجز (لرؤبة) انظر الديوان ص 134.
(2/301)
________________________________________
القُنْفُعَةُ: الفُرْقُعَة وهي الأسْتُ بلغةٍ يمَانية، قال «111» ،
قَفَرْنِيَة كأنَّ بطَبْطَبَيْها ... وقُنْفُعِها طِلاءَ الأُرْجُوانِ «112»
والطُّبْطُبان: الثَّدْيان، وأنشد:
إذا طَحَنَتْ دُرْنيَّة «113» لعِيالها ... تَطَبْطَبَ ثَدْياها فطارَ طَحينُها
وقال هؤلاء الأعرابُ: القُنْفُعَةُ الاسْتُ. وهي العَزافةُ والعزافة والعَزّافة «114» والرَّمّاعةُ والصَّنّارةُ «115» والرمّازةُ والخَذَّافة.
قنبع: قَنْبَعَ الرجلُ في ثيابه: إذا دَخَلَ فيها. وقَنْبَعَتِ الشَّجرةَ: إذا صارت زَهْرَتُها في قُنْبُعةٍ أي في غِطاء. والقُنْبُعَةُ مثل الخُنْبَعَةِ إلا أنّها أصغَرُ.
قعنب: القَعْنَب: الشَّديدُ الصلب [من كل شيء] «116» ،
عضنك: العَضَنُّكُ: المرأةُ اللَّفّاء العَجُزِ التي ضاقَ مُلْتَقَى فَخِذَيْها مع تَرارَتِها، وذلك لكثرة اللحم.
__________
(111) اللسان (قنفع) غير منسوب أيضا.
(112) في الأصول المخطوطة: قرنبية.
(113) في ط: ذرنية (بالذال المعجمة) ، والبيت غير منسوب.
(114) لم نجد في المعجمات الموجودة هذه المادة.
(115) لا وجود للكلمة في المعجمات المتيسرة بهذه الدلالة وذلك لأن الصنارة والصفارة بالنون أو بالفاء تدلان على معان أخرى غير المنصوص عليها في كتاب العين.
(116) زيادة يقتضيها السياق، وهي كذلك في التهذيب.
(2/302)
________________________________________
عكرش: العِكْرِشُ: نبتٌ شبه قَرْنِ الثيْقَل «117» [ولكنه] «118» أشدُّ خشونةً منه، وفيه مُلُوحةٌ، لا ينبُتُ إلاّ في سَبخةٍ. والعِكْرِشةُ: الأرْنَبَةُ الضَّخمة وبها سُمِّيت الأرْنَبَةُ لأنَّها تأكل العِكرش، قال الشَّمّاخ:
تجر برأس عكرشة زموع «119»
وعِكراشٌ رجل كان أرْمَى أهلِ زمانِه، صاحِبَ قِفارٍ وفيافٍ، وله يقولُ الشاعر:
إذْ كانَ عِكْراشُ فتىً خِدْريّا ... سَمَّحَ واجْتابَ فلاةً فَيّا «120»
الخدريّ: المُقيمُ مع نسائِه لا يكادُ يَجتابُ الفَلاة.
صعلك: الصُّعْلُوكُ، وفِعْلُه التَّصَعلُكُ، ويُجمع الصَّعاليك، قال:
إن اتّباعَكَ مَوْلَى السُّوءِ تَتْبَعه ... لكالتَّصَعْلُكِ ما لم تَتَّخِذْ نَشبا «121»
وهم قومٌ لا مالَ لهم ولا اعتماد. ومُصَعْلَكُ الرَّأس: مُدَوَّر الرأس، قال «122» :
__________
(117) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب الثيل.
(118) زيادة من التهذيب.
(119) كذا في الديوان، وصدر البيت:
فما تنفك بين عريرضات
ورواية العجز في اللسان: تمد برأس عكرشة زموع.
(120) لم نجد الشاهد في أي من المعجمات. في الأصول: جدريا بالجيم ولم نجد (الجدري) بهذه الدلالة. وعكراش بن ذؤيب كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم-
(121) من الشواهد التي تفرد بها العين.
(122) (هو ذو الرمة) . والبيت في الديوان ص 398.
(2/303)
________________________________________
يُخَيِّلُ في المَرْعَى لهُنَّ بشخصِه ... مُصَعْلَكُ أعْلَى قُلَّةِ الرَّأْس نِقْنِقُ
عكنكع «123» : العَكَنْكَعُ: الذَّكر من الغِيلان، قال:
غُولٌ تَداعَى شَرِساً [عَكَنْكَاع] «124»
علكس: اعْلَنْكَسَ الشَّعرُ إذا اشتدَّ سوادُه وكَثُرَ، قال العجّاج:
بفاحِمٍ دُورِيَ حتّى اعْلَنْكَسا «125»
والمُعْلَنْكِس: من اليَبيس: ما كَثُرَ واجْتَمَعَ. والمُعْلَنْكَس: المُتَراكِم من الرَّمْل والمُعْلَنْكِس: الكثير من كلّ شيءٍ. ورجلٌ مُعْلَنْكِس: إذا كانَ مُقيماً بالبَلَد. ويقال: ما له قد اعْلَنْكَسَ. وقومٌ مُعْلَنْكسُون: مُقيمون بالبَلَد قال:
يا رُبَّ تَيْسٍ قَهَوانٍ قَهْوَسِ ... سِيقَتْ له في نَشَرٍ مُعْلَنْكِسِ
مُطبقَةَ الغَضِّ كعَيْنِ الأشْوَسِ «126»
الغضُّ «127» : يعني الكفَّةَ، ولذلك قال كعَين الأشْرَس لأن وَسَطَ الكفَّةِ يبدو منها شيءٌ صغيرٌ أو ثُقْبةٌ، فهو كعين الأشوَس لصغرَها. والقَهْوَسُ: الشَّديد المشي المجترىء باللَّيْل على السَّيْر. والقَهْوانُ: الطويل القرنين.
__________
(123) سقطت هذه المادة من س.
(124) لم نجد الشاهد. في الأصول: عكنعاع وهو تصحيف ثقيل.
(125) وقبله في الديوان ص 31: أزمان غراء تروق العنا.
(126) لم نجد الرجز في أي من المظان المتيسرة لدينا.
(127) في الأصول المخطوطة: العض.
(2/304)
________________________________________
عكلس: عكلس «128» : اسمُ رجلٍ من اليَمَن. وعَكْلَسَ الشَّعرُ: إذا سُقي الدِّهانَ ومارسَ بالأشياء حتى يكبُر ويطوُل.
عركس: اعْرَنْكَسَ الشيءُ: تَراكَم بعضه على بعض، قال العجاح يصف الإبل:
واعْرَنْكَسَتْ أهوالُهُ واعْرَنْكَسَا «129»
واعْرَنْكَسْتُ الشيءَ: حملتُ بعضه على بعض.
كرسع: الكُرْسُوعُ: حرف الزَّنْد الذي يلي الخِنْصر عند الرُّسْغ. وامرأةٌ مُكَرْسَعةٌ: ناتئةُ الكُرْسُوع تُعابُ بذلك. وبعضٌ يقول: الكُرْسُوع: عُظَيم في طَرَف الوَظيف ممَّا يَلي الرُّسْغ من وظيفِ الشَّاء ونحوها. وهو من الانسان كذلك.. واسم الطَّرَفَيْن الكاعُ والكُرْسُوع.
عكمس: ويُقالُ: عَكْمَسَ اللَّيلُ عَكْمَسَةً: إذا أظْلَمَ، قال: واللَّيلُ ليلُ السَّماكَيْن العُكامِس. وكلُّ شيءٍ كَثُفَ وتَراكَم فهو عُكامِس، قال العجّاج:
عُكامِسٌ كالسُّنْدُسِ المَنْشورِ «130»
عكسم: والعُكْسُوم: الحِمارُ بالحميرية. ويقال: هو الكسعوم «131» .
__________
(128) في التهذيب: علكس (بفتح العين) اسم رجل من أهل اليمن، وبذلك تكون المادة كلها جزء من المادة السابقة وهي علكس.
(129) وقبله في الديوان ص 129. وأعسف الليل إذا الليل غسا.
(130) وقبله في الديوان ص 232: ليل تمام تم مستحير.
(131) في التهذيب 3/ 304 قال الليث: الكعسوم الحمار بالحميرية، ويقال: بل الكُسْعُوم.
(2/305)
________________________________________
دعكس: الدَّعْكَسَةُ: لَعِبُ المَجُوس: يَدُورُونَ وقد أخذ بعضُهم يَدَ بَعْضٍ كالرَّقْص. يقال: دعكس وتدعكس بعضُهم على بعض، قال الراجز:
طافُوا به معتكفين «132» نُكَّسا ... عَكْفَ المَجُوسِ يلعَبُونَ الدَّعْكَسا
عكلط: لَبَنٌ عُكَلِط وعُجَلِط «133» : أي خاشِرٌ حامِضََّ.
علكد: العِلْكِد «134» : الشَّديد العُنُق والظَّهْر، ويقال: رَجُلٌ عَلْكدٌ وامرأةٌ عَلْكَدَةٌ، ويُثَقَّل الدال عند الإضطرار. قال:
أعيَس مَصْبُور القَرَى عِلْكَدا
كنعد: الكَنْعَدُ: ضربٌ من السَّمك البَحْريّ، ويُقال: كَنْعَد بسكون النُّون ويُلقَى تَسكين العَيْن على النُّون، قال:
قلْ لِطغامِ «135» الأزْدِ لا تَبْطَروا ... بالشيم والجريث والكنعد
__________
(132) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب واللسان: معتكسين.
(133) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: عكلد عن الليث. ومن المعلوم أن العجلط يعني أيضا اللبن الخاثر مثل العكلد.
(134) كذا في الأصول المخطوطة، والتهذيب وفي اللسان: العلكد (بكسر فسكون فكسر) والعلكد (بضم ففتح فكسر) والعلكد (بفتح فسكون ففتح) والعلكد (بضم فسكون فضم) والعلاكد بضم العين وكسر الكاف، والعلكد بكسر العين وفتح اللام مع تشديدها وإسكان الكاف، كله الغليظ الشديد العنق.
(135) من (س) . في (ص وط) : لطعام بالمهملة.
(2/306)
________________________________________
وقال «136» :
عليك بقُنْأَةٍ وبزَنْجبيلٍ ... وحلتيت وشيء من كنعد
كعدب: الكُعْدُبُ والكُعْدُبَةُ: الفَسْلُ من الرِّجال.
كعتر: كَعْتَرَ الرّجل في مشيِه: إذا تَمايل كالسَّكران.
كرتع: وكَرْتَعَ الرَّجُلُ: إذا وَقَعَ فيما لا يَعْنيه. وكَرْتَع: إذا مَشَى مَشْياً يُقارِب بينَ خطوه «137» ، وقال:
.............. يَهيمُ بها الكَرْتَعُ
عكبر: العُكْبَرة من النساء الجافية العكباء في خُلُقها. قال:
عكْباء عُكْبُرَة في بطنها ثَجَلٌ ... وفي المفاصل من أوصالها فَدَعُ «138»
كعبر: المُكَعْبَرُ: من أسْماء الرِّجال. والكُعْبَرَةُ «139» من النِّساء: الجافيةُ العِلْجَةُ العَكْباءة في خَلْقِها، قال: عكباء كُعْبُرة اللَّحْيَينْ حجمرش «140» يعني الكبيرة. الكُعْبُرةُ ويجمعُ كَعابِر: وهو عُقَدُ أنابيب الزَّرْع والسُّنْبُل ونحوه.
__________
(136) اللسان (حلت) غير منسوب أيضا. وفيه: سندروس مكان زنجبيل.
(137) كذا في س، وفي ص وط: خطويه.
(138) لم نهتد إلى القائل.
(139) كذا في الأصول المخطوطة واللسان، وفي التهذيب: العكبرة.
(140) كذا في الأصول المخطوطة واللسان، وفي التهذيب: عكباء عكبرة اللحيين ...
(2/307)
________________________________________
بركع: البَرْكَعةُ: القِيام على أربعٍ «141» ، ويُقال: تَبَرْكَعَتِ الحَمامةُ للحَمامةِ الذَّكَر، ويقال: أصبح فلان متبركعاً، أي: لا يقوم إلا على كراسيعه. قال رؤبة:
هَيْهاتَ أعْيا جدنا أن يصرعا ... ولو أرادوا غيرَه تَبَرْكَعا
14»
عكرم: العِكْرِمة: الحَمامةُ الأنْثى، قال:
وعِكْرِمة هاجَتْ لنفسي عَبْرَةً ... دَعاها دَعَتْ ساقاً لها فوق مَرْقَبِ «143» !
كثعم: كَثْعَم: من أسماء الفَهْد والنَّمِر.
كعثب: [وامرة] كَعْثَبٌ وكعْثَمٌ: الضَّخمةُ الرَّكبِ. ورَكَبٌ كَعْثَبٌ، ويقال: كثعب، وكعثم. وبعضٌ يقول: [جارية] كَثْعَبٌ: أي ذاتُ رَكَبٍ كَثْعَبٍ.
عثكل: العُثْكُولةُ «145» : ما عُلِّقَ من عِهْنٍ أو زِينةٍ فتَذَبْذَبَ في الهواء! قال:
....... كقنو النخلة المتعثكل «146»
__________
(141) كذا في س واللسان، وفي ص وط: أربعة.
(142) ديوانه/ 93 والرواية فيه: ومن أبحنا عزه تبركعا ونسب في الأصول إلى (العجاج) .
(143) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول.
(145) في التهذيب العثكول.
(146) من عجز بيت (لامرىء القيس) وتمامه:
وفَرْعٍ يُغَشِّي المَتْنَ أَسْوَدَ فاحمٍ ... أَثِيثٍ كقِنْوِ النَّخلةِ المُتَعَثْكِلِ
(2/308)
________________________________________
والهَوْدَجُ يُعَثْكَلُ أي يُزيَّنُ بعُهُونٍ تعلَّقُ عليه فتَتَذَبْذَبُ.
بعلبك: بَعَلْبَك: اسم أرض بالشّام.
بلعك: ويقال: جَمَلٌ بَلْعَكٌ وهو البَليدُ.
علكم: العُلْكوم: الناقةُ الجَسيمةُ السَّمينةُ، قال لبيد:
بَكَرَتْ به جُرشِيَّةٌ مَقْطورة ... تَروي الحَدائِقَ بازل عُلكُومُ «147»
قوله: جُرَشية يَعْني ناقةً منسوبةً إلى جُرَش، وهو مَوْضع «148» ، والمقطورةُ المطليّةُ بالقَطِران. قال أبو الدُّقيش: عَلْكَمَتُها عِظَم سَنامِها.
عنكب: العَنْكَبوتُ بلغة أَهْل اليَمَن العَنْكَبوه والعَنْكباه، والجمع العَناكِب، وهي دَوَيبةٌ تَنْسِجُ نَسْجاً بينَ الهواء وعلى رَأْس البئر وغيرها، رَقيقاً مُتَهلْهِلاً، قال ذو الرّمة:
هي اصطَنَعْته نَحْوَها وتَعاوَنَتْ ... عَلى نَسْجها بينَ المَثابِ عناكبه «149»
__________
(147) البيت في الديوان ص 122 وروايته:
............... .. ... تروي المحاجر بازل علكوم
(148) في الديوان: أرض باليمن.
(149) ديوانه 2/ 854 والرواية فيه: انتسجته...... على نسجه.
(2/309)
________________________________________
ضرجع: الضَرْجَع: اسم من أسماء النَّمِر خاصّة
ضمعج: الضَمْعَج: الضَّخمةُ من النُّوق. وأتانٌ ضَمْعَجٌ: قصيرةٌ ضخمةٌ، ولا يقال ذلك للذَّكر، قال:
يا رب بيضاء ضِحوكٍ ضَمْعَجِ
وقال الشّماخ:
أنا ابنُ رَباحٍ وابنُ خاليَ جَدْشَنٌ ... ولم أُحْتَمَلْ في بَطْنِ سَوْداءَ ضَمْعَجِ «150»
عضفج: العِضْفَاجُ «151» : الضَّخْم السَّمين الرِخْو. وعَضْفَجَتُه: عِظَمُ بطْنه وكَثرةُ لحمه. وقد يقال: عفضاج بمعنى عِضْفاج، مقلوب.
شرجع: الشَّرجَعُ: السَّريرُ الذي يُحْمُل عليه الميّت، قال:
وساريةُ القَوْم في شَرْجَع ... ليهدى إلى حُفْرةٍ نازِحَه «152»
والمُشَرْجَع من مطارق «153» الحدادين ما لا حروفَ لنَواحيه. وكذلك
__________
(150) ليس البيت في الديوان ولكن ورد. بيت آخر فيه الكلمة موطن الشاهد وهو:
أضر بمقلاة كثير لغوبها ... كقوس السراء نهدة الجنب ضمعج
(151) خلت معجمات العربية من هذه المادة واقتصرت على مقلوبها عفضاج.
(152) لم نهتد إلى قائل البيت.
(153) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: مطارقة.
(2/310)
________________________________________
من الخَشَب إذا كانت مُرَبَّعَةً فأمرتَهُ أن يَنْحِتَ حُروفَه قُلتَ: شَرْجَعَهُ، قال:
كأن ما فات عينيها ومَذْبَحَها ... مُشَرْجَعٌ من عَلاة القَيْن مَمْطُول «154»
جرشع: الجُرْشُعُ: الضَّخم الصَّدر، قال:
جَرْشُعَةٌ إذا المَطيُّ أدْرَجَا
جعشم: الجُعْشُم: الصغيرُ البَدن القَليل اللَّحم والجسم، قال العجّاج:
ليس بجُعْشوشٍ ولا بجُعْشُمِ «155»
وقال بعضهم: الجُعْشُمُ الرّجل المُنْتَفِخ الجَنْبَيْنِ غَليظُهما، قال رؤبة:
تنجو إذا السَّيرُ استمرَّ وذَمُهْ ... وكلُّ نئّاج عُراضٍ جَعْشَمُهْ «156»
والشَجْعَمُ: الطويلُ من الأسْد مع عِظَمٍ، وكذلك من الإبِل والرِّجال.
عجلط: العُجَلِط: اللَّبن الخاثِرَ الطيِّبُ من الألبان، ويُجْمَعُ عَجالِط. وعُجالِطُ لغة، قال الراجز:
__________
(154) البيت في اللسان وروايته:
كأن ما بين عينيها ومذبحها............... ..........
وفي التهذيب:
كأن ما بين عينيها ومذبحها............... ..........
(155) وقبله في الديوان ص 293:
في صلب مثل العنان مؤدم
(156) الجعشم (بفتحتين) : الوسط.
(2/311)
________________________________________
إذا اصطَحَبْتَ لَبناً «157» عُجالِطا ... من لَبَنِ الضَّأنِ فلَسْتَ ساخِطا
عشنط: العَشَنَّط: الطَّويل من الرجال والجميع عَشَنَّطُون وعشانط. ويقال: هو الشّابُّ الظَّريفُ مع حُسْن جِسْمٍ، قال:
إذا شِئتَ أن تَلقَى مُدِلاًّ عَشَنَّطاً ... جَسُوراً إذا ما هَاجَه القَومُ يَنْشَبُ
وصفه بخِلافٍ وسوءِ خُلُقٍ.
عنشط: والعَنَشَّط أيضاً لغة، قال:
أتاكَ من الفتيان أرْوعُ ماجدٌ ... صَبُورٌ إذا ما هاجَ هَيْجَ عَنَشَّط «158»
عشزن: العَشَوْزَنُ: المُلتوي العسِرُ الخُلُق من كلّ شيء، ويُجمع على العَشاوِز بحذف النُّون. وناقةٌ عَشَوْزَنَةٌ. قال يصف القناة:
عَشَوْزنةً إذا غمزت إذا غُمِزَتْ أَرَنَّتْ ... تَشُجُّ قَفَا المُثَقِّفِ والجَبينا «159»
عشزر: العَشَنْزَرُ: الشَّديد من كلِّ شيء، قال الراجز:
__________
(157) في التهذيب: رائبا مكان (لبنا) .
(158) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب:
............... .. ... صبور على ما نابه غير عنشط
(159) (عمرو بن كلثوم) - من معلقته.
(2/312)
________________________________________
وصادفوا المدت جهارا مُشعَرا ... ضَرْباً وطَعْناً باقِراً عَشَنْزَرا «160»
شرعب: الشَرْعَبَةُ: شَقُّ اللَّحم والأديم طُولاً. والشَّرْعَبِيُّ: ضربٌ من البُرُود. والشَرْعَبةُ: قِطعةٌ كالرَّعْبلة، قال:
قَدّاً بهَدّادٍ وهَذّاً شَرْعَبا
يصف [ناب] «161» البعير. وشَرْعَبْت الأديمَ واللَّحمَ: أي شقَقْتُه طُولاً. والمشرعب: المطول. والمشرعب الطويل ورجلٌ مُشَرْعَبٌ: طويل، قال طفيل الغَنَويّ:
أسيلةُ مَجْرَى الدَّمْع خُمْصانَةُ الحَشَا ... بَرُودُ الثَّنايا ذاتُ خَلْقٍ مُشَرْعَبِ
شعفر: شَعْفَر: بَطْنٌ من بني ثَعْلَبة يقال لهم: بنو السِّعْلاة، قال الشمّاخ:
وإني لولا شَعْفُرٌ إن أرَدْتُهم ... بَعيدَيْنِ حتى بَلّدا بالصَّحاصِحِ «162»
شمعل: شَمْعَلَتْ اليهودُ شَمْعَلةً: وهي قراءتهم «163» ويقال: اشمعلت
__________
(160) في اللسان: نافذا مكان باقرا.
(161) زيادة من التهذيب.
(162) كذا في الأصول المخطوطة، وليس في ديوانه، وما في الديوان ص 104 هو: ولا شاهد فيه.
(163) في التهذيب واللسان: وهي قراءتهم إذا اجتمعوا في فهرهم.
(2/313)
________________________________________
الإبلُ: أي تَفَرَّقَتْ، ومَضَتْ مَرَحاً ونشاطاً. وناقةٌ شَمْعَلَةٌ: سريعةٌ نشيطةٌ، قال:
إذا اشمعلت سننا رسابها ... بذاتِ حَرْفَيْنِ إذا خَجا بِها «164»
يعني الغارةَ، وناقةٌ مُشْمَعِلَّةٌ مثل شَمْعلةٍ. واشمَعَلَّتِ الغارةُ إذا شَمِلتهم وتَفَرَّقَتْ في الغَزْوِ، قال:
صَبَحْتُ شَباماً غارةً مُشْمَعِلَّةً ... وأخرَى سأُهديها قَريباً لِشاكِرِ «165»
علوس: العِلَّوْس: الذِّئْب، وليس هذا من كلام العرب. قال زائدةُ: هو بالشين.
شنعب: الشِّنْعاب «166» : الرّجلُ الطويلُ الشديد.
شنعف: الشنعاف: الرّجل الطويلُ العاجز الرِّخْو.
عنفش: العِنْفِشُ: اللئيم القصيرُ. ومن النِّساء كذلك «167» ، قال الشاعر «168» :
__________
(164) التهذيب 3/ 326 وفيه (بذات خرقين) واللسان (شمعل) .
(165) التهذيب 3/ 326 وفيه: صحفت (سأهديها) إلى (شاهديها) واللسان (شمعل) .
(166) كذا في (ص وط) في س: الشنعاب: الرّجل الطويلُ العاجز الرِّخْو. وقد سقطت من (س) : (شنعف) وترجمتها.
(167) لم يرد هذا المعنى في المعجمات.
(168) ورد البيت شاهدا في عنفص في جميع المعجمات. والعنفص المرأة القليلة اللحم، البذية القليلة الحياء. ورواية البيت:
لعمرك ما ليلى بورهاء عِنْفِصٍ ... ولا عَشَّة خَلْخَالُها يتقعقع
(2/314)
________________________________________
لعمرك ما ليلى بورهاء عِنْفِشٍ ... ولا عَشَّةٍ مثل الذي يَتَعبَّسُ
عسلج: العسلوج: غُصْنٌ ابنُ سنةٍ. وجاريةٌ عُسْلوجة الشَّباب والقَوام، قال العجاج:
وبَطْنَ أيْمٍ وقواماً عُسْلُجا
والعُسالِج: ما كان رَطْباً في طُولٍ وحُسْن. وعَسْلَجَتِ الشَّجَرة: أخْرَجَتْ عَساليجَها قال طرفة:
إذا أنْبَتَ الصَّيف عَسالِيج الخَضِرْ «169»
ويقال: بل العساليجُ عُروق الشَّجَر، وهي نُجُومُها التي تَنْجُمُ من سَنَتِها فيما زُعِمَ والعَساليجُ عند العامَّة: القُضْبانُ الحديثةُ.
عسجر: العَيْسجُورُ: الناقةُ الشديدة. والعَيْسَجُور: السِّعْلاةُ. وعَسْجَرَتْها: خُبْثُها.
عجنس: العَجَنَّسُ: الجَمَلُ الضَّخْمُ، قال «170» :
يتبَعْنَ ذا هداهد عجنسا ... إذا الغرابان به تَمَرَّسا
عسجد: العَسْجَدُ: الذَّهبُ، ويقال: بل العَسْجَد اسم جامعُ للجَوْهر كُلِّه، من الدر والياقوت.
__________
(169) ديوانه/ 53، وصدر البيت فيه:
كبنات المخر يمأدن كما
وفي الأصول المخطوطة: عساليج خضر. وفي الديوان كما بدلا من إذا.
(170) الرجز في اللسان منسوب إما إلى (العجاج) ، وإما إلى (جري الكاهلي) .
(2/315)
________________________________________
جعمس: ورجُلٌ مُجَعْمِسٌ وجُعامِس: أي وَضَعَ الجُعْمُوسَ بمرَّة، وهو العَذِرة.
عجلز: العِجْلِزَةُ: الفَرَسُ الشديدةُ الخَلْق. ويقال: [أُخِذ] «171» هذا من النَّعْت من جَلْز الخَلْق، وهو غير جائز في القياس ولكنهما اسمان «172» اتفقت حُروفُهما. ونحو ذلك قد يجيء وهو متباين في أصل البناء. ولم اسمعهم يقولون للذكر من الخَيل عِجْلِز، ولكنهم يقولون للجَمَل عِجْلِز وللناقة عِجْلِزة. وهذا النَّعْت في الخيل اعرف. قال «173» :
وقُمْنَ على العَجالِز نصفَ يومٍ ... وأَدَّيْنَ الأواصِرَ والخِلالا
وعِجْلِزة: رملة.
جندع: الجُنْدُع والجَنادِعُ،
وفي الحديث: إني أخاف عليكم الجَنادِعَ والمربّات؟ «174»
يعني البلايا والآفات. والمربّات؟: الدواهي الشديدة. والجُنْدُع: الجُخْدُب وهو شِبهُ الجرادة إلا أنه أضخمَ من الجرادة.
__________
(171) زيادة من التهذيب مما نقل عن الليث أي الخليل في العين.
(172) كذا في التهذيب، وفي الأصول المخطوطة: ولكنها أسماء ...
(173) البيت (لذي الرمة) كما في التهذيب وروايته:
مررن على العجالز ... ............... ..........
وهو من الزيادات في الديوان ص 671.
(174) كذا في ص وط، وفي س: المرابات. ولا وجود لهذه الكلمة في الحديث في التهذيب واللسان فيما نقل من كلام الليث. ولم أهتد إلى حقيقة الكلمة.
(2/316)
________________________________________
عنجد: العُنْجُدُ: الزَّبيبُ، قال:
رءوس الحناظب 17» كالعنجد
شبه رءوس الخنافِس بالزَّبيب، ومن رَوَى العناظِب فهي الجراد، شَبَّه رءوسها بالزَّبيب.
دعلج: الدَّعْلَجُ: ألوان الثياب. ويقال: ضربٌ من الجواليق والخِرَجة، قال يصف الثَّور في الحشيش:
لَثِقُ القَميصِ قد احتواهُ الدَّعْلَجُ «176»
قال السُلَميّ: الدَّعْلَجُ عندنا الضَّبُّ إذا هاجَ فإنَّما هو مُقبلٌ ومُدبرٌ. والدَّعْلَجَةُ: أثَر المُقبل والمُدبر. رأيتُ دَعْلَجَتَهم: أي آثارَهم.
جعدل: الجَعْدَلُ: البعير الضَّخْم القويّ.
عجلد: والعَجَلَّدُ والعَمَلَّطُ والعُجالِدُ والعُمالِط: اللبن الخاثِرُ، قال «177» :
هل من صَبوحٍ لَبَنٍ عُجالِدِ
جلعد: الجَلْعَدُ: الناقةُ القويّة الظَّهيرة، قال «178» :
أكسُو القُتودَ ذاتَ لَوْثٍ جَلْعَدَا
__________
(175) في التهذيب واللسان: العناظب.
(176) لم نهتد إلى القائل.
(177) لم نهتد إلى القائل.
(178) لم نهتد إلى القائل.
(2/317)
________________________________________
عجرد: عَجْرَد: اسمُ رجلٍ. والعَجْرَدية: ضربٌ من الحَرُوريّة.
جمعد: جَمْعَدٌ «179» : حِجارة مَجموعةٌ.
جعدب: جُعْدُبةُ: اسم رجل من المدينة.
جنعظ: الجِنعاظةُ: الرجل الذي يَتَسَخَّط «180» عند الطعام من سُوء خُلُقه، قال:
جِنعاظةٌ بأهلِهِ قد بَرَّحا ... إنْ لم يجدْ يوماً طَعاماً مُصْلَحا «181»
جعمظ: الجَعْمَظُ: الشَّيخُ الشَّرِهُ.
جعظر: الجَعظَريُّ: الأكُول.
وفي الحديث: أبغَضُ النّاس إلى الله الجَوّاظُ الجَعْظَريُّ «182»
فالجوَّاظُ الفاجر، قال:
جواظة جعنظر جنعيظ
وجَعَنْظَرٌ وجِنعيظٌ وجَنْعَظرٌ كله سواء. والجِعْظار: الرجل القصيرُ الرِّجْلَيْن
__________
(179) في اللسان: الجمعد: حجارة مجموعة عن كراع، والصحيح الجمعرة. وجاء في التهذيب أيضا: وقال الليث: يقال للحجارة المجموعة جمعر.
(180) في التهذيب: يسخط.
(181) تكملة الرجز في التهذيب نقلا عن الليث: قبح وجها لم يزل مقبحا
(182)
الحديث في اللسان: إلا أخبركم بأهل النار؟ كل جعظري جواظ مناع جماع
(2/318)
________________________________________
الغليظ الجسم. وهو الجِعِنْظارُ أيضاً، وإن كان مع غِلَظ جسمه وترارةِ خَلْقِه أكولاً قويّاً سُمِّيَ جَعْظرياً.
عذلج: المُعَذْلَجُ: الناعمُ. وعَذْلَجَتْه النَّعمةُ، قال العجاج:
مُعَذْلجٌ بَضٌّ قُفاخِريٌّ «183»
يصف خَلْقَها.
عثجل: العَثْجَلُ: الواسعُ الضَّخم من الأسقِية والأوعية «184» ونحوها، قال الراجز يصف الناقة:
تَسقي به ذاتَ فراغٍ عثْجَلا
أي كَرْشاً واسعاً.
ثعجر: الثَّعْجَرَةُ: انصباب الدَّمْعِ المتتابع. واثْعَنْجَرَت العينُ دمعاً، واثْعَنْجَر دمعها. واثْعَنْجَرَ السَّحابُ بالمطَر، واثْعَنْجَرَ المطر تشبيه كأنّه ليس له مسلك ولا حِباسٌ يَحْبِسُه، ولو وصَفْتَ به فعل غيره لقلت ثَعْجَرَه كذا، قال امرؤ القيس عند موته:
رب جفنة مثعنجره ... وطَعْنةٍ مُسْحَنفِره
تَبقَى غداً بأَنْقَره
أي يكون ثَمَّ قَتْلى. ويعني بالمُثْعَنْجِره المملوءة ثريدا تفيض إهالته.
__________
(183) في الديوان: ص 315: مغذلج بيض قفاخري. وهو وهم من المحقق.
(184) في التهذيب: من الأساتي. وهو وهم من المحقق.
(2/319)
________________________________________
جعثن: الجِعثِن: أروحةُ الشَّجَر بما عليها من الأغصان، الواحدة جِعْثِنة، وكلُّ شَجَرةٍ تَبقى ارومتها في الشتاء من عظام الشَّجَر وصغارها فلها جِعْثِن في الأرض، وبعد ما يُنْزَعُ فهو جِعْثِن، حتى يقال لأصول الشوك على الأرض جِعْثِن حتى يقال لأصول الشوك: جِعْثِن، قال الطّرمّاح في وصف لحيَي النّاقة على الأرض «185» :
ومَوضِع مشكوكَين ألقَتْهما معاً ... كوطأة ظبي القُفِّ بين الجعاثِنِ
[وجِعْثِن: من أسماء النّساء. وتَجَعْثَن الرّجلُ إذا تجمَّع وتقبَّض. ويقال لأرومة الصِّلِّيان: جِعْثِنة] «186»
جعثم: الجُعثُومُ: الغُرمول الضَّخْم.
عرجل: العَرْجَلَةُ: القطيعُ من الخيل. وهي بلغة تميم الحَرْجلة.
عرجن: العُرجُون: أصلُ العِذْق، وهو أصفر عريضٌ يُشبهُ الهلال إذا انْمَحَقَ «187» . والعُرجُون: ضربٌ من الكَمْأة قَدْر شِبْرٍ أو دُوَيْنَ ذلك. وهو طيِّبٌ ما دام غَضّاً رطباً والجمعُ العراجِينُ. والعَرْجَنَةُ: تصوير عراجين النخل، قال «188» :
__________
(185) ديوانه 493.
(186) ما بين القوسين سقط من الأصول المخطوطة وأثبتناه من التهذيب.
(187) في التهذيب عن الليث: لما عاد دقيقا.
(188) هو (رؤبة) . والرجز في الديوان ص 161 وقبله:
أو ذكر ذات الربذ المعهن
(2/320)
________________________________________
في خِدْرِ ميّاس الدّمى مُعَرْجَنِ
أي مُصوَّر فيه صُور النَّخْل والدُّمَى.
عنجر: العَنْجورةُ «189» : غِلافُ القارُورة. وكان عَنْجورة اسم رجلٍ إذا قيلَ له: عَنْجِرْ يا عَنْجورِةُ غَضِبَ.
جعفر: الجَعْفَرُ: النَّهْرُ الكبير الواسع، قال:
تأود عسلوج على شط جَعْفَر
جرعن: اجْرَعَنَّ «190» الرجُلُ: إذا سَقَطَ عن دابّته.
عجرف: العَجْرَفِيَّة: جَفْوَةٌ في الكلام وخُرق في العقل «191» . وتكون في الجمل فيقال: عَجْرَفيُّ المَشْيِ لسُرعته. ورجلٌ فيه عَجْرَفيَّةٌ. ويقال: بعيرٌ ذو عَجاريف. والعُجْروفُ: دُوَيبة ذاتُ قوائِمَ طِوال. ويقال أيضاً: هو النَّمْلُ الذي رَفَعَتْه قوائمه عن الأرض. وعَجاريفُ الدهر: حَوادثُه قال قيس «192» :
لم تُنْسِني أُمُّ عَمَّارٍ نَوًى قَذَفٌ ... ولا عَجاريفُ دَهرٍ لا تُعَرِّيني
أي لا يُخَلِّيني ولا يتركني من أذاه.
__________
(189) في التهذيب عن الليث: العجنحرة. وفي اللسان: العنجرة.
(190) كذا في الأصول المخطوطة أما في التهذيب: ارجعن وهو تصحيف. انظر اللسان.
(191) في التهذيب عن الليث: العمل وهو تصحيف.
(192) التهذيب 3/ 321 واللسان (عجرف) غير منسوب.
(2/321)
________________________________________
عرفج: العَرْفَجُ: نباتٌ من نَبات الصَّيف ليِّنٌ أغْبَر له ثَمَرةٌ خَشْناء كالحَسَكِ، الواحدة عَرْفَجةٌ. وهو سريع الاتّقاد، قال لبيد:
مَشْمُولةٍ غلثت بنابت عرفج ... كدخان نار ساطِعٍ أسنامُها «193»
جعبر: الجَعْبَريَّةُ والجَعْبَرة أيضاً: القصيرةُ الدَميمةُ، قال: «194»
لا جَعْبريّات ولا طَهامِلا
أي قِباحُ الخِلْقة. ويقالُ: يريد طِوالاً دِقاقاً.
عجرم: العُجَرُمةُ: شجرة غليظة لها كِعابٌ كهَيْئة «195» العُقَد تُتَّخَذُ منه القِسِيّ، وهي العُجْرومة. وعَجْرَمَتها: غِلَظ عُقَدها، قال العجاج:
نَواجِلٌ مثلُ قِسِيّ العُجْرُمِ «196»
والعُجْرُمُ: أصلُ الذكر. وإنه لمُعَجْرَمٌ: إذا كان غليظ الأصل، قال رؤبة:
ينبو بشَرْخَي رَحْلِهِ مُعَجْرَمُه ... كأنّما يزفيه حاد ينهمه «197»
__________
(193) البيت في ديوان لبيد ص 306.
(194) هو (رؤبة بن العجاج) والرجز في الديوان ص 121
(195) في التهذيب عن الليث: كهنات نقلا عن مخطوطة واحدة وفي المخطوطتين الأخريين: كهيئات.
(196) كذا في الأصول المخطوطة والديوان ص 59، وفي اللسان: نواجلا.
(197) ديوانه/ 151.
(2/322)
________________________________________
مُعَجْرَمُهُ: حيث عُجْرِمَ وَسَطُه أي غَلُظَ. والعجاريم من الدّابّة «198» : مجتمع عُقَدٍ بين فَخذَيه وأصل ذَكَره. والعُجْرُم من أسماء الرّجال ومن ألقابهم القِصار. والعِجْرِم أيضاً: دُوَيبة صُلْبة كأنّها مقطوعة، تكون في الشجر وتأكلُ الحشيش.
جعمر: الجَعْمَرة «201» أن يجمعَ الحِمارُ نفسَه وجَراميزه ثم يحمل على العانة وعلى شيءٍ أراد كَدْمَه.
علجم: العُلْجُوم: الضِفدِعُ الذَكرَ. ويقالُ: البَطُّ الذكر، قال:
حتى إذا بَلَغَ الحَوْماتُ أكرُعَها ... وخَالَطَتْ مُستَنيماتِ العَلاجِيمِ
يقال: فلانٌ مُستنيم وليس بنائم ولكنه أمِنَ حتى إذا بَلَغَ حَومة الماء رَمَى بها، وهذا بالظنِّ. والعَلاجِيمُ هاهنا. الضفادِعُ. قال: ونحن نقول في لغتنا: تَيْسٌ عُلْجُوم وكُبْشٌ عُلْجُوم ووَعِلٌ عُلجُومٌ، وهي كبارُها. والعُلْجُومُ: الظُلْمَةُ المتراكمة، قال ذو الرمة:
__________
(198) كذا في الأصول المخطوطة واللسان، وفي التهذيب: عجارم.
(201) كذا في الأصول المخطوطة واللسان، وفي التهذيب الجمعرة.
(2/323)
________________________________________
أو مزنة فارق يجلو غوارِبَها ... تَبَوُّجُ البرقِ، والظَلْماءُ عُلْجُومُ
عفجل: العَفَنْجَل: الكثيرُ فُضُولِ الكلام.
عفنج: العَفَنْجَجُ من الناس: كلُّ ضَخْم اللَّهازِمِ ذو وَجَنات «202» أكُولٌ فَسْلٌ، بوزن فَعَنْلَل، ورجلٌ عَفَنْجَج مُضطرِب.
جلعب: الجَلْعَبُ: الرّجلُ الجافي الكثيرُ الشرِّ، ويقال: بل هو الجَلَعْبَى
جِلفاً جَلَعْبَى ذا جَلَب «203»
ويقال: بل هو الجَلَعباء «204» ، والمرأةُ جَلَعْباة «205» ، وهما من الإبِلِ: ما طال في هَوَجٍ وعَجْرفيَّة. والمُجْلَعِبُّ: المُسْتَعْجِلُ الماضي، وهو من نَعتِ رجل السَّوء «206» ، قال:
مُجْلَعِبّاً بينَ راوُوقٍ ودَنّ
علجن: العَلْجَنُ: الناقةُ الكِنازُ «207» اللَّحْم وكان فيها بُطءٌ «208» من عظمها، قال الراجز:
وخَلَّطَتْ ذات دلاث «209» علجن
__________
(202) وزاد في التهذيب: وألواح (عن الليث) .
(203) (اللسان) : (جلعب) .
(204) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب عن الليث: الجلعبي.
(205) في ص وط: جلعبات.
(206) في التهذيب: الشرير. وفي الأصول: الرجل السوء.
(207) كذا في س، وفي ص وط: الكبار.
(208) في ص وط: بطؤا.
(209) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب واللسان: وخلطت كل ...
(2/324)
________________________________________
جلفع: الجَلَنْفَعُ: الغَليظُ من الإبِلِ.
ضلفع: ضَلْفَعُ: موضِع، قال العجاج:
وعهد مَغْنَى دمنةٍ بضَلْفَعا «210»
عرضن: العِرَضْنَةُ والعرضنى: عدو في اشتقال، قال:
تعدو العرضنى خيلهم حَراجِلا
وامرأةٌ عِرَضْنةٌ أي ضَخمةٌ قد ذَهَبَتْ عَرْضاً من سِمَنِها.
عربض: أَسَدٌ عِرباضٌ: رَحْبُ الكَلْكَل، قال:
إنّ لنا عِرْباضةً عِرْبَضّا «211»
أي مُبالَغاً في أمره.
عرمض: العَرْمَضُ: نَبْتٌ رخْوٌ أخضَرُ كالصوف المنقُوش في الماء المُزمِن، وأظنُّه نباتاً «212» . والعَرْمَضُ أيضاً من شجرة العِضاه، لها شوك أمثالُ مَناقير الطيرْ، وهو أصلبُها عِيداناً.
عضمر: العَيْضَمُورُ: الناقةُ الضَّخمةُ مَنَعَها الشَّحْمُ أن تحملَ. والعَيْضَمُورُ: العجوزُ أيضاً
__________
(210) ليس في ديوان العجاج.
(211) رواية التهذيب واللسان:
إن لنا هواسة عربضا.
(212) في (س) : أقول: نبت ظنا.
(2/325)
________________________________________
عضرط: العِضْرِط: اللَّئيم من الرجال. والعُضْرُوط: الذي يَخدِمُكَ بطَعام بطنه، وهم العَضاريطُ والعَضارِطةُ، قال الأعشى:
وكَفَى العَضاريطُ الرِكابُ فبُدِّدَتْ ... منها لأمرِ مُؤَمَّلٍ فأزالَها «213»
ذعلب: الذِّعْلِبَة: الناقةُ الشديدةُ الباقيةُ على السير، وتجمع على ذَعالِب، قال نَهارُ بنُ تَوْسِعة:
سَتُخبِرُ قُفّالٌ غَدَت بسُروجها ... ذعالِبُ قُودٌ سَيرُهُنَّ وَجيفُ «214»
. والذِعلبةُ: النَّعامة وهي الظليم «215» الأنثى، وإنما تُشَبَّه بها الناقةُ لسرعتها. وكذلك جَمَل ذِعْلِبٌ. والذِعْلِبُ: القِطَعُ من الخِرَقِ المُتَشَقِّقَةِ، قال:
مُنْسَرِحاً إلاّ ذَعاليبَ الخِرَقْ
وتقول: إذلَعَبَّ الجَمَلُ في سيره إذلِعْباباً من النَّجاء والسرعة، قال الراجز:
ناجٍ أمام الرَّكبِ «216» مُذْلَعِبُّ
وإنَّما اشتُقَّ من الذِعْلِب. وكلُّ فعلٍ رُباعيٍّ ثُقِّلَ آخره فإنّ تَثقيله معتمدٌ على حرف من حروف الحلق.
__________
(213) كذا في الأصول المخطوطة، ورواية الديوان ص 26:
فكفى العضاريط الركاب فبددت ... منه لأمر مؤمل فأجالها
(214) لم نهتد إلى القول وفي غير الأصول.
(215) المعروف أن الظليم ذكر النعام. ولعل عبارة (وهي الظليم) زيادة من النساج، وتكون العبارة: والذعلبة: النعامة الأنثى.
(216) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: الحي.
(2/326)
________________________________________
ذعمط: قال شُجاع: الذَّعْمَط «217» من النساء: البذيئة وكذلك اللَّعْمَظ. وتقول: ذَعْمَطْتُ الشَّاةَ أي ذَبَحتُها ذَبْحاً وَحِيّاً، والذعْمَطَةُ مصدره.
عرفط: العُرفُطُ: شجرةٌ من شجر العِضاه، تأكلُه الإبلُ، الواحدة بالهاء.
عنظب: العُنْظُبُ: الجراد الذكر والأنثى عُنَظُوبة «218» .
عطرد: عُطارِد: كوكبٌ لا يُفارقُ الشَّمس. وهو كوكب الكُتّاب. وبنو عُطارِد: حيٌّ من بني سَعْدٍ.
عسطس: العَسَطُوس: شجرٌ يُشبِهُ الخَيْزُران، قال:
............... ... كأنّه ... عصا عَسَّطُوسٍ لينُها واعتدالها «219»
ويقال: هو شَجَرٌ يكون بالجزيرة. ويقال: بل العَسَطُوسُ من رءوس النصارى بالنبطية.
__________
(217) ضبطنا (الذممط) على ضبط (اللعمظ) .
(218) في الأصل: عنظوانة وهو تصحيف.
(219) البيت (لذي الرمة) وروايته في الجمهرة والمحكم واللسان (عسطس) :
على أمر منقد العفاء كأنّه ... عصا عَسَّطُوسٍ لينُها واعتدالها
وقد جاء البيت شاهدا في الكلمة وهي مشددة السين مفتوحة، وهي رواية كراع. ورواية البيت في الديوان ص 532:
............... ..... ... عصا قس قوس لينها واعتدالها
والقس: النصراني، وقوس: منارة الراهب.
(2/327)
________________________________________
عرطس: عَرْطَس الرجلُ: إذا تَنَحَّى عن القوم وذَلَّ عن مُنازعَتِهم ومُناوَأتِهم «320» ، قال الراجز:
يُوعدِني ولو رآني عَرْطَسا «221»
وفي لغة: عَرْطِزْ عنا أي تَنَحَّ عنّا.
عطمس: العَيْطَمُوس: المرأة التّارَّة، ذات قَوامٍ وألواح. ويقال لها ذلك في كلّ حال إذا كانت عاقراً. ويقال: عُطْمُوسٌ.
عطبل: عُطْبُول: جارية وَضيئةٌ فتيّةٌ حَسَنة، وجمعُها عَطابِيل وعَطابل، قال:
فسِرْنَا وخَلَّفا هُبيرةَ بعدَنا ... وقُدَّامَه البيضُ الحِسانُ العَطابِلُ «222»
عرطل: العَرْطَلُ: الطويل من كلِّ شيءٍ، قال أبو النَّجم:
وكاهلٍ ضَخْمٍ وعُنْقٍ عَرْطَلِ «223»
صنتع: حِمارٌ صُنْتُعٌ: شديد الرأس ناتىء الحاجِبَيْن عريضُ الجَبْهة. وظليم صنتع «224» .
__________
(320) كذا في ص واللسان، وفي ط وس: مساواتهم.
(221) الرجز في التهذيب واللسان، وقبله: وقد أتاني أن عبدا طبرسا.
(222) لم نهتد إلى القائل.
(223) الرجز في اللسان وروايته:
في سرطم هاد وعنق عرطل
وقد أدرجت مادة عنظب بعد هذا الرجز في س.
(224) في اللسان: وظليم صنتع أي صلب الرأس.
(2/328)
________________________________________
عترس: العِتريسُ «225» : الذكر من الغيلان. والعَتْرَسَةُ: العِلاجُ باليَدَيْن مثلُ الصِراع والعِراك،
وفي الحديث: جاءَ رجلٌ بغَريمٍ له مَصْفُودٍ إلى عُمَر فقال: أتَعْتَرسُه
أي تَغْصِبُه وتَقْهَرُه. ويقال: عَتْرَسْتُ ماله: أي أخَذْتُه عَتْرَسَةً أي غَصْباً. والعَنْتريسُ: الناقةُ الوثيقة، وقد يُوصَفُ به الفَرَسُ الجَوادُ، قال: «226»
كلُّ طِرْفٍ مُوَثَّقٍ عَنْتَريسٍ
والعَنْتَريسُ: الداهية. العَتْرَسَةُ: الغَلَبَةُ والأخْذُ من فوق.
عنتر: العَنْتَرُ: الشُجاع.
عترف: العُتْرُفان: الديك.
عضرس: العِضْرِسُ: ضَرْبٌ من النبات. وبعضٌ يقول: هو حمار الوَحْش، قال: «227»
والعَيْرُ ينفُخُ في المَكْنانِ قد كَتِنَتْ ... منه جحافِلُه والعِضْرِسِ الثُّجَرِ
المكنان: نَبات الربيع يَنْبُتُ مُتَكاوِساً أي كثير بعضه على بعض. (ويقال: العِضْرِس شجرة تشبه ثمرتها أعين الكلاب الزرق) «228»
__________
(225) في الأصول المخطوطة: العتريس من الغيلان الذكران والتصحيح من اللسان.
(226) البيت (لأبي داود) يصف فرسا، اللسان (عترس) ، وتمامه:
مستطيل الأقراب والبلعوم.
(227) قائل البيت هو (ابن مقبل) . انظر اللسان (عضرس) .
(228) ما بين القوسين أدرج بعد مادة [عنبس] في الأصول المخطوطة.
(2/329)
________________________________________
عنبس: العَنْبَسُ: من أسماء الأسد إذا نَعَتَّه قلتَ عَنْبَس وعُنابِس.
عملس: العَمَلَّسُ: الذئب الخَبيثُ، ويقال: عَمَلَّس دَلْهاث «229» ، قال الطرمّاح:
يوزِّعُ بالأمراس كلّ عَمَلَّس «230»
عرنس: العِرناسُ: طائرٌ كالحمامةِ لا تشْعُرُ به حتى يطيرَ تحت قَدَميك، قال:
لسْتُ كَمَنْ يُفْزِعُه العِرناسُ «231»
عرمس: العِرْمِسُ: اسم للصَّخْرة تُنْعَتُ به الناقةُ الصُلْبة، قال:
وَجْناءُ مُجْمَرةُ المنَاسِمِ عرِمِسٌ «232»
عنسل: العَنْسَل: الناقةُ السريعةُ الوَثيقةُ الخَلْقِ.
عربس: العِرْبِسُ والعِرْبَسيس: مَتْنٌ مُسْتَوٍ من الأرض، قال العجّاج:
وعِرْبِساً منها بسَيرِ وَهْسِ «233»
الوَهْس: الوطءُ الشديدُ. (وقال الطرمّاح في العربسيس:
__________
(229) كذا في س أما في ص وط: دلجات.
(230) رواية البيت في الأصول المخطوطة: يودع بالأمراس. أما التصحيح فهو من الديوان ص 171 والتهذيب واللسان وتمام البيت:
من المطعمات الصيد غير الشواجن
(231) لم نهتد إلى الراجز.
(232) لم نهتد إلى القائل ولا إلى تمام البيت.
(233) ليس الرجز في ديوان العجاج.
(2/330)
________________________________________
تُراكِلُ عَرْبَسيسُ المتْنِ مَرْتاً ... كظَهْر السَّيْحِ مُطَّرِدَ المتونِ
والعَرْبَسيس بفتح العين أصوَبُ من كسرها، لأن ما جاء من بناء الرُباعيِّ على مثال فَعْلَليل يُفْتَح صدرُه مثل سَلْسَبِيْل وأشباه ذلك، وإنما كسرت عَيْن عربسيس على كسرة عِرْبِس) «234» .
سلفع: السَلْفَعُ: الشُجاع الجسور. وامرأةٌ سَلْفَعٌ: أي سَليطةٌ. الرجلُ والمرأةُ فيه سَواءٌ، قال جرير:
أيّامَ زَيْنَبُ لا خفيفٌ حِلْمُها ... عند النساء ولا رءود سَلْفَعُ «235»
عسبر، عبسر: العُسْبُر: النَّمِر، والأنثى بالهاء. والعُسْبُور: وَلَدُ الكلب من الذِّئبة. والعُبْسُورة والعُبْسُرَة «236» : الناقةُ السريعة من النجائب، قال: «237» :
والمُقْفِراتُ بها الخُورُ العَباسيرُ
سبعر: وناقةٌ ذاتُ سِبعارةٍ يعني حِدَّتَها. وسَبْعَرَتُها: نشاطها إذا رفعت رأسها وخَطَرَتْ بذَنَبها وارتفعت واندفعت.
__________
(234) ما بين القوسين جاء بعد مسلفع المادة التالية.
(235) كذا رواية البيت في الأصول المخطوطة وفي الديوان ص 341:
............... .. ... همشى الحديث ولا رواد سلفع
(236) كذا في ص وط أما في التهذيب واللسان: العسبورة والعسبرة. وكذلك الشاهد:.... الخور العسابير. وجاء في اللسان أيضا: قال الأزهري: والصحيح العبسورة، الباء قبل السين في نعت الناقة، قال: وكذلك رواه أبو عبيد عن أصحابه، وكذلك ابن سيده.
(237) لم نهتد إلى القائل ولا إلى تمام القول.
(2/331)
________________________________________
سرعب: السُرْعُوبُ: اسمُ ابنِ عرْس، قال:
وثبة سُرْعُوبٍ رأَى زَبابا «238»
وهو الجُرَذ الضَّخْمُ.
سمدع: السَمَيْدَع: الشُجاع.
سعبر: السَعْبَرَةُ: البِئْرُ الكثيرةُ الماء.
سرعف: السَرْعَفةُ: حُسْنُ الغِذاء والنَّعمة. وهو سُرْعُوف ناعِم، قال العجّاج:
وقَصَبٍ لو سُرْعِفَتْ تَسَرْعَفا «239»
عمرس: يوم عَمَرَّسٌ «240» : شديد. وشَرٌّ عَمَرَّس، قال الأُرَيْقِط في وصف يومٍ ذي شَرٍّ.
عَمَرَّسٌ يَكْلَحُ عن أنيابهِ
العُمْروسُ: الجَمَلُ إذا بَلَغَ النَّزْوَ. والعَمَرَّس: الشرس الخُلُق القوي.
__________
(238) الرجز في التهذيب واللسان من غير عزو.
(239) الرجز في اللسان وفي الديوان ص 491 وقبله: بجيد أدماء تنوش العلفا.
(240) أدرجت المادة قبل أكثر من ثلاث صفحات.
(2/332)
________________________________________
زعفر: الزَّعْفَران: صِبْغٌ وهو من الطِّيبِ. والأسَدُ يُسَمَّى مُزَعْفَراً لأنَّه وَرْدُ اللَّوْن يضربُ إلى الصُفرة، قال أبو زبيد:
إذا صادَفوا دوني الوليدَ كأنَّما ... يَرَونَ بوادٍ ذا حِماسِ مُزَعْفَرا «241»
عفرز: عَفْزَرُ: اسمُ رجلٍ، قال:
[نَشِيمُ بُروقَ المُزْنِ أين مَصابُهُ ... ولا شَيْءَ يَشْفي منكِ] يا بنت عَفْزَرا
كأنّه اسمٌ أعجَميّ لذلك نَصَبَه.
زعنف: الزِّعْنِفةُ: صِنْفةٌ من ثَوب وطائفة من قبيلة يَشِذُّ ويَنْفَرِدُ. وإذا رأيت جَماعةً ليس أصلُها واحداً قُلتَ: إنَّما هم زَعانِفُ، بمنزلة زَعانِفِ الأديم، وهي في نَواحيه حيثُ تُشَدُّ فيه الأوتادُ إذا مُدَّ للدِباغ.
زبعر: رجلٌ زِبَعْرَى. وامرأة زِبَعراة: في خُلُقها شَكاسةً «242» . والزَّبْعَرُ: ضَرْبٌ من المَرْوِ. قال:
وكأنَّها الاسفِنْطُ يومَ لقِيتُها ... والضَوْمَران تَعُلُّهُ بالزَّبْعَرِ «243»
والزَّبْعَرِيّ: ضَرْبٌ من السِّهام، منسوب.
__________
(241) لم أجد البيت في شعر أبي زبيد.
(242) كذا في التهذيب وفي الأصول المخطوطة: شكس.
(243) كذا رواية البيت في س، وفي ص وط:
وشاهدنا الإسفنط يوم لقيتها............... ...
(2/333)
________________________________________
زعبل: الزَّعْبَلُ: الذي لا يَنْجُعُ فيه الغِذاء وقد عَظُمَ بَطْنُه ودَقَّ عُنُقُه، قال:
سِمْطاً يُرَبّي وِلْدَةً زَعابِلا «244»
عرزم: العَرْزَم: القويُّ الشديد من كل شيء، المُكْلَئِزُّ المجتمع، فإذا عَظُمَت الأرنَبَةُ وغَلُظَتْ قيل: اعَرَنْزَمَتْ، واللِّهْزِمَةُ كذلك إذا ضَخُمَتْ واشْتَدَّتْ قال «245» :
لقد أوقدَتْ نار الشروري بأرؤس ... عظام اللِّحَى مُعْرَنْزِماتِ اللَّهازِمِ
مرعز: المِرْعِزَّى: كالصُّوف يُخَلَّصُ من شَعْر العَنْز. وثوبٌ مُمَرْعَز. ومثلُه ما جاء على لفظه شِفْصِلَّى «246» . والمِرْعِزاء أيضاً إذا كَسَروا مَدّوا وخفَّفوا الزاي، وإذا فَتحوا الميم وكسَروا العين ثَقَّلوا الزاي وعَلَّقوا الياء مرسلة، وهذا في كلام العرب بناء نَزْرٌ. ويقال أيضاً مِرعِزى مقصوراً.
عرزل: العِرزالُ: ما يجمَعُه الأسدُ في مَأواه من شَيءٍ يُمَهِّدُه لأشباله كالعُشّ. قال زائدة: العِرزالُ جُحْرٌ لحَيّة، وذكره أبو النجم في شعره فقال:
تَلوّذ الحَيَّة في عِرزالها «247»
وعِرزالُ الصيَّاد: أهدامُه وخِرَقُه التي يمتَهدُها ويضطجع عليها في القترة، قال:
__________
(244) الرجز في اللسان (للعجاج) . وجاء فيه: قال ابن بري: الصحيح أنه (لرؤبة) ، وقبله:
جاءت فلاقت عنده الضآبلا
(245) لم نهتد إلى القائل في المصادر المتيسرة.
(246) كذا في (ص وط) . في (س) : فعللي.
(247) كذا في س، وفي ص وط:.... في عرزالها.
(2/334)
________________________________________
ما إنْ يني يفتَرِشُ العِرازلا «248»
يعني صاحبَ القُتْرة. ويقال: العِرزالُ ما يَجْمَعُ [الصائد] من القَديد في قُتْرته.
عصفر: العُصفُرُ: نباتٌ سلافتُه الجِرْيال، وهي معرَّبة. العُصْفُور: طائر ذَكَرٌ. والعُصْفُور: الذكر من الجراد. والعُصْفُور: الشِمراخ السائِلُ من غُرَّة الفَرَس لا يبلُغ الخَطْمِ. والعُصفورُ: قُطَيعةٌ من الدِماغ تحت فَرْخ الدِماغ كأنَّه بائن منه، بينَهما جُليدة تفصِلُه، قال:
ضَرْباً يُزيلُ الهامَ عن سَريره ... عن أمِّ فَرْخ الرأسِ أو عُصفورِهِ
والعُصفور في الهَوْدَج: خَشَبَةٌ تجمعُ أطرافَ خَشَباتٍ فيها، وهي كهيئة عُصفور الإكاف، وعُصفور الإكاف عند مُقَدَّمِه في أصل الذِئبة، وهي قطعة خَشَبٍ في قَدْرِ جُمع الكَفِّ وأعظم من ذلك شيئاً، مشدودة بين الحِنْوَيْن المُقَدَّمَيْن، قال الطِرمّاح:
كلُّ مَشْكوكٍ عَصافيرُه ... قانىء اللَّونِ حديث الرِمامِ «249»
يصف الهَوْدَج أي أُصْلِحَ حَديثاً. والرَمُّ: الأَسْر أيضاً، يعني أنه شُلَّ فَشُدَّ العُصفورُ من الهودج.
__________
(248) زيادة من اللسان.
(249) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: الدمام، وكذا في الديوان/ 401 وفي اللسان الزمام: وهو تصحيف.
(2/335)
________________________________________
صعفر: اصعَنْفَرت الحُمُرُ: إذا تَفَرَّقَتْ وابذَعَرَّت وهَرَبَت، قال:
فلم يُصِبْ واصْعَنْفَرَتْ جَوافِلا «250»
عرصف: العِرصافُ: العَقِبُ المُستطيل، وأكثر ما يقال ذلك لعَقِبِ المتْنَيْن والجنْبَيْن. وعَرَصَفْتُ الشيءَ أي: جَذَبْتُه فَشَقَقْتُه مُستطيلاً. والعَراصيف: أربعةُ أوتادٍ يجمعن بين أحناء رءوس القَتَب، في رأس كلّ حِنْوٍ من ذلك وَدّانِ مَشْدودان بجُلُود الإِبِل، يَعدِلُونَ الحِنْوَ بالعُرْصرف. وعَراصيفُ القَتَب: عصافيره. والعُصفور والعُرْصوف واحد.
صمعر: الصَّمْعَريّ: اللَّئيمُ. والصَّمْعَريّ: كلُّ مَن لم يعمَلْ فيه رُقْيةً ولا سِحْر أيضاً. والصَمْعَرِيَّةَ من الحيّات: الخبيثة، قال «251» :
أحَيَّةُ وادٍ ثُغْرةٌ صَمْعَريَّةٌ ... أحَبُّ إليكم أم ثلاثٌ لواقِحُ
أي: عقرب.
عصمر: العُصْمُورُ والعَصَاميرُ: دُلِيُّ المَنْجَنُون.
عرصم: العِرْصَمُّ: الرجل الشديد البضعة.
__________
(250) وفي اللسان: وروي: واسحنفرت. والرجز (لرؤبة) الديوان ص 127.
(251) كذا في الأصول المخطوطة، وفي اللسان: أحية وادي بغرة ...
(2/336)
________________________________________
عنصر: العُنْصُرُ: أصْلُ الحَسَب. إنما جاء عن الفُصَحاء مضمُومُ العَين منصُوب الصاد، ولا يجيء في كلامهم من الرباعي المُنبسِط على بناء فُعْلَل إلاّ ما يكون ثانيه نوناً أو همزةً نحو الجُنْدَب والجُؤْذَر. وجاءَ السودد كذلك كراهِيَة أن يقولوا سودُدٌ فتلتقي الضمّات مع الواو.
عنفص: العِنْفِص: المرأة القليلةُ الجسم، ويقال: هي أيضاً الداعِرة الخبيثة، قال:
ليستْ بسَوْداءَ ولا عِنْفِصٍ ... تُسارِقُ الطَّرْفَ إلى الداعِرِ «252»
وقال آخر:
صُلْبُ العَنافِصِ كلَّ أمرٍ أصلَحَتْ ... ومُعَمَّر في أهله مَعْمُورُ «253»
صعنب: الصَّعْنَبَةٌ: أن تُصَعْنِبَ الثريدة، تضُمُّ جوانبها وتُكَوِّمُ صَومعتها.
صنبع: والصَّنْبَعَةُ: انقباض البخيل عند المسألة. يقال: رأيتُه يُصَنْبِعُ لؤماً. وصنيبعات «254» : اسم موضع.
__________
(252) لم نهتد إلى الشاهد في كتب اللغة، وهو مما تفرد به العين.
(253) لم نتبين هذا البيت لانفراد العين بروايته.
(254) في ط: صنبعات.
(2/337)
________________________________________
عنصل: العُنْصُل: نباتٌ شِبْهُ البَصَل، وَوَرَقُه كورق الكُرّاث «255» ونوره أصفر يتخد منه صبيان الأعراب أكاليلَ، قال:
والضرب في جَأواءَ ملمومةٍ ... كأنَّما هاماتُها العُنْصُلُ «256»
عصلب: العَصْلَبيُّ: الشديد الباقي القوّة، «257» ، قال:
قد ضَمَّها اللَّيلُ بعَصْلَبيِّ
وعَصْلَبتُه: شِدَّة عَصَبه.
صلمع، صلفع: الصَلْمَعَةُ والصَلْفَعَةُ: الإفلاس «258» . ورجلٌ مُصَلْمِعٌ مُصَلْفِعٌ مُفْقِعٌ مُدْقِعٌ. صُلْمِعَ رأسُه وصُلْفِعَ: إذا استؤصِلَ شَعرُه. بلغة أهل العراق.
صعتر: الصَّعْتَر: ضَرْبٌ من البقول. والصَعْتَريُّ: الشاطِرُ
دعمص: الدُعْمُوص: دُوَيبةٌ تكونُ في الماء، قال:
ودُعْمُوصُ ماءٍ نَشَّ عنها غَديرُها
الدعْموص: الرجلُ الدَخّال في الأُمُور، الزَوّارُ للملوك، قال أمَيّة بن أبي الصَّلت:
دُعْمُوصُ أبواب الملوك ... وجانب للخرق فاتح
__________
(255) وزاد في التهذيب مما نقل عن الليث بقوله: أو أعرض منه.
(256) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في المصادر التي أفدنا عنها.
(257) في التهذيب عن الليث: الباقي على المشي والعمل، وكذلك في اللسان. وما أثبتناه فمما ورد في الأصول المخطوطة الثلاثة.
(258) وجاء في التهذيب مما نقل عن الليث: الإفلاس وذهاب المال.
(2/338)
________________________________________
رثعن: ارثَعَنَّ المطَرُ: إذا ثَبَتَ وجاد، قال «259» :
كأنَّه بعد رِياحٍ تَدْهَمُهْ ... ومُرْثَعِنّات الدُّجُونِ تَثمِهْ
والمُرْثَعِنُّ من الرجال: الضعيف، قال:
لستُ بالنِكْسِ ولا بالمُرْثَعِنْ
والمُرْثَعِنُّ: السيدُ الغالب: قال «260» :
حيثُ ارثَعَنَّ الوَدْقُ في الصَّحاصِحِ
بعثر: يقال بَعْثَرَه بَعْثَرَةً: إذا قَلَبَ الترابَ عنه.
عبثر: العَبَوْثَران: نباتٌ مثل القَيْصُوم في الغُبْرة، ذَفِرُ الريح، الواحدة عَبَوْثَرانة، فإذا يَبِسَتْ ثَمرَتُها عادت صفراءَ كَدِرة. وفيه أربع لغات بالياء والواو وضمّ الثّاء وفتحها.
عثلب: عَثْلَبَ زنداً: أي أخذه من شجرٍ لا يدري أيوري أم لا. وعَثْلَب: اسم ماء، قال الشمّاخ:
وصدَّتْ صُدوداً عن شَريعةِ عَثْلَبٍ ... ولا بنيَ عياذٍ في الصدور حَزائِزُ «261»
. عَثْلَبْتُ الحوضَ: إذا كسَرْتُه، قال العجّاج:
والنُؤيُ أَمْسَى جدره معثلبا «266»
__________
(259) (رؤبة) ديوانه/ 149.
(260) لم نهتد إلى القائل.
(261) كذا في الأصول المخطوطة والديوان ص 181، وفي التهذيب: حوامز
(266) لم يرد الرجز في ديوان العجاج.
(2/339)
________________________________________
دلعث: الدَّلْعَثُ: الجَمَلُ الضَّخْم، قال «262» :
دلاث دلعثي، كأن عظامه ... وعت في محال الزَّوْرِ بعدَ كُسُورِ
عمثل: العَمَيْثَلُ والعَمَيْثَلَةُ: الضَّخْمُ الثقيل. والعَمَيْثَلُ: إذا كان فيه إبطاءٌ من عِظَمه ونحو ذلك. وامرأةٌ عَمَيْثَلة ويُجمَعُ عَماثِلَ، قال «263» :
ليس بمُلْتاثٍ ولا عَمَيْثَلِ
ثعلب: الثَعْلَبُ: الذَكَر، والأنثى: ثُعالة. وثَعْلُبُ الرمح: ما دخل في عامِلِ صَدره في جُبَّةِ السِّنانِ. وثَعْلَبَ «264» الرجُلُ: جَبُنَ وراغ، كقول الشاعر:
فإنْ رآني شاعِرٌ تَثَعْلَبَا
والثَّعْلَبيَّةُ: اسم مكان. والثَّعْلبيَّةُ «265» : عَدْوٌ أشَدُّ من الخَبَبِ من عَدْوِ الفَرَس. وقال بعضُهم: الثَّعْلَبُ خَشَبَةٌ صُلْبة تُبْرَى ثم تدخُلُ في قَصَبَة القَناة، ثم يُرَكَّبُ فيها السِنانُ، وتُسَمَّى بالكلب، قال لبيد:
يُغرِقُ الثَعْلَبَ في شِرَّتِه ... صائِبُ الجذْمَةِ في غَيْر فَشَلْ
قولُه: في شِرَّتِه أي في أوَّلِ رَكْضه وسُرعته. والثَعْلَبُ: الحجر الذي يسيلُ منه المطر.
__________
(262) البيت في اللسان والتاج (دلعث) ، وجاءت (دلعثي) في التاج بياء مشددة ليستقيم الوزن. من غير عزو فيهما أيضا.
(263) لم نهتد إلى الراجز.
(264) وفي التهذيب: وثعلب الرجل وتثعلب....
(265) كذا في ص وط، وفي س: الثعلبة.
(2/340)
________________________________________
نعثل: النَعْثَلُ: الشَّيْخُ الأحمقُ، ويُقال: فيه نَعْثَلةٌ أي حُمْقٌ. وقال بعضُ الناس في عُثْمانَ: اقتُلُوا النَّعْثَلَ، يقال: شَبَّهَهُ بالضَبع كما يقال في العربيّة: يا ثَوْرُ، يا حِمارُ. والنَّعْثَلُ: الذيخ، وهو الذكر من الضِبْعان.
بلعم: البُلْعُومُ: البَياضُ الذي في جَحْفَلَة الحِمار في طَرَف الفَمِ، قال:
بيص البلاعيمِ أَمثال الخَواتيمِ
قال زائدةُ: البُلْعُومُ باطِنُ العُنُقِ كُلُّه، وليس كما قال.
عنبل: امرأةٌ عُنْبُلةٌ، وعَنْبَلَتُها: طولُ بَظْرِها. والعُنْبُلةُ: الخَشَبَةُ يُدَقُّ بها الشَيء في المِهْراس «267» . والعُنابِل: الوَتَرُ الغليظ، قال:
والقَوْسُ فيها وَتَرٌ عُنابِلُ «268»
والعُنابُ مثلُ العُنْبُلة أي البَظر.
عنبر: العَنْبَرُ: ضرب من الطيب.
__________
(267) في اللسان: يدق عليها بالمهراس، وكذلك في القاموس.
(268) الرجز في اللسان (لعاصم بن ثابت) .
(2/341)
________________________________________
يعفر: اليَعفُورُ: الخِشْف، سُمِّيَ بذلك لكَثرة لُزُوقِه بالأرض، قال طَرَفة:
آخرَ الليل بيعْفُورٍ خَدِرْ «269»
أي بشخص ظَبيٍ خَجِل مُسْتَحْيٍ.
يربع: يَرْبُوع: دُوَيْبةٌ فوقَ الجُرَذ، الذكر والأنثى فيه سواء. ويَرْبُوعٌ: قبيلة من تَميم.
برعم: البَرْعَمَةُ والبَراعم: أكمامُ ثَمَر الشَجَر.
لعظم: اللَّعْظَمةُ «270» : الانتِهاسُ على اللَّحْمِ مِلءَ الفَمِ. تقول: لَعْظَمتُ اللَّحم، وهو انتِهاسٌ على عجلة.
لعمظ: اللَّعْمَظَةُ: الحِرْصُ والشَهْوة في الطعام.
عظلم: العِظْلِمُ: عُصارةُ شَجَر لونه أخضَرُ إلى الكُدْرة.
رعبل: رَعْبَلْتُ اللَّحمَ رَعْبَلَةً: أي قَطَّعْتُه قِطَعاً صِغاراً كما يُرَعْبَلُ الثَّوْبُ فيُمَزَّقُ مِزَقاً، الواحدةُ رُعْبُولةٌ من الرَّعابِلِ، وهي الخِرَقُ المُتَمَزِّقَة. والشِّواءُ المُرَعْبَلُ: يُقَطَّعُ حتى تصلَ النارُ إليه فتنضجه، قال «271» :
__________
(269) وصدر البيت كما في اللسان: جازت البيد إلى أرحلنا.
(270) هذه المادة والتي تليها واحدة في الصحاح واللسان فكأنهما على القلب.
(271) التهذيب 3/ 364 واللسان (رعبل) وقد نسب فيهما إلى (ابن أبي الحقيق.)
(2/342)
________________________________________
من سَرَّه ضَرْبٌ يُرَعْبِلُ بعضُه ... بعضاً كَمَعْمَعَةِ الأباءِ المُحْرَقِ
الأباءُ: القَصَبُ. والأبُّ: الحشيش. أي يجُزُّ بعضُه بعضاً في السرعة، والمَعْمَعَةُ: السرعة. وامرأةُ رَعْبَل: في الخلقان، قال «272» :
كَصَوْت خَرقاءَ تُلاحي، رَعْبَلِ
أي تُشاتِمُ أخرى.
برعل، فرعل: البُرْعُلُ والفُرْعُلُ: وَلَدُ الضَّبع، الواحدةُ فُرْعُلة، قال «273» :
سَواءٌ على المَرءِ الغريبِ أجارُهُ ... أبو حَنَشٍ [أم] كانَ لحمَ الفَراعِلِ
عمرط: العَمَرَّط: الجَسُور الشديد. وبالدال أيضاً.
عفنط: العفنط: اللئيم الرذل السيىء الخلق.
عفنظ: العفنظ «274» : الذي يُسَمَّى عَناقَ الأرض.
عدمل: العدملي «275» : القديم.
__________
(272) في اللسان الرجز (لأبي النجم.)
(273) زاد في التهذيب: من الضبع. ولم نهتد إلى قائل البيت الشاهد وفي الأصول المخطوطة: (أو) مكان (أم) .
(274) في اللسان: العفنط عناق الأرض بالطاء المهملة والمادتان ومادة واحدة.
(275) في اللسان العدامل والعدملي والعدامل والعداملي واحد، وكذلك في التهذيب.
(2/343)
________________________________________
برذع: البَرْذَعَةُ «276» : الحِلْسُ الذي يُلْقَى تحت الرَّحْل وهو القِرطاط.
عذفر: العُذافِرةُ: الناقةُ الشديدةُ وهي الأَمُونُ. والعُذافِرُ: كوكبُ الذَنَب.
عذلم: العُذْلُمِيُّ «277» من الرجال: الحريصُ الذي يأكُلُ ما قَدِرَ عليه.
__________
(276) وهي بالدال المهملة أيضا.
(277) لم أهتد إليه ولم أجده في المعجمات المتيسرة لدي.
(2/344)
________________________________________
باب الخماسي من العين
قال الليث، قال الخليل: الخُماسيُّ من الكلمة على خمسة أحرف، ولا بدَّ أن يكونَ من تلك الخمسة واحد أو اثنان من الحروف الذَّلْق: ر، ل، ن، ف، ب، م، فإذا جاءت كلمة [رباعية أو خماسية] لا يكون فيها واحد من هذه الستة، فاعْلَمْ أنَّها ليست بعربية. قال: فإنْ قُلتَ مثلُ ماذا؟ قال: إن سُئِلْتَ عن [الحضاثج] ، فقل: ليست بعربية، لأنّه ليس فيها شيء من تلك الأحرف الستة. وكذلك لو قيل لكَ ما الخَضَعْثَج؟ فقل: ليست بعربية لأنّه ليس فيه من تلك الأحرف الستة شيءٌ. فمن الخُماسيِّ:
عفنقس وعقنفس: العَفَنْقَسُ والعَقَنْفَسُ: لغتان مثل جذب وجبذ، وهو السيىء الخُلُقِ المُتَطاوِلُ على الناس. يقال للعَقَنْفَس: ما الذي عَقْفَسَه وعَفْقَسَه؟ أي ما الذي أساء خلقه بعد ما كانَ حَسَنَ الخُلُق، قال العجّاج:
إذا أرادَ خُلُقاً عفنقسا «278»
عضرفوط: العضرفوط: دويبة تُسَمَّى العِسْوَدَّة «279» بيضاءُ ناعمةٌ تشبه بها أصابع
__________
(278) الرجز في الديوان ص 134 وفي التهذيب وبعده:
أقره الناس وأن تفجسا
(279) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: العسود.
(2/345)
________________________________________
الجواري، تكون في الرَمْل، وتُجمَعُ عَضافيط وعَضْرَفُوطات. ويقال: هي العَضْفُوط والعَضَافيطُ جماعة في القَولَين جميعاً. قال زائدة: العَسْوَدة، بالهاء، عظاءةٌ كبيرةٌ سَوداء تكون في الشَّجَر والجَبَل، وجمعه عِسْوَدٌ. وقال بعضهم: العَضْرَفوط: ذكر العَظاء، وهي من دَوابِّ الجِنِّ، قال:
وكلَّ المَطايا قد ركِبْنا فلم نَجِدْ ... أَلَذُّ وأَحْلَى من وَخيد الثَّعالِبِ
ومن فارةٍ مُزْمومةٍ شَمَّريَّةٍ ... وخَودٍ [ترى فيها] «280» امامَ الركائب
ومن عَضْرَفُوطٍ حَطَّ بي في ثَنيّةٍ ... يُبادِرُ سِرْباً من عَظاءٍ قَوارب
قَوارِب: طَوالِبُ الماء.
هبنقع: الهَبَنْقَعُ والهَبَنْقَعَةُ: المَزْهُوُّ الأحمق، والجميعُ: هَبَنْقَعُون وهَبَنْقَعَات، والفعل اهْبَنْقَعَ اهْبِنْقاعاً، إذا جَلَسَ جِلْسَةَ المَزْهُوِّ الأحمق، يُقال: هو يمشي الهَبَيَّخَى ويجلِسُ الهَبَنْقَعَة. الهَبَيَّخَى «281» : مِشيةٌ فيها نَفْجٌ وتحريك البدَن، قال جميل:
يَظَلْنَ بأعلَى ذي سَديرٍ عَواطباً ... بمُستَأنِسٍ من عيرجن هبنقع «282»
__________
(280) في س: تراميها، وفي ص وط: ترد فيها: ولم نجد الأبيات في غير الأصول من فطان.
(281) كذا هو الصحيح، وفي الأصول المخطوطة: الهبيخ.
(282) ديوانه/ 124 وفيه: لمستأنس.
(2/346)
________________________________________
قذعمل: القُذَعْمِلةُ والقُذَعْمِلُ: (الضَّخْمُ من الإبل) «283» . والقُذَعملة: الشديد من الأمر. قال زائدةُ: القُذَعْمِلُ الشَيءُ الصغيرُ شِبْهُ الحَبَّة، تقول: لا تُعطِ فلاناً قُذَعْمِلَةً.
قبعثر: القَبَعْثَرَى: الفَصيلُ المهزول، ويُجمعُ على قَبَعْثَرات وقَباعِث. وسألتُ أبا الدقيش عن تصغيره فقال: قُبَعْثرة «284» . ويقال: بل هو الفَصيلُ الرِخْوُ المضطرِب. وقال بعضُهم: ليس ذا بشيءٍ، ووافقه مُزاحم قال: ولكنّ القَبَعْثَرَى دابَّةٌ من دَوابِّ البحر لا تُرَى إلا مُنْقَبعةً في الثَّرَى أو على ساحل البحر.
عبنقاة: العَبَنْقَاة «285» : أي الداهية من العِقبان، ويجمَع عَبَنْقَيات وعَباقيّ. ومنهم من يقلبها فيقول: عَقَنْباة، قال الطرمّاح:
عُقابُ عَبَنْقاةٌ كأنَّ وَظيفَها ... وخُرْطُومَها الأَعْلَى بنارٍ مُلَوَّحُ
قوله: عَبَنْقاة أي حديدة الأظفار، مُلَوَّح لسوادها. ويقال: اعْبَنْقَى يَعْبَنْقي اعبنقاءً. وعَبَنْقاة بوزن فَعَنْلاة.
عنقفير: العَنْقَفير: الداهية، وعَقْفَرَتها: دهاؤها. وغُولٌ عَنْقُفيرٌ.
__________
(283) سقط ما بين القوسين من س.
(284) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب وزاد قوله: على الترخيم. في اللسان: قبيعث.
(285) في اللسان: عقاب عقنباة وعبنقاة وقعنباة وبعنقاة.
(2/347)
________________________________________
قرعبل: القَرْعْبْلانةُ: دُوَيْبَّةٌ عريضةٌ مُحْبَنْطِئةٌ. وما زادَ على قَرَعْبَل فهو فضلٌ ليس من حروفها الأصلية. ولم يأتِ شيءٌ من كلام العرب يَزيدُ على خمسة أحرف إلا أن تلحقها زيادات ليست من أصلها أو يُوَصَلَ حكايةً يُحكى بها، كقول الشاعر «286» :
فَتَفْتَحُه طَوْراً وطَوراً تُجيفُه ... فَتَسمعُ في الحالَيْنِ منه جَلَنَبَلَقْ
يَحكي صوتَ بابٍ في فَتْحِهِ وإصفاقه. وهما حكايتان جَلَنْ على حِدة، وبَلَق على حِدة. وقول الشاعر في حكاية جَرْي الدَوابِّ:
جَرَتْ الخَيْلُ فقالت ... حَبَطِقْطِقْ حَبَطِقْطِقْ
وإنّما هو إردافٌ كما أردَفُوا العَصَبْصَب، وإنّما هو من العَصيب.
جَنَعْدَل: الجَنَعْدَل «287» : التارُّ الغليظ الرقَبَة.
دلعوس: الدِّلْعَوْس، المرأةُ الجريئة على أمرها العَصيَّةُ لأهلها. والدِّلْعُوْسُ: الناقةُ الجريئة أيضاً.
سقرقع: السُقُرْقَع «288» : شراب لأهل الحجاز من الشعير والحُبوب قد لَهِجُوا به. وهذه الكلمة
__________
(286) التهذيب 3/ 368، واللسان (جلنبلق) . غير منسوب أيضا.
(287) من التهذيب 3/ 369 عن العين. في الأصول المخطوطة: جعندل.
(288) كذا في اللسان، وفي التهذيب: السفرفع (بالفاء) ، وفي الأصول المخطوطة بالشين.
(2/348)
________________________________________
حبشية وليست من كلام العرب، وبيان ذلك أنه ليس من كلام العرب كلمة صدرها مَضمُوم وعَجُزُها مفتوح إلاّ ما جاء من البناء المُرَخَّم نحو الذُرَحْرَحة والخُبَعْثَنة. وأصل هذا أنّهم يَعْمِدون إلى الشعير فَيُنَبِّتُونه، فإذا كَبَتَ أو هَمَّ بالنبات خَمَدوا إليه فجفَّفُوه ثم اتَّخَذوه هَيُوجاً لشَرابهم أي عَكراً، ثم يعمِدُون إلى خُبْز الشعير أو غير ذلك فيخبِزُونه خُبزاً غِلاظاً، ثم إذا أخرَجُوه حارّاً كسروه في الماء، ثم ألقَوا فيه من ذلك الطَّحين قَبْضةً فيُغليه ذلك أيّاماً، ثم يُضْرَبُ بالعَسَل فهو شَرابٌ قطامي صلب.
اقعنسس: اقعنسس العِزُّ: إذا ثَبَتَ ولَزِمَ، قال:
تَقَاعُسَ العِزُّ بنا فاقْعَنْسَسَا «289»
سقعطر: السَّقَعْطَريُّ من الرجال: لا يكون أطوَلَ منه. ويقال: تُنْعَتُ الإبلُ بهذا النَّعْت.
سبعطر: السَّبَعْطَريُّ: الضَّخْمُ الشديدُ البَطش
خبعثن: الخُبْعَثِنُ: من كلّ شيءٍ التّارُّ البَدَن، الرّيّانُ المَفَاصِلِ، وتقول: اخبَعَّثَ في مشيهِ، وهو مَشْيٌ كَمَشيِ الأسد، قال يصف الفيل:
خُبَعْثِنٌ مشيته عثمثم «290»
__________
(289) (العجاج) ديوانه/ 138.
(290) اللسان (عثم) غير منسوب أيضا.
(2/349)
________________________________________
ويقالُ: أسَدٌ خُبَعْثِنةٌ. ويقالُ: فلان خُبَعثِنةٌ. ويقال: للفيل خُبَعْثِنٌ وبَقَرةٌ خُبَعْثِنةٌ، قال أعرابيّ في صفة الفيل:
خُبَعْثِنٌ في مَشْيِهِ تَثْقيلُ ... أمثالُه بأرضِنا قليلُ «291»
وإن قلتَ: خُبَعْث على الترخيم جازَ لك. وإنْ قيل للذَكَر بالهاء كانَ صواباً كقولك أسَدٌ خُبَعْثِنَةٌ.
علطميس: العَلْطَمِيسُ من النوق: الشَديدةُ الضَّخْمَةُ ذاتُ أقطار وسَنام مُشرفٍ.
سلنطع: السَّلَنْطَعُ: الرّجُل المُتَعَتِّهُ في كلامه كأنه مجنُون.
عيطموس: العَيْطَمُوسُ من النّوق: الشديدةُ الضَّخْمَةُ.
عندليب: العَنْدَليبُ: طُوَيْرٌ يُصَوِّتُ ألواناً.
عفرناة: أَسَدٌ عِفِرْناة: شديد قوي. ولبوءة عِفِرْناة.
جَلَنْفَع: الجَلَنْفَعُ: الغليظ من الإِبِل.
تلعثم «292» : التَلَعْثُمُ: التَنَظُّرُ. لَعْثَم عنه أي نَكَلَ عنه. وتَلَعْثَمْتُ عن هذا الأمر أي نَكَلْتُ عنه.
__________
(291) لم نهتد إليه.
(292) من حق هذه الكلمة أن يترجم لها في أبواب الرباعي لأنها رباعية، ولكنه عبث النسخ.
(2/350)
________________________________________
ج 3
حرف الحاء
قال الخليل بن أحمد- رضي الله عنه «1» -: الهاء والحاء لا تأتلفان في كلمةٍ واحدةٍ أصليّة الحروف، لقُرب مَخْرجَيْهما في الحَلْق، ولكنَّهما يجتمعان من كلمتين، لكُلِّ واحدةٍ منهما معنىً على حِدَة، كقول لبيد:
يَتَمارَى في الذي قلتُ له ... ولقد يَسَمعُ قَولي حَيَّهَلْ
وقال آخر:
هَيْهاؤهُ وحَيْهَلُهْ
حَي كلمة على حدة ومعناها هَلُمَّ، وهل حِثِّيثَى، فجَعَلَهما كلمةً واحدة.
وفي الحديث «2» : إذا ذُكِرَ الصالحونَ فَحَيَّهَلا بعُمَرَ
أي فَأْتِ بذكر عُمَرَ. قال اللَّيْث: قُلتُ للخليل: ما مِثْلُ هذا في الكلام: أن يُجْمَعَ بين كلمتين فتَصير منهما كلمة واحدة؟ قال: قول العرب عَبْد شَمْس وعَبْد قَيْس فيقولون: تَعَبْشَمَ الرجل وتعبقس وعبشمي وعبقسي.
__________
(1) جملة الدعاء لم ترد في ص وط. والبيت الشاهد في ديوان لبيد ص 183
(2) وفي اللسان: وفي حديث ابن مسعود. وقد روي الحديث في التهذيب: فحيهل ...
(3/5)
________________________________________
باب الثنائي
باب الحاء والقاف وما قبلهما مهمل ح ق، ق ح مستعملان
حق: الحقُّ نقيض الباطل. حقَّ الشيْء يَحِقُّ حَقّاً أي وَجَبَ وُجُوباً. وتقول: يُحِقُّ عليكَ أنّ تفعَلَ كذا، وأنتَ حقيقٌ على أن تفعَلَه. وحَقيقٌ فَعيلٌ في موضع مفعول. وقول اللهِ عزَّ وجَلّ «1» - حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ
«2» معناه مَحقوق كما تقول: واجب. وكلُّ مفعُول رُدَّ إلى فعيل فمذكره ومؤنثه بغير الهاء، وتقول للمرأة: أنتِ حقيقةٌ لذلك، وأنتِ محقوقة أن تفعلي ذلك، قال الأعشى:
لَمحقُوقَةٌ أنْ تَسْتَجيبي لصَوْته ... وأنْ تَعلمي أنَّ المُعانَ مُوَفَّقُ «3»
والحَقَّةُ من الحَقِّ كأنَّها أوجَبُ وأَخَصُّ. تقول: هذه حَقَّتي أي حَقّي. قال:
وحَقَّهٌ ليست بقول التُرَّهة.
والحقيقة: ما يصيرُ إليه حقُّ الأمر ووجوبه. وبلغْتُ حقيقةَ هذا: أي يقين شأنه.
وفي الحديث: لا يبلُغُ أحدُكُم حقيقةَ الإِيمان حتى لا يعيبَ على مُسلِمٍ «4» بعَيْبٍ هو فيه.
وحقيقةُ الرجل: ما لَزِمَهُ الدفاعُ عنه من أهل بيته، والجميع حقائق.
__________
(1) في ص وط: وقوله من غير إشارة إلى أن القول آية.
(2) سورة الأعراف 105
(3) البيت في الديوان واللسان وقبله:
وإن امرء أسرى إليك ودونه ... من الأرض موماة ويهماء سملق
(4) في التهذيب واللسان والنهاية: مسلما
(3/6)
________________________________________
وتقول: أَحَقَّ الرجُلُ إذا قال حَقّاً وادَّعَى حَقّاً فوَجَبَ له وحَقَّقَ، كقولك: صدَّق وقالَ هذا هو الحقُّ. وتقول: ما كان يَحُقُّك أن تَفْعَل كذا أي ما حَقَّ لك. والحاقَّةُ: النازلة التي حقَّتْ فلا كاذبةَ لها. وتقولُ للرجل إذا خاصَمَ في صِغار الأشياء: إنّه لنَزِقُ الحِقاقِ.
وفي الحديث: مَتَى ما يَغْلُوا يحتَقُّوا
أي يَدَّعي كلُّ واحدٍ أنَّ الحقَّ في يَدَيْه، ويغلوا أي يُسرفوا في دينهم ويختصموا ويتجادلوا. والحِقُّ: دونَ الجَذَع من الإِبِل بسنةٍ، وذلك حين يَسْتَحِقُّ للرُكُوب، والأُنثَى حِقَّةٌ: إذا استَحَقَّتِ الفَحْلَ، وجمعه حِقاق وحَقائِق، قال عَديّ:
لا حقة هُنَّ ولا يَنوبُ «1»
وقال الأعشى «2»
أيُّ قومٍ قَوْمي إذا عزت الخمر ... وقامتْ زِقاقُهُمْ والحِقاقُ
والرواية:
قامت حِقاقُهُم والزِّقاق
فمن رواه:
قامت زقاقُهم والحقاق
يقول: استوت في الثمن فلم يفضلُ زِقٌ حِقّاً، ولا حِقٌّ زِقّاً. ومثله:
قامت زقاقُهم بالحِقاق
فالباءُ والواوُ بمنزلة واحدة، كقولهم: قد قامَ القَفيزُ ودِرْهَم، وقام القَفيزُ بدرهم. وأنتَ بخَيرٍ يا هذا، وأنت وخَيْرٌ يا هذا، وقال «3» :
ولا ضعافِ مُخِّهِنَّ زاهقِ ... لَسْنَ بأنيابٍ ولا حَقائقِ
__________
(1) لم نجده في ديوان عدي بن زيد.
(2) البيت في التهذيب واللسان (لعدي) . وقد ضمه محقق ديوان عدي إلى شعر (عدي) مما لم يذكر في الديوان. وفي الأصول المخطوطة منسوب إلى (الأعشى) ولم نجده في ديوان الأعشى ولعله من سهو الناسخ.
(3) الرجز في اللسان (لعمارة بن طارق) وروايته: ومسد أمر من أيانق......
(3/7)
________________________________________
وقال «1» :
أفانينَ مكتُوبٍ لها دونَ حِقِّها ... إذا حَمْلُها راشَ الحِجاجَيْن بالثُّكْلِ
جَعَلَ الحِقَّ وقتاً. وجمع الحُقَّةِ من الخَشَب حُقَق، قال رؤبة:
سوى مساحيهن تقطيط الحقق «2»
والحَقْحَقَةُ: سَيْرُ أوّلِ اللُيل، وقد نُهِيَ عنه، ويقال: هو إتعابُ ساعة.
وفي الحديث: إيّاكُم والحَقْحَقةَ في الأعمال، فإنَّ أحَبَّ الأعمال إلى الله ما داومَ عليه العبد وإنْ قلَّ.
ونباتُ الحَقيق «3» : ضرب من التَّمْر وهو الشِّيصُ.
قح: والقُحُّ الجافي من الناس والأشياء، يقالُ للبَطِّيخة التي لم تَنْضَج: إنَّها لقُحٌّ «4» . والفعلُ: قَحَّ يقُحُّ قُحوحةً، قال:
لا أبتغي سَيْبَ اللئيم القُحِّ ... يكادُ من نحنحة وأح
يحكي سعال الشَّرِقِ الأَبَحِّ «5»
والقُحُّ: الشَّيخُ الفاني. والقُحُّ: الخالصُ من كُلِّ شَيْءٍ. والقُحْقُحُ: فوقَ القَبِّ شيئاً. والقَبُّ: العظمُ الناتىء من الظَّهْر بين الأَلْيَتْين.
__________
(1) الشاعر (ذو الرمة) . والبيت في الديوان 1/ 153.
(2) الرجز في ديوان رؤبة.
(3) جاء في التهذيب: قلت: صحف الليث هذه الكلمة وأخطأ في التفسير أيضا، والصواب: لون الحبيق ضرب من التمر ردىء.
(4) قال الأزهري في التهذيب: قلت: أخطأ الليث في تفسير القح، وفي قوله للبَطِّيخة التي لم تَنْضَج إنهالقح، وهذا تصحيف. وصوابه: الفج بالفاء والجيم
(5) الرجز في التهذيب فيما نقله عن الليث، ثم تكرر في اللسان، وكله من غير عزو.
(3/8)
________________________________________
باب الحاء مع الكاف ح ك، ك ح «1» مستعملان
حك: الحَكيكُ: الكَعْبُ المحكُوكُ. والحَكيكُ: الحافِرُ النَّحيتُ. والحَكَكَةُ: حَجَرٌ رِخْوٌ أبيض أرْخَى من الرِّخام وأصلَبُ من الجَصِّ. والحاكَّةُ: السِنِّ، تقول: ما فيه حاكَّة. ويقال: إنَّه لَيَتَحكَّكُ بكَ: أي يَتَعَرَّض لشَرِّكَ. وحَكَّ في صدري واحتَكَّ: وهو ما يَقَعُ في خَلَدك من وسَاوِس الشيطان.
وفي الحديث: إياكم والحكاكات فإنَّها المآتم.
وحَكَكْتُ رأسي أحُكُّه حَكّاً. واحتَكَّ رأسُه احتكاكاً. وقوله «2» :
أنا جُذَيْلُها المُحَكَّك
أي عِمادُها ومَلْجَأُها.
كح: الأكح: الذي لا سن له. والكُحْكُحُ: المُسِنُّ من الشّاء والبقر.
باب الحاء مع الجيم ح ج، ج ح مستعملان
حج: قد تُكسَر الحَجّةُ والحَجُّ فيقال: حِجُّ وحِجَّةٌ. ويقال للرجل الكثير الحَجٍّ حَجّاج من غير إمالةٍ. وكلُّ نعت على فَعّال فإنّه مفتوح الألف، فإذا صيَّرتَه اسماً يَتَحَوَّل عن حال النَّعْت فتدخله الإمالة كما دَخَلَتْ في الحَجّاج والَعجّاج. وحَجٍّ علينا فُلانٌ أي قَدِمَ. والحَجُّ: كثرة القَصْد إلى من يُعَظَّم، قال:
كانت تحُجُّ بنُو سَعْدٍ عِمامتَه ... إذا أَهَلُّوا على أنصابِهم رَجَبا «3»
__________
(1) لم ترد هذه المادة في الأصول المخطوطة بعد مادة (حكك. وأثبتناها من مختصر العين [ورقة 55] .
(2) في التهذيب: وقول (الحباب
 أنا جذيلها ...
أنا جذيلها ...(3) لم نهتد إلى البيت ولا إلى قائله.
(3/9)
________________________________________
حَجُّوا عِمامتَه: أي عظَّمُوُه. والحِجَّةُ: شَحْمةُ الأُذُن، قال لبيد:
يَرُضْنَ صِعابَ الدُرِّ في كل حجة ... وإن لم تكن أعناقهن عواطلا «1»
ويقال: الحجة هيهنا الموسم. والحَجْحَجَةُ: النُّكُوصُ، تقول: حَمَلوا ثم حَجْحَجوا أي نَكَصُوا، قال «2» :
حتّى رَأَى رايتَهم فَحَجْحَجا
والمَحَجَّةُ: قارعة الطريق الواضح. والحُجَّةُ: وَجْهُ الظَّفَر عند الخُصومة. والفِعل حاجَجْتُه فَحَجَجْتُه. واحتَجَجْتُ عليه بكذا. وجمع الحُجَّة: حُجَجٌ. والحِجاج المصدر. والحَجاجُ: العظمُ المستدير حولَ العَين، ويقال: بل هو الأَعْلى الذي تحت الحاجب، وقال: «3»
إذا حَجاجا مُقلتَيْها هَجَّجا
والحَجيجُ: ما قد عُولِجَ من الشَجَّة، وهو اختلاط الدَّمِ بالدماغ فيصب عليه السَّمْنُ المَغْلِيُّ حتى يظهَرَ الدمُ فيُؤخَذُ بقُطنةٍ، يقال: حَجَجْتُه أحُجُّه حَجّاً. الجَحْجاحُ: السيِّدُ السَّمْحُ الكريمُ، ويجمع: جَحاجِحة، ويجوز بغير الهاء، قال أمية «4» :
__________
(1) رواية الديوان ص 243:
....... ... ولو لم تكن أعناقهن عواطلا.
وهو كذلك في ص وط في حين أن الرواية في س واللسان: يرضن صعاب الدو......
(2) صاحب الرجز هو (العجاج) . انظر الديوان ص 389. والرواية فيه:
حتى رأى رائيهم فحجحجا
(3) (الحجاج) أيضا. انظر الديوان واللسان.
(4) لا ندري (أأمية بن أبي الصلت) أم أمية آخر؟ ولم نجد البيت في ديوان أمية بن أبي الصلت.
(3/10)
________________________________________
ماذا ببدر فالعقنقل ... من مرازبة جَحاجحْ
وأَجَحَّتِ الكلبةُ: أي حَمَلَتْ فهي مُجحٌّ.
باب الحاء مع الشين ح ش، ش ح مستعملان
حش: حَشَشْتُ النارَ بالحَطَب أحُشُّها حَشّاً: أي ضَمَمْتُ ما تَفَرَقَ من الحَطَب إلى النار. والنابِلُ إذا راشَ السَهْمَ فأَلزَقَ القُذَذَ به من نَواحيه يقال: حَشَّ سَهْمَه بالقُذَذِ، قال:
أو كمريخ على شريانة ... حشه الرامي بظهران حشر «1»
والبَعيرُ والفَرَسُ إذا كان مُجْفَرَ الجنْبَيْن يقال: حُشَّ ظهْرُه بجَنْبَيْنِ واسِعَيْن، قال أبو داود في الفرس:
منَ الحاركِ مَحْشُوشٌ ... بجَنْبٍ جُرْشُعٍ رَحْبِ «2»
والحُشاشةُ: روحُ القلب. والحُشاشةُ: رَمَقُ بَقيَّة من حياة النفس، قال يصف القردان «3» :
__________
(1) البيت في التهذيب 3/ 392 فيما رواه عن الليث من غير عزو.
(2) البيت في اللسان (حشش) .
(3) البيت (للفرزدق) كما في التهذيب واللسان (حشش) والرواية فيه:
إذا سمعت وطء الركاب تنفست......
أما في ترجمة (نغش) فقد قال: وأنشد (الليث) لبعضهم. في صفة القراد:
إذا سمعت وطء الركاب تنغشت
(3/11)
________________________________________
إذا سمعت وطء الركاب تَنَغَشَّتْ ... حُشاشَتُها في غيرِ لحْمٍ ولا دَمِ
والحشيشُ الكَلَأُ، والطّاقَةُ منه حشيشةٌ، والفعل الاحتِشاش. والمَحَشَّةُ: الدُّبُر.
وفي الحديث: مَحاشُّ النساء حرامٌ
ويُرْوَى: مَحاسنٌّ بالسين أيضاً. والحَشُّ والحُشُّ: جماعة النَّخْل، والجميعُ الِحُشّان. ويقالُ لليَدِ الشّلاّءِ: قد حَشَّتْ ويَبِسَتْ. وإذا جاوزَتِ المرأةُ وقتَ الوِلادِ «1» وهي حاملٌ ويَبْقَى الولَدُ في بطنها يقال: قد حَشَّ ولدُها في بَطنها أي يَبِسَ. وأحَشَّتِ المرأةُ فهي مُحِشٌّ. والحَشُّ: المخرَجُ.
شح: يقالُ: زَنْد شَحاحٌ: أي لا يُوري. والشَّحْشَحُ: المواظِب على الشيء الماضي فيه. والشَّحْشَحُ: الرجل الغَيورُ وهو الشَّحشاح، قال «2» :
فيقدمُها شَحْشَحٌ عالمٌ
ويقالُ: شَحْشَحَ البعير في الهَدْر وهو الذي ليس بالخالِص من الهَدْر، قال:
فردَّدَ الهَدْرَ وما إنْ شحشحا «3»
__________
(1) كذا في ص وط، وفي س: الولادة
(2) البيت (لحميد بن ثور) كما في ديوانه ص 48 والرواية فيه:
تقدمها شحشح جائز ... لماء قعير يريد القرى
(3) الرجز في التهذيب 3/ 396 من غير عزو. ونسب في اللسان (شحح) إلى (سلمة بن عبد الله العدوي.)
(3/12)
________________________________________
ويقالُ للخطيب الماهِر في خُطْبته الماضي فيها: شَحْشَح. والشُّحُّ: البُخل وهو الحِرْصُ. وهما يَتَشاحّان على الأمر: لا يُريدُ كلُّ واحدٍ منهما أن يفوته. والنَّعْتُ شَحيح وشَحاح والعَدَدُ أشِحَّة. وقد شَحَّ يَشِحٌّ شُحّاً.
باب الحاء مع الضاد ح ض، ض ح مستعملان
حض: حضَّ: الحِضِّيضَى والحِثِّيَثى من الحَضِّ والحَثِّ. وقد حَضَّ يحُضُّ حضّاً. والحُضضُ: دَواء يُتَّخَذُ من أبوال الإبِلِ. والحَضيض: قَرارُ الأرض عند سفح الجبل.
ضح: الضِّحُّ والضَّيْحُ: ضوء الشَّمس إذا استَمْكَنَ من الأرض. والضَّحْضاحُ: الماءُ إلى الكَعْبَيْن، أو إلى أنصاف السُّوقِ. والضَحْضَحةُ والتَّضَحْضُحُ «1» : جَرْيُ السَّراب وتَلَعْلُعُهُ:
باب الحاء مع الصاد ح ص، ص ح مستعملان
حص: الحَصْحَصَةُ: الحركةُ في الشيْء حتى يَسْتَقِرَّ فيه ويَستَمكنَ منه. وتحاص
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: والتضحيح.
(3/13)
________________________________________
القَومُ تَحاصّاً: يَعني الاقتِسامَ من الحِصَّة. والحَصْحَصَةُ: بَيان الحق بعد كتمانه. حَصْحَصَ الْحَقُّ، ولا يقال: حُصْحِصَ الحقُّ. والحُصاصُ: سُرعة العَدْو فيِ شِدَّة. ويقال: الحُصاص: الضُّراط. والحُصُّ: الوَرْسُ، وإن جُمِعَ فحُصُوص، يُصْبِغُ به، وهو الزَّعْفَران أيضاً. والحَصُّ: إذهابُكَ الشَّعْر كما تَحُصُّ البَيْضة رأس صاحبها، قال «1» :
قد حَصَّتِ البَيْضَةُ رأسي فما ... أطعَمُ ونَوماً غيرَ تَهْجاعِ
وقال: «2»
بميزان قِسْطٍ لا يَحُصُّ شعيرةً ... له شاهدٌ من نفسه غيرُ فاضِلِ «3»
لا يَحُصُّ: أي لا يَنْقُصُ. ويقالُ: رجلٌ أحَصُّ وامرأةٌ حَصّاء. وقال في السنة الجَرداء الجَدْبة:
عُلُّوا على شارفٍ صَعْبٍ مراكبُها ... حَصّاءَ ليس بها هُلْبٌ ولا وَبرُ «4»
عُلُّوا: حُمِلُوا على ذلك
صح: الصِحَّةُ: ذَهابُ السَّقَم والبَراءة من كل عَيْب ورَيْب. صَحَّ يَصِحُّ صِحَّةً.
(والصَّومُ مَصَحَّةٌ «5» )
ومَصِحَّة، ونَصْب الصادِ أعلى من الكسر. يعني يصح عليه.
__________
(1) في التهذيب 3/ 400: وقال (أبو قيس بن الأسلت.)
(2) في اللسان: وفي شعر (أبي طالب) : البيت....
(3) والمعنى: ذهب الشعر كله.
(4) البيت في اللسان غير منسوب، والرواية فيه:
علوا على سائف صعب مراكبنها
(5) ما بين القوسين من الحديث الشريف كما في التهذيب 3/ 404
(3/14)
________________________________________
والصَّحْصَانُ والصَحْصَحُ: ما استوى وجَرِدَ من الأرض، ويجمع صَحاصِح، قال:
وصَحْصَحانٍ قُذُفٍ كالتُّرْسِ «1»
باب الحاء مع السين ح س، س ح مستعملان
حس: الحَسُّ: القَتْل الذَريعُ. والحَسُّ: إضرارُ البَرْد الأشياءَ، تقول: أصابتْهم حاسَّةٌ من البَرْد، وباتَ فلان بِحَسَّةِ سَوءٍ «2» : أي بحالٍ سيِّئةٍ وشدَّةٍ. والحَسُّ: نَفْضُك التُرابَ عن الدابَّة بالمِحَسَّة وهي الفِرْجَون. ويقالُ: ما سَمِعْتُ له حِسّاً ولا جرِسْاً، فالحِسُّ من الحركة، والجْرسُ من الصَّوْت. والحِسُّ: داءٌ يأخُذُ النُّفَساءَ في رَحِمها. وأَحْسَسْتُ من فُلانٍ أمراً: أي رأيتُ. وعلى الرؤيةِ يُفسَّر (قوله عَزَّ وجل) : فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ
«3» أي رأَى. ويقال: مَحَسَّةُ المرأة: دُبُرُها. ويقالُ: ضُرِبَ فلان فما قالَ حَسٍّ ولا بَسٍّ، ومنهم من لا ينوِّن ويجُرُّ فيقول: حَسِّ، ومنهم من يكسر الحاء «4» . والعرب تقول عند لَذْعِة نارٍ أو وَجَع: حَسٍّ حس «5» . والحس: مس
__________
(1) التهذيب 3/ 405 واللسان (صحح) ورواية فيهما:
وصحصحان قذف مخرج
(2) جاء في التهذيب: قلت: والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة بات بحيبة سوء، وبكينة سوء، وببيئة سوء. ولم أسمع بحسة سوء لغير الليث والله أعلم.
(3) سورة آل عمران 52
(4) وزاد في اللسان: والباء.
(5) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب 3/ 407 في اللسان: حس بس.
(3/15)
________________________________________
الحُمَّى أوّلَ ما تبدو «1» . والحِسُّ: الحَسيسُ تسمَعُه يمُرُّ بك ولا تَراه، قال:
تَرَى الطَّيْرَ العِتاقَ يَظَلْنَ مِنْهُ «2» ... جُنُوحاً إنْ سَمِعْنَ له حسيساً
وتَحَسَّسْتُ خَبَراً: أي سأَلْتُ وطَلَبْتُ.
سح: السَّحْسَحَةُ: عَرْصَة المَحَلَّة وهي السّاحةُ. وسَحَّتِ الشّاهُ تَسِحُّ سَحّاً وسُحُوحاً أي حَنَّتْ. وشاةٌ سمينة ساحٌّ، ولا يقال: ساحَّةٌ. قال الخليل: هذا مما يُحْتَجُّ به، إنّه قولُ العرب فلا نَبْتَدُع شيئاً فيه. وسَحَّ المَطَرُ والدَّمْعُ يَسِحُّ سَحّاً وهو شدَّةُ انصبِابِه. وفَرَسٌ مِسَحٌّ: أي سريع، قال «3» :
مسح إذا ما السابحات على الوَنَى ... أثَرْنَ الغُبارَ بالكَديدِ المُرَكَّلِ
باب الحاء مع الزاي ح ز، ز ح مستعملان
حز: الحُزُّ: قَطْعٌ في اللَّحْم غيرُ بائن. والفَرْضُ في العظم والعُود غير طائل حز أيضا. يقال: حززته حَزْاً، واحتزَزْتُه احتِزازاً، قال الشاعر: «4»
وعبدُ يَغُوتٍ تَحجِل الطَّيْرُ حولَه ... قد احتَزَّ عرشيه الحسام المذكر
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: تبدأ.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: يطلن.
(3) للشاعر (امرىء القيس) . انظر معلقته، وانظر اللسان (كدد) .
(4) (لذي الرمة) انظر الديوان 2/ 648، والرواية فيه: وقد حز....
(3/16)
________________________________________
فجعل الاحتزاز هيهنا قطع العنق. والحزازة: هبرية في الرَأس «1» ، وتجمَع على حَزازٍ. والحزازةُ أيضاً: وَجَعٌ في القَلْب من غَيْظٍ ونحوه. والحَزّاز يُقال في القَلْب أيضاً، قال الشمّاخ:
فلما شراها فاضت العين عبرة ... وفي الصدر حزاز من اللَّومِ حامِزُ «2»
وقال «3» :
وقد يَنْبُتُ المَرْعَى على دِمَن الثَّرَى ... وتَبْقَى حَزازاتُ النُفوس كما هِيا
وتقول: أعطيتُه حُزّةً من لَحْمٍ «4» . والحَزّاز من الرجال: الشَّديد على «5» السَّوْق والقِتال، قال:
فهي تفادى من حزاز ذي حَزِقْ «6»
وفي الحديث: أخَذَ بحُزَّته
يقال: أخَذَ بعُنقه، وهو من السَّراويل حُزَّة وحُجْزَة، والعُنُق عندي تشبيه به. وحَزّاز «7» القلوب: ما حَزَّ وحكَّ في قلبه. والحَزيزُ: مَوضِعٌ من الأرض كَثُرتْ حِجارتُه وغَلُظَتْ كأنَّها سكاكينُ، ويجمعُ على حُزّاِن وثلاثة أحِزَّة «8» . وإذا أصاب المرفقُ طَرَفَ كِرْكِرةِ البَعيرِ فقَطَعَه قيل به حاز.
__________
(1) وزاد في التهذيب: كأنها نخالة.
(2) ديوانه/ 190 وروايته فيه:
............... ........... ... وفي الصدر حزاز من الوجد حامز
(3) اللسان (حزز) ، وقد نسب فيه إلى (زفر بن الحرث الكلابي) .
(4) وفي اللسان: وأعطيته حذية من لحم وحزة من لحم.
(5) كذا في ص وس، وفي ط: من.
(6) الرجز في التهذيب 3/ 414 غير منسوب.
(7) كذا في س في ص وط: حواز. وفي اللسان مثل ما أثبتناه.
(8) في المحكم: والجمع أحزة وحزان بضم الحاء أو كسرها مع تشديد الزاي.
(3/17)
________________________________________
زح: الزح: جذب الشَّيءِ في العَجَلة. زَحَّه يزُحُّه زَحّاً. والزَّحْزَحة: التَنْحِيةُ عن الشيء [يقال] زَحْزَحْتُه فتَزَحْزَحَ.
باب الحاء مع الطاء ح ط، ط ح مستعملان
حط: الحَطُّ: وَضْعُ الأحمال عن الدَّوابِّ. والحَطُّ: الحَدْرُ من العُلوِّ. وحَطَّتِ النَجيبةُ وانحَطَّتْ في سيرها من السرعة، قال النابغة يمدح النُّعمانَ:
فما وخدت بمثلك ذات غرب ... حطوط في الزمام ولا لَجُونُ «1»
وقال: «2»
مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقِبلٍ مُدْبرٍ مَعاً ... كجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّه السَّيْلُ من عَلِ
وحَطَّ عنه ذُنُوبَه، قال:
واحْطُطْ إلهي بفَضْلٍ منك أوزاري «3»
والحَطاطةُ: بَثُرٌة تخرُج في الوجه صغيرة تُقَبِّح «4» اللَّوْنَ ولا تُقَرِّح، قال: «5»
ووجهٍ قد جَلَوتِ أُقَيْم صافٍ ... كقَرْن الشمس ليس بذي حطاط
__________
(1) البيت في الديوان ص 265.
(2) الشاعر هو (امرؤ القيس) ، والبيت في مطولته.
(3) لم نهتد إلى البيت ولا إلى قائله.
(4) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب واللسان: تقيح.
(5) (هو المتنخل الهذلي) كما في اللسان، والرواية فيه:
ووجه قد رأيت أميم صاف
وفي ديوان الهذليين 2/ 23:
ووجه قد طرقت أميم صاف
(3/18)
________________________________________
وبَلَغَنا أنَّ بني إسرائيلَ حيثُ قيل لهم: وَقُولُوا حِطَّةٌ «1» * إنّما قيل لهم ذلك حتّى يَسْتَحِطُّوا بها أوزارهم فتُحَطَّ عنهم. ويقالُ للجارية الصغيرة: يا حَطاطةُ. وجاريةٌ مَحْطُوطُة المَتْنَيْن أي ممدُودةٌ حَسَنة، قال النابغة:
محطُوطةُ المَتْنَينِ غيرُ مُفاضةٍ «2»
طح: الطَحَّ: أنْ يَضَعَ الرجلُ عَقِبَه على شيءٍ ثمَّ يَسْحَجُه بها. والمِطَحّةُ من الشّاةِ مُؤَخَّرُ ظِلْفها وتحتَ الظِلّفْ في مَوْضِع المِطَحَّة عُظَيم كالفَلْكة. والطَّحْطَحَةُ: تفريق الشيء هَلاكاً، وقال في خالد بن عبد الله القَسْريّ:
فيُمْسي نابذاً سُلْطان قَسْرٍ ... كضَوء الشمس طَحْطَحَه الغُرُوبُ «3»
باب الحاء مع الدال حد، د ح مستعملان
حد: فَصلُ ما بينَ كُلِّ شيئين حَدٌّ بينهما. ومُنْتَهَى كُلِّ شيءٍ حدُّه. وحَدَّ السيفُ واحتَدَّ. وهو جَلْدٌ حَديدٌ. وأحدَدْتُه. واستَحَدَّ الرجلُ واحتَدَّ حِدَّةً [فهو] «4» حديد. وحُدُودُ الله: هي الأشياء التي بيَّنَها وأَمَر أنْ لا يُتَعَدَّى فيها. والحَدُّ: حَدُّ القاذِف ونحوِه مما يُقامُ عليه من الجَزاء بما أتاه. والحديد معروف، وصاحبه
__________
(1) سورة البقرة 58، سورة الأعراف 161
(2) وعجز البيت:
زيا الروادف بضة المتجرد ... وهي من داليته المشهورة.
(3) اللسان (طحح) غير منسوب أيضا.
(4) الزيادة من اللسان (حدد) .
(3/19)
________________________________________
الحَدّاد. ورجل محدُود: مُحارِف في جدّه. وحَدُّ كلِّ شيءٍ: طَرَف شَباتِه كحَدِّ السِّنان والسَّيف ونحوِه. والحُدُّ: الرجلُ المَحدُودُ عن الخير. والحَدُّ: بأْسُ الرجل ونَفاذه في نجدته، قال العجاج:
أُمْ كيفَ حَدَّ مُضَرَ القَطيمُ «1»
وأحَدَّتِ المرأةُ على زَوجها فهي مُحِدٌّ «2» وحَدَّتْ بغير الألف أيضاً، وهو التَسليبُ بعد مَوته. وحادَدْتُه: عاصيته، مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ
، أي يُعاصيه. وما عن هذا الأمرِ حَدَدٌ: أي مَعْدِل «3» ولا مُحْتَدٌّ، مثله، قال الكُميت:
حَدَداً أن يكونَ سَيْبُكَ فينا ... رَزِماً أو مُجَبَّناً ممصوراً «4»
وحَدّان: حيٌّ من اليَمَن. والحَدُّ: الصَرْف عن الشيء من الخَير والشَرّ. وتقول للرامِي: اللهُم احدُدْه، أي لا تُوفِقّهْ للإصابة. وحَدَدْته عن كذا: مَنَعتُه والاستِحْداءُ: حَلْقُ الشيء بالحديد، وحَدُّ الشَّراب: صَلابتُه، قال الأعشى «5» :
وكأسٍ كعَيْنِ الديكِ باكَرْتُ حَدَّها ... بفِتْيانِ صِدق والنواقيس تضرب
__________
(1) الديوان ص 63 عن التهذيب. ورواية اللسان:
أم كيف حد مطر الفطيم.
(2) كذا في التهذيب وكتب اللغة الأخرى، وفي الأصول المخطوطة: محدة.
(3) في التهذيب: معزل.
(4) كذا في اللسان (حدد) ، وروايته في التهذيب:
............... ........... ... وتحا أو محينا محصورا
والرواية في الأصول المخطوطة: فمصورا.
(5) ديوانه/ 203.
(3/20)
________________________________________
دح: الدّحُّ: شِبْهُ الدَسِّ، وهو أن تضع شيئاً على الأرض ثمَّ تَدُقُّه وتَدُسُّه حتّى يَلْزَقَ، قال أبو النجم:
بيتاً خفّياً في الثَّرَى مَدحُوحا
والدَحُّ أن ترميَ بالشيءِ قُدُماً «1» . والدَحْداحُ والدَحْداحة من الرجال والنساء: المستديرُ المُلَمْلَم، قال:
أَغَرَّكِ أنَّني رجلٌ قصيرٌ ... دُحَيْدِحةٌ وأَنَّكِ عَلْطَميسُ «2»
باب الحاء مع التاء ح ت، ت ح مستعملان
حت: الحَتُّ: فركك شيئاً عن ثَوب ونحوه، قال الشاعر:
تحتُّ بقَرْنَيْها بَريرَ أراكة ... وتعطو بظلفيها إذا الغُصن طالها «3»
وحُتاتُ كُلِّ شَيءٍ: ما تَحاتَّ منه. والحَتُّ لا يبلُغُ النَحْتَ.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احْتُتْهُم يا سَعْدُ فِداكَ أبي وأُمِّي
يعني اردُدْهُم. والفَرَسُ الكريم العَتيقُ: الحَتُّ.
تح: وتَحْتَ: نقيضُ فَوْق. والتُحُوتُ: الذين كانوا تحتَ أقدام الناس لا يُشْعَرُ بهم.
وفي حديثٍ: لا تَقومُ الساعةُ حتى يظهَرَ التُحُوتُ «4»
__________
(1) الرجز في التهذيب فيما رواه الأزهري عن الليث، وهو منسوب (لأبي النجم) ، وزاد في اللسان: في وصف قترة الصائد.
(2) البيت في التهذيب واللسان من غير عزو.
(3) البيت في التهذيب 3/ 423 وهو مما أنشده (الليث) .
(4) التهذيب 3/ 424، وتتمته فيه:
ويهلك الوعول.
(3/21)
________________________________________
باب الحاء مع الظاء ح ظ مستعمل فقط ظ ح
حظ: والحظ: النَّصيبُ من الفَضْل والخير، والجميع: الحُظُوظ. وفلان حَظيظ، ولم نَسْمَعْ فيه فِعلاً. وناس من أهل حِمْص يقولون: حَنْظ، فإذا جَمَعوا رَجَعوا إلى الحُظُوظ، وتلك النُونُ عندهم غُنَّةٌ ليست بأصلية «1» . وإنّما يَجري على ألْسنتهم في المُشَدَّد نحو الرُزّ يقولون: رُنْز، ونحو أُتْرُجَّة يقولون أتْرُنْجة، ونحو اجّار يقولون انّجار فإذا جَمَعوا تركوا الغُنَّة ورجعوا إلى الصِحَّة فقالوا: أجاجير وحُظوظ.
باب الحاء مع الذال ح ذ مستعمل، فقط
حذ: الحَذُّ: القَطْعُ المُسْتَأْصلُ. والحَذَذُ: مصدر الأَحَذّ من غير فِعل. والأحَذُّ يُسَمَّى به الشيْءُ الذي لا يتعَلّقُ به شَيْءٌ. والقلبُ يُسَمَّى أحَذّ. والدُّنْيا وَلَّتْ حَذّاءَ مُدْبرة: لا يتعلّق بها شيء. والأحذ من عَروض الكامل: ما حُذِفَ من آخِره وَتِدٌ تامُّ وهو مُتَفاعِلُنْ حُذفَ منه عِلُنْ فصار مُتَفا فجُعل فَعِلُن مثل قوله:
وحُرِمتَ «2» منّا صاحباً ومُؤازِراً ... وأَخاً على السَّرّاء والضُرِّ
وقصيدةٌ حَذّاءُ: أي سائرةٌ لا عيبَ فيها. ويقالُ للحمار القصير الذَّنَب: أَحَذّ. ويقال للقَطاة: حَذّاء لقِصَر ذَنَبها مع خِفّتها، قال الشاعر: «3»
__________
(1) قوله: ليست بأصلية قد جاءت في التهذيب: ولكنهم يجعلونها أصلية.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: جرمت بالجيم الموحدة التحتية.
(3) (للنابغة الذبياني) يصف القطا، كما في التهذيب، وانظر الديوان (ط. دمشق) ص 176 والرواية فيه:
حذاء مدبرة سكاء مقبلة
(3/22)
________________________________________
حَذّاءُ مُقبلةً سَكّاءُ مُدبرةً ... للماء في النَّحْر منها نَوْطةٌ عَجَبُ
باب الحاء مع الثاء ح ث، ث ح مستعملان
حث: حثيثٌ فلاناً فهو حثيث مَحْثُوث، وقد احتَثَّ. وامرأة حَثيثةٌ في موضع حاثَّةٍ، وامرأ حثيث في موضع مَحثوثة. والحثِّيِثَى من الحَثّ، قال: اقبَلُوا دِلِّيلَى رَبّكُمُ وحِثّيثاه إيّاكم «1» يعني ما يدُلُّكم ويحثُّكُم. والحَثْحَثَةُ: اضطرابُ البَرْق في السِّحاب وانتخال «2» ، المَطَر والثَلْج. والحَثُوثُ والحُثْحُوث: السَّريعُ. قال زائدة: الحَثْحَثَةُ طَلَب الشيء وحَرَكُته، يقالُ: حَثْحَثَ الأمر ليتحرَّك. وحَثْحِثِ القَومَ: أي سَلْهُم عن الأمور.
ثح: الثَّحْثَحَةُ: صوتٌ فيه بُحَّةٌ عند اللَّهاةِ. قال:
أَبَحُّ مُثَحْثَحٌ صَحِلُ «3» الشَّحيحِ «4»
باب الحاء مع الراء ح ر، ر ح مستعملان
حر: حَرَّ النهار يَحِرُّ حَرّاً. والحَرُورُ: حَرُّ الشمس. وحَرَّتْ كَبِدُه حَرَّةً،
__________
(1) كذا في التهذيب، وفي الأصول المخطوطة: اقبلوا دليلاه ربكم
(2) كذا في اللسان وعنه صحح ما في التهذيب وكذا في ط وص في س: انتحال.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: صهل.
(4) كذا في الأصول المخطوطة، وفي اللسان: الثحيج
(3/23)
________________________________________
ومصدره: الحَرَرُ، وهو يُبْسُ الكَبِد. والكَبِدُ تَحَرُّ من العَطَش أو الحزن. وو الحريرة: دَقيقٌ يُطبَخُ بلَبَن. والحَرُّةُ: أرض ذاتُ حِجارة سُودٍ نَخِرة كأنَّما أُحرِقَتْ بالنار، وجمعه حِرار وإحَرِّين وحَرّات، قال:
لا خَمْسَ إلا جَندَلُ الإِحَرِّينْ ... والخَمْسُ قد جَشَّمَكَ الأَمَرِّينْ»
والحرّان: العطشان، وامرأةٌ حَرَّى. والحُرَّ: ولد الحيّة اللطيف في شعر الطِرِمّاح:
كانطِواءِ الحُرّ بينَ السِّلام «2»
والحُرُّ: نَقيضُ العَبد، حُرٌّ بين الحُرُوريَّة والحُرّية والحرار «3» . والحرارة: سحابة حُرَّة من كثرة المطر. والمُحَرَّرُ في بني إسرائيل: النذيرة. كانوا يجعلون الولد نذيرةً لخدمة الكنيسة ما عاشَ لا يَسَعُه تركه في دينهم. والحر: فعل حَسَن في قول طَرَفة:
لا يكنْ حبُّكَ داءً قاتلاً ... ليس هذا منك ماويَّ بحُرّ «4»
والحُرِّيَةُ من الناس: خِيارُهم. والحُرُّ من كل شيءٍ اعتَقُه. وحُرَّة الوَجْه: ما بداً من الوَجْنة. والحُرُّ: فَرْخَ الحَمام، قال حُمَيد [بن ثور] :
وما هاجَ هذا الشَّوقَ إلاّ حَمامَةٌ ... دَعَتْ ساقَ حُرٍّ في حَمامٍ تَرَنَّما «5»
وحُرَّة النِفْرَى: موضِع مَجال القُرْط. والحُرُّ والحُرَّة: الرَمْلُ والرَمْلةُ الطَيِّبة، قال:
__________
(1) في أرجوزة نسبت في اللسان إلى (زيد بن عتاهية التميمي) يخاطب ابنته بعد أن رجع إلى الكوفة من صفين.
(2) ديوانه/ 426 وصدر البيت فيه:
منطو في مستوي رجبة
(3) زاد في اللسان: الحرورية.
(4) البيت في ديوان طرفة ص 64.
(5) الرواية في الديوان ص 24: ترحة وترنما في مكان في حمام ترنما.
(3/24)
________________________________________
واقَبلَ كالشِّعْرَى وُضُوحاً ونُزْهةً ... يُواعِسُ من حُرِّ الصَّريمة معظما
يصف الثَور. وقول العجاج:
في خشاوى حُرَّةِ التَحريرِ
أي حُرَّة الحِرار «1» ، أي هي حُرّة. وتحرير الكتاب: إقامةُ حُروفه وإصلاحُ السَّقَط. وحَرْوراء «2» : مَوضعٌ، كان أوّل مجتمع الحُرُوريّة بها وتحكيمهم منها. وطائرٌ يُسمَّى ساق حر. والحُرّ في قول طَرَفة وَلَد الظَبْي حيثُ يقول «3» :
بين أكنافِ خُفافٍ فاللِّوَى ... مُخرِفٌ يَحْنُو لرَخْص الظِّلْف حُرّ
وحَرّان: مَوْضع. وسَحابة حُرَّةٌ تَصفِها بكثرة المطر. ويقال للَّيْلة التي تُزَفُّ فيها العَروس إلى زَوْجها فلا يقدِرُ على افتِضاضها ليلةٌ حُرَّةٌ، فإذا افتَضَّها فهي ليلةٌ شَيْباء، قال «4» :
شُمْسٌ مَوانِعُ كلَّ ليلةِ حُرَّةٍ
رح: الرَّحَحُ: انبساط الحافِر وعِرَضُ القَدَم، وكلُّ شيءٍ كذلك فهو أرَحُّ، قال الأعشى:
فلو أنَّ عِزَّ الناسِ في رأسِ صَخرةٍ ... ململمة تعيي الأرح المخدما «5»
يعني الوَعِل يصفه بانبساط أظلافه. ويستَعمل أيضاً في الخُفَّيْن وتَرَحْرَحَتِ الفَرَسُ إذا فَحَّجَتْ قَوائِمَها لَتُبوَل. رَحْرَحان: موضع.
__________
(1) في التهذيب واللسان: يعني حرة الذفرى.
(2) كذا في المصادر والأصول التاريخية، وفي الأصول المخطوطة: حرور
(3) هو (طرفة بن العبد) كما ديوانه/ 49.
(4) (النابغة الذبياني) ديوانه/ 103 وعجز البيت فيه:
يخلفن ظن الفاحش المغيار
(5) كذا في اللسان والتهذيب في الأصول المخطوطة: المخذما
(3/25)
________________________________________
باب الحاء مع اللام ح ل، ل ح مستعملان
حل: المَحَلُّ: نَقيضُ المُرْتَحَل، قالَ الأعشى:
إنَّ مَحلاًّ وإنَّ مُرْتَحَلا ... وإنّ في السَّفْر ما مَضَى مَهَلاً «1»
قُلتُ للخليل: أَلَيسَ تزعمُ أنَّ العَرَبَ العاربةَ لا تقول: إنّ رجلاً في الدار، لا تَبدأ بالنكرة ولكنّها تقول: إن في الدارِ رجلاً، قال: ليس هذا على قياس ما تقول، هذا من حكاية سَمِعَها رجلٌ من رجل: إن محلاًّ وإن مُرْتَحَلاً. ويصف بعد ذلك حيث يقول:
هل تذكُر العَهْدَ في تنمُّصَ إذ ... تضربُ لي قاعداً بها مَثَلاً
والمَحَلُّ الآخرة، والمُرْتَحَلُ: الدنيا، وقال بعضهم: أرادَ أنّ فيه محلاًّ وأن فيه مُرْتَحَلاً فأضمَرَ الصِفة. والمَحَلُّ مصدرٌ كالحُلُول. والحِلُّ والحلال والحلول والحلل: جماعة الحالّ النازل، قال رؤبة:
وقد أَرَى بالجَوِّ حَيّاً حِلَلاً ... حِلّاً «2» حِلالاً يَرْتَعون القُنْبُلا
والمحلّةُ: مَنْزِل القَوم. وأرضٌ مِحلال: إذا أَكَثْرَ القَومُ الحُلول بها. والحِلَةُ: قَومٌ نُزولٌ، قال الأعشى:
لقد كان في شَيْبان لو كنت عالماً ... قِبابٌ وحتى حلة وقبائل
__________
(1) انظر الصبح المنير ص 155
(2) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: حي، وكذلك في اللسان.
(3/26)
________________________________________
وتقول: حَلَلْتُ العُقْدةَ أحُلُّها حلاً إذا فَتَحْتَها فانحَلَّت. ومن قَرَأَ: يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي
«1» [ف] معناه ينزِلُ. ومن قَرَأَ: يحلُلْ يُفْسَّر: يحبُ من حَلَّ عليه الحقُّ يحُلّ محلاً. وكانت العَرَبُ في الجاهلية الجهلاء إذا نَظَرت إلى الهِلال قالت: لا مرحباً بمُحِلِّ الدَّيْن مُقَرِّبِ الأَجَل. والمُحِلُّ: الذي يَحِلُّ لنا قَتلُه «2» ، والمُحرِمُ الذي يَحرمُ علينا قتلُه، وقال: «3»
وكم بالقنان من مُحِلٍّ ومُحرِمِ
ويقال: المُحِلُّ الذي ليس له عهدٌ ولا حُرمة، والمُحرِمُ: الذي له حُرْمة. والتَحليل والتَحِلَّةُ من اليمين. حللت اليمين تحليلا وتحلة، وضربته ضربا تحليلا يعني شبه التعزير غيرَ مُبالَغٍ فيه، اشتُقَّ من تحليل اليمين ثمَّ أُجرِي في سائر الكلام حتّى يقال في وصف الإبِلِ إذا بَرَكَت:
نَجائِبٌ وقْعُها في الأرض تحليل «4»
أي: هَيِّنٌ. والحَليلُ والحَليلةُ: الزَّوْجُ والمرأةُ لأنَّهما يحلاَن في موضع واحد، والجميع حلائل. وحَلْحَلْتُ بالإبِلِ إذا قلت: حلْ بالتخفيف، وهو زَجْرٌ، قال:
قد جَعَلَتْ نابُ دُكَيْنٍ تَرْحَلُ «5» ... أخرى وإنْ صاحُوا بها وحَلْحَلوا
__________
(1) سورة طه 81
(2) في اللسان: قتاله.
(3) هو (زهير بن أبي سلمى) من مطولته المعروفة ديوانه/ 11 وصدر البيت:
جعلن القنان عن يمين وحزنه.
(4) قائل البيت (كعب بن زهير) ديوانه/ 13 وصدره:
تخدي على يسرات وهي لاحقة
والرواية فيه:
ذوابل وقعهن الأرض تحليل
(5) اللسان (حلل) غير منسوب أيضا. والرواية في: (تزحل) بالزاي.
(3/27)
________________________________________
وحَلْحَلْتُ القَوْمَ: أزَلْتُهم عن موضعهم. ويقالُ: الحُلَّةُ إزارٌ ورِداءُ بُردٌ أو غيرُه. ولا يقال لها حُلّة حتّى تكون ثَوْبَيْن. وفي الحديث تصديقُه وهو ثَوبٌ يمانيٌّ. ويقولون للماء والشيء اليسيرُ مُحَلَّل، كقوله: «1»
نَميرُ الماءِ غيرَ مَحَلَّلِ
أي غير يسير. ويحتمل هذا المعنى أن تقول: غَذاها غِذاءً ليس بمحلل، أي ليس بيسير ولكن بمبالغةٍ. ويقال: غير محلل أي غير مَنزُول عليه فيكْدُرُ ويَفسُدُ. قال الضرير: غير محلل أي ليس بقَدْر تَحِلَّةِ اليمين ولكن فوق ذلك رِياءً. وحَلَّتِ العُقوبة عليه تَحِلُّ: وَجَبَت. والحِلُّ: الحلال نفسه، لا هن حِلٌّ. وشاة مُحِلّ: قد أحَلَّتْ إذا نَزَلَ اللَّبَنُ في ضرَعْها من غير نِتاج ولا وِلاد. وغَنَمٌ مَحالٌّ. والإِحليلُ: مَخْرَجُ البَوْلِ من الذَّكَر ومَخَرجُ اللَّبَنِ من الضَّرْع. والحِلُّ: الرجل الحلال الذي خرج من إصراحه، والفعل أحَلّ إحلالاً. والحِلُّ: ما جاوَرَ الحَرَم. والحُلاَنُ «2» : الجَدْي ويُجمَع حَلالين، ويقال هذا للذّي يُشَقُّ عنه بطْن أُمَّه، قال عمرو بن أحمر:
تُهْدَى إليه ذراع الجفر تَكرِمةًُ ... إمّا ذبيحاً وإما كان حُلاّنا
ويُرْوَى: ذراع البَكْر والجَدْي. والحُلاحِلُ: السيّد الشجاع. والمَحَلُّ: مبلَغ المُسافر حيث يريد. والمَحِلّ: الموضِع الذي يَحِلّ نحرهُ يومَ النَّحر بعد رَمْي جِمار العَقَبة.
__________
(1) هو (امرؤ القيس) في معلقته، والشاهد شيء من عجز بيت هو قوله يصف جارية:
كبكر المُقاناةِ البياض بصفرةٍ ... غذاها نمير الماء غير محلل
انظر اللسان (حلل) .
(2) في التهذيب 3/ 439: حلام وحلان: ولد المعزى، وقد أيده بقول (ابن أحمر) المثبت في هذه المادة.
(3/28)
________________________________________
وفي الحديث: أحِلَّ بمن أحَلَّ بك «1» .
يقول: من تَرَكَ الإحِرام وأحلَّ بك فقاتَلَكَ فاحللْ أنتَ به فقاتِلْهُ.
لح: الإلحاحُ: الإلحاف في المسألة، ألَحَّ يُلِحُّ فهو مُلِحُّ. وأَلَحَّ المَطَرُ بالمكان: أي دام به. والإلحاحُ: الإقبالُ على الشيء لا يفتر عنه. وتقول: هو ابنُ عَمٍّ لّحٍ في النكرة، وابنُ عمّي لَحّاً في المعرفة، وكذلك المؤنَّث والأثنان والجماعة بمنزلة الواحد.
باب الحاء والنون ح ن، ن ح مستعملان
حن: الحِنُّ: حَيٌّ من الجِنِّ، [يقال: منهم الكلابُ السّود] «2» البهم [يقال:] كلب حِنِّيٌّ. والحَنانُ: الرحمةُ، والفعل: التَحُنُّن. والله الحَنّانُ المنّان الرَّحيم بعباده. وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا
«3» . أي رحمةً من عندنا. وحَنانَيْكَ يا فلانُ افعَلْ كذا ولا تفعَلْ كذا تُذَكِّرُه الرحمةَ والبِرِّ. ويقال: كانت أمُّ مَرْيَمَ تُسَمَّى حَنّة. والاستِحنان: الاستِطراب. وعُودٌ حَنّان: مُطرِّبٌ يَحِنُّ. وحَنينُ الناقة: صوتها إذا اشتاقَتْ، ونِزاعُها إلى ولدها من غير صَوتٍ، قال رؤبة:
حَنَّتْ قَلُوصي أمسِ بالأُرْدُنّ ... حنيِّ فما ظُلِّمتِ أنْ تَحِنِّي «4»
والحُنّة: خِرْقةٌ تلبسها المرأةُ فتُغَطّي بها رأسَها.
نح: النّحْنَحُة: أسهَلُ من السُّعال. وهو علة البخيل، قال:
__________
(1) الحديث في اللسان كما في النهاية:
من حل بك فأحلل به.
(2) ما بين المعقوفتين من التهذيب 3/ 445 عن العين.
(3) سورة مريم 13)
(4) والرجز في التهذيب 3/ 446
(3/29)
________________________________________
والتَغْلِبيُّ إذا تَنَحْنَحَ للقِرَى ... حَكَّ استَه وتَمَثَّلَ الأَمثالا
وقال:
يكادُ من نَحْنَحةٍ وأح ... يحكي سعال الشرق الأَبَحِّ «1»
باب الحاء والفاء ح ف، ف ح مستعملان
حف: حَفّ الشَّعْرُ يَحِفُّ حُفُوفاً: إذا يَبِسَ. واحْتَفَّتْ المرأةُ: أمَرَتْ من تَحُفُّ شَعر وَجْهها بخَيْطَيْن. والحُفُوفُ: اليُبُوسةُ من غير دَسَم، قال رؤبة:
قالتْ سُلَيمَى أنْ رَأَتْ حُفُوفي مَعَ اضطِرابِ اللَّحْمِ والشُّفُوفِ «2»
وحَفَّتِ المرأةُ وَجْهَها تَحُفُّه حَفّاً وحُفُوفاً. وسَويقٌ حافٌّ: غير مَلْتُوتٍ. والحَفيفُ: صوتُ الشيء تُحسُّه كالرَمْية أو طَيَران طائر أو غيره، حف يحف حفيفا. وحِفّان الإِبِل: صِغارُها. والحِفّان: الخَدَمُ. والمِحَفَّةُ: رَحْلٌ يحِفُّ بثَوْب تركبُه المرأةُ. وحِفافا كلِّ شيءٍ: جانِباه. وحَفُّ الحائكِ: خَشَبَتُه العريضة [يُنَسِّقُ] «3» بها اللُّحمة بينَ السَدَى. وحَفَّ القَومُ بسيِّدهم: أي أطافوا به وعَكَفُوا، ومنه قَولُه: حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ «4» . والحَفُّ: نَتْفُ الشَّعْر بخيط ونحوه.
__________
(1) استشهد بهذا الرجز في مادة قحح.
(2) في ديوان رؤبة ص 101:
قالت سليمى إذ رأت حفوفي.....
(3) من التهذيب 4/ 4 عن العين. في الأصول: ينسج
(4) الآية: وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. سورة الزمر 75
(3/30)
________________________________________
فح: فَحيح الحَيَّة شبيهٌ بالنَّفْخ في نَضْنَضة، أي بضَرْب أسنانِها. [وقيل] : فَحيح الأفْعَى دَلْكُ بعض جِلْدها ببعض، وهي خَشْناءُ الجلْد. والفَحْفاحُ: الأَبَحِّ من الرجال.
باب الحاء مع الباء ح ب، ب ح مستعملان
حب: أحبَبْته نَقيضُ أبغضته. والحِبُّ والحِبّةُ بمنزلة الحبيب والحبيبة. والحُبُّ: الجَرَّةُ الضَّخمةُ ويُجمَعُ على: حِبَبة وحِباب، وقالوا: الحِبَّةُ إذا كانت حُبوبٌ مختلفةٌ من كل شيء [شيءٌ] .
وفي الحديث: كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَميل السَّيْل.
ويقال لِحَبِّ الرَّياحينِ حِبّة، وللواحدة حَبّة. وحَبّة القلب: ثَمَرَتُه، قال الأعشى:
فرَمَيْت غَفلةَ عَينه عن شاته ... فأصَبْتُ حَبّةَ قلبها وطِحالَها «1»
ويقالُ: حبّ إلينا فلان يَحَبُّ حبّاً، قال:
وحَبَّ إلينا أنْ نكونَ المقدَّما «2»
وحَبابُك أن يَكون ذاك «3» ، معناه: غاية مَحبَّتك. والحِبّ: القُرْط من حَبّةٍ واحدة، قال: «4»
تبيتُ الحَيّةُ النَّضْناضُ منه ... مَكانَ الحِبِّ يَستمع السِّرِارا
__________
(1) البيت من قصيدة يمدح بها (الأعشى) قيس بن معديكرب (انظر الديوان ص 27) .
(2) الشاهد في التهذيب 4/ 8 واللسان وصدره:
دعانا فسمانا الشعار مقدما
(3) كذا في اللسان، وفي الأصول المخطوطة: وحبابك أن تكون ذاك
(4) هو (الراعي النميري) كما في اللسان (حبب) .
(3/31)
________________________________________
وحبَابُ الماء: فقاقيعُه الطافيةِ كالقَوارير، ويقال: بل مُعظَم الماء، قال طرفة:
يَشُقُّ حباب الماء حيزومها بها ... كما قسم الترب المفايل باليَدِ
فهذا يدُلُّ على أنه معْظَم الماء، وقال الشاعر:
كأنَّ صَلاَ جَهِيزةَ حينَ تَمشِي «1» ... حَبابُ الماء يَتَّبِعُ الحبَابا
ويُرْوَي: حين قامت. لم يُشبِّه صَلاها ومَآكِمَها بالفَقاقيع وإنَّما شَبَّههَا بالحَباب الذي كأنه درج في حَدَبَة «2» . وحَبَبُ الأسنان: تَنَضُّدُها، قال طرفة:
وإذا تضحك تُبدي حَبَباً ... كأَقاحي الرَّمْلِ عَذْباً ذا أُشُرْ
وحَبّان وحِبّان: اسمٌ من الحُبّ. والحَبْحابُ: الصغير: ونار الحُباحِب: ذُبابٌ يطيرُ باللَّيل له شُعاعٌ كالسراج. ويقال: بل نارُ الحُباحِب ما اقتَدَحْتَ من شَرار «3» النار في الهَواء من تصادُم الحِجارة. وحَبْحَبَتُها: اتِقّادُها. وقيل في تفسير الحُبِّ والكَرامة: إنّ الحُبَّ الخَشَباتُ الأربَعُ التي توضَعُ عليها الجَرَّة ذاتُ العُرْوَتَيْن، والكَرامة: الغِطاء الذي يُوضَع فوقَ الجرَّة من خَشَبٍ كانَ أو من خَزَفٍ. قال الليث: سمعت هاتَيْن بخراسان. حَبَّذا: حرفان حَبَّ وذا، فإذا وَصَلْتَ رَفَعْتَ بهما، تقول: حَبَّذا زَيْدٌ.
بح: عَوْدٌ أَبَحُّ: إذا كان في صوته غِلَظٌ. والبَحَحُ مصدرُ الأَبَحِّ. والبَحُّ إذا كان من داءٍ فهو البُحاحُ.
__________
(1) في اللسان وأنشد (الليث

كأن صلا جهيزة حين قامت
(2) كذا في اللسان في الأصول المخطوطة: حدته
(3) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب، وفي اللسان شرر.
(3/32)
________________________________________
والتبحْبُحُ: التَمكُّن في الحُلُول والمُقام، والمرأةُ إذا ضَرَبَها الطَّلْقُ، قال أعرابيّ: تركتُها تُبَحْبحُ على أيدي القَوابل. وقال في البَحَح أي مصدر الأبَحّ:
ولقد بَحِحْتُ من النداء ... لجَمْعِكم هلْ من مُبارز
والبُحْبُوحةُ: وسطُ مَحلّة القَوم، قال جرير:
ينفونَ تغلب عن بُحْبُوحة الدار «1»
باب الحاء مع الميم ح م، م ح مستعملان
حم: حُمَّ الأَمرُ: قُضِيَ. وقدَّرُوا احتَمَمْتُ الأمرَ اهتَمَمْتُ، قال: كأنّه من اهتمام بحَميم وقَريب. والحِمامُ: قَضاءُ المَوْت. والحميم: الماء الحارُّ وتقول: أَحَمَّني الأمرُ. والحامَّةُ: خاصَّةُ الرجل من أهله وولده وذوي قَرابته. والحَمّام: أُخِذَ من الحَميم، تُذكِّرُه العَرَب. والحميم: الماء الحارُّ. وأَحَمَّتِ الأرض: أي صارت ذاتَ حُمَّى كثيرة. وحُمَّ الرجُلُ فهو محموم، وأَحَمَّه الله. والحَمَّةُ: عَيْنٌ فيها ماءٌ حارٌّ يُسْتَشْفَى فيه بالغُسْل. والحَمُّ: ما اصطَهْرتَ إهالتَه من الأَلْيَةِ والشَّحْم، الواحدة: حَمّة، قال:
كأنَّما أصواتُها في المَعْزاء ... صوتُ نَشيش الحَمِّ عند القلاّء «2»
__________
(1) وصدر البيت كما في التهذيب واللسان والديوان:
قومي تميم، هم القوم الذين هم
(2) هذا من اللسان (حمم) وفي الأصول:
كأنما أصواتها في المعزا ... صوتُ نَشيش الحَمِّ عند المقلى
(3/33)
________________________________________
والحُمَم: المَنايا، واحدتُها حُمَّة. والحُمَم أيضاً: الفَحْم البارد، الواحدة حُمَمة. والمَحَمَّةُ: أرضٌ ذاتُ حُمَّى. وجاريةٌ حُمَّةٌ: أي سَوداء كأنها حُمَمة. والأَحَمُّ من كلِّ شيء: الأسَود، والجميع الحُمُّ. والحَمّة: الاسم. والحَمّةُ: ما رَسَبَ في أسفَل النِحْي من سَواد ما احتَرَقَ من السَّمْن، قال:
لا تَحسَبَنْ أنَّ يَدي في غُمَّهْ ... في قعر نحي أستثير حُمَّهْ
وقوله تعالى: وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ
«1» هو الدُخان. والحُمام: حُمَّى الإبِلِ والدَوابِّ وتقول: حُمَّ هذا لذاك أي قُضِيَ وقُدِّرَ وقُصِدَ، قال الأعشى:
هو اليَوْمَ حَمٌّ لميعادِها «2»
أي قصد لميعادها، يقول: واعدتها أن لا أحط عنها حتى القى سلامة ذا فائش. وأحمني فاحتممت، قال زُهَير:
[وكنت إذا ما جئت يوماً] لحاجة ... مضت وأَحَمَّتْ حاجةُ الغَدِ ما تخلو «3»
أي حانت ولَزِمَتْ. والحَميمُ: الذي يَوَدُّكَ وتَوَدُّه. والحَمام: طائر، والعَرَبُ تقول: حَمامةٌ ذَكَر وحَمامةٌ أُنْثَى، والجميع حَمام. والحَميم: العرق. والحَمّاءُ «4» الدُبُر لأنه مُحَمَّم بالشَّعْر، وهو من قولك: حُمَّ الفَرْخُ إذا نَبَتَ ريشهُ. واليَحْمُومُ: من أسماء الفَرَس، على يَفعُول، يَحْتَمِلُ أن يكون بناؤه من الأَحَمّ الأسود ومن الحميم العَرَق. والحِمْحِمُ: نَبات، قال عنترة: تَسَفُّ حَبَّ الحمحم «5»
__________
(1) سورة الواقعة 43
(2) البيت في الديوان ص 73 واللسان وصدره:
تؤم سلامة ذا فائش.
(3) ديوانه/ 97.
(4) كذا في اللسان، وفي الأصول المخطوطة: الحمى.
(5) في التهذيب واللسان (حمحم) : وقد يقال له بالخاء المعجمة واستشهد بعجز بيت (عنترة

وسط الديار تسف حب الخمخم
(3/34)
________________________________________
ويُروَى بالخاء. واستحَمَّ الفَرَس: إذا عَرِقَ. والرجُلُ يُطَلِّق المرأة فَيُحمِّمُها: أي يُمَتِّعُها تَحميماً، قال:
أنتَ الذي وهبت زيدا بعد ما ... هَمَمْتَ بالعَجُوز أن تُحَممَّا
والحَمْحَمةُ: صَوْتُ الفَرَس دونَ الصوت العالي.
مح: المَحُّ: الثَوبُ البالي. والمَحّاحُ: الذي يَرَى الناسَ بلا فِعلٍ من الرجال. والمُحُّ: صُفرة البَيْض، قال «1» :
كانَتْ قُرَيشٌ بَيْضةً فتَفَلَّقَتْ ... فالمُحُّ خالِصُة لعَبْدِ مَنافِ
وأَمَحَّ الثَوْبُ يُمِحُّ: إذا خَلِقُ، ولو استعمل في أَثَر الدارِ إذا عَفَّتْ كان جائزاً، قال: «2»
ألا يا قَتْلَ قد خَلُقَ الجَديدُ ... وحُبُّكِ ما يُمِحُّ وما يَبيدُ
باب الثلاثي الصحيح
باب الحاء والقاف والشين معهما ش ق ح يستعمل فقط
شقح: الشَقْحُ، العَرَبُ تقول: قُبْحاً له وشُقْحاً. وإنَّه لقَبيحٌ شَقيح. ولا يَكاد يُعْزَلُ الشَّقح من القُبْحُ. والشَّقيحُ «3» : تَلوينُ البُسْر إذا اصفَرَّ أو احمَرَّ، قيل: قد
__________
(1) البيت في اللسان (لعبد الله بن الزبعرى) .
(2) لم نهتد إلى القائل.
(3) لا بد أن يكون الصواب: التشقيح لأن الفعل: أشقح وشقح والثاني مضعف، وما أثبتناه فمن الأصول المخطوطة.
(3/35)
________________________________________
شقح.
وفي الحديث: «1» لا بأس ببَيْع تَمْر النخل إذا شَقَّحَتْ
، ويقال: أشقَحَتْ أيضاً.
باب الحاء والقاف والسين معهما ق س ح، س ح ق مستعملان فقط
قسح: القَسْحُ: صَلابةُ الانعاظ، إنّه لقُسّاح مَقْسُوحٌ. قال زائدة: القَسْحُ الفَتْل الشَّديد في الحَبْل. قَسَحْتُه قَسْحاً.
سحق: السَّحْق: دونَ الدَّقّ، وفي العَدْوِ دونَ الحُضْر وفوق السَّحْج، قال العجاج:
سَحْقاً من الجِدِّ وسَحْجاً باطِلاً «2»
ويقال للثَّوْب البالي: سَحَقَه البلَى ودَعَكَه اللُّبْس، قال:
وليسَ عليك إلا طيلسان ... نصيبي وإلا سَحْقُ نِيمِ «3»
وقال: «4»
سَحْقُ البِلَى جدَّتَه فانسحقا
وهو يَسْحَقُه سَحْقاً: ويقال: سَحَقَه وسَحَجَه إذا طَرَدَه طردا شديدا،
__________
(1) جاء في اللسان (شقح) :
وفي حديث البيع: نَهَى عن بيع الثَّمرَ حتى يشقح.
(2) في اللسان وملحق (ديوان رؤبة) (أبيات مفردات) ، ص 182
(3) من الشواهد التي تفرد بها كتاب العين والنيم: الغرو.
(4) (رؤبة) ديوانه ص 108 والرواية فيه: فأسحقا.
(3/36)
________________________________________
قال:
كانَتْ لنا جارةٌ فأزعَجَها ... قاذورةٌ تَسحَقُ النَّوَى قُدُما
والسَحْقُ: البُعد. ولغة أهل الحجاز: بعدٌ له وسُحْقٌ، يجعلونه اسماً، والنَّصْبُ على الدُعاء عليه، أي أبعَدَه اللهُ وأسحَقَه. وأتانٌ سحوق، وحمار سحوق، وهي طِوال المَسانّ ويجمَع [على] سُحُق، قال:
يُمنّيني النسيبُ قُبَيلَ شَهرٍ ... وقد أعيتْنيَ السُحُقُ الطِوالُ «1»
والعَيْنُ تسحق الدَّمعَ سحقاً، ودَمْعٌ مُنْسحِق، ودُمُوع مَساحيقُ كما تقولُ: مُنْكسِر ومَكاسير، قال الراعي:
ظلى طَرفَ عَيْنَيه مَساحيقُ ذُرَّفُ «2»
والاسِحاقُ: ارتِفاعُ الضَّرْع ولُزُوقُه بالبطنِ، قال لبيد:
حتى إذا يَئِسَتْ وأسْحَقَ «3» حالقٌ ... لم يُبلِه إرضاعُها وفِطامُها
ويُرْوَى: لم َيْبُله أي لم يجربه. ومَكانٌ سَحيقٌ: أي بعيد. والسَّوْحَق: الطويل.
باب الحاء والقاف والزاي معهما ق ح ز، ح ز ق، ق ز ح مستعملات فقط
قحز: القَحْزُ: الوثبان والقلق، قال «4» :
__________
(1) الشاهد مما تفرد به كتاب العين.
(2) كذا في الأصول المخطوطة وأورده صاحب التهذيب عن الليث كذلك ولم نهتد إلى الشاهد في أي من المظان.
(3) كذا في التهذيب 4/ 25 والديوان ص 311 في الأصول المخطوطة: وأخلق.
(4) (رؤبة) ديوانه/ 64.
(3/37)
________________________________________
إذا تَنَزَّى قاحزِاتُ القَحْز
يعني به شَدائد الدَّهْرِ، ويقال: قاحِزاتُ القَحْزِ نازياتُ النَّزْو.
حزق: الحَزْقُ: شِدَّة جَذْبِ الرباط والوتَرَ. والرجُلُ المُتَحزِّق: المتشدِّدُ على ما في يَدَيْه ضَنْكاً، وكذلك الحُزُقَّةُ والحُزُقُّ، قال امرؤ القيس:
وأعجبَنَي مَشْيُ الحُزُقَّةِ خالدٍ ... كَمْشيِ أتانٍ حُلِّئَتْ عن مَناهِلِ
ويقال الحَزَق أيضاً وقال في الحزق:
فهي تفادى «1» من حزاز ذي حَزَقْ
والحَزيقةُ: الجماعةُ من حُمْر الوَحْش، قال ذو الرمة: «2»
كأنَّه كلَّما ارفَضَّتْ حَزيقتُها ... بالقاعِ من نَهْشِه أكفالَها كَلِبُ
قزح: القُزَح: ابزار القِدْر. وقِدْرٌ مُقَزَّحة. وقَوْسُ قُزَح: طريقة مُتَقوِّسة تبدوُ في السَّماِء «3» أيامَ الربيع. قال أبو الدُقَيْش: القُزَح الطرائف التي فيها، الواحدة: قُزْحة. وقُزَح: اسم شيطان. والتَقزيح في رأْس شجرةٍ أو نَبْتٍ: إذا انشعب شُعباً مِثْلَ بُرْثُن الكلب. ونُهي عن الصلاة خَلْفَ شجرة مقزَّحةَ، وقول الأعشى:
في مُحيلِ القدَّ من صحب قزح «4»
__________
(1) اللسان (حزق) غير منسوب أيضا، وفيه: تعادى.
(2) ديوانه 1/ 59 وفيه: (بالصلب) في مكان (بالقاع) وفي الأصول المخطوطة: حزيقته.
(3) وزاد في التهذيب عن الليث: غب المطر.
(4) وصدر البيت كما في التهذيب واللسان والديوان:
جالسا في نفر قد يئسوا
(3/38)
________________________________________
يعني لقباً له وليس باسم.
باب الحاء والقاف والطاء معهما ق ح ط يستعمل فقط
قحط: القَحْطُ: احتِباسُ المَطَر. قُحِطَ القَوم وأقحَطُوا. وقُحِطَت الأرضُ فهي مَقْحوطة. أو قَحَطَ المَطَر: احتَبَس، قال الأعشى:
وهُمُ يُطْعِمُونَ إنْ قَحَطَ القطر ... وهَبَّتْ بشَمْألٍ وضريب «1»
ورجل قَحْطِيٌّ: أكْولٌ لا يُبقي على شَيءٍ من الطعام من كلام أهل العراق دون أهل البادية، أي كأنَّه نَجَا من القَحْط. قَحْطان: ابن هُودٍ، ويقال: ابن أرفَخشذ بنِ سامِ بن نوُحٍ.
باب الحاء والقاف والدال معهما ق ح د، ح ق د، ق د ح، ح د ق، د ح ق، مستعملات
قحد: القَحَدة: «2» ما بينَ المأْنَتَيْن من شَحْم السَّنام. ناقةٌ مِقحاد: ضَخْمةُ القَحَدة، قال:
المُطْعِمُ القَوْمِ الخِفافِ الأَزوادْ ... من كُلِّ كَوماءَ شَطُوطٍ مقحاد «3»
__________
(1) ديوانه/ 333، وفيه (إذ) في مكان (إن) .
(2) كذا في كتب اللغة عامة، وفي الأصول المخطوطة: القحد
(3) مما نقله الأزهري في التهذيب عن الليث، وذكره صاحب اللسان (قحد) .
(3/39)
________________________________________
حقد: الحِقْدُ: الاسمُ، والحَقْدُ: الفِعلُ، حَقَدَ يَحقِدُ حَقْداً، وهو إمساكُ العَداوة في القلب والتَرَبُّصُ بفُرصتها.
قدح: القداح: متخذ الأقداح، وصنَعْتُه القِداحة. والقدّاح: أرْادٌ رَخْصةٌ من الفِسْفِسة، والواحدة قَدّاحة. وأراد بالأَرآد جمعَ رُؤد وهو نَعْمةُ الشَّباب وغَضارتُه وأوَّليَّتُه ورَوْنَقُه. والمِقْدَح: الحديدة التي يُقْدَحُ بها. والقدّاح: الحَجَر الذي تُورَى منه النار، قال رؤبة:
والمَرْوَ ذا القَدّاحِ مَضبُوَح الفِلَقْ «1»
والقَدْحُ: فِعلُ القادِحِ بالزَّنْد وبالقدّاح ليُوري. والقَدْح: أُكّالٌ يَقَع في الشَّجَر وفي الأسنان. والقادِحةُ: الدُودة التي تأكُلُ الشَجَرَة والسِنَّ، قال اَلطِرِمّاح:
بَريٌء من العَيْبِ والقادِحهْ «2»
وقال جميل:
رَمَى اللهُ في عَيْنَيْ بُثَيْنَةَ بالقَذَى ... وفي الغُرِّ من أنيابِها بالقَوادِحِ «3»
القِدْحة: اسم مشتق من الاقتداح بالزَّنْد.
وفي الحديث: لو شاءَ اللهُ لجَعَلَ للنّاس قِدْحة ظُلْمةٍ كما جَعَلَ لهم قِدْحَة نورٍ «4» .
والإنسانُ يقتَدِحُ الأمرَ إذا نَظَرَ فيه ودَبَّر، قال عمرو بن العاص:
يا قاتَلَ اللهُ وَرْداناً وقِدحتَه ... أبدى لعمرُكَ ما في النفس» وردان
__________
(1) والرجز في ديوان رؤبة ص 106
(2) ديوانه/ 83 إلا أن الرواية فيه
قليل المثالب والقادحه
(3) ديوانه/ 53.
(4) الحديث في التهذيب 4/ 31.
(5) كذا في اللسان، وفي ص وط: الناس وفي س: الأمر.
(3/40)
________________________________________
والقَديحُ: ما يَبْقَى في أسفل القِدْر فيُعْرَف بجَهْد، قال النابغة:
يَظَلُّ «1» الإِماءُ يَبْتَدِرْنَ قَديحَها ... كما ابتدَرَتْ كلبٌ مياهَ قراقِر
والمِقْدَحة: المِغرفة. والقِدْح: السَّهْمُ قبل أن يُراش ويُنصَل، وجمعُه قِداح.
حدق: حَدَقَةُ العَيْن في الظاهر هي سواد العَيْن، وفي الباطن خَرَزَتُها، وتَجْمَع [على] حَدَق وحِداق أيضاً، قال أبو ذؤيب:
فالعين بعدهم كأن حداقها سملت ... بشوك فهي عور تدْمَعُ
والحديقةُ: أرضٌ ذاتُ شَجَر مُثْمِر، والجميع: الحَدائق. والحديقة من الرياض: ما أَحدَقَ بها حاجِزٌ أو أرضٌ مُرتفعة، قال عنترة:
فَتَرْكنَ كلَّ حَديقةٍ كالدِرْهَم «2»
يعني في بَياضه واستدارته. والتَحديقُ: شدَّة النَظَر. وكُلُّ شيء استدار شيء فقد أَحدَقَ به.
دحق: الدَّحْقُ: أن تقصُرَ يَدُ الرجُل وتناولُه عن الشَّيء، تقول: أدحَقَه الله: أي باعَدَه عن كلِّ خيَر. ورجل دَحيق مُدْحَق: مُنَحًّى عن الناس والخير، قال يصف العَيْرَ المغلُوب:
والدحيقَ العاملا «3»
__________
(1) ديوانه/ 173.
(2) وصدر البيت:
جادت عليها كل بكر حرة.
(3) كذا في الأصول المخطوطة، ولم نجد البيت على صورته في المظان التي رجعت إليها.
(3/41)
________________________________________
يَعني الذي قد أُخرجَ عن الحمير. وتقول: [دَحَقَتِ الرَّحِمُ: إذا] «1» رَمَتْ بالماء ولم تقبَلْه، قال النابغة:
لم يُحرمَوا حُسنَ الغذاء وأُمُّهُمْ ... دَحَقَتْ عليك بناتقٍ مِذكارِ
يَعني بامرأةٍ بناتق مِذكارٍ. وقولُه: دَحَقَتْ عليك: فَضَلَتْ عليك بأولادٍ، أي على الذي يُفاخره «2» .
باب الحاء والقاف والذال معهما ح ذ ق مستعمل فقط
حذق: الحِذْقُ والحَذاقةُ: مَهارةٌ في كُلِّ شيءٍ. والحِذَقْ مصدر حَذَقَ وحَذِقَ معاً في عمله فهو حاذق. وحذَقَ القرآنَ حِذقاً وحَذاقاً، والاسم الحَذاقة. وحَذْقُك الشيءَ: مَدُّكَه، تقطَعُه بمِنْجَل ونحوه حتَّى لا يبقى منه شيء. وانْحَذَقَ الشيْءُ: انقَطَعَ، قال:
يكادُ منه نِياطُ القَلْب يَنْحَذِقُ «3»
باب الحاء والقاف والراء معهما ر ق ح، ح ق ر، ق ح ر، ق ر ح، حرق مستعملات
رقح: الرَّقاحيُّ: التاجرُ. وإنَّه ليُرقِّحُ معيشته: أي يصلحها.
__________
(1) سقط من الأصول المخطوطة وأثبتناه من التهذيب 4/ 34 عن العين.
(2) كذا في ص وس، وفي ط: أفاخره
(3) التهذيب 4/ 35، واللسان (حذق) غير منسوب فيهما وغير تام أيضا.
(3/42)
________________________________________
حقر: الحَقْرُ في كلّ المعاني: الذِلَّةُ. حَقَرَ يَحْقِرُ حقرا وحقرية. وتَحقيرُ الكلمةِ: تَصغيرُها.
قحر: القَحْر: المُسِنُّ وفيه بقيَّةٌ وجَلَد.
قرح: القَرُحْ: في عَضِّ السِلاح ونحوه مما يَجْرَحُ من الجَسَد. إنه لَقِرحٌ قَريح، وبه قَرْحَةٌ داميةٌ. وقَرِحَ قَلْبُه من الحزن. والقَرْح: جَرَبٌ يأخُذُ الفُصِلانَ لا تكادُ تنجو منه، يقالُ: فَصيل مَقرُوح. والناقةُ تَقْرَح قُروحاً: إذا لم يظُنُّوها حاملاً ولم تُبَشِّره بذَنَبها فيَستَبينُ الحَمْل في بَطْنها. واقَتَرحْتُ الجَمَلَ: رَكِبْتُه قبل أنْ يُرْكَبَ. واقترَحْتُ الشَيء: ابتَدَعْتُه. ويقال للصُبح أقَرْح لأنَّه بياض في سَواد، قال ذو الرمة:
وَسُوجٌ إذا اللَّيْلُ الخُداريُّ شَقَّهُ ... عن الرَكْب مَعرُوفُ السَّماوةِ أقرَحُ «1»
يَعني الصُبْحَ. والقرحَةُ: الغُرَّةُ في وسط الجَبْهةِ، والنَّعْتُ أَقرَح وقَرْحاء. ورَوْضةٌ قَرْحاءُ: في وَسَطها نَوْرٌ أبيض، قال ذو الرمة:
حواء قرحاء أشراطية وكفت ... فيها الذهاب وحفَّتْها البَراعيمُ «2»
وقَرَحَ الفَرَس قُروحاً، وقَرَحَ نابُه فهو قارحٌ، والأُنْثَى قارحٌ أيضاً. والقارحُ: السُِّن التي بها صارَ قارحاً. ويقالُ للرجل والمرأة: قُرحان إذا لم يُصْبهما الجُدَريُّ ونحوه، والجميع قُرْحانُون. والقُرحان: ضرْبٌ من الكَمْأة
__________
(1) ديوانه 2/ 1219.
(2) ديوانه 1/ 399.
(3/43)
________________________________________
بيض صغار ذات رءوس، كرءوس الفُطْر، الواحدة بالهاء. وجمع القارح من الفَرَس قُرَّح وقُرْح وقَوارِح، قال: «1»
نحنُ سَبَقْنا الحَلَباتِ الأربَعا ... الرُبعُ والقرح في شوط معا
والقَراح: الماءُ الذي لا يخالِطُه ثُفْل من سَويق وغيره. والقَراح من الأرض: كلُّ قِطعةٍ على حِيالها من مَنابِت [النَّخْلِ] «2» وغير ذلك. والقِرْواح: الأرض المستوية، قال عبيد:
فَمَنْ بعَقْوتِه كَمنْ بنَجْوَتِه «3» ... والمُستَكِنُّ كَمَنْ يَمْشي بِقرْواحِ
حرق: حَريقُ النّابِ: صَريفُه إذا حَرَق أَحَدَهُما بالآخَر. والرجل يَحرِقُ نابَه، قال زهير:
أبى الضَيْم والنُعْمان يَحرقُ نابَه ... عليه وأفضَى والسُيُوفُ مَعاقِلُهُ
أفْضَى: أي صار في فَضاء ولم يَتَحَرَّزْ بشيءٍ. وأَحْرَقَني فُلانٌ: إذا بَرَّحَ بي وآذاني: قال: «4»
أَحْرقَني الناسُ بتكليفهم ... ما لَقِيَ الناسُ من الناسِ
وأحرَقَت النّارُ الشيءَ فاحتَرَق. وحَرَقُ الثَوبِ: ما يُصيبه من دق القصار. والحرقات: سُفُنٌ فيها مرامي نيران يُْرَمي بها العَدُوُّ في البَحْر بالبَصْرة، وهي أيضاً بلغتهم: [مواضع] القلاّئين والفَحّامين «5» .
__________
(1) لم نهتد إلى الراجز،
(2) من التهذيب 4/ 42 عن العين من الأصول المخطوطة: الأرض.
(3) اللسان (قرح) : والرواية فيه:
فمن بنجوته كمن بعقوته ...
أما ديوانه (دار المعارف) 25 وتحقيق (نصار) ص 41 فروايته:
أوصرت ذا بومة في رأس رابية ... أو في قرار من الأرضين قرواح
(4) لم نتبين القائل في المصادر بين أيدينا.
(5) سقطت كلمة مواضع من الأصول وأثبتناها من التهذيب مما نقله من كلام الليث.
(3/44)
________________________________________
والحَرُّوق والحُرّاق: ما يُورَى به النار. والمُحارَقةُ: المُباضَعة على الجَنْب. والحُرقة: حَيٌّ من اليَمَن. والحُرَيْقاء: من الأسماء. والحارقةُ: عَصَبةٌ بين وابلةِ الفَخِذ التي تَدُور في صَدَفة الوَرِك والكتَفِ، فإذا انَفْصَلتْ لم تَلْتَئِم أبداً. ويقالُ: إنّما هي عَصَبة بين خُرْبة الوَرِك ورأس الفَخِذ يقالُ عند انفصالها: حُرِقَ الرجُلُ فهو مَحروُق. والحُرْقة: ما يُوجَدُ من رَمَدِ عَيْنٍ أو وَجَع قلبٍ أو طَعْم شيءٍ مُحْرق. والحارقةُ من السبع: اسم له. والحرقة: احترِاقٌ يقَعُ في أصُول الشَّعْر فيَنْحَصُّ. والحُرقتان تَيْم وسَعْدٌ وهما رَهْط الأعشى، قال الأعشى:
عَجِبْتُ لآلِ الحُرقَتْين كأنَّما ... رَأَوْني نَفّياً من إيادٍ وتُرخُمِ «1»
رحق: الرَّحيقُ: من أسماء الخَمْر، قال حسان:
يسقون من وَرَدَ البَريصَ عليهِمُ ... كأساً تُصَفّقُ بالرَّحيقِ السَّلْسَلِ «2»
باب الحاء والقاف واللام معهما ح ق ل، ق ل ح، ق ح ل، ل ق ح، ل ح ق، ح ل ق مستعملات
حقل: الحَقْلُ: الزَّرْعُ إذا تَشَعَّبَ ورَقَهُ قبلَ أنْ يَغلُظَ. وأَحْقَلَتِ الأرضُ إحقالاً. والحَقيلةُ: ماءُ الرُّطْب في الأمعاء، ورُبَّما صَيَّرَه الشاعر حَقْلاً، قال: «3»
إذا الفُرُوضُ اضطمت الحقائلا
__________
(1) البيت في اللسان والديوان ص 123.
(2) ورواية البيت في اللسان (برص) والديوان (صادر) 180:
............... .......... ... بردى يصفق بالرحيق السلسل
(3) القائل (رؤبة) والرجز في الديوان ص 124 وفي التهذيب 4/ 48، وفي الأصول المخطوطة: (الفروض) بإلغاء، وهو تصحيف.
(3/45)
________________________________________
والحِقْلَةُ «1» حُسافة التَّمْر، وهو ما بَقي من نُفاياته. وحَقيل: اسم جَبَلٍِ بالبادية. والحَوْقَل: الشَّيْخ إذا فَتَرَ عن الجِماع، قال:
أصْبَحْتُ قد حَوْقَلْتُ أو دَنَوتُ ... وفي حَواقيلِ الرجالِ الموت «2»
والحَوْقَلةُ: الغُرْمُولُ اللَّيِّن، وهي الدَّوْقَلَة أيضاً. والمُحاقَلُة: بَيْعُ الزرع قبل بدو صلاحه. قال غيره: هو أن يدفع الأرض بالثُلُث والرُبُع أو أقَّلَّ أو أكثر.
قحل: القاحِلُ: اليابِسُ من الجُلود ونحوه. وشَيْخٌ قاحل. قَحَلَ يَقْحَلُ قُحُولاً، قال (رُجُلٌ من أصحاب الجمل) :
ردوا علينا شيخنا ثم بَجَلْ ... عُثْمانَ رُدّوه بأطراف الأَسَلْ
(فأجابه رجل من أصحاب عليٍّ) :
كيفَ نَرُدُّ نَعْثَلاً وقد قَحَلْ «3»
أي ماتَ وذَهَبَ.
قلح: القلح: صُفرةُ الأسنان. رجُلٌ أقْلَحُ وامرأةٌ قَلْحاءُ قَلِحةٌ. ويُسَمَّى الجُعَلُ أقلَحَ لأنَّه لا يُرَى أبداً إلا مُتَلَطِّخاً بعذرة «4» .
__________
(1) وفي اللسان والقاموس: الحقيلة حشافة التمر وما بقي من نفاياته.
(2) (رؤبة) ديوانه (أبيات مفردات) ص 170. والرواية فيه:
وو بعض حيقال الرجال الموت
(3) الرجز في اللسان مع خلاف يسير.
(4) من (س) . في (ص وط) : بقذرة.
(3/46)
________________________________________
لقح: اللِّقاحُ: اسم ماءِ الفَحْل. واللقَّاحُ: مصدر لقِحَتِ الناقةُ تَلْقَحُ لَقاحاً، وذلك إذا استبانَ لَقاحُها يَعني حَمْلَها، فهي لاقح، قال أبو النجم:
وقد أَجَنَّتْ عَلَقاً مَلْقُوحاً ... ضَمَّنَه الأَرحامَ والكُشُوحا
يَعني لَقِحَتْه من الفَحْل أي أخَذَتْه. وأولادُ المَلاقيحِ والمَضامينِ نُهِيَ عن بَيْعها، كانوا يَتَبايعون ما في بطون الأمهات وأصلاب الآباء، فالمَلاقيحُ هُنَّ الأُمَّهات والمَضامينُ هُمُ الآباء، الواحدُ مَلْقُوحٌ ومَضْمُون. واللِّقْحَةُ: الناقةُ الحَلْوب، فإذا جُعِلَ نَعْتاً قيلّ: ناقةٌ لَقُوح، ولا يقال: ناقةٌ لِقْحةٌ. و [يقال] هذه لِقْحةٌ بني فلان. واللِّقاحُ: جمع اللِّقْحة. واللُّقُحُ: جَماعةُ اللِّقُوح. وإذا نُتِجَتِ الإبِلِ فبعضُها وَضَعَ وبعضها لم يَضَع فهي عِشارٌ، فإذا وَضَعْنَ كُلُّهُنَّ فَهُنَّ لِقاح، فإذا أُرسِلَ فيهِنَّ الفَحْلُ بعد ذلك فهُنَّ الشَّوْلُ. واللَّقاحُ: ما تُلْقَحُ به النَّخلة من النَّخلة الفُحّالة. ألقَحُوا نَخْلَهم الِقاحاً ولقَّحوها تَلقيحاً في المبالغة. واستَلْقَحَتِ النخلةُ أَنَى لها أن تُلْقَح. وحيٌّ لَقاحٌ «1» : لم يُملَكوا قطٌّ. والَّواقِح من الرياح: التي تحمل النَّدَى ثمَّ تمُجُّه في السَّحاب وفي كُلِّ شيء، فإذا اجتَمَعَ في السَّحاب صارَ مَطَراً. والمَلْقَح كاللِّقاح وهما مصدَران، قال:
يشهَدُ مِنّا مَلْقَحاً ومَنْتَحا «2»
وحَرْبٌ لاقِح تشبيهاً لها بالأُنْثَى الحامل، قال: «3»
إذا شمَّرَتْ بالناسِ شَهباءُ لاقِحٌ ... عَوانٌ شديدٌ هَمْزُها وأظَلَّتِ
أي دَنَتْ، وهَمْزُها: عَضُّها ومَكرُوهُها.
__________
(1) زاد في اللسان: لم يدينوا للملوك.
(2) الرجز في اللسان (لقح)
(3) هو (الأعشى) . ديوانه 259 وفيه:
(وقد) في مكان (إذا) و (شمطاء) في مكان (شهباء ... و (فأضلت) بالضاد، في مكان (وأظلت) بالظاء.
(3/47)
________________________________________
لحق: اللَّحَقُ: كُلُّ شيءٍ لَحِقَ شيئاً أو أَلْحقْتُه به، من النَبات ومن حَمْل النَخل، وذلك أن يُرطِب ويتمر «1» ثم يخرُجُ في بَعضِه «2» شيءٌ أخضَرُ قَلَّ ما يَرْطُبُ حتى يُدركَه الشتاء، ويكون نحو ذلك في الكَرْمُ يُسَمَّى لَحَقاً. واللَّحَقُ من الناس: قَومٌ يلحقون بقَومْ بعدَ مُضيِهِّم، قال:
ولَحَقٍ يَلْحَق من أَعرابها «3»
واللَّحَقُ: الدَّعِيُّ المُوَصَّل بغير أبيه. وناقةٌ مِلْحاقٌ: لا تكاد الإِبِلُ تَفْوتُها «4» في السَّيْر، قال رؤبة:
فهي ضَروحُ الرَّكْضِ مِلحاقُ اللَّحَقْ «5»
ولاحِقٌ: اسمُ فَرَس «6» . وقوله: إن عذابك بالكُفّار مُلْحِقٌ بالكسر. ويقال: إنه من القرآن لم يجدوا عليها إلا شاهداً واحداً فوُضِعَتْ في القُنُوت. وهذه لغة موافقة لقوله تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ «7»
حلق: الحَلْقُ: مَساغُ الطَّعام والشَراب. ومَخرَجُ النَفَس من الحُلْقُوم. ومَوضع المَذْبَح مِن الحَلْق أيضاً، ويُجْمَع على حُلْوق. وحَلَقَ فُلانٌ فُلاناً: ضَرَبَه فأصابَ حلَقْهَ. والحَلْقُ: نَباتٌ لوَرَقِه حُمُوضةٌ يُخلَط بالوَسْمَةِ للخِضاب، الواحدة بالهاء. والحَلْقَةُ من القوم وتُجمَع على حَلَق. ومنهم مَن يثقِّل فيقول حَلَقة لا
__________
(1) كذا في ص، وفي ط وس والتهذيب: تثمر. وفي اللسان: تتمر بالتضعيف.
(2) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب، وفي اللسان: بطنه.
(3) الرجز في اللسان وبعده:
تحت لِواء المَوْتِ أو عقابها.
(4) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب: تفوقها.
(5) الديوان ص 107
(6) زاد في اللسان: لمعاوية بن أبي سفيان.
(7) سورة الإسراء 1 واللسان.
(3/48)
________________________________________
يبالي. والحلق: الخاتم من فِضَّةِ بلا فَصّ، قال المخبل في رجل أعطاه النعمان خاتَمَه:
وناوَلَ منا الحِلْقَ أبَيضَ ماجداً «1» ... رَديفَ مُلُوكٍ ما تُغِبُّ نوافله
أي لا يبطىء ولا يجيء غِبّاً. والحالِقُ: الجَبَلُ المُنيفُ المُشرف، قال:»
فخَرَّ من وجأته ميتا ... كأنما دهده من حالِقِ
والحالِقُ من الكَرْم والشَّرْي ونحوهِما ما التَوىَ منه وتَعَلَّقَ بالقُضبان، لم يَعرفوه. والمَحالق: من تعريش الكرم. وحلق الضرع ُيَحلُقُ حُلُوقاً فهو حالق: [يريد: ارتفاعه إلى البَطْنِ وانضمامَه] . وفي قول آخر: كَثْرة لَبَنه. وتَحَلَّقَ القَمَرُ: صارت حوله دوارة «3» . والمحلق: موضع حَلْق الرأس بِمنىً، قال:
كَلاّ وربِّ البيتِ والمُحَلَّق «4» .
وحَلَّقَ الطائر تحليقاً: إذا ارتَفَعَ. والحالق: المشْئُوم يَحلِقُ أهله ويقشُرهم. وفي شَتْم المرأة: حَلْقَى عَقْرَى، يريد مشئومة مؤذية. والمُحَلِّق: اسم رجل ذكره الأعشى:
وباتَ على النارِ النَّدَى والمحلق «5»
__________
(1) رواية الصدر في التهذيب واللسان
وأعطي منا الحلق أبيض ماجد
(2) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(3) كذا في الأصول المخطوطة، والذي في التهذيب عن العين 4/ 64 واللسان (دور) : دارة.
(4) التهذيب 4/ 59، واللسان (حلق) غير منسوب أيضا.
(5) وصدر البيت كما في الديوان واللسان:
تشب لمقرورين يصطليانها
(3/49)
________________________________________
باب الحاء والقاف والنون معهما ح ق ن، ن ق ح، ق ن ح، ح ن ق مستعملات
حقن: الحَقين: اللَّبَنُ المَحقُونُ في مِحْقَنٍ. وفي مَثَل: أَبَى الحَقينُ العِذْرة. وأصلُه أنّ أعرابياً أَتَى حَيّاً فسألهم اللَّبَن، فقيل له: ما عندَنا لَبَنٌ، فالتفت إلى سِقاء فيه لبن فقال: يأبَى الحَقينُ العِذْرة، أي يأبَى الحقين أنْ أقبَلَ عُذْرَكم. وحَقَنْتُه: جَمَعْتُه في سِقاء ونحوِه. وحَقَنْتُ دَمَه: إذا انْقَذْتُه من قَتْلٍ أحلَّ به. واحتَقَنَ الدَمُ في جَوْفه: إذا اجتَمَعَ من طعنةٍ جائفة. والحُقنةُ: اسمُ دواءٍ يُحْقَنُ به المريضُ المُحتَقِن. وبَعيرٌ مِحقانٌ يحقُنِ البَوْل، فإذا بالَ أكثَرَ. والحاقِنتان: نُقْرَتا التَرْقُوَتَيْن، والجميع: الحَواقِن
. نقح: النَّقْح: تَشذيبكَ عن العَصَا أُبَنَها. وكلُّ شيءٍ نَحَّيْتَه عن شَيء فقد نَقَحْتَه من أذىً. والمُنَقِّحُ للكلام: الذي يُفَتِّشُه ويُحسِنُ النَظَر فيه، [وقد] نقحت الكلام.
قنح: القَنْح: اتَّخاذُك قُنّاحة تشُدُّ بها عِضادةَ الباب ونحوه، تُسَمِّيه الفُرْس قانه. قال غير الخليل: لا أعرفُ القَنْح إلا في الشُرْب، وهو شُربٌ في أَفاويقَ، ويُرْوَى في الحديث.
وأَشْرَبُ فأَتَقَنَّحُ «1»
وأَتَقَمَّحُ، يُرْوَيان جميعاً.
__________
(1) في (ط) : وانقخ، وهو تصحيف. وجاء في التهذيب 4/ 66 بعد ذكر الحديث: قال ابن جبلة: قال شمر: سمعت أبا عبيد يسأل أبا عبد الله الطوال النحوي عن معنى قوله فأتقنح، فقال أبو عبد الله: أظنها تريد أشرب قليلا. قال شمر: فقلت: ليس التفسير هكذا، ولكن التقنح أن يشرب فوق الري، وهو حرف روي عن أبي زيد، فأعجب ذلك أبا عبيد، قلت: وهو كما قال شمر: وهوالتقنح والترنح.
(3/50)
________________________________________
حنق: الحَنَق: شِدُّةُ الاغتِياظ، حَنِقَ حَنَقاً فهو حَنِق. والاِحناق: لُزُوقُ البَطْنِ بالصُلْب، قال: «1»
فأحنَقَ صُلْبُها وسَنامُها
باب الحاء والقاف والفاء معهما ح ق ف، ق ح ف، ف ق ح مستعملات
حقف: الحِقْفُ: الرَّمْل ويُجْمَع [على] أحقاف وحُقُوف. واحقَوْقَفَ. واحقَوْقَفَ الرَّمْلُ، واحقَوْقَفَ ظَهْرُ البَعير: أي طالَ واعوَجَّ، قال العجاج:
سَماوةَ الهلال حتّى احقَوْقَفا «2»
والأحقافُ في القرآن يقال: جَبَل مُحيطٌ بالدنيا من زبرجدة خَضراء يَلْتَهِبُ يومَ القيامة فيُحشَرُ الناسُ من كُلِّ أفق.
قحف: القِحْفُ: العَظْم فوقَ الدِماغ من الجُمْجُمة، والجميع: القِحْفة والأَقحاف. والقَحْفُ: قَطْعُه وكَسْرُه فهو مَقْحُوف أي مَقْطُوع القِحْف، قال:
يَدَعْنَ هامَ الجُمْجُمِ المَقْحُوفِ ... صُمِّ الصَدَى كالحَنْظَل المَنْقُوفِ «3»
__________
(1) هو الشاعر (لبيد) ، وتمام البيت:
بطليح أسفار تركن بقية ... منها فأحنق صلبها وسنامها.
(2) والرجز في الديوان ص 496 واللسان (حقف) وقبله:
طي الليالي زلفا فزلفا.
(3) التهذيب 4/ 69 في روايته عن العين، واللسان (قحف) .
(3/51)
________________________________________
والقَحْفُ: شدَّةُ الشُرب، وقيل لامرىء القيس: قتل أبوك، وهو على الشَّراب، فقال: اليومَ قِحاف وغداً نِقاف، ومثلْه اليَومَ خَمْرٌ وغداً أمْرٌ. وقُحِف الإنِاءُ: شُرِبَ ما فيه. ومَطَرٌ قاحِف مثل قاعِف: إذا جاءَ مُفاجَأةً فأَقحَفَ كُلَّ شيءٍ. ويقال: سَيْلٌ قُحاف وجُحَاف وقُعاف [بمعنى واحد] «1» .
فقح: فَقَح الجُرْوُ: أي أَبصَرَ وفَتَح عَيْنَيه. والفُقّاح: من العِطْر، وقد يُجعَل في الدواء فيقال: فُقّاح الاذِخْرِ، الواحدة بالهاء وهو من الحَشيش. والفَقْحةُ: الراحة بلغة اليَمَن. والفَقْحة: معروفة وهي الدُبُر بجُمعِها. والتفقح: التفتح بالكلام.
باب الحاء والقاف والباء معهما ج ب ق، ح ق ب، ق ب ح، ق ح ب مستعملات
حبق: الحَبَق: دَواء من أدوية الصَيْدلانيِّ. والحَبْق: ضُراط المِعَز، حبقت تَحبِقُ حَبْقاً.
حقب: الحَقَبُ: حَبْل يُشَدُّ به الرَّحْل إلى بطْن البعير كي لا يَجْتَذبَه التَصدير: وحَقِبَ البعيرُ حَقَباً فهو حَقِب أي تَعَسَّرَ عليه البَوْل. والأحقَب: حِمارُ الوَحْش لبَياض حَقْوَيه، ويقال: بل سُمِّيَ لدِقَّة حَقْوَيه، والأُنثى حَقْباء، قال رؤبة:
كأنَّها حَقْباءُ بلقاء الزلق «2»
__________
(1) من التهذيب 4/ 70 للتوضيح.
(2) اللسان (حقب) ، والديوان ص 104
(3/52)
________________________________________
الزَّلَقُ: العَجُزُ وقارةٌ حَقْباءُ: دقيقةٌ مُستطيلةٌ، قال: «1»
تَرَى القارةَ الحَقْباءَ منها كأنَّها ... كُمَيْتٌ يُبارِي رَعْلةَ الخَيل فارِدُ.
ويقال: لا يقالُ ذلك حتّى يَلْتَويَ السَراب بحَقْوَيْها. والحِقابُ: شيءٌ تَتَّخذُه المرأةُ تُعلِّق به مَعاليق الحُلِيِّ تَشُدُّه على وَسَطها، ويجمع [على] حُقُب. واحتَقَبَ واستَحْقَبَ: أي شَدَّ الحقيبة من خلفه، وكذلك ما حمل من شيء من خلفه، قال النابغة:
حَلَق الماذيِّ خَلْفَهُمُ ... شُمُّ العَرانينِ ضَرّابُونَ للهامِ «2»
وقال: «3»
فاليومَ فاشرَبْ غيرَ مُستَحقِبٍ ... إثماً من اللهِ ولا واغِلِ
والمُحقِبُ كالمُردِف. والحِقْبة: زمان من الدهر لا وقتَ له. والحُقُبْ: ثَمانونَ سنةً والجميعُ: أحقاب
قحب: القُحابُ: سُعال الشَّيخ والَكلْب. قَحَبَ يَقْحُبُ قُحاباً وقَحْباً. وأخَذَه سُعالٌ قاحِب. والقَحْبَةُ: «4» المرأة بلغة اليمن.
قبح: القُبْح والقَباحة: نَقيضُ الحُسْن، عامٌّ في كلِّ شيء. وقَبَحه الله: نَحّاه عن كلّ خير وقوله تعالى: هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
«5» أي المُنَحَّيْن عن كل خير.
__________
(1) هو (امرؤ القيس) . انظر الديوان ص 458 واللسان (حقب) . وجاء في اللسان: أن البيت منحول وفي الديوان واللسان والتهذيب:
ترى القنة الحقباء.
(2) الرواية في التهذيب واللسان:
مستحقبي حلق الماذي يقدمهم.
وفي الديوان/ 221:
مستحقبو حلق الماذي فوقهم
(3) هو (امرؤ القيس) ، والبيت في الديوان واللسان (حقب، وغل) وروايته في اللسان: فاليوم أسقي....
(4) في التهذيب 4/ 74 عن العين: وأهل اليمن يسمون المرأة المسنة: قحبة.
(5) سورة القصص 42
(3/53)
________________________________________
قال زائدة: المقْبُوحُ الممقُوت. والقَبيح: طَرَفُ عَظْم المِرْفَق ويُجْمَع: قبائح، قال: «1»
حَيثُ تحُكّ الإبرةُ القَبيحا «2»
باب الحاء والقاف والميم معهما ق ح م، ق م ح، ح م ق، م ح ق مستعملات
قحم: قَحَمَ الرجُلُ يَقْحَم قُحوماً في الشِعْر، ويقال في الكلام العام: اقتَحَمَ وهو رَمْيُه بنفسَه في نَهْر أو وَهْدةٍ أو في أمْرٍ من غير رَوِيّة «3» . ويقال: قَحَمَ قُحُوماً: إذا كَبِرَ. قال زائدة: قَحَمَ وأقحَمَ تجاوَزَ، واقتَحَم هو. والقَحْم: الشّيْخ الخَرِف، والقَحْمةُ: الشَّيْخةُ، قال الراجز:
إنّي وإنْ قالوا كبير قَحْمُ ... عندي حُداءٌ «4» زَجَلٌ ونَهْمُ
والقُحْمةُ: الأمْرُ العظيم. لا يَركَبُها كل أحَد، والجمعُ: قُحَم. وقُحَم الطريق: ما صَعُبَ، قال:
يَرَكَبْنَ من فَلْجٍ طريقاً ذا قُحَمْ «5»
وبعيرٌ مِقحام: يقتَحِم الشَّوْلَ من غير إِرسالٍ فيها. والمُقْحَمُ: البعير الذي
__________
(1) هو (أبو النجم) الراجز. اللسان (قبح) .
(2) في التهذيب:
حيث تلاقي الإبرةُ القَبيحا.
(3) في التهذيب 4/ 77 نقلا عن الليث: من غير دربة.
(4) كذا في ط، وفي س: حمار
(5) لم نهتد إلى الرجز ومصدره وقائله.
(3/54)
________________________________________
يُربع ويُثنى في سنة واحدة فَتقتَحِمُ سِنُّ. وبعير مُقْحَم: يُقْحَم في مَفازة من غير مُسيمٍ ولا سائقٍ، قال ذو الرمة:
أو مُقحَمٌ أَضعَفَ الإِبطانَ حادِجُه ... بالأَمسِ فاستَأْخَرَ العِدْلانِ والقَتَبُ «1»
شبَّهَ به جَناحَي الظليم. وأعرابيُّ مُقْحَم: أي نَشَأ في المَفازة لم يخرُجْ منها. والتقحيم: رَمْي الفَرَس فارسَه على وجهه.
وفي الحديث: إنّ للخُصومة قُحَماً «2»
أي إنّها تُتَقَحَّمُ على المَهالِك وقُحْمُة الأَعراب: سَنَةٌ جَدْبةَ تَتقحَّم عليهم، أو تَقَحُّمُ الأعراب بلاد الريف.
قمح: القَمْحُ: البُرُّ. وأَقْمَحَ البُرُّ: جَرَى الدقيقُ في السُّنْبُل. والاقتِماحُ: ما تَقتَمِحُه من راحتكَ في فيكَ. والاسم: القُمْحة كاللُّقْمة والأكلة. والقميحة: اسم الحوارش. والقمحان: وَرْسٌ، ويقال: زَعْفَران. وقال زائدة: هو الزَّبَدُ وقال النابغة:
إذا فُضَّتْ خَواتُمه علاه ... يَبيسُ القُمَّحانِ من المُدام «3»
والقامِح والمُقامِحُ من الإبِلِ: الذي اشتدَّ عَطَشُه فَفَتَر فُتُوراً شديداً. وبَعير مُقْمَحٌ، وقَمَحَ يَقْمَحُ قُمُوحاً وأقمَحَه العَطَش والذليل مُقمَح: لا يكادُ يرفَعُ بصَره. وقول الله- عز وجل- فَهُمْ مُقْمَحُونَ
«4» أي خاشعون لا يَرفَعُونَ أبصارهم، وقال الشاعر:
ونحن على جوانِبِهِ عُكُوفٌ «5» ... نَغُضُّ الطرف كالإبل القماح
__________
(1) البيت في الديوان 1/ 120
(2) في التهذيب 4/ 77- 78
وفي حديث عليٍّ (رضي الله عنه أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة وقال: إن للخصومةقحما.
(3) البيت في اللسان (قحم) والديوان ص 160
(4) سورة يس 8
(5) في التهذيب: 4/ 81 واللسان (قمح) ، وفيهما: (قعود) في مكان (عكوف) ، والبيت فيهما غير منسوب أيضا.
(3/55)
________________________________________
وفي المثل: الظَمَأُ القامِحُ خَيْرُ من الرِيِّ الفاضِح يُضرَبُ هذا لِما كان أوّله مَنْفَعَة وآخرهُ نَدامة. ويقال: القامِحُ الذي يَردُ الحَوضَ فلا يشرَب. ويقال: رَوِيتُ حتّى انقَمَحْتُ: أي حتى تَرَكْتُ الشَرابَ. وابِلٌِ قِماحُ.
محق: مَحَقَهُ اللهُ فانمَحَقَ وامتَحَقَ: أي ذَهَبَ خيرُه وبَرَكَتُه ونَقَصَ، قال الشاعر:
يَزدادُ حتّى إذا ما تَمَّ أعقَبَه ... كَرُّ الجَديدَيْن نَقْصاً ثمَّ يَنْمَحِقُ «1»
والمُحِاقُ: آخِرُ الشَّهْر إذا انمَحَقَ الهِلالُ فلم يُرَ، قال:
بلالُ يا ابنَ الأَنجُمِ الأَطلاقِ ... لَسْنَ بنَحْساتٍ ولا مِحاقِ «2»
ويُرْوَي: ولا أَمحاقِ.
حمق: استَحْمَقَ الرجلُ: فَعَلَ فِعْلَ الحَمْقَى. وامرأةٌ مُحْمِقٌ: تَلِدُ الحَمْقَى. وفَرَسٌ مُحْمِقٌ: لا يَسْبِقُ نَتاجُها. وحَمَقَ حَماقة وحُمْقاً: صارَ أحمَقَ. والحُماقُ: الجُدَريّ «3» . يقال منه رَجُلٌ مَحمُوقٌ. وانحَمَقَ في معنى استَحْمَقَ، قال:
والشَّيْخُ يَوماً إذا ما خِيفَ يَنْحَمِقُ «4»
__________
(1) التهذيب 4/ 82، واللسان (محق) غير منسوب فيهما أيضا.
(2) (رؤبة) ديوانه/ 116. والرواية فيه: أمحاق
(3) في التهذيب: والحميقاء الجدري الذي يصيب الصبيان. وفي اللسان: الحماق والحميقاء: الجدري.
(4) ورواية الشطر في اللسان:
والشيخ يضرب أحيانا فينحمق.
(3/56)
________________________________________
باب الحاء والكاف والشين مهما ح ش ك، ك ش ح، ش ح ك مستعملات
حشك: الحَشَكُ: تَرْكُكَ النّاقَةَ لا تَحلُبُها حتّى يجتَمع لَبَنُها، وهي مَحْشُوكةٌ. والحَشَك: اسم للدِرّةِ المُجتَمعة، قال:
غَدَتْ وهي مَحشُوكةٌ حافِلٌ ... فراحَ الذِئارُ عليها صَحيحا «1»
كشح: الكشح: من لدن السرة إلى المَتْن ما بَيْنَ الخاصِرة إلى الضِلَع الخَلْف، وهو مَوضِع مَوقِع السَّيْف إلى المُتَقَلِّد. وطَوَى فلانٌ كَشْحَه على أمر: إذا استَمَرَّ عليه وكذلك الذاهب القاطع. والكاشِح: العَدوٌ، قال:
فذَرْني ولكنْ ما تَرَى رَأْيَ كاشحٍ ... يَرَى بيننا من جهلِه دقَّ مَنْشِمِ
ويقال: طَوَى كَشْحَه عَنّي: إذا قَطَعَكَ وعاداكَ. وكاشَحَني فلانٌ بالعَداوة.
شحك: الشَّحْكُ: من الشِّحاك، تقول: شَحَكْتُ الجَدْيَ: وهو عُودٌ يُعَرَّض في فَمِهِ يَمْنَعُه من الرِّضاع.
__________
(1) البيت في التهذيب واللسان (حشك) .
(3/57)
________________________________________
باب الحاء والكاف والضاد معهما ض ح ك مستعمل فقط
ضحك: ضحِكَ يَضَحَكُ ضَحِكاً وضِحْكاً، ولو قال: ضَحَكاً لكان قياساً لأنّ مصدر فَعِلَ فَعَل. والضُحْكَةُ: ما يُضحَكُ منه. والضُّحَكَةُ: الكثير الضَحِك يُعابُ به. والضِّحّاك في النَعْت أحسَنُ من الضُّحَكَةِ. والضَّاحكة: كلُّ سِنٍ من مُقَدَّم الأضراس ما يبدُو عند الضَّحِك. والضَّحّاكُ بن عدنان: الذي يقال مَلَكَ الأرض، ويقال له: المُذْهَب، كانَتْ أمّه جنّيَّةً فلحق بالجنِّ وتلبّد بالفِراء «1» . تقولُ العَجمُ إنّه عَمِل بالسِحْر وأظهَرَ الفساد أُخِذَ فشُدَّ في جَبَل دَنْباوَند. وقوله فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها
«2» يَعني طَمِثَتْ. والضَّحْك: الثَلجْ، ويقال: جَوْف الطَّلْع، وهي من لغة بني الحارث، يقالُ: ضحِكتِ النَّخلة إذا انشَقَّ كافورُها. وقال آخرون: هو الشُهُدُ، ويقالُ: الزُبْد، ويقال: العَسَلُ. وهو بهذَيْن أشبْهُ في قوله: «3»
فجاءَ بمزج لم يَرَ الناسُ مِثلَه ... هو الضَّحْكُ إلا أنّه عملُ النَّخْلِ
والضَحُوك من الطُرُق: ما وَضحَ فاستَبانَ، قال:
على ضَحوكِ النَّقْبِ مجرهد «4»
__________
(1) عبارة (وتلبد بالفراء) من (س) أما (ص وط) فالعبارة فيهما غير واضحة ولا مفهومة. أما في التهذيب 4/ 89 عن العين فالعبارة: (ويتبدى للقراء) . وفي اللسان: وسد القرا. وقد علق الناشر في الحاشية: كذا بالأصل بدون نقط، وأضاف: ولعله محرف عن: وبيداء القرى.
(2) سورة هود 71
(3) هو (أبو ذؤيب الهذلي) كما في التهذيب وديوان الهذليين 1/ 42
(4) (رؤبة) ديوانه/ 49 والرواية فيه:
على ضحوك النقب مصمعد
(3/58)
________________________________________
باب الحاء والكاف والسين معهما ح س ك، ك س ح يستعملان فقط
حسك: الحَسَكُ: نَباتٌ له ثَمَرةٌ خَشِنةٌ تَتَعَلّق بأصواف الغنم، الواحدة حَسَكة. والحَسَكُ: من أَدَوات الحَرْب رُبَّما يُتَّخَذُ من حديدٍ فيُلْقَى حَولَ العَسكر، ورُبَّما اتُّخِذَ من خَشَب فنُصِبَ حولَ العسكر. وحسك الصَّدْر: حِقْدُ العَداوة، تقول: إنه والحسك الصدر عليَّ. والحِسكيكُ «1» : القُنْفُذُ الضَّخْم.
كسح: الكُساحةُ: تُراٌب مجموع. وكَسَحَ بالمِكْسَحة كَسْحاً أي كَنْساً. والمُكاسحُة: المُشّارّةُ الشديدة. والكَسَح: شَلَلٌ «2» في إحدى الرِجْلَيْن إذا مَشى جَرَّها جَرّاً. ورجلٌ كَسْحان. وكَسِحَ يَكسَحَ كَسَحاً فهو أكسَحُ، قال: «3» .
كلّ ما يقطَعُ من داء الكَسَح
قال زائدة: أعرِفُ الكَسَحَ العَجْز، يقال: فلان كَسِحٌ: أيْ عاجز ضعيف. والأكَسَحُ: الأَعَرجُ.
باب الحاء والكاف والدال معهما ك د ح مستعمل فقط
كدح: الكَدْح: عَمَل الإنسان من الخَيْر والشَرِّ. ويكدَحُ لنفسه: أي يسعى.
__________
(1) كذا في (ص، ط) . في (س) : الحسيك، وفي التهذيب واللسان: الحسكك.
(2) في التهذيب من كلام الليث: ثقل.
(3) (الأعشى) ديوانه/ 245 والرواية فيه:
كل ما يحسم من داء الكشح
بالشين المعجمة. وصدر البيت
ولقد أمنح من عاديته.
(3/59)
________________________________________
وقوله تعالى: إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً
«1» أيْ ناصب، وكدحا أي نَصْباً. قال زائدة: إِلى رَبِّكَ في معنى نحو ربّك. والكَدْح: دونَ الكَدْم بالأسنان. والكَدْحُ بالحَجَر والحافِر.
باب الحاء والكاف والتاء معهما ك ت ح، ح ت ك يستعملان فقط
كتح: الكَتْح: دون الكَدْح من الحَصَى والشَّيء يُصيبُ الجلد فيُؤثّر فيه، قال: «2»
يَلْتَحْنَ وجهاً بالحَصَى ملتوحا ... ومرة بحافر مكتوحا
أي تضربه الريح بالحصى، قال:
فأَهْوِنْ بذِئبٍ يَكْتَحُ الريحُ باستِهِ «3»
أيْ تَضْربُه الريحُ بالحَصَى. ومن يروي: تكثَح، أي: تكشِفُ.
حتك: الحَتْك والحَتَكان: شِبْه الرَتَكان في المَشْي إلاّ أنَّ الرَّتك للإبِلِ خاصّة، والحَتْك من المشي للإنسان وغيره. والحوتك: القصير «4»
__________
(1) سورة الانشقاق 6
(2) هو (أبو النجم) الراجز. انظر التهذيب.
(3) الشطر في التهذيب واللسان (كتح) .
(4) وأضاف في التهذيب واللسان: القرب الخطو.
(3/60)
________________________________________
باب الحاء والكاف والثاء معهما ك ث ح يستعمل فقط «1»
كثح: الكَثْح: كشفُ الريحِ الشيءَ عن الشيء. ويَكثَحُ بالتُرابِ وبالحصَىَ: يضرِبُ به.
باب الحاء والكاف والراء معهما ح ر ك، ح ك ر، ر ك ح مستعملات
حرك: حَرَكَ الشيء يحرُكُ حَرْكاً وحركةً وكذلك يَتَحَرُّك. تقول: حَرَكْتُ بالسيف مَحْرَكَه حَرْكاً أي ضَرَبْتُه. والمَحْرَكُ: مُنَتَهى العُنُق وعند مَفصِل الرأس. والحاركُ: أعلى الكاهل، قال: «2»
مُغْبَطُ الحارِكِ مَحبُوكُ «3» الكَفَلْ
والحَراكيكُ: الحَراقِف، واحدها: حَرْكَكَة.
حكر: الحَكْرُ: الظُلم في النقص «4» وسُوء المعاشرة. وفلان يحكِرُ فلاناً: أدخَلَ عليه مَشَقّة ومَضَرَّةً في مُعاشَرته ومُعايَشته. وفلان يَحْكِرُ فلاناً حَكْراً. والنَعْت حكر، قال الشاعر:
__________
(1) في التهذيب: كثح، كحث مستعملان.
(2) هو الشاعر (لبيد) . وصدر البيت:
ساهم الوجه شديد أسره.
الديوان ص 187.
(3) كذا في الديوان واللسان (حرك) والتهذيب، وفي الأصول المخطوطة: محروك.
(4) في التهذيب عن الليث: الظلم والتنقص....
(3/61)
________________________________________
ناعَمَتْها أُمُّ صِدْقٍ بَرَّةٌ ... وأبٌ يُكرِمُها غيرَ حَكِرُ «1»
والحَكْر: ما احتَكرْتَ من طَعام ونحوه ممّا يُؤكَل، ومعناه: الجمع، والفعل: احتَكَر وصاحبه مُحتَكِرٌ ينتظر باحتباسه، الغلاء.
ركح: الرُكْح: رُكن مُنيفٌ من الجَبَل صَعْبٌ، قال:
كأنَّ فاهُ واللِّجامُ شاحي ... شَرْخا «2» غَبيطٍ سَلِسٍ مِركاح
أي كأنَّه رُكْح جَبَل. والرُكْح: ناحيةُ البَيت من وَرائه، وُرَّبما كانَ فَضاءً لا بِناءَ فيه.
باب الحاء والكاف واللام معهما ك ح ل، ل ح ك، ح ل ك، ك ل ح مستعملات
كحل: الكُحْل: ما يُكْتَحَلُ [به] والمِكحال: المِيلُ تُكحَلُ به العَيْنُ من المُكْحُلَة، والكَحَلُ: مصدره. والأكْحَل الذي يَعلُو مَنابِتَ أشفاره سَوادٌ خِلقةً. والأكحَلُ: عِرْق الحياة في اليَد وفي كُلِّ عُضو منه شعبة على حدة. والكحل: شِدَّة المَحْل. والكُحَيل: ضَرْبٌ من القَطِران.
لحك: اللَّحْك: شِدَّة لأَم الشّيء بالشيء، تقول: قد لوحِكَت فَقارُ هذه الناقة، أي دَخَلَ بعضُها في بعض. والمُلاحَكة في البُنيْان ونحوه، قال الأعشى: «3»
__________
(1) رواية التهذيب واللسان: نعمتها (بالتضعيف) .
(2) (العجاج) ديوانه/ 441. وبينهما قوله: يفرع بين الشد والإكماح في التهذيب 4/ 98 واللسان (ركح) : (شرجا غبيط) بالجيم.
(3) ديوانه/ 47.
(3/62)
________________________________________
ودأبا تلاحك مثل الفئوس ... لاحم فيه السليل «1» الفِقارا
حلك: الحَلَكُ: شدَّة السَّواد، حالِكٌ حلكوك، وحَلَكَ يَحلُكُ [حلوكا] «2» . والحَلَك: شِدَّة السَواد كلَون الغُراب، يقال: إنّه لأشدُّ سواداً من حَلَك الغُراب.
كلح: الكُلُوح: بُدُوّ الأسنان عند العُبُوس. وكَلَح كُلُوحاً. وأَكْلَحَه كذا. قال لبيد:
تُكلِحُ الأَرْوَقَ منهم والأَيَلّ «3»
حكل: تقُول: في لِسانِه حُكْلةٌ أي عُجْمة.
باب الحاء والكاف والنون معهما ن ك ح، ح ن ك، مستعملان فقط
نكح: نَكَحَ يَنكِحُ نَكْحاً: وهو البَضْع. ويُجرَى نَكَحَ أيضاً مجرى التزويج. وامرأةٌ ناكِحٌ: أي ذاتُ زوج، ويجوز في الشعر ناكحة بالهاء، قال: «4»
__________
(1) في (ص، ط، س) : الشليل، بالشين.
(2) في الأصول المخطوطة: حلكا.
(3) ديوانه/ 195. وصدر البيت:
رقميات عليها ناهض
(4) هو (الطرماح) ديوانه/ 89.
(3/63)
________________________________________
ومثلك ناحت عليه النساء ... من بين بِكْرٍ إلى ناكِحَهْ
وقال:
أحاطَتْ بخطّابِ الأيامَى وطُلِّقَتْ ... غَداتئِذٍ منهُنَّ من كان ناكحا «1»
وكانَ الرجلُ يأتي الحَيَّ خاطباً فيقوم في ناديهم فيقول: خِطبٌ، أيْ جئتُ خاطباً، فيقال «2» له: نِكحٌ، أي أنْكَحْناك.
حنك: رجلٌ مُحَنَّك: لا يُستقلّ منه شيء مما عضَّه الدهر. والمُحتَنِك: الذي تَمَّ عقًلُه وسنُّه، يُقال: حَنَّكَتْه السِّنُّ حَنْكاً وحَنَكاً. وحنَّكَتْه تحنيكاً: إذا نَبَتَتْ أسنانُه التي تُسَمَّى أسنان العقل، قال العجاج:
محنتك ضخم شئون الراسِ
ويقال: هم أهلُ الحُنْك، ومنهم من يكسر الحاء، ومنهم من يثقّل فيقول: أهل الحُنُك والحُنْكة يَعني أهلَ الشَرَف «3» والتَجارِب. والتَّحنيك: إن تغرِزَ عوداً في الحَنَك الأعلى من الدابَّة أو في طَرَف قَرْنٍ حتى يُدميه لِحَدَث يحدث فيه. واستَحنَكَ الرجلُ: اشتَدَّ أكْلُهُ بعد قِلَّة. وحَنَّكْتُ الصبيَّ بالتّمْر: دَلَكتُه في حَنَكه. والحَنَكانِ: الأعلى والأسفل، فإذا فَصلَوهما لم يَكادوا يقولون للأعلى حَنَك، قال حميد: «4»
__________
(1) التهذيب 4/ 103، واللسان (لكح) ، وفي اللسان: غداة غد.
(2) من (س) وهو الصواب. في (ص، ط) : فيقول:.......
(3) في التهذيب: السن.
(4) التهذيب 4/ 104 عن العين. أما (ص ط، س) فالرجز فيها فالحنك الأسفل منه أفعم والحنك الأعلى طوال مطهم
(3/64)
________________________________________
[فالحَنَكُ الأعلى طُوالٌ سَرطُم] ... والحنك الأسفل منه أفقمُ]
وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم- كانَ يُحنِّك أولادَ الأنصار.
واحتَنَكتُ الرجلَ: أخذتُ مالَه ومنه قوله تعالى: لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا «1» .
باب الحاء والكاف والفاء معهما ك ف ح يستعمل فقط
كفح: المُكافَحة: مُصادَفُة الوجْهِ بالوجْه عن مُفاجأة، قال عدي: «2»
أعاذل من تكتب له النّارُ يَلْقَها ... كِفاحاً َومَنْ يُكتَبْ له الخُلْدُ يَسْعَدِ
وكافَحها: قَبَّلَها عن غَفْلةٍ وِجاهاً. والمُكافحةُ في الحَرْب: المُضاربة تِلقاءَ الوُجُوه.
باب الحاء والكاف والباء معهما ك ح ب، ك ب ح، ح ب ك مستعملات
كحب: الكَحْبُ: [البَرْوَقُ] «3» بلغة اليَمَن، والحبة منه كحبة..
__________
(1) سورة الإسراء 62
(2) هو عدي بن زيد. والبيت في الديوان ص 103 وفيه: (الفوز) في مكان (الخلد) .
(3) التاج (كحب) : الكحب والكحم: الحصرم بالكسر، واحدته: كحبة بهاء، يمانية، وهو البروق. في الأصول المخطوطة: (فورق) وكذلك في مختصر العين (ورقة 61) . وفي التهذيب 4/ 110. (النورة) . وفي اللسان (كحب) : (العورة) .
(3/65)
________________________________________
كبح: الكَبْحُ: كَبْحُكَ الدابَّة باللِّجام، وهو قَرْعُك إيّاها.
حبك: حَبَكتْهُ بالسيف حَبْكاً: وهو ضَربٌ في اللَّحْم دون العَظْم، ويقال: هو مَحْبُوكُ العَجْز والمَتْن إذا كان فيه استِواء مع إرتفاع، قال الأعشى: «1»
على كُلِّ مَحبُوكِ السَّراة كأنَّه ... عُقابٌ هَوَتْ من مَرْقَبٍ وتعلت
أي: ارتفعت. وهوت انخَفْضَتْ.. والحِباكُ: رباطُ الحَضيرة بقَصَبات تُعَرَّضُ ثمَّ تُشَدُّ كما تُحبَكُ عُروشُ الكَرْم بالحِبال. واحَتَبكْتُ إزاري: شَدَدْتُه. والحَبيكة: كلُّ طريقة في الشَّعْر وكُلُّ طريقةٍ في الرَّمْل تَحْبِكهُ الرِياحُ إذا جَرَتْ عليه، ويُرَى نحوَ ذلك في البيضِ من الحديد، قال الشاعر:
والضاربُونَ حَبيكَ البيضِ إذ لَحِقُوا ... لا يَنكُصُونَ إذا ما استُلْحِموا «2» وَحَمُوا
أي اشتَدَّ قتالُهم. والحُبُك: جماعة الحبيك، ويقال: كذلك خِلْقةُ وجْهِ السَّماء. ويقال: ما طَعِمْنا عنده حبكة ولا لَبَكة، ويقال: عَبَكة، فالعَبَكةُ والحَبَكةُ معاً: الحَبَّة من السَّويق، واللَّبَكة: اللُّقمة من الثَريد ونحوِه.
باب الحاء والكاف والميم معهما ح ك م، م ح ك، ح م ك، ك م ح مستعملات
حكم: الحِكمةُ: مَرْجِعُها إلى العَدْل والعِلْم والحِلْم. ويقال: أحْكَمَتْه التَجارِبُ إذا كانَ حكيماً. وأَحْكَمَ فلانٌ عنّي «3» كذا، أي: مَنَعَه، قال:
__________
(1) ديوانه (تحقيق محمد محمد حسين) ص 261.
(2) كذلك في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: استحملوا.
(3) من (س) في (ص ط) : وأحكم عني فلانا شيء كذا.
(3/66)
________________________________________
أَلَمّا يَحْكُمُ الشُعَراءُ عَنّي «1»
واسَتحْكَمَ الأمرُ: وَثُقَ. واحتَكَمَ في ماله: إذا جازَ فيه حُكْمُه. والأسم: الأُحكُومة والحُكوُمة، قال الأعشى:
ولَمَثْلُ الذي جَمَعْتَ لرَيْب ... الدَّهْر يَأبَى حُكومةَ المُقتالِ
أي لا تَنْفُذُ حكومةُ من يحتكِم عليك من الأعداء. والمُقتالُ: المُفتَعِلُ من القَوْلِ حاجةً منه إلى القافية. والتَحكيم: قول الحَروريّة: لا حُكمَ إلاّ للهِ «2» . وحَكَّمنا فُلاناً أمرَنا: أي: يحكُمُ بيننا. وحاكَمناه إلى الله: دَعَوناه إلى حُكم الله. ويقال: نُهِيَ أنْ يُسَمَّى رَجُلٌ حَكَماً. وَحكَمة اللّجام: ما أحاطَ بحَنَكَيْه سُمِّيَ به لأنّها تمنعه من الجَرْي. وكلُّ شيء مَنَعْتَه من الفَساد فقد [حَكَمْتَهُ] وحَكَّمته وأحكَمْتَه، قال: «3»
أبني حَنيفةَ أَحكِمُوا سُفَهاءكُم ... إنّي أخافُ عليكُمُ أن أغْضَبا
وفَرَسٌ محكُومةُ: في رأسها حَكَمَةٌ. قال زائدة: مُحْكَمةُ وأنكَرَ مَحكُومة، قال:
مَحكوُمةٌ حَكمَات القِدِّ والأَبَقَا «4»
وهو القِتْبُ «5» . وسَمَّى الأعشى القصيدة المُحْكَمة حَكيمة في قوله:
وغريبةٍ تأتي المُلُوكَ حكيمةٍ «6» .
__________
(1) لم نهتد إلى البيت وإلى قائله.
(2) وزاد في التهذيب من كلام الليث: ولا حكم إلا الله.
(3) هو (جرير) . (3) هو (جرير) . ديوانه 1/ 466.
(4) الشطر في التهذيب (حكم) ويروى أيضا: قد أحكمته حكمات القد والأبقا
(5) انفرد كتاب العين بذكر هذه الدلالة.
(6) ديوانه/ 27 وعجز البيت فيه:
قد قلتها ليقال من ذا قالها.
(3/67)
________________________________________
محك: المَحْكُ: التَّمادي في اللَّجاجة عند المُساوَمة والغَضَب ونَحْوه. وتماحَكَ البَيِّعان.
حمك: الحَمَكُ: من نَعْت الأدِلاّء، [تقول] : حَمِكَ يَحْمَكُ.
كمح: الكَمْحُ: رَدُّ الفَرَس باللِّجام.
باب الحاء والجيم والشين معهما ش ح ج، ج ح ش مستعملان فقط
شحج: الشَّحيجُ: صَوْتُ البغل وبعض أصوات الحِمار. شَحَجَ يَشْحَجُ شَحيجاً. وشَحَجَ الغُرابُ شَحَجاناً: وهو تَرجيعُ الصَوْت فإذا مَدَّ [قيل] : نَعَب «1» . ويقال للبِغال: بَناتُ شاحِج وشَحّاج. ويقال للحِمار الوحشي «2» ، قال لبيد:
فهو شَحّاجُ مُدِلٌّ سَنِقٌ ... لاحِقُ البَطْن إذا يَعدُو زَمَلْ «3»
جحش: الجَحْشُ: وَلَدُ الحمار، والعَدَدُ: جِحَشة، والجميعُ جِحاشُ. والجَحْشة [يتخذها الرّاعي] كالحلقة من الصّوف يلقيها في يده ليغزلها «4» . والجِحاش: الدِفاع [تُجاحِشُ] «5» : تُدافِعُ عن نفسك. والجَحْشُ: دون الخَدْش. جُحِشَ فهوَ مَجحُوش.
__________
(1) في اللسان: فإذا مد رأسه نعب.
(2) من التهذيب 4/ 119 عن العين. في (ص، ط) : الشّيء، وفي (س) : وانحضج إذا ضرب مشحج وشحاج
(3) البيت في التهذيب 4/ 117 والديوان ص 189.
(4) من التهذيب 4/ 118 عن العين. والعبارة في الأصول مضطربة وفيها تقديم وتأخير.
(5) من اللسان (جحش لتقويم العبارة.
(3/68)
________________________________________
باب الحاء والميم والضاد معهما ح ض ج يستعمل فقط
حضج: الحَضْجُ «1» : الماءُ القليلُ. والحِضْج أيضاً قال: «2»
فأسأَرَتْ في الحوض حِضْجاً حاضجا
وانحَضَجَ الرجلُ «3» : إذا ضَرَبَ بنفسه الأرض غضبا و [يقال ذلك] إذا اتَّسَعَ بطنه، فإذا فَعلْتَ به قُلتَ: حَضَجْتُه أيْ ادخَلْتُ عليه ما يكادُ ينشَقُّ وانحَضَجَ من قِبلَه.
باب الحاء والجيم والسين معهما س ح ج، س ج ح يستعملان فقط
سحج: سَحَجْتُ الشَّعْرَ سَحْجاً: وهو تَسريح ليِّنٌ على فَرْوة الرأس. وسَحَجَ الشيءَ يَسحَجُه: أي يَقشِرُ منه شيئاً قليلاً كما يُصيبُ الحافِرَ من قِبَل الحَفا. والسَّحْجُ أيضاً: «4» جَرْيُ الدَوابِّ دون الشديد. وحِمارٌ مِسْحَج، قال النابغة:
رباعية أضر بها رَباعٌ ... بذاتِ الجِزْع مِسْحاجٌ شَنونُ «5»
والمُسَحَّج: من التَسحيج وهو الكدم.
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب نقلا عن الليث: الحضيج.
(2) في التهذيب 4/ 119 واللسان (حضج) : وأخبرني أبو مهدي قال سمعت هميان بن قحافة ينشده: الرجز......
(3) من التهذيب 4/ 119 عن العين، في (ص، ط) الشّيء، وفي (س) : وانحضج إذا ضرب....
(4) ديوانه/ 216. والرواية فيه:
رباع قد أضر بها رباع
(5) ديوانه/ 216. والرواية فيه:
رباع قد أضر بها رباع
(3/69)
________________________________________
سجح: الإسجاحُ: حُسنُ العَفْو كقولهم: مَلَكْتَ فأَسجحْ. ويقال: مَشَى مَشياً سجيحاً وسُجُحاً، قال الشاعر: «1»
ذَرُوا التَّخاجيَ وامشوا مشية سجحا ... إن الرجالَ ذوو عَصْبٍ وتذكيرِ
ويقال: سَجَحَت [الحمامة] «2» وسَجَعَتْ. ورُبَّما قالوا: مُزْجح في مُسْجح كالأسْد والأزْد. والسَجَحُ: لِينُ الخَدِّ، والنَّعتُ: أسجَحُ وسَجْحاء، قال ذو الرمة:
وخد كمرآة الغريبة أسجح «3»
باب الحاء والجيم والزاي معهما ح ج ز، ج ز ح يستعملان فقط
حجز: الحَجْزُ: أن تَحجِزَ بين مُقاتِلَيْن. والحِجاز والحاجز اسم، وقوله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً
«4» أيْ حِجازاً فذلك الحِجاز أمْر الله بين ماءٍ مِلْحٍ وعَذْبٍ لا يختلطان. وسُمِّيَ الحِجاز لأنّه يفصِلُ بينَ الغَوْر والشام وبيْنَ البادِية. والحِجازُ: حَبْلٌ يُلقَى للبعير من قِبَل رِجلَيْه، ثُمَّ يُناخُ عليه، يُشَدُّ به رُسْغا رِجلَيْه إلى حِقْوَيْه وعَجُزه. حَجَزْته فهو مَحجُوز، قال ذو الرمة:
__________
(1) الشاعر حسان بن ثابت والبيت في الديوان (ط تونس) ص 125. وفي اللسان:
دعوا التخاجؤ....
(2) سقطت في الأصول المخطوطة ووردت في التهذيب من كلام الليث.
(3) ديوانه 2/ 1217. وصدر البيت:
لها أذُنٌ حَشرٌ وذِفْرَى أسيلة
(4) سورة النمل 61
(3/70)
________________________________________
حتى إذا كانَ محجُوزاً بنافِذةٍ ... وقائظا وكِلا رَوْقَيْهِ مُخْتَضَبُ «1»
وتقول: كان بينهم رِمِّيّاً ثم حَجَزْتَ بينهم حِجِّيَزى. أيْ رَمْيٌ، ثم صاروا إلى المُحاجزة. والحُجْزَةُ: حَيثُ يُثْنَى طَرَف الأزِار في لَوْث الازِار، قال النابغة:
رِقاقُ النِعالِ طِّيبٌ حجزاتهم ... يُحَيُّونَ بالرَيْحانِ يومَ السباسِبِ
والرجلُ يحتَجزُ بإزارِه على وسَطه. وحُجْزُ الرجل: أصلُه ومَنْبِتُه. وحُجْزُ الرجل أيضاً: فَصْل ما بين فَخذِه والفَخِذِ الأخرى من عشيرته، قال: «2»
فامدَحْ كريمَ المُنْتَمَى «3» والحُجْزِ
جزح: جَزَحَ لَنا من ماله [جَزْحا «4» أو جَزْحةً: أيْ قَطَعَ قِطعةً. وجَزَحَ الشَجَرَ: حَتَّ ورقه.
باب الحاء والجيم والطاء معهما ج ط ح يستعمل فقط
جطح: جطح: يقال للعَنْز عند الحليب: جِطِحُ، أي: قَرِّي فتَقَرَّ. قال زائدة: جَطَح السَّخْلةَ إذا زُجِرَتْ ولا يقال للعنز.
__________
(1) ديوانه 1/ 109 والرواية فيه:
حتى إذا كن محجوزا بنافذة ... وزاهقا.....
رواية التهذيب 4/ 123 واللسان (حجز) :
فهن من بين محجوز بنافذة ... وقائظ وكلا روقيه مختضب.
(2) هو (رؤبة) ديوانه/ 65.
(3) في الأصول المخطوطة: المنتهى.
(4) في الأصول المخطوطة، جزاحا
(3/71)
________________________________________
باب الحاء والجيم والدال معهما ج ح د، ج د ح، ج د ح مستعملات
جحد: الجُحُود: ضدُّ الاقرار كالانكار والمعرفة. والجَحدُ: من الضيِّق والشُحِّ. ورجُلٌ جَحْدٌ: قليلُ الخير، قال:
لا جحدا ابتغينه ولا جَدا ... يَعدنَ من هازَلْنَه غداً غدا «1»
حدج: الحَدَج: حَمْلُ البِطِّيخ والحنَظْلَ ما دام صِغاراً خُضْراً. ويقال ذلك لحَسَك القُطْب ما دامَ رَطْباً، الواحدة بالهاء. والحُدْجُ لغةٌ فيه. والتَحديج: شِدَّة النَظَر بعد رَوْعةٍ وفَزْعةٍ، حَدَّجْتُ بَبصَرى، قال العجاج: «2»
إذا آثبجرّا «3» من سَواد حَدَّجا
وحَدَجْتُ ببَصَري: رَمَيتُ به. والحِدْج: مَرْكَبٌ غيرُ رَحْلٍ ولا هَوْدَج لنِساء العرب، حَدَجْتُ الناقةَ أحدِجُها حَدْجاً، والجميع: أحداج وحَدائج وحُدُوج، قال:
أَصاحِ تَرَى حَدائِجَ باكراتٍ ... عليها العَبْقَريَّةُ والنُّجُودُ «4»
وأحدَجْتُها: إذا شَدَدْتُ الحِدْجَ عليها.
__________
(1) لم نهتد إلى الرجز في المشهور من المظان.
(2) في اللسان: يصف الحمار والأتن.
(3) كذا في الأصول المخطوطة والديوان ص 379. وفي اللسان: اسبجرا.
(4) لم نهتد إلى البيت وقائله ولم نجده في المظان المعتمدة.
(3/72)
________________________________________
جدح: الجَدْحُ: خوض السَّويق واللَّبَن ونحوه بالمجدح ليختلِطَ. والمِجدَح: خَشَبةٌ في رأسها خَشَبَتان مُعتَرضَتانِ. والمِجداح: تردُّد رَيِّق الماء في السَّحاب «1» ، يقال: أرسَلَتِ السَماُء مَجاديحَ الغَيْثِ.
باب الحاء والجيم والظاء معهما ج ح ظ مستعمل فقط
جحظ: الجِحاظان: حَدَقَتا العَيْن إذا كانتا خارجتَيْن. وعَيْنٌ جاحظةُ جَحَظَتْ جُحُوظاً.
باب الحاء والجيم والذال معهما ذ ح ج مستعمل فقط
ذحج: ذَحَجَتِ المرأةُ بَوَلَدِها، إذا رَمَتْ به عندَ الوِلادة. ومَذْحِجٌ: اسم رجل.
باب الحاء والجيم والراء معهما ح ج ر، ج ح ر، ح ر ج، ر ج ح مستعملات
حجر: الأحجار: جمع الحَجَر. والحِجارة: جمع الحَجَر أيضاً على غير قياس،
__________
(1) وفي التهذيب: وما قاله الليث في تفسير المجاديح أنها تردُّد رَيِّق الماء في السحاب فباطل، والعرب لا تعرفه.
(3/73)
________________________________________
ولكن يَجْوزُ الاستحسان في العربية [كما أنه يجوز في الفقه، وترك القياس له] «1» كما قال: «2» .
لا ناقصي حسب ولا ... أيد إذا مُدَّتْ قِصارَهْ
ومثله المِهارة والبِكارة والواحدةُ مُهْرٌ وبَكْرٌ. والحِجْرُ: حطيم مكّة، وهو المَدارُ بالبيت كأنّه حُجْرَةٌ. مما يلي الَمْثَعب. وحِجْر: موضعٌ كان لثَمود ينزِلونَه. [وقصبة اليمامة] : حَجْرٌ، قال الأعشى:
وإن امرأ قد زُرْتُه قبل هذه ... بحَجْرٍ لخَيرٌ منكَ نفساً ووالِدا «3»
والحِجْر والحُجْر لغتان: وهو الحرام، وكان الرجل يَلقَى غيره في الأشهر الحُرُم فيقول: حِجْراً مَحجُوراً أيْ حَرامٌ مُحرَّم عليك في هذا الشْهر فلا يبدؤهُ بشَرٍّ، فيقول المشركون يومَ القيامة للملائكة: حِجْراً محجُوراً، ويظُنّون أن ذلكَ ينفعُهم كفِعلِهم في الدنيا، قال:
حتى دَعَونا بأَرحامٍ لهم سَلَفَتْ ... وقالَ قائلُهم إنّي بحاجُورِ «4»
وهو فاعُول من المنع، يَعني بمَعاذٍ. يقول: إني مُتَمسِّكٌ بما يعيذني منك ويَحجُبُك «5» عنّي، وعلى قياسه العاثُور وهو المَتْلَفُ. والمُحَجَّر: المُحَرَّم. والمَحْجِرُ: حيثُ يَقَعُ عليه النِقابُ من الوَجْه، قال النابغة:
وتَخالُها في البَيتِ إذْ فاجَأتَها ... وكأنَّ مَحْجِرَها سِراجُ الموقِدِ «6»
وما بَدَا من النِقاب فهو مَحْجِر. وأحجار الخَيْل «7» : ما اتخذ منها
__________
(1) من التهذيب 4/ 130 عن العين. والعبارة في الأصول مضطربة.
(2) هو الأعشى كما في التهذيب واللسان وديوانه ص 157
(3) ديوانه ص 65 والرواية فيه: بجو لخير منك......
(4) البيت في التهذيب واللسان (حجر) .
(5) في التهذيب: ويحجرك.
(6) عجز البيت في اللسان (حجر) والديوان ص 38. والرواية فيه:
قد كان محجوبا سراج الموقد
(7) في (ط) : النخل، وهو نصحيف.
(3/74)
________________________________________
للنَسل «1» لا يكادُ يُفرَد. ويقال: بل يقال هذا حِجْرٌ من أحجار خَيْلي، يَعني الفَرَسَ الواحد، وهذا اسم خاصٌّ للإِناث دونَ الذُكور، جَعَلَها كالمُحَرَّمِ بَيعُها ورُكوبُها. والحَجْر: أن تحجُرَ على إنسانٍ مالَه فتَمنَعَه أن يُفسدَه. والحَجْر: قد يكون مصدراً للحُجرة التي يَحتَجرُها الرجل، وحِجارُها: حائطُها المحيطُ بها. والحاجرِ من مَسيل الماء ومَنابِت العُشْب: ما استَدارَ به سَنَدٌ أو نهْرٌ مُرتفع، وجمعُه حُجْران، وقول العجاج:
وجارةُ البيتِ لها حُجْريٌّ «2»
أي حُرْمة. والحَجْرة: ناحيةُ كلِّ موضع قريباً منه. وفي المَثَل: يأكُلُ خُضْرةً ويَرْبِضُ حَجْرة «3» أيْ يأكُلُ من الرَوضة ويَربِض ناحيةً. وحَجْرتا العَسَكر: جانِباه من المَيْمَنةِ والميْسَرة، قال:
إذا اجتَمَعُوا فضضنا حجرتيهم ... ونجمعهم إذا كانوا بَدادِ «4»
وقال النابغة:
أُسائِلُ عن سُعْدَى وقد مَرَّ بعدَنا ... على حَجَرات الدارِ سَبْعٌ كَوامِلٌ
وحِجْر المرأة وحَجْرها، لغتان،: للحِضْنَين.
جحر: جَمْعُ الُجْحر: جِحَرة. أجْحَرته فانْجَحَر: أي أدخَلْتُه في جُحْر، ويجوز في الشعر: جَحَرتُه في معنَى أجْحَرتُه بغير الألف. واجتَحَر لنفسه جُحْراً. وجَحَرَ عنّا الربيع: تأخر، وقول امرىء القيس:
__________
(1) في (س) : للفسيل، وليس بالصواب.
(2) الرجز في التهذيب واللسان والديوان ص 316.
(3) في الأمثال ص 380 وفي التهذيب: فلان يرعى وسطا ويربض حجرة.
(4) البيت في التهذيب 4/ 135 واللسان. (حجر) .
(3/75)
________________________________________
جَواحِرُها في صَرَّةٍ لم تَزَيَّلِ «1»
أي أواخرُها. وقالوا: الجَحْرة السنةُ الشديدة، وإنّما سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها جَحَرَتِ الناسَ، قال زهير:
ونالَ كرامَ الناس في الجَحْرةِ الأَكْلُ «2»
حرج: الحَرَجُ: المَأُثم. والحارِجُ: الآثِم، قال:
يا ليتَني قد زُرْتُ غيرَ حارِجِ «3»
ورجُلٌ حَرِج وحَرَج كما تقول: دَنِف ودَنَف: في معنى الضَيِّق الصَدْر، قال الراجز:
لا حَرِجُ الصَدّرِ، ولا عنيفُ «4»
ويقرأ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً «5» وحَرِجاً. وقد حَرِجَ صدرهُ: أيْ ضاق ولا ينشَرحُ لخَير ورجلٌ مُتَحَرِّج: كافٌّ عن الإثم وتقول: أَحرَجَني إلى كذا: أيْ ألجَأني فخرِجْتُ إليه أي انضَمَمْتُ إليه، قال الشاعر: «6»
تَزدادُ للعَيْن إبهاجاً إذا سَفَرتْ ... وتَحْرَجُ العَيْن فيها حين تَنْتَقِبُ
والحَرَجَةُ من الشَجَر: الملتَفّ قَدْر رَمْية حَجَر، وجَمْعُها حِراج، قال:
ظلَّ وظلَّتْ كالحِراج قُبُلا ... وظلَّ راعيها بأخرى مبتلى «7»
__________
(1) وصدر البيت كما في الديوان، ص 22:
فألحقنا بالهاديات ودونه.
(2) وصدر البيت كما في الديوان ص 110:
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت
(3) لم نهتد إلى الرجز ولا إلى قائله.
(4) الرجز في التهذيب واللسان.
(5) سورة الأنعام 125
(6) البيت (لذي الرمة) انظر الديوان 1/ 31.
(7) لم نهتد إلى هذا الرجز.
(3/76)
________________________________________
والحرِجْ: قِلادة كَلْبٍ ويجمَع [على] أحرِجة ثم أحراج، قال الأعشى:
بنَواشِطٍ غُضُفٍ يُقلِّدُها ... الأَحراجُ فَوْقَ مُتُونها لُمَعُ «1»
والحِرْج: وَدَعة، وكِلابٌ محرّجةٌ: أي مُقَلّدة، قال الراجز: «2»
والَشُّد يُدني لاحقاً والهِبْلَعا ... وصاحبَ الحِرْج ويُدني ميلعا «3»
والحرجوج: الناقة الوقادة القَلْب، قال:
قَطَعْتُ بحُرْجُوجٍ إذا اللَّيلُ أظْلَما «4»
والحَرَج من الإبِل: التي لا تُركَب ولا يَضربُها الفَحل مُعَدَّة للسِمَن، كقوله: «5»
حَرَجٌ في مِرْفَقَيْها كالفَتَلْ «6»
ويقال: قد حَرَج الغبارُ غيرُ الساطعِ المنضَمِّ إلى حائطٍ أو سَنَد، قال:
وغارة يَحرَجُ القَتامُ لها ... يَهلِكُِ فيها المُناجِدُ البَطَلُ «7»
جرح: جَرحْتُه أجرَحُه جَرْحاً، واسمُه الجُرْح. والجِراحة: الواحدة من ضربة أو طعنةٍ. وجَوارح الإنسان: عواملُ جَسَده من يَدَيْه ورِجْلَيه، الواحدة: جارحة.
__________
(1) لم نجد البيت في الديوان (تحقيق محمد محمد حسين) .
(2) هو (رؤبة بن العجاج) ، الديوان ص 90
(3) ورواية الرجز في الديوان: (يذري) في مكان (يدني) في الرجز. و (هبلعا) بدون (أل) .
(4) لم نهتد إلى قائل البيت ولا إلى تمامه.
(5) هو الشاعر (لبيد) .
(6) وصدر البيت كما في الديوان ص 175:
قد تجاوزت وتحتي جسرة
(7) البيت في اللسان من غير عزو.
(3/77)
________________________________________
واجَتَرَح عَمَلاً: أي اكتسَبَ، قال:
وكلٌّ فتىً بما عملت يَداهُ ... وما اجتَرَحَتْ عوامِلُهُ رَهينُ «1»
والجَوارحُ: ذواتُ الصَيْد من السِباع والطَّيْر، الواحدة جارحة، قال الله تعالى: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ «2» .
رجح: رَجَحْتُ بيَدي شيئاً: وَزنته ونَظَرت ما ثِقْلُه. وأرجَحْتُ الميزان: أَثقَلْتُه حتى مال. ورجح الشيء رُجحاناً ورُجُوحاً. وأرجَحْتُ الرجلَ: أعطيته راجحاً. وحِلْمٌ راجح: يَرْجُحُ بصاحبه. وقَوْمٌ مراجيح في الحلم، الواحد مِرْجاحٌ ومِرْجَح، قال الأعشى:
من شَبابٍ تَراهُمُ غيرَ مِيلٍ ... وكُهُولاً مَراجحاً أحلاما «3»
وأراجيحُ البَعير: اهتِزازُه في رَتَكانه إذا مَشَى، قال:
على رَبِذٍ سَهْل الأراجيح مِرْجَم «4»
والفِعلُ من الأرجُوحة: الارتِجاح. والتَّرجُّح: التَذَبْذُب بينَ شَيْئَين.
باب الحاء والجيم واللام معهما ح ج ل، ل ح ج، ج ل ح، ح ل ج مستعملات
حجل: الحجل: القبج، الواحدة حَجَلةٌ. وحَجَلة العَروس تجمع على حجال
__________
(1) لم نهتد إلى قائل البيت.
(2) سورة المائدة 4
(3) كذا في التهذيب واللسان والديوان ص 249، وفي الأصول المخطوطة: أحكاما
(4) الرواية في التهذيب واللسان.
على ربذ سهو الأراجيح مرجم
(3/78)
________________________________________
وحَجَل، قال:
يا رُبَّ بيْضاءَ ألوفٍ للحَجَل
والحَجْل، مجزوم، مَشْيُ المُقيَّد. وحِجلاً القَيد: حَلْقَتاه. قال عديّ بن زيد:
أعاذلُ قد لاقَيْتُ ما يَزَعُ الفَتَى ... وطابقت في الحجلين مشي المُقيَّدِ «1»
وفلانٌ يَحْجِل: إذا رَفَعَ رجلاً وَيَثِبُ في مَشْيه على رِجْل، يقال: حَجَلَ. ونَزَوان الغُراب: حَجْله. والحِجْل: الخَلْخال، ويقال: الحَجْل أيضاً، قال النابغة:
على أنَّ حِجْلَيْها وإن قُلتُ أُوسِعا ... صَمُوتانِ من ملءٍ وقِلّةِ مَنطِق «2»
والتَحْجيل: بَياضٌ في قَوائِم الفَرَس، فَرَسٌ مُحَجَّل، وفَرَسٌ بادٍ حُجُولُه، قال: «3»
تَعالَوا فإِنَّ العِلْمَ عندَ ذَوي النُهَى ... من الناس كالبَلقْاء بادٍ حُجُولُها
والحَوْجَلةُ: من صِغار القَوارير ما وسعَ رأسُها، قال العجاج:
كأنَّ عَيْنَيهِ من الغئور ... قلتان أو حوجلتا قارور «4»
وحَجَل الإبلِ: أولادُها وحَشوها. وحَجَلتْ عينُه: غارَتْ، قال: «5»
__________
(1) ديوانه/ 103.
(2) ديوانه/ 184.
(3) هو (الأعشى) كما في اللسان (حجل) والتهذيب 4/ 145. والديوان ص 175.
(4) ديوانه ص 226، 227، والرواية فيه:
كأن عينيه من الغئور ... بعد الإني وعرق الغرور
قلتان في لحدي صفا منقور ... أذاك أم حوجلتا قارور
(5) في اللسان هو (ثعلبة بن عمرو) .
(3/79)
________________________________________
فتُصبحُ حاجلةً عينُه ... بحِنْو استه وصلاه عيوب
جحل: الجَحْل: ضرب من اليعسوب، والجمع جحِلان. غير الخليل: ضَبٌّ جَحُول إذا كان ضَخْماً كبيراً.
لحج: اللحَج: كَسر العين مثل اللَّخَص إلا أنّه من تحت ومن فوق. واللحجَ: الغَمَص نفسه. واللَّحْج، مجزُوم، المَيْلُولة «1» التَحجَوا إلى كذا. وأَلحَجَهُمْ فيه كذا: أَمالَهُم فيه، قال:
ويَلْتَحجُوا بَكْراً لدَى كلِّ مِذنَبِ «2»
قال العجاج:
أو تَلْحَجَ الألسُنُ فينا مَلْحَجا «3»
أي تقولُ فينا فتَميل إلى القَبْيحِ عن الحَسَن.
جلح: الجَلَحُ: ذَهابُ شَعْر مُقَدَّم الرأس، والنعتُ أجْلَحُ. والتَجليحُ: التَعميم في الأمر. وناقَةٌ مِجلاح: وهي المُجَلِّحة على السنة الشديدة في بقاءِ لَبَنٍها، والجميعُ: المَجاليح، قال:
شَدَّ الفَناءُ بمصباح مَجالحَه ... شَيْحانةٌ خُلِقَتْ خلق المصاعيب «4»
__________
(1) في اللسان: الميل.
(2) لم نهتد إليه.
(3) ديوانه/ 365. وقد نسب في اللسان إلى (رؤبة) .
(4) لم نجد هذا الشاهد في المظان المتيسرة لدينا.
(3/80)
________________________________________
والجالحةُ والجَوالحُ: ما تَطايَرَ من رءوس النَبات كالقُطْن من الريح ونحوه من نَسْج العنكبوت. وكالثلج إذا تَهافَتَ. والجَلْحاء: البَقَرةُ الذاهبُ قَرناها بأَخَرةٍ «1» . جُلاح: اسمُ أبي أُحَيْحَة، وكان سيِّدَ بني النَجّار وهو جَدّ عبد المطَّلب، كانت أمُّه سَلمَى بنتَ عَمْرو بنِ أُحَيْحَة. والمُجَلَّح: الكثير الأكل، ومنه قول ابن مقبل:
إذا اغبَرَّ العِضاهُ المُجَلَّحُ «2»
وهو الذي أُكِلَ فلم يُتْرَكْ منه شيءٌ.
حلج: والحَلْجُ: حَلْجُ القُطن بالمِحْلاج. والحَلْج في السَّيْر كقولك: بَيْننا وبينَهم حَلْجة صالحةٌ وحَلْجةٌ بعيدة «3» ، قال أبو النجم:
منه بعجز كصَفاةِ الحَيْجَل «4»
وفي الأصل: الحَيْلَج.
باب الحاء والجيم والنون معهما ح ج ن، ن ج ح، ج ح ن، ج ن ح مستعملات
حَجَنَ: المِحْجَنة والمِحْجَن «5» : عصا في طرفها عقافة. واحتجن الرجل: إذا
__________
(1) وجاء في التهذيب فيما نقله الأزهري عن الليث: والجلحاء من البقر التي تذهب قرناها أخرا.
(2) البيت في اللسان (جلح) وتمامه:
ألم تعلمي أن لا يذم فجاءتي ... دخيلي إذا اغبر العظاةالمجلح
(3) قال الأزهري: والذي سمعته من العرب: الخلج في السير بالخاء، ولا أنكر الحاء بهذا المعنى.
(4) لم نهتد إلى هذا الشاهد. في (س) : كصفاة الحيلج.
(5) كذا في اللسان، وفي الأصول المخطوطة: الحجن.
(3/81)
________________________________________
اختصَّ بشيءٍ «1» لنفسه دونَ أصحابه. والاحتجان أيضاً بالمِحْجَن. حَجَنته عنه: أي صَدَدْتُه، قال:
ولا بُدَّ للمشَعُوف من تَبَع الهَوَى ... إذا لم يَزَعْه من هَوَى النفس حاجنُ «2»
وغَزوةٌ حَجون: وهي التي تظهر غيرها ثمَّ تخالف إلى غير ذلك الموضع، [ويُقْصَدُ إليها] . يقال: غَزاهم غَزوةً حَجوناً، ويقال: هي البعيدة، قال الأعشى:
فتلك إذا الحَجونُ ثَنَى عليها ... عِطافَ الهَمِّ واختَلَطَ المَريدُ «3»
والحَجون: مَوضع بمكّة قال: «4»
فما أنتَ من أهل الحَجون ولا الصَفا
والحُجْنة: مَوضع أصابَه اعوِجاجٌ. والحَجَنُ: اعوجاجُ الشيء الأحجن. والصقر وما يشبهه من الطَّير أحْجَن المِنقار. ومن الأُنُوف أحجَن وهو ما أقبَلْتْ رَوثَتُه نحوَ الفَم فاستَأْخَرَتْ ناشزتاه قُبْحاً. وتكون الحُجْنةُ من الشَّعر: الذي جُعُودتُه في أطرافه.
نجح: النُجْح والنَجاح: من الظَّفَر [بالحوائج] . نَجَحَتْ حاجتُك وأنجَحْتُها لك. وسِرْتُ سَيراً نُجحاً وناجحاً ونجيحاً: أي وشيكاً، قال:
يَشُلُّهُنَّ قَرَباً نجيحا «5»
__________
(1) كذا في التهذيب واللسان وقد سقط من الأصول المخطوطة.
(2) البيت في اللسان (حجن) .
(3) ديوانه/ 325، والرواية فيه:
فتلك إذا الحجوز أبى عليه ...
(4) (الأعشى) ديوانه/ 123 وعجزه:
ولا لك حق الشرب في ماء زمزم.
(5) في (ط) : تشلهن بالتاء. والرجز في المحكم 3/ 63، وفي اللسان (نجح) ، والرواية فيهما: يغبقهن. غير منسوب أيضا.
(3/82)
________________________________________
يصف قرباً على طريق المصدر. ورأيٌ نَجيحٌ: صَوابٌ. وتناجحت أحلامه: إذ تَتابَعَت عليه رؤيا صِدقٍ. ونَجَحَ أمره: سَهُل ويَسَر.
جحن: جَيْحُونُ وجَيْحانُ: اسم نهر بالشام «1» . والجحن: السيىء الغِذاء، قال الشّماخ يذكُر ناقةً:
وقد عَرِقَتْ مَغاِبنُها وجادَتْ ... بدرَّتِها قِرَى جَحِنٍ قَتينِ «2»
أي قليلُ الطُّعْم.
جنح: جَنَحَ الطائرُ جُنُوحاً: أي كَسَرَ من جَناحَيْه ثم أقبل كالواقع اللاجىء إلى موضع. والرجُلُ يَجْنَحُ: إذا أقبَلَ على الشَيءِ يعَملُه بَيدَيْه وقد حَنَى إليه صدرهَ، قال: «3»
جُنُوحَ الهالكي على يديه ... مكبا يَجْتَلي نُقَبَ النِصال
وقال في جُنوح الطائر:
تَرَى الطَّيْرَ العتاق يَطَلْنَ منه ... جنوحا.... «4» ......
__________
(1) الذي بالشام هو جيحان، كما في معجم البلدان 2/ 196، أماجيحون فيجيء من موضع يقال له: ريوساران وهو جبل يتصل بناحية السند والهند وكابل. ولعل ترجمة (جيحون) سقطت من الأصول فاختلط الأمر واضطربت العبارة
(2) جاء في اللسان: قال (ابن سيده)
أراد قرادا جعله حجنا لسوء غذائه
، يعني أنها عرقت. فصار عرقها قرى للقراد. وهذا البيت ذكره (ابن بري) بمفرده في ترجمة (حجن) بالحاء قبل الجيم، قال: والحجن المرأة القليلة الطعم وأورد البيت. غير أن رواية العين (حجن) بالجيم قبل الحاء هي المعتمدة، فغد جاءت في مصادر معتبرة قديمة. جاء في المجهرة 2/ 59: والجحن: السيىء الغذاء. قال (الشماخ) :.. وأورد البيت. وتهذيب الألفاظ لابن السكيت ص 328، والمقاييس لابن فارس 1/ 430 والصحاح (جحن) والتهذيب 4/ 154، والمحكم 3/ 61.
(3) هو (لبيد) كما في التهذيب واللسان والديوان ص 78
(4) وتكملة العجز كما في التهذيب واللسان:.... إن سمعن له حسيسا
(3/83)
________________________________________
والسَفينةُ تجنَحُ جُنوحاً: إذا انتَهَتْ إلى الماءِ القليل فَلزِقَتْ بالأرض فلم تَمْض. واجتَنَحَ الرجُلُ على رِجْله في مَقْعَده: إذا انكَبَّ على يديه كالمتكىء على يَدٍ واحدة. وجَنَحَ الظَلامُ جُنُوحاً: إذا أقبَلَ الليل، والاسم: الجنح والجُنْح، لغتان، يقال: كأنُّه جنح اللَّيْل يُشَبَّهُ به العَسْكَرُ الجَرّار. وجَناحا الطائر: يداه. ويَدا الإنسان: جناحاه. وجَناحا العَسْكَر: جانِباه. وجَناحا الوادي: أنْ يكونَ له مَجْرى عن يَمينه وعن شمَالِه. وجَنَحَت الناقةُ: إذا كانَتْ باركةً فمالَتْ عن أحَدِ شِقَّيْها. وجَنَحَتِ الإبِل في السَّيْر: أسرَعَتْ، قال: «1»
والعيِسُ المَراسيلُ جُنَّحُ
وناقةٌ مُجَنَّحُة الجَنْبَيْن: أي واسعتها. وجَنَحْتُه عن وجهه جنحاً فاجتَنَحَ: أي أمَلْتُه فمالَ. واجْنَحْتُه فجَنَحَ: أمَلْتُه فمال، قال:
فإن تَنْأ لَيْلَى بعدَ قُرْبٍ ويَنْفَتِلْ ... بها مُجْنَحُ الأَيّام أو مُستقيمُها «2»
وجَوانِح الصدر: الأضلاع المتصلة رءوسها في وَسَط الزَّوْر، الواحدةُ جانحة.
حنج: يقال: حَنَجْتُه فاحتَنَجَ: أي أمَلْتُه فمالَ، وأحْنَجْتُه، لغة، قال العجاج:
فَتُحْمِلِ الأرواحَ حاجاً مُحْنَجاً ... إليَّ أعرِفْ وَجْهَها المُلَجْلَجا «3»
يَعني حاجةً ليسَتْ بواضحةٍ على وجهها ولكنَّها مُمالةُ المَعْنَى. والحَنْج: إمالة الشَيءِ عن وجهه. والمِحْنجة: شَيءٌ من الأدَوات.
__________
(1) هو (ذو الرمة) . ديوان 2/ 1215 وتمام البيت فيه:
إذا مات فوق الرحل أحييت نفسه ... بذكراك............... ......
(2) لم نهتد إلى نسبة البيت، وإن كان يتفق في الوزن والقافية مع قصيدة للمجنون في ديوانه.
(3) في الديوان ص 360: إلى أعرف وحيها الملجلجا.
(3/84)
________________________________________
باب الحاء والجيم والفاء معهما ح ج ف، ج ح ف، ف ح ج مستعملات
حجف: الحَجَفُ: [ضَرْبٌ من التِّرَسةِ] «1» مُقوِّرَةٌ من جُلُود الإبِل، الواحدة حَجَفة. والحُجاف: داءٌ يَعَتَري [الإنسان] من كَثرة الآكل أو من شَيءٍ لا يلائِمُه فيأخُذُ البطنَ استطلاقاً. وقيل: رجلٌ مَحْجُوف، قال: «2» .
والمُشتَكي من مَغْلة المحَجُوفِ
جحف: الجَحْفُ: شِبْهُ الجَرْف إلاّ أنّ الجَرْف للشيء الكثير والجحف للماء والكرة ونحوهما، تقول: اجتَحَفْنا ماءَ البئر إلاّ جُحفةً واحدة بالكَفِّ أو بالإناء. وتَجاحَفْنا الكُرَةَ بيننا بالصَوالِجة. وتَجاحَفْنا بالقِتال: تناول بعضُنا [بعضاً] بالعِصِيِّ والسُيُوف، قال العجاج:
وكانَ ما اهتَضَّ الجِحافُ بَهْرَجا «3»
اهتَضَّ: أي كَسَرَ، بَهْرَجاً: أي باطلاً، والجِحاف: مُزاحَمةُ الحرب. وسنة مُجْحفةٌ: تُجحفُ بالقَوم وَتْجَتحِفُ أموالَهم. ويقال: مَن آثَرَ الدُنْيا أجْحَفَتْ بآخِرتِه. والجُحْفةُ: «4» ميقات للإحرام.
فحج: الفَحَجُ: تَباعُدُ ما بينَ الساقَيْن في الإنسان والدابة، والنعْتُ: أفحَجُ وفَحْجاءُ، ويُقال «5» : لا فَجَحٌ فيها ولا صكك.
__________
(1) من التهذيب، وفي الأصول المخطوطة: ترس.
(2) هو (رؤبة) كما في اللسان وملحقات الديوان ص 178.
(3) ديوانه/ 383.
(4) في التهذيب: ميقات أهل الشام.
(5) من (س) . وسقطت من العبارة في (ص، ط) .
(3/85)
________________________________________
باب الحاء والجيم والباء معهما ح ج ب، ب ج ح، ج ب ح مستعملات
حجب: الحَجْب: كُلٌّ شيءٍ مَنَعَ شَيئاً من شيءٍ فقد حَجَبَه حَجْباً. والحِجابةُ: ولايَة الحاجب. والحِجابُ، اسمٌ،: ما حَجَبْتَ به شيئاً عن شيءٍ، ويجمع [على] : حُجُب. وجمع حاجب: حَجَبة. وحِجاب الجَوْف: جِلْدةٌ تَحْجُبُ بينَ الفُؤاد وسائر البطن. والحاجب: عظم العَيْن من فَوق يَستُرُه بشَعْره ولحمه. وحاجبُ الفيل: اسمُ شاعرٍ. ويُسَمَّى رءوس عظم الوَرِكَيْن وما يَلي الحَرْقَفَتَيْن حَجَبَتينِ وثلاث حَجَبات، وجمعهُ حَجَب، قال «1» :
ولم يُوَقَّعْ برُكُوبٍ حَجَبُهْ
حبج: أحْبَجَتْ لنا نارٌ وعَلَمٌ: أي بَدا بَغْتَةً، قال: «2»
عَلَوْتُ أقصاهُ إذا ما أحْبَجا
بجح: فلانٌ يَتَبَجَّحُ بفُلانٍ ويَتَمَجَّحُ به: أي يهذي به اعجاباً، وكذلك إذا [تَمَزَّحَ] «3» به. وَبَجَّحنَي فَبَجِحْتُ: أي فرَّحَني ففَرِحْتُ. وبَجِحْتُ وبَجَحْتُ لغتان، قال: «4»
ولكنّا بقرباك نبجح «5»
__________
(1) التهذيب 4/ 162 واللسان (حجب) غير منسوب أيضا.
(2) هو (العجاج) ديوانه/ 368 وفيه (أخشاه) في مكان أقصاه.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: تمدح.
(4) هو (الراعي) كما في التهذيب.
(5) وتمام البيت:
وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا ... إليك ولكنّا بقُرباكَ نَبْجَحُ.
(3/86)
________________________________________
جبح: جَبَحُوا بِكَعابهم: رَمَوا بها ليُنْظَرَ أيُّها يخرُجُ فائِزاً. والأُجْبُحُ «1» : مواضع النَّحْل في الجبل، الواحد جِبحْ، ويقال: هو الجَبَلُ، قال الطرماح: «2»
جَنَى النَحْل أضْحَى واتِناً بين أجبح
باب الحاء والجيم والميم معهما ح ج م، ج ح م، ج م ح، ح م ج، م ح ج مستعملات
حجم: الحِجامة: حِرْفُة الحاجِم وهو الحجّام، والحجم فعله. والمحجمة: قارورة. والمَحْجَم: مَوضعة من العُنُق. والحُجُومُ: اسمٌ للقُبل. والإِحجام: النُّكُوص عن الشّيء هَيبةً. والحِجام: شيءٌ يُجعل في خَطْم البَعير كي لا يعَضَّ، بَعيرٌ مَحْجُوم. والحَجْمُ: كفُّكُ إنساناً عن أمْرٍ يُريده. والحَجْم: وجدانُك شيئاً تحت ثَوْبٍ، تقول: مَسِسْتُ الحُبْلَى فوَجَدت حَجْمَ الصبَّيِّ في بَطْنها. وأحْجَمَ الثَدْيُ أي: نَهَدَ، قال: «3»
قد أحْجَمَ الثَدْيُ على نَحْرها ... في مُشرِقٍ ذي بَهجة نائر
جحم: الجَحيمُ: النّارُ الشديدة التَأَجُّج والالتِهاب، جَحَمَت تجحم جحوما.
__________
(1) في (ط) : والأجج: الجبل.
(2) ديوانه/ 102. وصدر البيت فيه:
وإن كنت عندي أنت أحلى من الجنى
(3) هو (الأعشى) كما في الديوان/ 139 والرواية فيه:
قد نهد الصدر على نهدها ... في مشرق ذي صبح نائر
(3/87)
________________________________________
وجاحِم الحرب: شدَّة القَتْل في معركتها، قال:
حتّى إذا ذات منها جاحِماً بَرَدا «1»
والحَجْمةُ: العَيْن بلغة حِمْيَر. قال: «2»
أيا جَحْمَتي بكي على أم واهب
وجَحْمَتا الأسَد: عَيناه بكلِّ لغة «3» . والأجحم: الشديدُ حُمرةِ العَيْن مع سَعَتها. والمرأةُ جَحْماءُ ونساءٌ جُحْمٌ وجَحْماواتٌ.
جمح: جَمَحَتِ السفينةُ جُمُوحاً: تَرَكَتْ قَصدَها فلم يَضبطْها المَلاّحُون. وجَمَح الفَرَسُ بصاحبه جِماحاً: إذا ذَهَبَ جَرْياً غالباً. وكلٌّ شيءٍ مَضَى لوجهِه على أمرٍ فقد جَمَحَ، قال:
إذا عَزَمْتُ على أمرٍ جَمَحتُ به ... لا كالذي صدَّ عنه ثُمَّ لم يَثُبِ «4»
وفَرَسٌ جَموحٌ: جامح، الذكَر والأُنثى في النَعتَيْن سواء. والجماح «5» و [الجميع] : الجَماميحُ: شِبْهُ سُنْبُلٍ في رءوس الحلي والصليان. وجمحموا بكِعابهم مثل جَبَحوا. والجُمّاح «6» : شيء يلعب به الصبيان، يأخذون ثلاث ريشات فيربطونها ويجعَلُون في وَسَطها تَمْرَةً أو عجيناً أو قِطعةَ طين فيرمونه فذلك
__________
(1) التهذيب 4/ 169، واللسان، والتاج (جحم) غير منسوب وغير تام أيضا.
(2) وفي اللسان (شنتر) : قال حميري يرثي امرأة أكلها الذئب. رواية البيت في التهذيب مع تمامه:
فيا جحمتا بكي على أم مالك ... أكيلة قليب ببعض المذانب
(3) وردد الأزهري ذلك في التهذيب 4/ 170 ناقلا عبارة (العين) . وفي اللسان (جحم) : لغة حمير، وقال ابن سيده: لغة أهل اليمن خاصة.
(4) اللسان (جمح) غير منسوب أيضا، وفيه، (لم ينب) بالنون في مكان (لم يثب) .
(5) في التهذيب من كلام الليث: الجماحة.
(6) في التهذيب 4/ 168: أبو عبيد عن الأموي: الجماح: ثمرة تجعل على رأس خشبة يلعب بها الصبيان. و (4/ 169) عن ثعلب عن ابن الأعرابي: الجماح: سهم يلعب به الصبيان.
(3/88)
________________________________________
الجُمّاح، قال: «1» عَبْداً كأنّ رأسَه جُمّاحْ وقال الحطيئة:
أخو المَرْء يُؤتَي دونَه ثُمَّ يُتَّقَى ... بزُبِّ اللِّحَى جُردِ الخُصَى كالجَمامِحِ
والجُمّاحةُ والجماميح: رءوس الحَليِّ والصِليِّان ونحو ذلك مِمّا يخرُجُ على أطرافه شِبْه سُنْبُل غيرَ أنّه كأذناب الثَعالب. والجِماح: موضع، قال الأعشى:
فكم بينَ رُحْبَى وبين الجماح ... أرضاً إذا قيسَ أميالُها «2»
حمج: وتَحميج العَيْنَيْن: إذا غارتَا، قال:
لقد تَقُودُ الخَيْلَ لم تُحَمِّجِ
أي لم تَغُرْ أعينُها. والتَحميج: النَظَرُ بخَوفٍ. ويقال: تَحميجُها هُزالُها. والتَحميجُ: تغُيُّر الوَجْه من [الغضب] «3» .
وفي الحديث: ما لي أراكَ مُحَمِّجاً.
محج: المَحْجُ: مَسْحُ شيءٍ عن شيءٍ. والرِيحُ تَمْحَجُ الأرضَ: أي تَذْهَبُ بالتُراب حتّى يتناولَ من أَدَمة الأرض تُرابَها «4» ، قال العجاج:
__________
(1) واللسان (جمح) : وروت العرب عن راجز من الجن زعموا وفيه: (هيق) في مكان (عبد) . للحكم 3/ 69
(2) رواية البيت في الديوان ص 165:
وكم دون أهلك من مهمه ... وأرض إذا قيس أميالها
(3) من عبارة العين في التهذيب 4/ 167 وهو الصواب.
(4) سقطت في الأصول المخطوطة، وهي في كلام الليث في التهذيب.
(3/89)
________________________________________
ومَحْجُ أرواحٍ يُبارينَ الصبَّا
ويُرْوَى: وسَحْجُ أرواحٍ «1»
مجح: التمَجُّح: «2» الاعجابُ بالشيء.
باب الحاء والصاد والشين معهما ش ح ص مستعمل فقط
شحص: الشَّحْصاء: الشاة التي لا لَبَنَ لها.
باب الحاء والشين والطاء معهما ش ح ط مستعمل فقط
شحط: الشَّحْطُ: البُعْدُ في الحالات كُلّها يُخَفَّف ويُثَقَّل. شَحَطَتْ دارُه تَشْحَطُ شُحُوطاً وشَحطاً. والشَحْطة: داءٌ يأخذ في صُدُور الإبِل لا تكادُ تنجُو منه. ويقال لأثَرِ سَحْج يُصيب جَنباً أو فَخِذاً ونحوه: أصابته شَحطةٌ. والشَّوْحَطُ: ضربٌ من النَّبْع. والمِشْحَطُ: عُوَيْدٌ يوضَع عند القضيب من قُضبان الكَرْم يقيه من الأرض.
__________
(1) وورد في اللسان (بيت العجاج) وكذا في ملحقات الديوان ص 73 وليس من إشارة إلى هذه الرواية.
(2) في التهذيب: قال غير واحدالتمجح والتبجح البذخ والفخر.
(3/90)
________________________________________
والتَشحُّطُ: الاضطِرابُ في الدم. والوَلَدُ يَتَشَحَّطُ في السَّلَى: أي يضطرِبُ فيه، قال النابغة:
ويَقْذِفْنَ بالأولادِ في كُلِّ مَنْزِلٍ ... تَشَحَّطُ في أَسلائِها كالوصَائِل «1»
يَعني بالوصائل البُرودُ الحُمْر.
باب الحاء والشين والدال معهما ح ش د، ش ح د يستعملان فقط
حشد: يقال: حَشَدوا أي خَفُّوا في التَعاوُن، وكذلك إذا دُعُوا فأَسْرَعُوا الإجابة، يستعمل في الجميع، قَلَّما يُقال: حَشَدَ، إلاّ أنَّهم يقولون للإبِل: لها حالِبٌ حاشدٌ أيْ لا يفتُرُ عن حَلْبها والقيام بذلك.
شحد «2» : الشَّوْحَدُ: الطَويل من النُّوق، قال الطرماح:
بفَتْلاءَ أمرار الذراعين شَوْدَحِ «3»
وهذا مقلوبٌ من شَوْحَد.
باب الحاء والشين والذال معهما ش ح ذ يستعمل فقط
شحذ: الشَّحْذُ: التَّحديد، شَحَذْت السِكِّينَ أشحَذهُ شَحْذاً فهو شحيذ ومشحوذ،
__________
(1) ديوانه/ 70.
(2) جاء في التهذيب من هذه المادة أشياء أخرى نسبها المصنف إلى الليث ولم يذكر الشوحد.
(3) ديوانه/ 116 (دمشق) والرواية فيه: بفتلاء ممران. وهذا الشاهد مما ذكره صاحب التهذيب في شدح التي أهملت في العين. وصدر البيت:
قطعت إلى معروفها منكراتها.
(3/91)
________________________________________
قال رؤبة:
يَشحَذُ لَحيَيْهِ بنابٍ أعْصَلِ «1»
والشَحَذانُ: الجائع
باب الحاء والشين والراء معهما ح ش ر، ش ح ر، ش ر ح، ر ش ح، ح ر ش مستعملات
حشر: الحَشْر: حَشْرُ يَومِ القِيامة [وقوله تعالى] : ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
«2» ، قيل: هو الموتُ. والمَحْشَرُ: المجمعُ الذي يُحشَرُ إليه القوم. ويقال: حَشَرتْهُم السَّنةُ: وذلك أنَّها تضُمُّهم من النَّواحي [إلى الأمصار] ، قال: «3»
وما نَجا من حَشْرها المَحْشُوش ... وَحْشٌ ولا طمْشٌ من الطُمُوش
قال غير الخليل: الحش والمحشوش واحد. والحَشَرة: ما كان من صِغار دَوابِّ الأرض مثل اليّرابيع والقَنافِذ والضبِّاب ونحوها. وهو اسمٌ جامعٌ لا يُفردَ منه الواحد إلاّ أن يقولوا هذا من الحشرة. قال الضرير: الجَرادُ والأرانِبُ والكَمْاة من الحَشَرة قد يكون دَوابَّ وغير ذلك. والحَشْوَر: كُلُّ مُلَزَّز الخَلْق. شديدةُ. والحَشْر من الآذانِ ومن قُذّذ السِهام ما لطُفَ كأنَّما بُرِيَ بَرْياً، قال: «4»
لها أذُنٌ حشر وذفرى أسيلة ... وخذ كمرآة الغريبة أسجح
__________
(1) ليس الرجز في ديوان رؤبة وهو في التهذيب 4/ 176 وفي اللسان (شحذ) غير منسوب.
(2) سورة الأنعام 38.
(3) هو (رؤبة بن العجاج) . والرجز في ديوانه ص 78.
(4) القائل (ذو الرمة) . والبيت في الديوان ص 2/ 1217.
(3/92)
________________________________________
وحَشَرْتُ السِنانَ فهو مَحْشُور: أي رَقَّقُته «1» وأَلْطَفْتُه.
شحر: الشِحْرُ: ساحِلُ اليَمَن في أقصاها، قال العجاج:
رَحَلْتُ من أقصَى بلاد الرُحَّلِ ... من قُلَل الشِحْرِ فجَنْبَيْ مَوْكِلِ «2»
ويقال: الشِحْر مَوضع بعُمان.
شرح: الشَّرْحُ: السَعَةُ، قال الله- عز وجل-: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ
«3» أي وسَّعَه فاتَّسَعَ لقَول الخير. والشَرْحُ: البَيان، اشرَحْ: أيْ بيِّنْ. والشَّرْحُ والتَشريحُ: قِطْعُ اللَّحم على العظام قَطْعاً، والقِطعة منه شَرْحةٌ.
رشح: رَشَحَ فلانٌ رَشْحاً: أي عَرِقَ. والرَشْحُ: اسمٌ للعَرَق. والمِرْشِحَةُ: بِطانةٌ تحت لِبْدِ السَّرْج لنَشْفِها العَرَق. والأُمُّ تُرشِّحُ وَلَدَها تَرشيحاً باللَّبَن القليل: أيْ تجعلُه في فَمِه شيئاً بعدَ شيءٍ حتى يقْوَى للمص. والترشيح أيضا: لحس الأُمِّ ما على طِفلها من النُدُوَّة، قال:
أُدْمُ «4» الظِباء تُرَشِّحُ الأطفالا
والراشِحُ والرَواشِحُ: جبال تَنْدَى فرُّبَما اجتَمَعَ في أصُولها ماء قليل وإنْ كَثُرَ سُمِّيَ واشِلاً. وإِنْ رأيتَه كالعَرَق يَجري خلالَ الحِجارة سُمِّيَ راشحا.
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة وفي نسخة من أصول التهذيب في سائرها: دققته.
(2) الرجز في الديوان (ط مصر) ص 46 والرواية فيه: بجنبي:
(3) سورة الزمر 39.
(4) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب 4/ 181 من العين واللسان (رشح) : أم الظبا ...
(3/93)
________________________________________
حرش: الحرش والتحريش: إغراؤك إنسانا بغيره. والأحرش من الدنانير ما فيه خشونة لجِدَّته، قال:
دنانيرُ حُرْشٌ كُلُّها ضَربُ واحِدٍ «1»
والضَبُّ أحرَشُ: خَشِنُ الجِلدِ كأنَّه مُحَزَّز. واحترشْتُ الضَبَّ وهو أن تحرشه في جحره فتُهيجَه فإذا خَرَجَ قريباً منك هَدَمْتَ عليه بقيَّةَ الجُحْر. ورُبَّما حارَشَ الضَبُّ الأفعَى: إذا أرادت أن تدخُل عليه قاتَلَها. والحَريشُ: دابَّةٌ لها مَخالِبُ كمخَالبِ الأسد ولها قرن واحد في وسط هامَتها، قال:
بها الحريشٌ وضِغْزٌ مائِلٌ ضَبِرٌ ... يَأوي إلى رَشَفٍ منها وتقليصِ «2»
والحَرْش: ضَرْبٌ من البَضْع وهي مُسْتَلْقِيةٌ.
باب الحاء والشين والنون معهما ح ش ن، ش ح ن، ش ن ح، ن ش ح، ح ن ش مستعملات
حشن: حَشِنَ السِقاءُ حَشَناً وأَحْشَنتُه أنا: إذا أكثَرْتُ استعماله بحَقْن اللَّبَن ولم يُغْسَل ففَسَدَتْ ريحه.
__________
(1) لم نهتد إلى نسبة الشطر.
(2) رواية البيت في التهذيب:
بها الحريشٌ وضِغْزٌ مائِلٌ ضئز ... يأوي إلى رشح منها وتقليص
واللسان (ضغز) :
ما يني ضئزا.... ... يأوي إلى رشف ...
(3/94)
________________________________________
شحن: شَحَنْتُ السَّفينةَ: مَلأَتها فهي مَشْحُونة. والشَحْناءُ: العَداوة، عَدُوٌّ مُشاحِن: يشحَنُ لك بالعَداوة «1» .
شنح: الشَناحيٌّ: نَعْتٌ للجَمَل في تَمام خَلْقه: قال «2» :
أعَدُّوا كلَّ يَعْمَلَةٍ ذَمُولٍ ... وأعْيَسَ بازلٍ قَطمٍ شَناحي
نشح: نَشَحَ الشاربُ: أي شَرِبَ حتّى امتَلأ، ويقالُ للَّذي يشرَبُ قليلاً قليلاً، قال: «3»
وقد نَشَحْنَ فلا رِيٌّ ولا هِيمُ
وسقاءٌ نَشّاح، أي: نَضّاح.
حنش: الحَنَشُ: من الحَرابيِّ وسَوامِّ أبرص ونحوه، تشبه رءوسه رءوس الحَيّات، وجمعُه أحناش، قال الشماخ:
تَرَى قِطَعاً من الأحناش فيه ... جَماجِمُهُن كالخَشَل النَزيعِ «4»
يَصفِها في الوَكْر.
__________
(1) في الأصول المخطوطة بعد كلمة (بالعداوة) : عبارة: والشيحان: الطويل لم نثبتها هنا، لأنها من معتل الحاء وسنثبتها في موضعها.
(2) كذا في التهذيب واللسان في الأصول المخطوطة: شناح. ولم نهتد إلى نسبة الشاهد.
(3) هو (ذو الرمة) . وصدر البيت:
فانصاعت الحقب لم تقصع صرائرها
انظر اللسان والديوان 1/ 453.
(4) البيت في التهذيب (حنش) واللسان (حنش وخشل) .
(3/95)
________________________________________
قال زائدة: الخشْل ما يُكْسَر من الحُلِيِّ، ونَزيعٌ ومَنْزُوع واحد.
باب الحاء والشين والفاء معهما ح ش ف، ش ح ف، ح ف ش، مستعملات
حشف: الحَشَفُ: ما لم يُنْوِ «1» من التَمْر، فإذا يَبِسَ صَلُبَ وفَسَدَ، لا طَعْمَ له ولا حَلاوة «2» . وقد أحشَفَ ضَرْعُ الناقة: إذا يَبِسَ وتَقَبَّضَ. والحَشيفُ: الثَوْبُ الخَلَق. والحَشَفةُ: ما فَوقَ الخِتان. والحَشَفُ: الضَرْعُ اليابسُ، قال طرفة:
فطَوراً به خَلْفَ الزَميل وتارةً ... على حَشَف كالشَّنِّ ذاوٍ مُجَدَّدِ «3»
فحش: الفُحْشُ: مَعرُوف، والفَحْشاءُ: اسمٌ للفاحِشة. وأفحَشَ في القَوْل والعَمَل وكلِّ أمر: لم يُوافقِ الحَقَّ فهو فاحِشةٌ. وقوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ*
«4» ، يَعني خُروجَها من بَيْتها بغير إِذْنِ زوجها المُطَلِّقها.
حفش: الحِفْش: ما كانَ من الآنِية مِمّا يكون أوعية في البَيت للطِيب ونَحوهِ، وقَواريرُ الطيب أحفاش. والسَّيْل يحفِش الماءَ حَفْشاً من كُلِّ جانب إلى مُستَنْقِعٍ واحدٍ فتلك المسايلُ التي [تَنَصبُّ «5» ] إلى المسيل الأعظَمِ من الحوافِش، الواحدة حافِشة، قال:
__________
(1) في (ط) : ينق وهو تصحيف.
(2) زاد في التهذيب واللسان: ولا لحاء. وهو كلام (الليث) .
(3) البيت من مطولة (طرفة) ديوانه/ 13.
(4) سورة النساء 19
(5) كذا في التهذيب من كلام (الليث) ، وفي الأصول المخطوطة: التي تنسب إلى المسايل
(3/96)
________________________________________
عَشيَّةَ رُحْنا وراحُوا إلينا ... كما مَلأَ الحافِشات المَسيلا «1»
وقال مرار بن منقذ:
يَرجِعُ الشَدُّ على الشَدِّ كما ... حفش الوابل غيث مُسْبَكِرّ «2»
وحَفَش: أي طَرَدَ فأسرَعَ، يصف الفَرَس. والحِفْشُ: البيتُ الصَغير أيضاً. والحَفْش: الجَريُ. وهُم يحفِشُون عليك ويجلُبون: أي يجتمعُون. والفَرَسُ يحفِشُ الجَرْيَ: أي يُعقِبُ جَرْياً بعدَ جَرْي فلا يزدادُ إلا جَودة.
باب الحاء والشين والباء معهما ح ش ب، ش ح ب، ح ب ش، ش ب ح، مستعملات
حشب: الحَوْشَبُ: عظمٌ في باطِن الحافِر بينَ العَصَب والوَظيف. والحَوْشَبُ: العظيم البطن، قال الأعلم الهذلي:
وتجُرُّ مُجرِيةٌ لها ... لَحمي إلى أجرٍ حَواشِبْ «3»
وقال العَجّاج في الوَظيف:
في رُسُغٍ لا يَتَشَكَّى الحَوْشَبا «4»
الحَوْشَب: من أسماء الرجال.
__________
(1) البيت في اللسان (حفش) غير منسوب أيضا.
(2) لم نهتد إلى البيت في المظان التي بين أيدينا.
(3) كذا في التهذيب وديوان الهذليين 2/ 80، وفي الأصول المخطوطة:
وتجر أجريه لها ... تحمي إلى أجر حواشب
(4) كذا في التهذيب، وفي الأصول المخطوطة: حوشبا وليس الرجز في ديوان العجاج (ط بيروت) .
(3/97)
________________________________________
شحب: شَحَبَ يَشحَبُ شُحوباً: أي تَغَيَّر من سَفَرٍ أو هُزال أو عَمَل، قال:
فإنّ كِرامَ الناس بادٍ شُحُوبُها «1»
حبش: الحَبَشُ: جنْس من السُودان، وهم الحبشان والحبش، و [في] لغة يقولون: الحَبَشِة على بناء سَفَرة، وهذا خطأ في القياس لأنّك لا تقول حابش كما تقول: فاسق وفَسَقة، ولكنّه سارَ في اللَّغات وهو في اضطِرار الشعر جائز. والأُحُبوش كالحَبَش، قال: «2»
كأنَّ صِيران المَهَا الأخلاطِ ... بالرَّمْل أُحبُوشٌ من الأنباطِ
وأما الأحابيش فكانوا أحياءَ من القارَة انضَمُّوا إلى بني ليث في الحَرْب التي وقَعَت بينهم وبينَ قُرَيش قبلَ الإسلام فيها يقول إبليس لقريش: إني جارٌ لكم من بني كبْت فواقِعوا محمداً، أتاهم في صورة سُراقة بن مالك بن جَعْثم، وذلك حيث يقول الشاعر:
لَيْثٌ ودِيِلٌ وكعبٌ والتي ظَأَرَتْ ... جُمْعَ الأحابيشِ لمّا احمَرَّتِ الحَدَقُ
سُمُّوا بذلك لتَجَمُّعِهم فلمّا صارَ لهم ذلك الاسمُ صارَ التَحبيش في الكلام كالتجميع، قال رؤبة «3» :
أولاك حَبَّشتُ لهم تجبيشي ... فَرضي وما جَمَّعْت من خُروشي
والحُبْشّيُة: ضَرْبٌ من النَّمْل سُودٌ عِظامٌ، لمّا جَعَلوا ذلك اسماً غيَّروا اللفظ
__________
(1) سقطت (فإن) من (ط) . ولم نهتد إلى القائل ولا إلى تمام البيت.
(2) هو (العجاج) كما في التهذيب واللسان والديوان ص 247.
(3) القائل هو (رؤبة) كما في التهذيب واللسان، أما في الأصول المخطوطة فهو (العجاج) . والرجز في ديوان رؤبة ص 78 وروايته:
أولاك حفشت لهم تحفيشي
(3/98)
________________________________________
ليكونَ فَرقاً بين النسبةِ والاسمِ. النِسبةُ: حبَشيَّة، والاسم: حبُشْيّة. وعلى هذا أيضاً الحُبْشيّة: ناقةٌ شديدة السَواد.
شبح: الشَبَحُ: ما بَدا لكَ شَخصُه من الخلق، يقال: شَبَحَ لنا أي مَثَلَ، وجمعهُ: أشباح، قال:
رمقت بعيني كل شبح وحائِلِ «1»
وقال:
كأنَّما الرَحْلُ منها فوقَ ذي جُدَدٍ ... ذبِّ الريادِ إلى الأشباح نَظّارِ «2»
أي كثير الرِياد وهو الاقبال والادِبار في الرَعْيِ. ويقال في التصريف أسماءُ الأشباح وهو ما [أدرَكَتْهُ] «3» الرُؤيةُ والحِسُّ، وأسماء الأعمال: ما لا تدركه الرؤيةُ ولا الحِس. والشَبْحُ: مَدُّك الشَيءَ بينَ أوتاد ليَجِفَّ. والمضُروبُ يُشّبُح إذا مُدَّ للجَلْد. ورجُلٌ مَشبُوح الذِراعَيْن: أي طويلُهما، قال أبو ذؤيب:
فذلك مَشبُوحُ الذراعَيْن خَلْجَمٌ ... خَشُوفٌ إذا ما الحَرْبُ طالَ مِرارُها «4»
باب الحاء والشين والميم معهما ح ش م، ش ح م، ح م ش، م ح ش مستعملات
حشم: الحَشَمُ: خَدَمُ الرجل ومَن دونَ أهلِه من وَلَدِه وعِياله. والحِشمةُ: الانقباض عن أخيك في المَطْعَم وطَلَب الحاجة، تقول: احتَشَمْتُ، وما الذي
__________
(1) في التهذيب 4/ 191 واللسان (شج) .
(2) (النابغة) ديوانه/ 236. وفيه: (الزياد) بالزاي وهو تصحيف. واللسان (ذبب) .
(3) مما نقل في التهذيب 4/ 192 عن العين في الأصول: أدركت.
(4) البيت في شرح أشعار الهذليين 1/ 82) .
(3/99)
________________________________________
حَشَمَكَ وأحشَمَكَ أيضاً. والحُشُومُ: الإِقبال بعدَ الهُزال، حَشَمَ يحشِمُ، ورجلٌ حاشِم، وقد حَشَمتِ الدَّوابُّ في أوَّل الربيع وذلك إذا أصابت شيئاً فحَسُنَتْ بطُونُها وعَظُمَت.
شحم: رجلٌ شاحِمٌ لاحم: إذا أطعَمَ الناسَ الشَّحْمَ واللحم. وقد شَحَمَهُم يَشْحَمُهُم شَحْماً. وشَحْمةُ الرُمّانة: هَنَةٌ في جَوْفها تَفْصِلُ بين حَبّها، وإذا غَلُظَت قلتَ رُمّانة شَحِمةٌ. وعَنِبٌ شَحِمٌ: قليلُ الماء صُلْبُ اللِّحاء. وشَحْمةُ الأُذن: لَحْمةُ مُتَعَلَّق القُرْطِ من أسفَلَ.
حمش: الحَمْشُ: الدَّقيقُ القوائِمِ. وساقٌ حَمْشةٌ، جزم، وتجمَع [على] : حُمْش وحِماش، قال الطرماح يصف الدِيَكةَ:
حِماشُ الشَّوَى يَصْدَحْنَ من كُلِّ مَصْدَح «1» .
أيْ: من كل وجه. والاستِحماش في الوَتَر أحسَنُ، يقال: أوتارٌ حَمْشةٌ، ووَتَرٌ حَمْشٌ: مُسَتْحِمش، قال: «2»
كأنَّما ضُرِبَت قُدّامَ أعيُنِها ... قُطْنٌ بِمُسْتَحِمشِ الأوتارِ مَحْلُوجُ
واستَحْمَشَ الرجُلُ: اشتَدَّ غضَبُه.
محش: المَحْشُ: تناولٌ من لَهَبٍْ يُحرِق الجلدَ ويُبدي العظمَ، يقال محشته النار محشا.
__________
(1) وصدر البيت في الديوان ص 99:
إذا صاح لم يخذل وجاوب صوته
،
(2) البيت (لذي الرمة) . انظر الديوان 2/ 995. والرواية فيه: عهنا بمستحصد.
(3/100)
________________________________________
باب الحاء والضاد والدال معهما د ح ض مستعمل فقط
دحض: الدَّحْضُ: الزَلَقُ، يقال: مَزْلَقَةٌ مِدحاضٌ. والدَّحْضُ: الماءُ الذي تكون منه المزْلَقَةُ. ودَحَضَتِ الشَمس عن بطن السَماءِ، أي: زالت. ودَحَضَت حُجَّتُه: أي: بَطَلَتْ. ودُحَيْضة: موضع، قال: «1»
َأَتْنَسْيَن أيّاماً لنا بدُحَيْضةٍ ... وأيّامَنا بينَ البَديِّ فَثَهْمَدِ
البدي: بئر لحمى ضرية لبني جعفر بن كلاب. ودَحَضَتْ رِجْلُ البعير: زَلَقَت.
باب الحاء والضاء والظاء معهما ح ض ظ مستعمل فقط
حضظ: الحُضَظ لغة في الحُضَض: [دواءٌ يتخذ من أبوال الإبل] «2» .
باب الحاء والضاد والراء معهما ح ض ر، ر ح ض، ح ر ض، ض ر ح، ر ض ح مستعملات
حضر: الحَضَرُ: خلافُ البَدْو، والحاضِرة خلاف البادية لأن أهل الحاضرة
__________
(1) هو (الأعشى) ، ديوانه/ 189، وانظر اللسان (دحض) .
(2) من مختصر العين (ورقة 65) ، وجاء في التهذيب من كلام الليث: الحُضَظ لغة في الحُضَض وهو دواء يتخذ من أبوال الإبل.
(3/101)
________________________________________
حَضَروا الأمصارَ والديار. والباديةُ يُشبِهُ أنْ يكونَ اشتِقاق اسمه من: بدا يبدو أى بَرَزَ وظَهَرَ، ولكنّه اسم لزم ذلك الموضع خاصَّةً دونَ ما سِواه، [والحَضْرَةُ: قرب الشَّيء] «1» . تقول: كنت بحَضرةِ الدار، قال:
فشَلَّتْ يَداهُ يومَ يحمِلُ رأسَه «2» ... إلى نَهشَل «3» والقَومُ حَضرةَ نَهْشَلِ
وضَرَبُته بحَضْرَة فلانٍ، وبمَحْضَره أحسَنُ في هذا. والحاضِرُ: هُمُ الحَيُّ إذا حَضَروا الدارَ التي بها مُجتَمَعهُم فصارَ الحاضر اسماً جامعاً كالحاجِّ والسامِرِ ونحوِهما، قال:
في حاضِرٍ لَجِبٍ باللَّيْلِ سامرُه ... فيه الصواهل والرايات والعَكَرُ «4»
والحُضْر والحِضار: من عَدْوِ الدابَّة، والفعل: الإحضار. وفَرَسٌ مِحضير بمعنى مِحضار غيرَ أنّه لا يقالُ إلا بالياء وهو من نَوادر كلام العرب، قال امرؤ القيس:
استلحم الوحش على أحشائها ... أهوَجُ مِحضيرٌ إذا النقْعُ دَخَنْ «5»
والحضيرُ: ما اجتَمَعَ من [جائية] «6» المِدَّةِ «7» في الجُرْح، وما اجتَمَعَ من السُّخد في السَّلا ونحوه. والمُحاضرةُ: أنْ يُحاضِرَك إنسان بحَقّكَ فيذهَب به مُغالَبةً ومُكابَرةٌ. والحِضار: اسم جامع للإبِلِ البِيض كالهِجان، الواحدةُ والجميع في الحضار سَواءٌ. وتقول: حَضارِ. أي: احضَرْ مثلُ نَزالِ بمعنَى انزل. وتقول: حضرت
__________
(1) من التهذيب 4/ 200 عن العين.
(2) كذا في الأصول المخطوطة والتهذيب وفي اللسان: راية.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي (ط) : فشل.
(4) البيت في التهذيب واللسان فيما نقله صاحب التهذيب عن (الليث) .
(5) ليس البيت في الديوان ولكنه غير منسوب في اللسان والتاج (دخن) .
(6) من المحكم 3/ 87 والجائية: الغليظة، وفي التهذيب 4/ 200: جايئة. وفي الأصول المخطوطة: جانبه.
(7) في اللسان المادة.
(3/102)
________________________________________
الصَّلاةُ، لغة أهل المدينة، بمعنى حَضَرت، وكلهم يقولون: تَحضُر. وحَضارِ: اسم كوكب معروف، مجرورٌ أبداً. وحَضْرَمَوْت: اسمان جُعِلا اسماً واحداً ثم سُمِّيَت به تلك الَبْلَدة، ونظيرهُ: أحمرجون «1» .
رحض: ثَوبٌ رَحيضٌ ومَرْحُوضٌ: أي: مَغسُول. والرحْضُ: الغَسْل.
وقالتْ عائشة في عُثمانَ: استَتابوه حتى إذا تَرَكوه كالثَوْبِ الرَّحيض أحالوا عليه فقَتَلُوه «2» .
والمِرْحَضةُ: شيءٌ يُتَوَضَّأ فيه مثل كنيف وكذلك المِرحاضُ وهو المُغَتسَل. والرُحَضاء: عَرَق الحُمَّى، رُحِض الرجُلُ أخَذَتْهُ الرُحَضاءُ.
حرض: التَحريضٌ: التَحضيضُ. والحُرضُ، (مثقل) ، الأشْنان، والمِحْرَضةُ: وِعاؤه. وقوله تعالى: حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً «3» أي مُحْرَضاً يُذيبك الهَمُّ، وهو المُشرِف حتى يكاد يَهلِك. رجلٌ حَرَضٌ ورجالٌ أحراض. والحَرَضُ: الذي لا خير فيه لؤماً ودقّةً من كلّ شيءٍ. [والفِعل منه «4» : حَرُضَ يحرُضُ حُروضاً. وناقةٌ حَرَضٌ وإبِلٌ أحراض: وهو الضاوي الرديءُ.
ضرح: الضَرْحُ: حَفرُكَ الضَريحَ للميِّت وهو قَبْرٌ بلا لَحْدٍ، ضَرَّحْتُ له. والضَرْحُ: الرَمْيُ بالشيْءِ. واضطَرُحوا فلاناً: إذا رَمَوا به، والعامَّةُ تقول: اطَّرَحُوه، يظُنُّونَ أنَّه من الطَرْح وإنّما هو من الضَرْح، قال:
ضرحاً بصليات النُسور نحتبي «5»
__________
(1) لم نجده في المظان التي بين أيدينا.
(2) التهذيب 4/ 203.
(3) سورة يوسف 85
(4) من اللسان (حرض) ، لتوضيح العبارة.
(5) كذا في الأصول المخطوطة، ولم نهتد إلى هذا الرجز ولم نتبينه.
(3/103)
________________________________________
ويقال: الضَرْحُ الرُمْح. والضرُّاح بيت في السَّماء. والمَضْرَحيُّ من الصِقُوُر: ما طالَ جناحاه، قال طرفة:
كأنَّ جَناحَي مَضْرحَيٍّ تَكَنَّفا «1»
ويقال للرجل السيد السَريِّ: مَضْرَحيّ. ويقال المَضْرَحّي. ويقال المَضْرَحِيُّ: الأبيضُ من كلّ شَيءٍ.
رضح: الرَضْحُ: رَضْحُك النَّوَي بالمِرْضاح أي: بالحَجَر، والخاء لغة قليلة.
باب الحاء والضاد واللام معهما ض ح ل، ح ض ل يستعملان فقط
ضحل: الضَّحْل: الماءُ القريبُ القَعْر. والضَّحْضاحُ: أعَمُّ منه قلَّ أو كثر. وأتان الضحل: الصَّخْرة بعضُها غامِرٌ وبعضُها ظاهر. والمَضْحَل: مكان يقِلُّ فيه الماء من الضَّحْل، وبه يُشَبَّه السَّراب، قال: «2»
حسِبتُ يَوماً غيرَ قَرٍّ شاملاً ... يَنسُجُ غُدراناً على مَضاحِلاً
حضل: حَضِلَتِ النخْلةُ: أي فَسَدَ أصولُ سعفها، و [حظلت] «3» أيضاً. وصَلاحُها: إشعالُ نارٍ فيها حتّى يحترقَ ما فَسَدَ من ليفها وسَعَفها ثم تجود بعد ذلك.
__________
(1) وعجز البيت كما في التهذيب واللسان والديوان:
حفافية شكا في العسيب بمسرد
(2) هو (رؤبة بن العجاج) . انظر الديوان ص 121 ونسب غلطا إلى (العجاج) في اللسان.
(3) كذا في التهذيب 4/ 209 واللسان (حضل) ، وفي الأصول المخطوطة: حضلت.
(3/104)
________________________________________
باب الحاء والضاد والنون معهما ح ض ن، ن ض ح، ن ح ض، ض ح ن مستعملات
حضن: الحِضْن: ما دونَ الإبْط إلى الكَشْح، ومنه احتضانك الشَيءَ وهو احتمالُكَهُ وحَمْلكَهُ في حضنِك كما تَحْتَضِنُ المرأة ولدها فتحمله في أحد شِقَّيْها. والمُحْتَضَنُ: الحِضْن، قال: «1»
هَضيمُ الحَشَا شَخْتَةُ المُحتَضَنْ «2»
والحَضانةُ: مصدر الحاضِنة والحاضِن وهما اللذان يُربِّيان الصَبيِّ. وناحِيَتا المَفازةِ: حِضناها، قال:
أجَزْتُ حِضْنَيه هِبَلاًّ وعثا «3»
وعَنْزٌ حَضون: أَيْ أحَد طُبْيَيْها أطوَلُ. والحَمامةُ تَحتضِنُ بَيْضَها حُضُوناً للتفريخ فهي حاضِنٌ. وسُقْعٌ حَواضِنُ: أي جَواثِمُ، قال النابغة:
رَمادٌ مَحَتْة الريحُ من كُلِّ وِجْهةٍ ... وسُفْعٌ على ما بَيْنَهُنَّ حَواضِنُ «4»
أي أثافيُّ [جَواثم] على الرَماد. وحَضَنْتْ الرجل عن الشيء: اختَزَلتُه ومَنَعْتُه، قال ابن مسعُود: لا تُحضَنُ زَيْنَبُ امرأةُ عبدِ الله «5» أي لا تُحجَب عنه ولا يُقْطَعُ أمرٌ دونها. وفُلانٌ احتَجَنَ بأمرٍ دُوني وأحضَنني: أي أخَرجَني منه في ناحيةٍ. وقالت الأنصار لأبي بَكْر: تُريدونَ أن تَحضُنونا «6» من هذا الأمر.
__________
(1) هو (الأعشى) كما في التهذيب واللسان والديوان ص 17.
(2) وصدر البيت:
عريضة بوص إذا أدبرت.
(3) ورواية الرجز في المحكم 3/ 91، واللسان:
أجزت حضنيها هبلا وغما
. وروايته في التهذيب 4/ 209
أَجَزْتُ حِضْنَيْهِ هِبَلاً وَغْبا.
(4) لم نجد البيت في ديوان الشاعر في مختلف طبعاته المتيسرة. وهو في التهذيب 4/ 210، واللسان (حصنن) منسوب إلى (النابغة) أيضا.
(5) الفائق 1/ 291. وفي التهذيب 4/ 210: ولاتحضن زينب امرأته عن ذلك.
(6) كذا في التهذيب 4/ 210، وفي (س) أيضا. وفي ط: تحضونها، وفي (ص) : تحضوننا.
(3/105)
________________________________________
والمِحْضَنة: المعمُولةُ من الطيِن للحمامة كالقصعة الرَّوْحاء. والمَحاضِن: المَواضِع التي تحضُنُ فيها الحمامة على بَيْضها، واحدُها مَحضَن. والأعنُز الحَضَينات: ضَربٌ منها شَديَدة الحُمْرة، وأسوَدُ منها شَديدُ السَواد. والحَضَن: جَبَل، قال الأعشى:
كخلْقاء من هَضبَات الحَضَنْ «1»
نضح: النضح: كالنضح رُبَّما اختَلَفا ورُبَّما اتَّفَقا. ويقال: النَّضخ ما بَقِيَ له أَثَرَ، يقال: على ثَوبه نَضْخُ دَمٍ. والعَيْن تَنْضَح بالماء نَضْحاً: أي تفور [وتنضخ] أيضاً. والرجُلُ يعتَرفُ بأمرٍ فيَنْتَضِحُ منه: إذا أظهَرَ البَراءةَ وبَرَّاً نفسَه منه جُهْدَه. والنَضيحُ من الحِياض: ما قرُبُ من البِئر حتّى يكونَ الافِراغ فيه من الدَلْوِ ويكونَ عظيماً، قال: «2»
فغَدَونا علَيهِمُ بُكرةَ الورد ... كما تورِدُ النَضيحَ الهِياما
والناضِحُ: جَمَلٌ يُسْتَقَى عليه الماء للقِرَى في الحَوض، أو سِقيْ أرضٍ وجَمعُه النَواضِح. والفَرَس يَنْضَحُ: أي يعْرَقُ، قال: «3»
كأنَّ عِطْفَيْه من التَنْضاحِ ... بالماء ثوباً مُنْهِلٍ مَيّاحِ
أي مُستَقٍ بيَده. والجَرَّة تنضَحُ بالماء: يخرُج الماء من الخَزَف لرِقَّتِها. والجَبَل يَنْضَحُ: إذا تَحَلَّبَ الماءُ من بين صُخُوره. ويقال في القتال: نضحوهم
__________
(1) البيت في الديوان (الصبح المنير) ص 16 وروايته:
وطال السنام على جبلة ... كخلقاء من هضبات الضحن
وفي حاشية صفحة الديوان: وروى غيره الحضن (بفتحتين) والحضن (بضم ففتح) . وقال (أبو عبيدة) : من هضبات الضحن. وفي الديوان (ط مصر) ص 19 ولكن الرواية فيه: من هضبات الدجن.
(2) هو (الأعشى) . انظر التهذيب واللسان والديوان ص 249، وفيه: بكر الورد
(3) هو (العجاج) . والرجز في الديوان ص 442.
(3/106)
________________________________________
بالنُّشّاب ورَضِّحوهم بالحِجارة. واستَنْضَحَ الرجلُ: أي رَشَّ شيئاً من الماء على فَرْجه بعد الوضوء. وإذا ابتَدَأَ الدقيق في حَبِّ السُنْبُل وهو رَطْبٌ قيلَ: قد أنْضَحَ ونَضَحَ «1» ، لغتان. والنَّضُوحُ: الطِيبُ.
نحض: النَحْضُ: اللَّحْم نفسُه، والقطعةُ الضَخْمةُ تُسَمَّى نَحْضَة. ورجُلٌ نَحيضٌ، وامرأةٌ نَحيضةٌ: كثيرة اللَّحْم. وقد نَحُضَ نَحاضةً، فإذا قُلتَ: نُحِضَتْ فقد ذَهَبَ لحمُها فهي مَنحُوضةٌ ونَحيضٌ. ونحضتُ السِنان رَقَّقْتُه، قال حميد:
كَمَوقِف الأشقَرِ إنْ تَقَدَّما ... باشَرَ مَنحُوضَ السِنانِ لَهْذَما
والموتُ من وَرائه ان أحجَما «2»
ضحن: الضَّحَنُ: اسم بَلَد.
باب الحاء والضاد والفاء معهما ف ض ح، ح ف ض يستعملان فقط
فضح: والاسم: الفضيحة: ويجمَع الفضائح. والفَضْح فِعلٌ مُجاوز من الفاضِح إلى المفضُوح، قال في الفضائح:
قَومٌ إذا ما رَهِبوا الفضائحا ... على النساء لبسوا الصفائحا «3»
__________
(1) في (ط) : أنضح (وأنطح) وهو تصحيف.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي هذه المصادر كلها ورد اسم الراجز حميد، ونرجح أن يكون حميد الأرقط لا حميد بن ثور الهلالي، لأن الأول راجز معروف والثاني شاعر لم يشتهر بالرجز.
(3) الرجز في التهذيب 4/ 215 نقلا عن العين، ثم في اللسان (فضح) .
(3/107)
________________________________________
وقال الأعشى:
لأَمُكُّ َبالهِجاء أحَقُّ مِنّا ... لِما أَوْلتْكَ من شَوط الفِضاح «1»
الشَوط: المُجازاة. يقال للمُفتَضِح: يا فَضُوح. وأفضَحَ البُسْرُ: إذا بَدَتْ فيه الحُمرة. والفُضْحةُ: غبرة في طُحْلة «2» يُخالِطُها لونٌ قَبيحٌ يكونُ في ألوان الإبِل والحمام، والنَعْتُ أفضَحُ. قد فَضِحَ فَضَحاً.
حفض: الحَفَض: القَعود نفسُه بما عليه، ويقال: بل الحَفَضُ كلُّ جُوالَقٍ فيه مَتاع القَوم ويُحْتَجُّ بقوله: «3»
على الأحفاضِ نَمنَعُ من يَلينا
ويقال: الأحفاضُ في هذا البَيت صِغارُ الإبِل أوَّلَ ما تُرْكَبُ، وكانوا يُكِنُّونها في البيت من البَرْد، قال:
بملقى بُيُوتٍ عُطِّلَتْ بحِفاضِها ... وإنَّ سَوادَ اللَّيل شُدَّ على مُهْر «4»
ويقال: الأحفاض عند الأخبية. ومَثَلٌ من الأمثال: يَومٌ بيوم الحفض المجور «5» .
__________
(1) ورواية البيت في الديوان ص 345.
لأَمُكُّ َبالهِجاء أحَقُّ مِنّا ... لما أبلتك من شوط الفضاح
في (س) : لأنك وهو تصحيف.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: ظلمة.
(3) هو (عمرو بن كلثوم) ، وصدر البيت:
ونحن إذا عماد البيت خرت
انظر اللسان والمعلقات ص 125
(4) لم نهتد إلى الشاهد.
(5) كذا في التهذيب واللسان (حفض) ، وفي (ط) : المجود. والمثل في مجمع الأمثال 2/ 310 وفيه: وأصل المثل كما ذكره أبو حاتم في كتاب الإبل أن رجلا كان له عم قد كبر وشاخ، وكان ابن أخيه لا يزال يدخل بيت ابن عمه ويطرح متاعه بعضه على بعض، فلما كبر أدركه بنو أخ أو بنو أخوات له، فكانوا يفعلون به ما كان يفعله بعمه. فقال: يوم بيوم الحفض المجور. أي هذا بما فعلت أنا بعمي فذهبت مثلا.
(3/108)
________________________________________
باب الحاء والضاد والباء معهما ح ض ب، ض ب ح، ح ب ض، ب ح ض، مستعملات
حضب: الحَضَب والحصب واحد، وقرىء: حَضَبُ جَهَنَّم، قال الأعشى:
فلا تَكُ في حَرْبِنا مِحْضَباً ... لتجعَلَ قَومَك شَتَّى شُعوبا «1»
أيْ موقِداً.
ضبح: ضَبَحْتُ العُودَ بالنار: إذا أحرقت من أعاليه شيئاً، وكذلك حِجارة القَدّاحة إذا طَلَعَتْ كأنَّها محترقة: مَضبُوحة، قال طرفة:
واصفَرَ مَضبْوُحٍ نَظَرتُ حوارهَ ... إلى النارِ واستَوْدَعتُه كفَّ مُجْمِدِ «2»
أي بَخيلُ يُريدُ المَضْبُوحَ بالنار. يقال: كلُّ شيءٍ مَسَّتْه النارُ فقد ضَبَحَتْه. والضبُّاح: صَوْتُ الثَعلَب. والهامُ يَضْبَحُ، قال الشاعر:
من ضابح الهامِ وبُومٍ نُوَّمٍ «3»
الأُرجوزة للعَجّاج، وقال ذو الرمة:
سَباريت يخلُو سَمْعُ مُجتاز رَكْبها «4» ... من الصَوتٍ إلاّ من ضباح الثعالب
__________
(1) البيت في اللسان (شعب) ، وفي ملحقات الديوان (ط أوروبا) ص 236 (عن التهذيب) .
(2) لم نجد البيت في ديوان طرفة. وهو في اللسان (ضج) غير منسوب.
(3) الرجز في التهذيب واللسان وروايته فيهما:
من ضابح الهامِ وبُومٍ بوام
(كذا) . ولا يستقيم الرجز. ولم نجد الرجز في ديوان العجاج (ط. دمشق) ولكن محقق التهذيب أشار إلى ملحقات الديوان (ط. مصر) فذكر أنه في الصفحة 87 وروايته: توأم بدل بوام
(4) في الديوان ص 58: مجتاز خرقها. وفي ص و (س) : يحلو. وهو تصحيف.
(3/109)
________________________________________
والخَيْلُ تَضْبَحُ في عَدوِها ضَبْحاً: تسمَعُ من أفواهِها صوتاً ليس بصهيل ولا حَمْحَمة.
حبض: حَبَضَ القلبُ يَحبِضُ حَبْضاً: أي ضَرَباناً شديداً. والعِرقَ يَحبِض ثم يسكُن، وهو أشَدُّ من النَبْض. والوَتَر يَحبِض إذا مَدَدَتَه ثم أرسَلْتَه. وحَبِضَ السُهْمُ: إذا لم يَقَعْ بالرَّميَّة وقصّرَ دونَها فوَقَعَ وَقْعاً [غَيْرَ شديدٍ «1» ] ، قال الراجز:
والنَبْلُ يَهوي خَطَأً وَحَبْضا
ويقال: أصابَ القومَ داهِيةٌ من حَبْض الدَّهْرِ: أي من ضَرَباته. ويقال: حَبْضُ الدهر وحَبَضُه أي حركاته. والحَبْض والنَبْض: الحركة، يقال: ما يَحبِض ولا ينبِض.
باب الحاء والضاد والميم معهما ح م ض، م ح ض، م ض ح مستعملات
حمض: الحَمْضُ: كلُّ نَباتٍ يبقى على القَيْظ فلا يَهيجُ في الربيع، وفيه مُلُوحة، تشربُ الإبِلُ الماءَ على أكلِه، وإذا لم تجدْه دَقَّتْ «2» وضَعُفَت. حَمَضَتْ تَحْمُضُ حُمُوضاً: إذا رَعَتْها، وهي حَوامِضُ، وأحْمَضناها، قال: «3»
قريبة ندوته من محمضه
__________
(1) من التهذيب 4/ 221 في الأصول: وقعا شديدا يؤيده أن النساخ ذكروا أن في نسخة الزوزني: إذا وقع بالدمية وَقْعاً غَيْرَ شديدٍ. قال الأزهري في التهذيب: فأما ما قاله (الليث
 إن الحابض الذي يقع بالرمية وقعا غير شديدفليس بصواب.
إن الحابض الذي يقع بالرمية وقعا غير شديدفليس بصواب.(2) كذا في الأصول المخطوطة، وفي التهذيب واللسان: رقت.
(3) هو (هميان بن قحافة) كما في اللسان.
(3/110)
________________________________________
وقد يُسَمَّى كلُّ ما فيه مُلُوحة حُمْضاً. ويقال للشيء الحامض: حَمَضَ حُموضةً، إلاّ أنَّهم يقولون للَّبَن خاصةً حَمَضُ حَمْضاً، وهو شديد الحَمْض. واللَّحمُ حَمْضُ الرِجال، وإذا حَوِّلت رجلاً عن أمرٍ فقد أحمَضْتَه، قال الطرماح:
لا يَني يُحمِضُ العَدُوُّ وذُو الخُلَّةِ ... يُشْفَى صداه بالإحماضِ «1»
والحَمْضة: الشَّهْوةُ للشَيء: وحَمضةُ اسم حَيِّ بلعاء بن قيس الليَّثيّ. والحُمّاض: بَقْلةٌ من ذُكُور البَقل لها زَهْرةٌ حَمراء، قال: «2»
كثَمَر الحُمّاضِ من هَفَت العَلَقْ
ويقال للذَّي يكونُ في جَوف الأُتْرُجِّ: حُمّاضة ويجمع الحُمّاض: قال «3» :
كأنَّما في فيه حُمّاضٌ نَزا
محض: المَحْضُ: اللَّبَنُ الخالصُ بلا رَغوة. وكلُّ شيءٍ خَلَصَ حتّى لا يشُوبُه شَيءٌ فهو مَحْضٌ. ورجلٌ مَمْحُوض الضَريبةِ: أي مخلص. وفضة مَحْضَة: لا شَوبَ فيها، فإذا قلت هذه الفضةُ محضاً جَعَلْتَ المحض [نصباً] اعتِماداً على المصدر أي قصداً له. ورجل عَرَبيُّ مَحْضٌ، وامرأةٌ مَحْضةٌ ومَحْضٌ.
مضح: مَضَحَ الرجلُ عِرْضَ فُلانٍ: «4» إذا شأنَه وعابَه، قال «5» .
لا تَمْضَحنْ عِرْضي فإنّي ماضِحُ ... عِرضَكَ إنْ شاتمتني وقادح
__________
(1) البيت في الديوان (ط. مصر) ص 87 واللسان (حمض) .
(2) هو (رؤبة بن العجاج) . انظر التهذيب والديوان ص 108 ورواية الرجز في اللسان:
كتامر الحُمّاضِ من هَفَت العَلَقْ.
(3) لم نهتد إلى الراجز.
(4) وزاد في التهذيب من كلام الليث: وأمضحه.
(5) في التهذيب 4/ 226 غير منسوب أيضا.
(3/111)
________________________________________
باب الحاء والصاد والدال معهما ح ص د، ص د ح يستعملان فقط
حصد: الحَصْد: جَزُّ البُرِّ ونحوه. وقَتْلُ الناس أيضاً حَصْدٌ. وقول الله تعالى: جَعَلْناهُمْ حَصِيداً
«1» أي كالحَصيد المَحصُود. والحَصيدةُ: المَزْرَعة إذا حُصِدَت كُلُّها. والجميع الحَصائد، قال الأعشى:
قالوا البقيَّةَ والهِنْديٌّ يحصُدُهُمْ ... ولا بقيَّة إلاّ الثَأرُ «2» فانكَشَفُوا
نَصَبَ البقيّةَ بفِعْل مُضمَر أي ألقَوا. وقوله تعالى: وَحَبَّ الْحَصِيدِ
«3» أي وحَبّ البُرِّ المَحصُود. وأحصَدَ البُرُّ: إذا أَنَى حَصاده أي: حانَ وقتُ جَزازه. والحِصَاد: اسمُ البُرِّ المحصود وبعد ما يُحصَد، قال ذو الرمة:
عليهن رفضا من حصاد القُلاقِلِ «4»
وقوله تعالى: يَوْمَ حَصادِهِ
وحِصاده، يُريدُ: الوَقْتَ للجزاز. والأحصَدُ: المِحْصَد: [وهو المُحْكِم فتله] «5» وصنعته من حَبل ودِرع ونحوه. ويقال للخَلْقِ الشَديد أَحصَدُ فهو مُحصَد ومُستَحصِد، وَتَرٌ أحصَدُ، قال: «6» .
من نزع أحصد مُسْتَأرِبِ
أي مُحكَم الأَرْب ومثله مُؤَرَّب الخَلْق أي مُحكَمُة، ومُستَأْرِب مُستَفْعِل، والدِرعُ الحصداء: المحكمة.
__________
(1) سورة يونس الآية 24.
(2) كذا في الأصول والتهذيب واللسان، وفي الديوان ص 311: إلا النار.
(3) سورة ق من الآية 9.
(4) وصدر البيت:
إلى مُقْعَداتٍ تَطْرَحُ الرّيح بالضحى
. انظر التهذيب واللسان والديوان ص 498.
(5) من التهذيب 4/ 228 عن العين أما الأصول فالعبارة فيها منقوصة قاصرة.
(6) في التهذيب 4/ 228. واللسان (حصد) : (قال الجعدي) .
(3/112)
________________________________________
صدح: الصَّدْح: من شدَّة صَوت الديك والغُراب ونحوهما، قال أبو النجم يصف الحمار:
مُحَشْرِجاً ومرةً صَدُوحا
والصادحةُ: المُغَنِيَّةُ. وصَيْدَح: اسمُ ناقَةِ ذي الرُمَّة، لا ينصَرِفُ، ولو كانَ اسماً عاملا لانصرف، قال:
فقلت لصَيْدَحَ انتَجِعي بِلالا «1»
باب الحاء والصاد والراء معهما ح ص ر، ص ح ر، ص ر ح، ح ر ص، مستعملات فقط
حصر: حَصِرَ حَصَراً: أي عَيَّ فلم يَقْدِر على الكلام. وحصر صدر المرء: أي ضاق عن أمرٍ حَصَراً. والحُصْرُ: اعتِقالُ البَطْن حُصِرَ، وبه حُصْرٌ، وهو مَحْصُور. والحِصار: مَوضع يُحْصَر فيه المَرءُ، حَصَروه حَصْراً، وحاصَرُوه، قال رؤبة:
مِدْحةَ مَحْصُورٍ تَشَكَّى الحَصْرا ... دَجْرانَ لم يشرب هناك الخمرا «2»
دَجران: أيْ سَكران: والإحصارُ: أن يَحصُرَ الحاجَّ عن بُلوغ المنَاسِك مَرَضٌ أو عَدُوٌّ. والحَصُور: مَن لا إربةَ له في النِساء. والحَصُور كالهَيُوب المُحجِم عن الشيء، قال الأخطل:
__________
(1) وصدر البيت:
سمعت الناس ينتجعون غيثا
انظر الديوان ص 442
(2) الرجز في ملحق الديوان ص 174 وروايته وتمامه:
مِدْحةَ مَحْصُورٍ تَشَكَّى الحَصْرا ... رأيته كما رأيت نسرا
كُرِّز يلقي قادمات زعرا ... دجران لم يشرب هناك الخمرا
(3/113)
________________________________________
لا بالحصور ولا فيها بسَوّار «1»
والحَصيرُ: سَفيفةٌ من بَردّي ونحوه. وحَصيرُ الأرض: وجْهُها، وجمعُه حُصُر. والعدد: أحصِرة. والحَصيرُ: فِرِنْد السيَف. والحَصيرُ: الجنب، قال تعالى: وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً «2» أي يُحْصَرون فيها.
صحر: أصحَرَ القَومُ: أي بَرزُوا إلى الصَّحْراء، وهو فَضاءٌ من الأرض واسِعٌ لا يُواريهم شيءٌ، والجمع الصَّحَارَى ولا يُجمَع على الصُّحْر لأنّه ليسَ بنَعْتٍ. والصَّحَرُ مصدر الأصحَر وهو لَونُ غُبْرةٍ في حُمرة خَفيفة «3» إلى بياض قليل، والجميع الصُّحْر. والصُّحْرةُ: اسم اللَّوْن، يقال حِمارٌ أصحَر، قال ذو الرمة:
صُحْرُ السَرابيلِ في أحشائها فبب «4»
وأصحارّ النَباتُ: أي أخَذَتْ فيه صُفرةٌ غيرُ خالصةٍ ثمَّ يَهيجُ فيَصفَرُّ. وَيقول: أبرز له ما في نفسه صَحاراً: أي جاهَرَه به جِهاراً. والصَحيرُ: النَهيقُ الشديد، صَحَر يَصحَرُ صحيرا، أي: نَهَق.
صرح: الصَرْح: بَيْت منُفَرِد يُبنَى ضَخْماً طويلاً في السماء، ويُجمَع الصُرُوح، قال: «5»
__________
(1) وصدر البيت:
وشاربٍ مُرْبحٍ بالكأس نادمَني
انظر الديوان ص 116.
(2) سورة الإسراء الآية 8
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: خفيفة.
(4) وصدر البيت:
تنصبت حوله يوما تراقبه
الديوان 1/ 56 والرواية فيه: صحر سماحج.....
(5) هو (أبو ذؤيب الهذلي) كما في التهذيب واللسان، ورواية البيت فيهما، وفي ديوان الهذليين 1/ 136:
على طرق كنحور الركاب ... تحسب آرامهن الصروحا
(3/114)
________________________________________
بهن نعام بنته الرجال ... تَحسِبُ أعلامَهُنَّ الصُرُوحا
يُريدُ بالنَعام: [خَشَبات] قائماتٍ على أرجاء الآباد. والصَريحُ: اللَّبَن المَحْضُ الخالصُ. ومن كل شيء. ومن البَول: إذا لم يكنْ عليه رَغوة، قال أبو النجم:
يَسُوف من أبوالِها الصَريحا ... حَسْوَ المريضِ الخَرْدَلَ المجْدُوحا «1»
والصَريح من الخَيل والرجال: المَحْض الحَسَب، وجمعه: صُرَحاء، وجمع الخيل: الصَرائح. وصَريح النُصْح: مَحْضُه، قال الشاعر:
أمرتُ أبا ثَورٍ بنُصْحٍ كأنَّما ... يرى بصريح النصح وكع العَقارِبِ «2»
وقول عبيد: «3»
فَتْخاءَ لاحَ لها بالصَرْحةِ الذيبُ
فالصَرْحةُ: موضع، ويقال: مَتْنٌ «4» من الأرض مُسْتَوٍ.
وكُرِّمَ ماءً صريحا
قال زائدة: بالصخرة الذيبُ. وقال في السحاب: «5» أي: خالصاً، كُرِّمَ «6» : كَثُرَ بلغة هُذيل وصَرَّح ما في نفسه تصريحا أي أبداه «7» . وخَمرٌ وكأسٌ صراحية وصراح:
__________
(1) البيت الأول وحده في التهذيب.
(2) لم نهتد إلى نسبة هذا البيت.
(3) هو (عبيد بن حصين الراعي) ، وصدر البيت:
كأنها حين فاض الماء واختلفت
انظر التهذيب 2/ 39 واللسان (صرح)
(4) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: هي.
(5) هو (أبو ذؤيب الهذلي) ، انظر ديوان الهذليين 1/ 131، وتمام البيت وروايته:
وهي خرجه واستجيل الرباب ... منه وغرم ماءصريحا
(6) في الأصول المخطوطة: كزم.
(7) كذا في ط، وفي ص: أنبأه.
(3/115)
________________________________________
أي لم تُشَبْ بمزاج، وصَرَّحَتِ الخمر تصريحاً: ذهب عنها الزَبَد، قال الأعشى:
كُمَيتاً تَكَشَّفُ عن حُمرةٍ ... إذا صَرَّحَتْ بعد إزبادِها
ويقال: جاء بالكُفر صُراحاً: أي جَهِاراً.
حرص: حَرَص يَحرِص حِرْصاً فهو حَريص عليك: أي على نفعك، وقَومٌ حُرَصاءُ وحِراصٌ. والحَرْصة: مستَقَرُّ وَسَط كُلِّ شَيءٍ كالعَرْصة للدار «1» . والحارصةُ: شَجَّةٌ تشُقُّ الجِلْدَ قليلاً كما يحرِصُ القَصّارُ الثوبَ عند الدق، ويقال منه قول الله- عز وجل-: وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ «2» . والمطَرُ يحرِصُ الأرضَ: يخرِقها.
باب الحاء والصاد واللام معهما ح ص ل، ص ل ح، ل ح ص، ص ح ل مستعملات
حصل: حَصَلَ يحصُل حُصُولاً: أي بَقِيَ وثَبَتَ وذَهَبَ ما سِواهُ من حِسابٍ أو عَمَلٍ ونحوه فهو حاصل. والتحصيلُ: تَمييز ما يحصل. والاسم: الحصيلة، قال لبيد:
وكل امرىء يَوماً سيَعلَم سَعْيَه ... إذا حُصِّلَتْ عند الإِله الحصائل «3»
ويُرَوى: إذا كُشِّفَت عند الإِله. وحَوْصَلةُ الطائر: معرُوف. والحَوْصلةُ: طَيْرٌ أعظَمُ من طير الماء طويل العنق، بَحْريَّةٌ جُلُودُها بيضٌ تُلْبَسُ،
__________
(1) وعلق الأزهري في التهذيب 4/ 240 وقال: لم أسمع حرصة بمعنى العرصة لغير الليث.
(2) سورة يوسف من الآية 103.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الديوان ص 257:
إذا كُشِّفَت عند الإِله المحاصل
(3/116)
________________________________________
ويُجمَع حَواصِل. والحَوْصَلُ: الشاةُ التي عَظُمَ ما فَوقَ سُرَّتِها من بَطْنها. ويقال: احوَنْصَلَ الطَيْرُ: إذا ثَنَى عُنَقَه وأخرَجَ [حوصلته] «1» .
صحل: الصحلّ: صَوْتٌ فيه بُحَّة، صَحِل صوتُه فهو أصحَلُ الصَوْت «2»
صلح: الصَلاحُ: نقيض الطلاح «3» . ورجل صالح في نفسه ومُصلِحٌ في أعماله وأمُوره. والصُّلْحُ: تصالُحُ القوم بينهم. وأصلَحْتُ إلى الدابَّة: أحْسَنْتُ إليها. والصِّلْحُ: نهر بمَيْسان.
لحص: اللَّحْصُ والتَلحيصُ: استقصاء خَبَر الشيء وبيانه، لَحَصَ لي فلان خَبَرك وأمْرَكَ أي بَيَّنَه شَيئاً شَيئاً. وقال «4» في بعض الوصف: أَمْرُ مَناقِع النّزّ ومواقع الرّزّ، حبُّها لا يُجَزُّ، وقصبها يهتزّ، وكتَبْتَ كتابي هذا وقد حَصَّلتُه ولحَّصتْهُ وفَصَّلُته ووَصَّلْتُه وترّصته «6» وفَصَّصْته مُحَصَّلاً مُلَحَّصاً مُفَصَّلاً مُوَصَّلاً مُتَرَّصاً مُفصّصا، وبعض يقول ملخصا بالخاء.
__________
(1) من مختصر العين (ورقة 67) ، وفي التهذيب 4/ 241 عن العين: وأخرج حوصلته. في الأصول المخطوطة: (صلبه) وفيه بتر وتصحيف.
(2) وصحل مثل فرح.
(3) في التهذيب من كلام (الليث) : نقيض الفساد.
(4) عبارة التهذيب عن (الليث) : وكتب بعض الفصحاء إلى بعض إخوانه كتابا في بعض الوصف فقال:
(6) وجاء النص في الأصول كثير التصحيف. (مناقح) بالقاف، في (ط) : منافع بالفاء (والنز) في (ط) : النبز، و (الرز) : الوز. و (ترصته) : في (س) : قرطسته. و (مترصا) من (س) : مقرطسا
(3/117)
________________________________________
باب الحاء والصاد والنون معهما ح ص ن، ص ح ن، ن ص ح، ن ح ص مستعملات
حصن: الحِصْنُ: كل مَوضِع حَصين لا يُوصل إلى ما في جَوفه، يقال: حَصُنَ الموضع حصانةً وحَصَّنْتُه وأحصنَتْهُ. وحِصنٌ حَصين: أي لا يُوصل إلى ما في جَوْفه. والحِصان: الفَرس الفَحْل، وقد تَحصَّن أي تكلف ذلك، ويجمع [على] حُصُن. وامرأةٌ مُحْصَنٌة: أَحصَنَها زَوْجُها. ومُحْصِنةٌ: أحْصَنَتْ زَوْجَها. ويقال: فَرْجَها. وامرأةٌ حاصِنٌ: بَيِّنة الحُصْن والحَصانة أي العَفافة عن الريبة. وامرأة حَصانُ الفَرْج، قال: «1»
وبِيني حَصانَ الفرجَ غيرَ ذَميمةٍ ... ومَوْمُوقةٌ فينا كذاك ووامِقَهْ
وجماعة الحاصن حواصن وحاصنات، قال:
وابناء الحَواصِنِ من نِزارٍ «2»
وقال العجاج:
وحاصِنٍ من حاصناتٍ مُلْسِ «3»
وأحسن ما يجمع عليه الحَصان حَصاناتِ. والمحصن: المكتل «4» . والحصينة: اسم للدِرْع المُحكَمِة النَسْج، قال:
__________
(1) البيت (للأعشى) ، انظر الديوان وفيه: غير ذميمة، وفي (ط) : دميمة.
(2) لم نهتد إلى هذا الشطر وإلى قائله.
(3) وتكملة الرجز كما في التهذيب واللسان والديوان ص 481:
من الأذى ومن قراب الوقس
(4) في اللسان: المكتلة.
(3/118)
________________________________________
وكل دِلاصٍ كالأضاةِ حَصينةٍ «1»
صحن: الصَحْنُ: شبه العُسِّ الضَخْم إلا أنَّ فيه عِرَضاً وقُرْبَ قَعْرٍ. والسائلُ يَتَصَحَّنُ الناس: أي يسأل في قَصْعةٍ ونحوها. والصِّحْناة «2» بوزن فعلاة إذا ذهب عنها الهاء دخلها التنوين، ويجمع على الصِحْنَى بحذف الهاء.
نصح: فلانٌ ناصح الجيب: أي ناصح القَلْب مثل طاهرُ الثياب أي الصدر. ونَصَحْتُه ونَصَحْتُ له نُصحاً ونَصيحةً، قال:
النُصْحُ مجّانٌ فمن شاء قبِل ... ومنْ أبَى لا شكَّ يَخْسَرْ ويَضِلّ «3»
والناصِحُ: الخيّاط، وقميصٌ مَنْصُوحٌ: أي مَخيطٌ. نَصَحتُه أنصَحُه نَصْحاً [منَ النِّصاحة] . والنِّصاحة: السُلُوكُ التي يُخاطُ بها وتصغيرها نصيحة، قال: «4»
وسَلَبْناهُ بُرْدَه المَنْصُوحا
والتنصح: كثرة النصيحة،
قال أكتم بن صيفي: إيّاكمْ وكثْرة التَنَصُّح فإنه يُورِثُ التُهَمَة.
والتَوْبةُ النّصوحُ: أن لا يعُودَ إلى ما تاب عنه. والنِّصاحات: الجُلود، قال الأعشى:
فتَرَى القَومَ نَشاوىَ كلَّهُمْ ... مثلَ ما مُدَّت نِصاحاتُ الرُبَحْ «5»
__________
(1) (الأعشى) ديوانه/ 205 وعجز البيت فيه:
ترى فضلها عن ربها يتذبذب
(2) الصحناة: الصير وهي السمكات المملوحة.
(3) لم نهتد إليه.
(4) لم نهتد إلى القائل.
(5) البيت في الديوان ص 243 وفي التهذيب 4/ 249 واللسان (نصح)
(3/119)
________________________________________
نحص: النَّحُوصُ: الأتانُ الوَحْشَّيُة الحائِل. ونُحْص الجَبَل: أصله.
حنص: الحِنْصَأوة من الرجال: الضئيل الضَعيف، قال:
حتّى تَرَى الحِنْصَأوةَ الفَروقا ... مُتَّكِئاً [يَقْتَمِحُ] «1» السَّويقا
باب الحاء والصاد والفاء معهما ص ح ف، ح ص ف، ف ص ح، ص ف ح، ف ح ص، ح ف ص، كلهن
صحف: الصُّحُفُ: جمع الصَحيفة، يُخَفَّف ويُثّقَّل، مثل سفينة وسُفْنُ، نادِرتان، وقياسُه صَحائف وسَفائن. وصَحيفة الوجه: بشرة جلده، قال:
إذا بَدا من وَجْهِكَ الصَحيفُ «2»
وسُمِّيَ المُصْحَفُ مُصْحَفاً لأنَّه أُصْحِفَ، أي جُعِلَ جامعاً للصُحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْن. والصَّحْفةُ شبه القَصْعة المُسْلَنْطِحة العَريضة وجمعه صِحاف. والصَّحَفِيُّ: المُصَحِّف، وهو الذي يَروي الخَطَأ عن قِراءة الصُّحُف بأشباه الحُروف.
حصف: الحصف: بثر صِغارٌ يَقيحُ ولا يعظُم «3» ، ورُبَّما خَرَجَ في مَراقِّ البطن أيام
__________
(1) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: يقتحم.
(2) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: الصحيفة.
(3) كذا في التهذيب واللسان، وفي الأصول المخطوطة: يقيح ولا يقيح ولا يعظم.
(3/120)
________________________________________
الحَرِّ. حَصِفَ جَلْدُه حَصَفاً. والحَصافَةُ: ثخانة العَقل. رجلٌ حَصيفٌ حَصِفٌ، قال
حَديثُكَ في الشِتاءِ حَديثُ صَيْفٍ ... وشَتْويُّ الحديثِ إذا تَصيفُ
فتَخلِطُ فيه من هذا بهذا ... فما أدري أَأَحمَقُ أم حَصيفُ «1»
ويقال: أحصَفَ نَسجَه: أحكمه. وأحصَفَ الفَرَسُ: عَدا عَدْواً شديداً، [ويقال: استَحْصَف القوم واستحصدوا إذا اجتمعوا] . قال الأعشى:
تَأوي طوائفُها إلى مَحْصُوفةٍ ... مَكرُوهةٍ يَخشىَ الكُماةُ نِزالُها «2»
فصح: الفُصِحْ: فِطْر النَصارَى، قال الأعشى:
بهم تَقرَّبَ يومَ الفِصْح ضاحيةً «3»
وتَفصيحُ اللَّبَن: ذَهابُ اللِّبأ عنه وكَثرةُ مَحْضة وذَهابُ رَغْوته، فَصَّحَ اللَّبَنَ تَفصيحاً. ورجلٌ فصيحٌ فَصُحَ فَصاحة، وأفصَحَ الرجلُ القَوْلَ. فلما كَثُرَ وعُرِفَ أضمَروا القَولَ واكتَفَوا بالفِعل كقَولهم: أحسَنَ وأسْرَعَ وأبْطَأَ. ويقال في الشِّعْر في وصف العُجْم: أفصَح وإن كان بغَير العربّية كقول أبي النجم:
أعجَمَ في آذانِها فصيحا «4»
يَعني صوتَ الحمارِ. والفصيحُ في كلام العامة: المعرب.
__________
(1) البيتان في تاج العروس (حصف) غير منسوبين أيضا.
(2) قال الأزهري في التهذيب: أرادبالمحصوفة كتيبة مجموعةو البيت في التهذيب 4/ 252 وفي الديوان ص 33. والرواية فيه: إلى مخضرة.
(3) ديوانه ص 111 وعجز البيت فيه:
يرجو الإله بما سدى وما صنعا
(4) الرجز في التهذيب 4/ 253 واللسان (فصح)
(3/121)
________________________________________
صفح: الصَّفْحُ: الجَنْبُ: من كلِّ شيءٍ. وصَفْحا السَيْف: وَجْههاهُ. وصَفْحةُ الرجلِ: عُرْضُ صَدره «1» وسَيْفٌ مُصَفَّحٌ [ومُصْفَح] وصَدرٌ مُصْفَحٌ: أي عَريض، قال:
وصَدري مُصْفَحٌ للمَوتِ نَهْدٌ ... إذا ضاقَت عن المَوتِ الصُدُورُ «2»
وقال الأعشى:
أَلَسْنا نحنُ أكرَمَ إن نُسْبنا ... وأضْرَبَ بالمُهَنَّدة الصِّفاحِ «3»
وقال لبيد: «4»
كأنَّ مُصَفَّحاتٍ في ذراه ... وأنواحا عليهن المَآلي
شَبَّهَ السَحَاب وظُلْمَتَه وبَرقَه بسُيُوفٍ مُصَفَّحة، والمَآلي جمع المِئلاة وهي خِرْقةٌ سَوداء بيَد النَوّاحة. وكل حَجَرٍ عَريضٍ أو خَشَبةٍ أو لَوحٍ أو حَديدة أو سَيْفٍ له طُولٌ وعَرْضٌ فهو صَفيحة، وجمعُه صَفائحُ. والصُفّاحُ من الحِجارة خاصةً: ما عَرُضَ وطالَ، الواحدة صفاحة، قال: «5»
ويوقدن بالصُفّاحِ نارَ الحُباحِبِ
وَصَفْحتُ عنه: أي عَفَوتُ عنه. وصَفَحْتُ وَرَقَ المُصْحَف صَفْحاً. وصَفَحْتُ القَومَ: عَرَضْتُهم واحداً واحداً «6» وتَصَفَّحْتُهم: نَظَرتُ في خِلالهم هل أرَى فُلاناً، أو ما حالُهم. وقوله تعالى: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً
«7»
__________
(1) في التهذيب من كلام الليث: وجهه.
(2) البيت في التهذيب 4/ 255، وفي اللسان (صفح) .
(3) البيت في الديوان ص 347 واللسان (صفح) .
(4) أضاف الأزهري في التهذيب قوله: يصف السحاب.
(5) هو (النابغة الذبياني) كما في التهذيب، وصدر البيت كما في الديوان:
تقد السَّلُوقيَّ المضاعفَ نَسجهُ
(6) (واحدا) الثانية ساقطة من (ط)
(7) سورة الزخرف الآية 5.
(3/122)
________________________________________
هو الاِعراض. والصُفّاح من الإبِلِ: التي عَرُضَت أسنامُها «1» ، ويُجمَع صُفّاحات وصَفافيح. والمُصافَحةُ معروفة.
فحص: الفَحْصُ: شِدَّة الطَلَب خِلالَ كُلِّ شيءٍ [تقول] : فحَصْتُ عنه وعن أمره لأَعلَمَ كنْهَ حاله. ومَفْحَصُ القَطا: موضِعٌ تُفرِّخ فيه. والدَجاجَةُ تفحَصُ برَجلَيْها وجَناحَيْها في التُراب: تَتَّخِذُ أُفحُوصةً تَبيضُ أو تربضُ «2» فيها.
وفي الحديث: «3» فَحَصُوا عن أوساط الرءوس
أي عَمِلوها مثلَ أَفاحيص القَطا. والمَطَرُ يَفحَص [الحصَىَ] «4» : يقلِبُه ويُنَحِّي بعضَه عن بعض.
حفص: أمُّ حَفْصة: تُكْنَى به الدَجاجةُ. ووَلَدُ الأَسَد يُسَمَّى [حفصاً] «5» .
باب الحاء والصاد والباء معهما ح ص ب، ص ح ب، ص ب ح، مستعملات
حصب: الحَصْبُ: رَمْيُكَ بالحَصْباء أي صِغار الحَصَى أو كِبارها.
وفي فِتنةِ عُثمان: تَحاصَبُوا حتّى ما أُبصِرَ أديمُ السَماء.
والحَصْبَةُ معروفة تخرُجُ بالجَنْب، حُصِبَ فهو مَحصُوب. والحَصَبُ: الحَطَب للتَنُّور أو في وقود [أما] «6»
__________
(1) في رواية التهذيب 4/ 258 عن العين: التي عظمت أسمتها.
(2) في رواية التهذيب 4/ 259 عن العين أو تجثم
(3) في التهذيب 4/ 259: ومنه اشتق قول أبي بكر.....
(4) كذا في التهذيب واللسان، وفي ص وط وس: القطا.
(5) من مختصر العين (ورقة 97) ، والتهذيب 4/ 259 عن العين. في الأصول المخطوطة: حفصة
(6) زيادة من التهذيب 4/ 260 عن العين، لتقويم العبارة.
(3/123)
________________________________________
ما دام غيرَ مُسَتْعمل للسُجُور فلا يُسَمَّى حصباً. والحاصِب: الريحُ تَحمِلُ التُرابَ وكذلك ما تَناثَر من دِقاق البَرَد والثّلج، قال الأعشى:
لنا حاصِبٌ مثلُ رِجْلِ الدَّبَى ... وجأواءُ تُبرِق عنها الهُيُوبا «1»
يصف جَيشاً جَعَلَه بمنزلةِ الريح الحاصب يُثير الأرض. والمُحَصَّب: موضع الجِمار. والتَحصيبُ: النَّومَ بالشِعْب الذي مَخرَجُه إلى الأبْطَح ساعةً من اللَّيل ثم يُخرَجُ إلى «2» مَكّة.
صحب: الصّاحِبُ: يجمعُ بالصَّحْب، والصُّحبان والصُحْبة والصِحاب. والأَصحابُ: جماعة الصَّحْبِ. والصِّحابة مصدرُ قولِك صاحَبَكَ اللهُ وأَحْسَنَ صِحابتَكَ. ويُقالُ عندَ الوَداع: مُصاحَباً مُعافىً. ويقال: صَحِبَكَ اللهُ [أي: حفظك] ، ولا يُقال: مصحوب. والصّاحبُ يكونُ في حالٍ نعتاً، ولكنَّه عَمَّ في الكلام فجرى مَجرى الاسمِ، كقولك: صاحبُ مال، أي: ذو مالٍ، وصاحبُ زيدٍ، أي: أخو زيدٍ ألا تَرى أنّ الألفَ والّلام لا تدخلانِ، على قياس الضّارب زيداً، لأنّه لم يُشْتَقّ من قولك: صَحِبَ زَيْداً، فإذا أَرَدْتَ ذلك المعنى قُلتَ: هو الصاحب زيداً. وأَصْحَبَ الرجُلُ: إذا كان ذا صاحبٍ. وتقول: إنَّك لَمِصْحابٌ لنا بما تُحِبُّ، قال: «3»
فقد أراك لنا بالوُدِّ مِصْحابا
وكلُّ شَيءٍ لاءَمَ شَيئاً فقد استَصْحَبَه، قال:
إنَّ لك الفضل على صاحبي «4» ... والمسك قد يستصحب الرامكا
__________
(1) في اللسان (حصب) وفي ملحقات الديوان 236
(2) في (ط) : من..
(3) هو (الأعشى) ، وصدر البيت:
إن تصرمي الحبل يا سعدى وتعتزمي
انظر ملحقات الديوان ص 235
(4) في اللسان: على صحبتي.
(3/124)
________________________________________
ويقال: جِلدٌ مُصْحِب: إذا كان عليه شَعْرُه وصُوفه.
صبح: [تقول] : صَبَحنَي فلانٌ: إذا أتاك صبَاحاً. وناوَلكَ الصَبُّوح صباحاً، قال طرفة بن العبد:
متى تَأْتِني أصبحك كأسا روية ... وإن كنتَ عنها ذا غِنىً فاغْنَ وازْدَدِ «1»
وتقول في الحرب: صَبَحناهم. أي غادَيناهم بالخَيْل ونادَوا: يا صَباحاه، إذا استَغاثُوا. ويومُ الصبَّاح: يومُ الغارة، قال الأعشى:
ويمنَعُه يَومَ الصَّباح مَصُونةٌ ... سِراعاً إلى الداعي تَثُوبُ وتُركَبُ «2»
(يَعني أنَّ الخَيْل تَمنَع هذا المصطَبح يَوْمَ الصبَّاح، المصونة: الخيْل، تثوب: ترجع) «3» . وكان ينبغي أن يقول: تُركَبُ وتَثُوب، فاضطُرَّ إلى ما قاله. وهذا مثل قوله تعالى: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ «4» إنَّما معناه: انشَقَّ القَمَرُ واقَتَرَبتِ الساعةُ. وكما قال ابن أحمر:
فاستَعرِفا ثم قُولا في مَقامِكُما ... هذا بَعيرٌ لنا قد قامَ فانعَقَرا «5»
مَعناهُ: قد انعَقَرَ فقامَ. والصَّبْحُ: سَقْيُكَ من أتاكَ صبَوحاً من لَبَنٍ وغيره. والصَّبُوح: ما يُشرَب بالغَداة فما دونَ القائلة، وفِعلك الاصطِباح. والصبَّوَح: الخمرَ، قال الأعشى:
ولقد غَدوتُ على الصَّبُوحِ معي ... شَرْبٌ كِرامٌ من بَني رُهْمِ «6»
__________
(1) البيت في اللسان (صبح) ، وفي معلقة الشاعر المشهورة.
(2) الرواية في الديوان ص 203:
يوم الصباح بالياء.. ... وسراع إلى الداعي تَثُوبُ وتُركَبُ
(3) سقط ما بين القوسين من ط وس.
(4) سورة القمر الآية 1
(5) لم نقف على البيت في المصادر المتيسرة لدينا.
(6) البيت في التهذيب 4/ 264 واللسان (صبح)
(3/125)
________________________________________
واستصبح القوم بالغدوات. والمُصْبَحُ: الموضع الذي يُصبَحُ فيه، قال:
بعيدةُ المُصْبَح من مُمساها «1»
والمِصباحُ: السِراج بالمِسرَجة، والمِصباحُ: نفْسُ السراج وهو قُرْطُه الذي تَراهُ في القِنديل وغيره، والقِراطة «2» لغة. والمِصباح من الإبِل: ما يَبْرُك في مُعَرَّسه فلا ينهضُ وإنْ أُثيرَ حتى يُصبحَ، قال:
أَعْيَس في مَبْرَكهِ مِصباحا «3»
والمَصابيحُ من النُجُوم: أعلامُ الكَواِكب، الواحدُ مِصباح، وقَوْلُ الله- عزَّ وجَلَّ-: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ «4» أي بعدَ طُلُوع الفجر وقبلَ طُلُوع الشمس. وصَبَحْتُ القومَ ماءَ كذا، وصبحتهم أيضا: أتيتهم مع الصَباح، قال:
وصَبَّحْتُهم ماءً بفيفاء قفرة ... وقد حلق النَّجْمُ اليَمانيُّ فاستَوَى «5»
والصُّبْح والصباح: هما أوَّل النَهار. والصَّبَحُ: شِدَّةُ حُمْرةٍ في الشَّعْر، وهو أصْبَحُ. والأَصْبَحيَّةُ والأَصْبَحيُّ: غِلاظ السياط وجيادها، وتقول: أصبَحَ الصبح صَباحاً وصَباحَةً. وصَبُحَ الرجلُ صَباحةً وصُبْحةً، قال ذو الرمة:
وتَجلو بفَرْعٍ من أَراكٍ كأنَّه ... من العَنْبَر الهِنْديِّ والمِسْكُ أصْبَحُ «6»
أراد به أذَكى ريحاً. ونَزَل رجلٌ بقَومٍ فَعَشَّوه فجَعَل يقولُ: إذا كانَ غدٌ وأصَبْتُ من الصَّبُوح مَضَيْتُ في حاجَة كذا (أراد أن يُوجبَ) «7» الصبوح عليهم
__________
(1) البيت في التهذيب 4/ 267 واللسان (صبح) .
(2) في التهذيب: القراط
(3) لم نهتد إلى الراجز.
(4) سورة الحجر من الآية 83.
(5) البيت في التهذيب 4/ 265 واللسان (صبح) من غير عزو.
(6) ورواية البيت في الديوان ص 83:
............... ............ ... من العَنْبَر الهِنْديِّ والمِسْكُ يصبح
(7) ما بين القوسين من (س) . في (ص) و (ط) : فإذا أوجب.
(3/126)
________________________________________
ففَطٍنُوا له فقالوا: أَعَنْ صبَوحٍ تُرَقِّقُ. أي: تُحسِن كلامَكَ فذَهَبَتْ مَثَلاً.
باب الحاء والصاد والميم معهما ح م ص، م ح ص، ص ح م، ص م ح، ح ص م، م ص ح كلهن مستعملات
حمص: الحَمَصيصُ: بَقْلةٌ دونَ الحُمّاض في الحُمُوضة، طَيِّبة الطَّعْم من أحرار البَقْل تنبت في رمل عالج. والحَمْصُ: تَرَجُّح الغُلام على أُرجُوحةٍ من غير أن يُرجَّح، يقال: حَمَصَ. وانحَمَصَ الوَرَمُ: أي سَكَن. وحَمَّصَه الدواء «1» . وحمصتُ القَذاةَ بيَدي: إذا رَفْقتَ بإخراجها من العَيْن مَسْحاً مَسْحاً. حِمْص: كُورةٌ بالشام أهلها يَمانُون. والحِمِصَّ: جمع الحِمِصَّة، وهو حبَّة القِدْر، قال:
ولا تَعْدُوَنَّ سبيلَ الصَّوابِ ... فأرزَنُ من كذِبٍ حمَّصَهْ «2»
محص: المَحْصُ: خُلُوصُ الشَيء، مَحَصْتُه مَحْصاً: خَلَّصْتُه من كلِّ عَيْب، قال:
يَعتادُ كلَّ طِمِرَّةٍ ... مَمْحُوصةٍ ومُقَلَّص «3»
والمحْص: العَدْوُ، يقال: خَرَجَ يَمْحَص كأنَّه ظَبْيٌ. والتَمحيصُ: التَطهيرُ من الذنوب.
__________
(1) جاء في التهذيب: وقال غيره (أي غير (الليث) حمزة وحمصه إذا أخرج ما فيه.
(2) لم نهتد إلى القائل.
(3) لم نهتد إلى القائل.
(3/127)
________________________________________
صحم: الصُحْمةُ: لَون من الغُبرة إلى سَوادٍ قليل. واصحامَّتِ البقلةُ فهي مُصحامَّةٌ: إذا أخَذَتْ ريَّها واشتدَّتْ خُضرتُها. والصَحْماءُ: اسمُ بَقْلةٍ ليسَتْ بشديدة الخُضرة. وبَلْدةٌ صَحْماءُ: ذاتُ اغبِرار، قال الطرماح:
وصَحْماءَ مَغْبَرِّ الحَزابي كأنَّها «1»
مصح: مَصَحَ الشَيءُ «2» يمصَحُ مُصُوحاً: إذا رسَخَ، من الثَرَى وغيره. والدارُ تمصَحُ: أي تَدْرُسُ فتذهَبُ، قال الطرماح:
قِفا نَسْأَلِ الدِّمَن الماصِحَهْ «3»
وقال:
عَبْلُ الشَّوَى ماصِحةٌ أشاعُرهْ «4»
أيْ رسَخَتْ أصُولُ الأشاعِر حتى أُمِنَتْ الانتِتافَ والانحِصاصَ.
صمح: صَمَحَه الصَيْفُ: أي: كادَ يُذيب دِماغَه من شِدَّة الحَرِّ «5» . قال أبو زبيد الطائي: «6»
__________
(1) وفي التهذيب 4/ 273 واللسان (صحم) : قول (الطرماح) يصف فلاة:
وصحماء أشباه الحزابي ما يرى ... بها سارب غير القطا المتراطن
والبيت في الديوان/ 487 وقد نسب في الأصول المخطوطة خطأ إلى (ذي الرمة) .
(2) في التهذيب 4/ 275 وهو كلام الليث: مصح الندى يمصَحُ مُصُوحاً إذا رسَخَ في الثرى.
(3) وعجز البيت كما في التهذيب والديوان ص 67:
وهل هي إن سئلت بائحه
(4) لم نهتد إلى القائل.
(5) جاء في (س) بعد كلمة (الحر) : (هذا في نسخة الزوزني، وفي نسخة الحاتمي: لا يقال: صمحه الصيف، لأنه خطأ) حذفنا هذه العبارة من الأصل لأنها ليست منه.
(6) في الأصول المخطوطة: أبو زيد، والبيت في اللسان (صمح) .
(3/128)
________________________________________
من سُمُومٍ كأنَّها لَفْحُ نارٍ ... صَمَحتْها ظَهيرةٌ غَرّاء
وقال ذو الرمة:
إذا صَمَحتْنا الشَمسُ كان مَقيلُنا ... سَماوَةَ بَيْتٍ لم يُرَوَّقْ له سِتْرُ «1»
وفي حديث مَقتَل حجر بن عَدِيّ عن أبي عُبَيد في ذِكْر سُمَيَّةَ أُمِّ زِيادٍ: إنَّها لَوطْباءُ «2» شدَيدة الصِماح تُحبُّ النِكاح
أيْ شديدة الحرِّ. ورجلٌ صَمَحْمَحٌ وصَمَحْمَحيٌّ: أي مُجْتَمِعٌ ذو ألواحٍ، وفي السِنِّ: ما بين الثَلاثينَ إلى الأربَعينَ.
حصم: حَصَمَ الفرس وخَبَجَ الحمار: إذا ضَرَط. والحَصُومُ: الضَرُوط.
باب الحاء والسين والطاء معهما س ط ح، س ح ط يستعملان فقط
سطح: السَطْحُ: البَسْطُ، يقالُ في الحَرْب سَطَحُوهم أي أَضْجَعُوهم على الأرض. والسَطيحُ: المَسْطُوح، وهو القَتيل، قال:
حتّى تَراه وَسْطَنا سطيحا «3»
وسَطيح: اسمُ رجلٍ من بني ذِئبٍ في الجاهليّة الجَهْلاء، كان يَتَكَهَّنُ، سُمِّيَ سطيحا لأنه لم يكن بين مفاصِلِه قَصَب يَعمِدُه، كانّ لا يقدِرُ على قُعُوٍد ولا
__________
(1) البيت في الديوان 1/ 591.
(2) الوطباء: العظيمة الثدي. في ص: رطباء وهو تصحيف.
(3) رواية الرجز في التهذيب 4/ 276: حتى تراه وسطها سطيحا وفي اللسان (سطح) : حتى يراه وجهها سطحيا،
(3/129)
________________________________________
قيام، وكان مسطحاً على ألأرض وفيه يقول الأعشى:
ما نَظَرتْ ذاتُ أشفارٍ كنَظْرتها ... يَوماً كما صَدَقَ الذِئبيُّ إذ سجعا «1»
والسَطْح: ظَهْر البَيْت إذا كان مُستَوياً، والفِعلُ التَسَطيح «2» . والمِسْطَح: شِبْهُ مِطهَرةٍ ليسَتْ بمُرَبَّعة. والمِسْطَحةُ: الكُوزُ ذو الجَنْب الواحد يُتَّخَذُ للأسفار، قال «3» :
فلم يُلْهِنا استِنْجاءُ وَطْبٍ ومسطح
. الاستنجاء: التشمم هاهنا. والمِسْطَح: عُودٌ من عِيدان الخِباء والفُسْطاط ونحوه، قال مالك بن عوف النضري: «4»
تعرض ضيطار وخزاعة دونَنا ... وما خَيْرُ ضَيْطارٍ يُقَلَّبُ مِسْطَحاً
سحط: سَحَطْتُ الشاةَ سَحْطاً، وهو ذَبْحٌ وحِيٌّ.
باب الحاء والسين والدال معهما ح س د، س د ح، ح د س، د ح س مستعملات
حسد: الحَسَدُ: معروف، والفعل: حَسَدَ يَحْسُد حَسَداً، ويقال: فلانٌ يُحْسَدُ على كذا فهو محسود.
__________
(1) البيت في الديوان ص 103 وروايته:
............... ......... ... حقا كما صَدَقَ الذِئبيُّ إذ سجعا
(2) في التهذيب من كلام الليث: والسطح ظهر البيت.....، وفعلكه التسطيح.
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى القول في غير الأصول
(4) في اللسان وقال مالك بن عوف النضري. وهذا من حواشي ابن بري. وفي التهذيب: عوف بن مالك النضري كذلك. في الأصول المخطوطة. النصراني.
(3/130)
________________________________________
سدح: السَّدْحُ: ذبحُكَ الحيوانَ وبَسْطُكَهُ على وجه الأرض، ويكونُ إضجاعك الشّيءَ على الأرضِ سَدْحاً، نحو القِرْبة المملوءة المسدوحة إلى جَنْبك. قال أبو النجم: «1»
يأخذ فيه الحيّةَ النَّبوحا ... ثمَّ يَبيتُ عنده مَذْبوحا
مُشَدَّخَ، الهامةِ أو مَسْدوحا
حدس: الحَدْسُ: التَّوهّمُ في معاني الكلام والأمور. تقول: بَلَغني عنه أمرٌ فأنا أَحْدِسُ فيه، أي: أقول فيه بالظَّنّ. والحَدْسُ: سُرْعةٌ في السَّيْر، ومُضِيُّ على طريقةٍ مُسْتمرّة. قال «2» :
كأَنَّها من بَعْدِ سيرٍ حَدْسِ
وحُدَسُ: حيٌّ من اليَمَن بالشّام. والعربُ تختلف في زَجْرِ البَغْل، فيقول: عَدَس، وبعض يقول: حَدَس، والحاءُ أصوبُ. ويقال: إنّ حَدَساً قومٌ كانوا بَغّالينَ على عهد سُلَيْمانَ بن داودَ عليهما السّلام، وكانوا يَعْنُفُون على البغال، فإذا ذُكِروا نفرتِ البغالُ خوفاً مما كانت تَلْقَى منهم.
دحس: الدَّحْسُ: التَّدْسيسُ للأمْرِ تَسْتبطِنُه وتَطْلُبُهُ أَخْفَى ما تَقْدِر عليه، ولذلك سميت دودة تحت التراب دحّاسة. وهي صَفْراء صُلْبة داهية، لها رأس مشعب
__________
(1) التهذيب 4/ 281. اللسان (سدح) ، غير منسوب.
(2) التهذيب 4/ 282. اللسان (حدس) غير منسوب.
(3/131)
________________________________________
يَشُدُّه الصّبيان في الفخاخِ لصَيْد العصافير، لا تؤذي. قال: [في الدّحس بمعنى] «1» الاستيطان: «2»
ويَعْتِلونَ مَنْ مَأَى في الدَّحْسِ
من مأى: أي: من نمَّ. والمَأْيُ النّميمة. مَأَتُّ بين القوم: نَمَمْتُ.
باب الحاء والسين والتاء معهما س ح ت يستعمل فقط
سحت: السُّحْتُ: كلُّ حرامٍ قبيح الذِّكْر يلزَمُ منه العارُ- نحو ثمن الكلب والخمرِ والخنزيرِ. وأَسْحَتَ الرّجلُ: وقع فيه. والسُّحْتُ: جَهْدُ العذاب. وسحتناهم- وأسحتنا بهم لغة- أي: بلغنا مجهودهم في المشقّة عليهم. [قال] الله عز وجل: فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ «3» . قال الفرزدق: «4»
وعَضّ زَمانٌ يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مُسْحَتٌ أو مُجَلَّفُ
أي: مُقَشَّر، ورجل مَسْحوتُ الجوف، أي: لا يَشْبَع. قال: «5»
يُدْفَعُ عنه جَوْفُهُ المَسْحُوتُ
أي: سَحَتَ جَوْفَهُ، فَنَحَّى جوانبَهُ عن أذَى يونس عليه السلام.
__________
(1) من التهذيب 4/ 284 في روايته عن العين.
(2) (العجاج) . ديوانه ص 482. في النسخ: (يقبلون) مكان (يعتلون) .
(3) طه 61.
(4) نزهة الألباء. ص 20 (أبو الفضل) . وليس في ديوانه (صادر) .
(5) (رؤبة) ديوانه ص 27.
(3/132)
________________________________________
باب الحاء والسين والراء معهما ح س ر، س ح ر، س ر ح، ر س ح مستعملات
حسر: الحَسْر: كَشْطُكَ الشَيْءَ عن الشيءِ. (يقال) : «1» حَسَرَ عن ذراعَيْه، وحَسَرَ البيضةَ عن رأسه، (وحَسَرَت الريحُ السَحابَ حَسْراً) «2» . وانحسَرَ الشيءُ إذا طاوَعَ. ويجيء في الشعر حَسَرَ لازماً مثل انحَسَرَ. والحَسْر والحُسُور: الإِعياء، (تقول) «3» : حَسَرَتِ الدابّة وحَسَرَها بُعْدُ السير فهي حسير ومحسورة «4» وهُنَّ حَسْرَى، قال الأعشى:
فالخَيْلُ شُعْثٌ ما تزال جيِادُها ... حَسْرَى تُغادرُ بالطريق سِخالَها «5»
وحَسِرَتِ العَيْن أيْ: كَلَّتْ، وحَسَرَها بُعْدُ الشيء الذي حَدَّقَتْ نحوه «6» ، قال: «7»
يَحْسُرُ طرف عينه فضاؤه
__________
(1) ما بين القوسين من التهذيب 4/ 286 مما نسبه الأزهري إلى الليث.
(2) ما بين القوسين من التهذيب 4/ 286 مما نسبه الأزهري إلى الليث.
(3) ما بين القوسين من التهذيب أيضا.
(4) هذا ما نرى وهو الصحيح، وفي الأصول المخطوطة: فهو حسير محسور.
(5) ورواية البيت في كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير ص 26:
بالخيل شعثا ما تزال جيادها ... رجعا تغادر بالطريق سخالها
(6) جاء في المحكم 3/ 130: وحسرت العين: كلت، وحسرها بعد ما حدقت إليه، أو خفاؤه. ونقل ابن منظور هذا في اللسان (حسر) .
(7) القائل (رؤبة) والرجز في التهذيب واللسان والديوان ص 3.
(3/133)
________________________________________
وحَسِرَ حَسْرةً وحسراً أي نَدِمَ على أمْرِ فاته، قال مرار بن منقذ: «1»
ما أنا اليومَ على شَيْءٍ خَلا ... يا ابنَهَ القَيْنِ تَوَلَّى بِحسِرْ
أي بنادم. ويقال: حَسِرَ البحرُ عن القرار «2» وعن السَّاحل اذا نضب عنه الماء ولا يُقال: انحسَرَ. وانحَسَرَ الطيْرُ: خَرَجَ من الريش العتيق إلى الحديث، وحَسَّرَها إبّان التحسير: ثَقَّله لأنّه فُعِلَ في مُهلةٍ وشَيء بعد شيء. والجارية تَنْحسِر «3» إذا صار لحمُها في مَواضعه. ورجل حاسر: خلاف الدارع، قال الأعشى:
وفَيْلَقٍ شهباءَ مَلمومةٍ ... تقذِفُ بالدارع والحاسر «4»
وامرأةٌ حاسِرٌ: حَسَرَتْ عنها درعَها. والحَسار: ضرب من النبات يُسلِحّ «5» الإبلِ. ورجل مُحَسَّر أيْ مُحَقَّر مؤذىً. ويقال: يخرج في آخر الزمان رجلٌ أصحابُه مُحَسَّرون أي مُقْصَونَ عن أبواب السُلطان ومجالس الملوك يأتونه من كل أوب كأنهم قزع الخريف يورثهم
__________
(1) هو (المرار بن منقذ العدوي) من شعراء الدولة الأموية. انظر الشعر والشعراء ص 586، وشرح المفضليات لابن الأنباري. والبيت في التهذيب واللسان.
(2) كذا في الأصول المخطوطة، وفي اللسان: العراق. نقول: وهو الصحيح. ولم ترد كلمة العراق في التهذيب.
(3) في التهذيب: والجارية تتحسر.
(4) ورواية البيت في الصبح المنير ص 108:
يجمع خضراء لها سورة ... تعصف بالدارع والحاسر
(5) في (س) : يسلح بلا تشديد.
(3/134)
________________________________________
الله مشارق الأرض ومغاربها.
سحر: السِّحْر: كلُّ ما كان من الشيطان فيه مَعُونة «1» . والسِّحْر: الُأْخَذُة التي تأخُذُ العين. والسِّحْر: البَيان في الفطنة. والسَحْرُ: فعل السِحْرِ. والسَّحّارة: شيءٌ يلعَبُ به الصبيان إذا مُدَّ خَرَجَ على لونٍ، وإذا مُدَّ من جانبٍ آخَرَ خرج على لون آخر مخالف (للأوّل) «2» ، وما أَشْبَهَها فهو سَحّارة. والسَّحْر: الغَذْوُ، كقول امرىء القيس:
ونُسْحَرُ بالطعامِ وبالشَرابِ «3»
وقال لبيدُ بنُ ربيعةَ العامريّ:
فإن تسألينا: فيم نحن فإنّنا ... عصافير من هذا الأنام المُسَحَّرِ «4»
وقول الله- عزَّ وجلَّ-: إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ*
«5» ، أيْ من المخلوقين. وفي تمييز العربية: هو المخلوق الذي يُطعَم ويُسقَى. والسَّحَرُ: آخِرُ الليل وتقول: لقيته سَحَراً وسَحَرَ، بلا تنوين، تجعله اسماً مقصوداً إليه، ولقِيتُه بالسَّحَر الأعلى، ولقيتُه سُحْرةَ وسُحْرةً بالتنوين، ولقيتُه بأعلى سَحَريْن، ويقال: بأعلى السَّحَرَيْن، وقول العجاج:
__________
(1) وعبارة التهذيب فيما نسب إلى الليث: عمل يقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه.
(2) زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(3) وصدر البيت كما في الديوان ص 47 (ط. السندوبي) :
أرانا موضعين لأمر غيب
(4) البيت في التهذيب واللسان والديوان ص 56.
(5) سورة الشعراء الآية 153.
(3/135)
________________________________________
غدا بأعلى سحر و [أجرسا] «1»
هو خَطَأ، كان ينبغي أن يقول: بأعلَى سَحَرَيْنِ لأنَّه أوّلُ تنفُّس الصبح ثمّ الصبح، كما قال الراجز:
مَرَّتْ بأعلى سَحَرَيْنِ تَدْأَلُ «2»
أي تُسرع، وتقول: سَحَريَّ هذه الليلة، ويقال: سَحَريَّةَ هذه الليلة، قال:
في ليلةٍ لا نَحْسَ في ... سَحَريِّها وعِشائِها «3»
وتقول: أسْحَرْنا كما تقول: أصْبَحْنا. وتَسَحَّرْنا: أكَلْنا سَحوراً على فَعولُ وُضِعَ اسماً لِما يُؤكَل في ذلك الوقت. والإسحارَّة: بَقْلة يَسْمَنُ عليها المالُ. والسَّحْر والسُّحْر: الرئة في البطن بما اشتَمَلتْ، وما تَعَلَّق بالحُلقوم، وإذا نَزَتْ بالرجل البِطْنة يقال: انتفخ سَحْرُه إذا عَدا طَوْرَه وجاوَزَ قَدْرَه، وأكثرُ ما يقال للجبان إذا جَبُنَ عن أمرٍ «4» . والسَّحْرُ: أعلى الصَدر،
ومنه حديث عائشة: تُوّفيَ رسول الله صلى الله عليه و [على] آله وسلم- بينَ سَحْري ونحري [ «5» .
__________
(1) الرجز في التهذيب 4/ 293 واللسان والأصول المخطوطة والرواية في كل ذلك: وأحرسا بالحاء المهملة. والصواب ما جاء في الديوان ص 131 (ط. دمشق) وأجرس أي سمع صوته.
(2) الرجز في التهذيب 4/ 293 واللسان ولم نهتد إلى الراجز.
(3) البيت في التهذيب 4/ 293 واللسان، وجاء في س: في ليلةٍ لا نَحْسَ في سحريها أي صبحها وعشائها. ويبدو أن (عشائها) سقطت في النسخ.
(4) وعقب الأزهري على هذا فقال: هذا خطأإنما يقال: انتفخ سحرة للجبان الذي ملأ الخوف جوفه فانتفخ السحر وهو الرئة حتى رفع القلب إلى الحلقوم ومنه قول الله جل وعز: وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا.
(5) روي الحديث في اللسان: مات رسول الله......
(3/136)
________________________________________
حرس: الحَرْس: وقت من الدهر دون الحُقْبِ، قال: «1»
َأْتَقَنه الكاتبُ واختارَهُ ... من سائر الأمثال في حَرْسِهِ
والحَرَسُ هم الحُرّاس والأحراس، (والفعل) «2» حَرَسَ يَحرُسُ، ويحترس أي: يحتَرِزُ: فعل لازم. والأحرَسُ هو الأصَمُّ من البُنيان.
وفي الحديث: أنّ الحريسةَ السرقة «3» .
وحريسةُ الجَبَل: ما يُسرَق من الراعي في الجبال وأدرَكَها الليل قبل أن يُؤويها المَأْوَى.
سرح: سَرَّحنا الإبِل، وسَرَحَتِ الإبِلُ سَرْحاً. والمَسْرَح: مَرْعَى السَّرْح، والسَّرْح من المال: ما يغُدَى به ويُراح، والجميع: سروح، والسارح اسم للراعي، ويكون اسماً للقوم الذين هم السَّرْح نحو الحاضر والسامر وهم الجميع، قال: «4»
سَواءٌ فلا جَدْبٌ فيُعرَفُ جَدْبُها ... ولا سارحٌ فيها على الرَعْي يَشبَعُ
والسَّرْحُ: شَجَرٌ له حَمْلٌ وهي [الآءُ] «5» ، والواحدة سرحة. والسرح: انفجار البول بعد احتباسه.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل.
(2) الزيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(3) يريد أن الكلمة وردت في الحديث وهو: أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة: احترسوا ناقة لرجل فانتحروها التهذيب 4/ 296 واللسان.
(4) لم نهتد إلى القائل.
(5) من اللسان (سرح) . أما في التهذيب فقد ذكر: وهي الألاءة. وفي الأصول المخطوطة: الأواو.
(3/137)
________________________________________
ورجل مُنْسَرِح الثياب أيْ: قليلها خفيف فيها، قال رؤبة:
مُنسَرِحاً إلاّ ذغاليبَ الخِرَقْ «1»
والسَّريحةُ: كل قطعة من خِرْقة مُتَمزِّقة، أو دم سائل مستطيل يابس وما يُشبِهُها، والجميع السَّرائح، قال: «2»
بلَبَّتِهِ سرائحُ كالعَصيمِ
يريد به ضَرْباً من القطران. والسَّريحُ: سَيْرٌ تُشَدُّ به الخَدَمة فوق الرُّسْغ، قال حميد: «3»
.............. ودَعْدَعَتْ ... بأَقْتادِها إلا سَريحاً مُخدَّما
وقولهم: لا يكون هذا في سريح، أيْ في عجلة. وإذا ضاق شَيْء فَفرَّجْتَ عنه، قلتَ: سَرَّحْتُ عنه تَسريحاً فانسرَحَ وهو كتسريحِكَ الشَّعرَ إذا خلَّصت بعضَه عن بعضٍ، قال العجاج:
وسَرَّحَتْ عنه إذا تَحَوَّبا ... رواجِبَ الجَوْفِ الصَّحيلَ الصُّلَّبا «4»
والتَسريح: إرسالُك رسولاً في حاجةٍ سَراحاً. وناقةٌ سُرُحٌ: مُنسَرِحة في سيرها، أي سريعة.
__________
(1) والرجز في الديوان ص 105.
(2) البيت في التهذيب 4/ 299 واللسان (سرح وعصم) منسوب إلى (البيد) ، وصدره: ولم نجده في ديوانه (ط. الكويت) .
(3) هو (حميد بن ثور الهلالي) ، ورواية البيت في ديوانه ص 10:
وخاضت بأيديها النطاف ودَعْدَعَتْ ... بأَقْتادِها إلا سَريحاً مخدما
في الأصول: (ذعذعت) بذال معجمة، و (أفيادها) وهو تصحيف.
(4) لم نجد الرجز في ديوان العجاج ولكننا وجدناه في اللسان وروايته:
............... ... ... رواجب الجوف الصهيل الصلبا
(3/138)
________________________________________
والسِّرْحان: الذئب ويجمع على السَّراح، النون زائدة «1» . والمُنسَرح: ضَرب من الشِعر على [مستفعلن مفعولات مستفعلن] [مرّتين] «2» .
رسح: يقال منه امرأةٌ رَسْحاء [أيْ] لا عَجيزَة لها. قد رَسَحَتْ رَسْحاً. وقد يوصف به الذئب
. باب الحاء والسين واللام معهما ح س ل، س ل ح، س ح ل، ح ل س، ل ح س، ل س ح كلهن مستعملات
حسل: الضَبُّ يُكْنَى أبا حِسْل، والحِسْلُ: ولدُه، ويقال: إنه قاضي الدوابّ والطَّيْر، ويقال: وُصِفَ له آدَمُ وصورتُه- عليه السلام-، فقال الضَّبُّ: وَصَفتُم طَيْراً ينزل الطير من السماء والحوت [في] الماء، فمن كان ذا جَناحٍ فَلْيَطِرْ، ومن كان ذا حافر فليحفر. وجمعة حِسَلةٌ «3» .
سحل: السَّحيل: ثَوْبٌ لا يُبْرَمُ غَزْلُة أي لا يفتل طاقَيْنِ طاقَْين، تقول: سَحَلُوه أي:
__________
(1) وفي التهذيب: الليث: السرحان: الذئب ويجمع على السَّراح. قال الأزهري: ويجمع سراحين وسراحي بغير نون كما قال: ثعالب وثعالي فأما السراح في جمع السرحان فهو مسموع من العرب وليس بقياس.
(2) في الأصول: مستفعلن ست مرات وليس الأمر كذلك. والصواب ما أثبتناه.
(3) وزاد الأزهري في التهذيب: قلت: ويجمع حسول.
(3/139)
________________________________________
لم يَفْتِلوا سَداه «1» ، والجمع السُّحُل، قال «2» :
على كلِّ حالٍ من سَحيلٍ ومُبْرَمِ
والمِسْحَلُ: الحِمارُ الوحشيُّ، والسَّحيل: أشدُّ نهيق الحمار. والسَّحْل: نَحْتُكَ الخَشَبَةَ بالمِسْحَل، أيْ: المِبْرَد، ويقال له ومِبْرَد الخَشَب، إذا شَتَمه. والمِسْحَل: من أسماء الرِّجال الخُطَباء، واللِّسان، قال الأعشى:
وما كنتُ شاحرداً ولكن حَسْبتُني ... إذا مِسْحَلٌ سَدَّى ليَ القَوْلَ أَنطِقُ «3»
ومِسْحَل يقال، اسمُ جِنّيّ الأعشى في هذا البيت، ويُريد بالمِسْحَل المِقْوَل. والريحُ تَسْحَل الأرض سَحْلاً تَكْشِطُ أَدَمَتَها. والسُّحالةُ: ما تحات من الحديد إذا بُرِدَ، ومن الموازين إذا [تَحاتّتْ] «4» ، ومن الذُّرَة والأَرُزِّ إذا دُقَّ شِبْهُ النُّخالة. والسَّحْل: الضرْب بالسياط مما يَكْشِطُ من الجِلد. والمِسَحلان: حَلْقَتان إحداهما مُدْخَلة في الأخرى على طَرَفَي شَكيم الدابّة، وتُجمَع مَساحِل، قال: «5»
__________
(1) وزاد الأزهري: وقال غيره (غير الليث) : السحيل: الغزل الذي لم يبرم، فأما الثوب فإنه لا يسمى سحيلا ولكن يقال للثوب سحل.
(2) القائل هو (زهير بن أبي سلمى) والبيت في مطولته (الديوان ص 14) ، وتمامه:
يمينا لنعم السيدان وجدتما ... على كلِّ حالٍ من سحيل ومبرم
(3) البيت في الصبح المنير ص 148 والديوان (ط مصر) ص 221. وروايته في الأصول المخطوطة: وما كنت شاجردا.... بالجيم.
(4) وعبارة التهذيب: والسُّحالةُ ما تَحاتَّ من الحديد وبرد من الموازين. في س: تحتت، وفي (ط) و (ص) : نحتت ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) القائل (رؤبة) والرجز في ملحقات الديوان ص 180 وروايته
لولا شكيم المسحلين اندقا
وكذلك في التهذيب واللسان.
(3/140)
________________________________________
لولا شَباةُ المِسْحَلَيْنِ اندَقَّاً
وقال: «1»
صُدودَ المَذاكي أفلتتها المساحل
والساحل: شاطىء البحر. والإسْحِل: من شَجَر السِّواك. ومُسْحُلان: اسمُ وادٍ، قال النابغة:
سأربِطُ كلبي أنْ يَريبك نَبْحُهُ ... وإنْ كنتُ أرْعَى مُسْحُلانَ وحامِرا «2»
وشابٌّ مُسْحُلان «3» : طويل حَسَن القامة.
سلح: السَّلْح: السُّلاح، ويقال: هذه الحشيشة تُسَلِّح الإِبِل تسليحاً. والسِّلاح من عِداد الحرب ما كان من حديد، حتى السَّيف وحدَه يُدعَى سِلاحاً، قال:
طَليحَ سِفارٍ كالسِلّاح المُفَرَّد
يعني السيف وحدَه. والسُّلْحة: رُبُّ خاثر يُصَبُّ في النِحْي.
__________
(1) القائل هو (الأعشى) (الصبح المنير ص 187) ، والديوان ص 271. وتمام البيت:
صددت عن الأعداء يوم عباعب ... صدود المذاكي أقرعتها المساحل
(2) والبيت في الديوان (ط أوروبا) ص 82 وروايته:
سأكعم كلبي أنْ يَريبك نَبْحُهُ............... ...........
(3) القائل هو (الأعشى) ، والبيت في الديوان (ط مصر) ص 189، وتمامه:
ثلاثا وشهرا ثم صارت رذية ... طَليحَ سِفارٍ كالسِلّاح المُفَرَّد
وكذلك ورد في التهذيب 4/ 310 واللسان (سلح) من غير عزو.
(3/141)
________________________________________
والمَسْلَحة: قومٌ في عُدَّةٍ قد وُكِّلوا بإزاء ثَغْر، والجميع المَسالِح، والمَسْلَحيٌّ: الواحد المُوَكَّل به. والاِسليح: شجرة تغرُز عليه الإبل. وسَيْلَحِين وسَيْلَحُون ونُصيبِين ونَصيُبون، كذا تُسميه العرب بلغتين.
حلس: الحِلْس: ما وَلِيَ البعير تحت الرحل «1» ، ويقال: فلان من أحلاس الخيل، أي في الفُروسيّة أي كالحِلْس اللازم لظَهْر الفَرَس. والحِلْس للبيت: ما يُبْسَطُ تحت حُرِّ المتاع من مِسْحٍ وغيره. وحَلَسْتُ البعيرَ حَلْساً: غشَّيتُه بحِلْسٍ.
وفي الحديث في الفِتْنة كُنْ حِلْسَ بيتِكَ حتى تأتيك يدٌ خاطية أو مَنِيّةٌ قاضية «2» .
وحَلسَتِ السماءُ: أمطرتْ مطراً رقيقاً دائماً. وعُشّبٌ مُسْتَحِلس: ترى له طرائق بعضها فوق بعض لتراكُمه وسواده. واستَحْلَسَ الليلُ بالظلام، أي: تراكَمَ. واستَحْلَسَ السَّنام إذا رَكِبَتْه رَوادِفُ الشَّحم ورَواكبُه. والحَلِس (بكسر اللام) : [الشجاع الذي يُلازمُ قِرْنَهُ] «3» والحِلْس: أن ياخذ المُصَدِّق مكان الإبل دراهمَ «4» .
__________
(1) وزاد الأزهري في التهذيب فيما نسبه إلى الليث:..... تحت الرحل والقنب، وكذلك حلس الدابة بمنزلة المرشحة تكون تحت اللبد.
(2) وجاءت رواية الحديث في التهذيب واللسان كالآتي:
كن حلسا من أحلاس بيتك في الفتنة......
(3) من التهذيب 4/ 312، لأن الرابع من القداح إنما يسمى حلسا بحاء مكسورة ولام ساكنة.
(4) لم يرد هذا المعنى في غير كتاب العين.
(3/142)
________________________________________
والحِلْسُ: الرّابعُ من القِداح. والمُسْتَحلِس: الذي يلزم المكان.
لحس: اللَّحْسُ: أكل الدَّوابّ «1» الصوف، وأكل الجَراد الخضر والشجر ونحوه. واللاحوس: المشئوم يَلْحَس قومه. واللَّحُوس: الذي يَتَتَبَّع الحلاوة كالذُّباب. والمِلْحَس: الشُّجاع الذي يأكل كل شيء يرتفع إليه.
باب الحاء والسين والنون معهما ح س ن، س ح ن، ن ح س، س ن ح، ن س ح مستعملات
حسن: حَسُنَ الشَيْءُ فهو حَسَن. والمَحْسَن: الموضع الحسن في البدن، وجمعه مَحاسن. وامرأةٌ حَسناء، ورجُل حُسّان، وقد يجيء فُعّال نعتاً، رجلٌ كُرّام، قال الله- جل وعز-: مَكْراً كُبَّاراً «2» . والحسان: الحسن جدا، ولا يقال: رجل أحسنَ. وجارية حُسّانة. والمَحاسِن من الأعمال ضد المساوىء، قال الله- عز وجل-: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ
«3» أي الجنة وهي «4» ضد السوءى.
__________
(1) في التهذيب واللسان: أكل الدود.... نقول: والدابة تشمل الحيوان كافة مما يدب على الأرض، والدود على ذلك مما يدب أيضا.
(2) سورة نوح، الآية 22.
(3) سورة يونس، الآية 26.
(4) في ص وط: هو.
(3/143)
________________________________________
وحَسَن: اسم رَمْلةٍ لبني سعْد «1» . وفي أشعارهم يوم الحَسَن، وكتاب التَّحاسين، وهو الغليظ ونحوه من المصادر، يُجْعَل اسماً ثم يجمع كقولك: تقاضيب الشَّعُر وتكاليف الأشياء.
سحن: السُّحْنة: لينُ البشرة، والناعم له سُحْنة. والمُساحنة: المُلاقاة. والسَّحْن: دَلْكُكَ خشبةً بِمَسْحَنٍ حتى تلين من غير أن يأخذ من الخشبة شيئاً.
نحس: النَّحْس: خلاف السَّعْد، وجمعه النُحوُس، من النجوم وغيرها. يومٌ نَحِسٌ وأيّام نَحِسات، من جعله نعتاً ثَقّله، ومن أضاف اليوم إلى النَحْس خَفَّفَ النَحْس. والنُّحاس: ضربٌ من الصُّفْر شديد الحُمْرة، قال النابغة:
كأنَّ شِواظَهُنَّ بجانِبَيْه ... نُحاسُ الصُّفْر تضربه القُيُون «2»
والنُحاس: الدُّخان الذي لا لهب فيه، قال: «3»
يُضيءُ كضوء سراج السليط ... لم يجعل الله فيه نُحاسا
والنِّحاس: مبلغ طبع وأصله، قال: «4»
__________
(1) في التهذيب: والحسن نقا في ديار بني تميم معروف. نقول: ولم يذكر ياقوت في معجمه
(2) البيت في ديوان النابغة (تحقيق شكري فيصل) ص 262.
(3) قائل البيت هو (الجعدي) كما في اللسان (نحس) .
(4) نسب الرجز خطأ في اللسان إلى (لبيد) والصواب أنه من قول (رؤبة) كما في ملحق مجموع أشعار العرب ص 175، والرواية فيه:
......... ... عني ولما يبلغوا أشطاسي
(3/144)
________________________________________
يا أيها السائل عن نِحاسي ... عَنّي ولمّا تَبلُغَنْ أشطاسي
سنح: سَنَحَ لي طائر وظبيٌ سُنُوحاً، فهو سانح إذا أتاك عن يَميِنكَ، يُتَيَمَّنُ به، قال الشاعر: «1»
أبالسنح الأَيامِنِ أمْ بنَحْسِ ... تمُرُّ به البَوارحُ حينَ تجري
وسَنَحَ لي رَأْيٌ أو قريضٌ أيْ: عَرَض. وكان في الجاهلية امرأةٌ تَقومُ في سوق عكاظ فتُنْشد الأقوالَ وتضرِب الأمثالَ وتُخْجِل الرجالَ، فانْتَدَبَ لها رجلٌ، فقالتْ ما قالتْ، فأجابها فقال:
أسيكتاك جامِحٌ ورامِحٌ ... كالظَّبْيَتَيْنِ سانِحٌ وبارِحٌ «2»
فَخَجِلَتْ وهَرَبَتْ.
نسح: النَّسْحُ والنُّساح: ما تحاتَّ عن التَّمْر من قِشْره، وفُتات أقْماعه ونحوه مما يبقى في أسفل الوعاء. والمِنْساح: شَيْءٌ يُدْفَعُ به التراب ويذرى به.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل، والبيت في اللسان، والتاج (سنح) ، غير منسوب أيضا
(2) الرجز في التهذيب 4/ 321. واللسان (رسخ) ، غير منسوب أيضا. في (ط) : إسكتاك وفي التهذيب 4/ 321 عن العين: وأسكتاك (بفتح الهمزة) وليس بالصواب.
(3/145)
________________________________________
باب الحاء والسين والفاء معهما ح س ف، ح ف س، س ح ف، س ف ح، ف س ح، ف ح س، كلهن «1» مستعملات
حسف: حُسافة التَّمْر: قُشوره ورديئة، (تقول) «2» : حَسَفْتُ التَّمْرَ أحسِفُه حسَفاً: نَقَّيْتُه «3» .
حفس: رجل حِيْفْسٌ، وامرأة حِيَفْساء، والحِيَفْساء إلى القِصَر ولؤم الخِلْقة.
سحف: السَّحْف: كَشْطُكَ الشَّعَر عن الجلد حتى لا يبقى منه شيء تقول: «4» سَحَفتُه سَحْفاً. والسَّحائف، الواحدة سَحيفة: طرائق الشَّحْم التي بين طرائق الطَفاطِف ونحوها ممّا يُرَى من شَحْمة عريضة مُلْزَقة «5» بالجِلْد. وناقة سَحوف: كثيرةُ السَّحائف، وجَمَلٌ سَحوف كذلك، قال: «6»
بجَلْهَة عِلْيانٍ سَحوِف المعقب «7»
__________
(1) رتبنا المواد على النحو الذي أثبتناه وخالفنا ما جاء في الأصول المخطوطة جريا على نظام التقليب المتبع في العين والذي احتذاه الأزهري في التهذيب وابن سيده في المحكم. وقد رتبت المواد في الأصول المخطوطة الثلاث على النحو الآتي: سحف، حسف، سفح، فسح، فحس، حفس.
(2) كذا ورد في س وفي التهذيب فيما نسب إلى الليث، وليس شيء من ذلك في ص وط.
(3) كذا في الأصول المخطوطة، ولكن في التهذيب جاء: نفيته (بالفاء) وهو تصحيف.
(4) كذا في س وفي التهذيب وقد خلا من ذلك كل من ص وط.
(5) كذا في ص وط أما في س والتهذيب ففيهما: ملتزقة.
(6) لم نهتد إلى القائل.
(7) كذا في ص أما في ط وس فقد جاء: جلهة عليان.....
(3/146)
________________________________________
والقطعة منه سَحيفة وتكون سَحْفة. والسُّحاف: السِّلُّ. والسَّحُوف من الغنم: الرقيقة صُوف البطن. والسَّيْحَف: النَّصْل العريض، والجميع: السَّياحف.
سفح: سَفْح الجَبَل: عُرضهُ المُضْطَجع، وجمعه سُفُوح. وسَفَحَتِ العَيْنُ دَمْعَها تَسْفَحُ سَفْحاً. وسَفَحَ الدَّمْعُ يَسفَحُ سَفْحاً وسُفُوحاً وسَفَحاناً، قال الطرماح:
سِوى سَفَحانِ الدمْعِ من كُلِّ [مَسْفَحِ] «1»
وسَفْحُ الدَّمِ كالصَّبِّ. ورجلٌ سَفّاح: سَفّاكٌ للدِماء. والمُسافَحة: الإقامة مع امرأة على فجور من غير تزويج صحيح، ويقال لابن البغي: ابن المُسافحة.
وقال جْبِريل: يا مُحمَّد ما بينك وبين آدَمِ نِكاح لا سِفاحَ فيه.
والسَّفيحان: جُوالِقانِ يُجْعَلانِ كالخُرْج «2» ، قال:
تَنُجو إذا ما اضطَرَبَ السَّفيحانْ ... نَجاءَ هِقْل جافلٍ بفَيْحانْ «3»
__________
(1) من الديوان (ط أوروبا) ص 72 واللسان (سنح) ، أما الأصول فالبيت فيهن:
سِوى سَفَحانِ الدمْعِ من كل مدمع
نقول: والذي نراه أن الخلاف وهم وخطأ في رواية العين ولعل ذلك من أحد النساخ فثبت في هذه الأصول المتأخرة. وليس من قصائد الديوان على هذا الوزن ما كان رويه عينا مكسورة.
(2) جاء في التهذيب مما نسب إلى الليث:..... يجعلان كالخرجين.
(3) كذا في التهذيب واللسان أما الرواية في الأصول المخطوطة فهي:
............... .......... ... نجاء هقل حافل بفيحان
وقد جاء في حاشية محقق التهذيب 4/ 326: أنه للجعيل كما في كتاب مشارف الأقاويز في محاسن الأراجيز ص 299، والرواية فيه السبيجان بدلا من السفيحان.
(3/147)
________________________________________
والَّسفيح: من أسماء القِداح.
فسح: الفُساحة: السَّعَة في الأرض، بَلَدٌ فَسيح»
وأمر فَسيح، فيه فَسحة أي: سَعَة. والرَّجل يَفسَحُ لأخيه في المجلس: يُوسِّعُ عليه. والقَوم يَتَفَسَّحُون إذا مَكَّنُوا. وانفَسَحَ طرْفه إذا لم يَردُدْه شيءٌ عن بُعْد النَّظَر. والفُساح: من نَعْت الذَّكَر الصُّلْب «2» .
فحس: الفَحْس: أَخذُك الشَيْءَ بلسانِك وفَمِك من الماء ونحوه، فَحَسَه فَحْساً.
باب الحاء والسين والباء معهما ح س ب، ح ب س، س ح ب، س ب ح، «3» مستعملات
حسب: الحَسَبُ: الشَرَف الثابت في الآباء. رجل كريم الحَسَب حسيبٌ، وقَوْمٌ حُسَباءُ،
وفي الحديث: الحَسَبُ المالُ، والكَرَمُ التقوى «4» .
__________
(1) وقد ورد في التهذيب، بعد بلد فسيح مما نسب إلى الليث: ومفازة فسيحة
(2) لم نجد هذا المعنى وهذا النعت للذكر في سائر المعجمات.
(3) لم يكن ترتيب المواد على هذا النحو في الأصول المخطوطة، وهذا الترتيب المثبت يوافق نظام التقليب.
(4) وفي التهذيب في هذا الموضع زيادة فيما جاء في الكلام المنسوب إلى الليث وهي:
وروي عن النبيّ صلى الله عليه أنه قال: تنكح المرأة لمالها وحسبها وميسمها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك.
(3/148)
________________________________________
وتقول: الأَجْر على حَسَب ذلك أي على قَدْره،
قال خالد بن جعفر للحارث بن ظالم: أما تَشكُرُ لي إذْ جَعَلْتُك سيِّد قَومِكَ؟ قال: حَسَبُ ذلك أشكُرُكَ.
وأمّا حَسْب (مجزوماً) فمعناه كما تقول: حَسْبُك هذا، أيْ: كَفاكَ، وأَحْسَبَني ما أعطاني أي: كفاني. والحِسابُ: عَدُّكَ الأشياء. والحِسابةُ مصدر قولِكَ: حَسَبْتُ حِسابةً، وأنا أحْسُبُه حِساباً. وحِسْبة أيضاً «1» ، قال النابغة:
وأَسْرَعَتْ حِسْبةً في ذلك العَدَدِ «2»
وقوله- عز وجل-: يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ* «3» اختُلِفَ فيه، يقال: بغير تقدير على أجْرٍ بالنقصان، ويقال: بغير مُحاسَبةٍ، ما إنْ يخاف أحدا يحاسبه «4» ، ويقال: بغير أن حَسِبَ المُعطَى أنّه يعطيه: أعطاه من حيثُ لم يَحتَسِبْ. واحتَسَبْتُ أيضاً من الحِساب والحسبة مصدر احتِسابك الأجْرَ عند الله. ورجلٌ حاسِبٌ وقَوْمٌ حُسّاب. والحُسْبان من الظنّ، حَسِبَ يحسَبُ، لغتان، حُسْباناً، وقوله- عز وجل-: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ
«5» ، أي قُدِّرَ لهما حِسابٌ معلوم في مواقيتِهما لا يَعدُوانِه ولا يُجاوزانِه. وقوله تعالى: وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ
«6» أي نارا تحرقها.
__________
(1) كذا في ص وط أما في س فقد جاء: والحسبة....
(2) عجز بيت في التهذيب واللسان (حسب) وفي الديوان (ط دمشق) ص 16 وصدره:
فكملت مائة فيها حمامتها
(3) سورة آل عمران الآية 37.
(4) في التهذيب 4/ 333: ما يخاف أحدا أن يحاسبه عليه.
(5) سورة الرحمن الآية 5.
(6) سورة الكهف الآية 40.
(3/149)
________________________________________
والحُسْبان: سهِام قِصارُ يُرمى بها عن القِسِيِّ الفارسية، الواحدة بالهاء. والأَحْسَبُ: الذي ابيضَّتْ جلدتُه من داءٍ ففَسَدَتْ شَعَرتُه فصار أحمَرَ وأبيَضَ، من الناس والإبل وهو الأبرَصُ، قال: «1»
عليه عَقيقتُه أَحْسَبا
عابَه بذلك، أَيْ لم يُعَقِّ له في صِغَره حتى كَبِرَ فشابَتْ عقيقته، يعني شَعَره الذي وُلِدَ معه «2» . والحَسْبُ والتَحسيب: دَفْن الميِّت في الحجارة، قال:
غَداةَ ثَوَى في الرَّمْل غيرَ مُحَسَّبِ «3»
أيْ غيرَ مُكَفَّن.
حبس: الحَبْس والمَحْبِس: موضعان للمحبوس، فالمَحْبِس يكون سِجْناً ويكون فعلاً كالحَبْس. والحَبيس: الفَرَس: يُجْعَل في سبيل الله. والحِباس: شيء يُحْبَس به نحو الحِباس في [المَزْرَفة] «4» يحبس به فضول الماء.
__________
(1) هو (امرؤ القيس) كما في الديوان (ط. المعارف) ص 128، واللسان (حسب) . وصدر البيت:
أيا هند لا تنحكي بوهة
(2) جاء بعد هذا نص ليس من العين، فيما نرى، وهو: قال القاسم: الأحسب: الشعر الذي نعلوه حمرة. أدخله النساخ في الأصل.. نحسب أنه من كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، فقد جاء في التهذيب 4/ 334: وقال أبو عبيد: الأحسب: الذي في شعره حمرة وبياض.
(3) كذا في التهذيب واللسان، ورواية ابن سيده: في الترب بدلا من قوله في الرمل. وهو غير منسوب إلى قائل.
(4) كذا في التهذيب واللسان في الأصول المخطوطة: الدرقة. ولا معنى للدرقة. وجاء في مادة حبس في اللسان. أن الحباسة هي المزرفة بالفاء أي ما يحبس به الماء. ولم نجد في مادة زرف لفظ المزرفة بل وجدنا فيها: الزرافة: منزفة الماء.
(3/150)
________________________________________
والحباسة في كلام العجم: (المكلا) «1» ، وهي التي تُسَمَّى المَزْرَفة، وهي الحباسات في الأرض قد أحاطت بالدَّبْرة يُحْبَس فيها الماء حتى يمتلىء ثم يُساق إلى غيرها. واحتَبَسْتُ الشَيْءَ أي خَصصتُه لنفسي خاصَّةُ. واحتَبَست الفِراشَ بالمِحْبَس أي بالمِقْرَمة «2» .
سحب: السَّحْبُ: جَرُّكَ الشَّيْءَ، كسَحْب المرأةِ َذْيَلها، وكسَحْبِ الريحِ التُرابَ. وسُمِّيَ السَّحابُ لانسحابه في الهواء. والسَّحْبُ: شدَّة الأكْل والشُّرْب، رجلٌ أُسْحُوب «3» : أَكُولٌ شَروبٌ. ورجل مُتَسَحِّب: حريص على أكل ما يوضَع بين يَدَيْه.
سبح: قوله- عز وجل- إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا
«4» ، أي: فَراغاً للنَّوم عن أبي الدُّقَيْش، ويكون السَّبْحُ فراغاً باللَّيْل أيضاً. سُبْحانَ اللهِ: تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي أن يُوصَف به، ونَصبُه في موضع فِعْلٍ على معنى: تَسبيحاً لله، تُريدُ: سَبَّحْتُ تَسبيحاً للهِ [أي: نزَّهتُه تنزيهاً] «5» . ويقال: نُصِبَ سُبحانَ الله على الصرف، وليس بذاك، والأول أجود.
__________
(1) هكذا رسمت في الأصول، ولم نهتد إلى ضبطها.
(2) المقرمة: ما يبسط على وجه الفراش للنوم. انظر التهذيب (حبس) 4/ 343
(3) عقب الأزهري في التهذيب 4/ 336 فقال: قلت الذي عرفناه وحصلناه رجل أسحوت بالتاء إذا كان أكولا شروبا، ولعل الأسحوب بهذا المعنى جائز.
(4) سورة المزمل الآية 7
(5) من التهذيب 4/ 338 عن العين. في الأصول: تنزهه
(3/151)
________________________________________
والسُّبُّوح: القُدُّوس، هو اللهُ، وليس في الكلام فُعُّول غير هذين. والسُّبْحةُ: خَرَزات يُسَبَّح بعددها.
وفي الحديث أن جبريل؟ قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم-: إن لله دون العرش سبعين حِجاباً لو دَنَونا من أحدها لأَحْرَقَتْنا سُبُحاتُ وَجْهِ رَبِّنا
يعني بالسُّبْحة جَلالَه وعَظَمَتَه ونورهَ. والتَّسبيح يكونُ في معنى الصلاة وبه يُفسَّر قوله- عَزَّ وجل- فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ «1» ، الآية تأمُرُ بالصَّلاة في أوقاتِها، قال الأعشى:
وسَبِّحْ على حينِ العَشِيّات والضُّحَى ... ولا تَعْبُدِ الشَّيطانَ واللهَ فاعبُدا «2»
يعني الصلاة. وقوله تعالى: فَلَوْلا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
«3» يعني المُصَلِّين. والسَّبْح مصدرٌ كالسِّباحة، سَبحَ السابحُ في الماء. والسابح من الخَيْل: الحَسَنُ مَدِّ اليَدَيْن في الجَرْي. والنُجُوم تَسْبَح في الفَلَك: تجري في دَوَرانه. والسُّبْحة من الصلاة: التَطَوُّع.
__________
(1) سورة الروم الآية 17.
(2) ديوانه ص 137، وقد لفق من بيتين له، هما:
وذا، النصب المنصوب لا تنسكنه ... ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا
وصل على حينِ العَشِيّات والضُّحَى ... ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا
(3) سورة الصافات الآية 143.
(3/152)
________________________________________
باب الحاء والسين والميم معهما ح س م، ح م س، س ح م، س م ح، م س ح «1» مستعملات
حسم: الحَسْم: أن تَحسِمَ عِرْقاً فتَكويه لئلاّ يَسيل دمه. والحسم: المنع، والمحسوم: الذي حُسِمَ رَضاعُه وغِذاؤه. وحَسَمْتُ الأمْرَ أي: قَطعتُه حتى لم يُظفَر منه بشيء، ومنه سمِّي السَّيفُ حُساماً لأنّه يحسِمُ العدوَّ عَمَا يُريد، أي يمنَعُه. والحُسُوم: الشُّؤْم، تقول: هذه ليالي الحُسُوم تحسِم الخَير عن أهلها، كما حُسِمَ عن قَوم عادٍ في قوله تعالى: ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً
«2» أي شُؤْماً عليهم ونَحْساً «3» . حُسُم: موضع، قال: «4»
وأدْنَى مَنازلِها ذو حُسُمْ
وحاسم: موضع. وحَيْسُمان: اسم رجل «5» .
__________
(1) هذا هو الترتيب في المواد الذي اقتضاه نظام التقليب، وهو غير ما ذكر في الأصول المخطوطة. وفي أن المستعملات هي مواد أما السادسة (محس) فقد عدها الخليل من المهمل في حين ذكرها الأزهري في التهذيب وأدرج فيها قدرا موجزا من الفوائد.
(2) سورة الحاقة الآية 7.
(3) بعده بلا فصل: قال القاسم: حسوما: متتابعة. رفعناها من الأصل لأنها تعليق أدخله النساخ فيه. والقاسم هو أبو عبيد القاسم بن سلام، كما سبق أن بينا ذلك في هامشنا (ص 149)
(4) القائل هو (الأعشى) ، والبيت في ديوانه (الصبح المنير) ، وتمام البيت فيه:
فكيف طلابكها إذ نأت ... وأدنى مزارا لها ذو حسم
وكذلك في ديوانه (شرح الدكتور محمد حسين) ص 35، وفي الديروانين: (وأدنى مزارا) بالنصب، وهو لحن. ورواية البيت في معجم ما استعجم (2/ 446) :
وأدنى ديار بها ذو حسم
(5) وزاد الأزهري في التهذيب مما نسب إلى الليث:.... اسم رجل من خزاعة. وفي القاموس: ابن إياس الخزاعي، صحابي.
(3/153)
________________________________________
حمس: رجُلٌ أحْمَس أي شجاع. وعامٌ أحْمَس، وسنة حَمْساء أي شديدة، ونَجْدَة حَمْساء يُريد بها الشجاعة، قال «1» :
بنجدةٍ حَمْساءَ تُعدي الذَّمْرا
ويقال: أصابَتْهم سِنُونَ أحامِسُ لم يُرِد به مَحْضَ النَّعْت، ولو أرادَه لقال: سِنونَ حُمْسٌ، وأريد بتذكيره الأعوام. والتَنَّور: هو الوَطيس والحَميس. والحُمْسُ: قُرَيش. وأحماس العَرَب: أُمُّهاتُهم من قُرَيش، وكانوا مُتَشدِّدين في دينهم، وكانوا شُجَعاء العرب لا يُطاقُون، وفي قَيْسٍ حُمْسٌ أيضا، قال:
والحُمْسُ: قد تُعلَمُ يوم مأزق «2»
والحمس: الجَرْس، قال:
كأن صَوْتَ وَهْسِها تحتَ الدُجَى ... وقد مضى ليل عليها وبَغَى «3»
حَمْسُ رجالٍ سَمِعُوا صَوْتَ وَحَا «4»
والوَحَى مثل الوَغَى.
سحم: السُّحْمةُ: سَوادٌ كَلَوْنِ الغُرابِ الأَسْحَم، أي: الأَسْوَد.
__________
(1) الرجز في اللسان غير منسوب (حسم) .
(2) لم نهتد إلى الرجز ولا إلى الراجز.
(3) كذا في ص وط أما في س فقد جاء: سجا
(4) الأول والثالث من هذا الرجز في التهذيب واللسان (حمس) .
(3/154)
________________________________________
والأَسْحَم: اللَّيل في شعر الأعشَى:
بأسحَمَ داجٍ عَوْضُ لا نتفرَّقُ «1»
وفي قول النابغة: السحاب الأسود:
وأسْحَم دانٍ مُزْنُه مُتَصَوِّبُ «2»
سمح: رجلٌ سَمْحٌ، ورجالٌ سُمَحاءُ، وقد سَمُحَ سَماحةً وجادَ بمالِه «3» ، ورجلٌ مِسْماحٌ مَساميح، قال: «4»
غَلَبَ المَساميح الوليد سَماحةً ... وكَفَى قُرَيش المُعضِلاتِ وسادَها
وسَمَحَ لي بذلكَ يَسمَحُ سَماحةً وهو الموافقة فيما طَلَبَ. والتَسميح: السُّرْعة «5» ، والمُسامَحةُ في الطِّعان والضرِّاب والعَدْوِ إذا كانت على مُساهلة، قال: «6»
وسامَحْتُ طَعْناً بالوَشِيج ِالمُقَوَّمِ
ورُمْحٌ «7» مُسَمَّح: تُقِّفَ حتى لان. وكذلك بعير [مسمح] «8» . ورجل
__________
(1) عجز بيت (للأعشى) وصدره:
رضيعَيْ لِبانٍ ثديَ أم تحالفا
، والبيت في ديوانه (الصبح المنير) والتهذيب 4/ 345 واللسان (سحم) .
(2) البيت في الديوان (ط. دمشق) ص 73 وفي اللسان (سحم) ، وصدره:
عفا آية ريح الجنوب مع الصبا
(3) في التهذيب 4/ 345 عن العين.
(4) البيت (لجرير) كما في المحكم 3/ 159 واللسان والتاج (سمح)
(5) وزاد الأزهري في التهذيب مما نسب إلى الليث الرجز الآتي: سمح واجتاز فلاة قيا. وكذلك في اللسان.
(6) الشطر في التهذيب 4/ 346، واللسان (سمح) غير منسوب وغير تام أيضا.
(7) كذا في التهذيب مما نسب إلى الليث، وهو الصواب وذلك لأن في ص وط: ورجل مسمح. وهذا لا يستقيم مع المعنى. وقد جاء في س: ورمح ورجل مسمح، وهو غير وجيه أيضا. والذي أشار إليه محقق التهذيب 4/ 346: أن في بعض النسخ المخطوطة رجل بدل رمح.
(8) آثرنا إضافتها لأنها متطلبة.
(3/155)
________________________________________
مِسْماح أيْ: جَوادٌ عند السَّنة.
مسح: يقال للمريض: مَسَحَ اللهُ ما بكَ، ومَصَحَ أجوَدُ. ورجل ممسوح الوَجْهِ ومَسيحٌ إذا لم يبقَ على أحَد شِقَّي وَجْهه عَيْنٌ ولا حاجبٌ إلا استَوَى. والمَسيحُ الدَّجّال على هذه الصفة. والمَسيحُ عيسِى بن مَرْيَمَ عليه السلام- أُعرِبَ اسمُه في القرآن، وهو في التَوراة مَشيحا «1» ، قال:
إذا المَسيحُ يقتُل المَسيحا
يَعْني عيَسى يقتُل الدَّجّال بنَيْزَكه. والأمْسَحُ من المَفاوِز كالأَمْلَس، والجميع الأماسِحُ. والمِساحةُ: ذَرْعُ الأرض، يقال: مَسَحَ يمسَحُ مَسْحاً ومِساحةً. والمَسْحُ: ضَرْب العنق تمسَحُه بالسَّيْف مَسْحاً ومنه قوله- عز وجل-: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ «2» . والتِّمْسَحُ والتِّمْساح: خَلْقٌ في الماء شَبيهٌ بالسُّلَحْفاة، إلا أنه ضَخْمٌ طويلٌ قَويٌ. والماسِحة: الماشطة. والمُماسحَة: المُلايَنة في المُعاشَرة من غير صفاء القَلْب. وعلى فلانٍ مَسْحةٌ من جَمال، وكانَتْ مَيَّةُ تتمَّنَى لقاء «3» ذي الرُّمَّة فلمّا رَأَتْه استَقْبَحته فقالت: أن تسمع بالمعيدي خير من أن تَراه، فَسِمع ذو الرُمَّة فهَجاها فقال:
على وجْهِ مَيٍّ مَسْحَةٌ من مَلاحةٍ ... وتحت الثَياب الشَّيْن لو كانَ بادياً «4»
__________
(1) كذا في س أما في ص فإنه: مسيحا (بالسين) .
(2) سورة ص الآية 33.
(3) كذا في س أما في ص وط: لقي.
(4) البيت في ديوان ذي الرمة ص 675.
(3/156)
________________________________________
والمَسيحة، قِطعة من الفِضَّة. والمَسيحة والمسايحُ: ما تُرِكَ من الشَّعَر فلم يُعالَج بشَيْءٍ وفُلانٌ يُتَمسَّحُ به لفَضْله وعبادته.
باب الحاء والزاي والدال معهما د ح ز يستعمل فقط
دحز: الدَّحْز: الجِماع.
باب الحاء والزاي والراء معهما ح ز ر، ح ر ز، ز ح ر، ر ز ح «1» مستعملات
حزر: الحَزْر: حَزْرُكَ الشَّيءَ بالحَدس تَحْزِرُه حَزْراً. والحاِزُر والحَزْر: اللَّبَن الحامِض. والحَزْرَةُ: خِيار المال «2» ، قال:
الحزرات حزرات النَّفْسِ «3»
حرز: مكان حَريز: قد حَرُزَ حَرازةً، والحَرَزُ: الخَطَر، وهو الجَوْزُ المَحْكُوك يُلْعَبُ به «4» ، وجمعُه أحراز. وأخطار. والحِرْز: ما أحْرَزْتَ في موضع من
__________
(1) رتبت المواد بحسب ما يقتضي نظام التقليب، وفي الأصول المخطوطة ما يختلف عما أثبتنا.
(2) كذا في التهذيب 4/ 358 عن العين وغيره من المعجمات، في الأصول المخطوطة: الموت: وهو من خطإ الناسخ.
(3) الرجز في التهذيب 4/ 358 واللسان (جذر) غير منسوب
(4) في التهذيب 4/ 360 عن الليث، يلعب بها الصبي.
(3/157)
________________________________________
شَيْء، تقول: هو في حِرْزي. واحتَرَزْتُ من فُلانٍ.
زحر: زَحَرَ يَزْحَر زَحيراً وهو إخراج النَّفَس بأَنين عند شِدَّةٍ ونحوها، والتَزَحُّر مثله. وزَحَرَتِ المرأةُ بوَلَدها، وتَزَحَّرَت عنه إذا وَلَدَتْ، قال: «1»
إني زعيم لك أَن تَزَحَّري ... عن وارِمِ الجَبْهة ضَخْمِ المَنخَرِ
وفُلانٌ يَتَزَحَّرُ بماله شُحّاً.
رزح: رَزَحَ البعيرُ رُزُوحاً أي: أعْيا، وبَعير مِرْزاح ورازِح وهو المُعْيي القائم، وإبِل رَزْحَى ومَرازيح. والمِرْزيح: الصَّوْت.
باب الحاء والزاي واللام معهما ح ز ل، ح ل ز، ز ل ح، ز ح ل، ل ح ز «2» مستعملات
حزل: الإحزِئْلال: الارتِفاع، احزَأَلَّ يَحْزَئِلُّ في السَّيْر وفي الأرض صعداً كما يَحْزَئِلُّ السحاب إذا ارتَفَعَ نحو بَطْن السَّماء. واحزَأَلَّتِ الإبِل: اجتَمَعَتْ ثُمَّ ارتَفَعَتْ على مَتْنٍ من الأرض في ذهابها، قال: «3»
__________
(1) في التهذيب 4/ 357 واللسان (زحر) ، غير منسوب أيضا.
(2) هذا هو ترتيب التقليب وهو غير ما هو موجود في العين.
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى الشطر في غير الأصول.
(3/158)
________________________________________
بَنُو جُنْدَعٍ فاحزَوْزَأَتْ واحزَأَلَّتِ
والاحتِزال: الاحتِزام بالثَّوْب. واحزَوْزَأَتِ الدَّجاجة على بَيْضها: «1» تجافَتْ، وهذا من المضاعف.
حلز: القَلْبُ يَتَحلَّزُ عند الحُزْن كالاعتِصار فيه والتَوَجُّع. وقَلْبٌ حالِز، وإنسانُ حالِز: ذو «2» حَلْزٍ، ويقال: كَبِدٌ [حِلِّزَة وحَلِزَة، أي: قريحة] «3» . ورجلٌ حِلِّزٌ (أيْ بخيل) «4» . وامرأةٌ حِلِّزَةٌ بخيلةٌ.
زلح: (الزَّلْحُ من قولك) : «5» قَصْعةٌ زَلَحْلَحة: لا قَعْر لها.
زحل: زحل الشيء: زال عن مَقامه. والناقة تَزْحَلُ زَحْلاً إذا تأخَرَّت في سَيْرها، قال: «6»
فإنْ لا تُغَيِّرْها قريش بملكها ... يكن عن قُرَيشٍ مُسْتَمازٌ ومَزْحَلُ
وقال: «7»
قد جعلت ناب دكين تزحل
__________
(1) كذا في ص وط أما في س: بيضتها.
(2) جاء في التهذيب: وهو ذوه وهو خطأ صوابه ما أثبتنا مما جاء في الأصول المخطوطة.
(3) من اللسان (حلز) . في الأصول: حلز. وقرحة
(4) زيادة من التهذيب 4/ 362 مما نسبه إلى الليث.
(5) زيادة من التهذيب 4/ 361 مما نسبه إلى الليث.
(6) القائل هو (الأخطل) والبيت في ديوانه ص 11.
(7) الرجز في التهذيب 4/ 363 واللسان (زحل
(3/159)
________________________________________
والمزَحَل: المَوْضِع الذي يُزْحَل إليه. والزَّحُول من الإبل: التي إذا غَشِيَت الحَوْضَ ضَرَبَ الذائد وجْهَها فوَلته عَجُزَها (ولم تَزَلْ تَزْحَلُ حتى تَرِدَ الحوضَ) «1» ، وربَّما ثَبَتَت مقبلةً، قال لبيد في زحل الشيء إذا زال عن مقامه «2» :
لو يقومُ الفيلُ أو فَيَّالُه ... زَلَّ عن مِثْل مَقامي وزَحَلْ
لحز: رجُلٌ لَحِزٌ أي شَحيحُ النفس، وأنشد:
تَرَى اللَّحِزَ الشَّحيحَ إذا أُمِرَّتْ ... عليه لِما له فيها مُهينا) «3»
والتَلَحُّزُ: تَحَلُّبُ فيكَ من أكل رمّانٍة ونحوها «4» . شهوةً.
باب الحاء والزاي والنون معهما ح ز ن، ز ح ن، ن ز ح، ن ح ز مستعملات
حزن: الحُزْن والحَزَن، لغتان [إذا ثقّلوا فتحوا، وإذا ضحّوا خفّفوا، يقال: أصابه حَزَنٌ شديدٌ، وحُزْنٌ شديد] «5» ، ويقال: حَزَنَني الأمرُ [يَحْزُنُني فأنا محزون] وأحزنني [فأنا مُحْزَنٌ، وهو مُحْزِنٌ] ، لغتان أيضاً، ولا يقال: حازن. وروي عن أبي عمرو «6» : إذا جاء الحَزَنُ منصوباً فَتَحوه، وإذا جاء مكسوراً
__________
(1) زيادة من التهذيب 4/ 363 مما نسب إلى الليث.
(2) البيت في التهذيب 4/ 363 واللسان (زحل) ، وديوانه (ط الكويت) ص 194.
(3) ما بين القوسين زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(4) في التهذيب مما نسب إلى الليث: أو إجاصة.
(5) ما بين الأقواس من التهذيب 4/ 364 عن العين أثبتناه، لأن عبارة الأصول قاصرة ومضطربة.
(6) هو أبو عمرو بن العلاء.
(3/160)
________________________________________
مرفوعاً ضَمَّوه، قال الله عز وجل-: وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ «1» وقال- عزَّ اسمه-: وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً «2» . وقوله- عز وجل-: نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
«3» . ضَمُّوا الحاءَ هنا لكَسْرة النون، كأنّه مجرور في استعمال الفعل. وإذا أفردُوا الصَّوْتَ والأمْرَ قالوا: أمْرٌ مُحزن وصَوْتٌ محُزن ولا يقال: حازن. والحَزْنُ من الأرض والدَّوابِّ: ما فيه خُشونة، والأنثى حَزْنة، وقد حَزُنَ حُزونةً. وحُزانةُ الرجل: من يَتَحَزَّن بأمره. ويُسَمِّي سَفَنْجقانية العرب على العجم في أوَّل قُدومهم الذي استَحَقُّوا به ما استَحَقُّوا من الدور والضياع «4» حُزانة «5» .
زحن: زَحَنَ الرجلُ يزْحَنُ زَحْناً، وتَزَحَّنَ تَزَحُّناً أي: أبطَأَ عن أمره وعَمَله. وإذا أرادَ رَحيلاً فعَرَضَ له شُغْل فبَطَّأَ به قلت: له زَحْنةٌ بعد. والرجل الزيحنة «6» : المتباطىء عند الحاجة تُطلَب إليه، قال:
__________
(1) سورة يوسف الآية 84.
(2) سورة التوبة الآية 92.
(3) سورة يوسف الآية 86.
(4) كذا في س أما في ص وط: الضياعة.
(5) عقب الأزهري على ما نقله الليث عن الخليل فقال في التهذيب (4/ 366) فقال: السفنجقانية: شرط كان للعرب على العجم بخراسان إذا افتتحوا بلدا صلحا أن يكونوا إذا مر بهم الجيوش أفذاذا أو جماعات أن؟ ينزلوهم ويقروهم ثم يزودوهم إلى ناحية أخرى في (س) : سفنجانية.
(6) في (س) : الزحنية، ولعله تحريف، فقد جاء رسم الكلمة في التهذيب 4/ 366 وفي مختصر العين (ورقة 70) ، وفي المحكم 3/ 167، وفي اللسان (زحن) مطابقا لما في (ص) و (ط) .. وجاء في القاموس المحيط ما يزيل اللبس، فقد قال: والزيحنة كسيفنة: المتباطىء، وتابعه التاج (زمن) . أكبر الظن أن ما جاء في (س) وما ورد في آخر المادة في النسخ، الثلاث المخطوطة من عبارة: (الحاء ساكنة) ... من فعل النساخ.
(3/161)
________________________________________
إذا ما التَوَى الزِّيحَنَّةُ المُتآزِفُ «1»
نزح: نَزَحَتِ الدارُ تَنْزَح نُزُوحاً أي بَعُدَت. ووَصْل نازح أي بعيد، قال: «2»
أم نازحُ الوصْل مِخلافٌ لشِيمته
ونَزَحْتُ البِئْرَ، ونَزَحْتُ ماءَها، وبئر نَزوحٌ ونَزَحٌ أي قليلة الماء، [ونَزَحَتِ البِئْرٌ، أي: قلّ ماؤها] «3» والصَّواب عندي: نُزِحَتِ البئرُ أي: اسْتُقِيَ ما فيها.
نحز: النَحْز كالنَّخْس. والنَّحْز شَبْهُ الدَّقّ. والراكبُ يَنْحَزُ بصدره واسِطَ الرَّحْل، قال ذو الرمة:
إذا نَحَزَ الإدْلاجُ ثُغرةَ نَحْره ... به أَنَّ مُستْرخي العِمامِة ناعِسُ «4»
قال: والنُّحازُ داءٌ «5» يأخُذُ الإبل والدَّوابَّ في رِئاتها «6» ، وناقةٌ ناحِز: بها نُحاز، قال القطامي:
تَرَى منه صدور الخيل زورا ... كأن بها نحازا أو دكاعا «7»
__________
(1) الشطر في التهذيب غير منسوب.
(2) لم نهتد إلى القائل ولا إلى الشطر.
(3) سقط ما بين القوسين من الأصول المخطوطة الثلاث وأثبتناه مما نقل في التهذيب 4/ 376 عن العين، لتقويم العبارة.
(4) البيت في الديوان ص 317.
(5) في التهذيب 4/ 367: سعال.
(6) كذا في التهذيب مما نسب إلى الليث، وفي الأصول المخطوطة: رئتها.
(7) كذا في ص وط والديوان ص 33. أما في س: فبالراء وهو تصحيف.
(3/162)
________________________________________
والنّاحزِ أيضاً: أن يُصيبَ المِرفقُ كِرْكِرةَ البعير، فيقال: به ناحز «1» ، وإذا أصابَ حَرْفَ الكِرْكَرة المِرفقُ فحزَّة قيلَ: بها حازٌّ، مُضاعَف، فإذا كان من اضطغاط عند الأبِطْ قيل بها ضاغِط. والمِنْحاز ما يُدَقُّ به. ونَحيزة الرجل: طبيعتُه، وتجمع: نَحائز. ونَحيزةُ الأرض كالطِّبَّة ممدودةٌ في بَطن الأرض تقود الفَراسِخَ وأقلّ (من ذلك) «2» ، ويجيء في الشعر نَحائز يُعْنَى بها طِبَبٌ من الخِرَق والأَدَم إذا قُطِعَتْ شرُكُاً طِوالاً.
باب الحاء والزاي والفاء معهما ز ح ف، ح ف ز يستعملان فقط
زحف: الزَّحْف جماعة يزحَفُون إلى عدوِّهم بمَرَّة، فهُم الزَّحْف والجميع زُحُوف. والصَّبيُّ يَتَزَحَّفُ على الأرض قبل أن يمشي. وزَحَفَ البعير يزحَفُ زَحْفاً فهو زاحف إذا جَرَّ فِرْسَنَه من الاعِياء، ويجمع زَواحف، قال: «3» .
على زَواحِفَ تُْزَجى مُخُّهارِيرُ
وأَزْحَفَها طولُ السَّفَر والازدحاف كالتزاحف.
__________
(1) كذا في التهذيب أما في الأصول المخطوطة ففيها: أن يصيب المرفق كركرته. وقد عقب الأزهري على عبارة العين المشار إليها فقال: قلت: لم نسمع الناحز في باب الضاغط لغير الليث، وأراه أراد الحاز فغيره. نقول: وتعقيب الأزهري غير صحيح فقد بين الخليل ذلك بعد الناحز فذكر الحاز الذي أشار إليه الأزهري.
(2) من التهذيب مما نسب إلى الليث وهو ما ذكره الخليل في العين.
(3) القائل هو (الفرزدق) ، والشطر في التهذيب واللسان، وفي الديوان 1/ 213 (ط صادر) والرواية فيه:
على عمائِمنا تُلْقَى وأَرْحلنا ... على زواحف نزجيها محاسير
(3/163)
________________________________________
حفز: الحَفْزُ: [حثّك] الشَّيْءَ حثيثاً من حَلفه، سَوْقاً أو غير سَوْق «1» ، قال: «2»
وقد سِيقَتْ من الرِّجْلَيْن نفسي ... ومن جَنْبي يُحَفَّزُها وَتينُ
أي يحثها الوتين، وهو نِياط القلب، بالخروج. والرجُلُ يَحْتَفِزُ في جلوسه: يُريد القيام أو البَطْش بالشَّيْء. واللَّيْلُ يَحْفِزُ النَّهار: يسوقُه، قال رؤبة:
حَفْزُ الليالي أمَدَ التَّدليف «3»
والحَوْفَزان من الأسماء.
باب الحاء والزاي والباء معهما ح ز ب يستعمل فقط
حزب: حَزَبَ الأمرُ يَحْزُبُ حَزْباً إذا نابَكَ، قال: «4»
فنِعْمَ أخاً فيما ينوبُ ويحزُبُ
وتَحَزَّبَ القَومُ: تَجَمَّعوا. وحَزَّبْتُ أحزاباً: جَمَّعْتُهم. والحِزْبُ: أصحابُ الرجل على رَأْيه وأَمِره، قال العجاج «5» :
لقد وجَدْنا مُصْعَباً ُمَستَصعَبا ... حتى رمى الأحزاب والمحزبا) «6»
__________
(1) من التهذيب 4/ 372 عن العين، في الأصول المخطوطة: الحفز: سوقك الشيء حثيتا من خلفه أو غير سوق وهي عبارة قاصرة مضطربة.
(2) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(3) مجموع أشعار العرب ص 101.
(4) لم نهتد إلى القائل ولا إلى الشطر.
(5) سقط ما بين القوسين من (س) وفي (ص) و (ط) : (رؤبة بن العجاج) وه وهم.
(6) الرجز في ديوان العجاج ص 94، والرواية فيه:
لقد وجدتم مصعبا مستصعبا ... حين رَمَى الأحزابَ والمُحزِّبا
(3/164)
________________________________________
والمؤمنون حزبُ الله، والكافرون حزبُ الشَّيْطان. وكلُّ طائفةٍ تكون أهواؤهم واحدة فهم حزبٌ. والحَيْزَبون: العَجوز، النون زائدة كنون الزيتون. والحزباءة، ممدودة،: أرض حَزْنةٌُ غليظة، وتُجمَع حَزابيّ، قال: «1»
تحِنُّ إلى الدَّهْنا قَلوصي وقد عَلَت ... حَزابيَّ من شَأْز «2» المُناخ جديبا
وعَيْرٌ حَزابيةٌ في استداره خَلَقه، قال النابغة:
أَقَبَّ ككَرِّ الأَنْدَريِّ مُعَقْربٌ ... حَزابية قد كدَّمَتْه المساحل «3»
وركب حزابية، قال: «4»
إن حِري حَزَنْبَلٌ حَزابِيَهْ ... إذا قَعَدْتُ فوقَه نَبابِيَهْ
كالقَدَح المكبوب فَوْقَ الرابيهْ
ويقال: أرادَت: حَزابي أي: رَفَع بي عن الأرض.
باب الحاء والزاي والميم معهما ح ز م، ز ح م، م ز ح، ز م ح، ح م ز، م ح ز كلهن مستعملات
حزم: المِحْزَم: حِزامة البقل، وهو الذي تُشَدُّ به الحُزْمة، حَزَمَه يحزِمُه حزما.
__________
(1) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(2) كذا في ص وط أما في س فهو: شأو.
(3) البيت في الديوان (ط. دمشق) ص 114 والرواية فيه:
أقب كعقد الأندري معقرب............... .............
(4) الرجز في التهذيب 4/ 374 واللسان حزب وهو لا مرأة تصف ركبها
(3/165)
________________________________________
والحِزامُ للدابَّة والصبَّيّ في مَهْده. والمِحْزَم: الذي يَقَع عليه الحِزام من الصَّدْر. والحَزيم: موضِع الحزِام من الصَّدْر والظَّهْرِ كله ما استدارَ به، يقال: شَدَّ حَزيمَه وشَمَّرَ، قال: «1»
شَيْخٌ إذا حمل مكروهة ... شد الحَيازيمَ لها والحَزيمْ
والحَيْزُوم: وَسَط الصَّدْر حيث يلتقي فيه رءوس الجَوانح فوقَ الرُّهابة بحِيال الكاهل، قال ذو الرمة:
تَكادُ تَنْقَضُّ مِنْهُنَّ الحَيازيمُ «2»
والحَيْزوم: اسم فَرَس جِبْريل «3» ع-. والحَزْم أيضاً: َضْبُطَك أمرَكَ وأخْذُكَ فيه بالثقة، حَزُمَ الرجُلُ حَزامةً فهو حازم ذو حَزْمة «4» . والحَزْم: ما احتَزَمَ السَّيْل من نَجَوات الأرضِ والظُهور، وجمعُه حُزُوم.
زحم: زَحَمَ القَوْمُ بَعضُهم بعضاً من شِدَّة الزِّحام إذا ازدَحموا. والأمواجُ تَزْدَحِم، قال: «5»
تَزَاحُمَ المَوْجِ إذا الموج التطم
__________
(1) البيت غير منسوب في التهذيب واللسان.
(2) من قصيدة الشاعر:
أعن ترسمت من خرقاء منزلة
الديوان ص 569 وصدر البيت:
تعتادني زفرات من تذكرها
(3) كذلك في الجمهرة 2/ 149، والمحكم 3/ 172، واللسان، والقاموس والتاج، حزم) .
(4) كذا في الأصول المخطوطة أما في التهذيب فهو: حزم.
(5) الرجز في التهذيب واللسان من غير عزو.
(3/166)
________________________________________
جعل مصدر ازدَحَمَ تَزاحُماً. والفيل والثَّوْر يُكَنَّيانِ أبا مُزاحِم. ومُزاحم أو أبو مُزاحِم: أوّل خاقانٍ ولَيَ التُّرْكَ وقاتَلَ العرب، فقُتِل زَمَنَ أَسَد بن عبد الله القسري.
مزح: المِزاح مصدر كالمُمازَحة، والمُزاحُ الاسم، قال: «1»
ولا تَمْزَح فإن المَزْحَ جَهْلٌ ... وبَعضُ الشرِّ يبدَؤُه المُزاح
مَزَحَ يَمْزَحُ مَزْحاً ومُزاحاً ومُزاحةً.
زمح: الزَّوْمَح [والزُّمَّحُ] : الأسود القبيح من الرجال، ويقال: الزُّمَّح الضيِّق الخُلُق «2» ، قال بعض قريش: «3»
لازُمَّحيّينَ إذا جئْتَهم ... وفي هِياج الحَربِ كالأَشْبُلِ
[والزُّمّاح: طائرٌ عظيم] «4» .
حمز: حمز اللوم فُؤاده وقلبَه أيْ: أوجَعَه، قال الشماخ بن ضرار:
فلما شراها فاضت العين عبرة ... وفي الصدر حزاز من اللوم حامز «5»
__________
(1) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(2) جاء في التهذيب 4/ 378: الزمح القصير السمج الخلقة السيىء الأدم المشئوم. ما بين القوسين زيادة من مختصر العين (ورقة 71) .
(3) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(4) من مختصر العين- الورقة 71.
(5) البيت في الديوان (ط. دار المعارف) ص 190 والرواية فيه:
............... ........... ... وفي الصدر حزار من الوجد حامِزُ
(3/167)
________________________________________
الحامِز: الشديدُ من كلِّ شيء. ورجل حامِزُ الفؤاد: شديدُه.
وقال ابن عباس: أفضل الأشياء أحمزها
أي: أَشَدُّها وأَمتَنُها «1»
محز: المَحْزُ: النِكاح، تقول: مَحَزَها، قال جرير:
مَحَزَ الفرزدق أُمَّه من شاعرِ «2»
باب الحاء والطاء والراء معهما ط ح ر، ط ر ح يستعملان فقط
طحر: الطَّحْر: قَذْف العَيْن قذاها «3» ، وطَحَرتِ العَيْنُ الغَمَصَ أي رَمَت به، قال: «4»
وناظرتَيْنِ تطحَران قَذَاهما
وقال في عَيْن الماء: «5»
تَرَى الشريريغ يطفو فوق طاحرة ... مسحنطرا ناظرا نحو الشناغيب
(يصف عَيْنَ ماء تفُور بالماء، والشُّرَيْرِيغ: الضِّفْدَع الصغير،
__________
(1) جاء في اللسان (حمز) :
وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أفضل؟ قال: أحمزها عليك
يعني أمتنها وأقواها وأشدها، وقيل: أمضها وأشقها. (أشدها) في الأصل: زيادة من (س) .
(2) البيت في ديوان جرير ص 307 وصدره:
كان الفرزدق شاعرا فخصيته
وقد ورى نساخ الأصول المخطوطة عن الفرزدق فأثبتوا وزنه الصرفي الفعلل.
(3) والرواية في التهذيب: بقذاها.
(4) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى البيت.
(5) لم نهتد إلى القائل، والبيت في التهذيب واللسان (طحر) .
(3/168)
________________________________________
والطاحرةُ: العَيْن التي ترمي ما يُطْرْح فيها لشِدَّة حَمْوَة مائها من مَنبَعها وقُوَّة فَوَرانه، والشَّناغيب والشَّغانيب: الأغصان الرَّطْبة، واحدها شُغْنُوب وشُنْغوب، والمُسْحَنْطِر: المشرف المنتصب) «1» . وقوس مطحرة: ترمي بسهمها صُعُداً لا تقصِدُ إلى الرَّمِيَّة. والقَناة إذا التَوَتْ في الثِّقاف فوَثَبَتْ فهي مِطْحَرة، وأما قول النابغة: مِطْحَرةُ زَبون «2» فإنّه نعت للحرب. والطَّحِير: شِبْه الزَّحير.
طرح: طَرَحْتُ الشَّيْءَ فأَنا أطْرَحُه طَرْحاً، والطِّرْح: الشَّيْءُ المطروحُ لا حاجة لأحَدٍ فيه. والطَّروح: البعيد نحو البَلْدة وما أشبهها.
باب الحاء والطاء واللام معهما ط ل ح، ط ح ل، ل ط ح، ح ل ط مستعملات
طلح: شَجَرُ أمِّ َغْيلان، شَوْكُه أَحْجَنُ، من أعظم العِظاه شَوْكاً، وأصلبِه عُوداً واجوده «3» صَمْغاً، الواحدة طَلْحة. والطَّلْح في القرآن المَوْز.
__________
(1) ما بين القوسين كله من التهذيب مما نسب إلى الليث، ولم يرد منه في الأصول المخطوطة إلا قوله: يعني: أغصان الشجرة تدلت، الواحد شنغوب.
(2) لم نجد هذه العبارة في قصيدة (النابغة) النونية من الوافر (الديوان ط دمشق ص 256) بل هناك عبارة حرب زبون في قوله: وحالت بيننا حرب زبون.
(3) كذا في (ص) و (ط) وفي التهذيب 4/ 383 عن العين. في (س) : أصلبها، أجودها.
(3/169)
________________________________________
والطَّلاح نقيض الصَّلاح، والفعل طلح يطلح طَلاحاً. وذو طَلَح: مَوضِع: قال: «1»
ورأيْتُ المرءَ عَمْراً بِطَلَحْ
قال بعضهم: رأيته يَنْعُمُ بنعمة، وهو غلط، إنما عمرو هذا بموضعٍ يقال له: ذو طَلَح، وكان مَلِكاً. والطَّلاحة: الإِعياء وبَعيرٌ طَليحٌ، وناقةٌ طَليح، وطِلْح أيضاً، قال: «2»
فقد لَوَى أنْفَه بمِشْفَرها ... طِلْحُ قَراشيمَ شاحِبٌ جَسَدُهْ
والقُرْشُوم: شَجَرَةٌ تزعمُ العرب أنّها تُنْبِتُ القِرْدان، والقُرْشُوم: القُراد الضَّخْم.
طحل: الطُّحْلة: لوْنٌ بين الغُبْرة والبَياض في سَوادٍ قليل كسَواد الرَّماد. وشَرابٌ طاحِل: ليس بصافي اللَّوْن، والفعل طَحِلَ يطْحَل طَحَلاً. وذِئبٌ أطحَلُ، ورَماد أطحَلُ. والطِّحال معروف. ورجل مطحول إذا ديء «3» طِحالُه.
لطح: اللَّطْح كاللَّطْخ إذا جَفَّ ويُحَكُّ لم يبْقَ له أثَرٌ. واللَّطْحُ كالضرب باليد.
__________
(1) القائل هو (الأعشى) ديوانه 237- والرواية فيه: كم رأينا من أناس هلكوا
وكم رأينا من أناس هلكوا ... ورأينا المرء عمدا بطلح
(2) القائل هو (الطرماح) ، والبيت في التهذيب واللسان والديوان (ط. القاهرة) ص 118.
(3) في الأصول المخطوطة: دئي، والصواب ما أثبتناه.
(3/170)
________________________________________
حلط: حَلَطَ فلان إذا نَزَل بحال مَهْلكة. والاحتِلاط: الاجتِهادُ في مَحْكٍ ولَجاجة. وأحْلَطَ الرجل بالمكان إذا أقامَ به، قال ابن أحمر:
وأحْلَطَ هذا: لا أريمُ مَكانيا «1»
باب الحاء والطاء والنون معهما ط ح ن، ح ن ط، ن ح ط، ن ط ح، ط ن ح، مستعملات
طحن: الطِّحْن: الطَّحين المطحون، والطَّحْن الفِعل، والطِّحانة: فعل الطَّحّان. والطّاحُونة: الطَّحّانة التي تدور بالماء. وكل سن من الأضراس طاحنة. والطُّحَنَةُ: دُوَيْبَّةِ كالجُعَل، ويُجْمَع [على] طُحَن. والطّحون: الكتيبة [من الخيل] تَطْحَن كُلَّ شيءٍ بحَوافرها.
حنط: الحِنْطة: البُرُّ. والحِناطةُ: حِرفة الحَنّاط، وهو بَيّاع البُرِّ. والحَنُوط: يُخلَط (من الطِّيب) «2» للميِّت خاصَّةً،
وفي الحديث: أنّ ثَمُوداً لمّا أيقَنُوا بالعذاب تَكَفَّنُوا بالأَنْطاع وتَحَنَّطوا بالصبر «3» .
__________
(1) البيت في التهذيب و 4/ 387 واللسان (حلط) ورواية اللسان: لا أعود ورائيا وصدره:
(2) زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث. وفي (س) : يحنط به الميت خاصة.
(3) التهذيب 4/ 390.
(3/171)
________________________________________
نحط: النَّحْطةُ: داءٌ يُصيب (الخيل) «1» والإبل في صدورها، فلا تكاد تسلم منه. والنَّحْطُ شِبْه الزَّفير، والقَصَّار يَنْحِط إذا ضَرَب بثوبِه على الحَجَر، ليكون أروَحَ له، قال الراجز: «2»
ما لك لا تنْحِطُ يا فلاّح ... إنَّ النَّحيطَ للسُّقاةِ راحُ
أي راحة. والنَّحّاط: الرَّجل المتكبِّر، وقال النابغة:
وتَنْحِطْ حَصانٌ آخِرَ اللَّيْل نَحْطةً ... تَقَضَّبُ منها أو تكادُ ضُلوعُها «3»
نطح: النَّطْح للكِباش ونحوها، وتناطحت الأمواج والسُّيُول والرجال في الحروب. والنَّطيح: ما يأتيكَ من أمامِك من الظِّباء والطَّيْر وما يُزْجَر. والنَّطيحة: ما تناطَحا فماتا، كان أهل الجاهلية يأكلونَها فنُهِيَ عنها.
باب الحاء والطاء والفاء معهما ف ط ح، ط ح ف، ط ف ح، مستعملات
فطح: الفَطَح: عِرَضٌ في وَسَط الرأس، وفي الأَرْنَبة حتى تلتزق بالوجه كالثور
__________
(1) زيادة من التهذيب 4/ 389 مما نسب إلى الليث.
(2) لم نهتد إلى الراجز ولا إلى الرجز في غير الأصول
(3) البيت في التهذيب 4/ 390 واللسان (نحط) والديوان (ط. دمشق) ص 124.
(3/172)
________________________________________
الأفطَح، قال أبو النجم:
قبصاء لم تفطح ولم تُكَتَّلِ «1»
طحف: الطَّحْف: حَبٌّ يكون باليَمَن يُطْبَخ «2» .
طفح: طَفَحَ النَّهْر إذا امتَلَأَ. والشارب طافح «3» أي ممتلىء سُكْراً. والرِّيحُ تَطفَح القُطْنةَ إذا سَطَعَت بها، قال أبو النجم:
مُمَزَّقاً في الرِّيح أو مطفوحا «4»
وما طَفَح فوقَ شَيءٍ فهو طُفاحة كطُفاح القِدْر.
باب الحاء والطاء والباء معهما ح ط ب، ح ب ط، ب ط ح مستعملات
حطب: الحَطَب معروف، حَطَبَ يَحطِب حَطْباً وحطبا، المخفف مصدر، والمثَّقَل اسم. وحطَبْتُ القوم إذا احتَطَبتَ لهم، قال: «5»
__________
(1) الرجز في التهذيب واللسان (فطح) .
(2) عقب الأزهري فقال في التهذيب 4/ 392 فقال: قلت هو الطهف بالهاء ولعل الحاء تبدل من الهاء.
(3) وعبارة التهذيب عن الليث: ويقال للذي يشرب الخمر حتى يمتلىء سكرا: طافح.
(4) الرجز في اللسان (طفح) .
(5) القائل (ذو الرمة) والبيت في الديوان ص 665، وعجزه:
أصول ألاء في ثرى عمد جعد.
(3/173)
________________________________________
وهل أحطِبَنَّ القوم وهي عَرِيَّةٌ
(ويقال) «1» للمُخلِّط في كلامه وأمره: حاطبُ لَيْلٍ، مَثَلاً له لأنّه لا يَتَفَقّد كلامَه كحاطب اللَّيل لا يُبصر ما يجمع في حَبْله من رديء وجيّد. وحَطَب فلان بفُلان إذا سَعَى به. والحَطَب في القرآن «2» النَّميمة، ويقال: هو الشَّوك كانت تَحمله فتلقيه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-. ويقال للشديد الهزال حَطِبٌ «3» .
حبط: الحَبَط: وَجَع يأخُذُ البعيرَ في بَطْنه «4» من كَلأَ يَسْتَوْبِلُه، (يقال) «5» : حَبِطَتِ الإبِل تحبَط حَبَطاً. وحَبِطَ عَمَلُه: فَسَدَ، وأحبَطَه صاحبُه، واللهُ مُحْبِطٌ عمل من أشرك. و [الحبطات] «6» : حيٌّ من تميم.
بطح: بَطَحْتُه فانبَطَحَ. والبَطْحاء: مَسيل فيه دُقاق الحَصَى، فإنْ عَرُضَ واتَّسَعَ سُمِّيَ أبطَح. والبَطيحة: ماء مستنقِع بينَ واسِطٍ والبصرة، لا يُرَى طَرَفاه من سَعَته، وهو مَغيض دجلةَ والفُرات، وكذلك مَغايض ما بين البصرة والأهواز، والطَّفُ: ساحل البَطيحة.
__________
(1) زيادة من التهذيب.
(2) في قوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وهي أم جميل امرأة أبي لهب وكانت تمشي بالنميمة. (التهذيب 4/ 394) .
(3) وفي اللسان: وأحطب أيضا.
(4) هذه عبارة التهذيب أما في الأصول المخطوطة فهو: وجع يأخذ في بطن البعير.
(5) زيادة من التهذيب
(6) كذا في التهذيب 4/ 397، أما في الأصول المخطوطة ففيها: الحبط.
(3/174)
________________________________________
وتَبَطَّحَ السَّيْل أي: سالَ سَيْلاً عريضاً، قال ذو الرمة:
ولا زالَ من نَوْء السِّماكِ عليكُما ... ونَوْءِ الثُرَيّا، وابِلٌ مُتَبَطِّحُ»
وقال الراجز:
إذا تَبَطَّحْنَ على المحامِلِ ... تَبَطُّحَ البَطِّ بشَطِّ الساحِلِ «2»
والبَطْحاءُ والأبْطَحُ ومنِىً من الأبْطح «3» . ويقال: بين قَرْية كذا وقَرْية كذا بطحة «4» بعيدة.
باب الحاء والطاء والميم معهما ح ط م، ط م ح، ط ح م، م ح ط، ح م ط، م ط ح كلهن مستعملات
حطم: الحَطْمُ: كَسْرُك الشَّيْءَ اليابس كالعظام ونحوها، حَطَمْتُه فانحَطَمَ، والحُطامُ: ما تَحَطَّمَ منِه، وقِشْر البَيْض حُطام، قال الطرماح:
كأنَّ حُطامَ قَيْضِ الصَّيْف فيه ... فَراشُ صَميم أقحاف الشئون «5»
والحَطْمَةُ: السَّنة الشديدة. وحَطْمةُ الأسَد في المال: عَيْثه وفَرْسُه. [والحُطَمَةُ: النّار] «6» . وقيل: الحُطَمَةُ: بابٌ من جهنّم. والحطيم: حجر مكة.
__________
(1) البيت في التهذيب واللسان والديوان ص 77.
(2) الرجز في التهذيب واللسان والرواية فيهما:
............... ........... ... تبطح البط بجنب الساحل
(3) كذا في س أما في ص وط فقد جاء: بطحاء وأبطح.
(4) كذا في ص وط أما في س فقد جاء: بطيحة.
(5) البيت في التهذيب واللسان (حطم) والديوان (ط. مصر) ص 178
(6) ما بين القوسين من مختصر العين، من الورقة 71، زيد هنا لتقويم العبارة.
(3/175)
________________________________________
طحم: طَحْمة السَّيْل: دَفّاعُه ومُعْظَمُه. وطَحْمةُ الفِتْنة: جَوْلة الناس عندها، قال: «1»
تَرمي بنا خِنْدُفُ يوم الايسادْ ... طَحْمةَ إبليسٍ ومَرداةَ الراد «2»
محط: مَحَّطْتَ الوَتَرَ: أمرَرْتَ الأصابعَ عليه لتُصلِحَه، وكذلك تُمَحِّطُ العَقَبَ فَتُخَلَّصُه، والبازي يُمُحِّطُ ريشه: يُذهبه «3» ، وتقول: امتَحَطَ البازي «4» .
طمح: طَمَّحَ الفَرَسُ رأسه أي رفعه، وكذلك طَمَّحَ يَدَيْه «5» . وطَمَحاتُ الدَّهْر: شَدائدُه، [وربّما خُفِّف] «6» قال: «7»
باتت همومي في الصدر تحضؤها ... طمحات دهر ما كنت أدرؤها
وطَمَّحْتُ الشْيَء وغيرَه في الهواء أي رَمَيْتُ به تطميحاً. وطَمَح ببَصَره إذا رَمَى به إلى الشيْء. وفَرَس طامِحُ البَصَر والطَّرْف، قال: «8»
__________
(1) لم نهتد إلى القائل ولم نهتد إلى مصدر البيت ولم نجده فيما بين أيدينا من مظان.
(2) لم نهتد إلى القائل ولم نهتد إلى مصدر البيت ولم نجده فيما بين أيدينا من مظان.
(3) كذا في الأصول المخطوطة، أما في التهذيب فقد جاء: يدهنه. نقول: وقد جاء في اللسان كما في الأصول المخطوطة.
(4) ورد في الأصول المخطوطة مما أخل به الناسخ كلمةمحط وهي حديدة يسقل بها الجلد حتى تلين. ووجه الإخلال أن هذه المادة هي في حطط ولا صلة لها ب محط.
(5) أصل هذه العبارة في التهذيب طمح الفرس رأسه ويديه أي رفعه، وقد آثرنا إعادة ترتيب العبارة على الوجه الذي أثبتناه.
(6) من التهذيب 4/ 404 عن العين.
(7) البيت في التهذيب 4/ 404 وفي اللسان (حثنا) أيضا، غير منسوب. في الأصول: تحطاها، وهو تصحيف.
(8) لم نهتد إلى القائل ولا إلى البيت.
(3/176)
________________________________________
طمحت رءوسكم لتبلُغَ عِزَّنا ... إن الذليل بأن يُضامَ جديرُ
حمط: الحمطيط و [جمعه] الحَماطيط، والحَماط: نبْت. والحَماطة: حُرْقة يجدُها الرجلُ في حَلْقه، تقول. أجدُ في حَلْقي حَماطةً.
باب الحاء والدال والثاء معهما ح د ث يستعمل فقط
حدث: يقال: صارَ فلان أُحدوثة أي كَثَّروا فيه الأحاديث. وشابُّ حَدَثٌ، وشابَّة حَدَثة: [فتيّة] في السِّنِّ. والحَدَث من أحداث الدهر شِبْه النازلة، والأُحدوثة: الحديث نفسه. والحديث: الجديد من الأشياء. ورجل حِدْث: كثير الحديث. والحَدَث: الإِبْداء.
باب الحاء والدال والراء معهما د ح ر، ح د ر، ر د ح، ح ر د، د ر ح مستعملات
دحر: دَحَرْتُه أدحَرُه دَحْراً أي بعَّدتُه ونَحَّيْتُه. ومَلُوماً مَدْحُوراً
«1» أي: مطرودا.
__________
(1) من سورة الأعراف، الآية 18، والآية هي: قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً.
(3/177)
________________________________________
حدر: الحَدْر: ما تحدِرُه من علو إلى سفل، والمطاوعة منه الأنْحدار، وحَدَرْتُ السَّفينة في الماء حُدوراً. والحَدور اسم مُنحَدَر الماء في انحطاط صبَبَه، وكذلك الحَدور في سَفْح جَبَل. وحَدَرْتُ القرِاءةَ حَدْراً، وحَدَرَتْ عيَنْي الدَّمْعَ، وانحدَرَ الدمعُ. وناقةٌ حادرةُ العينين أي ممتلئتهما «1» نقيا قد ارتوتا وحَسُنَتا «2» . وكل رَيّان حَسَن الخَلْق حادر، وقد حَدُرَ حدارة، قال: «3»
وعسير «4» أدماء حادرة العين ... خَنُوفٍ عَيْرانةٍ شِمْالال
وقال: «5»
أُحِبُّ صَبيَّ «6» السَّوْء من أجل أُمِّه ... وأُبْغِضُه من بُغْضِها وهو حادِرُ
وامرأةٌ حَدْراءُ، ورجل أحْدَرُ. والحَدْرة (جزم) «7» : قَرْحةٌ تخرج بباطن جَفْن العَيْن (وقد) «8» حَدَرتْ عينه حَدْراً. ويقال: الحَدْر في نعت العَيْن في حسنها خاصة مثل الحادرة، قال: «9»
وأنكرْتَ من حَدْراءَ ما كنت تعرف
__________
(1) كذا في س في ص وط: ممتلئتها.
(2) كذا في التهذيب مما نسب إلى الليث. في الأصول المخطوطة: قد ارتوت وحسنت.
(3) هو (الأعشى الكبير) ، والبيت في ديوانه (الصبح المنير) ص 6.
(4) كذا في الديوان ص 5. والتهذيب واللسان أما في الأصول المخطوطة ففيها: وعيسين، وهو تصحيف.
(5) لم نهتد إلى القائل، والبيت في التهذيب واللسان.
(6) كذا في الأصول المخطوطة، وأما في التهذيب واللسان ففيهما: الصبي.
(7) كذا في الأصول المخطوطة، ويراد به إسكان الدال في الحدرة، وقد صحف في التهذيب واللسان فصار جرم ولا معنى له.
(8) زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(9) القائل هو (الفرزدق) ، والبيت في التهذيب واللسان والديوان 2/ 551، وصدره:
عزفت بأعشاش وما كنت تعزف
(3/178)
________________________________________
وحيدرة: اسم علي بن أبي طالب عليه السلام- في التوراة، وارتجَزَ فقال:
أنا الذي سَمَّتْني أُمّي حَيْدَرَه «1»
وحَدَرَ جِلْده يحدُرُ حُدوراً أي تَوَرَّمَ، قال: «2»
لو دَبَّ ذرٌّ فوقَ ضاحي جلدها ... لأبانَ من آثارِهنَّ حُدورُ
ومنه يقال: حَدَرْتُ جلدَه بضرْبٍ، وأحْدَرتُ لغة.
ردح: الرَّدْح: بَسْطُكَ الشَّيء فَتُسَوٍّي ظهرهَ بالأرض، قال أبو النجم:
بَيْتَ حُتُوفٍ مُكْفأً مردوحا «3» ... شَخْتا خَفيّاً في الثَّرَى مدحُوحا «4»
يصف القُتْرة. ويجيء في الشعر مُردَح مثل مَبْسُوط ومُبْسَط. وناقةٌ رَداحٌ: ضَخْمة العَجيزة والمآكِم «5» ، تقول: رَدُحَت رَداحةً فهي رَدُوحٌ ورَداحٌ. وكَبْشٌ رَداح: ضَخْم الأَلْية، قال: «6»
ومَشَى الكُمأةُ إلى الكماة ... وقُرِّبَ الكبَشْ الرَّداحْ
وكتيبة رَداح: مُلَمْلَمة كثيرة الفُرسان «7» .
__________
(1) الرجز في التهذيب واللسان وهو أول ثلاثة أشطار.
(2) (عمر بن أبي ربيعة) ديوان ص 146 (صادر) .
(3) في صحاح الجوهري: مكفحا مردوحا.
(4) كذا في س وهو الصواب أما في ص وط فهو: شحتا بالحاء المهملة.
(5) جاء في التهذيب واللسان مما نسب إلى الليث: وامرأةرداح أي ضخمة العجيزة والمآكم.
(6) البيت في اللسان (ردح) غير منسوب.
(7) في التهذيب واللسان: وكتيبة رداح أي ضخمة ململمة....
(3/179)
________________________________________
حرد: الحَرَدُ مصدر الأحْرَد الذي إذا مَشَى رَفَعَ قوائمه رفعاً شديداً ويَضَعُها مكانَها من شِدَّة قَطافته في الدَّوابِّ وغيرها. وحَرِدَ الرجلُ فهو أحرَد إذا ثَقُلَتْ «1» عليه دِرعُه فلم يستطع الانبِساط في المشْي، قال:»
إذا ما مَشَى في دِرْعِه غيرَ أحرَدِ
والحَرْدُ والحَرَد لغتان، يقال: حَرِدَ فهو حَرِد إذا اغتاظ فَتَحرَّشَ بالذي غاظه وهَمَّ به فهو حاردٌ، قال: «3»
أسود شرى لاقت أسود خفية ... تساقين سما، كَلُّهُنَّ حَوارِدُ
وقطاً حُرْدٌ أيْ سِراع، قال: «4»
بادَرْتُ حردا من قطاها النامي
وقول الله جل ذكره: وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ
«5» ، أيْ على جِدٍّ من أمرهم. وحَرِدَ السَّيْرُ إذا لم يستَوِ قَطْعُه. والحُرْديّة: حِياصة الحَظيرة التي تُشَدُّ على حائطٍ من قَصَب عَرْضاً (تقول) «6» : حَرَّدناه تحريداً، ويجمع على حرادي.
__________
(1) في التهذيب: ثقل.
(2) الشطر في التهذيب واللسان غير منسوب أيضا.
(3) لم نهتد إلى القائل، والبيت من شواهد التهذيب واللسان. غير أن في اللسان رواية لبيت منسوب إلى (الأشهب بن ميلة) وهو:
أسود شرى لاقت أسود خفية ... تساقوا على حرد غماء الأساود
(4) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول.
(5) سورة القلم، الآية 25.
(6) زيادة من التهذيب.
(3/180)
________________________________________
وحَيٌّ حَريدٌ: (الذي) «1» ينزل مَنزِلاً من جَماعَة القبيلة لا يخالطهم في ارتِحاله وحُلُولِه. والحِرْد: قِطعة من سِنَام «2» . والمُحاردةُ: انقِطاعُ اللَّبَن من المَواشي والإبِل، وناقة مُحاردِ: شديدةُ الحِراد. والحَرْدُ: القَصْد، قال: «3»
أَقَبلَ سَيْلٌ جاء من أمْر الله ... يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المُغِلَّةْ
باب الحاء والدال واللام معهما ح د ل، د ح ل، ل ح د، د ل ح، مستعملات
حدل: الأحْدَلُ: ذو الخُصْيَة الواحدة من كُلِّ شيء، ويقال لمِائِل الشِّقَّينْ أيضا. والحودل: المُذَكَّر من القِرْدان. وبَنو حُدال: حَيُّ نُسبوا إلى محَلَّة [كانوا ينزلونها] «4» . والتَّحادُل: الانحناء على القوس.
__________
(1) زيادة من التهذيب مما نسب إلى الليث.
(2) وعلق الأزهري في التهذيب (4/ 415) فقال: قلت: لم أسمع بهذا لغير الليث، وهو خطأ، إنما الحرد المعى.
(3) البيت في التهذيب واللسان غير منسوب.
(4) تكملة من اللسان (حدل) ، للبيان.
(3/181)
________________________________________
دحل: الدَّحْل: مَدْخلٌ تحتَ الجُرْف أو في عُرْض جَنْب «1» البئر في أسفلِها، أو نحوه من المناهِل والموارد، ورُبَّ بيت من بُيُوت الأَعراب يُجْعَل له دَحْل تدخُلُ المرأةُ فيه إذا دَخَلَ عليهم داخِلٌ، وجمعُه دُحْلان وأدحال، قال: «2»
دَحْلُ أبي المِرقال خيرُ الأدْحالْ
والداحُول وجمعه دَواحيل: خشبات على رءوسها خِرَقٌ كأنهَّا طَرّاداتٌ قِصارٌ، تُرْكَز في الأرض لصيد الحمر «3» . والدحل: [ال] عظيم البطن، ويقال: الخَدّاع.
لحد: اللَّحْد: ما حُفِرَ في عُرْضِ القَبْر، وقَبْرٌ مُلْحَد، ويقال: مَلْحُود، ولَحَدوا لَحْداً، قال ذو الرمة:
أَناسِيُّ ملحود لها في الحواجب «4»
شبَّه إنسانَ العَيْن تحت الحاجِب باللَّحْد، حين غارت عُيون الإبِل من تَعَب السَّيْر. والرجل يلْتَحِد إلى الشَيء: يلجأُ إليه ويميَل، يقال: أَلْحَد إليه ولَحَدَ إليه بلسانه أيْ: مال، ويُقرأ: لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ ويلحدون «5» .
__________
(1) كذا في الأصول المخطوطة، في التهذيب واللسان: خشب. وهو تصحيف لأنه لا يتناسب مع قوله في أسفلها.
(2) لم نهتد إلى الرجز ولا إلى قائله.
(3) جاء في التهذيب واللسان: لصيد الحمر والظباء.
(4) وصدر البيت في الديوان ص 63 وهو:
إذا استوجست آذانها استأنست لها
(5) إشارة إلى الآية 103 من سورة النحل: لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.
(3/182)
________________________________________
وأَلْحَد في الحَرَم، (ولا يقال: لَحَدَ) «1» إذا تَرَكَ القَصد ومال إلى الظلم، ومنه قولُه تعالى: مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ
«2» يعني في الحَرَم، قال حميد الأرقط: «3»
لما رَأَى المُلْحِدُ حينَ أَلْحَما ... صواعِقَ الحجّاج يَمْطُرنَ دَما «4»
دلح: دَلَح البعيرُ فهو دالِحٌ إذا تثاقَلَ في مَشْيِه من ثِقَلِ الحِمْل. والسَّحابةُ تَدْلَح في سَيْرها من كَثْرة مائِها، كأنَّما «5» تَنْخَزِلُ انخِزالاً، قال: «6»
بينما نحن مُرتِعون بَفَلْجٍ ... قالتْ الدُلَّحُ الرِّواءُ أنيه «7» .
__________
(1) سقطت العبارة المحصورة بين القوسين من التهذيب واللسان مما نسب إلى الليث وبذلك اختل المعنى.
(2) سورة الحج، الآية 25
(3) الرجز في التهذيب واللسان وروايته في الأصول المخطوطة:
لما رَأَى المُلْحِدُ حينَ ألجما.
(4) وجاء في الأصول المخطوطة بعد هذا البيت ما يجب ألا يضم إلى كتاب العين لأنه كلام الليث وهو: قال الليث: حدثني شيخ من بني شيبة في مسجد مكة قال: إني لأذكر حين نصب المنجنيق على أبي قبيس، وابن الزبير متحصن في البيت، فجعل يرميه بالحجارة والنيران، فاشتعلت النار في أستار الكعبة (حتى أسرعت فيها) ، فجاءت سحابة من نحو الجدة مرتفعة كأنها ملاءة يسمع منها الرعد ويرى فيها البرق حتى استوت فوق البيت فمطرت فما جاوز (مطرها البيت ومواضع الطواف) حتى أطفأت النار، وسال المرزاب في الحجر، ثم عدلت إلى أبي قبيس فرمت بالصاعقة فأحرقت المنجنيق وما فيها. قال الليث: فحدثت بهذا الحديث بالبصرة قوما، وفيهم رجل من أهل واسط، وهو ابن سليمان الطيار شعوذي الحجاج، فقال الرجل: سمعت أبي يحدث بهذا الحديث، وقال: لما أحرقت المنجنيق أمسك الحجاج عن (القتال) ، وكتب إلى عبد الملك بالقصة على ما كانت بعينها، فكتب إليه عبد الملك: أما بعد فإن بني إسرائيل إذا قربوا قربانا فتقبل الله منهم بعث نارا من السماء فأكلته، وإن الله قد رضي عملك، وتقبل قربانك فجد في أمرك والسلام. نقول: ما ورد بين قوسين من كلام الليث المتقدم في هذه الحاشية (4) أخذناه من التهذيب لأن عبارته أصلح من عبارة الأصول المخطوطة.
(5) كذا في الأصول المخطوطة، أما في التهذيب مما نسب إلى الليث فإنه: كأنها.
(6) لم نهتد إلى القائل، ولم نجد البيت في أي من المصادر التي رجعنا إليها.
(7) لعلها: إن إية وخففت بحذف همزة (إيه) ونقل حركتها إلى نون (أن بدلالة قوله: أي: صبي وافعلي.
(3/183)
________________________________________
الموضوع:
الكتاب: كتاب العين2 بقسم



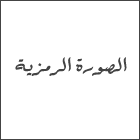







 العرض الشجري
العرض الشجري